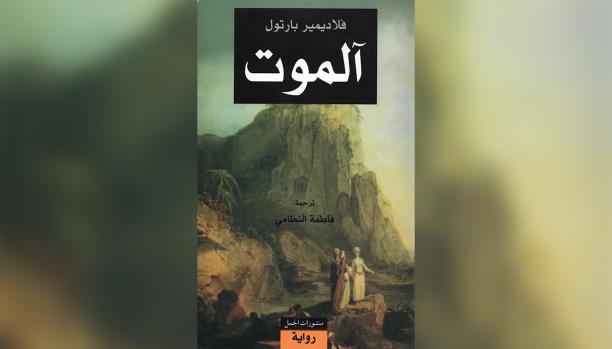يتقدّم المجتمع حين يصبح النقدُ شعاره ومساره
وفيق غريزي
هذا الكتاب شغوف بالابتهاج والسرور، لأنه يدعو الى ايقاد نيران المباهج وكأن الأمر يتعلق بيوم عيد. إنها دعوة الى فن الابتهاج، ليس بإمكان الانسان ان يتذوقه الا حين يحتفل بعيد الحرية، لأن ما يجعل عصرنا عصراً عظيماً هو الاعتراف بالحرية وملكية الفكر. لأن الانسان المجرد من الحرية والفكر يكون عبارة عن حيوان يقاد بالسوط لأنه مغمض عينيه خوفاً من رؤية شروق جديد ورائع للشمس، مثل الخفاش الذي يخيفه ضياء الشمس. أما الانسان الذي ينعم بالحرية والفكر فانه يتمتع بانخراطه في حديث التنوير الذي سيمنحه الثقة بالنفس لكي يحقق مرحلة الوعي بالذات ويتمكن من الثورة على قيود الطغيان والاستبداد. لكن هل يتعلق الأمر بحلم فلسفي يستحيل تحقيقه في الواقع، أم بواقع محنط ومسطح لا يؤمن بالحلم والحرية والفكر؟ هذا ما يجيب عنه كتاب الدكتور عزيز الحداوي.
الوعي بالذات
عندما تتحول كل الطرق التي يسلكها فيلسوف ما، بالرغم منه، الى طرق تيه، غالباً ما تقوده الى نعمة الصمت والانصات الى نداء المدى الذي يسكنه في غسق العزلة، ومتعة العيش مع الواحد، يجد نفسه يتمرن على اكتساب مقام السعادة، لا من أجل احتقار حاضره، ولكن بغية امتلاك بهجة تحريك الرغبة في هدم الأصنام والقصور الفكري والعدمية السياسية التي تجعل من الانسان مجرد عبد يسير بالجهل والعنف والتجويع من قبل سلطة تتحكم في متاهات الدولة التي تحتكر العنف وشرعية استعماله، “إنها مجرد آلة تنتج أصنافاً متنوعة من العنف وتبيعها للسلطة بأجور مرتفعة، حيث تصبح السلطة الحاكمة مجسدة من قبل الدولة”. ذلك ان العلاقة بين السلطة والدولة لا يحددها الا المكر والخداع.
الواقع ان التدخل العنيف الذي استهدف سقراط، قد صدر عن وحش يعيش خارج دائرة اللوغوس، ولم تكن تهمة أسئلة الفيلسوف حول العدالة، بل ما كان يهمه هو الشخص “الفيلسوف” المزعج بأسئلته، لأن العدالة هي نعمة من السماء يطبعها مبعوث الله في الأرض. ويرى المؤلف ان الانسان أجبر على تقبلها، ولا يحق التساؤل بصددها، والا سيصبح مزعجاً، مربكا للنظام الالهي، وغير مرغوب فيه بالمدينة.
فمبدأ الحرية ومصدرها كامنان في الانسان ذاته، والناس، يقول المؤلف: يضعون تاريخهم ويحققون العجائب عندما تصلهم نعمة الحرية والقدرة على الحركة”. هكذا نجدهم يؤسسون واقعهم ويبدعون مستقبلهم، لأن التقدم العلمي والازدهار الاقتصادي والتقني، والرقي الحضاري مرتبطة كلها بالانسان المتنور الذي يعيش في نعيم الحرية والديموقراطية بعدما قام بثورة على السلطة ونسف متجدد من العدمية الأسياد الطغاة.
الثالوث المقدس
التنوير ـ الثورة ـ الحداثة
ان التنوير أبديّ ما دام هناك استبداد واستعباد للانسان، انه ممتزج بنسيم الحرية ومذاق العدالة والديموقراطية، “انه تاج مملكة النزعة الانسانية الذي يعيد للانسان قدسيته ويحرره من الطغاة الذين يستعبدونه مقابل أتفه الأشياء: الثروة وسادية السلطة” ان الغاية من ذلك هي الوصول الى حقيقة الحقيقة التي تقول: “لا حداثة بدون ثورة، ولا ثورة بدون تنوير”. فهذا الثالوث المقدس يشكل ماهية سيرورة التاريخ، لأن الانسان، خلق حراً، وأخذت او سلبت منه حريته، اذ لا بد من استرجاعها بمجرد ما تصيبه رياح التنوير ويحقق وعيه الذاتي، اي بمجرد ان يتحول من حيوان الى انسان حين يصل الى امتلاك ما يمتلكه طبيعياً وهو نور العقل، ويستعمله استعمالاً جيداً للحصول على الحق في الحق. والانتماء الى مملكة الحقيقة. وهنا نسأل ما هي الحداثة؟ وما علاقتها بالراهن؟ وكيف يمكن ان تصبح موضوعاً للفلسفة حين تدرك عصرها. بل أكثر من ذلك، ما علاقة الفيلسوف بعصره، بحاضره، بما يحيط به؟ ولماذا يتحمس الى التنوير والى الثورة، والى النزعة الانسانية التي تقوم بطرد الأشرار من مملكتها؟.
من أجل الحداثة والحديث عن سؤال الحداثة الذي طرح في الثقافة الكلاسيكية، يؤكد المؤلف ان الحداثة مشروع مكتمل يؤخذ بكامله، أو يرفص بتمامه، غير قابل للانتقاء. إنها كالدواء الأعظم الذي يصفه طبيب الحاضرة للمجتمعات التعيسة والبائسة، التي تسير في طريقها نحو الانهيار والانقراض. لا بد ان يؤخذ هذا الدواء كاملاً لكي يعطي مفعوله، لأنه من الواجب ان تقوم بجنيالوجيا الحداثة، لا كمفهوم، ولكن الحداثة كسؤال انبثق من النص الكانطي حول التنوير والثورة مع العلم ان هذا السؤال يشكل هو نفسه جزءا من سيرورة التاريخ في معناه العام، حيث يصبح التنوير يستحق اسم التنوير بمجرد تماهيه في سيرورة ثقافية متميزة حققت وعيها الذاتي عندما اختار اسمه.
سياسة العدمية والبداوة
الواقع ان العالم العربي حتى الآن لم يطرح سؤالا ذا ثقل وجودي كالذي طرحته الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية وما استتبعته من بؤس وفقر وجهل، ومن المؤسف، يقول المؤلف: “ان العالم العربي قام بإحباط كل من تجرأ على التساؤل من خلال وضعه أمام مقدسات البلاد التي لا تتغير بالزمان”. انها ثابتة في لحظة ما من التاريخ. هكذا يجد العالم العربي نفسه في معزل عن التحولات الكبرى التي عرفها العالم، انه يستريح على جسر يقع فوق الهاوية مطمئناً بعيداً عن ضوضاء التغيير والايمان بحق المواطنين اصحاب الرأي بحكم أنفسهم بأنفسهم وليس بالرجال وهم أكسل الناس حسب قول أرسطو. ذلك ان العالم العربي المحافظ الوسطوي، لا يهتم بالفكر، او بالفلسفة السياسية، بل يرى فيها فكراً مزعجاً بأسئلته وإثارته للدهشة، والنقد، والدفع بالانسان نحو امتلاك انسانيته من خلال المعرفة، والكرامة، والحق في الحق. وذلك الاهتمام بالانسان، يؤكد المؤلف، ليس معناه توزيع طعام اليوم في رمضان، بل يعني ان توجد في الاشياء وبينها وربما الاقامة في كينونتها وجعلها في خدمة النبل والمحبة والفضيلة، لكونها بوابة مفتوحة على انسانية الانسان.
هكذا تكون العناية بالفلسفة السياسية شهادة على اننا قادرون على التفكير في عصرنا وراهننا، لعل هذا ما سيبعد عن العدمية وتجار الحقيقة وبائعي النزعة الانسانية الذين قاموا باغتيال نبل السياسة في قلوب الناس وتحولت الى مجرد مجرم يتعين القبض عليه لأنه يتاجر في المخدرات وأرواح الناس ويصفق في البرلمانات.
وهنا يتساءل المؤلف: “كيف يمكن التخلص من العدمية؟ اكثر من ذلك أين تقيم العدمية: هل في المجتمع، أم في المؤسسات التي تسيّر البلاد، أم في الفضاء السياسي؟”.
ان العدمية تحيط بعنايتها العالم العربي، ما دام ان الفكر قد هاجر كطائر جريح، وكلما اراد العودة يفكر في تلك الشباك التي تريد ان تصطاده، لأنه يطالب بالحرية والسياسة الحقيقية، وليس سياسة العوام، كما يطالب بالعدالة والديموقراطية وكرامة الانسان، حيث من العيب ان تنحدر طبقة متوسطي الحال الى الطبقة الكادحة وتتحالف معها ضد الطغيان.
السياسة والعائلة المقدسة
إننا في حاجة الى عصر تنوير يخرجنا من ظلامية الفكر ودوغمائية الرأي السياسي التي قتلت في الناس الثقة في براءة السياسة باعتبارها حياة الدولة، لأن الدولة تنهار بمجرد ان تموت السياسة في قلوب متوسطي الحال باعتبارهم عماد الدولة. والواقع، حسب اعتقاد المؤلف، ان العالم العربي الآن بحاجة ماسة الى بناء قنطرة توصله بعصر التنوير، ويعتبر هابرماس ان مشروع عصر التنوير لم يكتمل بعد لأنه لم يحقق كل غايته، وما دام ان هناك فلسفة فستظل الحاجة الى التنوير ملحة وأن الفلسفة تقوم بالنقد للانحرافات الأخلاقية لأن الانسان المعاصر هو نتاج للنقد. ذلك ان المجتمع يتقدم حين يصبح النقد شعاره، باعتباره ذاكرة وسجلا لهذا المجتمع.
يقول المؤلف: “ان ما يقع في العالم العربي يشبه الى حد ما تلك الجثة التي يتم تأجيل دفنها لأنها ولود”. وكان هنري كوربان قد تنبأ بمستقبل ظلامي للعالم العربي حيث قال “إنه بتشييع جنازة ابن رشد قام المجتمع العربي بتشييع الفلسفة في العالم العربي والشاهد على ذلك ان العالم العربي ينتج خطابا مزدوجاً تجاه الفلسفة”. ولسنا ندري هل يحبها أم يكرهها، لكننا على يقين بأننا مهمشون ومبعدون نتوجه نحو ذلك المدى البعيد لأننا مجرد فلاسفة نزعجهم بنقدنا وعشقنا للحقيقة، ولعل “أهم مثال يتجلى في النبذ والقهر الذي مارسته وزارة الثقافة العربية على أصدقاء الفلسفة”.
وإزاء ذلك لا بد من تأسيس نظرية للمعرفة تكون هي عماد نظرية الوجود والعالم، فبدون تنوير وبدون معرفة لا يمكن استعادة الفلسفة وبناء الإنسان الأعلى الذي يرى من خلال نور العقل، وليس الإنسان باعتباره آلة متنفسة مجردة من العواطف وفاقدة للعقل. لأن هذا الإنسان قد اقترب من النهاية والانقراض الأبدي، باعتباره قد حكم على نفسه بالاقامة في نعيم القصور الفكري من أجل أن يسير من قبل سياسة الخبث والتفاهة، باعتبارها مقاولة للضجيج واغتيال الآمال.
[ العالم العربي في ضيافة العدمية
[الدكتور عزيز الحدادي
[دار التنوير ـ بيروت ـ 2011
المستقبل