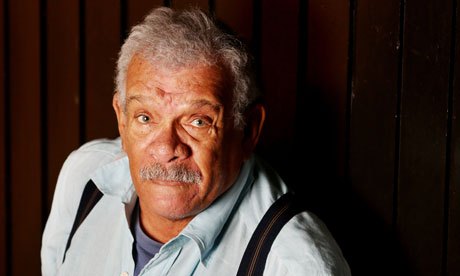يوم في اللاذقية… هل أصبنا بمرض شراهة الحزن؟!
هيفاء بيطار
ما إن أنزلق داخل حزني كل صباح، حتى يبدأ يومي.
صرت أتحاشى النظر إلى وجهي في المرآة كي لا أواجه ذلك الكائن الذي يستحوذ علي والذي يكتسحني: الحزن.
أقف مقابل مستشفى الأسد الجامعي لأوقف تاكسي يقلني إلى المستشفى الوطني، كل صباح تطالعني وجوه جديدة لشهداء وقتلى في عمر الورود. التجديد الوحيد في سوريا هو وجوه القتلى! لا أصدق أن الموت في سوريا هو حقا موت! أحيانا أصر على إقناع نفسي بأن هذا الموت ليس سوى تمثيلية، شيء من لهو، من مزاح ثقيل وبأنه من المستحيل أن يكون عدد القتلى 200، وسطيا كل يوم! ونحن نعيش تحت لافتة كبيرة حقوق الإنسان!
أقول لسائق التاكسي: إلى المستشفى الوطني من فضلك. يسألني أين تقع؟ أعرف من لكنته أنه من حلب. أتأمل ملامحه في المرآة الأمامية للسيارة، يصعقني حزنه، صرت فنانة في تصنيف أنواع الحزن، أعرفه من تلك الصلابة الخفيفة في الجبهة ومن النظرة الحائرة المنطفئة في العينين. أقول له: حسنا سأدلك على طريق المستشفى. أسأله عن حلب، أشعر أن مواطنة سورية حزينة تسأل مواطناً سورياً منكوباً عن حلب! يخبرني أن بيته تدمر بالكامل وبأنه بالكاد استطاع الهروب من جحيم القصف مصطحبا زوجته وأطفاله الأربعة، وبأنه استأجر شقة بائسة في البسيط لأنه لا يملك مالا لاستئجار شقة في اللاذقية. يخبرني أن أولاده لا يذهبون إلى المدرسة وأن ابنته الكبرى تظل نائمة لأنها حزينة جدا وتفتقد بيتها في حلب ومدرستها وصديقاتها. سألته ماذا تعني بأنها تظل نائمة!
قال: كما قلت لك تظل نائمة لا تريد أن تصحو، ولولا أمها التي توقظها لتأكل لبقيت مستلقية على الفرشة كميتة.
– ما عمرها؟
أجاب: 12 سنة.
قلت له: لكنها بحاجة لعلاج نفسي فهي تعاني من صدمة عصبية.
انفجر ضاحكا بمرارة مكررا كلماتي بسخرية لا تخفى: ما ناقصنا إلا العلاج النفسي! أوراق نعي جديدة تفرش الجدار الخارجي للمستشفى الوطني. كلهم الشهداء الأبطال. وأنا أخربش توقيعي على دفتر الدوام ألتقط حديث اثنين من زملائي:
– تصور أهله دفعوا 7 ملايين ليرة فدية عن ابنهم المخطوف، وهم يعرفون تماما من خطفه لكنه لم يرجع.
– وكيف دفعوا قبل أن يفكوا أسره!
– ما بيدهم حيلة.
أمشي شاعرة أنني أنزلق نحو هاوية برغم خطواتي المستقيمة، أفكر أنني يجب أن أشحذ تفكيري لاختراع آلة تشبه المضخة تساعد السوريين على ضخ حزنهم الذي يفوق قدرة الإنسان على تحمله كي يضخوا أحزانهم إلى الخارج! كي لا ينفجروا كفقاعات الغيظ والقهر. نتحلق ممرضات وأطباء حول فنجان القهوة، أشعر أننا في جلسة عزاء، فالحديث دوما عن قتلى ومخطوفين وعن فظائع! نحاول (كل منا) أن يستمد شيئا من عزاء من نظرة إنسانية وصوت إنساني، نحتاج أن يذكر بعضنا بعضا أننا بشر نحيا. لكن الحقيقة المفزعة التي تصلنا، وكل منا مرآة الآخر، بأنك حين تعيش في بلد القتل اليومي والتدمير اليومي ولمدة تقترب من عامين، فهذا يعني أنك أنت ذاتك تصير موتا، أنت ذاتك تتحول رغما عنك إلى إنسان يتحرك ويمشي ويأكل وهو مسكون بالموت.
أتذكر موعدي مع العقيد في فرع أمن الدولة في اللاذقية. لقد طلب مني مراجعة الفرع حال عودتي من البحرين. لا يزال منعي من السفر قائما وعلي كل مرة أن أقدم إذنا للسفر!
مشيت متجاوزة الحواجز الإسمنتية وحواجز أكياس الرمل المكدسة. بدا المنظر أشبه بشرايين مقطعة. فكرت أنني ما عدت أميز لا في لغتي ولا أحاسيسي بين جسد الإنسان والمكان. كما لو أن المكان هو الجلد الحقيقي لنا.
صُعقت حين وجدت شجرة ياسمين عملاقة خلف الباب الحديدي العملاق لمبنى أمن الدولة، شجرة موفورة الحيوية والصحة ومثقلة بالزهور البيضاء البديعة. فكرت كيف تجرؤ شجرة ياسمين على التباهي بزهور روحها في مبنى أمن الدولة! لوهلة انتابني الشك بأنها اصطناعية، لكنني مددت يدي وقطفت بعضا من زهورها ودسستها في جيبي فسرت رعشة فرح، كدت أنساه، في روحي، وابتسمت ابتسامة خرجت من شغاف قلبي، وأضاءت عينيّ المعتمتين بالأسى.
سألني العقيد بلطف وإيجاز عما فعلت في البحرين، ثم طلب من موظف أن يصحبني إلى غرفة مجاورة ليسجل بدقة لامتناهية ماذا فعلت في البحرين. وطلب هويتي وأخذ يكتب ببطء. وددت لو أسأله لم لا يحضرون آلة لتصوير الهويات بدل أن تظل أنفاسنا عالقة بقلم الموظف.
قررت أن أمشي وصورة شجرة الياسمين المزهرة بإفراط في مبنى أمن الدولة قد أمدتني بحيوية مباغتة. لكن مع كل بضع خطوات يفاجئني المتسولون وخاصة من النساء والأطفال. النساء يحملن بطاقة هوية كي يؤكدن للمارة أنهن من المناطق المنكوبة والمدمرة، والأطفال يحملون علبا صغيرة ممتلئة بحبات العلكة. بدت لي العلكة أهم مادة في الحياة لأنها تساعدنا على مضغ أحزاننا وهضمها.
أطفال سوريا النازحون يهيمون على وجوههم، يبيعون العلكة ويرتمون بين السيارات كمن يرغب أن يموت ويفر إلى سماء رحيمة.
تستوقفني وأنا أمشي لوحات إنسانية مروعة كما لو أنني أحضر معرضا للبؤس الإنساني. يجمدني منظر شاب في حضنه طفل يبكي عمره أشهر وقدماه مزرقتان من البرد والى يمينه طفلة تنام على قارعة الرصيف على وسادة أحلامها المقصوفة بشظايا ورصاص، والى يساره طفل يمضغ بضجر قطعة خبز. أقف أمام المشهد الحقيقي، أشعر بانصعاق أن ما أراه حقيقي! نتبادل نظرة أنا والأب، نظرة تخلق نفقا يعج بآلاف النازحين والقتلى. لا أجرؤ على أن أسأله أي سؤال، إذ أخشى أن يقصم جوابه ظهري، فما عدت أتحمل المزيد والمزيد من الحزن، كما لو أن الشعب السوري مصاب بمرض شراهة الحزن: يصلني دعاءه: الله يوفقك ويحفظك.
ينقذني من ذاتي اتصال صديقة تسألني إن كنت أرغب بمرافقتها إلى المدينة الرياضية التي تغص بالنازحين، كي نقدم هدايا العيد للأطفال. ياه كم صرت هشة، كيف فجرت تلك العبارة البسيطة دموعي. كيف فجرت تلك العبارة «هدايا العيد للأطفال» سؤالا صعبا: كيف يمكن أن نحافظ على بذرة الحياة وسط محيط الموت والقتل والدماء والدمار؟
كيف يتحول وجودنا إلى معركة حقيقية كي نقنع أنفسنا بأننا أحياء حتى اللحظة!
ألا يجب أن نعيد تعريف الحياة!
هل نحن أحياء حقا ونحن نعوم على بحيرة من دماء السوريين والعالم المجرم يتفرج! وبان كي مون يرقص رقصة لا أعرف اسمها وتغيب عيناه من الضحك.
أكياس طافحة بهدايا العيد حملناها إلى أطفال سوريا النازحين. شعارات ونداءات في الفضائيات.
تبرعات من أجل الشعب السوري.
ضحايا العيد من أجل الشعب السوري.
لكن لا داعي لأضاحي العيد. لا داعي لذبح الخراف فالشعب السوري هو الأضاحي.
الشيطان استحى في سوريا من وحشية القتل، فقال للسوريين: اتقوا الله.
الشيطان خسر معركته في سوريا واعترف بأن هناك شياطين للقتل في سوريا تتفوق عليه.
في زاوية من حديقة المدينة الرياضية استوقفتني لوحة مذهلة: لوحة تستحق جائزة عالمية لمن يبغون الشهرة في التقاط صور معبرة. أم تلبس عباءة سوداء مهترئة وتحمل في يدها قطعة قماش، وابنها متكوّم كجنين في جاط بلاستيكي ينتظر أن تحممه بزجاجة ماء واحدة فقط!
أم وطفل كان لهما بيت وسقف. كانا يملكان كرامة وإنسانية وماء حياة. الآن عليها أن تجهد فكرها بأمر واحد فقط، كيف ستكفي زجاجة ماء كي يغتسل ابنها على مرأى الجميع كقط، ككلب، إنما ليس كإنسان.
اقتربت من الطفل حاملة هدية العيد. اختطفها من دون أن ينظر إلي. تواريت وراء حائط أرقب الأم تحمم ابنها. تذكرت طقوس المعمودية عند المسيحيين. فكرت أن معمودية الماء لم تعد تكفي في سوريا، بل صار واجبا علينا أن نتعمد بالدم.
السفير