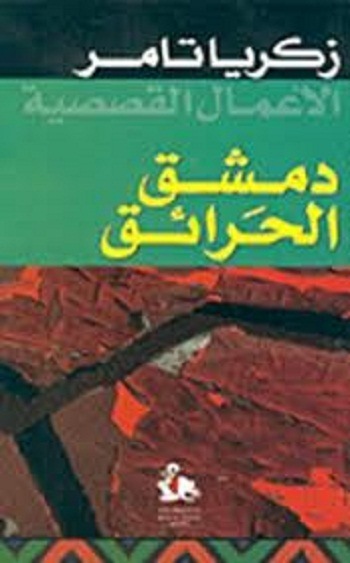إرهاب مانشستر وإعادة إنتاج التنميطات العمياء/ صبحي حديدي

مدهش أن يقرأ المرء من معلّق مخضرم في شؤون الشرق الأوسط، مثل باتريك كوبرن، في الـ»إندبندنت» البريطانية أمس؛ اختزالاً مذهلاً للإرهاب الجهادي الذي ضرب مدينة مانشستر مؤخراً، وقبلها لندن وباريس وبروكسيل: أنّ الأصل في هذا الجهاد هو الوهابية، وبالتالي المملكة العربية السعودية، وهذا ما يتعمّد الغرب عدم الإشارة إليه بسبب علاقات المال والأعمال مع آل سعود. «ما صار يُسمّى الجهادية السلفية، جوهر عقائد تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة، انبثق من الوهابية، وحمل عقائده إلى المجموعات الإرهابية كنتيجة منطقية وعنيفة. الشيعة واليزيديون لم يكونوا هراطقة في نظر هذه الحركة، التي كانت طرازاً من الخمير الحمر الإسلاميين، بل كائنات بشرية أدنى يتوجب استئـــــصالهم أو استعبادهم»؛ يكتب كوبرن.
بعض هذه الخلاصة، في ما يخصّ علاقة الجهادية السلفية بالوهابية تحديداً، هو كلام حقّ بالطبع؛ ولا جديد فيه أصلاً، بل بات تحصيل حاصل، قبل «داعش» بعقود، وربما قبل صعود منظمة «القاعدة» ذاتها. ما هو باطل، في المقابل، واختزالي على نحو فاجع إذْ يصدر عن كوبرن نفسه، إنما يتمثل في انتقاء جذور شبه وحيدة، لظاهرة باتت كونية ومتعددة النطاقات والعقائد، ومن الجهل والفظيع، والحماقة التي لا تُغتفر، أن يتمّ حصرها في جذور أحادية، وتربة وحيدة، هي الوهابية.
فإذا صحّ أننا لا نسمع عن مجموعات إرهابية يزيدية (وجمع هذه العقيدة مع الشيعة خيار فاضح بدوره، وقاصر وجاهل، أصلاً)؛ فهل يعقل أنّ كوبرن لم يسمع بإرهاب «شيعي»، على غرار ما مارسته وتمارسه مفارز «الحشد» هنا وهناك في العراق، وفي الموصل بصفة خاصة؟ هل كان صعباً عليه أن يخطف نظرة سريعة إلى موقع «غوغل»، فيقرأ ما وثقته مجلة «دير شبيغل» من جرائم عناصر «الحشد»، الذين أطلقت عليهم الأسبوعية الألمانية صفة «الوحوش»، ليس أقلّ؟ الأرجح أنّ كوبرن يعرف، بل لعله أعرف منّا بالنظر إلى صلاته العتيقة بالمنطقة، وليس سكوته عن تلك الانتهاكات إلا بعض أغراض سيرورة الاختزال؛ هذه التي لم تعد ركيزة كبرى في كتاباته، وأمثاله، فحسب؛ بل باتت منهجية راسخة في فرز جماعات المسلمين إلى معسكرين: واحد يفرّخ الإرهاب (من أهل السنّة، عموماً، الذين يعادون المثليين وحقوق المرأة، أيضاً!)؛ ومعسكر آخر يتوجب تصنيفه في الطرف النقيض (من الشيعة واليزيديين، ولا نعرف على وجه الدقة لماذا تجاهل كوبرن الفرق الإسلامية الأخرى!).
وهذه المنهجية تستدعي التذكير، مجدداً، بأنه إذا كانت يد الإرهاب عمياء غالباً تجاه يخصّ الضحايا، لأنّ البطش هنا يظلّ عشوائياً واعتباطياً، لا يكترث بإقامة أية موازنة بين الغاية والوسيلة؛ فإنّ نقطة الاستذكار التالية، المقترنة بالأولى مباشرة، هي حقيقة أنّ المنخرطين في مختلف مستويات الإرهاب ليسوا دائماً قتلة محترفين، تخرّجوا من مدارس الجريمة المنظمة والعنف وسفك الدماء. الثابت، خاصة بين شرائح مجنّدي «داعش» على الأرض الأوروبية، أنّ غالبية كبيرة من هؤلاء ليست مصابة بمسّ من جنون متأصل، تجعلها في حال من البغضاء المطلقة ضدّ الإنسانية جمعاء (كما يوحي هواة التنميطات المسبقة، العنصرية منها تحديداً)؛ أو ضدّ «النموذج الحضاري الغربي»، كما يساجل دعاة صدام الحضارات، ممّن يستهويهم حصر مشكلات الإرهاب في جذور عقائدية ـ دينية تخصّ الإسلام أوّلاً.
ذلك، في خلاصة موازية غير اختزالية، يعني أنّ بعض أسباب الأعمال الإرهابية الداخلية، إذا جاز التعبير، أي تلك التي تشهدها المجتمعات الغربية على أيدي أبنائها وليس بأيادٍ خارجية؛ ليست بعيدة عن سياقات التربية العائلية، ومشكلات الحياة اليومية، وطبائع السلوك العام، والأمزجة النفسية، والنزوعات الفكرية والثقافية. تلك، في مثال أوّل، كانت حال مايكل أديبولاجو، البريطاني من أصل نيجيري، مرتكب الجريمة الإرهابية البشعة التي وقعت في ضاحية وولتش، جنوب شرقي العاصمة البريطانية لندن، قبل سنوات قليلة: لقد ولد في بريطانيا، ودرس في مدارسها، وانتسب إلى إحدى جامعاتها، حتى ساقته الأقدار (في سنّ البلوغ!) إلى اعتناق الإسلام، ثمّ التطرّف في فهم التباس العلاقة بين الغرب والمسلمين، وصولاً إلى اعتبار كلّ جندي بريطاني مسؤولاً عن «قتل المسلمين كلّ يوم»، كما ردد على الملأ، حاملاً ساطور ذبح يقطر دماً.
تلك، أيضاً، كانت حال ياسين حسن عمر ومختار محمد سعيد إبراهيم ورمزي محمد وحسين عثمان، البريطانيين من أصول مسلمة، الذين حوكموا وأُدينوا بالتخطيط لأعمال إرهابية واسعة النطاق شهدتها العاصمة البريطانية، صيف 2005. فهل كان سقوط هؤلاء في حمأة الإرهاب والكراهية والقتل العشوائي وهستيريا الاستشهاد الزائف، بمثابة مآل حتمي لتعاليم الديانة التي اعتنقوها؟ أم جرّاء تفسير متطرّف لمصائر تلك الديانة في الأحقاب المعاصرة، بعد أن تسيّست على أيدي سلطات حاكمة فاسدة ومجموعات متشددة على حدّ سواء؟ أم لأسباب تربوية ذات صلة بهذه الاعتبارات وغير منفصــــــلة عن وضعــية الالتباس ذاتها، بين الغرب والعالم المسلم؟ أم، أخيراً، وكما يستدعي المنطق البسيط، للأسباب هذه كلّها، مجتمعة ومتكاملة ومترابطة؟
وما دامت هذه السطور تتناول واقعة مانشستر الإرهابية، ثمة هنا مثال ثالث تصحّ استعادته لأنه قد يمثّل المستوى الأقصى في توصيف الإشكالية بأسرها؛ أي حال ازدواج الشخصية التي كان يعيشها حسيب صادق وشاهزاد تنويري ومحمد خان، إرهابيو عمليات تفجير أنفاق لندن، صيف ذلك العام أيضاً، والتي أوقعت 52 قتيلاً ومئات الجرحى: بين اندماج كامل، أو شبه مكتمل، في الحياة البريطانية والحضارة الغربية إجمالاً؛ وبين انسلاخ إرادي عن هذه الحياة، استجابة إلى اعتبارات عقائدية صرفة، لا تغيب عنها السياسة دون ريب. وبهذا المعنى تصبح التفسيرات الأحادية لسلوك هؤلاء الإرهابيين مجرّد لغو، لأنهم لم يرتكبوا تلك الفظائع احتجاجاً على هذا أو ذاك من أعراف الحضارة الغربية وأعرافها، أو هذه أو تلك القضايا التي تخصّ واقع الإسلام في بريطانيا؛ أو ـ في استطراد المنطق ذاته ـ لأنّ الوهابية كانت، وحدها، فلسفة التشدد والعنف الطاغية في نفوسهم.
والحال أنه ليس مدهشاً، في الخلاصة، أنّ اختزالات معلّقين من أمثال كوبرن لا تبدي كبير اكتراث بالسياسة، أو بالأسباب الأعمق ـ الجديرة، أولاً، بالصفة الراديكالية ـ التي قادت أمثال سلمان عبيدي، إرهابي مانشستر، إلى «داعش»، في ليبيا أو سوريا أو العراق؛ ثمّ آبت بهم إلى بروكسيل، وقبلها باريس، وأورلاندو، وبعدها لندن، ثمّ مانشستر قبل أيام؛ لكي لا يعود المرء بالذاكرة إلى حقبة أسبق، لم يكن الخليفة البغدادي قد تسيدها بعد، حين أصاب الإرهاب قطارات مدريد وأنفاق لندن وباريس. حتى الاجتماع السياسي، في حدوده الدنيا، وبمعنى روابط الحياة العائلية مع السياسة في الشارع والوجدان والثقافة والديانة، لا يُطرح إلا على نحو انتقاصي واختزالي. تأثيراته ليست هيّنة بالتأكيد، لكنها ليست العوامل الكبرى الحاسمة في تكوين الذهنية الجهادية، ثم الإرهابية الانتحارية.
ليس أسهل من أن يدين كوبرن الوهابية، ويدين تغاضي الغرب عن السعودية (وكان سهلاً عليه، كذلك، لو تذكّر كيف دُشّنت «الصناعة الجهادية» من أفغانستان، ضدّ السوفييت، ليس بوحي من الوهابية بل بهندسة من زبغنيو بريجنسكي مستشار الأمن القومي في رئاسة جيمي كارتر، وتنفيذ المخابرات المركزية الأمريكية والبنتاغون). ثمّ، في استكمال المعادلة هذه، ليس أيسر على المعلّق المخضرم من أن يقرأ واقعة إرهاب دامية، مثل تفجير الحفل الغنائي في مانشستر، ليس من منطلق الذهاب إلى جذور الظاهرة، بل بقصد إعادة إنتاج التنميطات العتيقة التي باتت أسطوانة مشروخة.
وليته زاد في الطنبور نغماً، واحداً على الأقلّ!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
القدس العربي