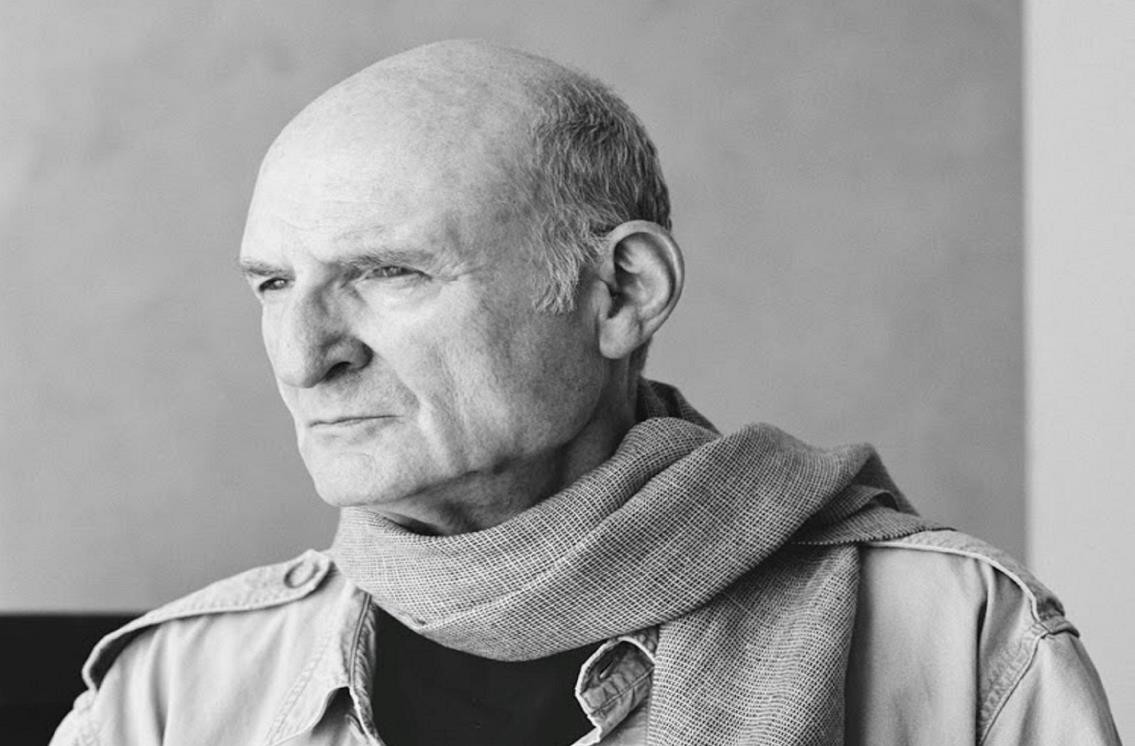الكاتب يردي ضحاياه!/ إبراهيم اليوسف

يسأل المرء نفسه، وهو يتابع ما يقدم عليه بعض من الكتاب والكتبة، من مواقف لا يمكن أن تبدرعن أي «أزعر»، لأنه حتى لهذا الأنموذج الأزعر، نفسه، ثمة ضوابطه التي يتقيد بها، ولا يخرج عنها إلا ضمن حالة سايكولوجية وحشية، يفترض بالكاتب، حتى المبتدئ، أن يترفع عنها، لاسيما عندما تنطلق كتاباتهم، من بؤر كيدية، لا علاقة لها البتة، بمنظومة القيم الأخلاقية التي تحصن الكاتب، وتجعله يلتزم بها، بما يجعله يناقش حتى ما يطرحه خصومه في الرأي، الذي ينكرون عليه، ليس حرية رأيه-فحسب- وإنما حياته، أيضاً، وقد امتلأت المكتبة الكلاسيكية بتلك الحوارات الحادة، التي طالما تمت بين أصحاب آراء متضادة، بحيث يكون لكل طرف من الأطراف قاعدته الفكرية التي ينطلق منها، تاركين للمتلقي، تشكيل موقف ما، إلى جانب هذا الرأي، أو الآخر، أو حتى نفي الرأيين معاً، والخروح برأي آخر.
بعد بدء الثورة السورية، وظهور التشكيلات الاجتماعية والثقافية المتناحرة، صار في إمكان أي متابع حصيف أن يقول:»هل كان هؤلاء يعيشون بيننا حقاً؟» أو «أليس من الضروري أن يكون هناك في حدود محيط أي كاتب ينتهك حرمة الكتابة ويسيء إلى المتلقي أن يقنعوه بالإقامة في أي مصح عقلي، شأنه في ذلك شأن أي كائن يصاب بعدوى السعار، إذ يعد الحرص على علاجه، حتى إن كان عبر الحجر عليه، إلى أن يبرأ، من أولويات مهمات هؤلاء، لأن سلاح الكلمة بات له الآن مفعول – القنبلة الذرية – ذات الخطورة الأوسع من خطورة براميل الـ»تي إن تي» التي يستخدمها القاتل، ولابد من أن يكون أي سلاح من هذا النوع، في أيدي أسوياء، معافين، لهم آراؤهم في هذه القضية، أو تلك، على هذا النحو، أو ذاك، ولكن، ضمن شرط الكتابة، وشرط الرأي، لا ضمن فهم الإرهابي الذي يقدم في لحظة استعماء على تفخيخ نفسه، والضغط على زر التحكم، أو عبر الريموت كونترول المخصص، ليردي ضحاياه، ضمن زمن محدد، ومكان غير محدد، مفتوح، على مدى القارات كلها، بعد أن أصبحت ثورة التقانة والاتصالات، في خدمة خطاب الشر، كما هي في خدمة خطاب الخير.
ربما كان متوقعاً، في ما قبل، أن يصادف أحدنا، في مكان ما، أحد هؤلاء المنفلتين عن القيم، المتجردين من الأخلاق، وقد يتعرض إلى الأذى المعنوي أو الجسدي، على يديه، نتيجة عنفه السعاري الأعمى، بيد أنه كان يعد طفرة اجتماعية، متفهمة من قبل الوسط الاجتماعي، غير أن حدود هذا الأنموذج كانت جد ضيقة، وقد كان التجنب ممكنا، حتى إن كان أحد الذين يستطيعون تفريغ شحنات عنفهم – كتابياً – ضد سواهم، علناً، أو سراً، إذ أن تأثيره كان غير ذي شأن، وربما أنه لم يبق أحد، لم يتعرض للأذى من قبل هذا الصنف، لاسيما إذا كان صاحب رأي، أو موقف، أو ممن يحققون الإنجازات للصالح العام، حيث يسيل لعاب بعضهم، وقد تؤدي الاحتقانات المزمنة التي يعانون منها، إلى التنفيس عنها، عبر مثل هذه الممارسة الدنيئة.
إن ما يحدث الآن، من قبل أنفار من الكتاب والكتبة الذين باتوا يتفاعلون مع وسائل الإعلام المتاحة: المرئية، والمسموعة، والمقروءة، وقبل كل ذلك عبر الفضاء الافتراضي، عبر تقديم خطاب مبني على أسس عدوانية، انتحارية، إنما هو انتهاك لم يعد يمارس بحق شخص، أو أسرة، أو مؤسسة، أو جماعة، وإنما هو انتهاك معمم، يستشعره أي متلق، وكأنه هو المعني، مادام أنه منفلت، متهور، أرعن، ضغائني، ثأري، لابد من التوقف ملياً عنده وتشريحه وتعريته، وفضح آلياته، معرفياً، بعيداً عن لغة ردات الفعل التي قد نلجأ إليها، في ما إذا كنا المستهدفين من قبلها، على نحو مباشر.
صحيح، أن من يقدم على هذه الكتابات السعارية، إنما يعزل نفسه، بعيداً عن النخبة التي يفترض أنها موجودة، وأنه دأب على موضعة نفسه ضمنها، هذه النخبة التي لما يزل ينظر إليها، رغم كل أسباب تقصيرها، بحق ذاتها، باعتبارها لم تمارس وظيفتها على الشكل المرجو، وهو ما أدى إلى تشويه صورتها، وافتقاد الثقة بها، إلا أن هذا الحكم غير خاضع للتعميم، باعتبار أن هناك، من لم يتخل عن دوره، حتى ضمن أصعب ظروف الحرب الممارسة على إنسانه، داخلاً اللجة، أياً كان موقعه، وهو ما يمنحه شرف الموقف، ويعيد الاعتبار إلى طابور الكتبة الذين تخلوا عن الدور الافتراضي لهم، نظراً لاعتبارات عديدة، لا مسوغ لها، بل نظراً لاعتبارات ساقطة، في أي امتحان حقيقي.
وسط غبار الحرب، ودخان حرائقها، وشميم رائحة شوائها للأخضر واليابس، بات بعضهم يخندق الكلمة في موقع المفخخة، في سلوك يبز سلوك ممارس – الإرهاب – إساءة بحق الآخر، إما ترجمة لغل ثأري قديم، أو طمعاً في لفت النظر إليه، بعد أن غدا خامل الذكر، أو مستقوياً بعنف البندقية التي لا يجرؤ على استخدامها في موقعها الحقيقي – ساحة الحرب – ويبدو أن هؤلاء، باتوا ينطلقون من مساحة الأحقاد التي تنشأ- عادة – في ظروف القتل والدمار والتهجير، ليوغروا صدور- قبضايات الحرب والحقد- حالمين بأدوار مستقبلية ما، حتى إن كان مقابلها إعدام ما قدمه بعض هؤلاء من نتاج ثقافي، وقد كان الأجدر بهم، أن يكونوا دعاة خطاب متزن، مكتوب بلغة الحكمة والعقل، حتى إن ساورتها انفعالات ما، من دون أن تؤسس لثقافة الكراهية البائسة التي لم تنطلق الثورة السورية، من أجلها، أصلاً، وإنما من أجل أهداف نبيلة، تم إجهاضها، أمام أعيننا، لدواع كثيرة، لابد من أن يتناولها الكاتب المعني بكل جرأة وشجاعة.
على الكاتب الذي يمتلك رؤية الثورة، ويمتلك أخلاقياتها، وطهرانية المبادئ السلمية الأولى التي انطلقت منها، ويدرك مسؤوليته التاريخية، إزاء ما هو مطلوب منه، أن يكون رده على الخطابات الكيدية، البائسة الرخيصة، التي تبدر من نظيره المختلف، ولو المتجني، والمفتقدة إلى منظومة التقويم الأخلاقي، بما هو معرفي صرف، متسامياً على ما هو مبتذل، أو مهاتر، أو حتى شعبوي، لئلا يكرس ثقافة العنف، بدلاً من دحضها وكبحها وهتكها، مهما تمادت رحى الحرب في طحن منظومة القيم لدى بعضهم، بعد أن بان كل على حقيقته، كأحد أهم منجزات الثورة السورية التي أسقطت ورقة التوت عن العورات بلا تحفظ.
كاتب سوري