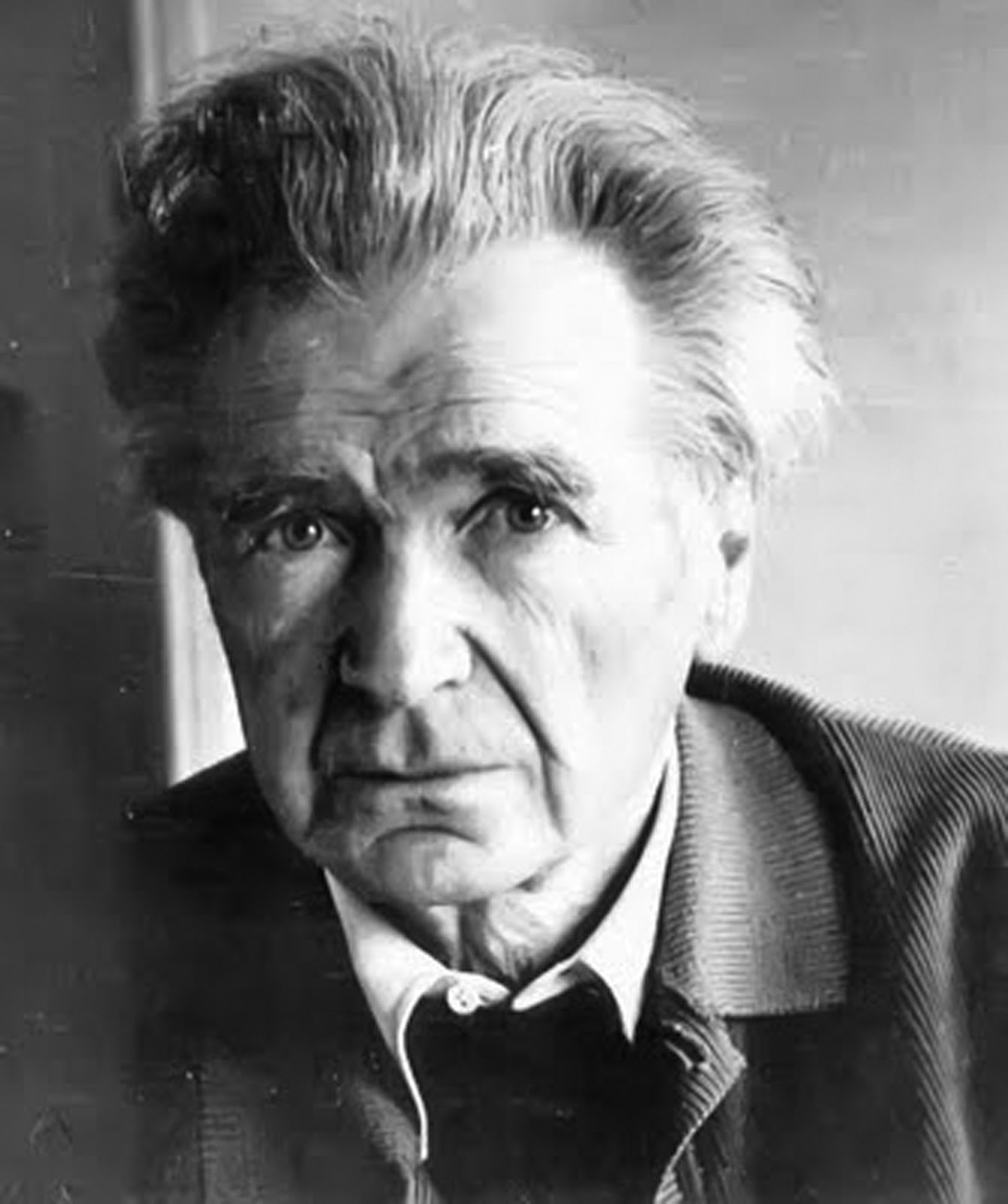كلاسيكيات الرواية العربية/ محمد العباس

في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2013 نشرت جريدة «أخبار الأدب» ما وصفته بقائمة لأفضل مئة رواية عربية، نقلاً عن اتحاد الكُتّاب العرب في دمشق، وقد توزعت الروايات على كل الأقطار العربية بنسب مختلفة، لتفادي حساسية الريادة والكفاءة الحاضرة بقوة عند مقاربة المنجز الروائي العربي، حيث تم إدراج بعض الروايات من باب المحاصصة الأدبية والتعريف بمنجز كل دولة ولو بعيّنة روائية.
هذا الإجراء التعريفي يمكن تفهُّم مبرراته اللاأدبية، ولكن لا يمكن اعتماد القائمة كمرجع لأفضل الروايات العربية، خصوصاً أنها تعرضت للعبث بعد نشرها في (ويكيبيديا ) بواسطة كُتّاب مدّعين، كما لا يمكن اعتبارها دليلاً للروايات الكلاسيكية، وتقديمها كأطلس للقارئ المعني بالتعرُّف على الرواية العربية، على الرغم من اتساعها واشتمالها على أسماء روائية مهمة.
الرواية الكلاسيكية كمنجز إبداعي له صفة الخلود والمرجعية الفنية والموضوعية، لا تكتسب هذه السمة لكثرة الطرق عليها إعلامياً، ولا بموجب رافعة نقدية، ولا بمقتضى ما تحصده من جوائز، أو ما تحظى به من ترجمات إلى لغات عالمية، أو تعرضها لتعسّف الرقابة، ولا حتى بمقتضى أرقام عدد الطبعات والمبيعات والتهافت الجماهيري، إنما تدخل الرواية في نادي الروايات الكلاسيكية الخالدة عندما تنجح في المرور عبر مرشحات أكبر ناقد وهو (الزمن)،
ذلك يعني أن الرواية تتخلّد عندما تتوالى القراءات عليها وتتراكم عبر أجيال وأمزجة ومتغيرات زمنية وجمالية وموضوعية، فتكون كل قراءة بمثابة اكتشاف لمكمن جوهري في الرواية، بحيث تكون محطة حتمية لأي قارئ يريد التماس الفني والمفهومي مع المنجز الروائي، وهكذا تتوطن في الذاكرة الجمعية العربية كمرجعية أدبية بعد أن تتخطى بموضوعها وتأثيرها الإقليم الذي تولدت فيه.
من هذا المنطلق التقعيدي، الذي لا يشكل مسطرة حادة الحواف لانتخاب أو قياس الروايات الخالدة، بقدر ما يمكن التعامل معه كمعيارية تقريبية لمجادلة جانب من المنجز الروائي العربي، يمكن فحص قائمة اتحاد الكُتّاب العرب وما يتداعى عنها من روايات للوقوف على الروايات التي يمكن بالفعل اعتمادها ضمن سلالة الروايات التي تحظى بميثاقية مع القراء، بعيداً عن التنميط والتكريس القائم على انتقاءات مفتعلة.
ثلاثية نجيب محفوظ مثلاً، التي تتصدر القائمة تمثل مرجعية مهمة في تاريخ الرواية العربية، كما تشكل دعامة من دعامات الإنجاز المحفوظي بشكل خاص، والإنجاز الروائي العربي بشكل عام، إلا أن رواية «أولاد حارتنا» أول رواياته بعد انتصار ثورة يوليو/تموز يمكن أن تكون أكثر أهمية وجاذبية للقارئ ليس بسبب الضجيج الذي رافق نشرها ومنعها، وتعرُّض نجيب محفوظ للاغتيال بسببها، واعتبارها أبرز عمل استحق بموجبه جائزة نوبل، ولكن لأنها استطاعت اختراق الزمن وإذهال القارئ بموضوعها الديني فائق الحساسية وبنائها الفني الرمزي المؤسس على نقدية رمزية مغايرة عن أسلوبه الواقعي، حيث تحتفظ الذاكرة العربية بسجالات وتعليقات صاخبة حولها.
رواية «الخبز الحافي» لمحمد شكري أيضاً صارت مع مرور الزمن وتراكم القراءات واحدة من كلاسيكيات الرواية العربية، على الرغم من أنها لم تنشر بالعربية إلا عام 1982، أي بعد عقد من كتابتها عام 1972 ونشرها باللغتين الإنكليزية بترجمة بول باولز، والفرنسية بترجمة الطاهر بن جلون، حيث سجلت هذه الرواية اقتراباً حقيقياً وصادماً من حافة السيرة الذاتية بدون رتوش ولا مونتاج، لتضيف بعداً مغايراً في المنجز الروائي العربي، وهو أداء سردي لم تعهده الذهنية والرواية العربية، حيث بلغت فيها المكاشفة حدّاً غير مسبوق في تعرية نظام الأسرة التقليدي، وتشريح دور الأب بمشارط عاطفية وعقلانية، وكأن محمد شكري أراد أن يتجاوز بالكتابة الرواية محدودية الأدبي بكل مجازيته وخيالاته إلى رحابة الفضاء الحياتي بواقعيته المرّة، وهذا هو السبب الذي أهّل الرواية لموجات متتالية من الدراسات والقراءات التأويلية التي حافظت على حضورها في وجدان الإنسان العربي،
ولا يمكن لقارئ أو مهتم بالرواية العربية أن يتجاوز رواية الطيب صالح «موسم الهجرة إلى الشمال» التي نشرت ابتداء علـى حلقات عبر مجلة «حوار» عام 1966، حيث أسست هذه الرواية لجدل من نوع آخر لا علاقة له لا بالحساسية الدينية ولا بالبطرياركية، إنما طرحت في قالب روائي إشكالية الشرق والغرب المزمنة، لدرجة أن الرواية شجعت روائيين آخرين على تناول الموضوع ذاته من منطلقات أخرى، حيث انطرحت داخل الرواية، وعلى هامش وفرة العلاقات النسائية لبطلها مصطفى سعيد جُملة من المفاهيم المتعلقة بصورة الآخر وتشكيل الهوية وصدام الثقافات، بمعنى أن الرواية العربية عند هذا المنعطف صارت أكثر قابلية وقدرة على استدماج الأفكار الكبرى في السياق الروائي وتذويبها في تدفقات السرد، وهذا هو بالتحديد ما رفع من منسوب اهتمام القراء والنقاد بهذه الرواية ورصدها منذ لحظة صدورها بوابل من القراءات التحليلية.
كذلك حظيت رواية الطاهر بن جلون «ليلة القدر» التي حصل بموجبها على جائزة الغونكور، بمقروئية واسعة وممتدة داخل الزمن منذ صدور ترجمتها إلى العربية عام 1987 كاستكمال لروايته «ابن الرمال»، وقد جاءت أهمية هذه الرواية من جرأتها في مقاربة ثيمة على درجة من الحساسية والخطورة في المجتمعات العربية، تتمثل في تمجيد الذكورة واحتقار كل ما يتصل بالأنوثة، من خلال شخصية (زهرة) التي يُراد لها أن تعيش في جلد ووعي وإحساس (أحمد)، فيما يبدو مسخاً لأنوثتها بتواطؤ أبوي اجتماعي، حيث استطاع الطاهر بن جلون نقل أكثر الإشكالات الاجتماعية العربية وعورة، المتعلقة بقيم الرجولة المزيفة إلى فضاء الرواية، من خلال كتابة روائية تشريحية فطنة وموجعة وكاشفة لعورات الذات والمجتمع العربي، وهو الأمر الذي جعل الرواية محل اهتمام الدارسين والقراء، كما حاول طابور من الروائيين تقليد نسيجها الفني والموضوعي باعتبارها مرجعية كبرى في هذا الصدد.
وعلى الرغم من ضخامة رواية عبدالرحمن منيف «مدن الملح» بأجزائها الخمسة (التيه – الأخدود – تقاسيم الليل والنهار – بادية الظلمات – المُنُبَتّ) الصادرة تباعاً منذ عام 1984، إلا أنها كانت وما زالت محل اهتمام القراء والنقاد، وتعود أهميتها إلى عدة عوامل فنية وموضوعية، فهي رواية ملحمية وتنتمي إلى ما يُعرف في الأدب الروسي بالروايات الأنهار، وتشكل كشّافاً فاحصاً للجزيرة العربية وتبدلاتها السياسية والاجتماعية والثقافية، إثر اكتشاف النفط، وتلك الجرعة السياسية تحديداً هي بمثابة وثيقة لتأريخ لحظة من لحظات التحوّل الكبرى في حياة إنسان الجزيرة العربية، بما يمثله ذلك التحوّل من ارتدادات في المحيط العربي، الأمر الذي جعلها نبعاً مرجعياً لفهم شخصية المكان وما طرأ عليها من تبدّلات في العمق، إذ لا غنى لأي قارئ أو دارس للرواية العربية من مقاربتها باعتبارها مجرة تأثير، سواء على مستوى الأسلوب أو الموضوع، حيث حذا حذو عبدالرحمن منيف مجموعة من الروائيين، وما زالت الرواية تضغط على المنجز الروائي بتأثيراتها المفهومية والجمالية.
ولأن القارئ والباحث العربي على موعد أبدي ومصيري مع القضية الفلسطينية تتزاحم الروايات الفلسطينية للدخول في نادي كلاسيكيات الرواية العربية، حيث تحضر أسماء مهمة كإبراهيم نصرالله وسحر خليفة وأميل حبيبي ورشاد أبو شاور وجبرا إبراهيم جبرا وغيرهم، إلا أن القارئ العربي يجد طمأنينته ومرجعيته عند غسان كنفاني، وعلى الرغم من الوعي التجذيري في روايته «عائد إلى حيفا» إلا أن روايته «رجال في الشمس» الصادرة عام 1963 تبدو أكثر حضوراً وتأثيراً، إذ ما زال صدى العبارة الشهيرة «لماذا لم يطرقوا جدران الخزان؟» يتردد عند القراء والنقاد كأشهر جُملة في الأدب الفلسطيني وأكثرها قابلية للتأويل، لدرجة أنها تخضع بين آونة وأخرى لقراءات تحليلية تعيد للرواية وهجها، فهي رواية تطرح تأثيرات النكبة وعذابات الدياسبورا الفلسطينية، ويمكن اعتبارها بمثابة الصرخة التي تتردد أوجاعها من بين خيام التشرد، وهو الأمر الذي يدعو القراء والدارسين إلى اعتبارها مرجعية لوعي جوهرانية القضية الفلسطينية.
لم تغب الروائية العربية عن المشهد الروائي منذ بدايات التأسيس، حيث دخلت غادة السمان – مثلاً – برواياتها في قائمة الكلاسيكيات، إلا أن ذلك الحضور كان ساطياً عند جيل من القراء، ولم تعد اليوم محطة قرائية لأي قارئ مهتم بالرواية، كما أن روايات نوال السعداوي يُنظر إليها كأفكار أكثر مما يتم التعامل معها كسرديات، فيما استطاعت أحلام مستغانمي أن تفرض حضورها برواية «فوضى الحواس» عام 1993، التي أثارت جدلاً واسعاً على أكثر من مستوى داخل الرواية وخارجها، إذ يبدو أن جيلاً جديداً من القراء قد تشكّل وباتساع كبير جعل من هذه الرواية، التي عُرفت ابتداءً بعد فوزها بجائزة نجيب محفوظ، تتمدد بسرعة في المشهد، وتأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام والدراسات، فيما قيل حينها بأنها رواية ذات منزع شعري بصري، تتفادى البنائية لصالح التهويمات والعبارات الرّنانة، لدرجة أن الرواية صارت مصدر إلهام لما بعدها من الكتابات الشبابية، بمعنى أنها غدت مدرسة مرجعية، على الرغم من كل موجات العداء والنقد التي جوبهت بها، وما زالت إلى اليوم تحظى بإقبال شعبي كبير باعتبارها علامة للتجديد الروائي الذي يعتمد الخطفات الشعرية.
وفي عام 2008 كان المشهد العربي على موعد مع رواية من نوع آخر سرعان ما انظمت إلى قائمة كلاسيكيات الرواية العربية، على الرغم من ثقل مادتها، حيث تدور أحداثها في القرن الخامس الميلادي، وتحكي قصة الصراع المذهبي بين آباء الكنيسة، وهي رواية يوسف زيدان «عزازيل» التي حصدت جائزة البوكر العربية بعد صدورها بعام، وهي رواية مكتوبة بموجب مرجعية الوثائق وبلغة صوفية من داخل اللحظة المجسدة، وبغض النظر عن المهاترات التي صاحبتها من قبل ما تبقى من المتمذهبين، إلا أنها بدت رواية متينة على مستوى السرد والمعلومة والمعالجة الدرامية، فيها من القيم البحثية والعاطفية ما يولّد المتعة والتشويق، وقد جاءت في لحظة من لحظات الظلامية الدينية العربية وكأنها تحاكم اللحظة الراهنة بوقائع وشواهد تاريخية تدين التطرف وتبشر بالتسامح والتحاور الإنساني، حتى صارت محل اهتمام النقاد برصيد هائل من الدراسات التي لم تتوقف، وبمطالعات القراء الذين وجدوا فيها انتصاراً للخطاب الروائي الناضج بعد سيل من المشتبهات الروائية، إذ لم يعد بمقدور أي مهتم بالرواية تفادي الارتطام بها.
هذه المطالعة لا تقترح أجمل وأفضل الروايات العربية، بل تقارب نادي كلاسيكيات الرواية العربية الذي يتسع لما هو أكثر من هذه العينات، وهو قابل للتمدُّد بالمزيد من الإصدارات ومراكمة القراءات المتجدّدة، إذ يمكن التوقف – مثلاً – عند رواية «رامة والتنين» لإدوارد الخراط كنقطة انطلاق لما عُرف بالكتابة أو الحساسية الجديدة، إلا أنها قد لا تشكل أي إغراء للقارئ مقابل الاشتغالات النقدية، ويمكن تشكيل قائمة بأسماء لها حضورها ببعض رواياتها في وعي ووجدان القارئ العربي كحنة مينا وغائب طعمة فرمان وفؤاد التكرلي وإبراهيم الكوني وإسماعيل فهد إسماعيل والطاهر وطار ورشيد بوجدرة وصنع الله إبراهيم وبهاء طاهر وعبدالرحمن مجيد الربيعي وغالب هلسا وخيري شلبي وغيرهم، وهي أسماء يتفاوت حضورها لدى القراء والدارسين، إذ يمكن أن تُعد روايات عربية في قائمة الكلاسيكيات داخل المحيط الثقافي القُطري، إلا أنها قد لا تلقي بظلالها على كامل المشهد العربي، كما أن الانفجار الروائي العربي في الألفية الثالثة ما زال قيد الدرس والقراءة ليتأهل منه ما يمكن أن يكون جزءاً من كلاسيكيات الرواية العربية.
كاتب سعودي
القدس العربي