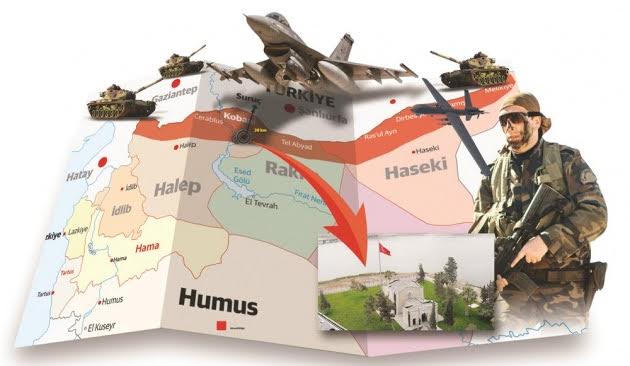مقالات لكتاب سوريين تناولت العدوان الاسرائيلي على غزة

عن غزة… وعن فلسطين
مجموعة الجمهورية
تتوالى الأيام منذ بدء العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزّة، وتتضاعف معه أعداد الشهداء والجرحى… هذه وقائع ومشاهد وأرقام معهودة، فهي سيرة فلسطين والفلسطينيين منذ أكثر من ستّ وستين سنة، وهي أيضاً مشاهد ووقائع وأرقام باتت مألوفة، بشكل دامٍ ومؤلم، للسوريين.
في الحقيقة، بات السوريون اليوم شعباً ذا قضية كبرى، لا يستطيع النظر إلى المنطقة والعالم إلا من خلالها وتحت تأثيرها، مَثَلُنا في ذلك مَثَل الأرمن واليهود والفلسطينيين والبورنديين من قبلنا، ومِثلهم أيضاً تضعنا كارثتنا الوطنية أمام خيارين أخلاقيّين متناقضين: إما السماح لإحساس المرارة والمعاناة الاستثنائية أن يدفعنا إلى نبذ أو تبخيس كل القضايا الأخرى، وإما تحويل قضيتنا إلى منصّة إنسانية تحرّرية، تجعل السوريّين قادرين أكثر من غيرهم على الإحساس بما تعنيه الكوارث الكبرى، من احتلال وقمع وقتل وتهجير وتجاهل وتحامل دولي. إننا نعتقد أن حاملي الفكر التحرّري لا يمكنهم إلا الانحياز للخيار الثاني، بل هم معنيّون بربط قضيتهم دوماً بكل القضايا العالمية المعنيّة بحرّيّة الشعوب وحقّها في حياة كريمة وعادلة.
من هذا المنطلق، نرى أن الموقف السوري التحرّري من القضيّة الفلسطينية ليس «التضامن» فحسب، بل هو شعور بوحدة حال متحرّر تماماً من الإجماعات القسريّة التي بُنيت عليها سرديّات النظام الأسدي. لسنا في وحدة حال مع فلسطين اليوم لأننا ننتمي إلى قوميّة أو دين واحد، كما دأبت جلّ الأحزاب التقليدية في المنطقة على القول، بل لأننا نُدرك ونعيش الظلم الواقع على الفلسطينيين، ظلم الحرمان من الحرّية والكرامة والمساواة. نحن جميعاً، قبل أن نكون عرباً ومسلمين ومسيحيين، وقبل أن نكون طوائف وعشائر وإثنيّات، نستحقّ أن نكون سادةَ أجسادنا وممتلكاتنا ومستقبلنا، وأن تتساوى حياتنا، في القيمة، مع حيوات أصحاب الهيمنة والسيطرة، ورثةِ «الرجل الأبيض» المُستعمِر بيننا من محتلّين ومستوطنين ومستبدّين.
لقد أسهم خطاب الهويات، عالمياً كان أم محلياً، في إبعاد النظر عن الجذر الأساس للقضيّة الفلسطينية، تماماً كما فعل بجذر الثورة السوريّة الأساس. فكلّما تكرّس الحديث عن «قوميّات تتنازع على الأرض»، أو «طوائف تتصارع على الحُكم»، غرقنا أكثر في متاهات «إدارة النزاع» بدلاً من إحقاق العدل، وانشغلنا بعوارض الصراع وجزئياته بدلاً من أُسُسه الكلّيّة الثابتة.
إن لما يجري على غزّة اليوم منبعاً عميقاً، ألا وهو حرمان الفلسطينيين من الحرّية والكرامة والمساواة، وتتحمّل إسرائيل، بوصفها الطرف المسؤول عن هذا الحرمان، المسؤوليّة الكبرى دائماً وأبداً عن كلّ ما يجري. الضحية واضحة والجاني أوضح. لكن هذا الوضوح لا يجب أن يمنعنا من تحميل الفصائل الفلسطينية عموماً، وخصوصاً حكومة حماس في القطاع، مسؤوليتها عمّا آلت اليه القضيّة الفلسطينية اليوم. لقد حصل فصل تدريجي لـ«قضيّة» غزّة عن القضيّة الفلسطينية ككل، عن اللاجئين والأسرى والضفّة والقدس والمقاومة الشعبية، وتواطأت المقاومة الإسلامية المسلّحة، سواءً بشكل مقصود أو غير مقصود، مع تحويل المواجهة العسكرية غير المتكافئة في غزّة إلى «طقس موسمي» باهظ الثمن، لا تختلف مآلاته عن بداياته في كلّ مرّة. ما دامت ’حماس‘ هي الحاكم الفعلي المباشر لقطاع غزّة، وتتفاوض مع أطراف دوليّة على هذا الأساس، فهي مَدينة للفلسطينيين ولأصدقائهم في العالم بكلام حقيقي، لا دعائي، عن فهمها لطبيعة النضال الفلسطيني في المرحلة الحاليّة، وعن دور صواريخها وعمليّاتها وقراراتها السياسيّة ضمن هذه الرؤية الشاملة. نعرف في سوريا تعقيدات ومصاعب المقاومة المسلحة، وحاشى أن نقول عنها عبث أو مغامرة، ولكن هذا لا يعني التخلّي عن النقد والمحاسبة وتحميل المسؤولية.
إن وضع حدّ للعدوان الإسرائيلي على غزّة هدف مباشر وطارئ، فوقف القتل والدمار هو الحاجة الأكثر إلحاحاً اليوم، ولا ينتهي العدوان حتى وقف الحصار الإسرائيلي-العربي على القطاع. ومع ذلك، نرى من موقعنا المتواضع، كملتزمين بالتوجّه التحرّري الإنساني في سوريا وفلسطين وكلّ البلاد العربيّة وغير العربيّة، ضرورة التذكير بأنه لا نهاية للمأساة إلا بحلّ جذري وحقيقي للقضيّة الفلسطينيّة، حلّ يقوم على دولة ديمقراطيّة علمانيّة تمتدّ من النهر إلى البحر. نحن مقتنعون بأن حلّ الدولتين، بعد عشرين سنة من المفاوضات التي تلت توقيع اتفاقيّة أوسلو، أفضى اليوم إلى كيان فلسطيني مشوّه ومقطّع الأوصال، منزوع السلاح وفاقد السيادة على حدوده وأجوائه ومياهه، ومرتبط بعلاقات تبعيّة اقتصاديّة مع إسرائيل، تجعل من أكثر مواطنيه عمّالاً أجانب من الدرجة الخامسة. إن حلاً تحت سقف العدوّ، كهذا، لن يحقّق الحرّية أو الكرامة أو المساواة للشعب الفلسطيني، بل سيحرّر إسرائيل مع الوقت من صورة الدولة المحتلّة والمكروهة، وسيحرّرها أيضاً من مسؤوليتها عن الدمار والتشوّه الاقتصادي الهائل في المناطق المحتلّة منذ أكثر من ستّة عقود ونصف. إن لنا في غزّة، منذ انسحاب القوّات الإسرائيليّة منها عام ٢٠٠٥، أبلغ العِبَر عن وضع يستمرّ فيه الاحتلال دون تواجد يومي للقوات المحتلة على الأرض.
إلى ذلك الحين، تتواطأ رائحة البارود ووهج الانفجارات وأزيز الطائرات لإعادة تشكيل الصورة الواحدة، لاحتلال استيطاني إسرائيلي في فلسطين واحتلال استبدادي أسدي في سوريا، تواطؤاً يفضح وحدة حال الظالمين، شكلاً ومضموناً، ويدفع المظلومين للإحساس، ولو قليلاً، بأنهم ليسوا وحدهم أمام عالمٍ –في أحسن الأحوال– يتفرّج.
موقع الجمهورية
“حماس” في المعادلة الفلسطينية: إيقاعات التشدد والاعتدال/ صبحي حديدي
حركة المقاومة الإسلامية، أو «حماس» في الاختصار الشهير، ليست صواريخ القسام والعمليات الانتحارية والتبشير العقائدي الإسلامي، فقط؛ ولا هي الفوز الصريح في الانتخابات التشريعية للعام 2006، والحكومة الحمساوية، والاقتتال الداخلي مع أجهزة محمد دحلان داخل السلطة الوطنية الفلسطينية و»فتح»، فحسب… بل هي، إلى ذلك كله، مؤسسات اجتماعية وخيرية، كالمدارس والمشافي ورياض الأطفال وصناديق الإغاثة؛ ثمّ «الجامعة الإسلامية»، التي أسستها الحركة سنة 1978، وتضمّ كليات علمية كثيرة غير الشريعة والفقه الإسلامي (سبق للقاذفات الإسرائيلية أن استهدفت الجامعة، مراراً).
وهذه الجامعة لا ترمز إلى الجوانب المعقدة لتاريخ وموقع حركة «حماس» فقط، بل لعلها ترمز أيضاً إلى مفارقة انقلاب السحر على الساحر في سياسات الاحتلال الإسرائيلي. ذلك لأنّ السلطات الإسرائيلية كانت في طليعة مشجّعي تأسيس حركة «حماس»، ضمن محاولة لشقّ المجتمع الفلسطيني، والالتفاف على الوجود السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في غزّة، واستهداف الشعبية الواسعة التي كان يحظى بها الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. وحين أطلق الشيخ أحمد ياسين أولى مؤسسات «حماس»، سنة 1973، وعُرفت آنذاك باسم «المجمّع»، وكانت مؤسسة خيرية تشرف على سلسلة من المشافي ورياض الأطفال والمدارس؛ لم تسارع سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى منح الترخيص فقط، بل أشارت بعض التقارير إلى تقديم دعم مالي غير مباشر لتلك المؤسسة الحمساوية الأبكر.
وكان طبيعياً، يومذاك، أن تثور الحساسيات بين «المجمّع» ومعظم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، ومن خلفها المؤسسات الخيرية التي كانت منظمة التحرير تدعمها أو تديرها؛ كما حدث مطلع 1980، حين هاجم نشطاء إسلاميون مقرّ «جمعية الهلال الأحمر»، وحاصروا بيت رئيسه الدكتور حيدر عبد الشافي، وحاولوا الضغط على دور السينما ومحال بيع الخمور والحانات. تلك كانت أطوار التشدد العقائدي، والسلوكي، التي لا تنحسر أو تتراجع على الأجندات الحمساوية، إلا لتطلّ من جديد، على خفر تارة أو على نحو صاخب طوراً.
والحال أنّ «حماس» الراهنة هي الوريث الأهمّ لجماعة «الإخوان المسلمين»، التي تأسست في غزّة سنة 1946، وقد اتخذت أسماء عديدة قبل أن تستقرّ على هذه المختصرات. والواقعة التاريخية تقول إنّ سبعة من كبار القيادات الإخوانية التقوا، أواخر 1987، وأعلنوا تأسيس الحركة، وهم: الشيخ أحمد ياسين وإبراهيم اليازوري ومحمد شمعة (ممثلو مدينة غزة)، وعبد الفتاح دخان (ممثل المنطقة الوسطى)، وعبد العزيز الرنتيسي (ممثل خان يونس)، وعيسى النشار (ممثل رفح)، وصلاح شحادة (ممثل منطقة الشمال). كذلك شهدت مرحلة التأسيس صعود قياديين من أمثال خليل القوقا، موسى أبو مرزوق، إبراهيم غوشة، وخالد مشعل.
وعقيدة «حماس»، كما نصّ عليها ميثاق الحركة الذي صدر في صيف 1988، لا تعطي لليهود الذين احتلوا فلسطين عام 1948 حقّ الاستيلاء على البلد؛ ولكن الحركة لا تعادي اليهودية في حدّ ذاتها، بل تعتبرها ديناً سماوياً. كما تعتبر مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي «صراع وجود وليس صراع حدود»، وتنظر إلى دولة إسرائيل كجزء من مشروع «إستعماري غربي صهيوني» يهدف إلى تمزيق العالم الاسلامي والعربي وتهجير الفلسطينيين من ديارهم. ولهذا تعتقد الحركة بأن الجهاد، بأنواعه وأشكاله المختلفة، هو السبيل إلى تحرير التراب الفلسطيني؛ وترى أن مفاوضات السلام مع الإسرائيليين مضيعة للوقت، وبوّابة للتفريط في الحقوق. وتعتقد «حماس» أن عمليات التسوية بين العرب وإسرائيل، منذ مؤتمر مدريد عام 1991، قامت على أسس خاطئة، ولهذا فإنها تعتبر اتفاقات أوسلو تفريطاً بحقّ العرب والمسلمين في أرض فلسطين التاريخية. كما ترى، أخيراً، أنّ إسرائيل هي الملزمَة أولاً بإقرار مشروعية الفلسطينيين في أرضهم، والاعتراف بحقّ العودة.
وعلى نقيض عرفات، لم تتعاطف الحركة مع صدّام حسين حين اجتاح الكويت سنة 1990، وهذا ما جلب عليها رضا الدول الخليجية وتردد أن «حماس» ظلت تتلقى معونات تبلغ 28 مليون دولار شهرياً، من السعودية خاصة، الأمر الذي مكّنها من الحلول سريعاً محلّ منظمة التحرير في الأعمال الخيرية في غزة. وفي سنة 1994 أعطى موسى أبو مرزوق، وكان يقيم في الأردن آنذاك، أولى الإشارات على أن الحركة تقبل بـ»هدنة» مع إسرائيل إذا انسحبت إلى حدود 1967، الأمر الذي أكده أيضاً الزعيم الروحي للحركة الشيخ أحمد ياسين.
خلال الانتفاضة الثانية ازدادت أنشطة «حماس» السياسية والعسكرية، فتعاونت مع كتائب الاقصى التابعة لـ»فتح» في تنفيذ عمليات انتحارية، وانفتحت اكثر نحو إيران و»حزب الله» اللبناني على حساب السعودية ومصر؛ ثمّ قفزت شعبيتها في الشارع الفلسطيني قياساً على تضحيات قياداتها (تقول الإحصائيات إنّ العشرات من أبناء وبنات هذه القيادات اغتيلوا على يد إسرائيل، إلى جانب اغتيال الشيخ أحمد ياسين في آذار/مارس 2004، ثمّ الرنتيسي، خليفته في القيادة، بعد أسابيع). وفي موازاة تعثر المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، والحصار الذي فُرض على عرفات في رام الله ثمّ وفاته في ما يُظنّ أنه عملية تسميم، وانتخاب محمود عباس في غمرة فساد السلطة الوطنية الفلسطينية والرموز التاريخية لحركة «فتح»؛ كان طبيعياً أن تكتسح «حماس» الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مطلع 2006.
ومنذ سنة 1996، حين وقعت سلسلة من العمليات الانتحارية، وتزامنت مع توقيع اتفاقات أوسلو II؛ تردّد أن محمد دحلان، رئيس «الأمن الوقائي» (جهاز الاستخبارات الأقوى في غزّة آنذاك)، تولى مهمّة تفكيك مؤسسات «حماس» السياسية والعسكرية. وفي صيف 2007 وقعت المواجهة الحاسمة والختامية، بين «فتح» و»حماس»، وأسفرت عن سيطرة الأخيرة على مقاليد الأمور في غزة، ولجوء عباس إلى إقالة الحكومة وتشكيل أخرى في رام الله تتولى تصريف الأعمال. وكان الصحفي الأمريكي دافيد روز قد نشر، في مجلة Vanity Fair لشهر نيسان (أبريل) 2008، تحقيقاً مثيراً عن هذا الحدث، اعتمد فيه على وثائق أمريكية رسمية عالية السرّية؛ فبرهن أنّ السلطة الفلسطينية وإسرائيل خططوا للانقلاب على «حماس»، فاستبقتهم الحركة وانقلبت عليهم!
ومنذ البدء قامت «حماس» على ثلاثة أجنحة منفصلة: السياسي، وأداره المقرّبون من الشيخ ياسين (اليازوري، إسماعيل أبو شنب، محمود الزهار)؛ والأمني والاستخباراتي، وكان يُعرف باسم «المجد»، بإدارة يحيى سنور وروحي المشتهى؛ والجناح العسكري، وبدأ من خلايا صغيرة قبل أن يصبح فصائل عز الدين القسام كما تُعرف حالياً. وعلى امتداد السنوات، وتعاقب الأحداث والأزمات، استقرّت قيادة «حماس» السياسية على جناحين، داخلي مقيم في قطاع غزّة، وخارجي مقيم في دمشق وبيروت؛ وثمة، في كلّ جناح، فريق اعتدال (يقوده أبو مرزوق)، وفريق تشدّد (لعلّ الزهار على رأسه)، وفريق وسط (أبرز رجالاته إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة).
وبعد اندلاع الانتفاضات العربية، اختلطت أوراق «حماس» السياسية، والعقائدية استطراداً؛ فانحازت إلى الحراكات الشعبية، في تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن؛ وترددت، حول الانتفاضة السورية (بسبب انخراط الحركة في ما يُسمّى «محور الممانعة»، وعلاقة خالد مشعل الشخصية بالنظام السوري من واقع إقامته في دمشق)، قبل أن تحسم أمرها وتقف مع الانتفاضة، مما ألزم قياداتها بمغادرة سوريا.
وكما نجم فوز «حماس» في انتخابات 2006 عن رغبة المواطن الفلسطيني في معاقبة «فتح» على فساد قياداتها، فإنّ حروب إسرائيل المتعاقبة ضدّ غزّة تظلّ منبع الشعبية الأوّل للحركة؛ كما تصنع عامل الترجيح الأهمّ في ضبط إيقاعات التشدد والاعتدال داخل صفوف «حماس»: تزيد المتشددين تشدداً، وتزيد المعتدلين… تشدداً أيضاً!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
مملكة إسرائيل ومملكة الأسد في مواجهة عالميهما الثالثين/ ياسين الحاج صالح
يتعذر على السوريين أكثر من غيرهم أودون غيرهم تجنب المقارنة بين الحرب الإسرائيلية على غزة و40 شهرا من الحرب الأسدية في سوريا.
أول ما يجمع إسرائيل ونظام الأسديين هو التفوق المطلق في سلاح الجو. كانت إسرائيل متفوقة دوما في هذا المجال على الدول العربية. ومنذ انتهت حروب الدول ضدها قبل أكثر من ثلاثين عاما، دانت لها سيادة جوية تامة. فإذا كانت مساحة إسرائيل الأرضية أقل من مساحة فلسطين التاريخية، فمساحتها الجوية تعادل مساحة العالم العربي كله، ومعلوم أن طيرانها الحربي ضرب ما بين بغداد وتونس في عقود سابقة. بالمقابل، حتى حين كان يقال إن ثائرين سوريين يسيطرون على نحو ثلثي مساحة البلاد، كان النظام يسيطر على كامل مساحة البلد الجوية، ويحقق تفوقا حاسما في هذا المجال.
في امتلاك السماء ما يتجاوز ميزة حربية تكتيكية مهمة، إلى حيازة القدرة على القتل المتعالي، القتل المجرد من أعلى ومن بعيد. ربما يمكن قتل أعداد أكبر بصواريخ بعيدة المدى أو بسلاح كيماوي، على ما فعل النظام الأسدي، لكن القصف بالطيران الحربي، حيث العلو والسرعة والبعد، يحمل علامة هيمنة وتفوق مالكي هذا السلاح على أعدائهم، وانكشاف الأخيرين وشللهم أمام الموت القادم من السماء. قد يمكن للطرف الأضعف ان يملك أسلحة فردية، وربما مدافع ودبابات، لكن لم يعرف عن حركة مقاومة أو ثورة أن امتكلت سلاح طيران. الطيران الحربي سلاح الدول، تقتل من تستعمرهم، سواء كان الاستعمار داخليا أم خارجيا.
الطيران الحربي سلاح قتل طبقي لا يتقدم عليه في ذلك غير السلاح النووي. وهو يحيل إلى ما يتجاوز السلاح وموازين القوى العسكرية من موازين قوى اجتماعية وسياسية. فما يجمع إسرائيل حيال الفلسطينيين والنظام الأسدي حيال عموم السوريين، بمن فيهم موالون له، هو هذا الانفصال بين عالمين. إسرائيل هي العالم الأول القوي والمحصن في مواجهة العالم الثالث الفلسطيني الذي لا تكف عن إبادته سياسيا، وتبيده فيزيائيا حين يتجاسر على مواجهتها، على ما يحصل اليوم. ويشكل النظام الأسدي العالم الأول الداخلي في سوريا، ويحمي عالم السوريين البيض في مواجهة السوريين السود والعالم الثالث الداخلي.
ولعل في هذا التماثل البنيوي ما يفسر الموقف المتجاذب لقوى العالم الأول الحقيقية حيال النظام الأسدي، فهم يشمئزون من وحشيته، لكنهم قليلو التعاطف مع العالم الثالث الداخلي الذي يطاله التدمير والموت على يديه. لديهم عوالمهم الثالثة الخاصة (مهاجرون، لاجئون) التي يحاذرون منها، يزيدهم حذرا أن من ثالثييهم من ينضم إلى ثالثيي السوريين ضد العالم الأول المحلي والدولي.
لكن هذا لا يعني بحال أنهم يعتبرون النظام الأسدي من العالم الأول، إنه أول على برابرته المحليين، يُحتقر، لكنه مفيد. نسبة طيران إسرائيل الأمريكي إلى طيران النظام السوري مثل نسبة هذا الطيران الأخير إلى الأحياء السورية التي يقصفها. الواقع أن أسلحة النظام الأسدي كلها لا تصلح لغير مواجهة قوى أضعف منه بكثير من سوريين وفلسطينيين ولبنانيين. السلاح لم يستورد منذ أربعين عاما لغاية وطنية عامة.
وبالطبع لا تتساوى قيمة الحياة بين العالمين. حياة الفلسطيني لا يمكن أن تعادل حياة يهودي إسرائيلي، وحياة عموم السوريين لا يمكن أن تقارن بحياة الأسديين. قبل 34 عاما من اليوم قتل رفعت الأسد بين 500 و1000 من السجناء الإسلاميين بعد محاولة فاشلة لاغتيال أخيه حافظ. ومقابل مئات من طرف النظام سقط في الحرب الأسدية الأولى (1979-1982) عشرات الألوف. اليوم، في الحرب الأسدية الثانية، انكسر احتكار السلاح، وخسر النظام أكثر، لكن إن دانت له السيطرة فسيقتل أضعاف ما قتل حتى اليوم، كي يعيد رفع الحاجز العنصري بين السادة والعبيد. لكن بينما كان الحاجز في سنوات الحرب الأسدية الأولى أمنيا: «جدار الخوف»، نرجح له أن يرتفع هذه المرة ليكن جدار فصل عنصري بين عالمين. فإن فاز النظام بمحصلة الحرب الأسدية الثانية، ربما نرى استيلاء أوسع بما لا يقاس على الأملاك والأراضي والموارد الخاصة، يضاف إلى الاستئثار بالموارد العامة. مخططات «إعادة الإعمار» ربما تكون فرصة لإرساء نظام فصل عنصري، يعزل الأفقر بين السكان في مناطق مكشوفة ومراقبة. نريد أن النظام الأسدي، إن فاز بالجولة الراهنة، سيتطور باتجاه إسرائيلي.
وتنال إسرائيل حماية دبلوماسية وعسكرية من الولايات التحدة، القوى الغربية عموما، نال ما يشبهها النظام الأسدي أثناء الثورة من روسيا والصين، اللتين مارستا حق النقض لمصلحته 4 مرات خلال 3 أعوام. ليست العلاقة الغربية الإسرائيلية مثل العلاقة الروسية الأسدية. محرك الأخيرة يتصل بالسلطة ونظام السيطرة الإقليمي والدولي، فيما للعلاقة الغربية الإسرائيلية بعد ثقافي وتاريخي أعمق. لكن علاقة الحكومة الروسي بعموم السوريين لا تغاير في شيء علاقة الإدارة الأمريكية بعموم الفلسطينيين: «آخرون»، لا قيمة لحياتهم.
في المحصلة يبدو لنا أن النظام الأسدي اليوم أشبه بنيويا بإسرائيل، وقبلها بنظام جنوب أفريقيا العنصري، مما هو بنظام استبدادي عادي. إنه من نوع الأنظمة الطبقية العنصرية التي ترفع الفرق بينها وبين محكيومها إلى مرتبة الفرق بين عنصرين أو مرتبتين من مراتب القيمة البشرية.
على أن هناك فرقا بين موقع القضيتين الفلسطينية والسورية في عالم الكفاح التحرري العالمي. عبر تاريخ من الصراع عمره يقارب 7 عقود، استطاع الفلسطينيون صنع قضيتهم وجعلها قضية عالمية، وهذا حتى في بلدان الغرب. هناك ضرب من الهيمنة الفرعية للقضية الفلسطينية في أوساط يسارية وليبرالية عالمية، ليست بقوة ما تناله إسرائيل من ولاء وانحياز سياسي وأساسي، لكنها قوية بقدر معقول. إسرائيل في عين أوساط واسعة في الغرب ذاته قوة استعمارية معتدية، واحتلالها هو مصدر العنف المستمر في فلسطين/ إسرائيل.
الأمر بعيد بخصوص السوريين. نحن نبدأ بالكاد من حيث بدأ الفلسطينيون، وليس من حيث انتهوا. سلتزم جهود كبيرة من أجل صنع قضية سورية عادلة تنال تعاطفا قويا في العالم. وبخاصة توضيح طبيعة الصراع السوري والنظام السوري. فإذا كانت الحرب الأسدية الأولى أسست للنقلة نحو نظام ملوكي استعبادي، فإن الحرب الأسدية الثانية ستؤسس لنقلة أكبر نحو نظام عنصري أكثر إجراما.
في مواجهة هذا التطور المرجح، يلزم التفكير في قضيتنا والعمل من أجلها بمنطق إنساني وتحرري عام، لا بمنطق ديني أو منطق طائفي. في الخبرة الفلسطينية غير قليل مما يسعفنا في هذا المجال.
٭ كاتب سوري
نتنياهو الفاشل والأسد الناجح/ عمر قدور
ربما يجد نتنياهو نفسه في موقع المظلوم، بالمقارنة مع نظيره الأسد، فالهجوم الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة أخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام الدولي، على العكس من مجازر النظام، التي بقيت قيد الإهمال من قبل الإعلام العالمي، ولم توضع في صدارة الأخبار سوى في حالة الهجوم الكيماوي على الغوطة وما تلاه من تهديدات أميركية. وربما أيضاً يحسد نتنياهو نظيره الأسد على الحظوة الدولية، التي طالما رأى العرب أنها وقفٌ على إسرائيل وحكامها، ولم يكتشفوا إلا مؤخراً الحظوة الكبرى التي ساندت النظام السوري ومنعت سقوطه قبل سنتين. ترافق هذا كله مع ما عُدّ خطاباً للنصر ألقاه الأسد في مستهل ولايته الجديدة، متعهداً باستمرار المجازر حتى النهاية، أي فناء وتشريد ما يقارب نصف السوريين.
تظاهرات كبيرة، لئلا نقول حاشدة، في مدن غربية كبرى تخرج للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ تلك المدن نفسها لم تشهد سوى وقفات خجولة لأشخاص قلائل في أيام عالمية خُصصت للتضامن مع السوريين. البعض أحال هذا الفارق إلى قدم القضية الفلسطينية، والخبرة التي اكتسبها فلسطينيو الشتات في عرض قضيتهم على الرأي العام العالمي، ولا ننسى بالطبع قدم القضية الفلسطينية التي أنهت ستة وستين عاماً من عمرها. لكن هذه الإحالة تتغاضى عن المتغيرات الدولية خلال تلك المدة، والتي يُفترض أنها عززت ثقافة حقوق الإنسان في المركز الغربي، والتي يُفترض أيضاً أنها جعلت من العالم قرية كونية أكثر معرفة بأحوالها. افتراض من هذا القبيل قد يوجب على السوريين الانتظار طويلاً كي يتمرسوا في مخاطبة الرأي العام الغربي، وكي يحظوا بقدر من التعاطف الدولي لا يكفي على أية حال لحل قضيتهم.
إلى وقت قريب، كان يُعتقد أيضاً أن العراق جزء عزيز من الإستراتيجية الأميركية، لكن التطورات الأخيرة وسيطرة داعش على أجزاء كبيرة منه ورد الفعل الأميركي الضعيف حيالها أثبتا عدم اكتراث الغرب بما يحدث في العراق، حتى تهجير المسيحيين من الموصل لم يحظَ باهتمام غربي على النحو الذي كان متوقعاً. الحق أن الهجوم الإسرائيلي على غزة نال الاهتمام الأكبر. بالطبع، الفلسطينيون يستحقون أكثر منه، ولم يستخدم الغرب الأحداث الإقليمية الكبرى المحايثة له من أجل صرف الأنظار عن القضية الفلسطينية كما كان يُتهم من قبل. هذا السلوك بقي مقتصراً على جماعة الممانعة الذين وجدوا في الهجوم الإسرائيلي فرصتهم للتغطية على المجازر في سوريا، وعلى النظام الطائفي في العراق، وعلى مجمل الأزمات الداخلية في المنطقة التي يُراد القول إنها باقية ببقاء إسرائيل.
لا الأسد ولا المالكي أسعفا نتنياهو للظهور بمظهر المجرم الصغير، فظهر عالمياً كما هو؛ نتنياهو الذي لا يطيقه الغرب بمعظمه، ويتمنى خروجه سريعاً من حلبة السياسة الإسرائيلية وعدم عودته ثالثة. نتنياهو، بخلاف إصرار العرب على عدم وجود فوارق بين القادة الإسرائيليين، لم يكن يوماً الوجه المحبب للإدارة الأميركية سواء كانت ديموقراطية أو جمهورية، ولم يكن أيضاً الوجه المقبول في عموم الغرب منذ توليه رئاسة الحكومة أول مرة عام 1996. آنذاك ركز الإعلام الغربي على تطرفه، رغم محاولته وضع حرب إسرائيل على الفلسطينيين ضمن اهتمام الغرب بمكافحة الإرهاب، يُذكر أن لنتنياهو كتابين عن الإرهاب، أولهما بعنوان «الإرهاب: كيف يحقق الغرب الانتصار» وثانيهما «الإرهاب العالمي: التحدي والرد»، إلا أن أفكاره عن الإرهاب لم تلقَ اهتماماً واسعاً، وهي بالتأكيد لا ترقى إلى مستوى الفعل والتعاون المخابراتي الواسع، الذي أبداه النظام السوري، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.
إذاً، منذ البداية لم يُقدّم نتنياهو كوجه دولي مقبول، بخلاف بشار الأسد الذي رُوّج له كوجه حداثي شاب، بل كان مجرد وجوده القصير في الغرب للدراسة مجالاً للحديث عن تشربه بالثقافة الغربية! بالطبع لا معنى هنا للحديث عن غربية نتنياهو، لأن نسبة لا يُستهان بها من الإسرائيليين تنحدر من أوروبا، أي أن إقامة الأخير لسنوات في الولايات المتحدة لا تعني شيئاً في معيار غربية إسرائيل وفق هذا المفهوم. الغرب الذي يستسهل إطلاق الأحكام فيما يخص الحكام والبلدان العربية لا يتصرف على الشاكلة ذاتها فيما يخص ما يعدّه جزءاً منه؛ إسرائيل ليست مجالاً لإطلاق أحكام اعتباطية بل هي موضع انتباه وحرص يقتضيان التفكر الجدي في شؤونها؛ إسرائيل ليست موضوعاً للتساهل أو الاستهانة.
لا بد أن نشير في هذا السياق إلى أن فترة صعود نتنياهو تزامنت مع الرغبة الدولية في حل القضية الفلسطينية، أو تصفيتها، سلمياً. فالمشروع الإسرائيلي، بتعالقه مع المخططات الغربية، كان قد بلغ مداه، وأصبحت وظيفة إسرائيل كحاجة غربية داخلية من الماضي، وبدأت بالظهور تيارات في الغرب وإسرائيل تدعو إلى توطينها في المنطقة بدل انتمائها الكلي إلى الغرب. العدوان الإسرائيلي لم يعد مقبولاً، لا لأسباب أخلاقية بحتة، وإنما لأنه لم يعد يحقق أهدافاً سياسية كبرى تتعلق بمصالح دولية أو بوجود إسرائيل، حتى إن عدوانياً متمرساً مثل شارون وعى الدرس وصار يُصنف معتدلاً بالقياس إلى نتنياهو الصاعد.
مكانة إسرائيل الخاصة في الوجدان الغربي تحمّلها تبعات لا نجدها في أي بلد من البلدان المحيطة بها، هنا ينبغي فهم الشراكة الإسرائيلية الغربية جيداً، فالغرب معني إلى أقصى حد بالحفاظ على أمن إسرائيل، وفي هذه الحالة يتساهل معها فيما يعتقد أنه حقها في الردع. لكن الشراكة متعددة الأوجه لا تقف عند هذا الحد، الأمر يشبه مثلاً المستويات والمعايير التي يجب تحققها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو مستويات الكفاءة اللازمة للانضمام إلى حلف الناتو. بناء على ذلك، وفيما عدا ما يُعتقد أنها تهديدات أساسية، يُنظر إلى الانتهاكات الإسرائيلية من منطلق المنظومة الغربية لحقوق الإنسان، بينما يُنظر إلى مثيلاتها في الجوار العربي على أنها جزء من الثقافة السائدة فيه. سنكون مبالغين جداً إذا رأينا في الانتقادات الغربية لإسرائيل نجاحاً فلسطينياً في تسويق القضية الفلسطينية، ومن دون أن نبخس تلك الجهود حقها لا بد من النظر إلى الانتقادات بكونها مبنية على الأساس النظري الذي يضع إسرائيل في مرتبة الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة، والتي ينبغي أن تلبي معايير تلك المكانة.
وأن ينجح الأسد فيما يفشل فيه نتنياهو فذلك ليس دلالة على براعة الأول، ولا على حظوة أو مباركة دوليتين لدوره في المنطقة؛ هو نجاح مبني في الدرجة الأولى على غياب الاهتمام العالمي بسوريا، على العكس من الاهتمام الذي لم يتراجع بإسرائيل. ما هو مسموح لبشار الأسد فعله بالسوريين ليس مسموحاً لنتنياهو أو غيره فعله بالفلسطينيين، لا لأن العالم حريص جداً عليهم بل لأن العالم لا يقبل أيضاً بأن تتحول إسرائيل إلى وحش أعمى على منوال أنظمة الاستبداد. هذا أيضاً الثمن الذي تدفعه إسرائيل لقاء انتمائها للمنظومة الغربية، بحيث يبدو الغرب في كثير من الأحيان أحرص من القادة الإسرائيليين على صورتها، وعندما يقوم قادتها بخدش هذه الصورة الراسخة في الوجدان الغربي، فإن جزءاً من التعاطف الشعبي المعلن مع الفلسطينيين آتٍ لأنهم ضحايا إسرائيل، التي لا ينبغي لها أن تكون هكذا، لا ينبغي أن تكون بوحشية جيرانها المتوحشين أصلاً. ينجح الأسد لأنه يفعل ما يُعتقد أنه اعتيادي في أنظمة الاستبداد، ويفشل نتنياهو لأن وحشيته منافية لصورة إسرائيل في العقل الغربي. ينجح الأسد لأن حصتنا الفعلية من الاهتمام العالمي هي الإهمال.
المستقبل
غزة … درس وحدة الموقف الفلسطيني/ بشير البكر
من عدوان إسرائيلي لآخر نستفيد من الدروس، نتعلم من جديد. بعضها ندركه للمرة الأولى، وبعضه الآخر نستعيده رغماً عنا، لأننا لا نقرأ الأحداث جيداً. وقد جرت العادة أن تشنّ إسرائيل الحرب. تضرب وتقتل وتدمر، وتعود إلى قواعدها سالمة، بينما لا نجد نحن ما نقوم به سوى دفن الشهداء وتدبيج المراثي، وسط عجز عربي وتواطؤ دولي.
دروس العدوان على غزة هذه المرة مختلفة وصريحة أكثر. ربما نحسها كذلك، نظراً لكون المرحلة سوداء وقانية في الوقت ذاته، بسبب ما آلت اليه الأوضاع في مصر وسورية من انحطاط وتراجع ودموية.
مصر ذهبت إلى أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. أما سورية فقد أحال الرئيس السوري، بشار الأسد، الثورة إلى مذبحة للشعب السوري، الذي لم يلتقط أنفاسه منذ ثلاثة أعوام. ولا تزال المحنة مستمرة، فالإجرام الأسدي الذي لم يقف عند حد، أدخل المنطقة في حالة من التفتيت والانهيار، على نحو يفوق ما يمكن أن يفعله العدو.
ومن دون شك، فإن ابلغ درس من غزة هو وحدة الموقف الفلسطيني. هذه الوحدة بدأت بالموقف الشعبي الذي تحرك في الضفة الغربية منذ بداية العدوان، وتدرج موجة وراء أخرى حتى وصل يوم الجمعة إلى مواجهات شاملة مع قوات الاحتلال والمستوطنين، وسقط خلاله ثمانية شهداء في الضفة الغربية. ولم يكن ذلك مستغرباً لأن الشرارة بدأت من الضفة، عندما اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من اختفاء المستوطنين الثلاثة ذريعة للعدوان.
الموقف الشعبي الفلسطيني انعكاس للحس الوطني العام الذي لم يتخرب، وبقي على عفويته ونقائه. وقد كان دأب الاحتلال طيلة سبعة أعوام من حصار قطاع غزة، أن يدمر هذا الوعي، وسعى بشتى السبل ليفصل بين الشعب الواحد، ويجعل من القطاع منطقة مغلقة، ويحوله في نظر العالم حاضنة تطرف تستحق الحكم بالحصار حتى الموت.
ولأن الحس الشعبي هو الذي يفرض نفسه في هكذا منعطفات، ويقرر وجهة الموقف السياسي فقد وجدت السلطة الفلسطينية نفسها تقترب في كل يوم خطوة من ردود أفعال الجماهير. وبعدما حاولت في الأيام الأولى للعدوان منع الشارع من رفع السقف ضد الاحتلال، وجدت نفسها مدفوعة في الأسبوع الأخير إلى تغيير خطابها وسلوكها، وصارت تدعو الى التظاهر ضد الاحتلال. ويسجل لقيادة حركة “حماس” أنها راهنت على تصليب الموقف الفلسطيني الرسمي، ونجحت في ذلك. وهذا ما يعكس روحية المصالحة التي سارت بها الحركة، وقادت إلى تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية.
تصليب الموقف الفلسطيني اليوم، ليس مطلباً فلسطينياً فقط، بل هو أمل كل عربي حريص على فلسطين وقضيتها من أن تبدد زخمها المفاوضات العبثية التي تدور منذ عشرين سنة بلا طائل. ويجب رفع الشكر للمقاومين والشهداء في غزة الذين برهنوا أن خياراً آخر غير الاستجداء ممكن، بل ضروري، ولا بديل عنه. وهذا ما أخاف إسرائيل وجعلها منذ البداية تحاول أن تتلطى وراء إيقاف إطلاق نار برعاية السلطة الفلسطينية ومصر. وقف إطلاق نار يقوم على قاعدة نزع سلاح المقاومة في غزة، وحراسة أمن إسرائيل.
الدرس الأكثر أهمية هو أن العدوان لم يكسر المقاومة. وهذه مسألة يجب البناء عليها في هذا الزمن العربي الرديء، ولكن الثمن كان باهظاً. أكثر من ألف شهيد خلال قرابة عشرين يوماً، غالبيتهم من المدنيين. وقد كان واضحاً أن إسرائيل أرادت أن تنتقم من الصمود بإلحاق أكبر قدر من الأذى بالمدنيين. وهذا أمر يجب ألا يمر من دون أن يدفع نتنياهو ثمن جرائم الحرب، وهذه الفرصة يجب ألا تهدر، ولا سيما أن التضامن العالمي مع غزة كان منقطع النظير، وخرجت تظاهرات في كبريات عواصم العالم، وبدت إسرائيل معزولة على مستوى الرأي العام الغربي، رغم التغطية التي حاول أن يوفرها لها “لوبي” السياسة والإعلام.
العربي الجديد
وطيس حروب الصورة/ صبحي حديدي
السجلّ الميداني للصحافي المصري ـ الأمريكي أيمن محي الدين حافل، ومشرّف؛ من نقل جلسات محاكمة صدّام حسين، إلى وقائع «الربيع العربي»، في مصر تحديداً. وخلال العدوان الإسرائيلي على غزّة، مطلع العام 2009، كان الوحيد الذي راسل محطات عالمية، أمريكية بصفة خاصة، متواجداً على الأرض. وفي أواخر العام 2012 غطى، أيضاً، الغارات الإسرائيلية على القطاع؛ وقبل أيام كان الشاهد البليغ، المؤثر عاطفياً والمحترف مهنياً، على قصف القاذفات الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين الأربعة الذين كانوا يلعبون على رمال الشاطيء.
كيف كافأته محطته، الـNBC الأمريكية،على التقرير الأخير، الانفرادي والاستثنائي؟ كفّ اليد عن العمل، والنقل إلى موقع آخر، ليس خارج القطاع وحده، فحسب؛ بل خارج فلسطين كلها، أو إلى جهة ظلت مجهولة طيلة أيام. زملاؤه، وأوساط صحافية وإعلامية في أمريكا أوّلاً، وعلى نطاق عالمي، تضامنوا معه دون إبطاء، وبصدق، وبنزاهة بدت مدهشة بالقياس إلى حساسية ملفّ غزّة، وسطوة مجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل. لا أحد، إلا رهط المتواطئين الشامتين، اشترى الذريعة التي ساقتها المحطة في تفسير نقل محي الدين، أي الحرص على أمنه الشخصي مع دنوّ احتمالات اجتياح برّي إسرائيلي. ولهذا راجعت إدارة الـNBC قرارها، مضطرة أغلب الظنّ، فأصدرت بياناً تعلن فيه إعادة الرجل إلى غزّة، مع تنويه خاصّ بـ»مساهمته القيّمة والفريدة في حكاية موت الأطفال الفلسطينيين الأربعة».
والحال أنّ الصورة، وهي أيقونة عصور العولمة بامتياز، تظلّ ساحة حرب شرسة لا تختلف في الشدّة والضراوة، وفي الوحشية والبربرية، عن قتال القاذفات والدبابات والمدفعية في ميادين الحروب الحيّة. ولا يجد المرء دليلاً على صحّة هذه المقارنة، واتضاح أبعادها الخافية بصفة خاصة، مثلما يجده حين تشنّ إسرائيل عدواناً، بربري الطابع بالضرورة، ضدّ الشعب الفلسطيني؛ تعرف، مسبقاً، أنها فيه الخاسرة على صعيد الصورة. وهنا تقتضي الحاجة استنفار الإمبراطوريات الإعلامية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا، سواء تلك التي تتحكّم رساميل يهودية في إدارتها، أو يملك نافذون يهود تأثيراً حاسماً في قراراتها؛ الأمر الذي يبلغ، أحياناً، درجة النطق بالكلمة الفصل فيما يُنشر وما يتوجب أن يغيب حتماً، وأياً كانت المحاذير المهنية الناجمة عن انحياز فاضح كهذا.
ولكي لا تبدو حال محي الدين منفردة، فإنّ المرء يستعيد حكاية أخرى، غزّاوية أيضاً، وقعت قبل سنوات؛ خاضتها المجلة الإلكترونية الأمريكية الشهيرة MSNBC، التي اعتادت تنظيم مسابقة سنوية لأفضل الصور الفوتوغرافية، يشارك في تحكيمها قرّاء المجلة، عن طريق التصويت الإلكتروني المباشر. والخطوة الأولى تنطوي على قيام لجنة تحكيم مختصة بتصفية آلاف الصور في شتى الميادين، واختيار عدد محدود منها لتكون بمثابة اللائحة الخاضعة لتصويت المشاهدين، وهذه هي الخطوة الثانية.
وذات سنة كانت صورة «موت في غزة»، عن استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة، قد صعدت إلى المركز السادس، فالرابع، حتى استقرّت أخيراً في المركز الأوّل بأغلبية مليون صوت. وكان واضحاً أنها سوف تفوز دون منافسة تُذكر، خصوصاً بعد أن تحوّلت إلى مادّة لنوع من حرب الرسائل الإلكترونية بين المتعاطفين معها (ومع الانتفاضة والفلسطينيين إجمالاً)، والمناهضين لها (وللانتفاضة والفلسطينيين إجمالاً، واستطراداً). وفي الحصيلة ارتفع عدد الأصوات المؤيدة للصورة إلى ثلاثة ملايين صوت، من مختلف أنحاء العالم، مقابل نحو نصف مليون عند إطلاق المسابقة.
فهل فازت «موت في غزة»؟ كلا، بالطبع، لأنّ الناطق باسم MSNBC أعلن أنّ التحرير قرّر إلغاء المسابقة، نهائياً! «لدينا أدلة مادية على وجود تزوير في التصويت»، قال البيان الرسمي، موضحاً أنّ زوّار الموقع الإلكتروني صوّتوا من أمكنة جغرافية معيّنة، تبدأ من إسرائيل ولا تنتهي عند المملكة العربية السعودية، ممّا يدلّ على «انحراف في نزاهة التصويت». ما الذي يمكن أن تعنيه هذه العبارة؟ وكيف يمكن للتصويت أن ينحرف إذا كانت المجلة الإلكترونية معروضة على شبكة الإنترنيت العالمية، أي العالم بأسره، وليست مقتصرة على منطقة جغرافية بعينها؟ وإذا كان نظام اختيار الصورة الفائزة لا ينطوي على قاعدة أخرى سوى حيازة أغلبية الأصوات، فكيف انحرف التصويت، وكيف وقع التزوير؟
من العبث البحث عن إجابات، خاصة وأنّ التحرير سحب الصورة الأولى، ممّا عقد التنافس لصالح الصورة الثانية، التي تلتقط جرواً كسيحاً! كأنّ المجلة فضّلت التعاطف مع الحيوان، والطعن في نزاهة التصويت للإنسان، وشتّان بين الجرو والطفل الفلسطيني، حين يحتدم وطيس حروب الصورة!
كوباني وغزّة: محنة مدينتين/ هوشنك أوسي
هنالك وحدة حال بين الشعبين الكردي والفلسطيني في ما يخصّ الظلم والقمع والمجازر، وإرادة المقاومة والإصرار على المضي في النضال لنيل حقوقهما المغتصبة، فضلاً عن الانقسام السياسي الكارثي، وتورّط المجتمع الدولي والإقليمي في محنتهما.
ومنذ انطلاقة حركة التحرير الوطنيّة الفلسطينيّة ضد إسرائيل، انخرط الآلاف من الشباب الكردي، خصوصاً منهم السوريين والعراقيين في الفصائل والمنظمات الفلسطينيّة وسقط منهم المئات شهداء دفاعاً عن القضيّة الفلسطينيّة. في المقابل، لا يوجد فلسطيني واحد انخراط في الأحزاب الكرديّة وحمل السلاح ضدّ النظام العراقي السابق أو تركيا أو نظام الأسد الأب، لردّ الجميل، ولم يطالبهم الكرد بذلك، لكن أقلّ المطلوب كان ألّا تنظر النخب السياسيّة والثقافيّة (مع استثناءات قليلة جداً)، إلى قيام دولة كرديّة في الشرق الأوسط على أنها «إسرائيل ثانية»!
حين يسمع الكردي من مثقف وأكاديمي فلسطيني معروف كلاماً يعتبر فيه دخول البيشمركة الكرديّة إلى كركوك «احتلالاً، تحقيقاً لأوهام تاريخيّة»! وحين يرى الكرديُّ المواطنَ الفلسطيني، يأتي من فلسطين ولبنان وسورية وأوروبا، ليقاتل الكرد ضمن «داعش» و «النصرة»، فهل من الغرابة أن يشعر بالخيبة والخذلان؟ فهذا أقلّ ما يُقال فيه إنه «نكران جميل» وإهانة للدماء الكرديّة التي أريقت في سبيل القضيّة الفلسطينيّة.
منذ أشهر، والإرهابيون التكفيريون يحاصرون مدينة كوباني الكرديّة على الحدود التركيّة – السوريّة، وهي تقاوم غزوات «داعش» بأسلحة خفيفة، قياساً إلى الأسلحة الثقيلة (دبابات، مدفعيّة ثقيلة، سيارات مفخخة، وانتحاريين…) التي حصل عليها «داعش» من الجيش الأسدي و «الجيش الحر» والجيش العراقي، بينما لم يصمد جيش نوري المالكي، المدجج بالأسلحة الأميركيّة المتطوّرة أمام «داعش» لأيّام! منذ أشهر والمقاتلون والمقاتلات الكرد، المحسوبون على حزب العمال الكردستاني، وفرعه السوري، حزب الاتحاد الديموقراطي، يقاومون الغزو «الداعشي» وحدهم، بإمكانات متواضعة، وهنالك حالة صمت إعلامي عربي مطبق. بل ثمّة تشويه لهذه المقاومة الكرديّة الباسلة. ففي الصحافة وقنوات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي العربية، لا تضامن عربي أو فلسطيني مع محنة كوباني، فيما أعلن كثر من المثقفين والكتّاب والساسة الكرد السوريين تضامنهم مع مدينة غزّة، وشجبهم واستنكارهم الشديد للعدوان الإسرائيلي الوحشي عليها!
والغريب أنه بدلاً من أن يتّجه المقاتلون العرب والأجانب، والفلسطينيون خصوصاً، إلى فلسطين، لردّ العدوان البربري الإسرائيلي، نراهم يتّجهون نحو كوباني والمناطق الكرديّة لمحاربة الكرد!
الفلسطيني واللبناني والسوري، وسط محنهم، وكذلك الليبي واليمني والمصري والسوداني… لا يسترعيهم بؤس أوضاعهم وحال بلدانهم، بل تضيق أعينهم بأن يدير الكرد أمورهم في مناطقهم السوريّة، وأن يفكّر كرد العراق بالانفصال عن العراق، بحجّة الحرص على وحدة الأمّة العربيّة؟!
والكردي يتساءل: ما الذي فعله حتى يتعاطى شريكه العربي في التاريخ والجغرافيا معه بهذه الطريقة المخيّبة؟! هل هو السبب في ما يجري من صراع بين «فتح» و «حماس»، أو في باقي البلدان العربية؟ ثم ما هي أفضال هذه البلدان وأنظمتها، ونخبها الحاكمة والمعارضة، على الأكراد، حتى يُنظر إليهم نظرة السيّد القلق من تحوّل عبيده نحو الانعتاق والتحرر منه؟!
صحيح أن كثراً من النخب الثقافيّة والسياسيّة الكرديّة السوريّة غير راضين عن سياسات وممارسات حزب الاتحاد الديموقراطي القمعيّة، وينتقدونها بشدّة، إلّا أنهم يقفون إلى جانب مقاتليه ضدّ «داعش»، ليس وفق العبارة العربيّة «أنا وأخي على ابن عمي…»، بل عن قناعة مفادها: «جحيم هذا الحزب السوري الأوجلاني، ولا جنّة داعش».
وصحيح أن الكثيرين من الكرد غير مرتاحين للإسلام السياسي، وتفريخاته المعتدلة والمتطرّفة، إلّا أنهم مع غزّة ضدّ همجيّة إسرائيل ووحشيتها، فيما الكثير من الإخوة العرب (وليس كلّهم طبعاً)، سرّاً أو جهراً، يمنّون النفس بأن يسيطر «داعش» على كركوك وكوباني وكل كردستان، كرهاً بالكرد، لا حبّاً بـ «داعش»!
وبعد ذلك، يحدّثونك، بغزارة وحرقة ومرارة، عن الأوطان والكيانات الوطنيّة والمواطنة، وضرورة أن يكون اندماج الكرد ضمن هذه «الكيانات الوطنيّة» خيارهم الوحيد، في العراق أو سورية! وما إن يعبّر الكردي عن تحفّظه أو شكوكه بهذه السرديّات العربيّة حتّى تبدأ العين الليبراليّة المعتدلة بالاحمرار مثلها مثل العين القوميّة والإسلاميّة المتطرّفة!
فإذا كانت هذه حال النخب العربيّة، مع استثناءات قليلة، فلا عتب على العوام.
* كاتب كردي سوري
الحياة
عذراً غزة “سوريتي” تؤلمني أيضاً/ كارول شاهين
تتوالى أيام الحرب القاسية على غزة، وتتوالى معها – دون إرادتي – مقارنتي المعتادة بين الحرب على غزة، والحرب في سوريا، أنسى تارة صراع الثلاث سنوات في سوريا، لأحدق في صور الصراع الفلسطيني الطويل الحاضر الغائب، ثم أذهب قليلاً إلى “داعش” والعراق، ثم أصمت.
حالي حال كل السوريين وغيرهم من العرب، غزة ليست في القلب، بل أكثر من ذلك، غزة هي قضية، هي عشق، هي آثار وجع قديم لم تلئم جراحه، لكن هل خفت شرارة هذا الثأر الداخلي، أم إنها تراجعت قليلاً مع ظهور عناوين جديدة مثل “الحرب في سوريا” و “داعش في العراق”؟
الواقع ينفي هذه الفرضية الناجمة عن تصارع داخلي، لأن ما ظهر ويظهر هو تضامن كبير مع غزة، وصل لدرجة نسيان الصراعات العربية، والتفرغ لقضية غزة ومستجداتها، ما يعتبر دليلاً نقياً على وجود أمل داخلي بتحقيق النصر، اتقد مع أول “صاروخ” على إسرائيل، والتهب مع أسر أول جندي إسرائيلي.
إلا أن المقارنة الموجعة التي أقلبها في رأسي يومياً واضحة للجميع، ولكنها غريبة، ففي حين أن قضية فلسطين واضحة والعدو واضح كعين الشمس، والشعب واحد في صراع واحد، والهدف هو إزالة ذلك الكيان الغريب في هذه الأرض العربية المقدسة، يطل الصراع السوري بمفرداته المعقدة، وقصصه الغريبة بين أطراف لها فروع وفروع لها جذور، ليتناوب لقب العدو بين هؤلاء المشاركين، كل يصف به خصمه.
وفي خضم هذه الدوامة يظهر التباين أيضاً بالهدف من هذا الصراع، بين إسقاط نظام وحكم، وبين طموح بحرية تائهة، وبين إرهاب يسعى لتأصيل جذوره في المنطقة.
هنا، يصبح من الصعب أن أصف حال شعب تشرد ونزح ولجأ إلى مختلف أصقاع الأرض، نتيجة حرب لا منتهية، لم يعرف لها مسار أو هدف، افتقر نتيجتها للأمل الموجود لدى كل عربي وفلسطيني ينظر إلى غزة، يتابع أحداثها بشغف، وكله أمل بالنصر، بينما ينظر شعب سوريا لقضيته بلا أمل ويحاول قدر الإمكان تجاهل سماع أخبارها.
والمفارقة أن شعب غزة المجروح لديه عدوه ولديه أيضاً أمل كبير لم تستطع الأيام أن تمحوه، فيما يبقى الشعب السوري موجوعاً تائهاً مفتقراً للأمل، فأي ألم أسهل؟
بالطبع ما عاناه الشعب الفلسطيني في هذه السنوات لا يختصر بالكلام، لكنه يداوى بالأمل والمحاولة، وأنا كسورية أشعر بالأسى على أطفال غزة ونسائها، وعلى المجازر المرتكبة بحق شعبها من قبل الإسرائيليين، لكن ما يحدث في سوريا، لا يستهان به أيضاً، لذا عذراً غزة سوريا توجعني أيضاً.
موقع 24