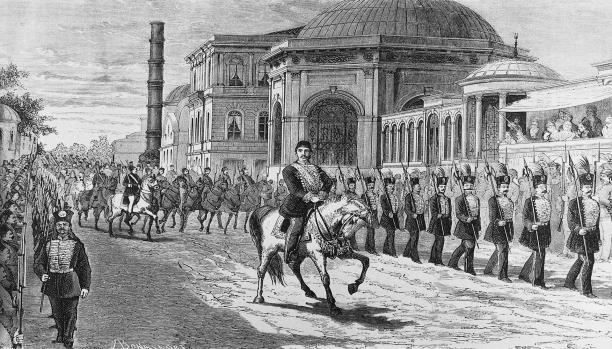بعض الأصول السياسيّة والفكريّة لدونالد ترامب والترامبيّة/ حازم صاغية

يتناول دونالد كريتشلو، صاحب كتاب «فيليس شلافلي ومحافظة القواعد»، تلك السيّدة والمحامية التي اضطلعت في أواخر السبعينات، بدور بارز في إلحاق الهزيمة بالتعديل المقترح على الدستور الأميركي والمعروف بـ«تعديل المساواة في الحقوق» بين الرجال والنساء. أمّا حجّتها في ذلك، فـ«الدفاع عن ربّات البيوت» اللواتي رأت أنّ التعديل «يحرمهنّ امتيازاتهنّ». لكنّ الدور الرجعيّ الأبرز لشلافلي تجسّد في المساهمة التي قدّمتها لبلورة اليمين الشعبويّ، كما عبّر عنه لاحقاً ترامب ووصل به إلى الترشّح الجمهوريّ. فهي وقفت بحماسة إلى جانب باري غولدووتر في انتخابات 1964 الرئاسيّة، ما أكسبها النجوميّة العامّة على نطاق وطنيّ. وقد بقي الثابت لديها العداء للنخبويّة والمدينيّة ولكلّ ما هو عالميّ أو، لاحقاً، معولم.
شلافلي وتافت
وفي خوضها معركة غولدووتر، نشرت شلافلي مانيفستو سجاليّاً بعنوان «خيار وليس صدى»، لا يتعدّى الـ120 صفحة، حيث رسمت مرشّحها صوتاً للمحافظة الحقيقيّة ضدّ المؤسّسة الليبراليّة للشمال الشرقيّ، بما فيها قيادات الحزب الجمهوريّ التقليديّة ممّن كانوا يُعرفون بـ«جمهوريّي روكفلر». وكان أن بيعت من ذاك الكرّاس المناهض لترشيح نيلسون روكفلر، ملايين النسخ اشتراها جمهور تخاطبه نظريّة المؤامرة التي عزاها المانيفستو إلى «صانعي ملوك سريّين» يسيطرون على الحزب الجمهوريّ.
وشلافلي إنّما مثّلت حساسيّة شعبويّة مقيمة في الجذور القاعديّة للحزب ضدّ نُخبه السياسيّة والماليّة والثقافيّة، وضدّ الرأسماليّة كذلك. والحال، أنّ أصحاب هذه الحساسيّة مالوا دائماً إلى تفضيل مرشّح لا يكون من تيّار الحزب العريض، بل يكون برّانيّاً كغولدووتر، أو كترامب في ما بعد، أو إلى مرشّح ثالث من خارج الحزبين.
أمّا «صانعو الملوك» ممّن تهاجمهم شلافلي، فهم من أصحاب المصالح الماليّة الممسكين لا بقرار حزبها فحسب، بل أيضاً بقرار الحزب الآخر. ذاك أنّ المصالح النخبويّة محطّة تقاطع بين ديموقراطيّيهم وجمهوريّيهم الذين ابتزّوا الحزب ودفعوه إلى تسمية مرشّحين لم يكونوا جمهوريّين حقيقيّين. وكان من هؤلاء ألْف لاندون الذي رشّحه الحزب في 1936 وهزمه فرانكلين روزفلت بفارق ضخم، فأُخذ عليه فتوره في معاداة روزفلت و«النيوديل»، ثمّ وِندِل ويلكي، مرشّح الجمهوريّين في 1940، الذي هزمه روزفلت أيضاً، وأُخذت عليه موافقته على أمور عدّة في الروزفلتيّة، ثمّ عمله في إدارة روزفلت، وكذلك توماس ديوَي، المرشّح في 1944 و1948، الذي هزمه روزفلت وهاري ترومان على التوالي، وعُدّ قائد الجناح التقدّميّ ذي التوجّه العالميّ في الحزب الجمهوريّ، قبل أن يتولّى روكفلر قيادة الجناح المذكور.
وليس بلا دلالة أنّ متطرّفي الحزب الجمهوريّ كان لديهم يومذاك رجلهم ممثّلاً بروبرت تافت الذي عُرف بشدّة عدائه لروزفلت وللنقابات، وبنزعته الانعزاليّة في السياسة الخارجيّة، إلاّ أنّه خسر ترشيح الحزب ثلاث مرّات، في 1940 أمام ويلكي، وفي 1948 أمام ديوي، وفي 1952 أمام دوايت آيزنهاور الذي تجنّبت شلافلي مهاجمته بسبب شعبيّته، وهو جالب النصر في الحرب الثانية، فلم تُدرجه في خانة منقوديها. مع هذا، اعتبرت أنّ آيزنهاور سرق، في معركة 1952 الرئاسيّة، فرصة الترشّح من تافت.
غولدووتر ونيكسون وريغان
عكست حجج شلافلي عن الأربعينات والخمسينات صفاء أيديولوجيّاً لا يساوم ممزوجاً بسياسات شلليّة داخل الحزب الجمهوريّ نفسه. فهي عبّرت عن أفكار «اليمين القديم» لجهة الحذر من التورّط الخارجيّ والعداء للسوفيات والإصرار على التفوّق العسكريّ الأميركيّ، ودائماً ما أرفقت ثوابتها تلك بتوكيد المسافة عن قيادات التيّار الحزبيّ العريض والمعتدل. في هذا الوقت نفسه، جاء صعود باري غولدووتر ليعكس استيلاء ناشطي الوسط الغربيّ، وهو معقل التافتيّين، والمجموعة التي عُرفت بـ»الحزام الشمسيّ» في الجنوب، على جزء أساسيّ من القرار الحزبيّ. وهذا لم يكن عديم الصلة بتحوّلات سكّانيّة شرعت تعزّز وزن الجنوب والوسط على حساب الشمال الشرقيّ.
والمعروف أنّ غولدووتر، سناتور أريزونا وعدوّ النيوديل وخصم جمهوريّي روكفلر، كان قد طرح تحدّياً ليبيرتيريّاً على السلطة من خلال كتابه «ضمير محافظ» الصادر في 1960، وهو أيضاً أقرب إلى مانيفستو من 123 صفحة يحمل وجهة النظر الأكثر محافظة في المسائل الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ثمّ من خلال ترشّحه في 1964 حين مني بهزيمة شعواء.
لكنْ، كان لجمع شلافلي بين الأيديولوجيا والسياسات الحزبيّة واليوميّة أن فعل فعله. ففي 1968، حظي ريتشارد نيكسون بتأييدها في مواجهة رونالد ريغان. فهو، في ذروة الحرب الباردة عهدذاك، كان الأسبق والأشدّ في بلورة سياسات تلك الحرب كما تتطلّبها المواجهة مع موسكو. أمّا ريغان، الذي كان قد انتُخب قبل عامين حاكماً لكاليفورنيا، فاعتبرته وجهاً محلّياً، وغير مجرّب في السياسة الخارجيّة وقضايا التسلّح النوويّ قياساً بمنافسه الذي شغل نيابة الرئاسة في الخمسينات. وما لبثت أن اندلعت المعركة المديدة، التي غطّت السبعينات، حول المساواة في حقوق الجنسين، فصوّبت شلافلي نيرانها باتّجاه «المؤسّسة» في الحزبين، ومعها هوليوود والإعلام والحركة النسويّة، وقد استطاعت أن توحّد العديد من الأجنحة المحافظة المتناثرة خلف شعار واحد هو «أوقفوا تعديل المساواة في الحقوق»، لتكسب المعركة في النهاية.
بيد أنّ ما فعلته آنذاك كان له دور تأسيسيّ على صعيد آخر: فهي بمخاطبتها الإنجيليّين بوصفهم جماعة سياسيّة، وهو ما كان يحصل للمرّة الأولى بالصفة هذه، أعطت درساً مبكراً لاستراتيجيّي الحزب الجمهوريّ ممّن بدأوا يتوجّهون إلى هذه الفئة من المصوّتين، وهو ما سجّلته انتخابات منتصف الولاية عام 1978. وبالفعل، كان لصعود اليمين الدينيّ أن تسبّب بفوز الجمهوريّين بالبيت الأبيض خمس مرّات من أصل سبع، ما بين 1980 و2004.
على أنّ ظنّ شلافلي بنيكسون قد خاب، من دون أن تقتصر عليها خيبة الظنّ. هكذا أيّدت ريغان في 1980، هو الذي تحوّل سريعاً بطلاً لليمين المحافظ. ومع أنّها لم تُعط أيّ منصب في إدارته، وسط إشارات إلى رغبتها في المنصب، فإنّها واظبت على تأييده بالحماسة إيّاها. وعلى مدى السنوات العشرين لما بعد ريغان، بحثت عن بطل آخر يكون «خياراً» ولا يكون «صدى». فهي لم تؤيّد جورج بوش الأب في محاولته الوصول إلى البيت الأبيض، ولا أيّدت بوش الابن، كما استنكفت عن دعم جون ماكّين. غير أنّها بايعت ميت رومني في 2012، ردّاً منها على منافسه باراك أوباما. وما لبث في 2016، أن ظهر مرشّحها الفعليّ. إنّه دونالد ترامب. فهو جسّد، في نظرها، كلّ ما أرادته بعد غولدووتر وريغان: وطنيّ، مع الحمائيّة التجاريّة، مع الحدّ من الهجرة، وانعزاليّ جديد. وقد رفضت شلافلي الحجج القائلة إنّ ترامب ليس محافظاً جدّيّاً، وأنّه جاهل بالمبادئ الدستوريّة والقيم الدينيّة والعائليّة، لا بل غضّت النظر حتّى عن آرائه الإيجابيّة بفلاديمير بوتين، مسخّرة جهدها لمساعدته على بلوغ الترشّح الحزبيّ. فمع ترامب، يتحقّق هدف ناضلت شلافلي طويلاً لأجله، وهو انتصار اليمين الشعبويّ على المؤسّسة الحزبيّة. لكنّها ما إن باركت بطلها حتّى رحلت عن دنيانا، بعد 92 عاماً في خدمة الوعي الرجعيّ.
«اليمين البديل» ورون بول
أمّا ماتيو شافيلد فيبدأ، في تناوله ترامب، من رفض النظريّة التي عبّر عنها المؤتمر الوطنيّ الأخير للحزب الديموقراطيّ، من أنّ ترامب ليس جمهوريّاً ولا ينتمي إلى التقليد المحافظ للحزب. ففي خطابها يومذاك، ربطت هيلاري كلينتون بينه وبين حركة سياسيّة قوميّة بيضاء تُعرف بـ«اليمين البديل». كما تردّد، وشارك في هذه المعزوفة بعض الجمهوريّين، أنّ حملته انشقاقٌ عن السياسات الجمهوريّة.
وهذا، في رأي شافيلد، صحّته جزئيّة. ذاك أنّ ترامب امتداد لاستراتيجيّة سياسيّة عُرفت بالليبيرتيريّة العتيقة (باليو)، والتي كانت ذات مرّة قويّة في بعض أوساط الجمهوريّين، لا سيّما المرشّح الجمهوريّ السابق للرئاسة رون بول. ويدهش الكاتب أنّ أكثريّة القوميّين البيض وأصحاب النظريّات التآمريّة ممّن خاطبهم رون بول، صاروا ترامبيّين متحمّسين.
وبول، ما بين 1937 و2003، سجّل الرقم القياسيّ في الكونغرس في التصويت المحافظ، أمّا سياسته الخارجيّة فتقوم على رفض كلّ تدخّل بالمطلق، ولهذا كان المرشّح الوحيد غير الديموقراطيّ، عام 2008، الذي صوّت ضدّ حرب العراق في 2002، وهو يؤيّد الانسحاب من الأمم المتّحدة ومن الحلف الأطلسيّ لأنّهما، كما يرى، يضعفان السيادة الوطنيّة. وفي هذا المعنى، كان رون بول بين أبرز نقّاد المحافظين الجدد على سياستهم الخارجيّة التدخّلية. فهو، إلى تأييده المطلق لإسرائيل ورفضه كلّ ضغط أميركيّ عليها، يذهب إلى أنّ التورّط في الشرق الأوسط إنّما يأتي بخطر الإرهاب على بلاده، ويؤكّد دائماً أمن الحدود وحيويّته.
لقد مثّل بول في الليبيرتيريّة تغليباً لمبدأ القوميّة البيضاء على مطلب تقليص الدولة، وهو يُعدّ «العرّاب الفكريّ» لحركة «حفلة الشاي» التي تأسّست في 2009، وعُدّت منبراً لليبيرتيريّي الحزب الجمهوريّ من دون أن تقتصر عليهم. والحال، أنّ الحركة هذه اضطلعت بدور ملحوظ في تمكين الجمهوريّين من أن يستعيدوا، في 2010، سيطرتهم على مجلس النوّاب.
والليبيرتيريّة (الحرّيانيّة ؟) في الولايات المتحدة ذات دلالات لا تنسجم دائماً مع دلالاتها الأوروبيّة. فهناك طغى عليها معنى رفض الدولة، الذي أخذ به يساريّون فوضويّون وإن ظلّ اليمينيّون، في ولائهم للحرّيّة الفرديّة وحكومة الحدّ الأدنى، أبرز دعاته وممثّليه. وفي الأحوال كافّة، فبسبب حرب فيتنام، منذ بداياتها في أوائل الستينات، انتهى كلّ تداخل محتمل بين يسار ويمين ليبيرتيريّين، إذ عارض أوّلهما الحرب التي تحمّس لها الثاني.
ولبول كتب عدّة في الاقتصاد، ويعتبر نفسه تلميذاً للاقتصاديّين النمسويّين، فريدريك هايك ولودفيغ فون ميس وموراي روثبارد، معارضاً بذل أيّة تقديمات لـ«الأغراب غير القانونيّين»، ومناهضاً حادّاً للإجهاض. أمّا في ما خصّ الضرائب، فأُطلق عليه لقب «دكتور نو»، تيّمناً بعنوان فيلم سينمائيّ شهير لجيمس بوند، لكثرة ما صوّت رفضاً لها.
مورّاي روثبارد
أمّا المثقّف والاقتصاديّ الذي تمثّل أفكاره الجسر الواصل بين بول وترامب، فهو مورّاي روثبارد، النمسويّ الأصل والمنتمي إلى المدرسة الاقتصاديّة النمسويّة، والذي شارك في تأسيس «معهد كاتو» الشهير ويُعتبر، على نطاق واسع، أب الليبيرتيريّة. وهو، على عكس كثيرين من الليبيرتيريّين الذين رأوا إلى مذهبهم كتجاوز لانقسام اليمين واليسار، اعتبر الليبيرتيريّة لا أكثر من إعادة الصياغة لمعتقدات «اليمين العتيق» التي عارضت النيوديل وكلّ أشكال التدخّل الأجنبيّ في مطالع القرن الماضي. وقد عبّر كثر من تابعيه عن آراء عنصريّة، وكان أبرز هؤلاء الكاتب هـ ل منكن، الذي عُرف، بين أمور وأخرى، بعلمويّته وداروينيّته الاجتماعيّة ورفضه الديموقراطيّة التي تجعل «أصحاب النقص يتحكّمون بالمتفوّقين»، فضلاً عن رفضه مشاركة بلاده في الحربين العالميّتين الأولى والثانية.
وقد وُجد بعض التعاطف مع العنصريّة واللاساميّة في أجواء الليبيرتيريّين. وفي 1976، كرّست مجلّة «ريزون» (عقل) الناطقة بلسان الحركة، عدداً كاملاً للتشكيك في المحرقة، كما نشرت بإفراط افتتاحيّات تدافع عن النظام العنصريّ في جنوب أفريقيا.
إلاّ أنّ تأسيس روثبارد «معهد لودفيغ فون ميس» في 1982، تكريماً للاقتصاديّ والمنظّر النمسويّ الذي أرسى أسس المدرسة النمسويّة في الاقتصاد، ومن بعدها مدرسة شيكاغو، هو ما مكّن الحركة السياسيّة الناشئة من عقد صلات متينة مع جماعة النيوكونفيديراليّة التي تعيد قراءة الحرب الأهليّة الأميركيّة في ستينات القرن التاسع عشر بقدر ما تعيد الاعتبار الى «قضيّة مخسورة» هي كونفيديراليّة الجنوب العنصريّة. هكذا باشر المعهد نشر أعمال نقديّة عن «الدمج القسريّ» في أميركا، وتهجّمية على أبراهام لينكولن، واعتذاريّة لقادة الكونفيديراليّة. كذلك التقى باحثو المعهد وأكاديميّوه مجموعات عنصريّة كـ»عصبة الجنوب» التي ترفع علم الكونفيديراليّة، وتعتبر أنّ هدفها الحصول على جمهوريّة حرّة ومستقلّة في الجنوب.
كوكلاكس كلان ومكارثي
لا بل نشر روثبارد في كتابه «أخلاق الحرّية»، فصلاً يقتطف منه ماتيو شافيلد قوله: «سيمتلك المجتمع الحرّ الصافي سوقاً حرّة مزدهرة بالأطفال»، من دون أن يحدّد أعراق الأطفال الذين يُفترض أن يباعوا في تلك السوق.
هذا الرأي وآراء كثيرة مماثلة عبّر عنها كتّاب المعهد، إلاّ أنّ بعض أكثرها مباشرة وسوءاً كان ما كتبه روثبارد في 1992، إذ نعى هزيمة القوميّ الجمهوريّ الأبيض والقياديّ السابق لكوكلاكس كلان ديفيد ديوك في انتخابات حاكميّة لويزيانا قبل عام، حيث ألحق الهزيمة به ائتلاف من الحزبين. وإذ وسّع بضع موضوعات كان قد تناولها، في 1990، صديقه وشريك حياته، لويلين روكويل، الاقتصاديّ والكاتب الموصوف بالفوضويّة الرأسماليّة، وجامع التبرّعات للقضايا الليبيرتيريّة، فقد جادل روثبارد بأنّ ترشّح ديوك ضرورة حيويّة لأنّه يوضح حقيقة أنّ «أميركا العتيقة» إنّما أطاحها «ائتلاف متعصرن في القرن العشرين يجمع بين العرش والهيكل»، أمّا «كنيسة الدولة» لدى هذا الائتلاف فالموظّفون الرسميّون والصحافيّون وعلماء الاجتماع.
وفضلاً عن امتداحه ديوك بوصفه المرشّح النموذجيّ، أثار روثبارد موضوع سناتور ويسكونسن السابق والراحل، «المثير» جوزيف مكارثي، الذي اشتُقّت المكارثيّة من اسمه، لا من زاوية آرائه الاقتصاديّة، بل بسبب شعبويّته العاصفة واستعداده للقيام بأعمال يستنكف عنها سواه. وقد حمل وصف روثبارد لمكارثي ما يذكّر بحملة ترامب: «الشيء المدهش والمثير في جو مكارثي هو بالضبط «أدواته» – شعبويّته اليمينيّة: استعداده للتواصل وقدرته عليه، وتعطيله نخبة السلطة: الليبراليّين والوسطيّين والإعلام والمثقّفين والبنتاغون وجمهوريّي روكفلر، وصولاً منه إلى الجماهير مباشرة وتحميسها… مع جو مكارثي، هناك حسّ بالديناميّة، بعدم الخوف، وباللامحدوديّة، كما لو أنّه يجعلنا نتساءل عمّن سيستدعيه إلى المحكمة تالياً».
وفي استكمال لما بدأته شلافلي، أكّد أنّ الليبيرتيريّين يحتاجون إلى التحالف مع من قد لا يحبّونهم من أجل مضاعفة أعدادهم، وهو ما ينطبق على علاقتهم باليمين المسيحيّ المحافظ الذي يكره الحكومة الفيديراليّة ولا يكفّ عن التخويف بالمخدّرات والجريمة.
كلّ هذه المواقف الليبيرتيريّة العتيقة عبّر عنها ديوك في حملتيه لمجلس الشيوخ في 1990 وللحاكميّة في 1991. لكنّ سياسيّاً آخر كان يحبّه روثبارد عبّر أيضاً عنها: إنّه، أيضاً وأيضاً، رون بول، الذي غادر الحزب الجمهوريّ في 1988، ليخوض عن الحزب الليبرتيريّ المعركة الرئاسيّة عامذاك.
فروثبارد وبول عرف واحدهما الآخر وعملا معاً في السبعينات، حين شاركهما العمل روكويل الذي خدم بول في هندسة سياساته وخططه في الكونغرس، قبل أن ينتقل مع روثبارد إلى تأسيس «معهد ميس». وعلى امتداد العقود اللاحقة، رأس روكويل تحرير عدد من نشرات الرسائل الإخباريّة التي عادت ملكيّتها إلى صديقيه. ولئن اشتهرت منشورات رون بول إبّان الحملات الرئاسيّة، فإنّ طبيعتها الخلافيّة والإثاريّة لم تعد تفاجئ. فهي إلى كونها مربحة جدّاً، غالباً ما نمّت عن مواقف عنصريّة تذكّر ببعض ما يفعله ترامب الآن. فقد وصل الأمر بأحد محرّريها إلى تقديم النصح باستخدام بندقيّة غير مسجّلة في الدوائر الرسميّة لإطلاق النار على «شبّان المدن». وسخر من السود عدد آخر من المحرّرين، فاقترح أحدهم أسماء بديلة لنيويورك كـ«زوفيل» (مدينة حديقة الحيوانات) و«رايبتاون» (مدينة الاغتصاب).
وتولّت منشورات بول توسيع التعريف بعمل جارِد تايلر، وهو كاتب قوميّ أبيض ومحرّر صحافيّ أسّس مجلّة «النهضة الأميركيّة»، وبات من أبرز رموز اليمين البديل المؤيّدين لترامب. وقد حملت مقالاته بعض نظريّات المؤامرة اللاساميّة وبعض التهكّم على المثليّين.
على أيّة حال، فإنّ فشل بول في الحصول على ترشيح حزبه في 1988، مّا اضطرّه إلى الترشّح عن حزب ثالث، إنّما عُدّ نكسة لذاك التيّار، خصوصاً أنّ الذي حاز الترشّح الجمهوريّ والفوز نخبويٌّ وروكفلريّ نمطيّ هو جورج بوش الأب. لكنْ في السنوات القليلة الماضية، تراجع استخدام تعبير «الليبيرتيريّة العتيقة» لمصلحة «اليمين البديل»، ومعه بدأ جيل يكتشف ميراثه المخبّأ ويجهر بعنصريّته وبالنظريّات التآمريّة. ويردّ الكثيرون من كتّاب اليمين البديل أصولهم إلى روثبارد الذي تشبه دعوته إلى «أمم سيّدة ترتكز على العرق والإثنيّة» معتقدات يحملها عتاة الترامبيّين الذين سبق لهم أن تجمّعوا حول رون بول.
وهناك أسماء بعينها تشكّل نقاط تقاطع واضح بين بول وترامب. فإبان الحملة الرئاسيّة للأوّل، تبرّع له ستيفن دونالد، المعروف بـ»دون بلاك» بـ500 دولار. ومع تواضع المبلغ، فإنّ صيت الدون أثار ضجيجاً وحمل كثراً على مطالبة بول بعدم قبول تبرّعه. ذاك أنّه مالك المواقع الإنترنتيّة المعروفة بـ»ستورمفورت»، والتي تسمّي نفسها مواقع لـ»التفاخر الأبيض». وبالطبع، لم يرفض بول ذاك الدعم الرمزيّ لرجل حضّ، في آذار (مارس) الماضي، مستمعي الراديو على التصويت لترامب. أمّا صاحب البرنامج الإذاعيّ في ممفيس جيمس إدواردز، فقد سبق له أيضاً أن دعم بول فيما يدعم ترامب اليوم، وهذا فضلاً عن ديوك الذي عبّر تكراراً عن إعجابه بالرجلين.
تحوّلات المجتمع والجمهوريّين
ويتناول زاك بوشامب جانباً آخر هو العلاقة بين النظام الجديد وصعود اليمين الراديكاليّ في موازاة تحوّلات الحزب الجمهوريّ نفسه. فهو يلاحظ أنّ الولايات المتّحدة لم تعرف التقليد القوميّ الشعبويّ الذي عرفته أوروبا، وإذا صحّ أنّ الشعبويّ المحلويّ بات بوكانان (وهو يُحسب على المحافظة العتيقة مثله مثل نيوت غينغريتش)، وجد بعض النجاح الانتخابيّ، فإنّه لم يكسب أيّة انتخابات وطنيّة. ومن أبرز أسباب ضعف هذا التقليد في الولايات المتّحدة، العراقيل التي يضعها النظام الأميركيّ أمام أيّ حزب ثالث. فمثلاً، حين حصل المرشّح الرئاسيّ روس بيرو، عام 1992، على خُمس مجموع الأصوات، فهذا لم يُترجَم إلاّ صفراً في الكليّة الاقتراعيّة.
لقد كان ترشّح باري غولدووتر، في 1964، بداية لتحوّل يمكن أن يجعل الحزب الثالث، أو المفترض ثالثاً، هامشاً قابلاً للتوسّع من هوامش الحزب الجمهوريّ نفسه. فغولدووتر ترشّح ضدّ الديموقراطيّ ليندون جونسون الذي وقّع مرسوم الحقوق المدنيّة، أي أنّه ترشّح فعليّاً ضدّ هذا المرسوم الذي غيّر طبيعة الحزبين: فمن الديموقراطيّ خرج الجنوبيّون البيض الذين ظلّوا قاعدته منذ القرن التاسع عشر لينضمّوا إلى الجمهوريّين ممّن صار حزبهم يضمّ الكتلة العنصريّة الأكبر من المقترعين.
وبناء على دراسة أعدّها نيكولاس فالنتينو حول اتّجاهات التصويت في الولايات المتّحدة منذ السبعينات، تبيّن أنّ البيض الذين يعيشون في الولايات، التي شكّلت قبل الحرب الأهليّة كونفيديراليّة الجنوب، كانوا دائماً أشدّ تعبيراً عن التحيّز العنصريّ من بيض المناطق الأخرى في أميركا. إلى ذلك، أضيفت هجرة المكسيكيّين اللاتينو إلى ولايات الجنوب لتتضاعف بين 1980 و2008، فيما تضاعفت نسبة من ولدوا منهم خارج الولايات المتّحدة أربعة أضعاف: من حوالى 2،4 مليون إلى 8،17 مليون. ولئن بدا الديموقراطيّون الطرف المؤهّل للاستفادة الانتخابيّة من هذا التحوّل، فإنّ الانتقال الأبيض إلى الحزب الجمهوريّ جعل يتلاحق ويتنامى. ولأنّ ما ينطبق على اللاتينو ينطبق على الأفرو – أميركيّين، السود، بتنا أمام النتيجة التالية: بينما تزداد البلاد تعدّداً وانفتاحاً واختلاطاً، يزداد الحزب الجمهوريّ صفاءً، مُكسباً هؤلاء الأشدّ عنصريّة في صفوفه نفوذاً أكبر، ومتيحاً لهم التحكّم بالحزب وقراره. هكذا صار مطلوباً ظهور ماري لوبن أميركيّ.
وكان مايكل تسلر قد لاحظ، في تناوله الانتخابات التمهيديّة لاختيار مرشّح رئاسيّ في 2008 و2012، أنّ الأكثر عنصريّة لم يكونوا يصوّتون لميت رومني وجون ماكّين، أي للذين يفوزون بالترشيح الحزبيّ في النهاية. لكنّ القاعدة انقلبت مع ترامب، بحيث غدا «أوّل جمهوريّ في الأزمنة الحديثة يفوز بالترشيح الحزبيّ للرئاسة استناداً إلى عواطف مناهضة للأقليّات». فهو مرشّح الخوف من التعدّد الثقافي ومن انهيار الأكثريّة البيضاء.
وقد بدا ترامب، بثرائه ونجوميّته وبعده من النخبة الجمهوريّة، الأكثر استعداداً لأن يقول ما كان قوله محرّماً، وبدا أنّ ما يقوله إنّما يحظى بتأييد واسع في القواعد الحزبيّة. ولم يكن عديم الدلالة أن تترافق بدايات صعوده السياسيّ مع تشكيكه في أصول باراك أوباما وما إذا كان ولد في أميركا، في ما بات يُعرف بالحركة «الوِلاديّة». ففي تطهير الأصول، تبدأ السياسة التي تنطوي على حنينين، واحد إلى كونفيديراليّة الجنوب السابقة على الحرب الأهليّة، وآخر إلى البياض الخالص الذي لا يخالطه لون آخر وثقافة أخرى.
الحياة