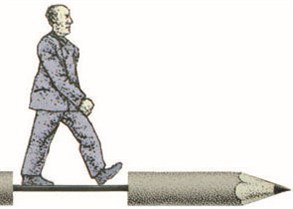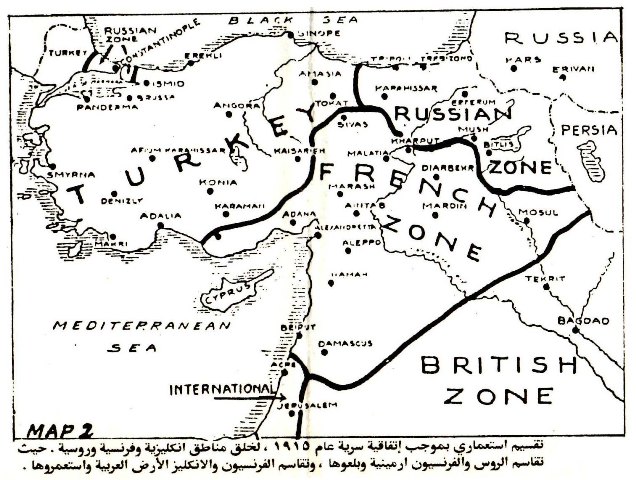الطائفة والطائفية ومشكلات التوحيد الكياني
عبد الاله بلقزيز
يمكن استعارة مفهوم العصبية الخلدوني لتعريف الطائفة بأنها شكل من أشكال الاعتصاب الاجتماعي . نحن ندرك، طبعاً، أن العصبية في التحليل الخلدوني مدارها على النسب، في المقام الأول، وأنها إلى رابطة الدم ترتدّ، حتى وإن كان النسب “أمر وهميّ” في رأي ابن خلدون، وأن الفائدة منه إنما في تحقيق الالتحام وتوفير أسباب النُّعْرة، وحتى إن كانت رابطة الولاء، ورابطة الحلف، تؤدي من الوظائف ما تؤديه رابطة النسب عينها، إذ ليست العبرة في الاعتصاب بما عليه يقوم من مواد أو أساسات، وإنما بما يوفره من علاقات تضامنية داخل جماعة اجتماعية ما .
والحال إن الطائفة، وإن هي قامت على رابطة أخرى غير النسب وقرابة الدم، تؤدي من الوظائف في الاجتماع الإنساني عين ما تؤديه عصبية القبيل التي كانت العصبية الأساس في الاجتماع الإسلامي التقليدي، واْبَتَنى عليها ابن خلدون تحليله لذلك الاجتماع، ولأدوارها في تطوّر المجتمعات والدول، وتشكيل مؤسساتها .
يمكن تعريف الطائفة تعريفاً تصاعدياً متعدداً، من حيث هي ظاهرة مركَّبة من تكوينات ومستويات متعددة، بما هي ظاهرة ثقافية – أيديولوجية ابتداءً، وظاهرة اجتماعية – اقتصادية تالياً، ثم بما هي ظاهرة سياسية أخيراً . وليست المستويات الثلاثة هذه منفصلة عن بعضها، ولا هي متعاقبة في الزمان، بل إن أشكالاً من التداخل بينها، والتزامن، تفرض نفسها على القارئ فيها، وعلى نحو قد يتعَسَّر معه – أحياناً – رؤية بُعدٍ واحد منها بمعزل عن غيره من الأبعاد . على أن ما تنطوي عليه من تركيب وتشابك في التكوين لا يقبل التبين إلا متى أعدنا البنية المتمفصلة العناصر إلى وحداتها التكوينية الأولى الطائفة، في مستوى أوّل منها، رابطة ثقافية – عَقَدية – روحية، تتأسس على الاعتقاد بانتماء جماعة إلى فكرة دينية، أو مذهبية، واحدة تصهر أفرادها جميعاً في بنية جمعية واحدة، وتميزهم من غيرهم من الجماعات الملتئمة على فكرة “روحية” مخالفة . على حدود هذا الشعور بالذاتية والتمايز، ميَّز النسطوري نفسه من اليعقوبي، وميَّز المعتزلي نفسه من الأشعري والماتريدي أمس، ويميز السني نفسه – اليوم كما أمس – من الشيعي والإباضي والزيدي، مثلما يميز البروتستانتي نفسه من الكاثوليكي والأورثوذوكسي، والمسيحي نفسه – عموماً – من المسلم وبالعكس . لقد كان هذا النمط من الاعتصاب، القائم على رابطة الملّة والنِّحلة، سمة مميزة للجماعات طوال عهود العصر الوسيط، أو ما قبل – الحديث، وكانت النُظُم الثقافية والاجتماعية والدولتية القديمة توفر له شروط الإمكان وتبرّر وجوده، إذ لم يكن يمكن للانقسامات الاجتماعية أن تعبّر عن نفسها، في تلك الأوضاع المجتمعية، إلا في شكل تقاطبات عمودية يلعب الثقافي والأيديولوجي دوراً محدداً فيها .
والطائفة، في مستوى ثانٍ، رابطة اجتماعية تولّدها علاقات الجوار والقرابة والمصاهرة، والشعور بالتضامن والانتماء المشترك إلى جماعة ذات منظومة قيم خاصة تميزها من غيرها من الجماعات .
وللحفاظ على هذه الرابطة الاجتماعية، وإعادة إنتاجها باستمرار، وتعظيم فوائدها المادية والرمزية، تميل الطوائف إلى مأسسة كياناتها الاجتماعية من طريق توليد الأطر الاجتماعية والأهلية: الدينية والتربوية وسواها مما به تتجدد روابطها الداخلية كعصبيّة اجتماعية . ويساعدها في ذلك أن معظم المجتمعات والدول – قديماً وحديثاً – تسلّم للطوائف بالحق في اتباع نظام خاص بها في الأحوال الشخصية يحفظ لها هويتها الخاصة . وقد تذهب المأسسة إلى قيام الطوائف بوظائف اقتصادية موازية للوظائف الاقتصادية التي تنهض بها الدولة، نتيجة سيطرتها على الموارد الضريبية الشرعية (الأوقاف السنية أو زكاة الخمس الشيعية، أو أوقاف الكنائس . . إلخ)، وهي وظائف تزيد مع إمكان تأسيس مؤسسات إنتاجية أو خِدمية أو بنكية خاصة بالطوائف تلك، بل إن الميل إلى ذلك غالباً ما يكون صارخاً، لأنه يقوم على واقع حاجة موضوعية في الاجتماع الطائفي، هي أن سلطة الطائفة الاجتماعية تتعزز بسلطتها الاقتصادية، أو تضعف بضعف الأخيرة .
ثم إن الطائفة، في مستوى ثالث، رابطة سياسية تتولد من اشتداد عصبيتها الجماعية، ومن رغبتها في تعظيم مكانتها في الدولة والنظام السياسي . وتنحو الطائفة نحو التمأسس السياسي إما من طريق قيام زعمائها ووجوهها بأدوار سياسية باسم الجماعة الطائفية التي “يمثلونها”، أو من طريق تشكيل أحزاب سياسية ناطقة باسمها، ومشاركة في الحياة السياسية قصد حيازة مكانة للطائفة في النظام السياسي وتعظيم حصصها في ذلك النظام . ومن النافل القول إن المشكلة الطائفية تبدأ من هذه اللحظة التي تنتقل فيها الطائفة من تضامن يولده شعور جمعي بالاشتراك في دين أو مذهب، إلى كيان مغلق يبحث لنفسه عن حصة من السلطة والدولة لا تتحقق إلا بإعادة تعريف الشعب والدولة على نحو جديد مختلف .
ليست الطوائف قصراً على مجتمعات المشرق العربي، فقد لا يخلو مجتمع في العالم من تكوين طائفي أو مذهبي، لكنها لا تطرح مشكلاتها إلا في مجتمعات عصبوية تعاني نقصاً فادحاً في الاندماج الاجتماعي، ولم تتحقق فيها عملية صهر كافية للجماعات في كيان وطني جامع، على مثال ما هي عليه المجتمعات العربية الراهنة . هكذا تبدو الطائفية، في هذه الحال، نقيضاً للهوية الوطنية ونقضاً لها باسم الهوية والخصوصية، مثلما تبدو عائقاً أمام تكوُّن الدولة الوطنية الحديثة بما هي تمثيل مجرد للشعب والأمة، وتجسيد للسيادة الوطنية . غير أن مشكلة الطائفية ليست في وجود طوائف، ومشاعر طائفية لدى جماعات اجتماعية بعينها، في مجتمع ما من المجتمعات، وإنما هي في نظام سياسي مغلق، وغير تمثيلي، يعجز عن تقديم جواب مادي: اجتماعي وسياسي، عن مشكلة التمثيل والمشاركة السياسية، فيميل إلى التصرّف بوصفه نظام أقلية في مواجهة جماعات أخرى! وهذه حال النظام السياسي في البلاد العربية المعاصرة .
مشكلة الطائفية ليست مسألة سوسيولوجية، لأنها ليست مسألة تكوين اجتماعي نافر أو شاذ، وإنما هي – بالتعريف – مشكلة سياسية، لأنها مشكلة نظام سياسي متأخر يفتقر إلى أسباب الصيرورة نظامَ شرعيةٍ شعبيةٍ ووطنية . وهكذا لا دواء لداء الطائفية إلا بتأسيس الدولة والاجتماع السياسي على علاقات المواطنة، وما تستجرُّه – إلى جانب الولاء للوطن – من حقوق مدنية وسياسية تعيد تعريف الناس بما هُم مواطنون متساوون، لا بما هم جمهورُ جماعات – عصبوية مغلقة تعرّف نفسها بهوياتها الصغرى الفرعية . لا تنتهي الطائفية إلا بتحلل العصبيات الأهلية الصغرى، وتَكَوُّنِ عصبية كبرى جامعة هي “عصبية” الانتماء الوطني العابرة لحدود الدين والجنس وما في معنى ذلك . . .
الخليج