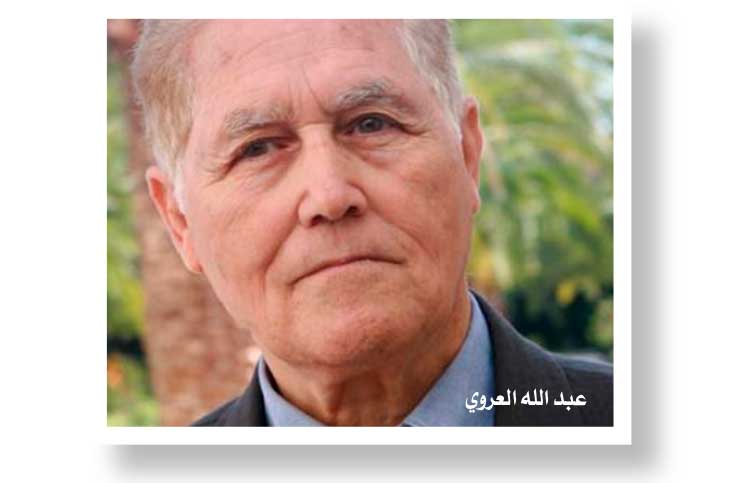الثورة هي الآمرة والمأمورة سلما أو حربا؟
مطاع صفدي
عندما تطغى النشاطات الدبلوماسية في سياق ثورة أهلية اجتماعية كبرى، على وهج أحداثها اليومية، فليس معنى ذلك أن الثورة فقدت حيويتها، أو أنها قد بلغت حد التحول إلى شبكيات المناورات المعقودة خلف ظهرها أو على حساب إنتاجها العقلي على الأرض، بل ربما جاء التحرك الدبلوماسي رديفاً ضاراً بالعمل الشعبي أصلاً، وهو يدعي أنه يختصر نضاله، ويوصله إلى نتائجه المرجوة من دون أثمانها الدموية الباهظة التي تدفعها القوى الشبابية من أرواح شهدائها، ومن مصالح أنصارها.
المناداة فجأة بالحلول السياسية، ترن في آذان الثوار كأنها نعي لمشروعهم. وفي الوقت عينه قد تقام أصناف من المحاكم الصامتة مابين وجدانات رموزها، كأنما يغدو المناضلون في أعين ذواتهم، مدانين بارتكابات لم يقصدوها، فهل أخطأت الثورة أم كان هو الخطأ عندما اختاروا وتنادوا للإنتماء لها، ثم راحوا يمارسون كل أفعالهم باسمها، وتحت وصاية مبادئها. وقد تكون هي بريئة كلياً مما قد يُعزى إليها أحياناً من انحرافات بعض أدعيائها. فمن هو المتّهم الحقيقي في هذه المحكمة الكبرى التي تُعقد على أنقاض ثورة مأمورة بالتوقف قبل أن تكمل مشوارها الموعود. هذا الأمر بالتوقف يأتيها من خارجها، لم تفرضه أخطارها المجهولة، لم تحتّمه محصّلةُ عجزٍ متراكم في شعاراتها ومناهجها، لم تحققه هزيمة واضحة المعالم، أحاقت بوقائعها كلياً أو جزئياً. ومع ذلك، ينصب الأمر بالتوقف على رؤوس جحافلها، كما لو أن الثورة لم تعد تملك خياراً سوى أن تنهي نفسها بنفسها، تنفّذ انتحاراً محكومة به من سواها. أليس المفجع في كوارث الأمم أن تكون هزائمها التاريخية من صنع أبطالها أنفسهم، كما لو كان هؤلاء أمسوا من صميم جنس أعدائها.
العالم الدبلوماسي غربياً وشرقياً مشغول هذه الأيام بمعزوفة (الحل السياسي). فقد اكتشف زعماؤه مرة واحدة أن القتل هو المنتصر الوحيد مابين السلطة في سورية والمقاومة ضدها. وإن القتل وحده هذا ـ إذا ما تُرك طليقاً ـ يمكنه أن يصبح القانون السيد على الجميع، متحكماً في كل ظالم أو مظلوم معاً، إذ يجعلهما متساويْن في العبودية لمبدأ القوة العمياء، فلم تنفجر الثورة، ولم تنفتح أبواب الجحيم من كل جهة كيما تنقلب حياة الناس رأساً على عقب، إلا لأن ما يسمى بالحل السياسي كان مستحيلَ الوجود، منذ ما قبل الثورة بعشرات السنوات، تحت ظل الحكم المطلق لمركّب الاستبداد/الفساد. هذا التسلط الابتدائي للشر المطلق الذي اقتلع كل نبتة خضراء للسياسة، حاولت الاعتلاء قليلاً ما فوق حقوله من الأشواك والعناكب والأعشاب الضارة. فقد منعها الاستبداد عن دولته لصالح الطغيان فحسب، كما حرمها على شعبه لصالح الطاعة والانصياع الأعمى لإرادته.
ليست هذه العودة الدولية والإقليمية إلى أسطورة الاختيار ما بين حلين سياسي أو عسكري، وتفضيل الأول على الثاني، بل التأكيد الجازم على ضرورته. ليست سوى همروجة دعاوية جديدة موظفة سلفاً في خدمة النوايا الأمريكية المبيّتة ، والتي يكشفها أقطاب جمهورية أوباما الأولى السابقة بعد أن تركوا مناصبهم الرسمية، هؤلاء يصرحون بكل وضوح أنهم كانوا مع الحل العسكري، وأنهم اقترحوا على أوباما، بل طالبوه بإجازة تسليح المعارضة السورية، لكن البيت الأبيض كان يرد الطلب في كل مرة. ماذا يعني هذا سوى أن الرئيس الأسمر الأول الذي سُمح له أن ينام في البيت الأبيض هو وعائلته، وأن يحكم نصف العالم من المكتب البيضاوي للرئاسة الأمريكية، هذا الرجل المتهم بانتمائه الديني إلى الإسلام، وانحداره من الأرومة العالمثالثية، هو الذي أخذ على عاتقه حماية أعنف ديكتاتورية عرفها تاريخ السياسة الكونية، وليس العربية وحدها. لقد أعطى أوباما إلى جلادي دمشق حرية الإبادة الجماعية للشعب السوري، مصحوبة بإرادة التدمير المنهجي لتاريخ حضاراته المتتابعة منذ آلاف السنين. فمن هو المسؤول حقاً عن هزيمة كل حل لمعضلة الديكتاتورية المطلقة، سواء كان اسمه سلمياً أو حربياً. أليست هي سلطة الدولة العظمى التي حكمت على شعب كامل أن يُلقى هو مع أطفاله ونسائه وشيوخه إلى أنياب الذئاب الشرهة، أن يظل أعزل عارياً من كل وسيلة دفاع مشروعة عن مجرد وجوده. ما أضافه أوباما إلى موسوعة القمع الاستعماري، ليس الترخيص لسلالة الجلادين بمنع شعوبهم من ممارسة حقهم في اكتساب حقوق إنسانيتهم، ليس في منعهم من أن يوجدوا كبشر أحرار فحسب، بل كبشر أحياء.
لقد أوكل أوباما لطغمة القتلة الفاسدين في الشام، أن ينوبوا عن جيوشه بارتكاب كل الفظائع المحرمة في القانون الدولي. لم يكرر أخطاء سلفه بوش الصغير، لم يُدَنِّس أيدي عسكره بدماء الأطفال والنساء، لم تدمر قنابله آلاف البيوت على رؤوس سكانها، لم تمْحِ عشراتٍ، بل مئات من القرى والبلدات والأحياء من خارطة الوطن السوري، ترك هذه المهمات القذرة لوكلائه المحليين. وتلك هي وظيفة أقدم استعمار غربي، يجددها أول رئيس أسمر لحاكمة الملكوت الأبيض على الأرض، أمريكا. لكن لهذه الوظيفة قصة معقدة، قد لا تكرر وقائعها كقواعد عمل راسخة، بقدر ما تنوع أساليبها. ولعل أصعب ما يميز استخدامها الحالي أن السادة الاستعماريين الكبار أصبحوا مضطرين إلى استخدام أعدائهم المفترضين كأفضل شركاء موضوعيين، قد يحققون لهم، أخطر النتائج الاستراتيجية التي عجزوا، هم ـ الأسياد المباشرون ـ، عن تنفيذها. فمن كان يتصور في سياق الصراع مع إسرائيل، أن يأتي يوم يغدو فيه الجيش السوري، صاحب الدور المركزي في هذا الصراع، هو الجيش العربي الأول الذي يعلن حرباً إبادية شاملة على شعبه. أي كابوس همجي جنوني يمكنه أن يسوغ المذابح اليومية للأطفال وأمهاتهم، أن يفرغ الجيش ذخائره بآلاف الأطنان من القنابل على كل ما هو عامر وقائم في جغرافية هذا البلد، أن يصبح الحاكم هو العامل الحاسم في تمزيق النسيج المجتمعي، وإشعال حروب الانتماءات الفرعية والثانوية للقضاء على الهوية التاريخية الواحدة والجامعة لمعظم مكونات الوطن الشامي. هنالك مراهنة دولية خبيثة على اجتثاث وإجهاض كل دور سياسي لشعوب هذا الوطن، فإن إلغاء الديمقراطية من الديار العربية طيلة عقود، لم يكن هدفه فقط استمرار (الوضع تحت السيطرة) حسب المصطلح الجيوفلسفي، بل كان لا بد للقمع المتمادي أن يولّد الانفجارات الشعبوية من كل نوع، لتكون هي الأثمان المنتظرة، بحيث تأكل الشعوب من لحمها وعظمها بدلاً من أن تتصدى لأعدائها الحقيقيين.
لقد انتظر الدوليون عشرين شهراً أو أكثر كيما ينادي أسيادهم بالحل السياسي، بعد أن هجر هذا الهدفُ كلَّ حوامله الموضوعية. فالنظام الحاكم في دمشق، الفاقد والمدمر لكل اعتبار ثقافي أو عملي لمفاهيم التضامن المجتمعي، لا يمكنه أن يتحول بين عشية وضحاها من الذئبية الشرسة إطلاقاً إلى أدوار الحَمَل المسالم. أما الثوار الفعليون، فلن يروا لذواتهم أية أمكنة طبيعية في الهمروشة الجديدة حول التكالب على المناصب والألقاب السلطوية التي تنتظر قياداتهم.
في حقيقة الأمر، ومن خلاصة الأحداث السورية طيلة هذا الزمن الدموي الرديء، لا يمكن للمراقب أن يجزم أن ثمة بحثاً جدياً حول أي حل، قد أمسى قيد التداول. فالمبادرة المنتجة الوحيدة لا تزال حكراً على إرادة الدولتين الأمريكية والروسية. وهما معاً لا يعنيهما من (الأزمة) سوى استمرارها. وبالتالي فالعقدة لا تزال رهن النوايا ولن تخرج قريباً إلى حيز المخططات القابلة للمعقولية، ومن ثم للتطبيق العملي. وقائع المعركة على الأرض قد لا تكون هي الفاصلة في أفق منظور إلا إذا نجحت الثورة أخيراً في تجاوز ألعاب التبعيات والانتماء كلياً لذاتها بدلاً عن المراوحة في هوامش الخارج، ذلك أن مكتسبات الثورة هي حتى اليوم من ثمرات الاعتماد على الذات، وأما كل العثرات الأخرى، فلم تصبها إلا من نوافذ مفتوحة على الرياح الخارجية. فحين انطلقت شرارتها الأولى، لم تنتظر توجهاتُها أيةَ إشاراتٍ من أحد. وهي إن توقفت يوماً فلن يكون ذلك إلا من أمرها وحدها…
‘ مفكر عربي مقيم في باريس
القدس العربي