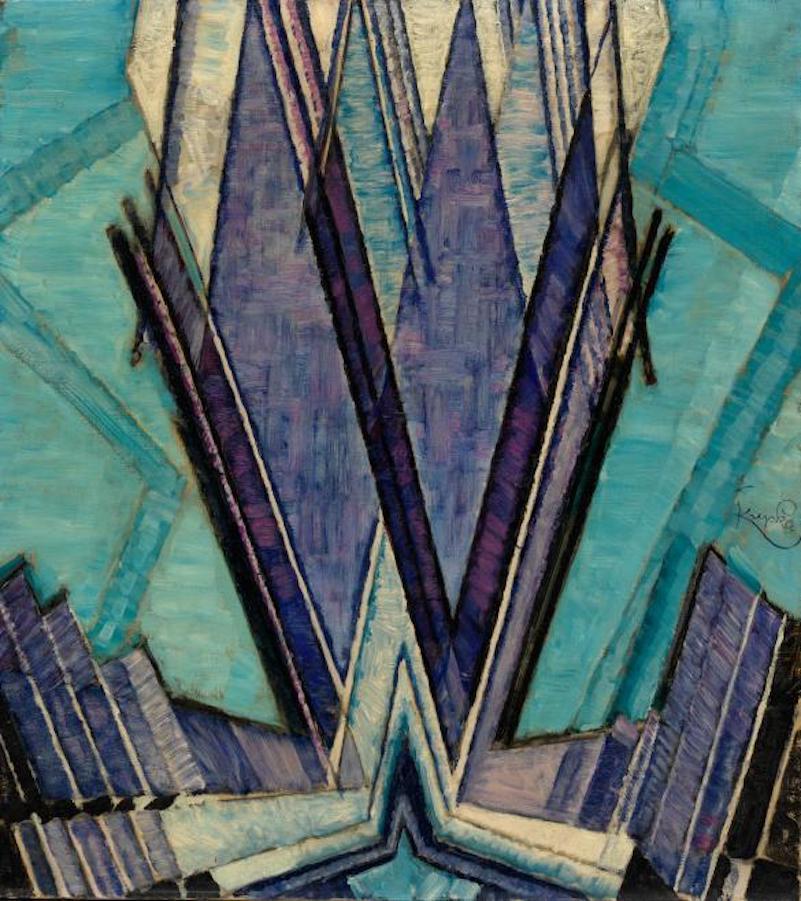التجربة الليبيّة وسؤال الثورات
حازم صاغية
انقضى أكثر من عام على ضربات حلف الناتو الجوّيّة التي بدأت في 14 آذار (مارس) 2011 ودكّت نظام معمّر القذّافي. وكما نذكر جيّداً، انتهى الأخير نهاية بشعة فيما كان يحاول الهروب يوم 20 تشرين الأوّل (أكتوبر) 2011.
لكنّ ليبيا لم تدخل حتّى اليوم مرحلة ما بعد القذافيّة بأيّ معنى إيجابيّ للكلمة، وإن حدث انتقال من السلطة الاعتباطيّة للشخص الواحد إلى السلطة المفتّتة بما يوازي التفتّت الاجتماعيّ البعيد للبلد نفسه.
ذاك أنّ الميليشيات، على رغم انفتاح الجيش والمؤسّسات الرسميّة أمام أبنائها، لا تزال تنازع الدولة على سلطتها، ولا يزال بعض مسلّحيها يتحكّمون بمناطق في طرابلس العاصمة نفسها. ولم يعد سرّاً أنّ الحكومة المؤقّتة برئاسة علي زيدان تجد نفسها عاجزة عن منع المجموعات المسلّحة من اقتحام وزاراتها والمطار وباقي المؤسّسات والمرافق العامّة. وهذا ما يكاد يصبح رياضة وطنيّة في ليبيا الثورة.
وكمثل غير حصريّ على قوّة القبائل والعشائر ذات الحول والطول الميليشياويّين، كنّا قرأنا في أواسط نيسان أنّ “قبيلتي أولاد سليمان والتبو وقّعتا على ميثاق للصلح بين القبيلتين في اختتام مؤتمر “الصلح خير” الذي عُقد في طرابلس برعاية رئاسة الأركان العامّة”. ويجدر الذكر أنّ القبيلتين المذكورتين كانتا، في نيسان (أبريل) الماضي، قد خاضتا حرباً ضروساً في ما بينهما أدّت إلى مقتل ما يزيد عن سبعين شخصاً في منطقة سبها الجنوبيّة.
أخطر من ذلك أنّ النوازع الانفصاليّة غدت أشدّ تعبيراً عن نفسها، ليس فقط في بنغازي الحريصة على تمايزها عن طرابلس، أو فزّان في الجنوب، أو مع “سادة الصحراء” الذين يمثّلون عصبيّة الطوارق، بل أيضاً في مدينة مصراتة شرق طرابلس، وفي تاجوراء وسوق الجمعة في ضواحي العاصمة. ويبدو أنّ التعبير الملتوي عن الرغبة في إضعاف السلطة المركزيّة يتّخذ شكل التشدّد مع رجالات الحكم السابق وأولئك الذين يُحسبون هكذا. فمثلما ارتبطت الحساسيّة الشيعيّة في العراق بالتطرّف في مطلب “اجتثاث البعث”، تعبّر النزعة البنغازيّة عن طرّف مماثل في ضرورة إقرار قانون “العزل السياسيّ” الذي قد يشمل وزراء ورسميّين حاليّين في عدادهم رئيس المؤتمر الوطنيّ محمّد المقريف نفسه.
لكنّ ما يفوق سواه خطورة ذاك الالتحام بين تفكّك الدولة الليبيّة وبين حركات العنف الأصوليّ في البلدان المجاورة لليبيا. وقد دلّت تجربة جماعة “أنصار الدين” في مالي على الطابع الانفجاريّ للقاء الفقر وضعف بنى الدول في تلك المنطقة وانتشار السلاح الآتي من ليبيا.
والحال أنّ الانتشار هذا، والذي ظهرت آثاره الفتّاكة في الجزائر، وربّما في سيناء عبر حركتها السلفيّة المسلّحة، قادر، في زمن القاعدة وأخواتها، على منع السلطة المركزيّة الليبيّة من صيانة حدودها والسيطرة على أمنها. وهذا ما نمّ عنه، بين أحداث أخرى، اغتيال السفير الأميركيّ في بنغازي على يد “أنصار الشريعة”، ثمّ تفجير السفارة الفرنسيّة، علماً بأنّه لولا الولايات المتّحدة وفرنسا لكان القذّافي لا يزال يحكم اليوم سعيداً في جماهيريّته.
وما من شكّ في أنّ تلك الأوضاع والتطوّرات تترك أعمق انعكاساتها على الاقتصاد وتوافر الموارد التي يُشترط بوجودها بناء دولة ومجتمع مستقرّين. ففي 10 نيسان الماضي، مثلاً، أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانيّة أنّ الميليشيات المسلّحة في ليبيا لم تعد مجرّد تحدٍ كبير لحكومة طرابلس أو مجرد تهديد للأمن، بل غدت، فوق هذا، “تستنزف خزائن الدولة من عوائد الصادرات النفطيّة”.
وذكرت الصحيفة أنّ “الرواتب التي يحصل عليها عشرات الآلاف من الثوّار المسلّحين، بعد دمجهم في القوّات المسلّحة والشرطة الليبيّة، ساهمت في تضخم فاتورة رواتب القطاع العامّ لهذه السنة، وصولاً إلى 16 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من ضعف الميزانيّة المخصّصة لموظّفي القطاع، خلال حكم نظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذّافي، والبالغة 6.6 مليار دولار”.
وهي لوحة بالغة الكآبة تشير إلى النتائج الكارثيّة التي تترتّب على نظام استبداديّ حافظ على الولاءات القديمة وحال دون وجود طبقة وسطى وتقاليد سياسيّة. وفي المعنى هذا تحوّل وجود الثراء النفطيّ من نعمة إلى نقمة، لأنّه بات واحداً من أهمّ الأسباب المؤجّجة لتنافس الجماعات ونزاعها.
طبعاً سيجد المناهضون للثورات العربيّة ضالتهم في كلام كهذا. لكنّ تلك الثورات لم تفعل سوى إزاحة الغطاء السلطويّ الكابح عن المجتمعات بما يضع تلك المجتمعات أمام مسؤوليّاتها أو يُظهرها على حقيقتها. وربّما كنّا، في ليبيا وفي سواها، أمام انسداد تاريخيّ لا سبيل إلى التستّر عليه، إلاّ أنّ المؤكّد أنّ نظام القذّافي وما يشابهه من أنظمة كان يجب أن يسقط، وكان سقوطه أشبه بالحتم الذي لا رادّ له، إن لم يكن اليوم ففي غد قري
موقع 24