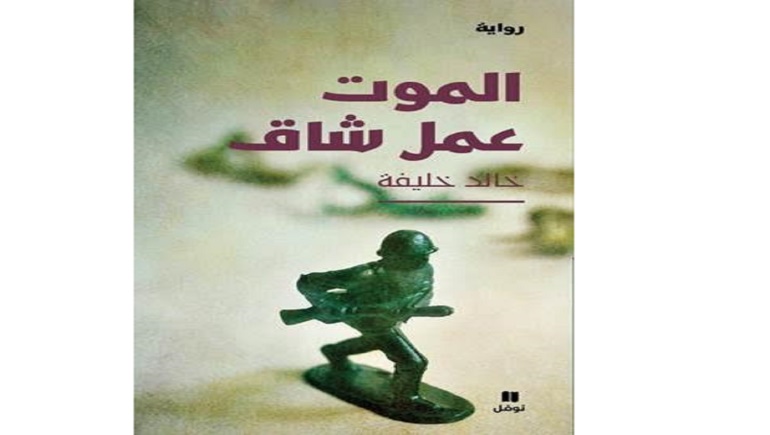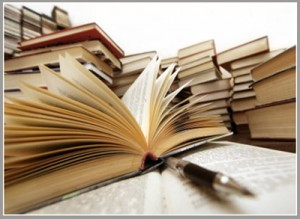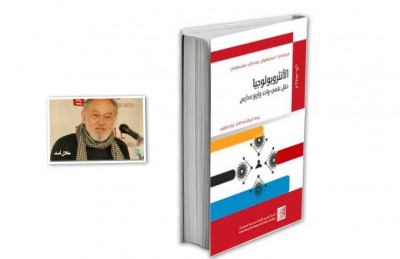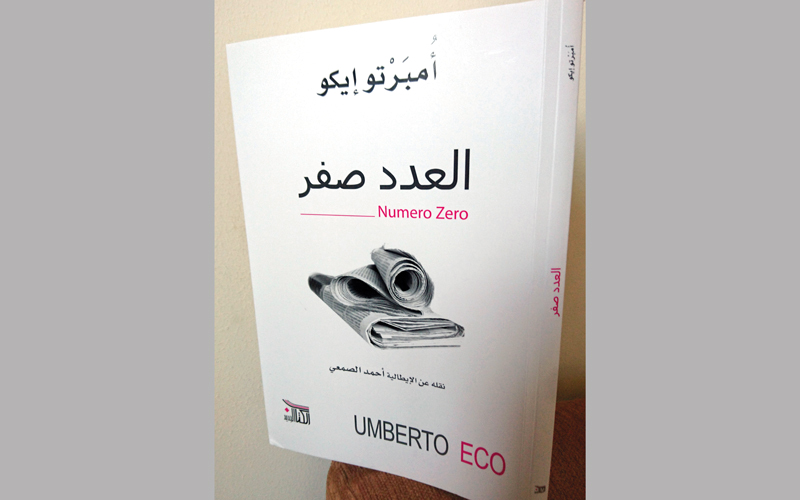لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة” لخالد خليفة
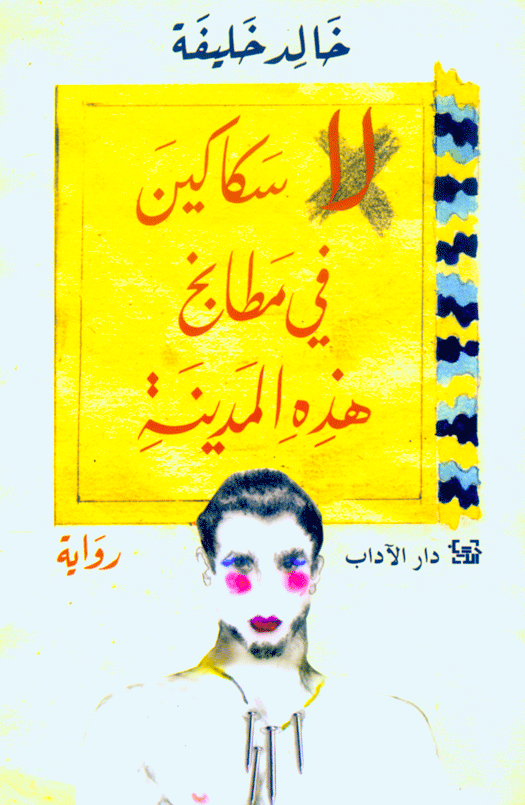
عار البعث الذي تقاسمه السوريون
معلّمة حلبية، أُغرمت بشاب ريفي، تزوجته، وانتقلت للعيش معه بجوار أهله في القرية، هجرها إلى أميركا مع امرأة أجنبية تكبره بثلاثة عقود، وهي لا تزال في الثلاثين، عادت بقلب محطّم إلى مسقط رأسها مع أولادها الأربعة، وعاشت “حياة موازية مع الحزب الذي صادر ما تبقى من حريات، أوقف تراخيص الصحف ومنع صدورها، عطّل البرلمان، وفرض دستورا جديدا، يمنح الرئيس المفدّى صلاحيات مطلقة، الرئيس الذي لم تصدّق موته في حزيران 2000″، على الرغم من حالة الحداد التي فُرضت على البلاد لأربعين يوما، ظلت تعتقد أنه لا يزال حيا، يقرأ تقارير المخّبرين عنها وعن أمثالها من ضحاياه، إلى أن تعفّن جسدها من الخوف، وقضت نحّبها من نقص الأوكسجين، قبل أن تبلغ الخامسة والستين.
والسيرة المرّعبة للمرأة المهجورة، التي تتماهى مع سيرة الوطن المُروّع بالقمع، هي إحداثيات البدء التي يضعها خالد خليفة في الصفحات الأولى من روايته الجديدة “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة”، إحداثيات تنمو وتتفرع في خمسة فصول، تصف مرايا الذّل الذي تقاسمه السوريون على كافة المستويات، طوال أربعة عقود من حكم البعثيين: “يُخّرجون الطلاب من قاعات الدروس، ويقودهم في مناسبات الحزب بمسيرات تأييد، تنتهي بكتابة رسالة بالدم، وإرسالها إلى القائد المسترخي في قصره، بعد إسكات أي صوت معارض، وتدمير مدينة حماه، واعتقال عشرات الآلاف من الطلبة اليساريين والمتدينين” (ص71)، و”في استفتاء الرئاسة الجديد عام 2000…خرج الحزبيون مستعيدين سيرة عمرها أكثر من ثلاثين عاما، نشروا الذل نفسه في كل مكان من البلاد، أطباء ومحاميون وصحافيون وتجار ونواب وطلاب جامعات ومدارس، يجري إجبارهم جميعا على الرقص في دبكات وسط زعيق مكبّرات صوت رديئة، تصنع صورة جديدة للديكتاتور” (232)، “تسعون بالمئة من السوريين عاشوا حياة موازية مع الحزب والنظام الذي حكم بكل هذا البطش، ولم يلتقوا، انقسمت البلد إلى ضفتين، على الضفة الأولى مرتزقة لا يعرفون الضفة الأخرى، التي تتناسل فيها الحياة، تجري بهدوء وبطء، وتعرف كل شيء عن ضفة أهل النظام” (ص116).
هي سيرة العار بكل معانيه العامة والخاصة، التي بدأت بعسّكرة المجتمع واغتصاب الحريات السياسية، وانتهت بخوف المواطنين وصمتهم المطبق، مرورا بتسييد المخابرات على أجهزة الدولة، نهب الثروات، إفساد الإدارة والاقتصاد، ترييف المدن، تراجع الأخلاق وتفشي الجريمة، انحدار الثقافة والفن، وظهور الأصوليات… عار بكل وجوهه المعّلنة والخفية، التي بدأت تجتاح البلاد والعباد بالتدريج، منذ انقلاب الثامن من آذار 1963، الموافق ليوم ميلاد سارد السيرة، والإبن الأصغر في عائلة الأم المهجورة، شاهد عيان يعيش في قلب المعركة من أجل البقاء، لم تتلوث يداه، ولا يتذمر من فقره وهشاشته، يسرد قصص من عرفهم والتقاهم، كمن يحدّث صديقا له، ويأتمنه على أسراره.
يسرد بنبرة حميمة، ولغة تلقائية متدفقة، تحاول جذب القارئ بكل الأساليب، من شعرية التعبير إلى ضراوة اللفظ عند اللزوم. تقوده تداعيات الذاكرة، ولا يكترث لترتيب الأحداث أو تسلسلها، يقطع السيرة حيث يشاء، يبدأ أخرى، يعاود إلى الأولى، لكنه لا يتدخل أبدا في سياق الحدث، ولا يعلي صوته على صوت الشخصيات، جلُ غايته أن يروي بأمانة ما كان شاهدا عليه وما سمعه، أن يجمع أخباره في صورة حقيقية لمدينته حلب، بطبيعتها وناسها، تاريخها وتراثها، طقوس عيشها ومطبخها، مثقفيها وحثالتها، حلتها العثمانية، ثم الفرنسية، وصولا إلى زيّها العسكري، الذي قضم حقول الخس من حولها، وأتى بعشوائيات البؤس والموالاة.
يبدأ بسيرة أمه، ينتقل إلى أجداده وأقاربه وأخوته وجيرانه، أصدقاؤه وأصدقاء أهله، قائمة مطوّلة من الأسماء، لا تظهر بوصفها شخصيات متكاملة، بقدر ما هي مفاتيح وحلقات للعبور، تتحرك في مدى قرن ونصف من الزمان، وتقف قبيل اندلاع الثورة السورية، تبني شبكة واسعة من العلاقات الاجتماعية، تنكشف من خلالها آفات الحزب القائد على كلا الضفتين المتوازيتين: زبانيته من المخبرين والضباط والتجار ورجال الدين، ومعارضيه من الفارين أو الغارقين بيأسهم المطلق، وسوف تكون أخت السارد سوسن حلقة الوصل بين الضفتين، شخصية متحوّلة باستمرار، صدامية، منفتحة على الحياة، تحمل في سيرتها كل التقلبات النفسية الحادة والمتطرفة، التي يمكن أن يحدثها الكبت بمعناه السياسي والاجتماعي.
كرهت الفتاة الجميلة الرومانسية ضعفها، واستضعاف جارها الضابط فواز لها ولأهلها، فانتسبت إلى صفوف البعث ودورة المظّليات، تهادت ببنطالها المبّرقع، حملت المسدس، كتبت التقارير بزميلاتها في المدرسة ثم الجامعة، أغوت قائدها منذر، ويوم تخرجها من الدورة، انتشرت مع زميلاتها في الطرقات “يوقفن السيارات، ينزعن الأغطية عن رؤوس النساء، ويتحرشّن بالرجال، يبصقّن على أي أحد يعترضهن، دب الذعر في المدينة، وفي الأيام التالية أصبحت العاصمة مكانا شبه مهجور” (ص78). سوسن التي سوف تتوب إلى الله، بعد ان هجرها منذر، تنسحب من الحزب، ترتدي الحجاب، وترّقع بكارتها، ثم تعود ثانية إلى سفورها وشبقها في الأربعين، تحبل من حبها العذري القديم جان عبد المسيح، تتزوج ميشيل المثلي، وتغادر معه إلى باريس.
سيرة مثلى للتحدي الماجن، وعدم الرغبة في الرضوخ، يقابلها نقيضها على الضفة الأخرى، أخاها رشيد، عازف الكمان الموهوب، الذي تعلّم العزف على يد خاله المثلي نزار، ورافق جوقته في ملاهي الليل، خوفا أن يبصر خراب النهار، ثار على جبنه، والتحق بالأصوليين من جماعة أبي قتادة، غادر معهم إلى العراق أثناء غزوه، نجا من الموت، ولم ينجُ من سجن الأميركيين، أدعى أنه عازف موسيقي مسيحي، وشى برفاقه، خرج من السجن، وانتهى بالانتحار. أما شخصية الخال نزار، فهي مفتاح الدخول إلى عالم الأغنياء والفنانين، في طفولته، يرتدي ملابس أخته الداخلية، يضع زينتها، ويبكي أنوثته المكبوتة. دخل السجن بتهمة اللواط، اغتُصب، ولم يعرف الفرح الحقيقي ونشوة الحب، إلا في السنة التي قضاها ببيروت.
و”مثل ألف ليلة وليلة” تلد السيرة بنتها، قبل أن تكتمل، وتتناسل الشخصيات الواحدة بعد الأخرى، تارة تسكن الماضي، وأخرى تعيش في الحاضر، تنتمي إلى كل الشرائح والمشارب، كل الأديان والطوائف، السكان والوافدون والمهاجرون، الأقليات من الأرمن والكرد والمستشرقون، مؤيدون وناقمون ويائسون، أنقياء وعملاء، مجرمون وأفاقون وعاهرات، مثّليون ومثّليات، يفتحون كل أقفال حلب، يدخلون القصور وبيوت الطين، القلاع والسجون، المقاهي والملاهي، يكشفون أستارها وأسرارها، مدينة شبقة، جعلها القمع والكبت تحجب وجهها الجميل في وضح النهار، وتمارس فجورها في الخفاء، شأنها في ذلك شأن كل المدن السورية.
وبطبيعة الحال فإن مقترح الرواية، بأبعاده الذهنية والنفسية، يجعل الجنس حاضرا على صفحات الكتاب، بإيروتيكية من كل الأصناف والأنواع، تصف بلا أدنى مواربة هياج السكان، الذي يفرغونه في أجسادهم، حمّى اغتصابهم لبعضهم البعض: “تنصب له شراك الرغبة، وعلى مدرج مسرح النبي هوري الروماني المدمر، تركع على قدميها، بجرأة تفك أزرار بنطاله الجينز، وتداعب عضوه بشفتيها، تتركه هائجا، ولا تمنحه شفتيها أبدا” (36)، وفي السجن يدهن الشيخ جمعة جسد نزار بعطور المشايخ “ويقوده إلى زاوية قريبة من المرحاض، يعري مؤخرته، ويضاجعه ككلب أجرب، لا يجرؤ على رفع صوت بكائه” (ص97).
على لسان الراوي يتخطى الجسد حدود حياته الطبيعية، يصبح سجنا، مرتعا لأشباح الخوف وكوابيس الليل، يصير حاملا لأزمة الوجود وهدف القمع، وتجربته في الزود عن كينونته، تكتب تاريخا آخر من العنف، ماثلا في شهوة الاغتصاب، والشبق الذي لا ينضب، أو في الاستسلام الكامل للزهد، وهاجس الموت الذي يتراءى للكثير من اليائسين، خلاصا يحمله الانتحار أو العمليات الانتحارية.
خالد خليفة
[ مواليد حلب 1964، حاصل على إجازة الحقوق عام 1988، واحد من مؤسسي مجلة “ألف” الأدبية عام 1990، كتب العديد من سيناريوات المسلسلات والأفلام التليفزيونية والروائية، قدّم وأنتج بعض البرامج الوثائقية حول كتّاب عرب. له أربع روايات: “حارس الخديعة 1993″، “دفاتر القرباط 2000″، “مديح الكراهية 2006″، التي تُرجمت إلى الإنكليزية والإسبانية والفرنسية والهولندية والإيطالية والنرويجية والدنماركية، ودخلت قائمة “ميوز ليست” لأفضل 100 رواية في العالم ذاك العام، وروايته الرابعة “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة” صدرت في القاهرة عن دار العين عام 2013، وعن دار الآداب في بيروت، كما نالت ميدالية نجيب محفوظ للأدب.
جائزة نجيب محفوظ
[ منذ عام 1996، تمنح الجامعة الأميركية لأفضل رواية عربية، جائزة سنوية باسم الراحل نجيب محفوظ، في ذكرى مولده المصادف للحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر، ويحصل الفائز على ميدالية فضية ومبلغ مالي رمزي، كما يُترجم العمل الفائز إلى اللغة الإنكليزية، من خلال وتنشره الجامعة الأميركية للنشر في القاهرة ونيويورك ولندن.
[الكتاب: “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة”، رواية في 255 ص، قطع متوسط.
[المؤلف: خالد خليفة.
[ الناشر: دار الآداب/ بيروت 2013.
تهامة الجندي
المستقبل