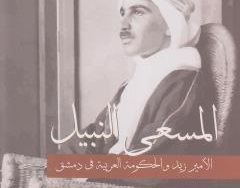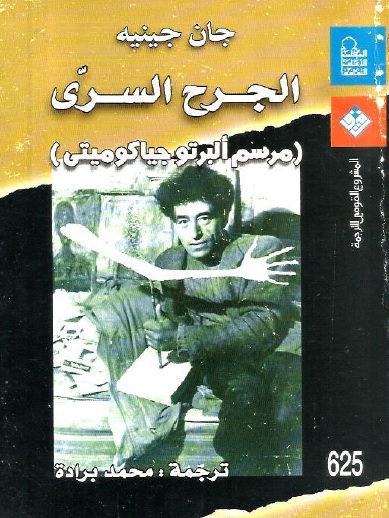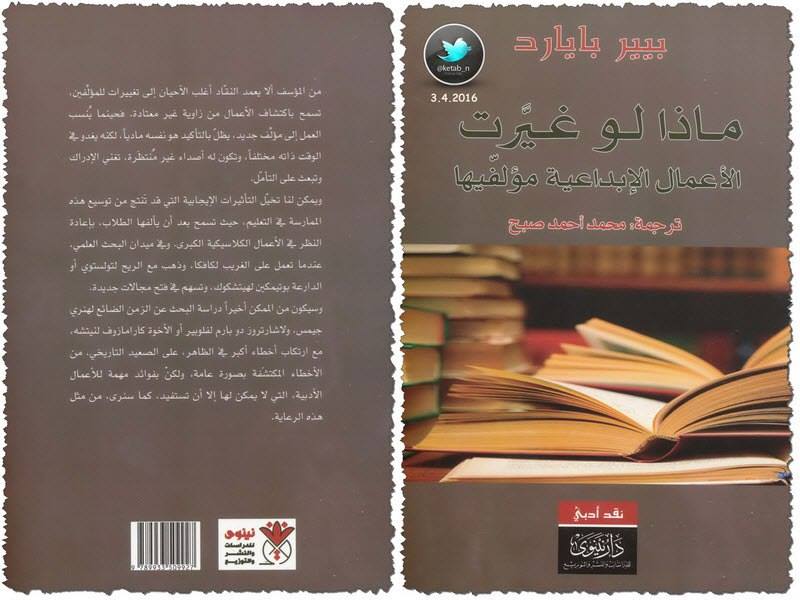كتاب – “تصديق الهذيان” لـنزيه أبو عفش: حين تكون الهلوسة من أرقى حالات العقل/ ناهدة عقل

قبل أن نقرأ العنوان، يصدمنا الشاعر نزيه أبو عفش بعبارة “عكس الشعر” التي يُصنِّف بها نوع كتابه “تصديق الهذيان” الصادر حديثاً عن “دار التكوين” بدمشق 2015. فكيف يمكن والحال هذه تناوله وفق مذهبٍ ما، نقديّ للشعر؟!
ربما الأجدر بنا أن نناقش أبعاد هذا التصنيف الجديد والغريب بالتحديد، ولا سيما أنَّ أحداً من شعراء اليوم والأمس، شرقاً وغرباً، لم يُقدِم على مثل هذه الخطوة من قبل. أعني: قلب منظومة فهمنا لما يُسمّى الشعر. فعلى أقلّ تقدير علينا ألاّ نتوقّع من النصّ الشعري أن يسمو على الواقع ويجمّله بل أن ينافسه واقعيةً ويتكلّم بلغته ذاتها.
تقول إحدى القطع المكتوبة على الغلاف الخلفي للكتاب: “إذْ كانوا يدقّون المساميرَ في راحتيه، كانوا يواسونه: “لا تحزنْ! نحن معك”. وتأكيداً للحبّ: جعلوا على رأسه إكليلاً. ولكي يسهلَ نسيانه: رفعوه إلى مرتبة شهيد”.
فضلاً عمّا تعرضه علينا هذه المقطوعة (من عكس القراءة المألوفة) للحادثة الإنجيلية المتعلّقة بموت المسيح؛ نرى أمامنا نصّاً إبداعياً إشكالياً إلى أبعد حد، هارباً من أيِّ تصنيف مألوف لنوعٍ أدبيّ، ألصقَ بالحياة من الأدب، وأكثر فنيّةً وأسطرةً من الأدب، في آن واحد.
يقول أبو عفش ضمن نصٍّ يسمّيه “هرطقة”: “وحدهُ ما يُوْقِعكَ في الحيرة/ يوقعكَ في الحب”. ولكم تنطبق هذه المقولة على حال قارئ هذا الكتاب المُشاكس الذي لا يدّعي لنفسه حتّى تسمية العمل الإبداعي! ذاكَ أنّ أكثر ما يوقعنا في الحيرة هو الجمال الغامض الغريب الذي لا نعرف أداةً لوصفه أو تحليل أسباب قدرته على أسرنا بمحبتهِ وإعجابنا بجماله. هل يكمن السرّ مثلاً في “نوع” اللغة؟
كانت لغة نزيه أبو عفش في معظم كتبه السابقة أقرب إلى الرمزية، مع فارق أنّها تخطّت حدود قدرات الرمزية حين استطاعت أن تنقل عبرها معنىً محدّداً مركزياً للنصّ الذي تريد؛ وهذا ما يتناقض مع طبيعة الرمزية كأداة ومذهب، كما مع طبيعة اللغة الخلاّقة في ذاتها من حيث شدّة قابليتها للتأويل ونزوعها للتملّص من التحديد الدلالي.
أمّا في “تصديق الهذيان”، فنرى أنّ آثار الرمزية قد اختفت بالكامل تقريباً من نصّ الشاعر، وبدلاً من أن تكون جمل النصّ مفتوحةً على كمٍّ لا ينتهي من التأويلات، نطالع نصّاً بأكمله هو أشبه بمقولة واحدة محدّدة التأويل بالنسبة إلى المعنى.
إلى هذا، نلحظ اختفاءً شبه تام لشتى أنواع الأدوات والطرق الفنيّة للقول، لنكون إزاء نص مختلف بكل المقاييس عن مألوف لغة النصِّ الشعري والنثري، أقرب إلى الكلام العامي المكتوب باللغة الفصحى أو لنقل بمعنى أدق: أقرب إلى أسلوب عامة الناس وتعابيرهم: “لعلّهم على حقّْ./ هم أيضاً يريدون أن يكون لهم شأنٌ في مزادات الشرفْ:/ اللصوصُ، اللصوصُ المنَزَّهون،/ منشغلون بلا هوادة/ في السؤال عن مصدر لقمة حياتك، أو لقمة مسرّتكْ./ رجاءً، ساعِدْهمْ!” (ص27 من “لقمة ورد”).
أوّل ما يثير التساؤل في نص كهذا، هو كيف لتعبيرٍ شعبيّ عن الحنق، أن يكون مكثّفاً ومؤثّراً على هذا النحو؟
نقرأ أيضاً من نص “ما أكثركْ!” (ص20): “ما أكثَرَهم! ما أقَلَّكْ!/ كيفما هربتَ منهم، تجدهم أمامكْ:/ في الحقولْ، على رؤوسِ التلالْ، قُدّامَ اسطبلاتِ الدوابّ،/ على المعالفْ، تحت الأغطيةِ وفوقها، على منصّاتِ التتويج… وفي/ كواليسِ صغارِ الخدمْ/ حقاً، ما أكثرهم!/ لكنْ، مع ذلك، ثمة المزيدُ من الطاولات والكراسي/ بحيث، كيفما جلسوا، ومهما كثروا،/ يكون نصيبُ كلِّ واحدٍ منهم/ الجلوس على رأسِ طاولةْ./ ما أقلَّهمْ! ما أكثركْ!”.
ليست طريقة القول فحسب ما يقرب القول العادي المحكي بل الموضوع أيضاً حياتيٌّ بامتياز. ميزتهما الوحيدة نفحة أسطورية فائقة الحد تسم اللغة والموضوع معاً. وتالياً اعادتهما إلى نطاق السحرية.
ربما أراد أبو عفش خلق نصٍ ألصقَ بالحياة من تخيُّلِ أو حلمِ الحياة، لهذا أعفاه من كل زخرفةٍ وتخلّى عن كلِّ ما تمدّه به ذاكرته الجمالية من صيغ وأدوات فنّية، لكنه وقع في تهمة “الشعر” من جديد لمّا كانت حرارة العاطفة التي بثّها في هذهِ النصوص، وحدّة الذهن التي صاغها بها، كفيلتين وحدهما أسطرة هذا النصّ الواقعي بامتياز.
ربما أراد للسان الإنسان العادي، ومواضيع الحياة العاديّة أن ينتصرا على لسان الشاعر والأديب والفنان ومواضيعهم. أن يكسر “تابو” الفن والأدب، لتنتصر طريقة الحياة في عرض فنّيّتها المعتادة المكرورة. وهذا ما أراه دعوةً فكريةً وأخلاقية للانحياز إلى جمالية العادي والبسيط والمألوف، الانحياز إلى قيمة الأرض، بدلاً من التيه في عوالم غامضة.
من “هرطقة” (ص51) نقرأ أيضاً: “أحبُّ موسيقاتِ الغجر الهائمين/ في مواجهة هذيانات سترافنسكي،/ وباخ في مواجهة أفلاطون،/ ويهوذا الخَوَّان/ في مواجهة بطرس الصخريّ حامل وسام النصر”، وفي مقطعٍ آخر: “نكايةً بأباطرةِ رأسِ المال “العصاميّين”/ أحبُّ اللصوصَ الظرفاء/ والشَحّادين ذوي الدموع الجاهزة”.
لعل أهم ما تدفعنا إليه هذه الأطروحة الصغيرة المسمّاة “تصديق الهذيان”، هو التفكير في أنّ الوقت قد حان ليخرج النص الحديث من تابو اللغة التخييلية غير الواقعية فيتوافق مع عقل قارئ اليوم ووجدانه اللذين غدوَا أقرب إلى العلمي من الغيبي، وإلى الواقعي من المتخيَّل. فمن جملة ما يقوله الشاعر لحفيدته سلمى ضمن نص “في دمعة من الراتنج” ص137: “ليس لأنني أستحقّ/ بل، فقط، لأنني وقعتُ في هذه الحياة:/الأبديّةُ أصغرُ حقوقي”.
هذه هي العقيدة القديمة الجديدة للشاعر: الحياة أولاً. الحياة قبل كلِّ شيء. لهذا يصير لزوماً على الفن والأدب بما هما محض أدواتٍ من أدوات الحياة، أنْ ينصاعا لشروطها ويقدّرا قيمتها بدلاً من التعالي عليها بهدف تغييبها.
هو ليس “هذياناً” شعرياً، إذاً، بقدر ما هو رقيٌّ بالشعر ولغة الشعر. ولكم يستحقُّ من الحبِّ و”التصديق” ما دام يرتقي بالعقل والقلب الى الحد الذي بلغه “عكس الشعر”.