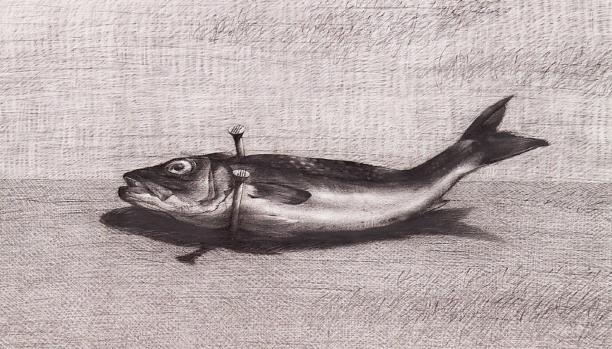“البعث السوري/ تاريخ موجز” لحازم صاغية
التاريخ العربي مشتبكاً مع ذاته ونائياً عن الفرد
يقدم حازم صاغية في مؤلفه الجديد “البعث السوري/ تاريخ موجز” (دار الساقي)، ما يشبه البانوراما البطيئة، المختصرة والوافية في الوقت نفسه، ليس عن سوريا وحسب، بل عن محيط عربي اهتز دوما بين معسكرين، واحد ليبيرالي وآخر اشتراكي.
البحث الذي قام به صاغية، يتناول في المقام الأول تطور حزب البعث السوري، واندماجه في باكورة أيامه مع الحزب العربي الإشتراكي ليتأسس ما سمّي “حزب البعث العربي الإشتراكي”، الذي تدرج إلى السلطة ثم قبض عليها مقصيا خصوما كثيرين. ما يمكن قراءته في كتاب صاغية، لا يقتصر على البيوغرافيا السياسية، ولا استعراض الظروف الخارجية والداخلية وتأرجح موازين القوى بين المعسكرين المتناحرين، الأميركي والسوفياتي في ذلك الوقت، ولا تأثير كل هذه العوامل على تسلم البعث دفة البلاد في سوريا، التي شهدت دوما انقلابات وارتدادات هزات سياسية إقليمية ومخاوف من أنظمة محيطة بها. فذلك الجانب من الشرق الأوسط المتضمن دولا محيطة بفلسطين، كان دوما سريرا لصراعات استخباراتية وسياسية وإيديولوجية لم ينج منها مفكرون، ولا صحافيون، ولا ذوو الصوت الحر، ولا منتقدو الأنظمة، كما لم يسلم منها، أولئك الذي اعتبروا أصدقاء لهذه الأنظمة تم التشكيك في ولائهم لاحقا.
المرحلة التي تمر بها البلاد العربية تفرض قراءة للتاريخ، وتحديدا، تلك الحقبة التي تزينت بمفاهيم كـ”الديموقراطية” و”الاشتراكية” و”القومية العربية” و”التحرر من الاستعمار” و”تحرير فلسطين” و”معاداة الامبريالية”. فالرقعة العربية التي خرجت من الإستعمار الغربي العلني، دخلت منذ أوائل الخمسينات تقريبا، في شكل آخر من الاستعمار، تحت مسمى العروبة والحفاظ على وحدة العرب وتمتين الآلة العسكرية والأمنية كأولوية في مواجهة إسرائيل، الذي سيبيِّن التاريخ لاحقا أنها العدو الأوضح والأكثر مباشرة. إلا أن هذه الأنظمة المنبثقة من تحت رماد آلة الحلفاء، ظلت تبحث عن سلطة لها على حساب شقيقاتها. فلا نعجب مثلا من الصراع الذي كان دائرا بين هاشميي الأردن والعراق من جهة، وناصريي مصر من جهة أخرى، وتذبذب سوريا بين هذين المعسكرين المرتبطين بالخارج. كان الهاجس الأمني “المستجد الثابت” على طاولة العسكريين إذا صح القول، وأبرز ضرورة شحن كل مواطن يُشَكُّ في أمره إلى السجون، بالقوة العسكرية والترهيب طبعا، فيما تمت مقارعة العدو الإسرائيلي بالخُطب والإيحاء بتوفر القوة متى استلزم الامر حربا إقليمية. ما تأسست عليه الأنظمة العربية تلك، ومنها النظام الناصري خصوصا، كان شكلا من أشكال الاستعمار أيضا، إلا انه كان استعمارا محليا، غير أجنبي، أمنيا، “ضروريا” ومبررا في أحيان كثيرة. إلا أن علامات هذا الاستعمار، كانت تتوارى خلف قماشة تربص العدو الإسرائيلي على الحدود، وتهيؤ فرنسا والولايات المتحدة لتفكيك هذا النظام أو ضربه بضراوة. في المقابل، فإن هذا الاستعمار لم يبلغ مستوى سياسيا منفرا محليا، ذلك أنه اوجد ماكينة لتدجين نمط محدد من الفكر، أو الفكرة الواحدة، وضرب في عمق الإنسان المصري خصوصا، فاصلا بينه وبين حقه في أن يكون حرا بدلا من توكيل شأن حريته إلى ضابط من بلده. وقد يكون عبد الناصر العسكري الوحيد، الذي فرض شروطه على العديد من الانظمة المحيطة به، مزينا بإطار القائد البطل، وساحبا في جنازته ملايين الناس في الشوارع. هذا المشهد تحديدا، إذا ما قورن بتاريخ كل الضباط الذين حكموا بيد من حديد خلال التاريخ، مفارقة تستحق البحث والقراءة.
لهذا، اوجد نظام عبد الناصر أحد أول المبررات للبعثيين السوريين لكي يتنبهوا، ويضطروا بعد فك التحالف معه إلى “تأمين” البلاد من الأذرع الخارجية المتسللة. في كل هذا، فإن المواطن العربي الذي أوهم تارة بـ”النظام الأمل” أو “النظام العروبي” أو “النظام المعادي للامبريالية” ومن ثم “النظام الممانع” في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تسميات أخرى ظرفية لم تعمر طويلا، ظل الضحية المنكفئة تحت “دفء” الخطاب الرسمي، وإن كان هذا الدفء في احيان كثيرة ثقيلا ومفتتا عظم الفرد. من هنا، فإن هذه الانظمة، التي تأسست وفق رؤى إيديولوجية (بعثي، ناصري، قومي، إشتراكي) سرعان ما اقتلعت عينها التي يمكن بها أن تلتفت إلى تاريخ المنطقة وخصوصية الفرد العربي، ووضعت هذه الرؤى مكان تلك العين المقتلعة. بذلك اصبحت أنظمة او اجهزة ذات وجهة واحدة، وأضحى العالم بأسره يتفلتر في تلك العين، فيما عميت تلك الأجهزة، وبكثير من التعالي، عن متطلبات الفرد على المستوى الاجتماعي والثقافي والإقتصادي والسياسي. وعليه، فإن تاريخ المنطقة العربية يبدو مشتبكا مع جغرافيتها، وكل محاولة للمرور إلى التاريخ الأشمل للمنطقة العربية يشبه رحلة في قطار لا مستقر لها، تفضي إلى صراعات وتجاذبات حزبية تغذت بأموال خارجية، وبدعم عسكري من دولة واحدة او اكثر في أي من المعسكرين التقليديين الاشتراكي – الليبيرالي.
هذا التهافت إلى بسط النفوذ وتعزيزه وإفراغ المكان من المنافسين، كان يبلغ مستوى سياسيا، من دون أن يلتفت إلى الشؤون الإجتماعية. حتى أن المشاريع الكبيرة والتقليدية لم تكن ليخطط لها وتنجز إلا كمؤونة اقتصادية للمحافظة على صحة النظام لا سلامة الفرد. وهو ما يفسر تعاطي الأنظمة العربية مع مفهوم الفرد المتظاهر ضدها، والثائر على جورها وظلمها له، وغير المكترث بالموت. فهي انظمة تفسر نفسها بنفسها، بلسانها الخاص، ولا تأبه لعجزها عن تفسير العنصر “الميكروسكوبي” في المجتمع، الذي اعتقد دوما أنه مُعطَّل. أما الأكثر مدعاة للاستغراب، فهو مدى بهتان الايديولوجيا التي قامت عليها تلك الاحزاب الحاكمة، والتي لم تبذل أدنى جهد في إذكاء نشاط فكري، ولو من باب خدمة النظام نفسه، الأمر الذي يضع مديري هذه الأنظمة التي تشهد ثورات، أمام إيديولوجيتهم مجددا، كمرجعية وحيدة، غير متنبهين أنها إيديولوجيات استهلكت اصلاًفي مناسبات متفرقة، ولم تعد تناسب تفسير العالم الجديد الذي اختاره الشعب العربي، منذ ان حرق عرّاب هذه الثورات، البوعزيزي، نفسه في إحدى بلدات تونس الفقيرة.
مازن م.
النهار