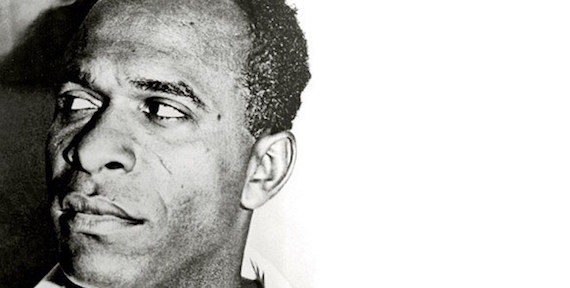الثورة الشعبية ومسألة العلاقة بين الأكثرية والأقلية
رداً على حمود حمود وعمار سليمان علي
عمار ديوب
أصل الحكاية:
ما يحدث في سورية منذ أشهر ستة هو انتفاضة شعبية ضدّ نظام استبداديّ كان غطاءً لمشروعٍ اقتصاديّ ناهب، أفقر الملايين ودمر الزراعة والصناعة وأَحكم قلةً احتكاريةً في سياسة التحرير الاقتصادي”الليبرالية”، وقاد البلاد إلى أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة تفجرت مؤخراً، كحال البلاد العربية الأخرى، انتفاضةً عارمةً امتدت في كل المدن والبلدات والقرى السورية إلا بعضها، ولولا العنف السلطوي، لانضمت الكتلة الصامتة إلى الانتفاضة.
ما منع الكثيرين من الوصول إلى حقائق الواقع كما هي : نقصٌ في المعرفة، ومنعٌ مطلقٌ لوسائل الإعلام عن تغطية الأحداث، وعنفٌ وحشيٌّ تتسلط به قوى الأمن والشبيحة والجيش على المنتفضين خاصةً، وعلى غير المنتفضين، وكمٌّ كبيرٌ من القصص والحكايا “البراباغندا” التي يتمّ تلفيقها بصورة مستمرة عن الاحتجاجات والثورة، ليظهر للعقل الخائف أنّها ثورة طائفية تستهدف الأقليات الدينية، وهي في الحقيقة ثورة شعبية ضد نظام استبدادي يشبه النظامين التونسي والمصري، قبل سقوطهما.
السياسات الليبرالية لتحرير السوق السورية، في السنوات العشر الأخيرة، هي التي لعبت الدور المركزي في تأجيج الغضب الشعبي والثورة لاحقاً، والرغبة في إنهاء عهود من التسلط والإفقار والإهانة والظلم، وصولاً إلى دولة مدنية حديثة، لكل أفرادها حقوقٌ متساويةٌ أمام القانون. هذا أصل ما يحدث في سورية، ولكن.
علاقة الأكثرية بالأقليّات:
في سورية هناك بالفعل مشكلة الأكثرية والأقليات الدينية- والقومية- ولكنها ليست مشكلة طائفية، أي أن المجتمع السوريّ ليس به تشكيلات سياسية طائفية، وليس مُقسّماً وفق هذه التشكيلات، ولا النظام السياسي مُشكّل وفقها، وهي مسألة متعلقة بالتأخر التاريخي للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي العام، وبالشروط الإمبريالية الضابطة والحاكمة لوحدة العالم ولسورية منذ بداية القرن العشرين على أقل تقدير. أي أن الوعي المجتمعي في جوانبه الأساسية وعيٌ دينيٌّ – بعد عهودٍ من التحكّم والضبط والقمع وغياب أيّة حياة سياسية- ويُمارسُ الأفراد كثيراً من العلاقات والطقوس الدينية وفق ذلك، وهم بذلك لا يقصدون الإساءة ولا القصاص من طوائفَ أخرى، بل هم يمارسون حياتهم الطبيعية، كأيّ مجتمعٍ بشريٍّ، ما دام الدين لا يزال غيرَ متجاوزٍ وله مريدوه. وبالتالي وفي هذا السياق، تشعر الأقليات بخوفٍ ما إزاء الأكثرية، ولكن هذا الموضوع لا يتجاوز خوفاً بسيطاً أوليّاً، يوجد بين عشائر كبيرة وصغيرة، أو بين عائلات كبيرة وصغيرة متجاورة في أحد الأحياء الدمشقية مثلاً، ولا تُبنى عليه أحكام وتحليلات وقضايا تصل إلى مستوى الخطر الوجودي. وهي تصل لهذا المستوى فقط، في المراحل الانتقالية، كما يحدث في سورية حالياً، وليس بسبب ممارسات الأكثرية، بل بشكل أساسيّ، بسبب التسلّط الأمني العنيف ومنع تغطية الأحداث، وتعمّد ذلك التسلط نشر أخبار ودعايات وفيديوهات، تَستثير الخوف الأقلّي. في قبالة أدوات السلطة هذه، هناك قوىً طائفيةٌ، وسياسيةٌ تُفعِّل الورقة الطائفية. كالقنوات الطائفية “الوصال، صفا وسواهما” وتنظيم الإخوان المسلمين، بعد حرب الثمانينات، والذين لم يُعلنوا بوضوحٍ شديدٍ عن دورهم الطائفي فيها، وكذلك خطاب جزء من المعارضة، التي تحدثت طويلاً عن المكونات الطائفيّة والأكثريّة والأقليّة الدينيتين في السنوات الست الأخيرة، ولا نعدم وجود أفكار طائفية لدى بعض المثقفين البائسين، وهي تلعب دوراً حقيقياً في تعميق ذلك الخوف. ولكن كل ذلك لا يتجاوز دوائر النخب، وبعض كتّاب ومعلّقي الفيسبوك الطائفيين، والتي هي فئات محدودة التأثير ولا تُمثل الواقع، ولا تُمثل الثورة ، ولا تخضع الثورة لها، وهي لم تطلقها من أصله، ولكنها كذلك تحاول السيطرة عليها! هذا ما يجب فهمه.
ومن ناحية أولى في الثورة: قد تجد بعض الأعمال الهامشية لممارسات طائفية من قبل أفراد يشاركون بالمظاهرات، ولكن أفعالهم تلك تعدّ أعمالاً معزولةً. ووجودها بسبب الضغط الأمني، الذي يتلازم في بعض الأماكن بسلوكيات طائفية، وهي ليست منهجاً ولا أمراً محبّذاً، وسريعاً ما يتم رفضها والتنكّر لها. المشكلة ليست هنا، بل هي في عدم وصول الثورة إلى مرحلة الحسم في أي مدينة في سورية، وإظهار برنامجها كثورة شعبية تستهدف بناء دولة مدنية حديثة، وهي تصارع نظاماً استبدادياً إفقاريّاً.
ولكن، ومن ناحية أخرى، يمكن لمن يتخذ وعياً طائفياً أقليّاً، أن يشارك في الثورة الجارية، فيقيم علاقات صحيحة مع الأكثرية التي يخاف منها. وكما تتخوف أبناء الأقليات من أبناء الأكثرية، فإنّ العكس صحيح كذلك، وبالتالي التخلّص من الاحتجاز ورفع الأسوار بين تلك الجماعات، لا يتم عبر التنديد بالثائرين وهم ليسوا أبناء الأكثرية قط، ويكون بالاندماج في الثورة ومنعها من الإنحرافات التي يتوهمون الجزء الأكبر منها، وبعض تخوفاتهم صحيحة، وهذا ما استدعى من كاتب سوري بحجم ميشيل كيلو، ليسأل الطائفة المسيحية، في مقالته “دعوة المسيحية إلى العقل” كيف ستتعايشون مع أبناء سورية، حالما تنجح الثورة؟ ألا يحق لنا هنا أن نسأل السؤال ذاته لكل أبناء سورية الصامتين؟! علماً أن مدناً كالسلمية والقامشلي والسويداء وحمص واللاذقية وطرطوس وكل المدن التي يحكى فيها عن الأكثرية والأقليات الدينية، قد شاركت بالثورة ومنذ البداية. نعم سورية تحتاج لمشاركة أوسع، كما هي تحتاج لمشاركة الكتلة الصامتة وهي أيضاً من كل الطوائف.
هناك قضية تاريخية، هي أن السلطة السورية، وعبر أربعة عقود، منذ بداية السبعينات، قدّمت نفسها كأنّها حامية حمى الأقليات الدينية، وأنّ أغلبية القيادات الأمنيّة والقيادة العسكرية الأساسية من طائفة محددة” العلوية” وأنّها كذلك لخوفها من الأكثرية “السنية” وهذا ما أجّج الوعي الديني، وأُعيد تشكيل المجتمع السوري دينياً، وليس طائفياً، ولكنه قابل للتحول نحو الطائفية، وهو ما يلاحظ حالياً وخاصة في مقالة الأستاذ عمار سليمان علي “حق الخوف في سوريّة” وكذلك في مقالة الأستاذ حمود حمود “في سورية: مثقف يخاف، مثقف ضد الخوف” حينما يبدأ مقاله بأنّ المشكلة الأساسية في سورية حالياً هي العلاقة بين الأكثريّة والأقليّات، ومسألة الخوف. بينما أحدّدها بأنّها ثورة الأكثرية الشعبية المفقرة. وبالتالي الثورة ثورة شعبية بامتياز، ويراد حرفها عن كونها صراعاً اجتماعيّاً، إلى أن تصبح صراعاً طائفياً. أمّا تشكيل تلك القيادات على هذا النحو فهو عمل سياسي محض، ولا يمت للطائفة “العلويّة” بصلة، ولكنه يفيد السلطة القمعية فهي لا تستطيع الحكم دون ذلك. ذلك التشكيل للسلطة أفاد فقط فئات قليلة من السكان وقد أثرت منها، وفئات برجوازية متحالفة معها، بينما أبناء الطائفة العلوية وبقية المجتمع السوري أُفقرت ونُهبت وأُذلّت وأُستبد بها، ولا يزال الأمر على حاله، في صيرورة الانتفاضة المستمرة.
الخوف الوجودي!
الكلام عن خوف الأقليات، وأنّه تعبير عن خطر وجودي كما يشير كل من عمار وحمود، قد يكون كذلك من تيار مجتمعي ينتمي إلى بعض الأقليات، وهو بسبب كثرة الأوهام الطائفية عن صراع طائفي قادم، بينما أغلب أبناء الأقليّات، تخاف من النظام ومما بعد النظام، وهذا ما يشلّ فاعليتها؛ أي أنّ الأغلبية المتضرّرة من النظام، والمعارضين للنظام والمتواجدين في مناطق الأقليّة يتعرضون لأسوأ أنواع التضييق والتشهيير، ويقوم بذلك حصراً أفراد مدفوع لهم، أو في غاية التعصب، وفي الحالتين مرتبطين بالسلطة، بينما القلق الراهن أو اتجاه المستقبل لأكثرية أبناء الأقليات، لا يرقى إلى مستوى قضيةٍ، وصراعِ وجود.
الطائفية الطارئة ووضعية المثقفين:
المثقفون الذين ينتقدهم الأستاذ حمود، ويرى بمقالتي استكمالاً لمنطقهم وتجاهلاً للمسألة الطائفية، أقول وأكرّر: بالفعل ليس في سورية طائفية أصيلة، وما يوجد هو نوع من الطائفية الطارئة، وتظهر بشكل فظ لدى بعض أبناء الأقليّات بسبب ذلك الخوف الموهوم، والذي لا أصادره عليهم- فلكل فرد الحق المطلق في الخوف- ولكنني كذلك لا أعمّمه على غيرهم، فهم خائفون مذعورون ليس بسبب الثورة الشعبية التي يتوهمونها طائفيةً، بل بسبب خطل أفكارهم عنها، وستزول تلك الحالة الرهابية، حينما تبدأ الثورة بالانتصار في أي مكان من سورية، أو حينما تتزعزع السيطرة الأمنية والعسكرية على المجتمع.
هناك ما يشبه هذه الحالة لدى الفئات المعارضة للسلطة، وهي أيضاً، تحاول الوصول بالانتفاضة إلى الانتصار، وهي خائفة من فشلها بالتأكيد، ولكنها الحالة الشاذة، والمرفوضة، وهي فئات هامشية، في نهر الانتفاضة الوطني الديمقراطي.
وبما يخص المثقفين، يبدو أن السيد حمود، لا يرى أن التيار الأكبر للمثقفين السوريين يقف إلى جانب الثورة، وهو في الحقيقة لم يقف يوماً إلى جانب النظام، هل أذكّره مثلاً بأسماء لامعة في الفكر وفي الصحافة؟ ثم، هل في سورية فرص أوليّة للمثقفين السوريين؟ هل فيها صحافة أو مراكز أبحاث، أو غيرها لعمل هؤلاء؟
طبعاً هناك جزء من المثقفين يقف إلى جانب النظام، لأسباب متعددة، وهناك من يعبر عن رؤية طائفية عنصرية إزاء الآخرين، ولكن الدعوات الطائفية في معظمها تصدرها نخب طائفية أو تتطيّف دون قصد منها! وربما تخاف تلك النخب من السقوط فتتذرع بالطائفية، فمن أين سيتعيّش هؤلاء الطائفيون؟ أمّا تلاقى المثقفين مع النظام في التنديد بالطائفية، فلا أعرف تياراً ثقافياً حقيقياً يمثل هذه الحالة، بل كان قبل فترة الاحتجاجات بعدّة سنوات تيارٌ ينتقد السلطة والدستور السوري وقوانين الأحوال الشخصية المزمع تغييرها حينها بسبب طائفية جزءٍ منها. وهناك من ناقش مفهوم الهويّة السورية الجامعة، ومكوّناتها الوطنية والقومية والأقلياتية القومية. وبما يخص موضوع نقد ورفض المثقفين للمسألة الطائفية، فهو بسبب أنّ الوعي القومي في سورية، يشكل الأرضية الأساسية لهم، وللسوريين عامة، ويجدون أن سورية، فيها وعيٌ قوميٌ جامعُ، كأساس للوعي العام، ولذلك يعدون المسألة الطائفية هامشية ومحدودة التأثير. رفضها إذن، يتم من هذه الزاوية تحديداً. أستطيع القول هنا: إنّ السوريين سيتجاوزن السؤال الطائفي عن الهويّة، حالما تحسم الثورة معركتها، لأنّه السؤال الطارئ، وسيبقى كذلك.
السؤال الطائفي، في لبنان أساسيّ لأنّ النظام السياسي مشكّل وفق الطائفيّة السياسية، وكذلك في عراق ما بعد صدام حسين، أمّا في سورية، فثورتها الحالية ليست ثورة طائفة ضد طائفة، بل هي كما عرّفتها سابقاً، ولهذا ستتجه ومهما حصل فيها من تطورات وردود أفعال… نحو الهدف المركزي: وهو بناء دولة مدنية ديموقراطية.
في تحديد الطائفية، ومشكلات سورية:
إذن، لا توجد مشكلة طائفية في سورية، وقد حدّدتها حصراً في أزمة الثمانينات، وما عدا ذلك، لا يخرج عن مشكلات وصراعات لا ترقى للكلام عن طائفية حقيقية، وأنا لم أدعم رأيي بأنّ الإخوان كانوا مقتنعين باللعبة الديموقراطية في الخمسينات فقط كما يشير حمود، بل في أنّ سورية، فيها قرنٌ كاملٌ من التطور القومي والتقدمي العام، وبهذا السياق تشكّل إخوان الخمسينيات، وبالتالي ليس هناك تخندق طائفي في سورية. وهذا لا يعني أن هناك وطنية جامعة، أو تركيبة مجتمعية منسجمة على الطراز الفرنسي مثلاً.
لا. ولكن ليس هناك انقسامات طائفية متحاربة كذلك. بما يخص الطائفية، أرى أنّها نظام سياسي- أو علاقة سياسية حينما تكون متعلّقة بطائفة ما- يرتبط بالسلطة الحاكمة وليس أمراً اجتماعياً؛ فاجتماعياً في سورية، هناك أديان ومذاهب، ولكن ليس هناك عداء دموي ولا صراعات طائفية، أي أن تطييف الدين هو أمر سياسي وليس موضوعاً دينياً وهي محاولة من السلطة لإخضاع المجتمع، وقد فشلت فيها تماماً، ولكن بقايا تلك السياسة لا تزال موجودةً ولم تتحول إلى صراعٍ سياسيٍّ مفتوح. ولذلك ما أجده الآن في سورية، وبما يخص الأقليات والأكثرية، ومن هذه الزاوية: إن الأكثرية تجد خلاصها في دولة مواطنين في المستقبل وتنفتح باتجاه الآخرين وتتقبلهم، بينما الأقليات ولا سيما الجزء البسيط الطائفي منها يجد خلاصه في الأمان والاستقرار المتأتي من تحكّم الأجهزة الأمنية بالدولة السورية وبالمجتمع؛ هذا الأمان الذي دام منذ الثمانينيات، هو ما يؤجج الانقسامات، ولكنها لا تصل إلى حدود الطائفية، لأن النظام ذاته ليس طائفياً والمشكلات التي خلقها للمجتمع، ليست مشكلات طائفية، بل هي مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية عامة، ولذلك تثور الأغلبية المفقرة ضده وتشاركهم طبقات أخرى، ويشتركون في الثورة من كل المدن والبلدات والقرى والطوائف؛ وما ترّكُزها وانبعاثها المتكرّر يومياً في مناطق الطائفة” السنية” بشكل أساسيّ، سوى تعبير عن التهميش المركّز عليهم، ولأنّهم الأكثر عدّداً في سورية بكل بساطة.
أيضاً، استفاد النظام من سقوط النظامين التونسي والمصري، وعَمِل سلفاً على آلياتٍ وخططٍ لتحييد مناطق الأقليات، وخاصة الطائفة العلوية، عن الاشتراك بفعل الثورة، وتابع ذلك منذ بداية الأحداث” قصص بندر، والعصابات، والعرب والأجانب المسلحين، والأطعمة والمياه الملوثة، وإطلاق الرصاص في الأزقة، والسيارات المحملة بالسلاح، ولاحقاً قصص الأجساد المقطعة وغير ذلك، وكل ذلك دون أي تحقيق قضائي، واللجان الشعبية، وغير ذلك كثير” وعَمِل كذلك على منع أي حراك سياسي أو مدني، لمحاصرة الثورة القادمة في سورية، عدا عن تسخير الإعلام الرسمي وخاصةً تلفزيون الدنيا وإذاعة شام إف إم في تأجيج تعصب الأقليّات والأكثرية، وقد نجح بذلك لدى جزء من أبناء الأقليات ولا سيما العلوية منها، وحيّد قسماً آخر، لم يقتنع بتلك القصص البائسة.
تنبت الطائفية في حقل السياسة وليس المجتمع أو الدين، وغياب أية حياة سياسية سورية، منع تشكّل أيّ قوىً سياسيةً فاعلةً، طائفية أم غير طائفية، وقد تطيّف المجتمع، بمعنى أنّه صار يميل نحو الدين كتعويض عن الفقدان، أي غياب حقوقهم الاقتصادية والسياسية، ولكن وبعكس تصور سابق لدى بعض المثقفين، من أن الدين يتفاعل طائفياً في المجتمع، وأن هناك مشكلة طائفية قوية في سورية، كما يشير كذلك الأستاذ حمود حمود، فإنّ المجتمع أظهر حراكاً سياسياً واقتصادياً ومطالبات بقضايا محدّدة ولم يقدم نفسه طائفياً أبداً، وبالتالي هناك فرق بين أن يحتمي الناس في العقدين السابقين بشكل خاص بالطائفة والعشيرة والمذهب والعائلة والجهوية، وبين أن نقول أن المجتمع صار طائفياً. إذن ذلك الارتداد دينيٌ وليس سياسياً، وكل تسييس له هو بفعل السلطة الحاكمةً، ولذلك أشدّد على أن ما يحصل في سورية، بعيدٌ عن كل طائفية؛ فرغم مضي ستة أشهر لا يزال الحراك شعبياً ويتطور في هذا الإطار، وهذا ليس لأنّ في سوريا خصوصية ما تمنع التفجّر الطائفي، وتوازنات ديموغرافية، بل لأنّ الحراك بأصله ليس طائفياً.
عن المعلّقين:
أخيراً، وليسمح لي المعلقون على المقالات الثلاث، من المؤيدين والمعارضين لأفكاري، بإبداء رأيي، فيما يكتبون: الفكرة المركزية هنا، أنّ عليهم التخلص من عقلية اجتثاث الرأي الآخر، والتعامل بروحية الحوار والنقاش والنقد والتأمل والنقض كذلك، من أجل إرساء عقلية تقبّل الآخر، والاعتراف بحقه المطلق في التعبير عن رأيّه، وتبني وجهة النظر التي يراها مناسبة وتخدم مصالحه. وعلينا جميعاً الانحياز للموضوعية والمنطق وإيراد حجج فعلية ومعطيات. بمعنى أن علينا الوقوف إلى جانب الحق المطلق للأفراد في التعبير عن أرائهم بكل حرية؛ فبذلك يُثمر الاختلاف وتتطور المعرفة وتصبح أكثر موضوعية.
وشخصياً لا يشرفني أن يؤيّد بعض المعلقين أرائي وتحليلاتي، لأنّها تنسجم مع أرائهم وأفكارهم، ويشتمون آخرين ينتقدون أرائي أو لديهم رؤاهم الخاصة، بل أنا أحيّي فيهم، روح النقد الهادئ والمنطقي والعقلاني وبلا شتائم من أيّ نوع كان، فبهذا أتشرف، فقط بهذا.
موقع الآوان