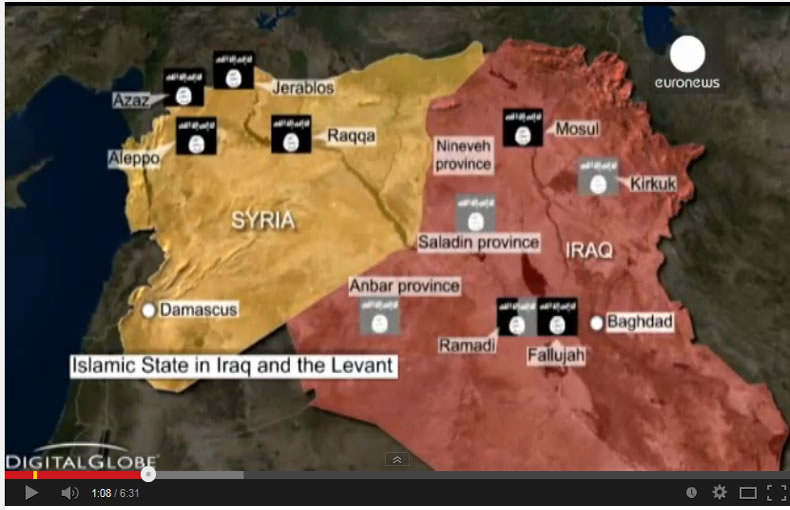السؤال الحاسم في الأزمة السورية
بدر الدين شنن
-1-
في أواخر آذار 1980 ، حضر إلى منزلي أحد قيادي ” التجمع الوطني الديمقراطي ” المعارض ، وتداولنا حينها الإضراب ، الذي تنادت إليه نقابات المحامين في سوريا ، مطالبة برفع حالة الطواريء والأحكام العرفية . وقد تساءل ضيفي أثناءها .. هل يستبق الرئيس الأسد الحدث بتحقيق مطالب المحامين لإجهاض إضرابهم المزمع القيام به بعد يومين ، وذكر أن مرسوماً رئاسياً جاهزاً في مكتب الرئيس يقضي بإجراء ذلك . قلت له .. وهل يمكن أن يقدم الرئيس على ذلك ، رغم أن دماء قتلى مجزرة مدرسة المدفعية مازلت بعد ساخنة . اللافت حينها ، أن أسلوب طرح السؤال من قبل ضيفي ، كان يعبر عن القلق من أن يفعلها الرئيس ، ويعوق بذلك استمرار الحراك السياسي المعارض المستبطن بأهداف هي أبعد من غايات المحامين المعلنة من الإضراب .
لم يفعلها الرئيس .. كما رغب ضيفي العزيز .. وحدث الإضراب . وكانت أولى تداعياته ، أن ذهب ضيفي مع كوكبة من زملائه المحامين إلى السجن . وتصاعد التوتر السياسي في البلاد . وانتقل الحراك السياسي المعارض بتلاوينه المتعددة .. الإسلامي المسلح ، والمدني ، والسياسي ، إلى المواجهات المفتوحة . وامتلأت السجون بالمعتقلين من مختلف أطياف المعارضة . وتساقط آلاف القتلى في المواجهات الدامية وفي التفجيرات المدمرة ، إلى أن ’استنزف الحراك المعارض . وسد العنف والقمع دروب تدحرج كرة الدم . و’فرض الاستقرار الأمني ..
لم يقارب أحد تلك المرحلة السياسية من تاريخ سوريا المعاصر بما تستحقه من النقد المبدئي ، حتى لاتتكرر أخطاؤها وجرائمها في المستقبل ، بل إن ما حدث ، هو أن معظم القوى المعارضة التي لعبت أدواراً أساسية في الأحداث ، وخاصة جماعة ” الأخوان المسلمين ” وحلفاؤهم المقربون ، ا ستخدموا ما تبقى من الشحن المتوتر إبان سنوات الصدام ، لمتابعة المواجهات مع السلطة لاحقاً . لم ينوه أي طرف معارض عن مكامن الخطأ هنا أو هناك .. لم يشر أحد إلى الانزلاقات التي أدت إلى حفر الضعف القاتلة ، التي تخللت الحراك المعارض إن على المستوى الخاص بهذا الفريق أو ذاك ، أو على المستوى العام ، بالنسبة للمنخرطين في خندق المعارضة . وموه الجميع على خطأ الحراك المعارض فيما يتعلق بالبعد الوطني في الحالة السورية ، إذ ’وضع هدف إسقاط النظام قبل اي اعتبار وطني ، وتم تجاوز المخاطر المحيقة بالوطن فعلاً وعلى الأخص من جانب إسرائيل ومطامعها التوسعية . كما جرى غض النظر عن التطرف الطائفي الدموي ” للطليعة الإسلامية المقاتلة ” التي احتوت معظم القوى الإسلامية المناهضة للنظام وفي مقدمتها ” الأخوان المسلمين ” ..
ولم يعترض أحد على تدخل الخارج في الأحداث الجارية لجر الدولة السورية إلى معسكر الموقعين على معاهدات ” سلام ” مع إسرائيل وتصفية القضية الفلسطينية .
وقد أدى كل ذلك إلى حصر الصراع بين النخب السياسية التي فجرت الحراك المعارض في الصراع على السلطة ، تحت سقف الديمقراطي شكلاً والطائفية مضموناً ، وبين النظام . ثم ما لبث أن أدى ذلك إلى انقسام الحراك المعارض ، حيث نأى ” التجمع الوطني الديمقراطي ” بنفسه عن هذا المسار – باستثناء الحزب الشيوعي المكتب السياسي – ، وبقي ” التجمع ” يعمل تحت سقف التغيير الوطني الديمقراطي . كما أدى ذلك إلى ابتعاد الطبقات الشعبية وخاصة الطبقة العاملة عن الإنخراط في هذا الصراع الملتبس على السلطة .
وقد الغى التدخل الخارجي المتعدد الخلفيات والمستويات ، وتلاقي الحراك الإسلامي المعارض المسلح مع المخطط الخارجي ، الذي يستغل ضعف الموقف السوري ، بعد أن سحب ” أنور السادات ” مصر من جبهة الصراع العربي الإسرائيلي ، لإجبار الدولة السورية على التوقيع معاهدة ” سلام ” مع إسرائيل تخسر سوريا بموجبها الجولان المحتل وتخسر سيادتها الوطنية ، وكذلك غياب برنامج سياسي وطني اجتماعي ديمقراطي بديل للنظام القائم آنذاك ، ألغى اعتماد ما حدث في تلك الأيام على أنه ” ثورة ” . وعلى ذلك ، خلال الثلاثين عاماً الماضية ، وحتى الآن ، يطلق على ما حدث في تلك المرحلة تسميات عديدة إلاّ اسم ” الثورة ” ..
بعد أكثر من عشر سنوات ، جاء في كتاب ” حوار حول سوريا ” أصدرته دارعكاظ في لندن عام 1993 ألفه ” محمود صادق ” وهو اسم مستعار لكاتب سوري معارض ، يتقافز الآن على حبال المعارضات تعبيراً عن معارضته المستقلة ، جاء فيه في الصفحة ( 172 ) ” قدمت المملكة العربية السعودية ، مابين 1972 – 1979 ( 25 ) مليار ليرة سورية للتيارات الدينية في سوريا باسم بناء مساجد في مختلف أنحاء سوريا ” وبطبيعة الحال ، الأخوان المسلمون هم القوة الأساس في هذا التيار – حينها كان سعر الدولار نحو أربع ليرات سورية – . وقد تضمن هذا الكتاب تقييماً لأسباب تعرض الوضع السوري للضعف ما بعد توقيع السادات لمعاهدة ” كمب ديفيد ” مع إسرائيل ، واستغلال التيارات الدينية المتطرفة هذا الضعف لانتزاع السلطة .
وجاء بعد خمسة عشر سنة ، في تقرير قدمه ، قيادي يساري معارض ، لقيادة حزبه عن فترة سجنه التي امتدت أكثر من 15 سنة ” عندما سئلت عما يفعله الأخوان المسلمون في سوريا ، قلت لهم أنهم يخدمون مخططاً استعمارياً لجر سوريا إلى معاهدة مع إسرائيل شبيهة بمعاهدة ” كمب ديفيد ” بين مصر وإسرائيل ، وفي تصريح صحفي له عن احتمال تحالفه مع الأخوان المسلمين من أجل التغيير في البلاد قال .. لن اقبل بالتحاف معهم إلاّ بعد أن يعتذروا عن الآلام التي ألحقوها بالشعب السوري في الثمانينات .. لكن عدم الاعتذار لم يحل دون التحالف المذكور الذي حدث أمام الملأ .
وقد أكدت معطيات تلك الأحداث ، أن مسلحي ” الطليعة المقاتلة ” وغيرهم من المسلحين ، الذين خاضوا المواجهات النارية الدموية في مختلف المدن السورية مع آليات الدولة العسكرية والأمنية ، قد تم تدريبهم من قبل الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية .
في ذلك الحين ” في الثمانينات من القرن الماضي ” لم تكن قنوات الجزيرة والعربية وأورينت وزميلاتها موجودة بعد ، ولم يكن الإعلام التلفزيوني قد بلغ هذا المستوى من التكنولوجيا والانتشار كما هو الان ، ولم يكن الإعلام عموماً قد اكتشف واستخدم كسلاح تعبوي وتحريضي واسفزازي وموجه فعال ، يكاد أن يوازي ، بل يتجاوز ، الأسلحة الجوية التدميرية الشاملة كما يستخدم الآن . ولم تكن ” دول ” الخليج ” باستثناء المملكة السعودية ، التي حظيت عائلاتها القبلية الرئيسية على ترخيص غربي لإقامة دول بأسمائها وتقاليدها المفوتة .. هي على ما هي الآن ، من قدرات مالية وعلاقات دولية مستقرة كجزء إقليمي تابع في المنظومة الإمبريالية العالمية . ولم تكن الدول الغربية ، بوجود الاتحاد السوفييتي ومعسكره الاشتراكي ، تستطيع أن تتمادى في سيطرتها ونفوذها كما تشاء على مستوى العالم وفي الشرق الأوسط ، كما فعلت في أوائل القرن الواحد والعشرين ، وتحاول أن تفعل الآن في عدد من الدول العربية ” الجمهورية ” متغيرات تنسجم مع مصالحها الاستعمارية . ولذلك انحصرت أصداء وتداعيات المواجهات السورية ، في الثمانينات الغابرة ، السياسية والعسكرية والعنفية ، إلى حد كبير ، ضمن الجغرافيا السورية كقضية داخلية بحتة . ولم يظهر منها سوى قمة جبل الجليد ، التي أطلت من مدينة حماة الضحية الأكبر للحرب بين من اختار السلاح من المعارضة الإسلامية لانتزاع السلطة ، وبين من اختار التمسك بالسلطة والدولة بأي ثمن .
لقد مارس المعارضون المسلحون أقصى ما في طاقتهم من العنف ، ودفعوا الثمن تصفيات سياسية وعقائدية وجسدية ، شلت قدراتهم على مدى ثلاثة عقود ، انعكست على المعارضات السياسية الأخرى اعتقالات وتهميش وانعدام وزن ، بل انعكست على المناخ السياسي العام ، حيث صودرت السياسة وتبعتها مصادرات الفكر والعقل المستقل والمبدع , ومارس اهل الحكم أقوى ما عندهم من آليات عسكرية وقمعية لسحق خصومهم ، وفرضوا نوعاً من الاستقرار المرتكز على الخوف والإخضاع ، ما حرم البلاد على امتداد ثلاثة عقود من النمو البشري والسياسي والاجتماعي الطبيعي . الأمر الذي نجم عنه دولة لاتملك قدرات مواجهة استحقاقات متغيرات الحاضر والمستقبل ، وخاصة المتغيرات الدولية البالغة القوة والخطورة على وجود الوطن كله ، وأنتج الكثير من النواقص والأخطاء والفساد ، حيث وصل الأمر إلى حد الاعتراف الرسمي بأهمية إحداث إصلاح جذري سياسي واقتصادي واجتماعي ودستوري في البلاد .
ما يعني بإيجاز ، أن الأوضاع في البلاد لايمكن أن تستمر بشكل عام ونوعي ، ولابد من إحداث تغيير يؤدي فعلاً إلى إعادة بناء سوريا ديمقراطية عادلة جديدة . وقد اصبحت جميع القوى السياسية والاجتماعية داخل الحكم وخارجه محكومة بأداء هذا الاستحقاق . وظهر في الشكل في المشهد السوري ، أن الجميع أخذ ينحو .. كل حسب خلفياته وأهدافه وقيمه .. وحسب ولاءاته الداخلية وامتداداته الخارجية ، نحو الزعم ، أنه سيحقق هذا التغيير .. وهو أهل لذلك . لكن في المضمون .. ما جرى واقعياً منذ وبعيد 15 آذار 2011 .. أخذ مناح أخر في معالجة مسائل التغيير .. والإصلاح ..
وكان إطلاق النار على متظاهرين في درعا في آذار 2011 ، هو الشرارة ألتي اطلقت أمنية معارض عبر قناة الجزيرة حول ما حدث في درعا ، إذ قال .. بأسلوب يعيد إلى الذاكرة أمنية ضيفي قبل ثلاثين عاماً في اقتحام المواجهات إلى أقصى الاحتمالات ، وينم على الرهان على الدم لإسقاط النظام ” لقد وقع بشار الأسد في الفخ ” . وتوالت الأحداث الدامية منذ وبعد 15 آذار 2011 ، على خلفية ، تكاد تطابق خلفية أحداث الثمانينات البائسة ، إنما بتلاوين وآليات داخلية وخارجية جديدة ، سياسية ، وطائفية ، ومالية ، وعسكرية ، وإعلامية ، حاملة عنوانين متناقضين .. الأول .. ” الصراع بين الثورة والاستبداد ” .. والثاني .. ” الصراع بين الدولة والمؤامرة ” ، وحاملة شبح المخططات الخارجية الاستعمارية ” السناريو الليبي ” لإسقاط النظام ..
الوقائع على الأرض ومعاييرها المطابقة ، للوطنية والديمقراطية والكرامة الإنسانية .. هي التي تحدد مصداقية الإجابة على السؤال الحاسم الآن في الأزمة السورية : هل الصراع في سوريا هو .. بين الثورة والاستبداد ؟ .. أم .. بين الدولة والمؤامرة؟ ..
-2-
في نهاية القسم الأول من هذا المقال ( 1 – 2 ) كان السؤال : هل الصراع ” الجاري الآن في سوريا هو بين ” الثورة والاستبداد ” ؟ – كما تقول أطراف من المعارضة – أم هو بين ” الدولة والمؤامرة ” – كما يقول ممثلو الدولة والسلطة ؟ .. وأعترف أنه كان من الأفضل أن يطرح السؤال بصيغة أكثر عمقاً ، ومقاربة للواقع الملموس ، على الشكل التالي : هل تعيش سوريا الآن حالة ” ثورة ” تخوضها قوى اجتماعية سياسية ، من أجل إحداث تغيير جذري سياسي واجتماعي في بنية الدولة والمجتمع ؟ .. أم أن سوريا تعيش ” حالة وطنية .. حالة حرب .. ” دفاعاً عن السيادة الوطنية ، وحفاظاً على وجود ووحدة ومستقبل شعبها ، بقيادة قوى الدولة بحكم واجباتها ومسؤولياتها ؟ ..
وإزاء هذا السؤال المركب ، الذي يحمل أبعاداً متشابكة على مستوى الداخل والخارج ، والذي يريده البعض أن يكون غامضاً أيضاً ، للتمويه على ممارسات وغايات غير نبيلة ، يصبح الجواب مركباً .. وملتبساً أيضاً . ويصبح تفكيك هذا التركيب .. الغامض .. ضرورة أولية ، حتى يستقيم الوضوح ، وتتوفر المقومات الموضوعية الشفافة لصياغة الجواب .
ولذا ، فمن أجل أن يتمكن الشعب السوري من الوصول إلى أهدافه ، التي ناضل ويناضل من أجلها ، المتمثلة بالحرية .. والديمقراطية .. والعدالة الاجتماعية .. والتزاماً بالوحدة الوطنية .. ونبذ الطائفية .. والعنف .. وكل ما يمس بالأذى تآخي مكونات الشعب السوري ، ودفاعاً الوطن الغالي ضد كل المتآمرين والمعتدين الإقليميين والدوليين .. فإنه من الأهمية بمكان ، أن يضاء أهم ما يتعلق بقوى وأهداف ما يسوق باسم ” الثورة ” .. وأهم ما يتعلق بوجود ودوافع ومخططات ما يسمى ” مؤامرة ” .. وذلك من خلال التمسك بالشفافية والموضوعية .. وبما يصح ، أن يسمى بالثوابت والمفاهيم العلمية ، لأي ثورة تمثل فعلاً حضارياً مواكباً لحركة التاريخ والحضارة الإنسانية .. وكذلك أيضاً ما يتعلق بأي مؤامرة تمثل فعلاً مضاداً للثورة ولحقوق الشعوب بالسيادة الوطنية والحرية وتقرير المصير .
وإذا بدأنا مقاربتنا ” بالثورة ” في الحالة السورية ، فإنه لكي تعتبر هذه ” الثورة ” حسب المعايير العلمية والتاريخية ، فعلاً حضارياً مواكباً لحركة التاريخ ، ينبغي أن نجد أولي هذه ” الثورة ” قد تجاوزوا ” النظام ” الذي يحاربونه ، بكل مكوناته ومقوماته ، الأيديولوجية ، والسياسية ، والحزبية ، والمؤسساتية ، التي شكلت – بالنسبة إليهم – تعارضاً عصياً على الحل بالطرق السلمية .. بما هو أكثر وطنية وحرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية مما هو قائم في البلاد . وذلك بتوفير قيادة ” للثورة ” ملتزمة ببرنامج سياسي اجتماعي ، يعبر عن رؤاها العلمية في إدارة الدولة على كل الأصعدة ، بما هو أرقى من رؤى مسيري الدولة .. قيادة معروفة بنزاهتها ووطنيتها والتزامها بقيم الحرية والديمقراطية بأبعاد اجتماعية عادلة ، تحقق العيش الكريم للطبقات الشعبية ، والنمو الاقتصادي الاجتماعي ، الذي يضع البلاد على مسارات الكفاية المضطردة والازدهار .. قيادة لديها توجهات راسخة واستراتيجية واضحة في كل ما يتعلق بسوريا في علاقاتها بالخارج الإقليمي والدولي ، لاسيما فيما يتعلق بتحرير الجولان ، والصراع العربي الإسرائيلي ، والمبادرة لخلق مناخ عربي قومي تحرري يؤسس لنهوض قومي جديد لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الوطن العربي .. في ثرواته .. ووحدة هويته .. وجغرافيته .. ولإشاعة الاستقرار والسلم الدوليين ، وحق الشعوب في تقرير مصيرها ، والمساهمة الجادة في بناء عالم متعدد الأقطاب يقوم على مؤسسات دولية ديمقراطية تنبثق عنها شرعية دولية بديلة لاحتكار شرعية الدول العظمى . لكننا نجد أن ” الثورة ” في الحالة السورية لاتتوفر لديها قيادة تتمتع بالواصفات المطلوبة وطنياً .. وليس لديها برنامج سياسي اجتماعي شامل ، بل إن بعضها جاهر بعلاقاته مع إسرائيل .. وقد سلمت قيادة ومصير البلاد ، علناً ” إلى أعتى الدول الاستعمارية المعادية للوطن ، وإلى أنظمة خليجية رجعية مفوتة .. التي يمثلها أوباما وساروزي وخليفته هولاند وكاميرون وأردوغان وحمد آل ثاني وسعود الفبصل ، ولجأت إلى استجداء مجلس الأمن عبر الجهات المذكورة ، لإصدار قرار بالتدخل العسكري الأجنبي التدميري في البلاد ، حسب السيناريو الليبي ، للوصول إلى السلطة ، وم ثم اصبحت هذه القيادة غطاء سياسياً وأداة تابعة للمجموعات المسلحة ، التي تشترك معها منظمات دولية مثل ” القاعدة ” و” بلاك ووتر ” ، التي تأتي من مختلف البلدان التي تهيمن عليها ، أو تنشط فيها ، منظمات سلفية تكفيرية ، عبر قواعد يشرف عليها حلف الأطلسي في تركيا ، وعبر اقطاعيات سعد الحريري في لبنان ، لزرع الدمار والفوضى في البلاد ولسفك دماء السوريين الأبرياء . ما يعني أن هذه ” الثورة قد تخلت عن معيار الوطنية والنزاهة والتقدم الحضاري .. وعن معيار النضال السياسي من أجل الأفضل المتنامي ، ليصبح القتل والدمار والخصومة التناحرية الدامية المرتهنة لأجندات الخارج معيارها الذي تلتزم به .
من هنا يمكن فهم ، لماذا التمسك باسم ” الثورة ” بدل ” المعارضة ” . لأن الثورة تعني التناحر مع الطرف الآخر الحاكم من اجل الحلول محله في الحكم ، بينما المعارضة تعني ، أنها طرف في حالة خلاف مع الطرف الحاكم . وكلا الطرفين يشكلان معاً العملية السياسية في البلاد ، ويمكن أن تجري عملية إعادة تموضع أطراف هذه العملية بين وقت وآخر . ومن هنا أيضاً يمكن فهم ، لماذا رفض الحوار والإصرار على التفاوض ، لأن الحوار يعني الاعتراف المتبادل بين المتحاورين ، وقد ينتج عنه ، في الغالب ، عقد اجتماعي سياسي جديد ، وذلك وفقاً لموازين القوى المستجدة . أما التفاوض ، فهو لاتخاذ إجراءات استسلام الطرف الحاكم . ولأن ما يطرح باسم ” الثورة ” هو من قبل الذين تجاوزا معايير الوطنية والديمقراطية الاجتماعية ، ولم يلتزموا ببرنامج سياسي وطني شامل ، فإن مايطرح في هكذا لقاء ، هو أوامر عسكرية توجه إلى الطرف الحاكم كي يستسلم ، ليس لهم بالضبط ، وإنما لمن يقودونهم في الخارج الذين يدعمونهم بالمال والسلاح والإعلام والخبرات الفنية العسكرية ، من أنقرة والدوحة والرياض وواشنطن ولندن وباريس وبروكسل . ما يعني وضع سوريا ، كما حصل في بلدان أخرى تحت الوصاية الدولية ، وإخضاعها لمخططات هذه الوصاية المتعلقة بالجيوسياسية السورية ، ضمن مخططات الشرق الأوسط الصهيو ـ أميركي الجديد .
اللافت ، والواجب ذكره في هذا السياق ، أن جل مطالب المعارضة قبل 15 آذار 2011 وخاصة ، رفع حالة الطواريء والأحكام العرفية وتعديل الدستور وقانون للأحزاب .. قد تحقق . وهذا يلبي إلى حد كبير ما كانت تطالب به الاحتجاجات السلمية المعارضة في بداية الأحداث . لكن المعارضة المسلحة قد تجاوزت الاحتجاجات السلمية وإنجازاتها الهامة التي فتحت في المجال للمزيد مما تصبوا إليه في المستقبل ، وصعدت بالتنسيق مع الخارج وأجنداته إلى سقف الصدام المسلح وإسقاط النظام . واللافت أكثر ، أن كثيراً من المعارضين في قيادة ” الثورة ” لم يجدوا حرجاً من لقاء المتآمرين على وطنهم من المسؤولين الإسرائليين والأمريكيين والأوربيين والخليجيين ، ويرفضون في الآن عينه أي لقاء مع المسؤولين في وطنهم ، لإيجاد مخرج سلمي ديمقراطي عادل للأزمة في البلاد .
ما تقدم ، لايعني ، أنه ليس هناك قطاعات شعبية مليونية مهمشة تعيش ، في الأحياء العشوائية حول ، وفي المدن الكبرى وفي الأرياف ، تكابد الفقر والبطالة وحرمانات موجعة لاتحصى ، بسبب الإستئثار المديد بالسلطة والثروة ، وبسبب الانتقال في السنوات الأخيرة إلى اقتصاد السوق الحر” الليبرالي ” ، قد انخرطت ، على أمل الانتقال إلى حياة أفضل ، أو تأثراً بعدوى العادات المبهرة في الظروف الاستثنائية ، أو استجرت بالتجهيل الديني ، قد انخرطت في العمليات المسلحة ، ويعتبر أفرادها أنهم ” ثوار ” بحق .. ومجاهدين كاسبين عبر الجهاد والشهادة في الدنيا والاخرة .. أو أنه ليس هناك فئات من المثقفين المهمشين بسبب قناعاتهم وآرائهم ، الذين قد تفاءلوا كثيراً بالربيع العربي ، أملاً بالخلاص من النظام العربي الخياني المتعفن . ما يعني ، أن تموضع هذه القطاعات والفئات في المشهد السوري ، يؤكد أن ليس كل ما يجري في سوريا هو مؤامرة ..
لدى مقاربة ما يسمى ” مؤامرة : لابد أولاً من التذكير ، أن سوريا كانت تسمى تاريخياً ببلاد الشام ، وكانت أكبر بكثير مما هي عليه الآن ، وكانت في التاريخ الحديث ، في مركز اهتمام الدول الاستعمارية والمظمات الصهيونية . ولعل أبرز محطات هذا الاهتمام هي ، المؤتمر الصهيوني في بازل بسويسرا عام 1897 الذي قررإقامة وطن قومي لليهود على جزء من الأراضي السورية في فلسطين ، ومن ثم كانت معاهدة سايكس ـ بيكو لاحتلال وتقسيم بلاد الشام ” سوريا ” بين الدولتين العظميين فرنسا وبريطانيا ، ثم كان وعد وزير خارجية بريطانيا صموئيل بلفور لليهود لإقامة دولتهم ” إسرائيل ” على أرض فلسطين .
وقد قسمت بلاد الشام ” سوريا ” ، بموجب المعاهدة والوعد المذكورين بعيد الحرب العالمية الأولى ، إلى أربعة دول هي ، سوريا الحالية ولبنان والأردن وفلسطين ، بعد أن استلبت تركيا الجديدة من سوريا مساحة من الأراضي السورية تبلغ ( 110 ) آلاف كيلو متر مربع تمتد من تخوم لواء اسكنرون غرباً إلى ماردين شرقاً . ثم قدمت فرنسا لتركيا مقاطعة كيليكيا التي تضم أضنة واسكندرون وانطاكية ، وذلك مقابل ضمان حياد تركيا في الحرب العالمية الثانية ، حيث بلغ مجموع الأراضي السورية التي استحوزت عليها تركيا في النصف الأول من القرن الماضي مساحة هي أكبر من مساحة سوريا الحالية . وعند النظر إلى المساحة التاريخية الكلية لبلاد الشام ، يتبين لنا أنها تبلغ نحو ( 600 ) ألف كيلو متر مربع .. وأنها تضم تنوعاً جيوسياسياً بالغ الأهمية . إذ أنها تمتلك كل الشاطيء الشرقي للبحر الأبيض المتوسط .. من أزمير واسكندرون شمالاً إلى غزة جنوباً .. وتتموضع على محور جغرافي يتوسط كل من أوربا وآسيا وأفريقيا .. ما يؤهلها أن تلعب دوراً إقليمياً ودولياً استراتيجياً هاماً .. لاسيما في مجالات التجارة الدولية والمواصلات والثقافة والمتغيرات الدولية الكبرى .
وبعد اكتشاف البترول الخليجي .. وبعد إقامة ” إسرائيل ” برزت ، أكثر من قبل ، الأهمية السترايجية لسوريا الحالية ، وأصبحت في قلب كل مخططات المتغيرات الاقتصادية والعسكرية الشرق أوسطية ، وذلك لتأمين جوار آمن ومدى حيوي لإسرائيل ، ولاستخدام أراضيها معابر لخطوط الشركات البترولية الإمبريالية الكبرى ، ولحركة الترانزيت التجاري والعسكري الأقل كلفة ، ولحجز الجغرافيا السورية ، وخاصة امتدادها الساحلي لصالح النفوذ البريطاني الفرنسي ومن ثم الأميركي والإسرائيلي ، وقد زاد من هذا الاهتمام إلى حد هيستيري اكتشاف مخزون كبير جداً من البترول والغاز في الباطن السوري براً وبحراً .
وقد دخلت سوريا في مرحلة هي الأخطر في تاريخها الحديث بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ، وانتهاء الحرب الباردة على تفرد الولايات المتحدة بالقطبية الدولية الأحادية للعالم . وكان من أولوية هذه المتغيرات ، الهجوم الامبريالي المتوحش للسيطرة على منابع البترول في الخليج ، وضمان أمن وتوسع إسرائل ، وإعادة رسط خريطة الشرق الأوسط ، التي لن تكتمل وتأخذ مداها في التحقق إلاّ بعد ضم سويا إليها . وقد تعزز هذا الهجوم وزاد شراسة بعد ما سمي بالهجوم الإرهابي على برجي التجارة العالمية في نيويورك عام 2001 ، الذي وظفه بوش ذريعة لشن حربه الإرهابية الكونية على العالم ، لفرض هيمنة القطب الأحادي الدولي ، ووضع القبضة الأميركية على ثروات ومصائر الشعوب وخاصة في الجيو ـ سياسية الشرق الأوسط . ومن أجل ذلك كان الهجوم الأميركي الأطلسي على أفغانستان .. ثم على العراق ، تمهيداً للهجوم على إيران وسوريا . وكان استغلال الاحتجاجات الشعبية ضد الأنظمة العربية المستهدفة أولاً في مخطط الهيمنة ، من التبني الشكلي للمطلب الديمقراطي .. إلى الدعم الإعلامي الهجومي غير المسبوق ، لإسقاط أنظمة بعينها دون غيرها وإن كانت هي الأسوأ ، ومنها النظام السوري ، وكان ذلك شبه هجوم كوني .
من الطبيعي أن تتحرك القوى الشعبية والمضطهدة والمهمشة في سوريا وغيرها لانتزاع حقوقها في العدالة وفي توزيع فائض القيمة وحرية الرأي والإبداع والاختيار ، وحسب الموقف إزاء هذه الحقوق يتحدد معيار وطنية وتقدمية وثورية وشرف كل القوى والشخصيات والنخب السياسية والثقافية .. يتحدد معيار وعي إنساني أصيل ينبع من الإحساس بشرعية وقدسية حق البقاء والارتقاء بكرامة وعدالة نحو الأفضل . لكن من غير الطبيعي أن رؤساء ومسؤولين في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ، الذين ذبحت دولهم الاستعمارية ملايين المناضلين الوطنيين في مختلف البلدان .. من كوريا وفيتنام إلى أفغانستان والعراق وليبيا والجزائر وفلسطين وسوريا وغيرها .. وأن ملوك وأمراء دول الخليج الرجعية المفوتة .. وخاصة قطر المحمية الأميركية والسعودية الأكثر رجعية واستبداداً في العالم ، وأن رئيس وزراء تركيا الحالم بطربوش السلطان العثماني ، أن يتولى هؤلاء وأتباعهم الصغار قيادة ” الثورة ” في سوريا ويقررون مصيرها ومصير شعبها ..
نعم ليس كل ما يحدث في سوريا مؤامرة .. لكنه ليس كله أو بعضه يبرر ما يحدث فيها من قتل وتدمير . لقد تجاوزت الأزمة في سوريا نتيجة عوامل عديدة .. غير عقلانية وغير أخلاقية .. داخلية وخارجية ، تجاوزت مرحلة الاحتجاجات .. ثم مرحلة المعارضات الانفعالية .. وتجاوزت الخلافات والخصومات الداخلية . لقد أصبحت حرباً قذرة تديرها قوى خارجية معادية لسوريا .. من واشنطن إلى أنقرة إلى ذلك البرج الذي يتمترس فيه أيمن الظواهري .. حرباً يقتل فيه السوريون بعضهم البعض لحساب الآخر .. لقد بلغ التدمير البشري والسكني والمؤسساتي حداً يعجز كل من يحمل ضميراً حياً وشرفاً أصيلاً عن التحديق في مشهده . وهذا ما يطرح السؤال الحاسم :
عنما تصبح المسألة الوطنية في ذروة مخاطرها ، هل يستقيم بأي معيار من المعايير الدينية والوطنية والأخلاقية والإنسانية ، ممارسة حرب الخصومات الداخلية تحت أي اسم كان .. أو استمرارها تحت أي ذريعة كانت .. لمتابعة تدمير البنى التحتية والأبنية السكنية وقتل آلاف ثم آلاف الأبرياء ، وتهجير مئات آلاف المواطنين من بيوتهم ومدنهم ، وتعطيل التعليم والخدمات العامة وسبل الحياة الطبيعية ؟ .. وهل تبقى أي قيمة لأي انتصار سياسي أو عسكري بين خصوم الداخل .. بعد كل هذا الدم المسفوك .. وبعد تمزيق وخسارة الوطن ؟ ..
ألا يستحق الشعب السوري الأبي العريق حياة كريمة .. مستقرة .. آمنة .. مفتوحة على آفاق التقدم والأمان والازدهار ، حيث يودع الشيوخ العمر مطمئنين على وطنهم وأسرهم ، وحيث ’يفتح أمام الشباب مستقبل واعد .. ضامن .. للعمل وللاعتبار والحياة الهانئة والأمل ، وحيث تنمو الطفولة برعاية القلوب والعيون .. في مناخ يحترم تفتحها على الحياة .. وعلى الصحة والفرح ؟ ..
أما آن أوان تغليب حوار العقل على حوار الدم ؟ ..