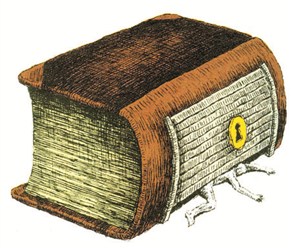نقاش في الديموقراطية وإشكالياتها/ ماجد كيالي

بديهي أن ثمة إشكاليات كثيرة في الديموقراطية، طرحت في اليونان القديمة، ومنذ أيام أفلاطون وأرسطو، حتى أيامنا هذه، ضمنها مشكلة المساواة بين بشر غير متساوين، في حيازة الثروة والقوة والوعي والإرادة والمكانة، في حين أن الديموقراطية تفترض المساواة. كما ثمة مشكلة أخرى تتمثل في تعيين الشعب، أو إخراج جزء منه (العبيد مثلاً)، من نطاق الشعب. ومعلوم أن حق الاقتراع تطور عبر التاريخ، مثلما تطور مفهوم الشعب، إذ كان يقتصر على طبقة النبلاء، أو طبقة الأحرار، أو سكان المدن، أو المتعلمين، أو دافعي الضرائب، كما كان يقصي النساء والأميين، والشبان إلى مرحلة عمرية معينة، إلى أن وصل أخيراً إلى اعتباره حقاً من حقوق المواطنة، لكل المواطنين، في منتصف القرن العشرين، بغض النظر عن نسبة ممارسة هذا الحق بين مجتمع وآخر. ولا ننسى في هذا السياق أن الكواكبي، في كتابه: «طبائع الاستبداد»، كان وجه نقداً قاسياً لـ «العوام»، باعتبارهم «قوت المستبد وقوته»، أي أن الجدل حول حق الانتخاب أو حق المواطنة، أو تحديد مفهوم الشعب هو جدل عالمي يخص كل المجتمعات عبر التاريخ.
ثمة مشكلة أساسية ثانية تنبع من حقيقة، مفادها أن أصحاب المال والقوة، ومؤخراً أباطرة الإعلام، الذين وصف سطوتهم هربرت شيللر بأفضل شكل في كتابه: «المتلاعبون بالعقول»، وذلك بحكم الثورة في تكنولوجيا الإعلام والاتصال الجماهيري، هؤلاء هم الذين يملكون قدرة أكبر على الوصول إلى عموم الناس وتشكيل أخلاقياتهم وأنماط سلوكهم، وتحديد اتجاهات تصويتهم في صناديق الاقتراع، في الظروف العادية. طبعاً هذه الأمور تحدث بتفاوت، في كل مجتمع، وحتى في إطار المجتمع الواحد، تبعاً لمستويات التعليم والوعي والحريات الفردية وبالـتأكيد تبعاً لمستوى المعيشة، إذ كلما قل ذلك ارتفع مستوى التأثير على سلوك الأفراد، بغض النظر عن مصالحهم أو حقوقهم، وبالعكس، ما يعني أنه لا توجد ديموقراطية مثالية، وتعبر عن إرادات الناس ومصالحهم، على نحو حقيقي. المهم أن كل ما تقدم يؤكد أن مشكلات ومحددات الديموقراطية تتباين بين المجتمعات وفق تطورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما أنها تختلف بين عصر وآخر.
المشكلة الأخرى للديموقراطية أنه لا توجد ديموقراطية مثالية، أيضاً. ففي مسار تطورها، أخذت الديموقراطية مكانتها من مسارين، أولهما، تقييد السلطة وإنهاء الحكم المطلق، مع نظرية العقد الاجتماعي (روسو) وفصل السلطات (مونتسكيو)، مع ملاحظة أن هذه النظريات ظهرت بعد الثورة الانكليزية أواخر القرن 17 التي قيدت الحكم الملكي. وثانيهما، بالاستناد إلى فكرة المواطن الحر، المستقل، إذ الحرية هي معطى فردي، فلا حرية لمجتمعات، من دون حرية المواطنين، الذين يشكلون الشعب، صاحب السيادة. أي أن الديموقراطية، وفق تمثلاتها في الغرب، هي ديموقراطية ليبرالية، لا تنشأ من حق الانتخاب وتداول السلطة، فقط، وإنما تنشأ من قيم عليا، تتعلق بضمان الحرية والمساواة بين المواطنين، أمام القانون وفي الفرص، بدون أي تمييز، وهذه كلها تشكل الإجماع الذي يتم النص عنه في دستور. وأهمية الدستور هنا أنه لا يخضع لمزاج غالبية سياسية، تفوز في الانتخابات في مرحلة ما، بحيث لا يعود ثمة أكثريات وأقليات من أي نوع، لا طائفي ولا طبقي ولا غيره، فقط ثمة أكثرية وأقلية بالمعنى الانتخابي الظرفي، لأن النظام ككل يعمل على أساس الفصل بين السلطات، وعلى أساس التداول والمراقبة والمحاسبة.
ولعل باسكال سلان خير من عبر عن ذلك في كتابه: «الليبرالية»، الذي تحدث فيه عن قرية يسكنها 100 فرد تحاول «مجموعة» منهم من 51 «شخصاً» تجريد 49 من سكان هذه القرية أموالهم وقد تصل هذه المجموعة إلى الحكم عن طريق انتخابهم ديموقراطياً، وسيكون كافياً لهم التصويت على تشريعات تساعد على تجريد الآخرين من أموالهم وأمتعتهم.» بمعنى أن الديموقراطية الليبرالية تحمي الضعفاء، وتهذب الأقوياء، وتحول دون الديكتاتورية، ودون انتقاص حقوق الجماعات والأفراد.
طبعاً الديموقراطية عندنا، حيث وجدت، لا علاقة لها بكل ذلك فهي لم تتأسس على مفاهيم الليبرالية، أي على مفاهيم الحرية، واستقلالية الإنسان الفرد، والمواطنة، فضلاً عن أنها مجرد ديموقراطية انتخابية، يتم التحكم بها، بسلطة الدولة والمال والإعلام ووسائل التربية. وعليه فلا يمكن القول بديموقراطية حقيقية بدون ليبرالية، أي بدون حريات فردية، تماماً مثلما لا يمكن القول بليبرالية حقيقية بدون ديموقراطية.
مناسبة هذا الكلام مثال التجربة التركية، وهي الأقرب والأحدث، إذ شهدنا نوعاً من محاولة إزاحة النظام البرلماني الديموقراطي، لمصلحة النظام الرئاسي، في محاولة لتركيز السلطات في شخص الرئيس، ما أثار مخاوف النكوص عن التجربة التركية الناجحة، التي زاوجت بين الإسلام والعلمانية، وبين الإسلام والديموقراطية. ومعلوم أن هذه التجربة لا تدين فقط للعلمانيين، وإنما للإسلاميين أيضاً، الذين صبروا على إقصائهم عدة مرات ولم يذهبوا إلى ردات فعل متسرعة ولا إلى العنف لإيمانهم بالديموقراطية، ما عزز ثقة الشعب بهم وأوصلهم إلى الحكم (2002). القصد أن النظام الديموقراطي يمكن أن يأخذنا نحو الدكتاتورية، أيضاً، بمعنى أن الديموقراطية تحتاج إلى تحصين، في دستور يحدد الإجماعات والقيم العليا، التي لا يمكن المس بها، لأنها من دون ذلك تكف عن كونها ديموقراطية حقة، أو ديموقراطية يمكن تطويرها، وتغدو مجرد ديموقراطية صورية، أو ديموقراطية انتخابات وجماعات.
* كاتب فلسطيني – سوري
الحياة