انشغالات التيارات السياسية العربية وإخفاقاتها/ ماجد كيالي
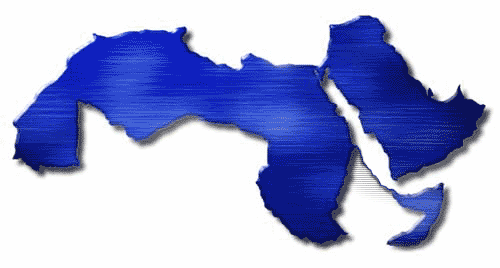
عاشت التيارات السياسية المركزية، في المنطقة العربية، سبعة عقود، أي طوال حقبة ما بعد الاستقلال، على القضايا والمشاريع الكبرى، والمشكلة أنها كبرى نسبة لأنها مجرد قضايا سياسية فوق وطنية، وأنها بانشغالاتها هذه لم تعط الاهتمام المناسب لقضايا المواطنة والمجتمع والحقوق والدولة، إذ تمحورت حول الوحدة والاشتراكية وتحرير فلسطين، أو الصراع ضد الإمبريالية وإسرائيل، فيما انشغلت التيارات الإسلامية بمشروع إقامة دولة الخلافة أو الدولة الإسلامية. ثمة مشكلة أخرى ومفادها أن هذه القضايا هي ذاتها التي انشغلت أو تغطّت بها الأنظمة الاستبدادية العربية، ما يفسّر عطف التيارات القومية واليسارية والعلمانية على هذه الأنظمة الاستبدادية ودفاعها عنها، علماً أن هذه الأنظمة برّرت بهذه القضايا مصادرتها الحقوق وهيمنتها على الدولة والموارد والمجتمع، كما قصورها في عدم قدرتها على إحراز أي تقدم في أي من القضايا المذكورة، التي اعتراها التآكل، بعد أن تم استهلاكها وتوظيفها في مجرد إنشاءات وسياسات أضرت أكثر مما أفادت.
للأسف، فإن التيارات المعنية، أي القومية واليسارية والإسلامية والعلمانية (التيار الليبرالي لا يكاد يلحظ)، على رغم كل إخفاقاتها لم تُقْدِم على أية مراجعة نقدية لأفكارها التأسيسية، ولا لأشكال عملها، حتى اعتراها التكلس، ودبّ فيها الوهن، وأخذتها الشيخوخة، وباتت ثمة غربة أو فجوة هائلة بينها وبين مجتمعاتها.
على هذا النحو فاجأت ثورات «الربيع العربي»، بما لها وما عليها، هذه التيارات، وأربكتها، وخلخلت بديهياتها، إلا أن هذه سرعان ما تمكنت من الخروج من ذهولها، لكن بدلاً من ذهابها إلى مراجعة أوضاعها وسياساتها والاصطفاف إلى جانب المجتمعات التي نزلت إلى الشارع، أو إلى مسرح التاريخ، للمرة الأولى في هذه المنطقة، إذا بها تصطف إلى جانب الأنظمة الاستبدادية، أو العسكرية، بهذه الحجة أو تلك، وحتى أن قسماً كبيراً منها وقف مع الحالات الارتدادية عن الثورات!
والفكرة هنا أن الحديث عن ربيع «إسلامي» لا يبرّر البتّة هذا النكوص عند التيارات السياسية العربية المتمثلة في كيانات معينة، بل إن صعود القوى الإسلامية مع الثورات، كما لاحظنا في الأعوام السابقة، هو دلالة على إخفاق التيارات القومية والوطنية واليسارية والعلمانية، أي أنها هي التي تتحمل المسؤولية عما حصل، علماً أننا هنا لا نتحدث عن أفراد. فثمة يساريون وقوميون وعلمانيون وقفوا مع الثورات العربية من البدايات.
واضح هنا أن المشكلة، كما ذكرنا، تكمن في أن التيارات السياسية العربية لم تشتغل في السياسة، على الأرجح، بقدر اشتغالها في الأيديولوجيا، أو بالصراعات الهوياتية، وهذا ينطبق على أصحاب الأيديولوجيات السماوية أو الأرضية. وأيضاً، أن هذه التيارات لم تشتغل بالسياسة باعتبارها تخصّ معاش البشر، وتدبّر أمورهم الحياتية، وشكل تنظيمهم لعلاقاتهم، وطريقة إدارة أحوالهم، بقدر اشتغالها على القضايا العامة، التي لا تحتاج إلا الى مجرد شعار، أو بيان، أو مهرجان خطابي، على نحو ما شهدنا في خطابات الأنظمة وكذا الأحزاب القومية واليسارية والوطنية.
هكذا، انشغل القوميون واليساريون والإسلاميون والعلمانيون، طوال العقود السبعة الماضية، بالدفاع عمّا يعتقده كل منهم الحقيقة المطلقة، أو المغلقة، التي لا حقيقة سواها، دون أن يشغلوا أنفسهم بمناقشات تخص واقع البشر، كأفراد وكجماعات، وما يواجهونه في حياتهم من تعقيدات في المعاش، والعمل والتعليم والصحة، والعلاقة مع السلطة – الدولة. وفي الأثناء، فضل معظم التيارات المذكورة، في غالب الحالات، الاشتغال بالسياسة تحت سقف الأنظمة «الثورية» أو «التقدمية» أو «الوطنية» أو «العلمانية»، لمجرد الوجود، بدلاً من التطلع إلى مراكمة عمل سياسي حقيقي، يعزز مشاركة الشعب في السياسة ويؤكد حقوق المواطنين في صوغ حياتهم ومستقبلهم ومكانتهم إزاء ما يفترض أنه دولتهم.
فوق ذلك، فإن ما يلفت الانتباه أن التيارات المعنية لم تفتح نقاشات جادة ومسؤولة في ما بينها، للتوافق على مفهوم المواطنة، ومعنى دولة المؤسسات والقانون والدستور، والأشكال الأنسب للديموقراطية، وعلاقة الدولة بالسلطة، وحدود السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية. وبالأساس سكتت هذه التيارات جميعها عن غياب مفهوم مكانة المواطنة في الواقع العربي، بالتلازم مع غياب مفهوم الدولة، إذ كانت مشغولة أكثر بالتصارع مع الامبريالية والصهيونية، وذلك في ساحات البيانات والمهرجانات والمؤتمرات.
هذا العرض يفيد بأن التيارات أو الكيانات السياسية العربية أضاعت سبعة عقود من التاريخ، أي أن ذلك لا يقتصر على الأنظمة التي أكلت أعمارنا، وأن بناء كيانات سياسية جديدة لا بد أن يحدث بالقطع مع التجربة الماضية، أي بناها وشعاراتها وأيديولوجياتها.
في هذا الإطار، إن هذا الأمر يفترض أن يتأسس، أولاً، على القطيعة مع التجربة السياسية القائمة على التمييز بين التحرير والحرية، إذ شهدنا خطابات وشعارات فائضة عن قصة التحرير، الذي اقتصر على الصعيد النظري، في حين ندر الحديث عن الحرية، في واقع تجرى فيه عملية مصادرة شاملة لها. وفي وقت يكثر فيه الحديث عن استعادة الأرض في حين لا يجرى أي حديث عن استعادة المواطنة أو يجرى قتل فكرة المواطن الحر والمستقل، وفي حين ثمة إسهاب في الكلام المرسل عن الجماهير بينما يقل الحديث عن الشعب أو يجرى تغييب فكرة الشعب. وبديهي أن هذا التمييز المقصود لا يقتصر على الأنظمة الاستبدادية، والأحزاب الأيديولوجية المتخشّبة، وإنما هو يشمل حركات التحرر الوطني، على نحو ما نعرف عن حركة التحرر الفلسطينية، كما يشمل ذلك مآلات «حزب الله»، الذي تحول إلى مجرد ذراع إقليمية لإيران تشارك في قتل السوريين، بعدما كان هذا الحزب يعد نفسه حركة مقاومة، كما يشمل هذا حركة «حماس» التي تهيمن على مجتمع الفلسطينيين في غزة في شكل أحادي، محاولة فرض أيديولوجيتها عليهم، كأنها وصية عليهم، أو كأنها ولية الله على الأرض، في حين يفترض أن تركز على طابعها كحركة مقاومة.
إن هذا يفترض، أيضاً، القطع مع فكرة العنف، أو فكرة التغيير بالسلاح، وضمن ذلك القطع مع فكرة الكفاح المسلح باعتبارها الطريق الوحيد والحصري للتغيير. واضح أننا نقصد أن هذه الفكرة هي نتاج التجربة الجزائرية ثم الفلسطينية، علماً أن ثمة تجارب عديدة، في الكفاح ضد الاستعمار أو ضد الاستبداد انتهجت الكفاح الشعبي للتغيير السياسي، وتأتي ضمن ذلك تجربة الثورات البريطانية والأميركية وتجربة التخلص من أكبر إمبراطورية استعمارية أي الهند، وتجربة إنهاء النظام العنصري في جنوب أفريقيا، وحتى التجربة الاستقلالية العربية من سورية إلى مصر إلى تونس والمغرب. مشكلة الصراع بالعنف أو بالكفاح المسلح أنه يستبعد الكفاح الشعبي، وتالياً الشعب، وأن عدواه تصيب المجتمع الذي يخضع للاستعمار، بحيث يصبح العنف هو الطريقة الأقرب والأسرع لحل القضايا الخلافية بين الفصائل التي تصارع الاستعمار، ناهيك بأن هذا الشكل غالباً ما يحرف الثورات أو يوظفها في خدمة الدول التي تؤمن الدعم المادي والتسليحي للفصائل. وعلى صعيد إسرائيل، مثلاً، فمن السذاجة بمكان الركون إلى الكفاح المسلح لتحرير فلسطين أو جزء منها، بواقع سيطرة إسرائيل على كل شيء حتى مصادر المياه والطاقة والتموين والمعابر، وبحكم تفوقها العسكري على الدول المجاورة ودعمها من جانب الولايات المتحدة فضلاً عن امتلاكها السلاح النووي، أو «سلاح يوم القيامة» وفق المصطلح الإسرائيلي، وذلك مع الاحترام للتضحيات والبطولات التي يبذلها الفلسطينيون منذ قرن. ويتضح من ذلك أن الكفاح المسلح يستخدم لغايات وظيفية معينة لا علاقة لها بالهدف الأساسي، أو خارج نطاقه. هذا إضافة إلى أن من وظائف الكفاح المسلح التغطية على إخفاقات الأنظمة في مواجهة التحديات التي نجمت عن قيام إسرائيل في المنطقة، وضمنه تفوقها العلمي والتكنولوجي وفي مستوى التطور الاقتصادي وشكل نظامها السياسي القائم على المواطنة والتداول والديمقراطية والانتخابات النسبية.
ثالثاً، هذا يشمل، فوق ما تقدم، القطيعة مع التجربة السابقة، بحيث يتمّ التحول من الأيديولوجيا إلى السياسة، ومن الصراع الهوياتي إلى الصراعات المتعلقة بالحقوق والرقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي.
طبعاً لا أخلص من كل ذلك أن تقييمي للتجربة السياسية العربية في العقود الماضية هو من حصيلة صفرية، إذ هذه التجربة جاءت أصلاً من عدم، وهي لم تستمد من أي تراث سابق (الفترة العثمانية)، أي أنها تجربة حديثة بكل معنى الكلمة، إلا أنه من الخطأ النوم على هذه التجربة، أو عدم نقدها. أي أن احترام هذه التجربة والاستفادة منها يفترضان القطع مع البديهيات التي حكمتها، حتى لا نضيع عقوداً أخرى في جدالات وصراعات تضعنا في الدائرة ذاتها، أو تجعلنا ندور في متاهة لا مخرج منها.
* كاتب فلسطيني.
الحياة

