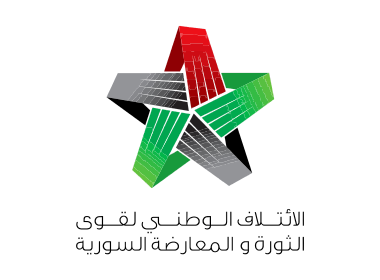مقالات لكتاب سوريين تناولت “موسكو 2”

بهدلة “المعارضة” السورية في موسكو 2/ برهان غليون
فشل، كما كان متوقعا، لقاء موسكو2، فشلاً ذريعا بالنسبة لتوقعات المعارضة والشعب السوري المنكوب، لكنه نجح نجاحاً باهراً بالنسبة لتوقعات النظام وموسكو اللذيْن صاغا بيانات الختام، حسب مطالبهما تماما، وما كانا يحلمان بإظهار ضعف المعارضة وتهلهلها وانقسامها وعدم تجانسها، ليبرروا تمسكهم بنظام القتل والديكتاتورية، كما بدت عليه بالفعل. وليس للمشاركين في لقاء موسكو2، بين ما سميت شخصيات من المعارضة ووفد النظام برئاسة بشار الجعفري الذي لم يتصرف في أي وقت، حتى في جلسات الأمم المتحدة، إلا كشبيح، في هذا الفشل الذريع أي عذر.
فقد قبلوا، أولاً، من دون نقاش، بأن يشاركوا في حوار ليست المعارضة هي التي تقرر وتعين من يمثلها فيه، وإنما طرف آخر. وبالتالي، هو الطرف الذي يحدد نوع العناصر والشخصيات المدعوة. وبالتالي، طبيعة الاجتماع والحوار الذي يمكن أن يُجرى فيه. وهذه إهانة للمعارضة بأكملها، وعار على من قبل به، كائناً من كان هذا الطرف.
وراهنوا ثانياً، من دون وعي، على وساطة طرفٍ ليس لديه أي درجة من الحياد، بل لم يخفِ، لحظةً، دعمه الكامل العسكري والقانوني والسياسي لنظام الأسد، ولا يكف عن تأكيد ذلك، وافتخاره بموقفه الذي يعتبره دعماً للشرعية ضد الإرهاب. وكان قد أعلن، قبل أيام من اللقاء، أنه لا يزال يورد الأسلحة والذخائر للأسد، وسوف يستمر في التزاماته.
جلسوا ثالثاً على طاولة “حوار” مع نظامٍ لا يزال يقتل ويدمر ويهجر ويعذب، ويرفض حتى الإفراج عن معتقليهم، بل يعتقل، في يوم افتتاح الحوار نفسه، أحد أعضاء مكتبهم السياسي، صالح النبواني، من دون أن يكون لديهم ما يعتمدون عليه من قوة سوى سراويلهم، وحاجة موسكو لهم لتأهيل نظامها، بعد أن قطعوا علاقتهم ببقية أطراف المعارضة، وخانوها، وتبرأوا من الكتائب المقاتلة على الأرض، التي لا يوجد من دون ما تمثله من تحد وضغط أي إمكانية لانتزاع شيء من نظام تربى في الجريمة والكذب والخداع. كان من الطبيعي، في ظل ميزان القوى هذا، ألا يظهر الجعفري سوى العجرفة والصلف والسخرية، وأن يرفض استلام أي قائمة بأسماء معتقلين ومخطوفين، كما كان من الطبيعي والمنتظر، في هذا الوضع، أن يقبل ما سميت شخصيات المعارضة الاستمرار في “حوار” هو، في الحقيقة، تسوّل واستجداء، بدل الاحتجاج والانسحاب الفوري ووقف المحادثات.
قبول المشاركين بكل هذه التنازلات ينفي عنهم أي نية حسنة، ويدين كفاءتهم السياسية، ويذكّر السوريين بالطريقة المريرة نفسها التي كان نظام الأسد يعامل بها المعارضة، أو الأطراف الخانعة منها، في العقود الطويلة الماضية، ويظهر أن أكثر المعارضين لم يستيقظوا بعد على الحدث الكبير الذي شكلته الانتفاضة الشعبية، ولا يعيشون فيه، ولا يزالون يتصرفون كما كانوا يفعلون في السابق، يداهنون للقوة، ويحنون ظهورهم لها ويعتبرون النظام صاحب الصولة والجولة، وأنفسهم الضعفاء الأذلاء، مع إضافة أن هذا النظام لم يعد نظام الأسد، وإنما نظام بوتين.
ارتكب المشاركون في لقاء موسكو، بوعي أو من دون وعي، وبصرف النظر عن كونهم شخصياتٍ، أو أحزابا، ثلاث جرائم سياسية، من وجهة نظر الانتفاضة الديمقراطية الوطنية التي ضحى فيها الشعب بأغلى ما يملك، أي بأرواح أبنائه، شباباً وبناتاً، وبحاضره كله، وأهم ما راكمه، خلال قرن من التمدن والتقدم المادي والسياسي والقانوني، ودمرت خلالها أكثر مدنه وبلداته، وتم محو معظم تراثه التاريخي والإنساني، ثلاثة أخطاء سياسية لا تغتفر: القبول بتزوير إرادة المعارضة السورية والشعب الذي يفترض أنها تمثله. المشاركة في تقسيم المعارضة، والدخول في لعبة الأسد لضرب بعضها ببعض، وتمزيقها بين معتدلة ووطنية وداخلية ومتطرفة وعملية وخارجية، وإظهار تهافتها، وعدم وحدتها وانسجامها، وفي النهاية نزع الصدقية عن أطرافها جميعا، وإظهارها على أنها غير ذات كفاءة لممارسة السلطة، أو حتى المشاركة فيها بجدية، أمام الرأي العام السوري والدولي. وهذا كان الهدف الواضح لموسكو من دعوة شخصياتٍ لا علاقة لها بالمعارضة، ولا بالسياسة أصلاً، وزجها بين صفوفها وتتويجها شخصيات سياسية معارضة، واختلاق أحزاب وهمية تمثلها، لاستخدامها ورقة للضغط على المعارضة، أو للتلاعب والوقيعة بين صفوفها، تماماً كما فعلت أجهزة الأمن السورية في عقود طويلة سابقة.
الخطأ السياسي الثالث، إضفاء الشرعية على مسرحية موسكو، لتأهيل النظام بتخليق معارضة له على مقاس قدميه، تقبل به وتتحاور معه، وتراهن على ما تسميه حواراً، وهو ليس أكثر من دورة في الاستذلال، يخضع فيها المعارضون الذين تم انتقاؤهم فرداً فرداً، لوابل من غطرسة بشار الجعفري، وشتائمه وسعاره، لا تختلف كثيراً عن جلسات “الحوار” التي كان ينظمها ضباط الأمن والمخابرات السوريين مع ضحاياهم من المعارضين، في مراكز الأمن والاحتجاز والاختطاف، بهدف التدجين والتهديد والابتزاز، واستخدام ذلك كله جداراً دخانياً، تستمر من ورائه، من دون ضجة أو سؤال أو اعتراض، حرب الإبادة الجماعية والتهجير والاستيطان، وعمليات القتل والذبح وإلقاء البراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية ومدفعية الميدان على رؤوس السوريين.
ليس هناك شيء يمكن أن يبرر لأبطال لقاء موسكو2 خطأهم، حتى لا أقول سقطتهم الكبيرة، لا المشاعر الإنسانية واللهفة على القتلى واليتامى واللاجئين والمحرومين، كما يدعي بعضهم، ولا الدوافع الوطنية والرغبة المشروعة في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، كما يتمنى بعض آخر، هذا إن بقيت هناك دولة ومؤسسات، ولا السعي إلى الشهرة والبروز وتعزيز دور الأحزاب والتشكيلات التي يمثلها المشاركون، وكلها أحزاب وتشكيلات وهيئات كرتونية، وكيانات هوائية، تنقسم بمقدار ما تفكر ولا تفكر إلا لتنقسم، ولا حتى اليأس من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وتهافت أدائه.
ما حصل ويحصل من جرجرة معارضين من مؤتمر إلى آخر، ومن عاصمة إلى أخرى، على طلبٍ، ولخدمة أجندات ليست صادرة عن حوار جدي داخل المعارضة نفسها وعن تفاهمها، هو إهانة للمعارضة بأكملها، وتجريح لصدقيتها، وتعميق للشرخ الذي يفصلها عن القادة والمقاتلين الميدانيين. والنتيجة، كما هو واضح، تفريغ المعارضة السياسية من محتواها، بفصلها عن القوة المقاتلة الرئيسية التي تعمل دفاعاً عن قضيتها، وإفقادها أي وزن في معركة طابعها الرئيسي، منذ أربع سنوات متتالية، المواجهة المسلحة وكسر العظم، من جهة، وترك الكتائب المقاتلة على الأرض، في هذه الحرب الضارية، من دون قيادة سياسية وعنوان وطني موحد، ومن دون أداة لتنسيق العلاقات الدولية. وبالتالي، ضحية لضغوط الأجهزة والأجندات الدولية.
تقع المسؤولية الرئيسية في ذلك، بالتأكيد، على عاتق الائتلاف الذي نجح في انتزاع الحق بتمثيل قوى الثورة والمعارضة، ولم يقم بما يلزم لتجسيده، وتقاعس عن القيام بالدور المطلوب، لتقريب وجهات نظر المعارضة وتوحيد صفوفها، وهو ما حالت دونه العقلية العصبوية الضيقة، الموروثة عن الحقبة السابقة، وفي ما وراء ذلك، خضوع كثيرين من أعضائه، أو ضعفهم أمام ضغوط الدول والحكومات، وتشوش الوعي الوطني، بل تحييده بعد نصف قرن من التعقيم الفكري والاغتيال السياسي والإعدام الأخلاقي لشعب كامل، الشعب السوري. لكن، مهما كان الأمر، لا يكون العمل الوطني، ولا يتحقق، من دون أداة فاعلة ومتسقة وموحدة. وللوصول إلى ذلك، فإن كل الأفراد، المقاتلين والناشطين، مسؤولون، ومن واجبهم الضغط في هذا الاتجاه. وإلا فإن أحداً لن يغير ما في سلوكه، من المسؤولين عن الوضع الراهن، ولن يغير في هذا الوضع، ما لم يغير كل واحد منا، في أي مكان وجد فيه، من سلوكه، ويتغلب على روح الفردية والتسليم بالواقع، وما لم يؤمن بقدرته على المساهمة في التغيير، وبمسؤوليته في إحداثه، بالتعاون مع الآخرين، أي ما لم نقضِ، مرة واحدة وإلى الأبد، على ثقافة العجز والاتكالية واليأس والاستسلام، ورمي المسؤولية على الآخرين.
العربي الجديد
موسكو 2/ سمير العيطة
حلّ موعد ما سُمّي اللقاء التشاوري السوري السوري الثاني في موسكو في لحظة كان واضحاً فيها أنّ الحرب في سوريا مقبلةٌ على التصاعد. فشل الهجومان المضادّان للسلطة وحلفائها في الشمال والجنوب، وخرجت مدينة إدلب عن سيطرتها، ودخلت “داعش” إلى مخيّم اليرموك في قلب دمشق. كذلك بدأت الهِدَن المحليّة، المسمّاة “مصالحات”، تتداعى الواحدة تلو الأخرى، في حين انسدّ أفق هِدَنٍ جديدة، حتّى تلك المتعلّقة بتجميد الصراع في حلب تحت رعاية أمميّة. بالتالي، بات المنطق المهيمن لدى السوريين بأطيافهم كافة أنّها الحرب حتّى النهاية، وأنّها مفروضة علينا، ولكنّ لا بدّ منها. ساعد في ذلك انشغال المنطقة ووسائل إعلامها ب “عاصفة الحزم” على اليمن وصفقة النوويّ الإيرانيّ وتداعياتهما.
كانت الخارجيّة الروسيّة التي وجّهت الدعوات تعرف ذلك جيّداً، وأنّ وفد السلطة السوريّة آتٍ ضمن منطق الحرب حتّى النهاية، مستقوياً فقط بنجاحه في تحويل الصراع إلى ثنائيّة إمّا أنا أو “داعش” و “النصرة”. أمّا المدعوّون، مهما اختلفت مواقفهم ومواقعهم من الصراع، فأغلبهم أتوا ضمن منطق التقدّم ولو خطوات ضئيلة على الصعيد الإنسانيّ أو وقف الحرب، قبل السياسيّ. ذلك تحديداً لخلق الأمل في إمكانيّة التوصّل إلى انطلاق آليّة حلّ سياسيّ. وقد نجحت موسكو هذه المرّة، على عكس المرّة السابقة، في تأمين حضور شخصيّات سياسيّة من الصفّ الأوّل، وكذلك شخصيّات فاعلة في المجتمع المدنيّ. وبالتالي، شكّل لقاء “موسكو 2″ محطّة مميّزة في ما يخصّ إمكانيّة تحقيق حلّ سياسيّ للصراع في سوريا، ومفترق طرق لا بدّ من استخلاص عبره. بل إنّه شكّل بداية تفاوض على نصوص، خلافاً “لموسكو 1″ الذي رُميَت في نهايته وثيقة ما تسمّى “مبادئ موسكو” أمام الإعلام، من دون أن يتمّ نقاش مضمونها.
اقتربت مشاورات “موسكو 2″ من تجربة مفاوضات “جنيف 2″، مع فارقٍ جوهريّ، هو أنّ الحاضرين من طرف “المعارضة” في “جنيف 2″ كانوا يمثّلون مجموعة متشابهة التوجّهات، وجزءاً واحداً من جزءٍ من المعارضة، أي قسمٍ من “الائتلاف” حينذاك. في حين جمع “موسكو 2″ وفداً حكوميّاً متناسقاً، يحتوي رئيساً للوفد وموظّفين آخرين يمرّرون له أوراقاً ولا يتدخّلون في الحوار، مقابل طيف متعدّد التوجّهات من “المعارضات” وأعضاء في “المجتمع المدنيّ”، من الصعب اختيار رئيس وفدٍ لهم، يُقارع وحده رئيس الوفد الحكوميّ.
يُمكن السجال طويلاً حول تركيبة وفد “المعارضة والمجتمع المدنيّ”، وعمّن يمثّلون، وإذا كانوا فعلاً معارضين أم لا؟ ولماذا تمّت دعوة هذه الشخصيّة ورفضت دعوة شخصيّات أخرى؟ ولماذا لم تحضر هذه الشخصيّة المدعوّة؟ وبالطبع يخضع الأمر لاعتبارات ترتبط بالعلاقات الرسميّة بين الحكومة الروسيّة والحكومة الحالية السوريّة ومختلف القوى السياسيّة والمدنيّة السوريّة، إلاّ أنّ مثل هذا السجال غير مفيد. بينما أبرزت شجاعة قرار الحضور من قبل المعارضة رسالتين مهمّتين.
الرسالة الأولى هي أنّ الطرف السياسيّ أو الشخصيّات المعنيّة الحاضرة مستعدّة لحمل هموم كلّ الطيف السوريّ على عكس السلطة القائمة – والتفاعل معها، حتّى لو كانت بعض الأطياف المتواجدة تناوئ مكوّنات أخرى أو تخشى أن ترحل السلطة تخوّفاً من “داعش” وشاكلاتها. الحاضرون اتفقوا جميعهم في النهاية أنّ القتل والدمار يجب أن يتوقّفا. وبات واضحاً في الحقيقة أنّ الواقع السوريّ أضحى شديد التعقيد، والبلاد مقطّعة الأوصال، والقوى المؤثّرة سياسيّاً ومدنيّاً… وعسكريّاً متعدّدة ومختلفة المشارب والتوجّهات. وهذا يفرض التعامل بواقعيّة سياسيّة ومواطنيّة مع هذا الأمر. فلا “معارضة استطنبول”، ولا تلك التي تتمّ محاولة تجميعها في القاهرة، ولا مؤسّسات المجتمع المدنيّ المعروفة، ولا أيّ من قوى ما يسمّى “المكوّنات” السوريّة، يُمكن أن يمثّل وحده من يدّعي تمثيلهم، خاصّة أنّ اللقاء تشاوريّ وليس مفاوضات.
الرسالة المهمّة الأخرى هي التعامل بإيجابيّة مع دعوة روسيا الاتحاديّة، بحكم تصنيفها كحليفة للسلطة القائمة. إذ أنّ هذا العضو الدائم في مجلس الأمن كان له موقف إيجابيّ في تحقيق استقلال سوريا، وعلاقات تاريخيّة وقويّة مع الدولة السوريّة وخاصّة الجيش والجهاز الأمنيّ. وهو يأخذ مخاطرة أمام المجتمع الدوليّ في دعوته لهذا اللقاء وإمكانيّة فشله، أكبر بكثير من تلك الذي يأخذها السياسيّ الذي يقبل الحضور. خاصّة أنّ مسار “الحلّ السياسيّ” عبر جنيف كان معطّلاً تماماً، وأنّه لا يُمكن تحقيق أيّ حلّ سياسيّ تفاوضيّ إذا مانعته روسيا.
جرى اللقاء في مثل تلك الظروف. وبدأ بيومين لم يحضر فيهما وفد السلطة. خصّص اليوم الأوّل للتوافق على جدول أعمال من 5 بنود. لم تكن سوى مواضيع للحوار، ليست فيها تراتبيّة، كما تمّ اقتراحه في اللقاء الماضي بموافقة الوسيط الروسيّ. لكنّ الالتباس كان قائماً حول المقصود في التعبيرين، خاصّة أنّ بعض القوى السياسيّة، بما فيها تلك التي لم تحضر، كانت تصرّ كشرطٍ لمجيئها على وجود جدول أعمال. قليلون كانوا قد قرأوا تجربة مفاوضات “جنيف 2″ حين تلاعب الوفد الحكوميّ بقضيّة تراتبيّة جدول الأعمال، وحرصوا أنّه إذا ما كان هناك تفاوض، فإنّ ترتيب البنود له أهميّة ويجب التوافق عليه مع الوفد المقابل منذ البداية.
في اليوم الثاني، جرى النقاش حول وثيقة مشتركة يقدّمها وفد “المعارضة والمجتمع المدنيّ” إلى الوفد الحكوميّ. وفي الحقيقة تمّ بذل جهود كبيرة من كثيرين للوصول إلى صياغة هذه الوثيقة والتوافق عليها. وتضمّنت هذه الوثيقة مختلف المواضيع المتواجدة في جدول الأعمال، بما يُمكن التوافق عليه. وهي تشكّل إنجازاً حقيقيّاً للقاء تشاوريّ في الظروف أعلاه انطلاقاً من الاختلافات الكبيرة في تركيبة الوفد. وتبرز أكثر واقعيّة من إعلان القاهرة الذي صدر حديثاً. لقد أصرّت الوثيقة على حتميّة الحلّ السياسيّ على أساس بيان جنيف و “مبادئه” كي لا يتمّ التلاعب بمضمونه، وعلى العمل كي يكون التفاوض في “جنيف 3″ المرتقب ناجحاً. كذلك شدّدت على أنّ الجميع شركاء في العمليّة السياسيّة، بما يُعني أنّه ليست “المعارضة” وحدها هي المعنيّة. وانتقلت الوثيقة إلى ضرورة وقف الحرب وأعمال العنف ومواجهة الكارثة الإنسانيّة وإنجاز التغيير الديموقراطيّ، في تلازمٍ بين المستويات الثلاثة كحزمة واحدة. وتصرّ في النهاية على تثبيت آليّات واضحة لإنجاز تلك الخطوات. وهكذا تمّ الاتفاق على أنّ الأكبر سنّاً، وهو رئيس “هيئة التنسيق”، هو الذي سيقرأ الوثيقة المشتركة.
جاء وفد الحكومة في اليوم الثالث، وقرأ ورقة كانت بمجملها أقلّ تشدّداً من سابقتها في “موسكو 1″. ممّا جعل كثيرين يتفاءلون خيراً. ثمّ، بعد عرض الوثيقة المشتركة للمعارضة، جرت نقاشات وعرض وثائق، تهرّب فيها الوفد الحكوميّ من نقاشها، كما خرج بعض المشاركين عن الالتزام بها. لكنّ تصرّفات رئيس الوفد الحكوميّ الفظّة واستخفافه بالحضور أخذت مجمل الأجواء إلى التشنّج. ثمّ تمّ عرض بعض الآليّات العمليّة، في محاولة لتثبيتها. وجرى تسليم أسماء معتقلين ومفقودين عن مناطق عدة في سوريا، مع المطالبة بخلق آليّة مثبتة للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم. احتوت القوائم على حوالى تسعة آلاف اسم موثّق، إضافة إلى حوالى الألف جرى تسليمها في “موسكو1″. بالطبع كان الهدف هو إحراج ممثلي الحكومة، الذي ادّعوا قبيل موسكو 2 أنّه أطلق سراح 683 معتقلاً. احتوت القوائم أسماء تخصّ هدناً/ مصالحات على وشك الانهيار/ مثل حال المعضميّة، بالتحديد لأنّ السلطة لم تفِ بعهدها لإطلاق سراحهم، ومناطق أخرى مثل حيّ الوعر، التي يشكّل فيها إطلاق المعتقلين بنداً أساسيّاً في إمكانيّة عقد هدنة حقيقيّة. كذلك تمّ تسليم رسالة من رفيقة عمر عبد العزيز الخيّر ووالدة ماهر طحّان تطالب فيها بالكشف عن مصيريهما وإطلاق سراحيهما، مع رفاقهم.
من ناحية أخرى، تمّت مطالبة السلطة بوقف القصف على السكّان المدنيين في حلب خلال ستّة أسابيع من طرفٍ واحد كإجراء بناء ثقة، كما كانت قد وعدت بذلك موفد الأمين العام للأمم المتحدة. وكذلك التوقّف عن قصف المعارضة المسلّحة التي ليست على تماس مع الجيش السوريّ وإنّما تحارب “داعش”. هنا أيضاً أتى هذا المطلب لإحراج السلطة حول جديّتها في ما تدّعيه من محاربة الإرهاب. لكنّ ممثلي الحكومة رفضوا تسلّم القوائم والمطالب، وجرى سجال حادّ انتهى بتسليم القوائم للوسيط الروسيّ، ما تمّ تثبيته في مؤتمره الصحافيّ. في نهاية النهار، وعندما بدا واضحاً أنّ الوفد الحكوميّ يعمل على تضييع الوقت من دون الدخول في أيّ موضوعٍ جديّ، أبرز الوفد وثيقة تحت عنوان أنّها نقاطه حول البند الأوّل من جدول الأعمال وهو تقييم الوضع الراهن، إلاّ أنّ مضمون هذه الوثيقة كان بالتحديد يتعلّق بأسس العمليّة السياسيّة، وهو البند الرابع. وقال إنّه لن ينتقل إلى أيّ بندٍ آخر قبل مناقشتها. هنا ارتكبت بعض أطياف “المعارضة والمجتمع المدنيّ” خطأً جوهريّاً بالذهاب طوال الليل في محاولة لدمج هذه الورقة بالوثيقة التي كانت أعدّتها، في حين كانت بعض الأطياف الأخرى تقول بالانسحاب نهائيّاً من اللقاء بسبب تلاعب الوفد الحكوميّ.
في اليوم الرابع والأخير، تمّ تقديم الورقة المُدمَجة. ولم يقبل وفد الحكومة سوى نقاش صفحتها الأولى التي تحتوي فقط بعض التعديلات على ورقته. وضاع نصف النهار الحاسم في نقاشات برز فيها واضحاً أنّ وفد الحكومة متمسّك بورقته ويريد التهرّب من الالتزام بنصّ “وثيقة جنيف 1″ ووضع أسس جديدة يُدعى المجتمع الدوليّ لدعمها تمهيداً لاعتمادها في “جنيف 3″. ثمّ حدثت المفاجأة بعد فترة الغداء بأنّ ثلاثة من وفد “المعارضة” التقوا جانبيّاً مع عضو في الوفد الحكومي وأنتجوا صفحة توافقيّة. وتمّ الدفع عند قراءتها إلى التصفيق، بينما وُجِهَت التحفظّات بأنّها محاولة لعرقلة التوافق والوصول إلى إجراءات بناء الثقة.
ثمّ جاء السفير الروسيّ السابق في دمشق، ليقرأ خطاب وزير الخارجيّة للمجتمعين، على عكس ما جرى في “موسكو 1″. وقد تحدّث عن “الظواهر السلبيّة التي ترفضها أغلبيّة السوريين” مثل “الفساد” وعدم إرساء حكم القانون، وعن دعمه “للمواقف البنّاءة لبعض الفصائل المسلّحة”. وشكّك في أنّ عدد المعتقلين ال683 الذين تمّ إطلاق سراحهم هو أقلّ من ذلك في الحقيقة. بدا ذلك انتقاداً واضحاً للسلطة في سوريا.
كان لقاء اليوم الرابع قد تمّ تمديده، إلاّ أنّه لم يكن قد بقي هناك سوى ساعات ثلاث. هنا أصرّ الوفد الحكوميّ على ألاّ يبحث الصفحة الثانية من الورقة المدمجة، بل مكافحة الإرهاب، بحجّة أنّها البند الثاني في جدول الأعمال، وكما لو أنّ الصفحة الأولى هي تقييم للوضع الراهن. وبدأ بمطالبة “معارضة ومجتمع مدنيّ”، لم يدعم أيٌّ منهم يوماً “داعش” أو “النصرة”، بما يُمكن أن يفعلوه من أجل محاربة الإرهاب. وبعد أكثر من ساعة من المماطلة أعلن أنّه يُعدّ ورقة لنقاشها سيسلّمها بعد قليل. هنا انفجر اللقاء، وأعلن كثيرون فشله، خاصّة أنّ موضوع الإرهاب خلافيّ في ظلّ قصف القوّات الحكوميّة والموالية للمدنيين. وجرت مشادّات وسجالات حادّة. وانتهت الساعتان الأخيرتان بحالة فوضى قدّم خلالها الوفد الحكوميّ ورقته المقترحة حول مكافحة الإرهاب، في حين سارع الكثيرون إلى توقيع وثيقة المعارضة المشتركة كي تكون الوثيقة الوحيدة الملزمة لهم. هنا أعلن الوسيط الروسيّ نهاية اللقاء التشاوريّ الثاني.
خيبة الأمل والمرارة كانت واضحة للجميع، وخاصّة الصحافيين الذين كانوا ينتظرون وفد المعارضة في الفندق، حتّى لدى أولئك الأقلّ مناهضة للسلطة.
برغم خيبة الأمل هذه، وفشل اللقاء، فإنّ هذه التجربة لها إيجابيّات مهمّة إذا ما تمّ استخلاص عبرها. إذ أنّها تطرح بشكلٍ أوضح مدى جديّة الأطراف كافّة للعمل في سبيل حلّ سياسيّ للصراع.
أنتج وفد معارض شديد التباين ورقة تفاوضيّة مشتركة يُمكن أن تكون مقبولة من حيّزٍ واسعٍ من أطياف “المعارضة” في الوقت الراهن، ومن حيّز أوسع من المجتمع المدنيّ. وهذا إنجاز لا يُستهان به. إذ ستكون هذه الوثيقة محور أيّ تباحث يجري حول المشاركة المُقبلة إذا ما قرّرت روسيا أن يكون هناك “موسكو 3″، مقابل ورقة الإرهاب التي وضعها الوفد الحكوميّ. كما قضايا المعتقلين ووقف القصف، ما يعني أنّ تجربة “موسكو 2″ أخذت الأمور إلى مواضيع في منتهى الجديّة، في ما يخصّ سبل الحوار أو التفاوض.
توضح هذه التجربة إذاً أنّ توافق المعارضة والمجتمع المدنيّ ما زال ممكناً، وأنّه يُمكن جمعهما مع الانفتاح على جميع الاتجاهات، بعيداً من الإقصاء ومحاولات الاستئثار أو التلاعب بما يُمكن لوفدٍ مفاوض أن يكون. لكنّ هذا يحتاج إلى آليات وجهد مشترك بين القوى الكبرى، خاصّة روسيا والولايات المتّحدة، وممّا يُعطي إضاءة خاصّة على ما يجري في القاهرة أو استوكهولم أو باريس أو في أمكنة أخرى.
أخيراً، أبرزت التجربة أنّ الوفد الحكوميّ هو الذي أضاع فرصة تاريخيّة، وارتكب الخطأ الأكبر. فكيف تصنع الورقة التي تلاعب لإنتاجها أيّ أملٍ للتقدّم نحو وقف الحرب والعنف ونجدة السوريين، وفي حلّ سياسيّ قريب؟ وكيف له أن ينجح في حلّ سياسيّ مع معارضة أكثر تشدّداً، إذا لم يستطع ذلك مع معارضة توصف ب “الليّنة”، يجمعها على تبايناتها تخوّفها ألاّ يبقى هناك بلد وشعب يتمّ التفاوض بشأنهما، وألاّ تتفاوض السلطة في المحطّة المقبلة سوى مع “داعش” و “النصرة”؟ ولن يكون هناك فرصة أخرى قبل شهور. وقد برز عدم جديّته بالتحديد أمام روسيا المفترض أنّها حليفته، لا أمام الدول التي تناهضه.
السفير
الحرب ضد «داعش» والحل!/ ميشيل كيلو
بعد النص المشؤوم الذي اقره من التقوا في موسكو من المعارضين السوريين وأشباههم، وفيه يتعهد هؤلاء بمساعدة جيش النظام على محاربة «داعش«، يبدو انه صار من الضروري العودة الى بديهيات الصراع الاولى في سورية، التي اكدتها وقائع لا حصر لعددها اهمها الصلة العضوية، الوجودية والمتبادلة، بين النظام والارهاب عموماً، وبينه وبين «داعش« بوجه خاص، الا اذا كان «المعارضون اياهم ينكرون حقيقة ان الاستبداد لم ينتج غير الارهاب، ولم يعد اجواء بلادنا لغير نشوئه وازدهاره، وان النظام الاسدي بالذات استمد مشروعية وجوده منه وامده بالمقابل بمشروعية شعبية انتجها ظلمه وقهره واقصاءه للعباد. امن قبيل المصادفة انه لم يكن في سورية اي تنظيم او تجمع اصولي او ارهابي قبل نظام الاسدين، وانه ليس فيها اليوم، بعد خمسين عاماً من «الحكم العلماني الممانع«، غير تنظيمات وتجمعات الاصوليين، كما يخبرنا بشار الاسد يوميا؟
بعد انهيار الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية، كان الاميركيون يعدون العدة لصراع بديل يخوضه الغرب، قالوا بكل صراحة ان طرفه الآخر سيكون العالم الاسلامي. وقد التقط الاسد الاب هذا الخيط في حينه وشرع يشكل تنظيمات اصولية يستقوي بها على العرب ويبتزهم ويخوفهم بها، تقربه في الوقت نفسه من اميركا، بما سيمسك به من خيوط اصولية وسيجمعه من معلومات عن تنظيماتها، ويحققه من اختراقات داخلها، ويكون في يده من مفاتيح تتصل بنشاطها وتتحكم بجوانب منه، ومن علاقات معها تمكنه في الوقت نفسه من استخدامها لممارسة ضغوط على الغرب، اذا ما قرر التخلي عنه او رفض اعتباره شريكاً له في الحرب ضد الإرهاب. كان الإرهاب والدعم الايراني هما البديل الذي اصطنعه الاسد لاقامة شيء من الحماية الرادعة لنظامه، في ظل نظام دولي جديد تقوده اميركا، ومن يتابع تلك الحقبة سيجد انه استخدم الارهاب في كل مكان الا ضد اسرائيل وايران: اولاهما كي لا يتنكر لما قدمه لها من ضمانات امنية طويلة الاجل، والثانية لانه وضع سوريا تحت تصرفها بعد امتثاله لمخططاتها العربية والتحاقه بها.
اذا كان الاستبداد ينتج الارهاب، ويقوض شروط خلق ونمو القوى الديمقراطية، كما تخبرنا تجربة سوريا خلال نصف القرن الماضي، فانه يكون من الانبطاح المشين امام الارهاب التعهد بدعم جيش النظام في ما يخاله موقعو البيان حربه ضده، ليس فقط لان جماعة «داعش« تلامذة صغار في مدرسة النظام الارهابي، بل كذلك لانه لا مصلحة للاسدية في محاربة جهة ساعدتها على تحويل ثورة من اجل الحرية الى اقتتال مذهبي – طائفي، استماتت كي تفبركها، وسارعت الى اخراجها من السجون بعد اشهر من الثورة، مع انها كانت تعتقل وقائياً كل من تعتقد انه ضدها، بمجرد ان تستشعر خطراً ما في اي مكان، وقد فعلت ما فعلته لاعتقادها الصحيح ان ممثلي هذه الجهة سيشكلون فور خروجهم من السجن تنظيمات مسلحة ستقوض الثورة السلمية والمجتمعية من داخلها، وسترفض ما يحاربه هو: الحرية والنظام الديمقراطي، وستمكنه من تسويق وجودها دولياً باعتبارها بديله الخطير على امن وسلام العالم، والذي يقوم «بمحاربته« بالنيابة عنه. هل يشك احد في أن الارهاب لم يقدم هذه الخدمة الاستراتيجية للنظام، وانها لم تؤثر على – موقف العالم من الصراع الجاري في بلادنا، ومن التفهم المحدود الذي ابداه تجاه الثورة ومطالبها؟ وهل هناك عاقل واحد يصدق ان النظام يحارب الارهاب، وانه رمى ورقته من يده وتخلى عن ايهام العالم بانه بديله الحتمي، وان عليه التمسك به وابقاءه في السلطة كي لا يواجه ما لا تحمد عقباه على يد «داعش«، التي لم يخدم اسلوبها في العنف المفرط وذبح اجانب اتوا لمساعدة الشعب السوري غير تبييض صفحة الوحش الكبير والتستر على جرائمه وتخويف السوريين من بديله، في حال تم اسقاطه؟ هل تمت انجازات النظام و«داعش« المشتركة بمحص المصادفة ام كانت نتاج خطة محكمة وضعها النظام وبقي الجهة التي تحركها وتشرف على تنفيذها، والتي جنت الفائدة المرجوة منها، وهي بقاؤه متسلطاً على سورية رغم ثورتها العارمة ضده، ونجاته من السقوط اسوة بما حدث في تونس ومصر وليبيا والى حد ما اليمن؟
لا أفهم كيف يمكن لمعارض، سواء كان مناضلاً أم شخصاً يتسلى «ثوريا«، ان يفصل النظام عن «داعش« و«داعش« عن النظام، وان يضع احدهما في مواجهة الآخر، بل ويفتعل حرباً بينهما، رغم انه يعرف دور «داعش« في تحرير المناطق المحررة من الجيش الحر، ودورها في قتل خيرة قياداته وكوادره، وتماثلها مع نظام الاسد مذهبياً ودورها في إعادة أعداد من السوريين الى حضن النظام تائبين نادمين، ومواصلة ما كان يمارسه من نهب سورية وتبديد ثرواتها وتدمير حضارتها وشخصيتها التاريخية، واقناع العالم بأنها ليست ناضجة لغير الاستبداد وليست مؤهلة لأي خيار ديمقراطي وانها بلد يستحق ما اخضع له من عبودية، وغير جدير بالحرية كما ظهر خلال «الثورة الارهابية«، لان حريتها ستعني نشوب حرب اهلية لا تبقي ولا تذر، قدمت «داعش عينات ونماذج عنها من خلال عمليات ذبح المسلمين وهم ينطقون بالشهادتين، ناهيك عن تكفير الشعب كله، واخذه الى حال لا يبقى معها شعباً موحداً وقابلاً للحياة، ستزول دولته التي سيستبدلها بـ«الدولة الاسلامية في العراق والشام«، بما تبشر به من عصر جديد لا دول فيه، تحكمه شراذم افاقين لم يجدوا ما يقدمونه لشعب ثار من اجل حريته غير قطع رؤوس بناته وابنائه، فرادى وجماعات.
ليس ما صدر عن موسكو موقفاً ضد الارهاب، لو كان ضده حقاً لما فصله عن النظام واوهمنا بوجود تناقض عدائي بينهما يستدعي الاصطفاف وراء جيش قتل وشرد ودمر وهجر ثلاثة ارباع شعبنا. وهو لن يقربنا من الحل السياسي، ان كان هناك حل كهذا، يؤمن به اليوم، بفضل لقاءات موسكو، المغفلون وحدهم!
المستقبل
حتى ينتهي غياب الغالبية السورية/ ريم تركماني
لم تكن الجولتان الأولى والثانية من لقاء موسكو التشاوري، سوى حلقة في سلسلة من الاجتماعات التي تخص الشأن السوري، وتجري في عواصم مختلفة بما فيها دمشق. سلسلة ستكون طويلة ومتعثرة وقد تبدو غير مترابطة، لكن محصلة مجرياتها ستساهم في خلق واقع سياسي سوري جديد يتم فرضه كإطار للحل السياسي.
في الغالب سيظل هذا الواقع بعيداً من واقع الأحداث في سوريا، وقاصراً عن تقديم إطار لحل مستدام، وخاصة إذا تكرر ما شهدته اجتماعات موسكو وغيرها، من غياب شبه كامل للحراك السياسي والمدني، الذي بدأ في آذار/مارس 2011. وما كانَ لحضور بقية القوى السياسية التي رفضت الدعوة إلى هذه الإجتماعات أن يعوّض هذا الفراغ.
جذر الصراع السوري سياسي بالدرجة الأولى، وإذ عَبر عَن نفسه في بداياته بتظاهرات رفضت القهر السياسي، فإن أربع سنوات ونيف من النشاط يفترض أن تكون قد أفرزت تنظيمات سياسية من حركات وأحزاب جديدة تنبت من قبل الحراك وتعبر عن أهدافه وتضع برامج لتحقيقها وتكون الشريك الأهم في الحل السياسي. لكن المشهد السوري الآن مليء بالتشكيلات العسكرية والمجالس المحلية والتنظيمات المدنية والأهلية والخدمية، وشحيح جداً بالتنظيمات السياسية، خاصة الجديدة منها.
لم يحصل هذا الفراغ بالصدفة، إذ أن أصابع الإتهام توجه بالدرجة الأولى إلى سلطة الاستبداد التي تعادي بطبعها، عبر شتى الوسائل أي نمو لخصمها الأشد: الحركات السياسية المنظمة. فالكثير ممن من الممكن أن يكونوا قيادات لمثل هذا الحراك؛ هم الآن إما شهداء أو معتقلين.
لكن ليس هذا هو السبب الوحيد، وهو لا يبرر غياب نشوء حركات سياسية جديدة حتى في المناطق التي خرجت عن سيطرة السلطة، أو مناطق اللجوء، وهي مناطق تغص بشتى أنواع التنظيمات المدنية والخدمية الجديدة.
حسم الصراع السوري سيكون سياسياً بالدرجة الأولى، هذا شيء كان معلوماً منذ البداية للكثيرين، وحتى التصعيد العسكري كثيراً ما كان يُبرر بأنه مجرد وسيلة ضغط تَجلب السلطة السورية إلى طاولة المفاوضات. لكن هدف المتدخلين الأول، كان ولا يزال: من سيجلس الى طاولة المفاوضات وكيف نتحكم بهم لصالح أجنداتنا؟ ومن هنا كانت الهرولة لتشكيل جسم يحصل على لقب “الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري”، وتهافت الدول على التحكم بهذا المُمَثل الوهمي بأساليب مختلفة، لم تزده إلا انقساماً وبعداً عن الواقع السوري. وتم كبح جماح أي تنظيم سياسي حقيقي ينمو من صلب الحراك. وفي النتيجة تمّ خلق واقع جديد لسان حاله يقول للشباب السوري: ما عليكم سوى التظاهر وسنقوم نحن بتمثيلكم سياسياً. أي تمت معاملتهم كالقطيع الذي لا يحق لأعضائه التفرد بالقول السياسي وإلا كان مصيره العزل. وكانت الرسالة بأن المقاعد السياسية قد تم ملؤها، وما عليكم سوى الاستمرار بفعل شيءٍ ما لتبرير وجودنا، لكن بالتأكيد ليس القيام بأي تشكيلات سياسية لأن هذا “سيشق الصف”. حتى عندما سيطرت العسكرة على الميدان ظلت الرسالة نفسها: ما عليكم سوى أن تقاتلوا وتعرضوا أنفسكم للخطر، وسنقوم نحن بتمثيلكم سياسياً، وبالتأكيد سننعيكم من فنادقنا وعلى أشهر القنوات كأبطال عظام إذا ما استشهدتم.
أما التحالفات السياسية في الداخل السوري وإن كانت أكثر منعة تجاه التدخلات الخارجية، فقد فشلت أيضاً في خلق فضاء يستوعب شباب الحراك الناشئ، وظل جل اعتمادها على أحزاب قديمة، لو كانت نجحت في عملها لما كان الحراك في سوريا قد بدأ أصلاً. ولا تزال واجهة هذه التشكيلات حتى الآن تحتلها الوجوه القديمة نفسها.
الكذبة الأخرى التي سُوقت وأخرجت معظم الفاعلين الجدد من دائرة الفعل، هي كذبة تحريم الحوار وتخوين أي نوع من التواصل مع السلطة السورية، واعتباره عملاً “يعطي الشرعية للنظام” ويدنس من يقوم به. هذا التحريم تم تحديداً من أكثر الجهات والأشخاص إدراكاً أن نهاية المطاف ستكون عبر التفاوض والحوار، بل أن بعضهم كان يخوّن الحوار على الإعلام، ليعود ويتابع قنواته الخاصة بالتواصل مع السلطة. وفقاً لهذا المنطق فإنه من المقبول أن يتم تنظيم حملات لإطلاق سراح المعتقلين، أو رفع الحصار مثلاً، لكن من المحرم أن يتم التواصل مع السلطة من أجل هذه القضايا.
محصلة كذبات مثل احتكار التمثيل السياسي والإبتعاد عن دنس الإجتماعات الدولية وتحريم التواصل مع الخصم، جعلت أربع سنوات ونيف من الجهود الجبارة للحراك المدني والسياسي السوري، وكأنها مجرد “صَبٌّ خارج الصحن”. وفي النتيجة كانت غرف الحوار في جنيف وموسكو خالية من مفاعيل الحراك السوري الحقيقية، خالية من الكثير من الخبرات والقدرات والإنجازات السورية المهمة، غرف تكلم فيها بالشأن الإنساني أقل العارفين به، واشتغل بملف المعتقلين أقل القادرين على حمله، وغاب عنها من هو قادر على وضع الأجندة السورية على الطاولة.
ليس الحراك السوري بخالي الوفاض، فأوساطه مليئة بالتنظيمات المدنية والخبرات والشخصيات الوطنية التي تعمل بإخلاص وصمت، ويعج برغبة كبيرة بالوصول إلى حل يحقق الاستقرار، من دون أن يكون على حساب الحقوق. هنالك مجالس محلية ومبادرات أهلية وروضة من الإعلام الجديد. هناك شبكات وتحالفات مدنية وهيئات تعليمية وإغاثية وغيرها الكثير، وليس كل فاعلي هذا الحراك بالضرورة من يصنف على أنه “جزء من الثورة”، بل أن الواقع السوري الجديد أفرز قوى جديدة تحركت استجابة للحاجة السورية الوطنية دون أن تكترث للاصطفاف السياسي. في هذه الأوساط رجال دولة وسيدات وطن، لن يكون لنا دولة ووطن، إذا لم يكن لأمثالهم قولٌ فاعل في أي اجتماع يخص الشأن السوري. لو كان القول لهؤلاء لما اختاروا أن يكون حل الأزمة السورية رهن اجتماع في موسكو وآخر في اسطنبول. لكن إذا كانت هذه الإجتماعات تجري خارج إرادتنا، فإن مسؤولية وطنية كبيرة أمامهم الآن، بأن لا يدعوا مجريات هذه الإجتماعات دون تأثير ودفع منهم يأخذها بإتجاه المصلحة السورية.
هذه المشاركة يجب أن تكون عبر دورين متكاملين كلاهما يهدف إلى التغيير السياسي لكن بمقاربات مختلفة. الدور السياسي الذي أصبح من الضروري أن تستعد له تنظيمات سياسية حزبية جديدة، ودور مدني لا يصطف خلف السياسي لكنه يؤثرعلى كل الفاعلين ليأخذ فعلهم بإتجاه مصلحة السوريين التي يعبر عنها ويساهم في تحقيقها.
أما التحالفات التي تلزم عندما تحين لحظات الحسم والتفاوض السياسي فهذه يتم تشكيلها بسهولة عندما يكون هنالك قوى سياسية ومدنية حقيقية، تعي مصالحها وتقاطعاتها مع الآخرين. واجب القوى المدنية والسياسية في هذه المرحلة أن تبحث عن هذه التقاطعات وأن تقتحم أي ميدان يتم تقرير مستقبل سوريا فيه، وإلا لاستمرت في الصب خارج الصحن، ولظل الصحن مليئاً بالمعطيات غير السورية.
المدن
فشل السياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط/ عمر كوش
غياب المنهجية
الأزمة السورية
مع النظام ومعارضته
يثير تعامل الساسة الروس مع قضايا وملفات الشرق الأوسط -وخاصة بعد اندلاع الثورات العربية- تساؤلات عديدة حول السياسة الخارجية الروسية في هذه المنطقة، وماهية المحددات والحيثيات التي توجهها، خاصة أن روسيا البوتينية (نسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين) تطمح للعب دور الدولة العظمى، التدخلية، ذات الأذرع الطويلة، والنفوذ الواسع.
كما تطمح لأن تمسك بخيوط جميع الملفات الساخنة، فيما يكشف واقع الحال أنها ليست أهلا لمثل هذه التحديات، ولا تملك ممكنات ومؤهلات القيام بمثل تلك الأدوار، على مختلف المستويات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية، كونها أقرب إلى دولة ريعية، اعتماد اقتصادها الأساسي يقتصر على ما تجنيه من بيع النفط والغاز والأسلحة، فإذا انخفض سعر البترول يترنح اقتصادها وتتراجع القدرات الإنتاجية، الصناعية والزراعية، ولعل أي زائر إلى موسكو سيلاحظ أن أكثر من 99% من السيارات التي تسير في شوارعها غير روسية، مثلها مثل أي عاصمة في دول ما كان يسمى “العالم الثالث”.
غياب المنهجية
تمتد التساؤلات حول السياسة الخارجية الروسية إلى قدرات صانعي هذه السياسة، وخاصة المسؤولين في وزارة الخارجية، التي يقودها منذ عقود عديدة سيرغي لافرورف، ذلك لأنهم أظهروا عدم كفاءة في التعامل مع القضايا والملفات، ولم يخفوا مواقف تبطن العداء والممانعة للتطورات والمتغيرات الجديدة، في المنطقة، وبدت سياسة بلادهم غير مفهومة ومستهجنة من طرف غالبية الشعوب العربية.
ولم تكن مواقفهم مبنية على أسس مؤسسية، لها منهجية أو ضوابط معينة، ذلك لأن محدداتها تمحورت حول مصالح الشركات الروسية أكثر من ارتباطها بمصالح روسيا الوطنية البعيدة المدى، إضافة إلى أنها عكست هواجس من إمكانية امتداد الحراك الشعبي في المنطقة إلى كيانات الاتحاد الروسي ومحيطه الحيوي، وعكست كذلك ردات فعل لما يفرضه الغرب الأوروبي والأطلسي من تحديات على قادة موسكو، لذلك راح ساستها يتحدثون عن مؤامرات أطلسية غربية تقف وراء الثورات والانتفاضات العربية.
وقد برر بعض صناع الساسة الروس إرباكات وإخفاقات سياسة بلادهم الخارجية بالقول إن قيادتها الحاكمة تفضل الاستقرار في المنطقة العربية، والركون إلى الاستثمار الذي تقدمه تحالفاتها وعلاقاتها مع الأنظمة العربية المتقادمة، بالرغم من الإشارات الخجولة إلى مطالب الشعوب المحقة واحتجاجاتها السلمية، فيما يشير واقع الحال إلى رفض روسي تام للانتفاضات والثورات التي عصفت بالأنظمة العربية منذ ديسمبر/كانون الأول 2010، وأفضت إلى تغيير الأنظمة في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن، وما زالت رياحها تعصف بالنظام المستبد في سوريا.
ويلاحظ المتتبع للموقف الروسي حيال ما حدث في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا من ثورة وتغيرات، أن المواقف الروسية ما زالت تستند إلى إرث مرحلة الحرب الباردة، وما يتمخض عنها من ردات فعل ضد المواقف الأوروبية والأطلسية، إلى جانب التخوف مما يمكن أن تقدمه التغييرات الجارية في بعض البلدان العربية من مساحات نفوذ للغرب الأوروبي والأطلسي. لكن ذلك لا يبرر الوقوف ضد مطالب الشعوب العربية وتطلعاتها إلى الحرية والكرامة والديمقراطية، وتحسين أوضاعها وأحوالها المعيشية.
إن ما يهم القادة الروس هي المصالح الاقتصادية، وجردة حسابات الربح والخسارة، فهم يرون أن العقوبات الغربية على إيران جعلتهم يخسرون ما يقارب 13 مليارا من الدولارات، وأنهم خسروا أكثر من أربعة مليارات في ليبيا، كانت مبرمة في عقود معها كثمن أسلحة.
الأزمة السورية
لا شك في أن المصالح الروسية في سوريا كبيرة وهامة، حيث تقدر مبيعات الأسلحة الروسية إلى سوريا بمليارات الدولارات، حيث ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في يناير/كانون الثاني 2012، أن 10% من جميع مبيعات الأسلحة الروسية تذهب إلى سوريا، وتقدر بنحو 1.5 مليار دولار سنويا، بينما يقدر “معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي” الدولي، أن روسيا تزود النظام السوري بـ72% من الأسلحة التي يمتلكها.
وبدهي القول إن الموقف الروسي حيال ما يجري في سوريا منذ أكثر من أربع سنوات، لا علاقة له بالجانب الإنساني أو الأخلاقي، لأن حسابات الساسة حيالها واعتباراتهم لا ترجحها الأيديولوجيا ولا المبادئ. ولم تكن كذلك في أي يوم من الأيام، والأمر نفسه يسري -ولو بدرجات متفاوتة- على مواقف الدول الكبرى والمؤثرة على الساحة الدولية.
ويبدو أن القادة الروس أرادوا أن يتخذوا من الأزمة السورية مثالا لإظهار مدى قوتهم وتأثيرهم في الأزمات الدولية، فأعلنوا عودة اللاعب الروسي من جديد إلى مسرح الشرق الأوسط، خصوصا بعد الثورة الليبية التي أحسوا من خلالها أن الغرب أبعدهم وتجاهلهم، ويريدون من الدول الغربية أن تحسب حسابهم وتشركهم في حل القضايا والأزمات الدولية.
وعلى أساس العودة الروسية المزعومة، راح القادة الروس يتعاملون مع الأزمة السورية بوصفها صراعا دوليا على سوريا، متعدد الأطراف، إقليميا ودوليا، ومختلف المركبات، الداخلية والخارجية. واعتبروا أنه يتوجب عليهم توفير الحماية للنظام، بما يفضي إلى منع محاولة الدول الغربية تجريدهم من أهم القلاع المتبقية لهم في المنطقة.
وعليه، لم يتوقفوا عن توفير الغطاء السياسي للنظام، وعن التعامل مع الأحداث في سوريا من زاوية الصراع الخارجي، وتمادى وزير الخارجية سيرغي لافروف في الحديث عن “الجماعات الإرهابية” و”العصابات المسلحة” و”المؤامرة الخارجية” التي تتعرض لها سوريا، وعن التدخل العسكري الخارجي.
بل راح ينظر إلى الأزمة السورية بوصفها مسألة صراع دولي وإقليمي، تتطلب حضور روسيا القوي، كي تتمكن من سد ساحة الفراغ الحاصل في هذا البلد، بالنظر إلى ما يتمتع به من موقع جيوسياسي هام بالنسبة إلى روسيا في المنطقة، خاصة في ظل معرفته الجيدة بعدم رغبة واستعداد الولايات المتحدة الأميركية للتدخل العسكري المباشر في الشأن السوري، كونها تفضل ترك الوضع السوري يتداعى، في ظل التدخل الإيراني السافر، ولا مانع لديها البتة من أن يصل إلى حالة من التعفن والتفكك والاقتتال العبثي ما بين المتطرفين من الشيعة والسنة.
وحشد الساسة الروس كل طاقاتهم الدبلوماسية والسياسية في الصراع على سوريا، فاستخدموا الفيتو في مجلس الأمن الدولي أربع مرات، بغية منع صدور أي قرار دولي يدعم التغيير في سوريا، واستمروا في تنفيذ صفقات السلاح المبرمة وتوفير الدعم والخبرات والخبراء الأمنيين والعسكريين، الأمر الذي وصل إلى درجة كبيرة من الدعم والإسناد.
وصار التنافس في مجلس الأمن الدولي تعبيرا عن مظهر من مظاهر تسجيل النقاط على الخصوم، وإفشال مشاريعهم، حيث تمكنت الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية من إظهار روسيا والصين بوصفهما البلدين الذين يتحملان وزر إطالة أمد الأزمة في سوريا، وبالتالي مسؤولين أخلاقيا وإنسانيا عن إراقة المزيد من الدماء السورية.
وظهر القادة الروس في موقع من يتصرف بردات الفعل حيال الغرب ومخططاته وطريقة تعامله مع ما يجري في المنطقة العربية. وارتكبوا أخطاء في تقديرهم لحسابات الربح والخسارة الجيوسياسية والاقتصادية، حيث وجدوا أنفسهم خاسرين إستراتيجيا واقتصاديا، بسبب مواقفهم المشككة والمريبة من التحولات التي أحدثتها الثورات العربية في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن، وربطوا ما يجري في سوريا بالتهديد المباشر الذي يأتيهم من نشر رادارات الدرع الصاروخي في تركيا، إضافة إلى خوفهم من خسارة ما يتوفر لأسطولهم البحري في ميناء طرطوس، بوصفه الموقع الإستراتيجي المميز على الشواطئ السورية، الذي يمكنهم من التواجد في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وساد اعتقاد في الأوساط السياسية الروسية، يفيد بأن حمايتهم للنظام السوري ستوفر لهم حضورا قويا في مختلف ملفات الشرق الأوسط، وفي التسويات التي يمكن أن تحصل في المستقبل بخصوص إيران وملفها النووي، بل يمكن أن يشكل سابقة يمكن البناء عليها مع إيران والعراق ولبنان، ضمن سياسة بناء حلف جديد في المنطقة، تكون روسيا محوره الأساس والفاعل.
مع النظام ومعارضته
كان الأجدى لروسيا أن تبحث عن إيجاد فرصة للحيلولة دون دخول الملف السوري إلى حيز التدويل، بل كان يمكنها أن تلعب دورا إيجابيا في الأزمة السورية بالنظر إلى علاقاتها التاريخية مع سوريا، وذلك من خلال الإسهام الفاعل في فتح المجال السياسي الذي أغلقه النظام منذ اليوم الأول للثورة السورية، الأمر الذي فاقم من صلابة جدار الأزمة الوطنية السورية العامة.
وقد استغلت الخارجية الروسية الفراغ السياسي الذي أحدثته الإدارة الأميركية في الملف السوري، وقامت بتحرك شحيح المحصول، تجسد في عقد لقاء تشاوري في موسكو في الفترة بين 26 و29 يناير/كانون الثاني الماضي، بين وفد من النظام وآخر معارض (معارضة من أجل النظام وليست ضده) وانتهى إلى الفشل، ثم كررت المحاولة، وعقدت لقاء موسكو2 التشاوري، في الفترة بين 6 و9 أبريل/نيسان الماضي الذي انتهى أيضا إلى فشل ذريع.
وظهر من لقائي موسكو الفاشلين أن ما بذله الساسة الروس من جهود، وما طرحوه من أفكار لحل الأزمة السورية، لم يرق إلى مصاف مبادرة متكاملة، لها مرجعية وأسس وخطوات محددة، ولم تحظ برعاية دولية من طرف الدول الفاعلة في الملف السوري، لذلك بدا كأنهم يستغلون فراغا سياسيا، ويحاولون إشغاله في ظل غياب الفاعلين الآخرين في الملف السوري عن القيام بأي فعل لحل عقد أزمته الكارثية.
وأظهرت حصيلة التحرك الروسي، أن الساسة الروس يهمهم التركيز على الشكل دون الاهتمام بمضمون ما يطرحونه، لذلك انفض لقاءا موسكو التشاوريان دون أن ينتج عنهما شيء يذكر من التوافق أو الاتفاق على خطوات، أو حتى مقدمات حل سياسي للأزمة السورية التي باتت تشكل كارثة مدمرة، وغير مسبوقة في التاريخ السوري، قديمه وحديثه.
وأثار فشل لقائي موسكو التشاوريين الذين رعتهما الخارجية الروسية، تساؤلات عن دورها وكفاءتها حيال الأزمة السورية، وامتد الأمر إلى سياستها في منطقة الشرق الأوسط. وتحدثت أوساط مقربة من الكرملين عن عدم رضا لدى دوائر صناع القرار تجاه تحركات الخارجية وسياستها.
ولم يمض سوى وقت قصير على التفكير بأسباب فشل لقائي موسكو التشاوريين، حتى تلقت السياسة الخارجية الروسية صفعة، جسدها التصويت بالإجماع في مجلس الأمن على القرار 2216، الذي يطالب الحوثيين بوقف استخدام العنف وسحب قواتهم من صنعاء وبقية المناطق، ويفرض حظرا للسلاح على الحوثيين وعلى قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله الصالح، الأمر الذي عنى هزيمة للسياسة الروسية الداعمة للحوثيين الذين يعتبرون الذراع التدخلية الإيرانية في اليمن.
الجزيرة نت