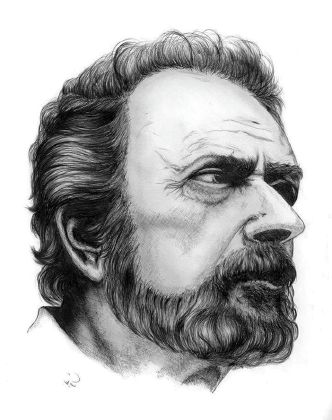الأدب والمنفى: هل نحن أمام مهجريّة جديدة؟/ عبد اللطيف الوراري

في كتابه «تمثيلات المثقّف»، يصف إدوارد سعيد المنفى بأنّه «من أكثر المصائر إثارة للحزن» مستخلِصاً أنّ النفي والطرد في التاريخ القديم كان عقاباً مروِّعاً للشخص المنفيّ، لأنه كان يعني سنواتٍ من التشرُّد الذي لا هدف له، بعيداً عن العائلة والأمكنة التي ألفها المرء، مثلما يعني نوعاً من النبذ وعدم الشعور بالاستقرار في المكان. وقد قارن سعيد بين المنفى في الأزمنة ما قبل الحديثة والمنفى في العصر الحديث، فوجد أنّ دلالة المنفى في الحاضر تحوّلت من تجربة شخصية إلى تجربة جماعية أصابت شعوباً وأعراقاً بكاملها تعرّضت للاقتلاع والتشريد والنفي القسري، ممثّلاً على ذلك بهجرة الفلسطينيين والأرمن. وقد وصل إلينا أنّ هناك مجتمعات شتاتٍ كاملة تبتعد، طوْعاً أو كرْهاً، عن أوطانها الأصلية، وتتخلّى عن لغتها الأم، وثقافاتها الأصلية لتصبح جزءاً من المجتمعات والثقافات الجديدة التي هاجرت إليها، مثل الأفارقة والمغاربيّين في فرنسا، والهنود والباكستانيين في بريطانيا. وقد أنتج هؤلاء آداباً مُهجّنة، وهم يتّخذون من الفرنسية أو الإنكليزية لغةً للتعبير والتواصل، كاشفةً عن حاجيات الذات الجديدة، وجُروحٍ في الوعي والكينونة، وتشظّياتٍ في الهويّة. وبسبب من ظروف الحرب في لبنان، أو الاضطهاد السياسي والحصار في العراق، أو بسبب الحرب في السنوات التي أعقبت احتلاله، والقمع في أكثر من بلدٍ عربيّ، شهدت العقود الثلاثة الأخيرة هجرة كبيرة لمجموعاتٍ بشريّة كبيرة، وفيهم المثقّفون والأدباء، إلى البلدان الأجنبية التي استضافتهم كيدٍ عاملة أو طلبة علْمٍ أو لاجئين سياسيّين. أليس صحيحاً أن النظرة إلى المنفى في الأدب، بل وفي الدين، تخفي ما هو رهيب وفظيع في حقيقته، وهو أنّ المنفى أمرٌ دنيويٌّ على نحو لا براء منه، وتاريخي بصورة لا تطاق، وأنه من فعل البشر بحق سواهم من البشر؟
بوسعنا أن ننظر إلى المنفى، كما يرى منظّرو ما بعد الدراسات الاستعمارية، في اتّجاهين مختلفين: منفىً مفروض وآخر اختياري، مُميِّزين بين المنفى والاغتراب، فالأول مفروض، حيث لا يستطيع المنفيُّ العودة إلى وطنه الأم حتى لو رغب في ذلك، أما الثاني فهو اختياري نشأ نتيجة رغبة المرء في مغادرة وطنه، لأي سبب من الأسباب. ومن الصّعْب اليوم أنْ نضع تخطيطاً لمعنى المنفى ضمن هذه الظروف المعقَّدة من عمليات النزوح والشتات والاغتراب والاقتلاع والتشريد والنفي من جهة، ومن مسارات الرحيل الطوعي أو الهجرة بحثًاً عن الحرية أو الرغبة في الرقيّ بأوضاع المعيش من جهة ثانية. ولذلك، يحتفظ معنى المنفى بطبيعته المعقّدة، ويستوعب معنيي الهجرة والاغتراب معاً: الهجرة حين يجري السعي إلى المنفى وتفضيل الإقامة فيه اختياريّاً ـ خارج الوطن، والاغتراب حين يُنظر إليه بوصفه حالة من الشعور بالعزلة والإبعاد اضطراريّاً ـ داخل الوطن وخارجه. وبالنتيجة، من الصعب أيضاً أن نميّز بين الثلاثة، لأنّ هذا التمييز ليس دقيقاً كما يجب؛ فثمة تداخلٌ ومساحاتٌ رماديّةٌ تصل ما بين المنفى والاغتراب، ثمّ بين ذينك وبين الهجرة.
وفي هذه الحالات جميعها، يمثّل المنفى واقعاً انتقاليّاً يتمُّ بالقوّة أو بالفعل، عندما يعني الانتقال من الأليف والمعلوم إلى الغريب والمجهول، ويعني مواجهة الكائن الإنساني لمصيره في حضرة رعب الوجود وقسريّته، وبالتالي ننتقل في الحديث عن المنفى من كونه واقعاً مستجدّاً إلى كونه تجربة إشكالية تقذف بالذّات المنفية في أتون أسئلة المصير والهويّة الملغزة. للمنفى، إذن، أسماء كثيرة ووجهان، داخليّ وخارجيّ. داخلي هو غُرْبَة المرء عن مجتمعه وثقافته بسبب سلطةٍ من السّلط، فيصير داخل الوطن تعريفاً حادّاً للمنفى. وخارجيّ هو انفصال المرء عن مكانه الأول وعن جغرافيته العاطفية وعن فضائه المرجعي. وإذا كان الأوّل يجد متنفس مدلولاته في الاغتراب بما هو شرخ في كينونة الذات، فإنّ الثاني يستتبع واقع الهجرة إلى المكان الغريب، حيث الانقطاع عن الفضاء المرجعيّ يولِّد لدى الذات الفردية رقْصاً على الأجناب بين الـ»هنا» والـ»هناك».
وليس هناك أقوى من الأدب للتعبير عن هذه التجربة، حيث تبرز لنا الطبيعة الغنيّة والمركَّبة لأدب المنفى عبر الموتيفات التي تلتمع في ذاكرته، وتتكرر في نصوصه الشعرية والسردية على السواء.
2
عبر التاريخ الثقافي، كان هناك دائماً حيّزٌ محفوظ لأدب المنفى بتعبيراته المتنوعة والنوعيّة، من عصر إلى آخر، ومن تجربة إلى أخرى، ذاتية وجمعيّة. فأدب المنفى قديم في الآداب الإنسانية، ويتجلّى حضوره في ثيمات الاستبعاد والخروج والهجرة القسريّة، ويتّخذ من لحظة النفي علامةً فاصلةً في تاريخ الفرد والجماعة، باعتبارها لحظة انتقالٍ نفسي ـ زمنيّ تتمّ من وإلى المكان المهجور إليه، ومن ثمّة تنطوي على شرخ في سيرة الفرد مثلما في تاريخ الجماعة. وهذه اللحظة الانتقاليّة، بكلّ تجلّياتها وأشواقها، كانت في معظمها تستدعي سؤال الكينونة ومعنى الوجود، في سياقِ لا يشي إلّا بالاغتراب والحنين والشعور بالانفصال. لكنّ حضوره اليوم طاغٍ، باعتبار «عبور الحدود» الرمزيّة والمادّية الذي يتصاعد، وتجارب الهجرات الآلام والمصائر المجهولة التي تترتّب عنه هجرةً أو نفيًا أو لجوءاً، حتّى أصبح تيمة غالبة، في سياق عصْرٍ متحوِّل، قياميّ.
ولم يسلم الأدب العربي، عبر تاريخه الطويل، من تجربة المنفى الأدبي؛ فقد شعر الكثير من شعرائه وكتّابه بطعم الاغتراب والبعد عن الوطن، واشتاقوا إلى الأمكنة التي هجروها، لسبب قاهرٍ على الأرجح. تجسّدت معاناة هذه التجربة في صيغٍ كتابيّة متنوّعة، بدءا من طلليّات الشاعر الجاهلي، ومروراً بكتّاب وشعراء ذاقوا النفي حنظلاً وكتبوا عنه، ولعلّ أشهر هؤلاء أبو حيان التوحيدي ودعبل بن علي الخزاعي وأبو فراس الحمداني والمتنبي وأبو تمام وابن عبد السلام الخشني وابن زيدون والمعتمد بن عباد، إلى أحمد شوقي وسامي البارودي وعلال الفاسي وطه حسين وتوفيق الحكيم في العصر الحديث. لكن يبقى المهجر اللبناني إلى أمريكا ـ أو «الأندلس الجديدة» بتعبيرهم، في الربع الأوّل من القرن العشرين، هو الأبرز في تاريخ الأدب العربي.
من مهجرٍ إلى آخر، كان الكُتّاب العرب يكابدُون مختلفَ حالاتِ النفْي، القسرية منها والاختيارية. والاغترابُ عن الوطن لا يعدو كونه إحدى هذه الحالات، بل ربّما صحّ القول إنه في الغالب أهون هذه الحالات، أي أخفّها وطأةً. وبسبب من الأوضاع المعقّدة التي تعيشها مجتمعاتنا العربية، والتحدّيات المصيرية التي تواجهها في الداخل والخارج، تعددت وتنوّعت مفاهيم النفي والمنفى لدى المثقّف العربي، الذي يجد نفسه حائراً بين الشكوى من المنفى وبين التغني به، متنازَعاً بين منافيه الداخلية ومنافيه الخارجية. وقد شاع الكلامُ كثيراً على المنفى ومفاهيمه في الأدب العربي الحديث، وصار واحداً من أبرز موضوعاته. ولم يدخل مصطلح أدب المنفى تاريخ الأدب العالمي إلّا في ثلاثينيات القرن العشرين.
لكن أدب المنفى اليوم يُثير إشكالَيْن:
أوّلاً، أنّه ليس نوْعاً أدبيّاً بالمعنى الدقيق، بقدر ما هو أدبٌ موضوعاتيّ يلازمه حدثٌ مهمٌّ ألا وهو النفي، سواء كان إجباريّاً أو اختياريّاً. ويغطّي أدب المنفى كل الأجناس الأدبية المعروفة من شعر ورواية وقصة قصيرة وملحمة ومسرحية، وأحيانًا يتجاوز المتعارف عليه من الأنواع الأدبية الرفيعة، ليُقدَّم في شكل يوميات أو شهادات أو سير ذاتية وغيريّة.
وثانياً، أنّ مفهومه مُلْتبس وفضفاض وغير قارّ، يختفي سرعان ما يظهر مجدّداً في حُلّة مغايرة تتلوّن بألوان العصر وظلاله السياسية والسوسيو ـ الثقافية، وتبعاً للسياق التاريخي والمعرفي الذي ظهر أو أُنْتِج فيه.
بغضّ النظر عن المُسمّيات التي أطلقها دارسو أدب المهجر الجديد، ورفض بعضهم لمُسمّى «أدب المهجر» بسبب من تغيُّر الحساسيّات ورؤى الكتابة، وتغيُّر الظروف الراهنة عن الظروف التي رافقت ولادة أدب المهجر، مٌفضّلين عنه مُسمّى «أدب الاغتراب» أو «المنفى»، إلّا أنَّنا لا نجد ضيراً في أن نأخذ بمصطلح «أدب المهجر»، لأنّه يتّسع لأدب المنفى، ويشتمل حتّى على معاني الغربة والنفي والحنين إلى الوطن والاغتراب بالمعنى الوجودي، وهي المعاني التي ظلّت ملازمة له، والموتيفات التي وسمته كظاهرةٍ أدبيّةٍ خلال النصف الأول من القرن الماضي وما بعده بتأويلات جديدة. وإذا كانت كلُّ هجرةٍ، بمعنى من المعاني، نَفْياً، فإنَّه ليس بالضرورة كلُّ نفْيٍ هجرَةً، فلكم عاش المرء منفاه، وذاق ويلاته وهو في وطنه حيٌّ يُرْزق.. ثم ليس كلُّ من عاش المنفى، خارجيّاً أو داخليّاً، كتب أدباً منفيّاً. إنّ مفهوم المنفى نفسه تغيَّر، وتغيّرت الشروط المستجيبة له.
لقد تغيّر»أدب المهجر» العربي، وتجدّدت ظاهرة المهجريّة بصورة لافتة، وتعدّدت المَهاجر، بدايةً من الربع الأخير من القرن العشرين. ولقد ترتّب عن هذه الأوضاع المستجدّة ما نلمسه من ثراءٍ نوعيّ وكمّي في الحالات والمآلات التي استقرّت عليها وضعيّة المهجر الجديدة، وهي تتدرّج من سكون اللحظة وحيادها إلى المأساوية المكثّفة، مروراً بأشكالٍ من التغرُّب ونبرة الاحتجاج والإحساس اللذوعي بسؤال الوجود والكينونة لم يكن يعرفها ويرقى إليها وعي المهجريّين الأُول. وفي خضمّ ذلك، انخرط المئات من الأدباء في الكتابة باللغة العربية أو باللُّغات الأجنبية، وقد امتزجت في كتاباتهم هموم أوطانهم في الواقع الذي يحيونه في الدول المضيفة، وتوحي تجاربهم في الغربة بذكريات طفولتهم ونشأتهم الأولى، وهو أهمّ ما يشكّل أدبهم ومفهومهم للكتابة والتخييل، مستثمرين الهجرة كأفق للكتابة وعاملين في أفق «الهوية المفتوحة»، وجدلية «الأنا» و»الآخر» غير القابلة للانفصام.
وفي هذا السياق، من المهجريّين من بقي مندمجاً في حركة الثقافة العربية في الداخل، ومستكملاً عناصرها بوجودهم الشعري على مستوى النصوص والمشروعات الشعرية أو الحضور الثقافي، ومنهم من ظلّ تابعاً للمراكز الثقافية الكبرى، وهم بذلك يُكرّسون مركزيّة المركز الثقافي وينتفعون منه أيضاً، وهم نفَرٌ غير قليل. لقد بدت المهجرية الجديدة كأنّها «تبدأ من الانقطاع التامّ عن أيِّ ماضٍ وارث للمكان الجديد، سواء ماضيها الشخصي والثقافي، أي كينونتها هناك في الداخل، والانتماء إلى مشروع ثقافي أوسع هو مشروع الحداثة العربية» على حدّ تعبير حاتم الصكر.
القدس العربي