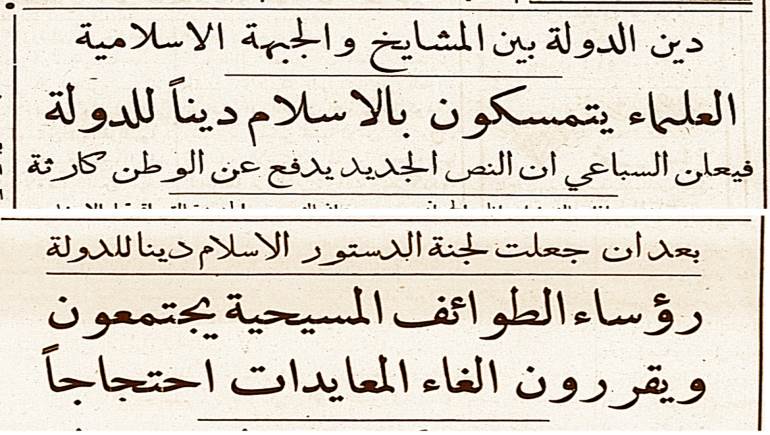السؤال العقيم: لماذا لم تنتج الانتفاضات فكراً جديداً؟/ وسام سعادة

يتثاءب المثقف تلو المثقف: لماذا لم ينتج الربيع العربي فكراً جديداً، لماذا لم تنتج الثورة، في مصر وسوريا تحديداً، فكراً جديداً؟
يتثاءب المثقف لأنّه يدرك، ولو كابر على ذلك ما كابر، أنّ فكرته عن «الفكر الجديد» المشتهى لا تمت بذي صلة إلى أدنى شروط استحقاق الفكر الجديد، وهو أنْ لا يُطلب طلباً لجُدّة، بل أن ينتج ما يجعله جديداً، ولو كان بالتحيز لفكرة قديمة، غابرة، بل سحيقة، على أخرى. فالمهم «أشكلة المسائل»، وفي السياسة، «أشكلة المسائل» لا تعني أبداً افتعال «الجديد» طول الوقت، بل ان تغذية المقاربة السياسية لتوالي الأحداث الراهنة، وأنماط التأثير والتأثر فيها، بمعين الفكر السياسي، والفلسفة السياسية منه بامتياز، رهن التنبه، على طريقة ليو شتراوس، كم أنّ الفلسفة السياسية القديمة ذات راهنية، وكم أنّ تاريخ الفلسفة السياسية لعبة مرايا تاريخية.
ليس المطلوب أبداً أن تنتج فكراً سياسياً «جديداً». تنتجه جديداً فقط حين لا يكون هذا طلبك. طبعاً ثمة شروط أخرى للجديد.
افتعال الجديد طول الوقت، أو افتعال الإحتدام بسبب عدم مجيء «الجديد المنتظر» إلى الموعد: شكلان من «التفكير» الذي لا يريد التفكير بنفسه، التفكير العقيم، شكلان من التفكير المنقطع عن تراث الفلسفة السياسية، قديمها وحديثها.
بل ان المضمر في هذا السؤال التبرّمي، التشاؤمي، العبثي، عن الفكر الذي لم تنتجه الانتفاضات، هو الاستخفاف بالسياسة لصالح الثقافة، وبالقانون لصالح الأخلاق، ثم الاستخفاف بالثقافة والأخلاق، لصالح الافتئات على.. الغيب!
يجري في باحة هذا المضمر الظنّ بالفكر، على أنّه مبضع عليه أن يغرس أكثر فأكثر للنفاذ إلى عصب المشكلة، كما لو كانت المشكلة، مدفونة، جوفية، تنتظر أن يصل اليها تنقيب المنقب الذي يتعقّب الورم، في حمأة ربيع.
والمضمر هنا الإفتراض بأنّ المشكلة التي اجتازها كل مجتمع عربي منذ 2011 إلى اليوم، سواء في البلدان التي حلت بها الانتفاضات أو في البلدان المجاورة، ليست مشكلة «عادية»، التحدي فيها هو توفير مسندين، اجتماعي من جهة ودستوري من جهة أخرى، لكل طرح سياسي إصلاحي تحويليّ للمسارات. بل إنها، مشكلة «فوق عادية»، قائمة في بنية تحت البنية التحية، في استحالة ثقافية دفينة، في برمجة ثقافية دينية، بل ربما في برمجة غيبية، أو عرقية، أو غيبية عرقية مشتركة، تحكم على كل اصلاح بالبوار، وكل تجديد بالضمور، وأنه كان يمكن فقط تجاوز ذلك، لو كتبت لعبقريات ما، أن تغتنم فرص الانتفاضات الشعبية، لطرق أم المسائل: «الغيب» الذي ينوّم ذهننا مغناطيسياً.
من هنا الشكوى بأن الثورات لم تنتج فكراً جديداً (وهو على الأغلب جديد مزعوم لنفس الابتذال القائل بأن «المشكلة في الاسلام»)، أي فكراً مجتراً معلوكاًً جديداً، ضد الغيب والغيبية، التي أدمنت أجيال من المثقفين، من أيام شبلي الشميل وفرح انطون إلى اليوم، هجاءهما بمقاصد ومعاجم مختلفة، بلا طائل.
لم تفكر الثورات التأسيسية للحداثة السياسية جدياً بأنها تؤسس للجديد، بالعكس. كانت فكرتها عن الجديد كفكرة «المجدّد» في التراث الفقهي عندنا في مطرح ما. فكما أنّ الفقيه المجدّد هو من يجدّد القطيعة النقلية والعقلية مع البدع، ويحيي علوم الدين، فإنً المجدّد التنويريّ أو الثائر، يحيي «عقلاً اغريقياً – رومانياً» ما، عقل ظلّت أحداث الثورة الفرنسية مثلاً وشعاراتها وألقابها تحيل اليه، بأشكال هزلية أحياناً. طبعاً، عقل الثورة نفسه «الاحيائي» للعقل القديم الاغريقي الروماني، ضد عقل «النظام القديم» ما قبل الثورة، كان أيضاً في مقام آخر، عقل «تأسيس من عدم»: يخترع إلهاً اصطناعياً يسميّه الشعب، وينقل بالتالي صلاحية التأسيس من عدم من الإله الخالق المتعالي، إلى الإله الخالق نفسه بنفسه، والمحايث، أي الشعب. في مقام ثالث، كانت الثورة الفرنسية، إلى جانب نزعتيها الاحيائية للعقل الفلسفي القديم، والقطيعية مع النظام القديم الملكي – الأرستوقراطي – الإكليروسي، ثورة متممة لمآلات النظام القديم نفسه، تجد بذورها في ما صنعه لويس الرابع عشر نفسه من نقلة نوعية باتجاه الدولة الأمة، الدولة المركزية، الدولة التي هي تتماهى مع مليكها بموجب معادلة «الحكم المطلق»، لا يصير مليكها سوى رمز لآلة حكم متعالية تتجاوزه، ويمكن أن تطيح برأس حفيده لاحقاً. نحن هنا أمام أبعاد ثلاثة: واحد احيائي، الثاني قطيعي، الثالثي استمراري. الجديد الذي جاءت به الثورة الفرنسية فكرياً، ما كان ليولد لو طرحنا الاحيائية جانباً، أو الاستمرارية مع ما بدأه لويس الرابع عشر جانباً، لو كنا اكتفينا بثقافة القطيعة لما كانت في الأصل قطيعة. المثال سيكون مسنداً أكثر لو تذكرنا الإحيائية الانجيلية الطافحة في الثورتين الانكليزية والأمريكية. أما الثورة الروسية فإنّ احالات اللاعبين فيها إلى أحداث ورموز وشخصيات ومصطلحات الثورة الفرنسية تشهد على نزعة احيائية – تغرّبية لا مثيل لها.
لا يعني كل ما سلف أنّ المجال الذي فتحته الانتفاضات الشعبية العربية أحسن اغتنامه فكرياً، لكن اغتنامه في الفكر السياسي ينبغي تحديده كنطاق مستقل تماماً عن التثاؤب المتعلّق بـ»اللماذية العبثية»، «لماذا لم تنتج الثورات فكراً جديداً».
النشاطية الفكرية يتحسن مستواها كلما كانت هذه الانتفاضات الشعبية، والنخب المنخرطة فيها، تنحو إلى تلبيس المقاربات السياسية، عمقاً اجتماعياً غير مفتعل، ومختلف عن البلادة الذهنية الماركسوية (الطبقات الخبط لصق) أو عن تفسير كل شيء بثنائية مدينة ريف، ناهيك عن البلادة الذهنية التسخيفية لمفهوم العصبية عند ابن خلدون لتفسير وتبرير أي شيء. وكلما كانت المقاربات السياسية، المعمقة اجتماعياً، توضع في اطار دستوري، اطار يبتعد هنا أيضاً عن البلادات الذهنية، سواء تلك التي ترى إلى الدساتير كمجرّد نصوص انشائية ينبغي ان لا تعيرها بالاً حركة الجماهير، أو التي ترى إلى الدساتير كلحظات قدسية تستلزم سلطة تأسيسية تقطع مع كل قديم، وتنطلق من الصفر. هذا الصفر الدستوري المطلق يُعدِم كل فكر دستوري. التصرّف كما لو ان التاريخ الدستوري لبلدان الشرق العربي غير موجود قبل الثورات، يصب في خانة ابعادها عن «دسترة» نظرتها لذاتها، ولمسارها بعد ذلك. هذا بدوره كان فاتحة التلهي بشعوذات من قبيل «الشرعية الثورية» أو من قبيل التفكير بأنّ الشرعية هي شيء يقبض عليه المرء ويحافظ عليه كما هو، لا يقل ولا ينقص.
أمامنا أربع سنوات بأرشيف متفاوت وثري جداً من الجيئة والذهاب بين الطروح السياسية والأبعاد الاجتماعية والمآلات الدستورية. أي فكر سياسي عربي جدي عليه أن ينطلق من هذا التراكم. أي تباك على عدم «ظهور فكر جديد» بعد الثورات، هو تثاؤب يحتج على التثاؤب، فيمضي من غفلة إلى غفلة.
٭ كاتب لبناني
القدس العربي