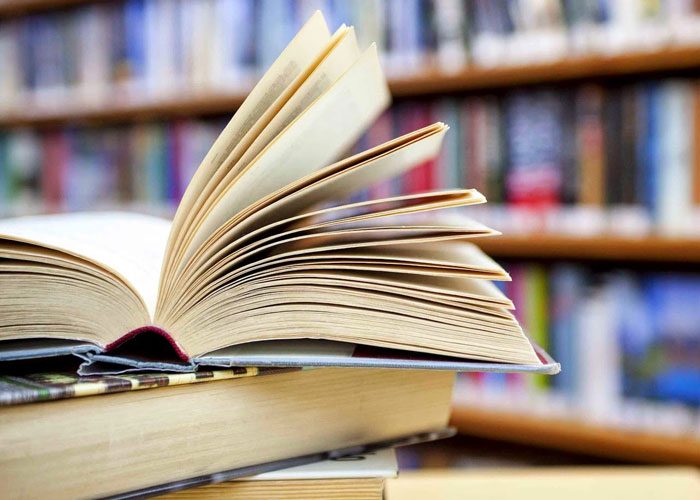من رواية “مولانا” لإبراهيم عيسى إلى الحركات الدينية في إيران
مسالك السلطة في إفساد الفقيه وأخلاق العامة
هذه الرواية تنتمي الى مرصد رقابي ونقدي واعتراضي، عريق في مشهدنا الثقافي والسياسي والاجتماعي، الذي يدخل فيه الدين، كمجال عام أو عمومي، دخولاً بنيوياً، يتأثر ويؤثر في السلب والإيجاب معاً.. أي أنه يتاثر إذا ما استقوت عليه السلطة لتستقوي به، ويؤثر، باستقوائه أو استيلائه على السلطة، ليبدأ من هناك، في مواجهة تحديات، تجعل الإيجابية، في أدائه صفة معقدة أو عابرة، تختزن تحت قشرتها سلبية مدمرة ـ أي ان هناك إشكالية مركبة، تظهر عندما يستدعي وضع السلطة واستمرارها أن تنتج الدين على قياسها، أو يستدعي الدين، اي رجال الدين، او الاسلام السياسي، الحامل لمشروعات السلطة أو الخادم، أن ينتج الدين والدولة على قياس غاياته الدنيوية، المغلفة بدعاوى أخروية .
إذن فهذه الرواية موصولة بماض قريب، أو ماضٍ مصري عريق وقريب، وله أشباهه العربية والإسلامية، غير انه دخل في طور تغيير، قد يكتمل وقد لا يكتمل .. ملخصه ان رجل الدين، العالم أو المتعولم، كان أداة السلطة المدني أو العسكري الملتبس بالعلماني والديني معاً .. فأصبح صاحب السلطة والأمر والنهي، وراعي أنظمة المصالح والعلائق.. أو شريكاً غالباً فيها من خلال انخراطه في مؤسسات السلطة أو هوامشها الاجتماعية أو وصايته عليها.. أو من خلال انتمائه الى منظومة أفكارها وقيمها، الحائرة بين الديني والمدني، والذاهبة الى الديني بمعناه الفقهي المخفف من الروح والرغبة في حراسة الفضاء المعرفي بالأسئلة، من دون المدني الذي ليس نفياً للديني بالضرورة .. تحت ضغط محمولها الإيديولوجي، وفقرها البرنامجي. وعليه فإننا نقرأ في هذه الرواية مسألة دينية في الذاكرة، في الماضي، الذي يبدو أننا سوف نستقبله، بتعقيد وتحديات وأسئلة وانكشافات، سياسية وإدارية وفكرية مختلفة، هذه المرة، وأعمق بكثير مما سمعنا ورأينا حتى الآن .
وإذا كانت المدرسة الروائية (الإقتصادية) اي التي تقتصد في رسم مشهدها الشخصي، اي عدد وحجم شخوصها العادية والمحورية، ووقائعها والظلال النفسية للحدث، وتتخفف من المجال الجغرافي والتاريخ على مقادير مختلفة من التجريد، إلا في حدود إسناد الواقعة وطرح الإشكاليات في تعقيداتها .. إذا كانت هذه المدرسة هي الأصعب، والتي يقل الإلتزام بها، كما هي عند ابراهيم اصلان أو همنغواي في الشيخ والبحر مثلاً، وكافكا وغيرهم .. فإن المدرسة الأخرى، أي التوسعية، أو الفضفاضة، والتي تجمع بين التاريخ والواقع والفرد واجتماعه، والواقعة واللوحة، والسرد والشعر، والموسوعية، أي الجمع بين حقول معرفية مختلفة، في نص سردي واحد (علم نفس واجتماع وأنثروبولوجيا وتاريخ واقتصاد وفنون تشكيلية وأساطير وألسنية وفلسفة الخ..) هذه المدرسة هي الأكثر شيوعاً، ورغم أنها تتحدى المبدع الحقيقي بالنجاح الذي يصبح مع الاستفاضة أشد صعوبة وخطورة ووعورة، فإنها تغري غير المبدعين بتغطية ضعف الرؤية والرواية، بحجم المرويات والتشعبات والصفحات ( ماركيز، سرفانتس، عبد الرحمن منيف ونجيب محفوظ في الثلاثية خاصة..الخ) .
هذه الرواية التي بين يدينا تنتمي الى المدرسة الثانية، على أهلية إبداعية لدى كاتبها ليست قليلة، بل عالية وعالية جداً مع إطلالة شبه تخصصية على حقول علمية عديدة. ولكن نزعة تقريرية، سببها تشعب وتركيب تجربته الثقافية والاجتماعية ومعلوماته الدينية، جذبته، حتى كادت الرواية أن تكون عدة روايات في واحدة، ما جعل النسيان، أو عدم القدرة على الجمع، يتحكم بالقارئ العادي أو ما فوق العادي (غير المتخصص) وقد كان بإمكان الكاتب الموسوعي، أن يختزل، من دون أن يخل بعمارة روايته، التي كاد العلم الديني، علم الفرق وعلم الكلام والفقه، يفصلها عن سياقها، ليذهب وحده مقارباً البحث الأكاديمي أو الدعاوى (الدفاع عن مذهب ما) . وقد كان معذوراً راوينا الجريء، وفي لحظة اسلاموية تستدعي المكاشفة وطرح الشكوك، عندما سلك سلوكاً فضائحياً، في متابعة السلوكيات المتناقضة لرجل الدين المسلم وأطلّ على المسيحي .. هذه المفارقة المتأتية من الخطاب التقوي العالي النبرة والتطهري لدى رجل الدين، والذي يرقى كلاماً الى ملائكية مستحيلة، لأنها خلاف الطبيعة، لتكون المبالغة في ادعاء التقوى والموعظة مقدمة وسبباً إضافياً للمخالفة الفاجرة .. أي للفسق المبالغ فيه، والذي يتعدى حاجات الجسد والدنيا الطبيعية، أو المفهومة، الى ممارسات تقارب الجريمة الوحشية، لأنها تفتك بالآخر وجماليات الكون والحب، وتفتك بمنظومة القيم الدينية والاجتماعية المسلَّمة والسالمة انسانياً، أي التي لا تجرم الآخر لأنه مختلف، ولا تعتبر الإختلاف مبرراً للإلغاء والعنف المباشر أو غير المباشر .
وإذا كان أحد مقاييس نجاح الرواية، هو انتشارها، فقد كان نجاح هذه الرواية قليل النظائر وهو متأت من تكتيكها الروائي قطعاً، ومن جمال سرديتها وموسوعيتها وسلاستها وحماوتها والمفارقات التي كشفتها .. ولكنه متأت أيضاً، من رغبة القارئ في أن يتبرع له كاتب قادر، بكتابة كاشفة للتناقضات والمفارقات والموبقات التي يكتشفها يومياً، ولا يستطيع أن يعبر عنها عجزاً أو خوفاً . فكفاه المؤلف المؤونة .. تماماً كما فعل نجيب محفوظ في ميرامار وثرثرة فوق النيل، وفعل يوسف ادريس في النداهة، وفعل ألبرتو مورافيا في الإحتقار والعصيان وامرأة من روما .. وفعل نابوكوف في لوليتا، والطيب الصالح في عرس الزين وموسم الهجرة .. وأنا هنا أجدني، ولأني معني جداً بما لامسه الكاتب .. أن أقدم له شكري لأنه كتب نيابة عني، ما كان هناك مانع لدي من كتابته لأن الرواية الحقيقية في رأيي هي التي تقوم على اختراق التابوات الدينية .. وعلى المكاشفات الجنسية أو الكشف الطبيعي لمقام الجنس بحسيته الحقيقية وروحيته أيضاً، كروايتنا هذه .
وإذا كان لا بد من تركيز الكلام على معادلة السلطة ورجل الدين باعتبارها معادلة خالدة وباهظة .. فإني اسجل مستجداً آخر في هذا السياق يشبه المستجد في انقلاب السلطة وتحول رجال الدين من تابع الى صانع سلطة .. وهو تحول رجل الدين، الذي يملك لساناً مطواعاً، يؤهله الى أن يكون داعية، ونجم شباك، ومعبوداً للجماهير، من كونه عاشقاً للظهور في وسائل غيره (سلطان المال او الحكم عموماً) عبر سلطة الإعلام، ليصبح مالكاً لفضائيات لا تعد ولا تحصى، وصار بإمكانه أن يحصل على تمويل سهل لفضائيته الخاصة التي لا تلبث أن تتحول، بسرعة، الى مصدر سلطة وثروة إضافية وخيالية، وهذه من مصائب الدين ومصائبنا، نحن المتضررَيْنِ الأَوّلَيْنِ من دين السلطة وسلطة الدين، وربما كنا الوحيديْن في هذا الضرر.
إن إشكالية رجل الدين والسلطة تملأ الرواية، أو هي أساسها وعلة كتابتها، لأن كل المفارقات تتشعب منها وتعود اليها، ما قد يعني أن الدولة أو السياسة أو السلطة، هي القضية الأولى، أو القصة الأولى، وإذا أراد الدين أو رجل الدين أن يسلم من أمراضها وتبعاتها، فما عليه إلا أن يدقق في الفارق المنهجي بين الدولة والدين، أو بين الديني والثقافي وبين السياسي .. من حيث أننا أمام حقول معرفية وعملية متعددة، إذا أدركنا اختلافها واحتضناه، يمكن أن نوفر لها فرصة التكامل الوظيفي (النهضوي والأخلاقي والإنساني) وإذا اعتبرناهما متناقضين، أو متطابقين غير مختلفين، فإننا نضعهما في مجال التقابل الحاد والتآكل .. ليكون الإنسان هو المأكول في المحصلة.
حسناً وإذا كان الحاكم في هذه الرواية هو حسني مبارك، فالإدانة سهلة، وقد لا تحتاج الى دليل، لأنه مستبد وفاسد من دون ايديولوجيا تغطيه، لا فلسفية ولا دينية. هو حاكم بالغريزة وبالصدفة فقط .. فكيف إذا كان الحاكم دينياً،أو إيديولوجياً، مثل محمد مرسي؟.. من دون أن يسرق بالضرورة، لأن الفساد والاستبداد هو نهج أكثر مما هو شخص، وقد يكون الشخص طيباً وزاهداً، ولكن نظامه ينظم تهريب الثروة القومية والعدالة والحرية بالعصبية الحزبية والجهالة وعدم المشاركة، هذا السؤال، يصاحبنا ويلازمنا أينما ذهبنا، ومن الرياض الى طهران الى دمشق، الى بغداد، وغيرها، وغيرها، ولكن الإجابة لا تأتي من الفكرة، بل من العصبية، التي تجعل رذائل الحاكم الديني أو المذهبي فضائل. وتجعل فضائل الحاكم المدني، إن تورط في فضيلة ما، رذائل .. وقد تتسامح معه وتقدسه وتقدس مدنساته، إذا استغل علمانيته في حفظ الطائفة ولو على حسابها.
في النهاية، تلك كانت قراءتي على أساس أني قارئ يتوقف على ما يقرأ من دون أن يصل الى حد اللياقة اللازمة لكتابة دراسة نقدية للرواية، أي رواية، في موضوعها وتكنيكها الروائي وسرديتها وعمقها وتركيبها الدرامي وهويتها في نوعها الابداعي . غير أني ومن موقعي الوظيفي (المعرفي الديني)، ومن موقع اهتمامي بالإشكاليات التي يحفل بها المشهد الديني السياسي وموقع الفقه والفقهاء فيه، قد أجد نفسي معنياً وقادراً على تقديم شهادة عن تاريخ ما للخلط العشوائي بين الدين والسياسة متواصلاً مع مستوى من مستويات السرد الذي أعتنى به الراوي والرواية بشكل مميز ومقصود. ولأني موصول بتجربة خاصة مبكرة مع الشأن الإيراني، ولأن إيران تشتغل وتشغلنا باندفاعها المحكوم بمصالحها الى إعادة إنتاج السياسة الدينية أو الدين السياسي وفرضه عبر النفوذ في اتجاهات عدة، فإني أركز شهادتي على تجربة إيرانية سابقة (قاجارية) وإن كانت المخاطر المحتملة للمسلك الإيراني الراهن أشد خطورة .
بعد الصفويين تولى السلطة في إيران (نادر شاه أفشار) 1736م وقد وصل من القوة والاهتمام بالتعدد والتنوع، ان يعمل على تأسيس اتحاد بين أهل الاديان، وطلب من العلماء ان يترجموا له متون الكتب الدينية السماوية من أجل ان يؤلف بنفسه متنا جامعا يستبعد الاختلافات ويرسخ الوحدة.
وبعد الدولة “الأفشارية”، تكونت الدولة (الزندية) نسبة الى مؤسسها “كريم خان زند” المتحدر من أصول “لارية” غرب إيران يقال بأنها في أصولها البعيدة (كردية) حكم إيران من 1752 الى 1779 وقد وصل الحكم في عهده من القوة والمصداقية الى حد ان كتب القنصل الفرنسي في بغداد رسالة الى باريس 1763 قال فيها: “يبدو ان البلاد قد استعادت عظمتها وازدهارها تحت زعامة كريم خان ذي التصرفات الحكيمة والنفوذ الشخصي فقد حل الأمان محل الفوضى المريعة والاحتراب المستمر.. واستؤنفت التجارة” وقد كان كريم خان كريما في دعمه للعلم والثقافة. بعد هاتين الدولتين جاء دور (القاجاريين) وهم يتحدرون من أصول مغولية (يسترعي الانتباه ان الأسرة الفارسية الوحيدة التي حكمت إيران هي أسرة بهلوي. رضا خان وولده محمد رضا من ثلاثينات القرن الماضي الى آخر السبعينات) وسنة 1786 وبعد معارك عدة أصبحت طهران عاصمة محمد خان القاجاري لتستمر الأسرة في حكمها الى سنة 1923م.
لقد التفت القاجاريون الى ان قوة الدولتين (الأفشارية والزندية) لم تنفعهما في إطالة عمرهما، فعمدوا الى خلط الدين بالسياسة -ما كان أهم مصادر قوة الدولة الصفوية وتسلطها على المجال الديني واستلحاقه- ضمانا لاستمرارهم، من دون ان يكون لديهم اي رصيد علمي كما كان للصفويين، فضاعت السياسة في الدين وضاع الدين في السياسة، عندما رأى (فتح علي شاه) 1834 ان كمال روحانيته وسياسته يحتاج الى المظهر، فأطلق لحيته التي أفرطت في طولها، واحتذى حذاء مخصوصا بأقدام العلماء، وأظهر الاحترام لأهل العلم، ما ادى الى كثرة العمائم وتزايدها السريع، حتى لم تعد قرية من قرى إيران، فضلا عن المدن والقصبات، الا وفيها عدد كبير من المشتغلين بالعلم الديني.
وتردت الاوضاع في إيران بسبب هذا الخلط والتخليط، وفقد الشعب صوابه بفضل حكامه، عندما رأى المفاسد تعم، وتقصر السياسة المخلوطة بالدين والدين المخلوط بالسياسة، عن منعها او الحد منها، في وقت بلغ فيه اهتمام أوروبا بمصالحها في إيران أوجه، وأخذت الأفكار الاصلاحية تراود الناس بمختلف الصور والألوان، وقد اتفق ذلك مع عودة البعثة الهندسية الايرانية الاولى من أوروبا عام 1815 وأخذ العائدون يقارنون بين المشهد في بلادهم وبين المشهد الغربي، وجاهروا بنبذ الأفكار السائدة وتوكيد دور العقل والعلوم الحديثة، وأخذوا بطرح الاسئلة على رجال الدين، في حين كان هؤلاء مشغولين بالإجابة عن اسئلة السلطان حول كيفية نكاح أهل الجنة وحكم الزواج بأكثر من أربع نساء فيها! ولم يكن رجال الدين مؤهلين للإجابة عن الاسئلة الجديدة، خاصة وان كثرتهم الكاثرة لم تعتمر العمامة ومسوح الدين طموحا الى العلم بل طمعا بالمعيشة السهلة، ما دفع بعض الغيارى الى التفكير بوضع حد لهذه الفوضى، وتمييز رجل الدين الحقيقي عن غيره لحفظ عقائد الناس واستعادة من فر من الهياكل الجوفاء، ومن المرتزقة محترفي الضحك على الذقون، وتأمين العيش الرغد من دون عمل، وتسخير البسطاء من المؤمنين واستلابهم بإيمانهم وسلبهم.. واستفحل أمر رجال الدين فأصبحوا هم الحاكمين والسلطات العليا تتبعهم ولا تخالف أوامرهم، وعلى سبيل المثال كان الشيخ “محمد باقر الشفتي” الأصفهاني يقيم الحد الشرعي والقصاص من جلد وقتل ورجم، وحده، لانه كان يرى نفسه حاكما مبسوط اليد ونائبا للإمام يجب عليه تطبيق الاحكام الشرعية.. وقد خصص مقبرة لدفن ضحاياه الذين بلغ عددهم مئة.
ولقد اضطر السلطان لأخذ إجازة من الشيخ “أبي القاسم القسي” لإصدار الاحكام وتولي شؤون الرعية نيابة عن الحاكم الحقيقي، اي الشيخ المذكور، وضاق السلطان بذلك ذرعا، ولكن لم يكن بإمكانه ان يفعل شيئا، بعدما تظاهر بالورع والتقوى وتشبه بالعلماء الذين استفحل أمرهم وأصبحت عودتهم الى نصاب السلطنة صعبة، في هذه الأثناء وصل الى إيران “الشيخ أحمد بن زين الدين الاحسائي” (1752 1825م) المولود في قرية المطيرف (الأحساء) وهو مؤسس “الفرقة الشيخية” التي ما زالت ناشطة حتى الآن في إيران والخليج، بشقيها الكرماني والتبريزي، والتي يعتبرها بعض معاصري نشأتها الحاضنة للفرقة “البابية”.
كما يعتبر البعض ان “البابية” التي تطورت الى “البهائية” احدى الفرق المتفرعة من الشيخية، وقد كان مؤسس البابية “ميرزا علي محمد الشيرازي” تلميذا مقربا للسيد “كاظم الرشتي” خليفة الأحسائي على الشيخية.
لقد وصل الشيخ الاحسائي الى إيران عام 1806م مسبوقا بسمعة علمية ساهم فيها رجال البلاط، فدعاه السلطان الى العاصمة، واستقبله في طهران مع رئيس وزرائه والوزراء والأعيان والأمراء وعدد وفير من الناس والعلماء، وأنزله منزل الكرامة، حتى ان الشاه رأى في منامه بعد زلزال وقع في طهران، قائلا يقول: لو لم يكن جناب الشيخ أحمد في هذه المدينة لهلك أهلها بالزلازل في ساعة واحدة” “وأشاع السلطان خبر المنام في القصر والمصر، متذرعا به وبغيره من المسالك، للتمهيد للانتقام من اتساع نفوذ رجال الدين وعددهم وانحسار نسبة معارفهم.. وهكذا ارتفعت مكانة الأحسائي على جميع العلماء، مما أوغر صدورهم… واستغل السلطان كون الشيخ غريبا لا يطمع بزعامة دائمة في إيران، فأخذ يوعز الى حاشيته بتقديم نوع من الاسئلة الى الشيخ ليجيب عنها بصراحة مكشوفة ومختلفة عن طريقة العلماء الآخرين، أسهم ذلك في إضعاف مكانة علماء إيران فاطمأن السلطان الى نجاحه، وأخذ يكيد للاحسائي، فانصرف عنه وكأنه لم يره ولم يسمع به، فغادر الشيخ إيران مصحوبا بحكم بكفره صدر عن عدد من علمائها.
ان ذلك يذكرنا بالملك الساساني “قباذ” الذي أفسح في المجال واسعا “لمزدك” والمزدكية فدك صروح رجال الدين، وثنى بمزدك وأتباعه، كما استفاد الشاه عباس الصفوي من الصوفيين وقربهم حتى أصبحوا قوام ملكه، ثم ضربهم وسلّط عليهم أهل الظاهر.. ولكن القاجاريين زادوا مع الشيخ الاحسائي ان جعلوه يعتد بعلمه ورأيه الى حد إحداثه بلبلة في تاريخ الشيعة، ما زالت آثارها ممتدة حتى الآن، وان كان المروي عنه أنه في أخريات حياته أعاد النظر وعاد الى حالة من الاعتدال.
هذا من الذاكرة، اما الآن المشهد الاسلامي عموما، والشيعي منه خصوصا، اكثر تعقيدا، وهو مشهد أسهمت في رسم ملامحه الثورة والدولة الاسلامية في إيران، والصحوة التي أعقبتها، الى غير ذلك من الأسباب التي تتصل بتجربة التحديث والدولة الوطنية في العالمين العربي والاسلامي، وما شجعت عليه تلك الصحوة من مماهاة السياسة بالدين والدين بالسياسة، بما اقتضى ذلك من توسيع مساحة المقدس الديني بالإضافة العشوائية اليه، حتى أصبحنا وكأننا أمام عملية انتاج جديدة للدين الموازي للدين، بما يفاقم ذلك من عصبيات تزين لأهلها ان يتجاوزوا الأصول المنهجية في تحصيل وتعميم المعرفة الدينية، في الفقه والعقيدة خصوصا، حيث يغلب المزاج الشخصي او الفئوي على حركة الفقر والاستنباط، مصحوبا بميل العصبيات المتعددة الى التمايز في ما بينها، ما يعبر عن نفسه بمسالك الغلو… وهكذا تصبح “الاحلام” والروايات الضعيفة او المرسلة، سندا ومصدرا، تماما كما هو عن الشيخية، سابقا ولاحقا، ويتسرب الغلو من أهل البيت(ع) الى شيوخ الطريقة او الفرقة، مشوبا بغنوصية تقترب من التصوف والفلسفة ولكنها لا تدخل فيهما احتياطا من ان تستقر على منهج علمي محدد يتيح الجدل معها إبراما ونقضا.
ربما كانت مقتضيات التحديث او الشروع فيه على النسق الغربي في أوائل القرن التاسع عشر (فترة البعثات الى أوروبا) تستدعي إحداث خلخلة في بنيان الاجتماع الاسلامي وفكره، تمت عبر الشيخية والبابية والبهائية والقاديانية وغيرها، وفي لحظة تنشيط للماسونية والصهيونية معا، مستفيدة من ميل الحاكم الى الاستفادة من العدد الكبير من رجال الدين (مصر وإيران) من دون ان يكونوا مؤهلين فعلا للتعامل المنهجي مع تحديات الحداثة، ما جعلهم ذريعة سياسية ضُربت عندما تحولت الى عائق تحديثي (ثانية تجربة محمد علي باشا مع علماء الأزهر اضافة الى التجربة القاجارية) فهل ان مقتضيات العولمة وما بعد الحداثة تستدعي الآن نهجا وسلوكا مماثلا؟
خلال ثلاثين عاما مضت، تعاظم نمو الحوزات الدينية في أقطار العالم الاسلامي كافة… وفي إيران لم تبق مدينة خالية من حوزة دينية او اكثر، وبعض هذه الحوزات حقق نسبة من الاستقلال عن حوزة قم.. وقد امتدت الحوزات الى القصبات والقرى، هذه الحالة من التوسع المفتوح على الزيادة المتسارعة جعل الحوزات ميدانا نموذجيا للتنافس السياسي، وجعل كل الأطراف السياسية تبدي مزيدا من الحرص على دعم الحوزات وطلب رضاها وولائها، وأصبحت الدول عامة، والدولة الايرانية خاصة، شريكا أساسيا في تمويل هذه الحوزات ورعايتها.
ان إيران تدفع سنويا بـ850 ألف عنصر جديد الى سوق العمل من دون ان تكون الفرص المتوفرة او المحتملة وافية بالجزء اليسير من الحاجة، ما جعل البطالة حالة مستشرية، وأسهم في اتساع مساحة الإقبال على طلب العلوم الدينية، لتمتلئ مستويات الدراسة الحوزوية بفيض من الطلاب.
يبلغ عدد الطلاب المتابعين لدروس المرجع (الشيخ وحيد خراساني) في مرحلة الابحاث المعمقة (الخارج) ألف طالب.. ما جعل بعضهم يتساءل عن عدد المجتهدين المحتمل ان يرسو عليه هذا العدد.. لتكون الاجابة بأنهم لا يتجاوزون العشرة، لان الكثرة ليست محكومة بالمعايير العلمية والمؤهلات، وربما كانت محكومة بالحاجة السياسية اكثر من غيرها، الى ذلك فان العلم لا يستأثر بجهد ووقت واهتمام الطلبة، بقدر ما تستأثر السياسة اليومية. في حين ان الطلاب في قم وغيرها من الحوزات الفرعية، كان عددهم قبل الثورة والدولة أقل، اما المجتهدون او المؤهلون للاجتهاد فكان عددهم أكثر ونسبتهم أعلى.
والسؤال المر:
أمن الضروري ان يكون الانسان عالما حتى يحتل موقعا علميا؟ وهل من الضروري ان يكون مجتهدا ليحرز لقبا عاليا؟ وطالما ان السياسي هو السائد بمعناه العصبي والدعاوي، فلا داعي للعلم أصلا.. وتتحول الحوزات الى مدارس (كادر) والى معسكرات يتعلم فيها المتدربون (الفك والتركيب) لنخوض المعارك بالكم لا بالنوع… ونعيد تأسيس التخلف على بوابة العولمة لنكون لقمة سائغة!!
والسؤال الأهم والأصعب .. ألا يسهم اختزال الإسلام في الخصوصيات المذاهبية ومراكمتها الدائمة والعشوائية بناء على حاجة السياسي أو السلطان، واختزال المنظومة الفكرية واللاهوتية في الفقه كعلم ظاهر يضعف دائماً أمام ترغيب السلطة وترهيبها، فيتيح لها مسوّغاتها الاستبدادية بعيداً عن الفضاء الروحي والإنساني والأخلاقي الذي يقوم مقام الغاية الحصرية للرسالة (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ألا يسهم ذلك كله في تمكين الحاكم وتسليطه على الفقيه الذي يُسْتَضْعف فيُسْتَتْبع فيذعن ويستقيل من الإعتراض والإرشاد؟
هاني فحص
المستقبل