وداعا أيها الشاعر العظيم: ملف صفحات سورية عن رحيل الشاعر أنسي الحاج
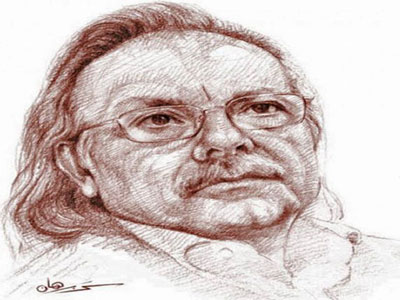
رحيل الشاعر اللبناني أنسي الحاج عن 77 عاماً
بيروت – “الحياة”
“لن أكون بينكم لأن ريشةً من عصفور في اللطيف الربيع ستكلّل رأسي وشجر البرد سيكويني وامرأة باقية بعيداً ستبكيني وبكاؤها كحياتي جميل…”، هذه العبارات ربما تكفي للتعريف بالشاعر والكاتب اللبناني الكبير أنسي الحاج (77 عاماً).
رحل الحاج وهو من شعر بأنه يكتب “من وراء الكتابة كصوت من ينطق من وراء الموت”، وها هو الآن يطوف بين الغيوم، جامعاً الكلمات معاً، الشعر والنثر معاً، كما كان ينشد، فهو من كتب “في كل مرة رميت نفسي من أعلى الجبل ليبتلعني الوادي، كانت الغيوم الوسيطة تستلقيني”.. فها هي الآن تضمه بين ذراعيها.
بدأ العمل في الصحافة في العام 1956 في جريدة “الحياة”، ثم في “النهار” مسؤولاً عن القسم الثقافي، ابتداء من 9 آذار 1956، العدد 6209. وتولى كذلك مسؤوليات تحريرية عديدة في “النهار” وأصبح رئيس تحريرها منذ العام 1992 إلى أيلول 2003.
وساهم الحاج في العام 1957 إلى جانب الشاعرين يوسف الخال وأدونيس في تأسيس مجلة “شعر” وهو يعتبر أحد رواد قصيدة النثر في الشعر العربي المعاصر.
في العام 1960 ظهرت مجموعته الشعرية الأولى، “لن” وكانت حداً فاصلاً في تاريخ الشعر العربي المعاصر، وفي العام 1963 صدرت مجموعة “الرأس المقطوع”، في العام 1965 صدرت مجموعة “ماضي الأيام الآتية” ومن ثم “ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة” في العام 1970، و”الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع” عام 1975، وفي العام 1983 أعاد طبع كتابيه الأولين: “لن” و”الرأس المقطوع”، ومن بعدها في العام 1994 كتب ديوان “الوليمة”.
كما للحاج كتاب مقالات في 3 أجزاء هو “كلمات كلمات كلمات”، وكتاب في التأمل الفلسفي والوجداني هو “خواتم” في جزئين، ومجموعة مؤلفات لم تنشر بعد، و”خواتم” الجزء الثالث قيد الإعداد.
ترجمت للراحل عدد من قصائده الى الفرنسية والانكليزية، واستوحى بعض المسرحيين قصائد له فأخرجوها منهم ريمون جبارة، كما استوحى بعض الموسيقيين قصائد له في أعمال موسيقية. وأيضا ً عدد من الرسامين اللبنانيين والعرب كرفيق شرف، منير نجم، جان خليفة، وضاح فارس وغيرهم اقترنت رسومهم بقصائد له.
تميّز الشاعر الكبير بعمله مع الأخوين رحباني، العام 1963، على اثر مقال كتبه عن فيروز، رافضاً مبدأ المقارنة بين صوتها وبين أصوات مطربات أخريات، معتبراً أن في صوت فيروز، “شيئاً أكثر” كما سمّاه، هو العامل الغامض الذي لا يستطيع أحد تفسيره، كما يظل كل “شيء أكثر” في الخليقة يحيّر العقل والتحليل.
والراحل، من بلدة قيتولي، قضاء جزين، جنوب لبنان. ولد في بيروت في 27 من تموز 1937. تلقى علومه في مدرسة الليسيه الفرنسية ثم في معهد الحكمة في بيروت. بدأ ينشر وهو على مقاعد الدراسة، مقالات وأبحاثاً وقصصاً قصيرة في مختلف المجلاّت الأدبية في منتصف الخمسينات، وكان على اهتمام خاص بالموسيقيين الكلاسيكيين.
رحيل الشاعر الأنقى أنسي الحاج
رحل الشاعر الأنقى أنسي الحاج، واحد من الكبار الذين أسسوا قصيدة النثر العربية. هو الذي آثر العزلة والوحدة في منزله وحتى في مكتبه، ونأى بعيداً عن المهرجانات والاحتفالات والمناسبات والعلاقات الاجتماعية، استطاع أن يؤثر بشعره المسافر عبر الصحف والكتب، ثم عبر وسائل التواصل الجديدة، إلى كل العالم، فكان له مريدون في لبنان والعالم العربي، يتابعون قصائده وكتاباته وأنفاسه بلهفة…
كانت قصائده المبكرة، التي نشرت في “لن”، تنذر بولادة شاعر متميز وغريب و”شيطان”، يشاغب على الشعر الموزون، بجملة شعرية متشظية ونزقة وجارحة ومتفاعلة مع حس حداثي جديد، قصيدة ولدت مع اختمار الحداثة وتفتح ما بعدها،فكان الشاعر العربي الجديد بامتياز. الفرق بين أنسي الحاج وشعراء مجلة “شعر”، أنه بدأ تجربته الشعرية بقصيدة النثر بخلاف سواه. لذا قال عنه أدونيس “هو الأنقى بيننا”. وكان الأنقى أيضاً بتعففه وابتعاده عن البطولات الشعرية وعن الاستعراض، وعن استثمار كونه شاعراً كبيراً، فلم يجنِ من شهرته مالاً ولا جاهاً، لكنه ولد شاعراً متميزاً لم يستطع شعراء شباب عرب بعده أن يكونوا مثله أو بمستوى ما قدمه في تجربته الشعرية الشبابية. واستمر أنسي الحاج شاعراً متميزاً وحاضراً وفاعلاً بقوة.
هنا نبذة مفصلة:
أنسي الحاج
– مواليد قيتولي 27 تموز 1937.
– والده لويس الحاج (1907 – 1995) رئيس التحرير السابق لصحيفة “النهار”
– والدته: ماري عقل (توفيت حين كان في السابعة) فتزوج والده مرة ثانية من أليس حنا نمور.
– تزوج عام 1957 من ليلى ضو ورزقا ندى ولويس.
– تلقى دروسه في مدرسة الحكمة والليسيه الفرنسية.
– بدأ يكتب وينشر مقالات وقصصاً قصيرة وهو على مقاعد الدراسة.
– عام 1956، وكان يعمل في جريدة “الحياة”، كتب مقالة في الصفحة الثقافية عن الأدب العربي، أثار النقمة والغضب عليه من رجال الدين واتهم بالشعوبية. انتقل بعدها إلى جريدة “النهار” وتولى رئاسة القسم الثقافي.
– عام 1957 التقى يوسف الخال وأسهم معـه في مجلـة “شعـر” وظهـرت لـه في الأعـداد الأولـى كتابـات نقديـة فقـط، ولم يبدأ بنشر قصائده إلا عام 1959.
– عام 1960 أصدر مجموعته الشعرية الأولى “لن” عن دار مجلة “شعر” مع مقدمة كتبها عن قصيدة النثر خصوصاً وعن الشعر عموماً. أثارت “لن” والمقدمة حرباً أدبية اشترك فيها العديد من الشعراء والكتاب في لبنان والعالم العربي.
– عام 1963 صدرت له مجموعة “الرأس المقطوع” عن دار مجلة “شعر”.
-عام 1964 أصدر الملحق الأسبوعي لجريدة “النهار” وظل يصدره زهاء عشر سنوات.
– عام 1965 أصدر مجموعة “ماضي الأيام الآتية” عن “المكتبة العصرية”.
– عام 1970 صدرت له مجموعة: “ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة؟” عن “دار النهار”.
– عام 1975 أصدر “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع” عن “دار النهار”.
– لم ينشر شيئاً أثناء الحرب الأهلية في لبنان، لكنه تابع الكتابة وكان يوقع باسم “سراب العارف”، وعاش أقسى أنواع الوحدة والصمت.
– اكتشف المدرسة السوريالية في أواخر الخمسينيات، بعد أن قرأ قصتها في كتاب لموريس نادو. لكنه لم يصبح سوريالياً.
– أمضى في باريس أربع سنوات (1977 – 1981) فرضتها عليه ظروف عمله. ولم يحاول في أثناء تلك الفترة أن يعقد أية علاقة أدبية أو اجتماعية.
– محب للعزلة والانفراد. لا يلبي دعوة إلى مهرجان ولا إلى ندوة، ولا إلى أمسية شعرية، ولا إلى مجرد لقاء. وهو إلى ذلك فقير لا يملك شيئاً من متاع الدنيا غير شقة بحرية مساحتها ثلاثون متراً مربعاً، اشتراها بالتقسيط أواخر السبعينات وعلى مدى سنتين. وليس عنده سيارة وبيته بالإيجار، وهو ذاته منذ أربعين سنة، بلا مصعد ولا ملجأ ومساحته 110 أو 115 متراً مربعاً.
– ساهم في إطلاق الحركة المسرحية الطليعية في لبنان، عن طريق الترجمة والاقتباس، فترجم مسرحية “كوميديا الأغلاط” لشكسبير، ومسرحية “الملك يموت” لأوجين يونسكو، كما ترجم “العادلون” لألبير كامو، و”القاعدة والاستثناء” لبرشت، و “نبع القديسين” و”رومولوس الكبير” لدورنمان و”الآنسة جوليا” لسترندبرغ. ترجم كتاب “كفاحي” لأدولف هتلر.
– عام 1988 جمع مقالاته التي كتبها في الصفحة الأخيرة من “ملحق النهار” تحت عنوان “كلمات كلمات كلمات”، وأصدرها في ثلاثة مجلدات عن دار “النهار” .
– عام 1991 أصدر كتابه “خواتم” عن شركة رياض الريس للنشر، وهو عبارة عن نثريات شعرية وفكرية واظب على كتابتها في مجلة “الناقد”.
– عام 1994 أصدر مجموعة “الوليمة” عن شركة رياض الريس.
– عين رئيساً للتحرير في جريدة “النهار” بعد وفاة والده في 19/3/1995.
– في 26 تشرين الثاني 1998 اقيمت له ندوة تكريمية في مسرح المدينة ببيروت لمناسبة صدور كتابه “الأبد الطيار” باللغة الفرنسية في باريس.
– في 17/12/1998 قرأ بعضاً من قصائده في معهد العالم العربي في باريس.
– استدعي إلى التحقيق القضائي بعد نشر مقالة في “النهار” للمقدم المتقاعد عدنان شعبان تعرض فيها لأجهزة الأمن السورية واللبنانية.
أقيل من جريدة “النهار” في تشرين الأول 2003.
– عام 2007 صدرت كتبه في طبعة شعبية في ثلاثة مجلدات ضمن سلسلة “الأعمال الكاملة” عن “هيئة قصور الثقافة” في القاهرة. ضم الأول: “لن” و”الرأس المقطوع” و”ماضي الأيام الآتية” والثاني: “ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة” و”الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع” و”الوليمة” فيما حوى الثالث “خواتم” بجزئيه.
– كتب في جريدة “الأخبار” صفحة أسبوعية تحت عنوان “خواتم 3” تنشر كل سبت.
توفي في 18 شباط 2014 بمرض عضال.
أنسي الحاج: أحد أبرز رواد الشعر العربي الحديث
أنسي لويس الحاج (1937 – 2014)
ولد عام 1937، أبوه الصحافي والمتّرجم لويس الحاج وامه ماري عقل، من قيتولي، قضاء جزّين.
تعلّم في مدرسة الليسيه الفرنسية ثم في معهد الحكمة.
أعماله الصحفية والأدبية
بدأ ينشر قصصاً قصيرة وأبحاثاً وقصائد منذ 1954 في المجلاّت الادبية وهو على مقاعد الدراسة الثانوية.
دخل الصحافة اليومية (جريدة «الحياة» ثم «النهار» ثم «الأخبار») محترفاً عام 1956، كمسؤول عن الصفحة الادبية. ولم يلبث ان استقر في «النهار» حيث حرر الزوايا غير السياسية سنوات ثم حوّل الزاوية الادبية اليومية إلى صفحة ادبية يومية.
عام 1964 أصدر «الملحق» الثقافي الاسبوعي عن جريدة «النهار»، وظلّ يصدره حتى 1974. وعاونه في النصف الأول من هذه الحقبة شوقي ابي شقرا.
عام 1957 ساهم مع يوسف الخال وأدونيس في تأسيس مجلة «شعر» وعام 1960 اصدر في منشوراتها ديوانه الأول «لن»، وهو أول مجموعة قصائد نثر في اللغة العربية.
له ستّ مجموعات شعرية «لن» (1960)، «الرأس المقطوع» (1963)، « ماضي الايام الآتية» (1965)، «ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالورد» (1970)، « الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع» (1975)، « الوليمة» (1994). وله كتاب مقالات في ثلاثة اجزاء هو «كلمات كلمات كلمات» (1978)، وكتاب في التأمل الفلسفي والوجداني هو «خواتم» في جزئين (1991 و1997)، ومجموعة مؤلفات لم تنشر بعد. و « خواتم» الجزء الثالث قيد الاعداد.
تولى رئاسة تحرير العديد من المجلات إلى جانب عمله الدائم في «النهار»، وبينها «الحسناء» (1966) و«النهار العربي والدولي» بين 1977 و 1989.
نقل إلى العربية منذ 1963 أكثر من عشر مسرحيات لشكسبير ويونيسكو ودورنمات وكامو وبريخت وسواهم، وقد مثلتها فرق مدرسة التمثيل الحديث (مهرجانات بعلبك)، ونضال الأشقر وروجيه عساف وشكيب خوري وبرج فازليان.
متزوج من ليلى ضو (منذ 1957) ولهما ندى ولويس.
رئيس تحرير «النهار» من 1992 إلى 30 ايلول 2003 تاريخ استقالته.
مستشار مجلس التحرير في جريدة «الأخبار» ابتداء من تأسيسها في ٢٠٠٦، حيث بقي حتّى أيّامه الأخيرة، وكتب زاويته الشهيرة «خواتم ٣» على الصفحة الأخيرة صباح كل سبت
تُرجمت مختارات من قصائده إلى الفرنسية والإنكليزية والألمانية والبرتغالية والارمنية والفنلندية. صدرت انطولوجيا «الابد الطيّار» بالفرنسية في باريس عن دار «أكت سود» عام 1997 وانطولوجيا «الحب والذئب الحب وغيري» بالألمانية مع الاصول العربية في برلين عام 1998. الأولى اشرف عليها وقدّم لها عبد القادر الجنابي والأخرى ترجمها خالد المعالي وهربرت بيكر.
يعتبر أنسي الحاج من رواد قصيدة النثر في الشعر العربي المعاصر.
مؤلفاته الشعريّة
– « لن» / 1960
– « الرأس المقطوع »/ 1963
– « ماضي الأيام الآتية»/ 1965
– « ماذا صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة؟»/ 1970
– « الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع»/ 1975
– « الوليمة» / 1994.
مؤلفاته النثريّة
– «كلمات كلمات كلمات»، ثلاثة اجزاء، مقالات (1978).
– « خواتم»، جزءان (1991 و1997).
– « الابد الطيّار » بالفرنسية في باريس عن دار «أكت سود» (1997).
– أنطولوجيا «الحب والذئب الحب وغيري » بالألمانية مع الاصول العربية في برلين (1998).
في نيسان 2007 صدرت الأعمال الكاملة لأنسي الحاج في طبعة شعبية، في ثلاثة مجلدات ضمن سلسلة «الأعمال الكاملة» عن «هيئة قصور الثقافة ». ضمّ المجلد الأوّل: «لن»، و«الرأس المقطوع »، و «ماضي الأيام الآتية». والثاني: «ماذا صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة؟ » و«الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع» و«الوليمة» . فيما حوى الثالث كتاب «خواتم» بجزءيه.
ترجم إلى العربية أكثر من عشر مسرحيات لشكسبير ويونيسكو ودورنمات وكامو وبريخت وسواهم، وقد مثلتها فرق مدرسة التمثيل الحديث (مهرجانات بعلبك)، ونضال الأشقر وروجيه عساف وشكيب خوري وبرج فازليان.
رحل الشاعر النبيل أنسي الحاج/ عبد القادر الجنابي
بعد نضال طويل مع مرض السرطان، رحل عنا، ظهر اليوم، الشاعر النبيل أنسي الحاج.
فمن موقفه الحر والجريء في منتصف ستينات القرن الماضي من حرية المرأة، إلى مقالاته الصائبة إبان الحرب اللبنانية، كان هناك خيط واحد يشد التأمل الشعري بالرؤيا اليومية ألا وهو لمحة الضمير. إذ كان أنسي يكتب ما يمليه ضميره، وبحرية كاملة، بحيث أصبحت كتاباته شهادة حيّة لتاريخ العصر العربي الحديث… ومرآة صادقة لأشياء كثيرة، بل كانت وستبقى مادة الهام لكثير من الشعراء الشباب.
لم يجر وراء الاحتفالات والدعوات التي لا يفوّت واحدة منها ذاك الدجال الكبير.
لم ينل أية جائزة، لأنه لم يلهث وراءها أي لم يتقلّب من أجلها.
بل بقي مرتكنا إلى عالم الشعر والقراءة؛ قراءة الكتاب الكبار الذين كان يحبهم لصراحتهم واضافاتهم الكبرى لفهم الكائن البشري كـ”بودلير”، “بروتون”،”ماركيز دي ساد”….
كان يعرف متى يصمت، ليعود بكلام واضح وصريح.
بقي أمينا للقصيدة الحديثة بكل تجلياتها. كان ينام معها ويستيقظان معا بركانا من الصور والمعاني الثاقبة.
وهكذا أستطيع أن أقول إن آخر كبار الشعر العربي الحديث قد رحل… ولم يبق سوى كبار صغار يستجدون الشهرة حتى في شيخوختهم لأنهم يعرفون أن لا شيء حقيقي في كل ما انتجوه.
لذا لا يسعني إلا أن أعزي القصيدة العربية الحديثة: البقاء في حياتِك.
سطور من سيرته كما جاءت في موقعه:
ولد عام 1937. – ابوه الصحافي والمتّرجم لويس الحاج وامه ماري عقل، من قيتولي، قضاء جزّين. – تعلّم في مدرسة الليسه الفرنسية ثم في معهد الحكمة. – بدأ ينشر قصصاً قصيرة وأبحاثاً وقصائد منذ 1954 في المجلاّت الادبية وهو على مقاعد الدراسة الثانوية. – دخل الصحافة اليومية (جريدة “الحياة” ثم “النهار”) محترفاً عام 1956، كمسؤول عن الصفحة الادبية. ولم يلبث ان استقر في “النهار” حيث حرر الزوايا غير السياسية سنوات ثم حوّل الزاوية الادبية اليومية الى صفحة ادبية يومية. – عام 1964 أصدر “الملحق” الثقافي الاسبوعي عن جريدة “النهار” وظلّ يصدره حتى 1974. وعاونه في النصف الاول من هذه الحقبة شوقي ابي شقرا. – عام 1957 ساهم مع يوسف الخال وأدونيس في تأسيس مجلة”شعر” وعام 1960 اصدر في منشوراتها ديوانه الاول “لن”، وهو اول مجموعة قصائد نثر في اللغة العربية. – له ستّ مجموعات شعرية “لن” 1960، “الرأس المقطوع” 1963، “ماضي الايام الآتية” 1965، “ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة” 1970، “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع” 1975، “الوليمة “1994 وله كتاب مقالات في ثلاثة اجزاء هو “كلمات كلمات كلمات” 1978، وكتاب في التأمل الفلسفي والوجداني هو “خواتم” في جزئين 1991 و 1997، ومجموعة مؤلفات لم تنشر بعد. و “خواتم” الجزء الثالث قيد الاعداد. – تولى رئاسة تحرير العديد من المجلات الى جانب عمله الدائم في “النهار” ، وبينها “الحسناء” 1966 و “النهار العربي والدولي” بين 1977 و 1989. – نقل الى العربية منذ 1963 اكثر من عشر مسرحيات لشكسبير ويونيسكو ودورنمات وكامو وبريخت وسواهم، وقد مثلتها فرق مدرسة التمثيل الحديث (مهرجانات بعلبك)، ونضال الاشقر وروجيه عساف وشكيب خوري وبرج فازليان. – متزوج من ليلى ضو (منذ 1957) ولهما ندى ولويس. – رئيس تحرير “النهار” من 1992 الى 30 ايلول 2003 تاريخ استقـالته. – تُرجمت مختارات من قصائده الى الفرنسية والانكليزية والالمانية والبرتغالية والارمنية والفنلندية. – صدرت انطولوجيا “الأبد الطيّار” بالفرنسية في باريس عن دار “أكت سود” عام 1997 وانطولوجيا ” الحب والذئب الحب وغيري” بالالمانية مع الاصول العربية في برلين عام 1998. الاولى اشرف عليها وقدّم لها عبد القادر الجنابي والاخرى ترجمها خالد المعالي وهربرت بيكر
“خواتم” أنسي الحاج: القصيدة الآتية/ عبدالقادر الجنابي
قد يسأل قارئ: هل توقف أنسي الحاج عن الشعر، مفضلاً أن يكتب حكماً، وصايا، تعاليم؟ لا أدري! على أني أعرف أن أنسي الحاج لا يعمل في صناعة سحر البيان، ولا يكتب شعراً حسب المسطرة الموروثة التي لا يزال شعراء يكتبون وفق مقاسها الإيقاعي. فتجربته كلّها تقوم على «الكلام الجوهري، منظّف الروح» من كلّ الرجس الجاري على الأفواه، حتّى تكون القيامةُ، مرةً واحدةً في تاريخها، بدايةَ العالم… بابلَ ضد بابل.
لتجربة أنسي الحاج الأولى آثار محفورة في كل ما يُكتَب من شعر منذ عقود. حافظت على وهجها حتى عندما دخل أنسي الحاج في صمت طويل، بحيث كانت تحمل نقاءها في كلّ طبعة جديدة. ولكن، حين قرر فجأة أن يولد من جديد، رأى أن الشكل الشعري الذي تميّزت به دواوينه الستة، لم يعد يتماشى مع واقع «قُذف في سباقِ سرعةٍ بلهاء قضت على التأمّل وأحلّت الألمعيّة الدّجالة الانتهازية محل الصدق والعمق والجديّة والشفافية». وحتى مقارباته النثرية التي كان يكتبها تحت عنوان «كلمات، كلمات، كلمات» أصبحت جزءاً من تاريخ سنوات بعيدة، جزءاً يذكّرنا بالزمان التجريبي الجميل الذي ضاع منّا، ولا نعرف كيف! كل هذا مدوّن في سجل تاريخ الكتابة العربية الحديثة. لقد وجد نفسه يستحم في جوٍّ جديدٍ اسمه الشوط الثاني من التجربة حيث الشعور «بالولادة كما الصحو من النوم». إنها تجربة كسرِ الصمت، «فالصمت لا يستطيع دائماً وحده التعبير عن الصمت»، تجربة الصعود أعاليَ الضفة الثالثة حيث «الكتابة كجسد جديد… لإعادة الفعل إلى الكلمة».
قلّب مغامرته التي كانت في صلب ريادة قصيدة النثر «هذا الحلم المكثّف والسريع» (رامبو)، فوجد عنصرها الأساسيّ: الإيجاز، فِصُّ الفكر… مَفصِلُه ومجزُّه، أفضلَ موئلٍ، «رغم صعوبته»، ينزل به نزولاً عميقاً حتى أمكنة الكلام الخبيئة. والحاج لا يعرف قنبلةً أخرى سوى الإيجاز، «شكل دقّةِ الإفصاح، اقتصاده» (جيرار ديسون)، إفصاح المواجهة مع قيم لغويّة/ مجتمعيّة، مع آيات الواقع التي تحتاج إلى كسر. و «الإيجاز، هنا، يترجّح ما بين اصطياد بَرْق الرأس، والسأم من التعبير».
هكذا، أصبح لنا «خواتم» مصوغة من شقائق النثر، وراءٍ جديدٍ في فلك ما يسمّى الكتابة المتشظيّة، المتفتتة التي فرضت نفسها منذ الرومنطيقيين الألمان، كفن أدبي مستقل مفتوح على أفضية شاعريّة لا متناهيّة، متحررٍ من إسار الوعظ والماضوية الذي يعاني منهما جنس الأشكال الوجيزة (القول المأثور، المَثل، الأمثولة، الخاطرة، الحِكمة، الكلمة الجامعة، الشاهدة، المُقتبس، ما قلّ ودلّ، النادرة… إلخ)،
يجب أن لا نُسلك «خواتم» في عداد هذه الأشكال… بل يجب أن يُنظر إلى كل فقرة/ مقطع فيها كـ Fragment التي تترجم عادة بـ «شظية» أو «قِطعة». لكنني أرى أن أقرب ترجمة لها هو شقيقة (وفي حالة الجمع: شقائق النثر) بدل «شظيّة» الخالية من أية إشارة فنيّة إلى المفهوم الأدبي الحديث للكلمة، حيث التدامج بين نثر تساوره الأفكار وشعر يقوم على المُجاورة، يولّد شاعريّةً «تستوعب أضدادها وتشتمل على نقائضها»… شاعريّة تقلب الحقائقَ المسلّمة، وتستبدلها بحقائق حدسيّة، «تجعلنا نعيد النظر في كلّ شيء، حتى في النشيج» (سيوران).
والشقيقة، واحدة الشقائق، هي كل ما استطار من البرق وانتشر في الأفق، والجمع شقوق، لكنني أفضل شقائق تذكيراً بتوهج ذلك النبات الأحمر المنير، الذي هو توهج الفكر عينه. وثَمّ اشتقاقات أخرى، مثلاً، «الشِّقَّة» هي القطعة المشقوقة من شيء. ويقالُ «شَقَّقَ الكلامَ» إذا أخرجه أحسَن مُخرَجٍ: «في أدنى حجمٍ وفي ألفاظٍ أقل، وبطاقَةٍ قصوى» (نيتشه)، على عكس الخطب السرديّة التي تسمّى «شقاشِق»، وهناك أيضاً «الشُّقّةُ» التي تعني «السفر الطويل» وهنا إيحاء إلى أنّ «هذا الذي يُعبَّر عنه بإيجاز هو ثمرةُ تفكّر طويل» (نيتشه). وإذا كانت الشقائق تعني أيضاً، «نظائر»، في لسان العرب: «النساء شقائِقُ الرجال»، فإننا، إذاً، مصيبون في تسميتنا هذه، خصوصاً أننا نرى، في معظم الشعر العالمي الحديث، الشقيقة باتت نظير قصيدة النثر، كما لدى رينيه شار.
وهي ليست مُصغَّرَ كُلٍّ كالكلمة الجامعة أو الهايكو، فالشقيقة تختلف عن الكلمة الجامعة بامتلاكها طابع اللاتكامل، الانفتاح على آفاق جديدة من دون أن ترتبط في شكل ثابت. «فهي ليست شقيقةً بالصدفة وإنما بطبيعتها» (شليغل). تَقطَع حبل السرّة مع حياة سابقة كانت فيها جزءاً من كلٍّ، لكي تكون هي الكلُّ، كغصن يسقط من الشجرة لكي يكون هو الشجرة: «أنا لا شيء، ولكن يجب أن أكون كلّ شيء» (ماركس). هكذا، تثبت الشقيقة أن «الكلَّ ليس حقيقياً» (أدورنو)، ناسفةً بذلك مفهوم الكلّ (تلازم الأجزاء العضوي) الهيغلي والوَحْدة (الحَبْكة) الأرسطوطالية. ناهيك عن أنّ كلمة شقائق تحمل معاني العنف، التشقق والاقتطاع، وهي عين ما تتضمّنه كلمة Fragment المشتقة من الكلمة اللاتينية Frango: خلع، كسر، شق… إلخ. ومعاناة التشقق الذهني بين الحياة والموت في «خواتم» واضحة: «كلما كتبت عبارة، أفعلُ كعائد من الموت أو كمزمعٍ على العودة إليه».
الشقيقة، لدى أنسي الحاج، هي «الحالة» المستسلم لنهشها. إنها شكلٌ، وليست جنساً أدبيّاً، إذ ليس لها قوانين مُقرَّرة، كقصيدة النثر مثلاً أو الشعر الحر، حتى يمكن تقليدها أو اتباعها، مع أنّ لها استقلاليتها التي تعكس استقلاليةَ كاتبها. من هنا، هي «ليست أسلوباً مُقَرَّراً مسبقاً، وإنما هي شكلُ المكتوب» (دريدا)… وحدةٌ نثريةٌ مستقلةٌ تبدو وكأنها نُدبة، جرحٌ غائرٌ في السرد. وأحياناً، تطفو في بياض شاسع، معلقةً كسهمٍ يبحث عن مرمى. إنها كالجسد الجريح تحمل شكل التمزق والألم أشبه برسالة شُقّت من أعماق اللاوعي فباتت علامة نقصانٍ وعدمَ اكتمال، وتبدو دوماً ناقصةً، مبتورةً – لكن أبداً ليست مجهضة – شيئاً لم يكتمل، بل لا تسعى أبداً – وهذا لا يقدم كبير عون للناقد المدرسي – «إلى أن تكتمل، وإنما إلى أن تتصيّر دائماً» (شليغل). إنها سرد مسدود «يحقّق نفسَه بواسطة توقّفه، موتِه، والانقطاعِ عن الاسترسال. فالشقيقة تنشأ، بطبيعتها، من كتابة جزئية الطابع أو مُجزّأة. فهي لن تكفّ عن التوقّف، وهذا هو عصبُ سيْرِها» (لاندميرال). و «لا يهتم بكتابتها إلا أولئك الذين اختبروا الخوفَ وسط الكلمات، خوفَ أن يتهدّموا هم والكلمات معاً» (سيوران) وأنسي الحاج واحد منهم.
شقائق «خواتم»، ليست موجزةً وإنما وجيزة، وليست قصيرة وإنما مقتضبة. على عكس صفحات مئات الناثرين، هنا لا إغراق في القول ولا التواءات في الطرح. إنّها في صلب الشعر الذي هو ليس مهنة، وإنما «حارس اللغة ونبيّها». فهي تولد حاملة معها ديمومتها الزمنية المتأثرة بحافز إيقاعي يقصر دائرتها، يخلصها من الاستطراد والإسهاب، مما تعود تعبيراً خاطفاً، آنيّاً، رسماً بيانيّاً لحركة الذهن يحضنا على النظر إلى كل شقيقة كما ننظر إلى صورة إشعاعيّة. فآلة الإفصاح لدى أنسي الحاج تترك الفكر يتدفّق بكل تقطّعاته، لا يخنقه الاسترسال أو الإطناب رغبةً في إيضاحٍ لا يحتاجه سوى البلداء، مع المحافظة على مسافة بينه وبين ما يطرأ فجأة، ما ينبجس من مَلَكة الإدراك المُتقَصّفة، وعلى صراحة متناهية في الإعراب عن لمحة الضمير، من دون الوقوع في مطب الانطباعات التي غالباً ما تنمو كالنباتات الخبيثة بسبب عفونة الواقع المحيط و «تقذف بك في مهبّ الخطاب». كما أنه لم يتناول الأمور من جوانبها الصغرى، أي من ضرورة اتخاذ موقف إزاء «المظهر الغشّاش»، وإنما من أماكنها الخبيئة، من سدرة ما تحلم به من سمو. هكذا، جاءت «خواتم 1 و2» كتابين تتقافز فيهما الأفكار، هذه الغنائم الذهنية، من تشخيص دقيق للغة، للشعر، للكتابة، لفراغ العالم القاتل، إلى تشخيصات أكثر دقة للواقع، للأشخاص، لهواجس تستيقظ أثناء التدوين من نوم اجتماعي طويل، لأنها «لا تستند في أيَّ شيءٍ على حب الذات، الأقصوصة، الحكمة أو الرواية… وإنما دُوِّنَت إبان التوتر، الغضب، الخوف، المنافسة، القرف، المراوغة، الخلو الخاطف مع النفس، توهم المستقبل، الصداقة، الحب». (شار)… أفكار لا تصل إلى طريق مسدود، لأنه بكل بساطة ليست ثمّة طريق قط، وإنما شسوع في كل الاتجاهات حيث «حرية ملاقاة الكلمات لأقدارها».
الشقيقة، جمالية الاقتضاب هذه التي «تتوافق فيها المتنافرات» (جونسون)، فنٌّ وليس لهواً. وإنّ المخيلة، كالوزن في الشعر، هي إحدى مُكوِّنات بُنيتِها. كل خاتَم/ ختمٌ ثريٌّ بما يكتمه.
«خواتم» أنسي الحاج، كالشّاشة، تتعاقبُ تعاقبَ المشاهدِ السينمائية، نهر يصعد إلى غير رجعة. إنها ليست سِقطَ ذهانٍ تأويليّ، وإنما هي انقداحاتُ ذهنٍ في صفوٍ عالٍ، رافضٍ كلّ توفيقية، أشبه بعملية إضاءة اللغة بضوء الولادة. إنها بزْرة اللّمْح، انكفاء في اللاشكل! تنسف الفرق الشائع بين النّثر والشعر… مقررة فرقاً أساسياً هو الفرق بين الفاضي والمليء.
يتميّز الإيجاز في «خواتم» بتلقائية تمنح فرصةً للروح لصوغ فكرة أوسع مما للتعبير. ذلك أن حركة الكتابة هي عين حركة القراءة: في كل تقطّع، توقّف، ينهض ظلٌّ، حضورٌ بلا حاضر، يعيدنا إلى عتبة النص لندخل من جديد. إنّها نهايةُ اندفاقِ شعورٍ انشقّ عن ماض ما، عن أصلٍ تلاشى في البياض، وها هو ملقى يحمل معه ختْمه، بلا حركة لكنه يحرّك جلّ المشاعر. نعم، إن أقرب معنى لـ «خواتم» هو نهايات… نهايات قياميّة تُفضي بنا، إلى مزيد من الإيمان بأنّ القصيدةَ هي دوماً قصيدةٌ آتية.
الموت يغيّب الشاعر اللبناني أنسي الحاج
بيروت – عدنان غملوش
غيب الموت الشاعر والأديب اللبناني، أنسي الحاج، عن عمر يناهز 77 عاماً بعد معاناة مع مرض عضال.
أنسي الحاج الذي ولد في بلدة قيتولي قضاء جزين جنوب لبنان، يعتبر علامة فارقة في عالم الثقافة والإبداع في لبنان والعالم العربي، عاش حياة زاخرة بالعطاء الأدبي عبر محطات كثيرة من الصحافة إلى الكتابة والقصائد، وصولاً إلى الترجمة والمسرح.
بدأ أنسي الحاج حياته الأدبية بنشر قصص قصيرة وأبحاث وقصائد منذ العام 1954 في المجلات الأدبية وهو على مقاعد الدراسة الثانوية.
دخل الصحافة اليومية في جريدة “الحياة” ثم “النهار” عام 1956 كمسؤول عن الصفحة الأدبية، قبل أن يستقر في “النهار”، حيث حرر الزوايا غير السياسية سنوات، ثم حول الزاوية الأدبية اليومية إلى صفحة أدبية يومية.
عام 1964 أصدر “الملحق الثقافي الأسبوعي عن جريدة “النهار”، وظل يصدره حتى عام 1974، وعاونه في النصف الأول من هذه الحقبة شوقي أبي شقرا.
ترك أنسي الحاج إرثاً ثقافياً وأدبياً كبيراً، فهو ساهم مع الشاعر الراحل يوسف الخال وأدونيس في تأسيس مجلة “شعر”، وعام 1960 أصدر في منشوراتها ديوانه الأول “لن”، وهو أول مجموعة قصائد نثر في اللغة العربية.
لأنسي الحاج ست مجموعات شعرية، وبعضها لم ينشر بعد، فيما لم يكمل الجزء الثالث من “خواتم”.
نقل إلى اللغة العريبة منذ عام 1963 أكثر من عشر مسرحيات لشكيسبير ودورنمات وكامو وريخت وسواهم.
متزوج من ليلى ضو ولهما ندى ولويس
“العرية.نت” التقت بعض أصدقاء أنسي الحاج ممن عاشوا تجربته الأدبية والشعرية، وأبرزهم الشاعر عقل العويط الذي قال “أعرف أن أنسي الحاج لا يعرف أين مر وماذا رأى، وهو ليس وليد جيل، بل هو الزوايا المختلفة”.
هو الشاعر الذي كتب لنفسه “أليس هو القائل كتبت لنفسي. كل كتاب لي هو لشخص واحد. المجد لله الذي أنعم علي بهذه القوة”.
يقول بيار أبي صعب، رئيس الصفحة الثقافية في جريدة “الأخبار” الذي كان الشاعر الراحل مستشاراً في أسرتها التحريرية، لـ”العرية.نت”: “صعب علينا غياب أنسي الحاج، لقد تربينا على شعره وأدبه وثقافته. حلم لنا أن يظل معنا في الصحيفة، لقد كان إضافة، وتحدٍّ أن تستوحي رؤية وحساسية وخطاب أنسي الحاج ومدرسته. أنشأ مدرسة وعلم جيلاً كاملاً الصحافة بتواضع، وهو آخر عمالقة جيل كامل من الصحافة، بتواضع كان يريد أن تكون بيروت عاصمة للثقافة والإبداع والحداثة”.
يقول أنسي الحاج قبل وفاته، جواباً عن سؤال حول كيف يوجز سيرته؟ “غالباً ما سردت الحكاية ذاتها. لا أعتقد أن ذلك يهم أحداً. أندم أكثر مما أفعل ولم أفعل إلا في غفلة من نفسي. وعندما لم يكن أحد يسألني رأياً في الأمور،كالحب والموت، قلت الحقيقة. لم أعد أقولها دائماً حين صار هناك من يسألني”.
أنسي الحاج شاعر الحرية والحب ورائد قصيدة النثر… رحل عن 77 عاماً شاعر الحداثة الذي يسابق نفسه إلى المستقبل
عبده وازن
شاعر الليل الذي لم يكن يغمض له جفن إلا عند انبلاج الفجر، أغمض عينيه أخيراً على ليل الموت. بعد هذه الإغماضة لن يكون انسي الحاج الساهر الاخير الذي اعتاد أن يسامر عتمة العالم حتى اول الضوء، فيأوي من ثم الى نوم هو نوم الشعراء المشبع أرقاً ويقظة. لعله، عندما اغمض عينيه، صرخ صرخته الاخيرة «كم هذا الليل»، مثلما كتب مرة في إحدى قصائد ديوانه «الرأس المقطوع»، مدركاً ان هذا الليل ليس سوى «شمس العودة» التي اختتم بها قصيدته الملحمية «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع».
غاب أنسي الحاج عن سبعة وسبعين عاماً ودواوين وقصائد و «خواتم» و «كلمات كلمات كلمات» وأحلام هي احلام الكائن الذي حدق الى السماء بنظرة حارقة بينما قدماه على الارض. وبدا غيابه إحدى قصائده الاليمة التي كتبها بحبر الاحتضار المضني والارق والمواجهة الميتافيزيقية السافرة. هذا الشاعر الذي استهل تجربته صارخاً في ديوانه الاول «لن» صرخته المدوية: «نحن في زمن السرطان، هنا وفي الداخل» كان قدره ان يحل به السرطان وينتصر على جسده فقط، بعدما قضى عمره يواجه شبحه في ساحة الشعر والكتابة وفي معترك الحب والحلم. هذا السرطان الذي كان هاجساً وجودياً لدى انسي الحاج منذ ان سرق امه وهو فتى ثم زوجته ليلى، استحال معه بعدما عاناه في جسده، سؤالاً فلسفياً وشعرياً، سؤال الكائن المحتج والمعترض، الكائن الذي خبر الماوراء وهو مفتوح العينين.
سبعة وسبعون عاماً هي عمر قصير في حياة شاعر في حجم انسي الحاج التواق دوماً الى الحياة كما أرادها هو، حياة الحالمين الكبار والطامحين ان يروا المعجزة وقد حلت على الارض. في الايام الاخيرة التي خامر فيها لحظات الاحتضار الطويل والاليم، كان حين ينهض، يسأل متى يمكنه ان يكتب. هذا الشاعر الذي وجد في الكتابة قدراً كان يستحيل عليه ان يعيش بعيداً عنها. حتى خلال صمته اعواماً غداة اندلاع الحرب الاهلية، جعل أنسي من هذا الصمت أجمل نص يمكن ان يُكتب.
لا أحد كان يتصور ان أنسي الحاج الشاب، إبن الثانية والعشرين، سيفتتح في العام 1960، عام صدور ديوانه «لن»، زمن قصيدة النثر عربياً، وعهد الشعر الآخر، شعر الحداثة «الملعونة»، شعر الصراع بين الكينونة والعدم، شعر الحدس والنزق والهجس والجنون الحكيم والرؤيا والحواس «المخربة» وفق مقولة رامبو. أطل ديوان «لن» كصرخة مدوية في ليل العالم، صرخة تحمل في قرارتها اصداء القصيدة الجديدة، قصيدة المستقبل، قصيدة المواجهة السافرة، قصيدة اللغة المنبجسة من صميم اللاوعي والعماء المضيء، والمشرّعة على جماليات الحلم والكابوس والتوتر والتشنج. اما مقدمة «لن» فغدت للحين أول بيان لقصيدة النثر العربية، وهو بيان كتبه شاعرنا بدم الشعر وليس نظرياً، بعدما عاش تجربة هذه القصيدة بالجسد والروح. وما برحت هذه المقدمة المرجع – الشاهد الذي لا بد من العودة اليه عند الكلام عن قصيدة النثر العربية.
ولعل أكثر ما أثار استغراب قراء انسي الحاج الذين دأبوا على مواكبته منذ البدايات هو ازدواجيته، الظاهرة طبعاً لا الباطنة، كشاعر يواجه اللغة ويغرق في عمائها بحثاً عن الغريب والمجهول واللامألوف وكناثر او كاتب زاوية أو تعليق، يجاهر بانتمائه الى المدرسة النثرية الجمالية والى فن المقال الذي كان تبلور مع ادباء وشعراء هم صانعو هذه المدرسة وأبناؤها الاوائل من مثل مارون عبود وفؤاد سليمان وتوفيق يوسف عواد والياس ابو شبكة وفؤاد حداد (ابو الحن) وسعيد تقي الدين وسواهم… ولم يلبث مقال انسي ان تجلى في زاويته «كلمات كلمات كلمات» التي حملها «ملحق النهار» بدءاً من العام 1964. وفي هذه الزاوية التي استهلها شاعرنا وهو في السادسة والعشرين من عمره، راح يمارس اقصى احوال الحرية في الكتابة المحتجة والمتمردة والرافضة، ولكن على عمق ثقافة ومعرفة، وعلى حدّة نظر وصفاء موقف. وقد حرر انسي المقالة من أسر الصحافة، مرتقياً بها الى مصاف الابداع الحقيقي على غرار ما فعل الآباء الرواد الذين كان خير وارث لهم. وكم لقيت زاويته «كلمات…» التي استعار عنوانها من هاملت، طوال عشرة اعوام قبل ان يحتجب «الملحق» عشية الحرب عام 1974، من إقبال لدى القراء اللبنانيين والعرب، ومن ترحاب لدى الطلاب الجامعيين الذين وجدوا في صاحبها المثال النقي للثورة والرفض. في تلك السنوات كان انسي أحد صانعي معجزة الحداثة التي عرفتها بيروت في الثقافة كما في السياسة والفكر والفن والشعر والرواية. وعندما وقعت الحرب الاهلية، والاكثر من اهلية، جارفة بنارها احلام المدينة ورموزها، كان انسي الحاج واحداً من اوائل ضحاياها. ولم تكن الصدمة عابرة وبسيطة بل هي اصابت الشاعر في عمق وجدانه الشخصي. وأمام هول الكارثة ارتأى الشاعر ان يصمت ولكن صمت الفارس الجريح قبل ان ينهض من عزلته ويكتب. فالحرب التي أغرقت انسي في الصمت هي التي حفزته على العودة الى الكتابة، لا سيما الشعرية. وكتب حينذاك قصائد «وطنية» غير مألوفة، فيها من الرثاء «الإرميوي» (مراثي إرميا) ما فيها من حدة ونزق وعبث، ورجاء هو اليأس بوجهه الآخر. كتب يقول في احدى قصائده: «اجلس على عشب لبنان المحروق وكلي موت/ ولم يبق فيّ من حياة/غير الالم». هذا لبنان انسي الحاج، الوجودي الطابع والميتافيزيقي البعد، الاغريقي القدر، لبنان الموئل والمآل، لبنان القادر على النهوض من موته «لمجد النور ولأجل الظلال» كما يقول الشاعر.
كتب انسي الحاج قصائد حب لم يألفها الشعر العربي سابقاً إلا في بعض التجارب الصوفية والشهوية القديمة. كان شعر الغزل يحتل الواجهة بخاصة مع قصائد نزار قباني وارث الغزل العربي القديم والنهضوي، عندما اطلق شاعرنا قصيدة الحب متمرداً على الغزل الذي جعل من المرأة ورموزها موضوعاً يدور الكلام حوله ونادراً ما يخترقه. جعل الحاج من المرأة ذاتاً حية، يتماهى فيها الحلم والرغبة، الميتافيزيق والشهوة، وفي ظل حضورها أو غيابها تتآلف المتناقضات، الحسي والروحي، الرمزي والمدنس، الإثم والنعمة، اللعنة والخلاص.
في العام 1991 اصدر انسي الحاج كتابه «خواتم» وكان بمثابة الجزء الاول من كتابات لم تنته إلا مع رحيله. كانت «خواتم» تجربة جديدة هي بين النثر والشعر، النثر اللامع والبارق والشعر بصفته روحاً وحالاً ومقاماً. لم تكن «خواتم» كتابة بديلاً حلت محل الشعر الذي غدا انسي آنذاك مُقلاً فيه، بل كانت تجربة مشرقة خاضها الحاج شاعراً بجرأته المعهودة، وناثراً يجعل من لحظة الكتابة لحظة بارقة برق الشرارة التي تخترق العتمة. بدت «الخواتم» خلاصات الكلام وخاتماته، تأويلاً وترجمة لجوهر «الشذرة» ومعناها وظاهرها. وقد جمعت هذه «الخواتم» بين كثافة الشعر ومعجزته، وتلقائية النثر وطواعيته، وومض الخاطرة.
الآن ندرك كم ان انسي الحاج كان شاعر المستقبل الذي يسابق نفسه دوماً الى امام. الآن، لا سيما الآن، بعد رحيل الشاعر بالجسد لا بالروح والقلب، ندرك اكثر فأكثر ان انسي الحاج سيظل شاعر المستقبل.
آخر الخواتم
غسان شربل
أتهمك بالخيانة، وأعني ما أقول. لا يحق لك، لا يجوز، ولم يكن من عاداتك أن تتنكر، وأن تتوارى، وأن تنحني. لا يحق لك أن تجمع جفونك وترحل. لا تستقيل العاصفة من قدرها، ولا يتنازل النبع المتفرد عن قرائه.
أعرف أن الزائر الغريب لا يطلب موعداً، لا يستأذن، لا يطرق الباب. يتسلل ويقيم، يقرض ويلتهم، لا تردعه حدود ولا ترشوه مسكّنات. كأن السرطان شاء أن يثأر. وذنوبك صارخة. أمضيتَ العمر تجلد سرطانات التخلف، والجمود، والظلام، والتعصب، والانغلاق. سرطانات الخوف من الحرية، والمخيلة، والإبداع، والشكوك وعلامات الاستفهام. سرطانات الذعر من التوق الموتور إلى اليقين.
أنسي الحاج،
يعرفك الآخرون أكثر مني. أكاد لا أعرفك. لم تربطنا صداقة حتى حين عملنا معا تحت سقف «النهار». بضع مواعيد رتبَتْها الصدفة، وبضع جمل قيلت على عجل، ودقائق خوف ونحن نجتاز بعد منتصف الليل المدينة التي انشطرت إلى نصفين وجرحين. وكأنني كنت أنصاع لرغبة دفينة، أن تبقى علاقتي معك علاقة قارئ بكاتب لامع. ولعلها أجمل العلاقات وأعنفها.
كنت صغيراً حين وقعت على الصفحة الأخيرة من ملحق «النهار». قرأت مقالك «كلمات كلمات كلمات». انتابتني متعةُ مَن وقع في الفخ. وكنت أسأل نفسي: مَن هذا الكاتب الأرعن الذي يجيز لنفسه جلد لصوص الهيكل والأصنام؟ مَن هذا الكاتب الجارح الساخر الشفاف؟ مرة يأتي شجرةً من اللهب وصقراً مؤذياً، ثم يأتي صافياً كبكاء الحسَاسين قبل الغياب؟ من هذا الوقح الذي يدفع القاموس إلى النهر ثم يصطاد الكلمات مغسولة شفافة مسنونة ويوزع خواتمه المسمومة على القراء؟ من هذا الكاتب الذي يقتحم اللغة بقسوة الجلاد يحارب العفونة والاستكانة والتقليد والأغلال ويطالب بحقوق المخيلة معلناً إسقاط الحدود؟
غداة صمت المَدافع صرت جزءاً من اسرة «النهار». وشعرت بالوحشة. كانت المدينة غارقة في الظلم والظلام. وكانت الحرب هجَّرت من الصحيفة كتّاباً درجْتُ على قراءتهم تلميذاً. وكان أنسي الحاج بين من هجِّروا. ولا أبالغ إن قلت إن ذلك المبنى كان مسكوناً بشياطين أفكاره. كان غائباً، لكنّ دوي ارتكاباته كان يتردد بين المكاتب كلمات كلمات كلمات.
وحين عاد لاحقاً وجدته مكسوراً. وجدت الصقر مبللاً بدموعه. وكأنه كان يشعر بواجب الاعتذار لمن استدرجهم، وحرضهم على ارتكاب الحلم، أو ارتكاب الكتابة. وشعرت أن هذا الهارب الدائم من وطأة النهار إلى زغب الليل يمشي على الزجاج المطحون. وخامرني شعور بأنه ينفرد في الليل بكل الأحلام التي أجهضت وكل العصافير التي اغتيلت.
أترك للنقاد أن يطلقوا مباضعهم في جسد الإرث الذي ترك. في دوره الرائد في قصيدة النثر ومجلة «شعر» ومعارك الحداثة. في لمسته التي أثرت المسرح والحلم الرحباني كما أثرى الصحافة اللبنانية كاتباً ورئيساً للتحرير. أكتب عنه كقارئ.
أقلقني صمته الطويل. وخفت أن يكون قتل مع المدينة. وان تكون مخيلته أفلست وينابيعه فرت. ثم عاد عبر الزميلة «الأخبار» وأوقعنا في فخ موعده. عاد السبعيني محتفظاً بنضارة قلبه. وبالعين النفاذة التي ترى. عاد محتفظاً بخضرة أسلوبه. وشعرت أن الحب كان مظلته الأخيرة. كان عزاءه الأخير. ولم تكن نكهة الوداع خافية في بعض مقالاته. كأنه كان يبلغ قراءه أن الزائر القاتل يستعد لتوجيه ضربته الأخيرة.
قبل الحرب كانت المدينة تنتظر كاتبها. لا أذكر أنها انتظرت أحداً كما انتظرته. بعد الحرب لم يعد للمضارب المتناحرة كاتب واحد. نبأ غيابه هز بيروت أمس. كأنها أضاعت تاج خيالها. كأنها أضاعت آخر خواتمها. أدركت حجم خسارتها فهذا الفتى الخائن كان ألمع أخطائها.
نموت حنيناً إلى زمن البرق. زمن الحالمين. زمن المحرضين على فتح النوافذ. زمن الأساتذة. قتلتنا رائحة الكهوف. قتلتنا جيوش الظلام.
رسالة ثانية إلى أنسي الحاج
أدونيس
الصديق الحبيب أنسي،
منذ بدأتَ استقصاءَ العالَم، ذهبتَ في اتّجاه أبعاده القُصْوى. احتضنتَ مَن كان رائداً، لكن جعلْتَ مِن كلّ فجرٍ يطلعُ دليلاً. وما كان في الكتابة ارتِجالاً أو طَيْشاً، أسّسْتَ له، لكي يتخطّى نفسَه ويندرجَ في تجربةٍ أو مشروع.
أردتَ للكتابة أن تنسخَ شيخوختَها وأن تستعيد سنَّ رُشْدها الأوّل.
هكذا غيّرتَ العلاقةَ بالزّمن، مُدرِكاً أنّ الحاضرَ لم يكن في الوعي السّائد القائد إلاّ وظيفةً تاعسةً في المستودع المتصدّع، التاعسِ هو أيضاً، والذي يُسمّى الماضي.
أردتَ أن تنفخَ من روحكَ في عالمنا، تأسيساً لحقوقه، هو الذي لا يعرف غيرَ الأمر والنّهْي. أردتَ أن تفجِّر أهواءه الخالقة، أملاً بولادة الفرْد، الفرْد الحرّ، المستقلّ، سيّد مصيره، في مواجَهةِ الكمّ التراكُميّ الجَمْعيّ. أردتَ أن تهدمَ تلك السلاسل التي سُمِّيت مبادئ وقواعد، والتي ليست إلاّ إكراهاتٍ خانقة، وسجوناً.
«أنتَ أنقانا»، قلتُ لك، مرّةً. وأكرّر هنا قولي هذا. وفيما أخذتَ تقتحمُ بقوةِ هذا النّقاء، جميعَ أشكالِ العَسْفِ، كنتَ تنحتُ في جسد الشّعر شامةً آسِرةً لطفولةٍ لا ينفد نِسْغُها. إذاً، داعبتَ الحداثةَ كما لم يداعبْها أحدٌ في زمنِكَ، ورسمتَ لها وَجْهاً بحبْرِ حَدْسٍ خلاّقٍ يبدو كأنّه نوعٌ من الجنون الضّاربِ في غياهبِ التعقُّل. وفهِمْتُ وأفهمُ، اليوم، على نحوٍ أكمل، كيف رأيتَ نفسَك مدفوعاً إلى أن تُراعيَ بعضاً وترعى بعْضاً بين أولئك الذين كانوا يتدافعون في موكب هذا الاقتحام. لا رغبةً منك ولا رهبةً، بل انتشاءً واحتفاءً بهذا التّكَوْكُب.
هكذا تأسلَبَتْ حياتُك في مختَبَر كتابتك، وتأَسْلَبَتْ هذه في مختَبَر تلك، في أنْسٍ مُفْرَدٍ كأنّما يمتزج فيه لُطفُ النّوارِسِ بصَخَب الموْج.
سبَقْتَني.
أكادُ أن أرى في ترابكَ العاشقِ جذرَ نبتةٍ غريبةٍ ومجهولةٍ، يمتدّ في أفُقِ ترابيَ المُقْبل لكي يعقد أواصرَ الصّداقةِ بين موتكَ وموتي، استكمالاً لتلك الأواصر بين حياتك وحياتي، والتي كانت تضطربُ – لكن راسخةً أبداً، وعاليةً أبداً.
الأبديّةُ هذه اللحظة، تديرُ ظهرَها إلى الموت.
صديقك
أدونيس
باريس في 10/2/2014
الشِّعر تحت شرشَف أسود
سمير عطاالله
“ومضى وأمام وجهه المزيد من الوَداع”
جورج شحاده
كانت “النهار” الأولى في سوق الطويلة قسمين: أربع غرف للتحرير والمحاسبة معاً، والقسم الآخر لماكينات صف الأحرف وتركيب الصفحات، والمطبخ. في غرفة صغيرة، مأخوذة من أخرى، كان يجلس أنسي الحاج، يقدّم، كل يوم، ربع صفحة عنوانها “أدب فكر فن”. من هذه النافذة أطلّ الأدباء والشعراء، وذوو التجربة الأولى. ومن خلف المكتب الحديد، حرَّك أنسي الحاج أمواج الحداثة ورفَعَ أعلام التمرّد ونَسَج لنفسه صورة الغريب.
غريب عن السائد. متمرّد على الشائع. كان في “النهار” وخارجها. في الصحافة وبعيداً منها. في لبنان وضده. كان يصل إلى المكتب وكأنه قادم من كوكب لا ينبت فيه سوى الصمت. ناحل، يرخي لحية صغيرة مثل علماء الصين. حتى وسامتُه كانت متفرّدة بملامحها ومقاييسها. وكان فيه صمت وغضب وخلفهما حب وأسى.
وفي قلبه كان حانياً ووديعاً وخائفاً. صمته كان دِرعه وقِناعه. وهو كان مرهفاً وعطوباً. وكان ناحلاً من الداخل أيضاً. يخاف من ضعف الناس ويحنو على ضعفهم ويستوعب أوهامهم ويُسامحهم برضى ومحبة.
لم يبتدئ ولم يتدرّج. جاء إلى الصحافة كأنه نازل إليها من سلسلة جبالها. بدأ في كتابة الأدب وكأنه مولود في مِذود الكلمة، مُلهم بها، ومفتون بسحر حروفها، حرفاً حرفاً. لم تكن لأنسي بدايات وبواكير يندم عليها ويُعيد النظر فيها أو يُعلن تبرّؤه من أبوّتها. هكذا أطلّ على هذه الصناعة: قالباً من ذهب مصقول، ونثراً من ذهب محفور.
في تلك المرحلة كان الانتماء شائعاً، وأحياناً فخرياً. وبقي هو خارج كل انتماء. لكنه كان أيضاً الأكثر شغباً في تقويم الالتواءات. كان يريد بقاء لبنان الذي أفاق عليه في حي “الخندق الغميق”، لكنه رآه ينزلق من بين أصابعه في انهيار متسارع، ويذوب على اعتاب التجار والجُلفاء وفُسّاد الروح، والذين لا يخجلون.
بنى لنفسه وحده حزباً ولم يشأ أن يحمِّل أحداً سواه مسؤولية الانضمام إليه. لكن كثيرين اتَّبعوه من غير أن يدري. كثيرون أحبّوه وهو مُصرّ على عُزلته. وأحبّته النساء ودخلن على صمته وعُزلته حتى أخرجنه عن صمته. وسُرَّ في داخله بدوره الجديد: جرس العشق وصنم الولَه.
رعاني أنسي في مراحل ضعفي وما بعدها. والضعف تتغيّر عوامله لكنه لا يتغيَّر. وفتَحَ لي زاوية “أدب فكر فن” أكتب فيها خواطر المراهقة وأسمّيها شعراً… وبعد سنوات طويلة، عندما صار رئيساً للتحرير وصُرت أكتب مقال الأربعاء، ظلّ يتلقّى النصّ بالمحبة نفسها. وظلّ يحدو ويعطف ويشجّع متظاهراً بالدهشة.
تواضع طويلاً خلْف وحدته. فعندما تُذكرُ حركة “شعر” لا يُذكر دور أنسي في مَداه وحجمه. لا أحد يقول إن “أدب فكر فن” كانت المقدمة إلى “شعر”، وإنه خاض معركة الحداثة قبلها. وعندما صار جزءاً من أخويّتها، كان ركناً من موسِّعي آفاقها وضابطي إيقاعاتها وحافظي لغَّتها. فقلَّة تعرف أن هذا الناحل، المُتواري خلْف صمته، علوّ من أعلياء النحو.
قال في مقابلة مع عبده وازن في “الحياة” إنه لا يزال يسكن في شقة من 90 متراً منذ زواجه. وفيها أودع روحه الجميلة ونُحوله الأخير. في أيام الاحتضار قال لي عقل العويط: “أنا لا أحتمل هذا المشهد. أرسلتُ إليه شقيقتي الراهبة، وتقبّل منها البرشانة”.
عاش حياته يخاف لحظة العبَث الكبير. لحظة العبَث المُطلق والنهائي، يوم يُنادي إنسان على مُعين ولا يسمع سوى صوت نفسه وصدى صفير الريح ووصول الغياب. جاءه معنى العبَث باكراً يوم فَقَد أمّه طفلاً في الخندق الغميق. علَّمه أن الموت – مثل الحياة – قسوة لا رحمة. وظلّ الخوف مقيماً في نفسه. فلما فقد زوجته، لم يكن قد نسي بعد الخندق الغميق وأن الغياب وحده لا يغيب. لا هو ولا ثقله ولا مَن لا حب مثل حبهم.
قال تيوفيل غوتييه في وداع هاينريش هاينه: “كان على أصدقائه أن يُسرّهم انتهاء هذا الاحتضار الأليم. لكنهم عندما يفكرون في أن هذا العقل الوضّاء المعجون بالأشعة والأفكار لم يبقَ منه سوى الشُحوب، يشعرون بألم لا يتقبّلونه دون ثورة. الحقيقة أنه كان مسمّراً في نعشه وهو حيّ، لكنك حين تُرهف السمع إليه وتُدْني أذُنك، تسمع الشعر يغنّي تحت الشرشف الأسود”.
عندما دُعي غسان تويني إلى باريس لحضور مشاهد أول نزول بشري على القمر، اختار أن يأخذ أنسي معه، وليس محرّراً من القسم الخارجي. مثل تلك الدهشة يليق بها النسَق الشعري لا الحدَثي. وطوال سنوات أعطاه مكانه على الصفحة الأولى، بالبُنط الأسود نفسه، يعبّر فيه عن الثورة على ملامح الزوال والتفتّت الداهمة والمتسارعة. وما بين أسلوبه الأدبي الألِق وشجاعته الأدبية الصافية، عكَس أنسي في “النهار”، كما عكَس في “الملحق”، آمال المرحلة وآلامها. ولم يكن غسان تويني يخفي إعجابه الشديد بهذا النقيض الكارِه للسياسة، الباعِد عن السياسيين، النافِر عن المجتمعات، ولكن من بعيد، يغوص في شؤون الوطن كأنه مُناظر مدرسة كثُر أمامه الطلاب الزعران والمُهمِلون والمُتهوِّرون والبُلَداء غلاّظ الذهن.
كان يلمح كل شيء، ولو بدا بعيداً ومنعزلاً. وكان يكتنز مآثر الناس ومشاعرها وأحاسيسها، فإذا حان الوقت، تفجَّر بها، حانياً ومحامياً. وكانت موهبته العظيمة تتّسع للمراحل التي كان فتى كل منها. مرحلة الانبهار بالسوريالية وأندريه بروتون وأراغون، ثم فجأة، يطلّ كأنه كاهن بين كتَبَة نشيد الإنشاد، عاشقاً وَلِهاً مثل نهر الينابيع.
في “أدب فكر فن” حوَّل الثقافة إلى صحافة يومية. وفي “الملحق” انتقل بالأدب والأدباء من المجلات الشهرية إلى الصحافة الأسبوعية. ولمع “الملحق” في موازاة “النهار” توأماً بمعالم مختلفة تماماً. وكان لبنان ينتظر “كلمات كلمات كلمات” ليغضب معه ضد القوة والظلم والتخشّب وتسخيف المنائر.
كم كانت تثيره الغِلظة والحَماقة. سألت عقل العويط إن كان أنسي قد مدّ يده لتناول البرشانة “يد مريض محرومة الهواء الطّلق. إن براثن الموت لم تظفَر بجلد أكثر طراوة وطلاوة من هذه اليد”. وإن كان “رفع باليد الأخرى جفن عينه المشلول، وهي عين لا تزال تحتفظ بمفهوم غامض للأشياء”، كما قال تيوفيل غوتييه.
أفَقْت على قراءة هذا الحبيب. وما قرأت له نصاً على أنه مجرد نص آخر. فكلّ نصٍّ وضعَه، كان فيه خليط من السحر والبلاغة والمفاجأة. وكان فيه دوماً الدعوة المقدسة إلى الانعتاق وذرّ للحرية على كل نقطة: حرية العبيد وحرية النساء وحرية الجمال.
أخيراً تحرّرت روحه المتمرّدة من قفَص الاحتضار. منذ أشهر وهو يكتب كنوع من المراثي، مكاشفاً أصدقاءه بما كان يضنُّ به وهو يشتدّ التصاقاً بعالمه الداخلي المُغلق بقِفل من عود الورد. عائشاً في غربة دائمة ومحصَّنة، لا يظهر في محاضرة، لا يُشاهد في منتدى، لا يقبل دعوة إلى مكان، يخشى حضور الجنازات وتقديم التعازي. النموذج الصافي الذي رسمه كولن ولسون في “اللامنتمي”، ولكن بصلابة لا تعرف التراجع ولا يليِّنها إغواء.
عاش في حسرة من الصحافة. سرقَت منه التفرّغ للشعر. وحسرَتُه الخفية كانت الرواية. قليلاً ما أقرّ أنها أعظم أنواع الأدب. سمِعتُه يقول ذلك في شبابنا عندما كان لا يزال يتسرّب من قلعته بعض الاعتراف. حتى المقابلات تجنّبها لئلا تقوِّض انزواءه وتُفسد أسواره.
وحدها المرأة شاركَته في الطلعة على التلّ والنزهة في الغابة ومقعد الحديقة بعد سدول الليل. أمامها وحدها خلَع قوّته وترك لها أن تقصّ شعره وتَمحَق صلابته واضعاً عنفوانه تحت قدميها، ممدّداً روحه الجميلة بين خصائل شعرها الطويل حتى الينابيع.
كلمات كلمات كلمات – حسرات حسرات حسرات. حسرته الكبرى كانت بلده. قبل خمسين عاماً كتب: “غداً يُعزف النشيد الوطني ونحن جالسون”. لم يعد هناك من يعزفه. الآن يتهمونه أنه مسروق من نشيد الريف المغربي. والوطن برايات كثيرة وعلمه على التراب.
الشاعر والوحش
الياس الديري
بيني وبينك أنسي، قهرني رحيلك. وزرع في نفسي حزناً قاسياً كحدّ السيف. وحين غمَرتُك للمرّة الأخيرة وطبعتُ على جبينك العالي قبلة، أظنّك سمعتني أهجو ذلك الوحش الذي غدَرك، وجعلَك تُبكّر في الرحيل، وكنا لا نزال نفكّر في ما يلي في هذه الدنيا الفانية، وفي هذا الهجير الصحراوي، وسط ضحالة مريعة.
يا رفيق الزمن الجميل، يا صديق الأيام الصعبة، ستسامحني لأنني لست الآن في وارد الحديث عن الشاعر المُتمرّد، والكاتب المُبدع، والظاهرة التي شكَّلْت نجمتها وأنت في أول الطريق مع ذقن وشاربين وشعر طويل وصوت يرنّ مثل النحاس، وصيت لعنترة الكلمة سبق صيت عنترة السيف.
ولا عن ذلك الأبيّ الأنوف الأنيق الجميل الذي كُنتَه وحافظتَ عليه وعلى خصاله كلها، حتى خلال صراعك ونِزالك مع ذلك الوحش. فغلَبتَه مرّة، ثم مرّتين. ثم ضقت ذرعاً به.
همّي الآن، كل ما أرغب فيه وأودّه الآن أن أحكي مع أنسي. أُنسي ورسولاته بشعور طويلة حتى الينابيع. وبعشق تهتف له الأمكنة والليالي والصباحات، من سوق الطويلة إلى شارع الحمراء إلى باريس إلى الحمراء ثانية. فإلى الوحدة الصارمة الشروط. إلى الغربة التي لم نستفق منها إلا بعد اندثار كل الأوهام وكل ما ضحكنا له ضحك طفلين معاً، وكل ما طرّزناه على الأوراق والصفحات والجدران، وبشتى الألوان والألحان.
ثم إلى أمّنا الخالدة في نفوسنا وأجسادنا وأقلامنا وكلماتنا، السيّدة الأولى التي تختصر حركة الدوران للزمن والفصول والأعمار، والتي تُدعى “النهار”.
لا أدري كيف حملت حالي بعد عودتي من وداعك، وسرت في اتجاه المكان الذي كان يقيم فيه مقهى “لاروندا”، حيث كنا نتجمّع لننطلق صوب مطعم مروش لنملأ بطوننا فولاً مدمّساً. غير أنني لم أهتدِ إلى معالم ذلك المكان. فزعلت، ويمّمت وجهي صوب سوق الطويلة حيث كانت تجثو تلك القرميدة التي استضافت “النهار” ردحاً من البدايات الصاخبة، وحيث كان مكتبك يلاصق مكتبي، فلم أجد معْلَماً واحداً من زمننا.
أين ذلك السلّم الطويل بدَرَجاته التي كانت تقاصصنا في الصعود والهبوط؟ كأن كل شيء تحوّل ذكريات من الأطلال.
لن يكون من السهل بَعْثرة كل هذه السنوات التي أمضيناها معاً، وبمرّها قبل حلوها. ولكن حتى المرّ منها كان يُضحكنا.
لقد كان عنده الكثير ليقوله ويكتبه ويترنّم به، ويجعله يشعرنا بأن الدنيا، دنيانا على الأقل، لم تصبح ظلاماً كلها، ما دام أنسي الحاج لا يزال شاهراً قلمه، وشاهراً ضحكته التي تنشر الفرح على مسافات بعيدة. لكن الوحش أبى إلا أن يغدره.
حين تناولت قلم “البيك” لأحكي معك كتابةً، وجدتك تحضر بكل ما في أرجائك من غضب وسخرية وشجاعة.
أحبّك أنسي، وسأظلّ أتفقّد أماكننا الضائعة إلى أن تتعب الشيخوخة من الضجر والفراغ.
أنسي الحاج وليمة المُفترس الأكول
عقل العويط
مات أنسي الحاج.
أيها الأدباء والقرّاء في لبنان والعالم العربي وفي العالم الناطق بالشعر، لا بدّ من إشهار الحقيقة القاسية، كما هي، كلبةً وعاهرةً، على غرار الحياة مطلقاً: الشاعر والكاتب والصحافي الكبير أنسي الحاج، ابن الكاتب والصحافي الكبير لويس الحاج، ربيب “النهار” من 9 آذار 1956 إلى أيلول 2003، ورئيس تحريرها لزمن، قد تدهور به المرض الأكول، إلى حدود الهلاك والعطب المستعصي.
هذه هي الحقيقة، التي يجب أن تعرفوها، وإن على وجعٍ مُهلكٍ منّا، مرفقٍ باعتذارٍ حبيب ومنسحق ومتواضع نوجّهه إلى أهله ومريديه: هذا الخطر الذي كان مفتوحاً على إلحاحات الغياب وهلوسات الموت، قد فات أوان التئامه بعد الآن. بل اليقين الأكيد هو هذا. لم يعد في مقدور هذا الذئب الشاعر أن يطيق الإقامة في كتاب الجسد المهيض.
المسألة واضحة، كما تعلمون. بل أكثر.
فأنسي الحاج وقع مريضاً بالسرطان الذي “تنبّأ” به منذ العام 1960، في مقدمة كتابه “لن”.
وإذا كان، هو، قد “لوّث” اللغةَ العربية، وهسترها، وفخّخها، وفخت عذريتها برضاها، ومحقها، وسرطنها، وزلزلها، فإن السرطان الذي نغل في كبده، وأنحاء كيانه، قد لوّث الآن جسده، وهستره، ومحقه، وسرطنه، وزلزله، ممعناً فيه تيئيساً وتخريباً وقتلاً.
المسألة واضحة تماماً: لم يتمكّن الشاعر، من أن يظلّ يغضّ الطرف عن هذا السرطان الوالغ في جسده البشري البالغ الهشاشة.
وها هي النتيجة، وهي كانت محسومة سلفاً.
أيها الأدباء والقرّاء، لقد آلت نهاية الجسد إلى توقيتها الأخير: الشاعر المسرطِن الذي سرطن اللغة، وجنّنها، قد سرطنه السرطان، الذي يقهقه، ويفحش، ويُجهز.
فلنُصَب بالذهول التراجيدي، كالذهول المصابة به هذه اللغة العربية، التي فكّك، هو، مفاصلَها، وخلخلها، وعرّى أسرارها، وراود جسدها، وعربد مع روحها، ونام مع جوع حروفها وعطش كلماتها، فذهبتْ إليه، ربما لتنتقم، لكنْ لتكتشف كينونتها اللغوية المؤجلة، ولتتعرّف إلى جسمها المرجأ، ولتلاعبه، وتشمّس عنبه وزبيبه، ولترغب به، وتشتهيه، وتفضّه، وتهلوسه.
فلأغتسل، قالت اللغة، ولأُنكَح، ولأتكهرب، ولأتعهّر، ولأستلذّ، ولأُمعن، كما لم أفعل مع أحدٍ غيره.
لقد ذهبت اللغةُ العربية إلى أنسي الحاج، بملء عقلها وجسدها التاريخيين، لتلد، بعد الثأر. وتولد.
لكنّ أنسي الحاج هذا، قد أصبح مسافراً أيها السادة.
هذا المستغيث، وهو في بطن أمّه، الملعون، المعطوب بالولادة، الشيطان، الرائي، المعربد، العاهر، الماكر، المنتقم، المفتن، الهارب، اللاجئ، المختبئ، الخائف، المذعور، الكريم، المبذِّر، النقي، اللازورديّ، الشفّاف، الحالم، البريء، المجترح، الموصول بكهرباء الكون، أنسي الحاج هذا، لن يجد في جسده لغةً تؤويه بعد الآن.
أيها الأدباء والقرّاء، في كلّ مكانٍ شعري من العالم، لم يعد يُجدي الكتمان.
شأن أنسي الحاج الذي “رأى”، هو، في هذه اللحظات المهولة، شأن “الملك يموت”، شأن الملك الذي مات، رائياً موته، وكاتِباً هذا الموت، لكنْ من دون حبر.
لقد طلبنا له أن يهزم السرطان. لقد طلبنا له أن يكسر الموت.
لكن. عبثاً. لن.
فأنسي الحاج لن يقلب مائدة المرض الأكول، ليقوم يمشي بيننا، وفي كلماته، بأبّهة الذئب الشاعر. وها نحن نطلب له، إذاً، النومَ اللطيف الطويل حتى الينابيع.
أنسي الحاج “الرسول” بشِعره الطويل حتى الينابيع (1937 – 2014) شاعر الحرائق
رامي زيدان
تصعب الإحاطة بمختلف جوانب الفرادة عند الشاعر أنسي الحاج، المباغت والوحشي، في عجالة واحدة، وفي هذا المناسبة بالذات. فهو شاعر ذو أقنعة ووجوه مختلفة، متفجرة، هدّامة، خلاّقة، متجددة، نقية، وتدميرية، وهو أحد أعمدة الثقافة اللبنانية، مثله مثل جبران وفيروز والرحابنة وسعيد عقل، ومجلات “شعر” و”الآداب” و”المكشوف” و”الأديب” و”الندوة اللبنانية”، حتى لتكاد تجربته الأدبية الطويلة تكون مرآة شاملة للثقافة اللبنانية الحديثة من الخمسينات حتى الآن.
كان أنسي الحاج ساحراً باسمه، فهو عرف كيف يحفر هذا الاسم وأسماء كتبه بل مقالاته في حسّ القراء والمثقفين والطلاب والتلاميذ والأحفاد والمنتقدين والمعترضين، بدءاً من “لن” وصولاً إلى “خواتم”.
هذا هو
هو في كل الأحوال، له أدواره وشخوصه وأقنعته، حيث تتجاور المتناقضات وتتشابك في مفرداته، فيجمع بين الموسيقى الجوانية والداخلية والحرائق، بين الفوضوي والرجعي، بين سيد الفجور وناسك الإيمان، بين شيطان مؤمن وملاك كافر، بين نقاء مبعثر وتناثر متجاوز، بين صلاة الناسك وخطيئة منتهك اللغة، بين ازدراء الاندهاش وتمجيد الفجيعة، بين الحنان وعنف الحنان، بين التعالي والشقاء الأمومي، بين الضعف والسوبرمانية، بين الأقلوي المسيحي والكوني المتفرد، بين اللبنانوي الفاجر والعروبوي الغامض والملتبس والفصامي، بين المحكوم بالإعدام وحبل المشنقة، بين الرسولة والرأس المقطوع، بين صراع غزيزتَي الموت والحياة، بين الشاعر المسيحي والمسيحي الشاعر، بين الاريستوقراطي والمتوتر الدائم، بين الشاعر الملعون بوجدانه والشاعر المرفه في مكانه، بين خراب اللغة وخلقها، بين اللغة واللالغة، بين تجديد اللغة العربية والضغينة على التراث العربي البالي، بين الأدب وضد الأدب (اللادب)، بين حرية الكلمة ومروق القصيدة، بين معاداة التراث العربي وعبادة التراث الأوروبي، بين احتقار المتنبي وأحمد شوقي والفرح العارم بجاك بريفير وبروتون، بين الملل من جبران والانجذاب لتوتر فؤاد سليمان وتموزه، بين الإنجيل الإيماني والكنسي والحركة السوريالية الملحدة، بين القلق الوجودي والتشبث بالفراغ والعدم، بين تقديس فيروز المغنية الخجلى وهجاء المطربة أم كلثوم السلطانة، بين الهتك المخلص والخلاص في الهتك، بين الرومنطيقية الحادة والغضب الموزع في كل الاتجاهات، بين مجد الموسيقى الداخلية ولهاث الإختزال، بين المرأة والحرية، بين عيون الذئب وشفاه الينابيع، بين الزندقة والدعابة، بين الحب والهرب من أسر الحب بحثاً عن الحرية، بين السخرية المرّة والمداعبة الإباحية والهذيان العبثي، بين الساحر والشاعر، بين السخرية الكتابية ووحشة غناء فريد الاطرش.
ما قبل وما بعد
من الضغينة والتوتر، ومن خارج التعبير المدجن والمعقلن، ولدت قصيدة أنسي الحاج في النصف الثاني من الخمسينات. هي قصيدة شخصية قبل أن تكون قصيدة نثر وقبل أن يكون هناك قصيدة نثر عربية، وقبل أن تتكرس هذه القصيدة في ديوان “لن” الذي صدر عام 1960. قد نحب هذا الكتاب وقد لا نحبه، وهذا أمر يتعلق بذوق كل قارئ أو ناقد، لكن الذي لا يمكننا الهرب منه، هو أن هذا الديوان كان محطة أساسية في الشعر العربي خلال القرن العشرين. هناك مقولة هي الآتية: ما قبل “لن” وما بعد “لن”. حتى وإن كان ثمة قصائد نثر سبقت هذا الديوان، فإن النجومية بقيت له، فبات يؤرخ للتحول في الشعر العربي وقصيدة النثر تحديداً. صدر هذا الديوان ضمن سلسلة منشورات مجلة “شعر”، على نفقة أنسي الحاج الخاصة، بما قدره مئة ليرة لبنانية، حاوياً بين دفتيه عدداً من النصوص أولها ”هوية”، وآخرها “حرية حرية حرية”. وقد ارتأى الحاج أن يسمّي هذا الديوان بحرف ناصب يفيد معنى النفي، لما ألفاه فيه من إمكان للتعبير عن موقفه من الواقع الموبوء المعيش آنذاك.
إلى جانب نبرة الرفض والغضب والضغط الطاغية في ديوان “لن” كله – وهو “ليس صرخة رفض للرفض”، كما يقول الأديب خليل رامز سركيس، بقدر ما يعني عمل الرفض في مصير الإنسان– تميزت طريقة كتابة نصوصه بخواص واضحة، لغةً وتصويراً وأسلوباً وإيقاعاً وبناء. لا تقتصر الشهرة على نصوص “لن”، الفاجرة والمشحونة بالغضب أو المزينة ببعض الملامح “السوقية” والمتوترة، بل تتعداها أيضاً، بالقدر نفسه أو أكثر، إلى تلك المقدمة النقدية – البيان التي كتبها أنسي الحاج لهذا الديوان، والتي حفلت بعدد من القضايا الأدبية بطريقة موجزة ومعبرة. محنة الكثير من النقاد انهم توقفوا عند المقدمة أكثر من الديوان نفسه، بل جعلوا أنسي الحاج أسير “لن” ومقدمته.
لقد تولدت المقدمة من حماسة شاعر مفرط في الاحتفاء بشعر جديد، تضمنت وعياً مبكراً بإشكالات لا تزال مستمرة. كان ملحاً ان يكتب الحاج تلك المقدمة ليشق الطريق امام قصائده، مع انه يعتبر ان الشعر يدخل بلا إذن، وهو ركّز على فكرة أساسية يختتم بها مقدمته يصف فيها شاعر قصيدة النثر بكونه شاعراً ملعوناً، ولا يكتفي بهذه الصفة، بل يرفقها بصفات تفصيلية تؤكد لعنة ذلك الشاعر. فهو ملعون في الجسد والوجدان معا، ولعنته نوع من الإصابة والمرض الممتد إلى الآخرين. “الجميع يعبرون على ظهر ملعون” كما يقول، أما مصدر اللعنة فمن الشاعر ومن متلقيه معا. الشاعر ملعون بسبب “كفاحه” لإشاعة الحرية بكل الوسائل بما فيها تلك التي لا تتطابق مع القيم المسلّم بها عند الآخر (المستهدف)، والآخر ملعون لمعاكسته الشاعر ومحاربته له. يضيف أنسي الحاج إلى الشاعر صفة أخرى أكثر مفارقة، هي نعته بالإله. بذلك، يعطيه سلطة غيبية متعالية رائية ترفع مقامه بين المتلقّين الذين عليهم في هذه الحالة، الخضوع للشاعر، لانحطاط وعيهم وحاجتهم لبصير وعليم بالأحوال الفنية. وهو لذلك يدعو الى “الهدم والهدم والهدم، إثارة الفضيحة والغضب والحقد”. يريد الشاعر الجديد زحزحة “الألف عام” المتراكمة من “العبودية”: “أول الواجبات التدمير، الخلق الشعري الصافي سيتعطل أمره في هذا الجو العاصف، لكن لا بد، حتى يستريح المتمرد إلى الخلق، لا يمكنه أن يقطن بركاناً، سوف يضيع وقتا كثيراً، لكن التخريب حيوي ومقدس”.
كتاب “لن” هو كوابيس طفولة الشاعر ومراهقته. عندما كتبه “كأنه كتابه الأول والأخير”، كما يقول. وإذ أحدث صدمة كبيرة فلأنه كان يحمل الشحنة الأولى والأقوى من العالم الداخلي، ولأنه ربما كشف، وللمرة الأولى، عن لغة صادمة.
أصدر الحاج “الرأس المقطوع” الذي لم يختلف كثيراً عن “لن”، ثم “ماضي الأيام الآتية” الذي حصل فيه بعض التغيير اللغوي، وكانت خالدة سعيد من أوائل من أكد خصوصية التجربة اللغوية في “لن” ووقوعها موقع صراع بين “اللغة واللالغة”. تقول: “هذا ما شحن شعر أنسي الحاج بالنزق والتمزق والتوتر، وكان من نتيجة هذا الصراع ما سميته منذ عشر سنوات، يوم صدور “لن” باللعثمة، هذه (اللعثمة) التي حجبت شعره السابق عن عامة القراء الذين اعتادوا الفكر المقولب المكبسل المنمق التفسيري، هي نفسها جعلت له في نظر قرائه جاذبية خاصة”.
من وجوه الفرادة لديه، أن المرأة تمتزج عنده بالمراحل الأساسية كلِّها، “الولادة والحياة والموت”، فهو يعتبرها “أرض الكلمات وفضاءها”، وعلاقته بها علاقة انتحارية، فـ”كلُّ امرأة هاوية، وكلُّ حبٍّ سقوط فيها”. يعترف بأنه “لم يحب إلا ما فيه إمرأة”، ويرى المسيح “من خلال المرأة”. إلحاحه على النثر “أنْ غدا النثر جوهراً في الشعر”، بحسب تعبير الشاعر شوقي أبي شقرا، إذ يسحره إسقاط العاطفية والغنائية والتقاليد الموروثة والعنف التصويري والتقشف النغمي، وإقلاق الثوابت، والتأليف بين الأضداد، وبعثرة المتآلف، وانقطاع حبل المعنى. فهو متمرد ويكره الثورة، شعره شعر ديني، وخصوصاً في الجانب الملحد منه، كما يقول، جاعلاً للكلمة سلطتها وقرارها، وهو المتمرد والفوضوي “الذي ينفخ في مزامير الأنبياء”، والقابض، من خلال كسره القوالب، على “جذور الحالة الشعرية”، والصانع شرعيةً لقصيدة “هجينة” أو “لقيطة”، ضاع النقاد في تفسير مصادر التنظير لها.
الانزياح
كان أنسي الحاج قد انزاح في لغته الشعرية عن تجربة “لن” و”الرأس المقطوع” و”ماضي الأيام الآتية” في ديوانه “ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة”. وإذا كان هناك من تغيّر فمردّ ذلك إلى أمرين: علاقة الشاعر بالمرأة التي انتقلت من المونولوغ إلى الحوار، أي محاولة إيجاد الشخص الأخر (قبل ذلك كان الشخص الآخر هو اختراع خياله، ثم أصبح له وجود).
سيكتب الحاج نصاً طويلاً بعنوان “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع”، غارفاً من الجماليات الرومنطيقية والغنائية، فاتحاً للذاتي الحميم مجالاً أوسع للتعبير. وقد أشارت خالدة سعيد إلى هذا الخرق الذي مارسه أنسي الحاج على ذخيرته الشعرية الشخصية. وقد لاحظت أنه تخلى في ديوان “ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة” عن لغة دواوينه السابقة، فمثّل نوعاً من الاغتراب اعتبرتها “لحظة استراحة تنتقم من صمت السنين”. أما اللغة التمثيلية النموذجية عند أنسي الحاج من وجهة نظر الباحثة، فهي لغة دواوينه الأولى.
مصادر
تختلف الآراء حول مصادر أنسي الحاج الشعرية. هناك تعميم في النقد يعتبر أن مصادره ومنطلقات الهامه كلها غربية، وفرنسية تحديداً، لكن الحاج يعتبر هذا الكلام ليس له أي نصيب من الحقيقة. فعندما بدأ كتابة قصيدته لم تكن مجلة “شعر” قد وجدت بعد، كما لم يكن كتاب سوزان برنار، “قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا هذه”، الذي أخذ الحاج وأدونيس منه تسمية “قصيدة النثر”، قد صدر بعد أيضاً. قبل كل شيء لم يكن أنسي الحاج يعرف أن ما يكتبه هو “قصيدة نثر” أصلا!
أدونيس هو المنظّر الأول لقصيدة النثر في اللغة العربية. مجموعة الماغوط، “حزن في ضوء القمر”، صدرت قبل “لن” بعام كامل. لكن “لن” هي اول مجموعة ضمّت قصائد نثر عرّفت عن نفسها علناً بهذا الاسم. يذكر أنسي الحاج في أكثر من مناسبة أنه اطلق وأدونيس تسمية “قصيدة النثر” على الشعر الذي كانا يكتبانه وذلك في محاولة لإعطائها نوعاً من “الوجود الشعري، نوعاً من الهوية وكي يوقفا التسميات الأخرى” مثل: “شعر منثور”، و”نثر شعري” وما شابه ذلك. قصيدة النثر ليست تيارا او مدرسة. إنها نوع أدبي هجين كتب في فرنسا وأضفى عليه بودلير شرعية من خلال اطلاق تسمية محددة عليه، ولا يختلف الأمر في العالم العالم العربي. يذكر الحاج “إن هناك بعض الكتّاب كتبوا هذا النوع الشعري بالعربية قبل أن يسمّى، مثلما حصل في اللغة الفرنسية، وأنا من هؤلاء، فقد بدأت بكتابة قصيدة النثر قبل أن نتوصل، في ما بعد، إلى إطلاق هذا الاسم عليها”.
عندما بدأ أنسي الحاج يكتب هذا النوع الشعري، كان لا يزال في المدرسة الثانوية، وكانت التصنيفات الأدبية تنقسم بين شعر ونثر ونقد وما شابه ذلك، ولم يكن قد اطلع بعد على التيارات الأدبية الحديثة، “إنما كنت قارئاً ومعجباً بكتّاب لبنانيين كتبوا شيئاً من النثر الشعري، خصوصاً أولئك الكتّاب الذين جمعوا بين الغنائية والتوتر”. كان يمل من جبران خليل جبران ويضجر منه ويحب نبض فؤاد سليمان وتوتره وهو كان يوقع كتاباته باسم “تموز”. بعد ذلك اطلع على كتابات كاتب آخر اسمه الياس خليل زخريا، وهو شاعر وكاتب مغمور. هذان الاسمان يذكرهما أنسي الحاج في مقدمة ديوان “لن” كمصدرين من مصادره الشعرية، ويقر بأن جذوره الشعرية والأدبية هي جذور عربية ليس لها علاقة إطلاقاً بالقصيدة الأجنبية. “أقول إن مصادري الأولى كلها عربية”، واطلاعه على القصيدة الفرنسية الحديثة جاء بعد أن نشر في مجلة “شعر” وليس قبل ذلك.
خواتم
لم يُعرف أنسي الحاج كشاعر فقط، بل عرف أيضاً كناثر عبر زاويته الشهيرة “كلمات كلمات كلمات” التي انصرف إلى كتابتها طوال سنوات في “الملحق” الذي أسسه في العام 1964. هذه التجربة النوعية هي الثالثة بعد “لن” و”الرسولة”، وأرّخت لزمن خصب ولمرحلة كاملة من تاريخ الثقافة اللبنانية والعربية. كما واكبت من الداخل تلك الحقبة الذهبية من تاريخ لبنان الادبي والفني والسياسي. وجاءت مرحلة الحرب فرفضها أنسي الحاج ورفض منطقها وآثر الصمت والعزلة، ولم يعد الى الكتابة في المطبوعات إلا من خلال مجلة “الناقد” التي اصدرها رياض الريس في نهاية الثمانينات، فكان يكتب مقالا شهرياً في زواية “خواتم” وسرعان ما صدرت المقالات في كتابين. نصوص “خواتم” شذرات فكرية ونقدية وجمالية، شذرات تأمّلية إلى الدرجة التي يتمنى فيها موت الكلمة: “… فلتمت الكلمة! فليمت الشعر، الأدب، الفن، لتنقرض اللغة ليضمحل الإنسان الإلهي لحساب البرنامج، ليبسط النسر الجديد جناحي ملكوته العملاق على الشرق والغرب”. لغة “خواتمه” هي تواصل الإدهاش والإلفة والحميمية والمصارحة التي تلامس السهل الممتنع، لكننا نراها تنقلب فجأة وتأخذنا إلى ما وراء التعبير حيث الشعر في النثر.
في العام 1994 أصدر انسي الحاج مجموعته “الوليمة” وهي امتداد لتجربته الشعرية، وهي في الوقت نفسه مختلفة عن اعماله السابقة، وفيها دعوة الى حرق الشعر.
ثمة تباين واختلاف في تقويم نتاج أنسي الحاج الشعري والنثري، فغالباً ما يعجب بعض النقاد وشعراء الحداثة بتجربته الأولى، أي “لن” و”الرأس المقطوع” و”ماضي الأيام الآتية”، ويعتبروها متجددة وشبابية وسابقة لأوانها. لكن ثمة ميل من بعض القراء الى كتاب “الرسولة بشعرها الطويل” الغنائي الكنسي الايقاعي الحميمي. أما المفارقة ففي شغف القراء بسلسلة “خواتم” التي كان يكتبها في السنوات الأخيرة. فمن يراقب مدى انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، يدرك مدى اهتمام القراء بها، والقصد من “خواتم” ليس مواقفه من بعض الأحداث السياسية السورية والاقليمية التي اصطدم فيها بالكثير من محبيه ومريديه ومتابعيه، بل نقصد وجدانياته وشذراته الحسيّة التي تخاطب القلب والعقل بلغة نثرية نادرة عن الحب والموت والحياة والمرأة والدين والالحاد والمسيح واليهود والجسد والرغبة والخطيئة والشعر والشعراء والأدب والاصدقاء والقمار وفيروز وعاصي والموسيقى وبيروت والنهضة والنهضويين والحميميات والغرابة والعزلة والأوثان واللاوعي… الخ
بعد عقود على تجربة أنسي الحاج ورفاقه في مجلة “شعر”، وفي كتبه “لن” و”الرأس المقطوع” و”ماضي الأيام الآتية”، كما في كتبه وتجاربه الأخرى، انتصرت قصيدة النثر. لكن، في غيابه الفادح الآن، ربما ينتظر الشعر أنبياء جدد، ينتصرون له بضغائن جديدة وتمردات مختلفة.
أنسي الحاج “الرسول” بشِعره الطويل حتى الينابيع (1937 – 2014) – هو
من آل الحاج من بلدة قيتولي، قضاء جزين، الجنوب. مولود في بيروت في السابع والعشرين من تموز 1937. تلقى علومه في مدرسة الليسيه الفرنسية ثم في معهد الحكمة في بيروت. بدأ ينشر وهو على مقاعد الدراسة، مقالات وأبحاثاً وقصصاً قصيرة في مختلف المجلاّت الأدبية في منتصف الخمسينات، وكان على اهتمام خاص بالموسيقيين الكلاسيكيين. تزوج في العام 1957 من ليلى ضو، ورزق منها ندى ولويس. احتفط بشعره ولم يبدأ بنشره إلاّ في أواخر الخمسينات. بدأ العمل في الصحافة في العام 1956 في جريدة “الحياة”، ثم في “النهار” مسؤولاً عن القسم الثقافي، ابتداء من 9 آذار 1956، العدد 6209. وتولى كذلك مسؤوليات تحريرية عديدة في “النهار” وأصبح رئيس تحريرها منذ العام 1992 إلى أيلول 2003. في العام 1964 أصدر “الملحق” الأسبوعي لـ”النهار”، الذي ظل يصدر عشر سنين حاملاً مقاله الاسبوعي “كلمات كلمات كلمات”. مقالاته، بين “النهار” و”الملحق” ومجلات لبنان الأدبية، لا تحصى، جمع بعضها في ثلاثة مجلدات صدرت عن “دار النهار” في العام 1988. أشرف على اصدار “النهار العربي والدولي” في بيروت. شارك في تأسيس مجلة “شعر” وفي اصدارها، وكان أحد اركانها منذ 1957 حتى توقفها في عهدها الاول (شتاء 1957 – صيف وخريف 1964)، ثم في عهدها الثاني (شتاء وربيع 1967 – خريف 1970). وفي اعدادها الاولى، ظهرت له كتابات نقدية ولم ينشر قصائد. أول ما نشر قصائد فيها كان العام 1958. وكل قصائده المنشورة هي قصائد نثر. في العام 1960 ظهرت مجموعته الشعرية الأولى، “لن”، “دار مجلة شعر”، مع مقدمة كتبها بنفسه في موضوع قصيدة النثر خاصة والشعر عامة. الحرب الأدبية التي أثارتها “لن”، اشترك فيها الشعراء والكتاب من العالم العربي كله، وكانت حداً فاصلاً في تاريخ الشعر العربي المعاصر. في العام 1963 صدرت مجموعة “الرأس المقطوع” عن “دار مجلة شعر” في العام 1965 صدرت مجموعة “ماضي الأيام الآتية” عن “المكتبة العصرية”. وفي العام 1970 صدرت مجموعة “ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة” عن “دار النهار للنشر”. في العام 1975 “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع” عن “دار النهار للنشر” وفي العام 1983 أعاد طبع كتابيه الأولين: “لن” و”الرأس المقطوع” عن “الدار الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع”. أصدرت له “دار الجديد” دواوينه الخمسة الأولى في العام 1994، وصدر له ديوان “الوليمة” لدى “دار رياض الريس” في العام 1994، وبالفرنسية في باريس لدى “دار أكت سود” في العام 1997 أنطولوجيا “الأبد الطيار” التي أشرف عليها وقدّم لها عبد القادر الجنابي، وأنطولوجيا “الحبّ والذئب الحب وغيري” في الألمانية في العام 1998، ترجمة خالد المعالي وهربرت بيكر. صدرت له “خواتم 1″ في العام 1991، و”خواتم 2” في العام 1997 لدى “دار رياض الريس”. في نيسان 2007 صدرت أعماله الكاملة في ثلاثة مجلدات لدى “هيئة قصور الثقافة” في القاهرة.
في الستينات ساهم في إطلاق الحركة المسرحية الطليعية في لبنان من طريق الترجمة والاقتباس، وكانت ترجمته لمسرحية “كوميديا الأغلاط” لشكسبير بلغة حية ومتحركة (مسرحية) وفصحى، همزة وصل بين الجمهور والمسرح الجدي، قديمه وحديثه. لكن نجاح هذه اللغة، ظهر، أكثر ما ظهر، مع ترجمة لمسرحية “الملك يموت” لاوجين يونسكو في العام 1965. ترجم ايضاً للفرق المسرحية اللبنانية (بعلبك – منير أبو دبس – برج فازليان – شكيب خوري – روجيه عساف – نضال الاشقر…) مسرحيات “العادلون” لكامو، “القاعدة والاستثناء” لبرشت، “احتفال لزنجي مقتول” لأرابال، “نبع القديسين”، “رومولوس الكبير” لدرونمات، و”الآنسة جوليا” لسترندبرغ.
إلاّ أن أقوى اندفاعاته، على صعيد المشاركة في الحركات الفنية، ربما هي اندفاعته مع الأخوين رحباني، اللذين كان بدء معرفتهما الشخصية به في حزيران 1963، على اثر مقال كتبه عن فيروز، رافضاً مبدأ المقارنة بين صوتها وبين أصوات مطربات أخريات، معتبراً أن في صوت فيروز، فوق الجمال والبراعة، “شيئاً أكثر” كما سمّاه، هو العامل الغامض الذي لا يستطيع أحد له تفسيراً، والذي سيظل يحيّره، كما يظل كل “شيء أكثر” في الخليقة يحيّر العقل والتحليل. الواقع أن هذا المقال لم يكن الأول الذي كتبه أنسي الحاج عن فيروز. ففي العام 1956 كتب في مجلة “المجلة” مقالاً عنها بعنوان “فيروز”.
ترجمت له قصائد عديدة الى الفرنسية والانكليزية، واستوحى بعض المسرحيين قصائد له فأخرجوها (منهم يعقوب الشدراوي وريمون جبارة)، كما استوحى بعض الموسيقيين قصائد له في أعمال موسيقية.
وكثيرون من الرسامين اللبنانيين والعرب (بول غيراغوسيان، رفيق شرف، منير نجم، جان خليفة، وضاح فارس إلخ…) اقترنت رسوم لهم بقصائد له.
أنسي الحاج “الرسول” بشِعره الطويل حتى الينابيع (1937 – 2014) – منذ بواكيره في “النهار“
جان داية
في 15 شباط 1956، نشرت مجلة “صوت الأجيال” البيروتية في عددها الأول الخبر الأدبي الآتي: “علمنا ان في ادراج أنسي لويس الحاج فصولاً عن الموسيقى منها جاهز، ومنها في الاعداد، وهو جادّ في جمعها الآن في مؤلف ضخم قد يستدعي ليرى النور أكثر من تسعة أشهر. ولديه كذلك مجموعة شعرية لم ينشر بعد قصيدة منها، ومقطوعات شعرية منشورة جديدة من نوعها، تؤلّف ديوانين كبيرين. وهو منصرف الآن، معظم الوقت، إلى هذا النوع الممتع من الأدب، ومجموعة قصصية ستظهر في كتاب قريبا، ومجموعة مقالات في النقد والسيرة”.
كان يمكن أن يستعدّ قرّاء المجلّة لشراء الكتب العتيدة، إن لم يكن بالجملة فبالمفرق، لو كان أنسي من مواليد 1917 أو حتى 1927، إذ ليس كثيراً على أديب موهوب في التاسعة والثلاثين أو في التاسعة والعشرين أن يدفع للمطبعة مؤلفاً ضخماً عن الموسيقى، وديوانين، ومجموعة قصصية، وكتاباً في النقد، وآخر في السيرة. أما وان صاحب المخطوطات من مواليد 1937، فإن حواجب القراء قد ارتفعت إعجاباً وتعجباً من ابن التاسعة عشرة وهم يتساءلون: متى ألّف مَن هو دون العشرين الكتب الستة الضخمة، وكم مئة كتاب سيصدر له حين يصبح في السّابعة والسبعين؟ قبل أن ترتطم الحواجب بسقوف البيوت العالية جداً وقتذاك، نشر قلم التحرير، في العدد نفسه، مقابلة طويلة عريضة مع أنسي الذي شرب كعادته حليب السباع وانتقد خلالها كبار الشعراء في مصر وبلاد الشام. في ما يأتي عيّنة من الأجوبة التي تعزز صدقية الخبر الأدبي.
رداً على السؤال الأول، أكد أنسي ان “جبران شاعر في “النبي” قبل أن يكونه في “المواكب”. فهو في الثانية الحكيم المتقشف والواعظ الناقم. لقد خانه العروض، وضيّق على خياله الذي يأبى الحصر. ولم ينفث الشعر ناضجاً إلا في نثره المتمرد الجميل حيث استراح إلى حرية التدوين، والاعتراف، وأعمل تمرده في نسف ما تعفن”. وعندما أبدى السائل تعجبه من اعجاب أنسي بجبران إلى درجة اعتبار نثره شعراً، قال المجيب: “قبل جبران لم يكن شاعر واحد في لبنان، لا الترك، لا اليازجي، لا الملاط، لا تقي الدين (أمين)، لا الارسلانيان”. أما الشاعر سعيد عقل الذي منحه بعض النقاد لقب “فاليري”، فقد اختصره أنسي بعبارة “معلم حساب رياضي أنيق، ومروّض فرح يلعب بالكلمة لا بقلبه. في الشعر الأنيق المنحوت الفرح سعيد عقل في الطليعة”. وماذا عن الياس أبو شبكة الذي أكد بعض النقاد انه مقلّد لبودلير: “أؤكد لك أنه اخ لبودلير. ربما فاقه أحيانا سادية متعجرفة. وربما فاق دو موسيه. ان كل ما يربطه ببودلير ودو موسيه وملائكة الرومنطيقية وشياطينها، انه ارتوى من النبع نفسه”. ولما نقل له المحرر عن اعجابه بفؤاد سليمان، أجابه بما يُفهم منه ان ذلك يتضمن نصف الحقيقة. ذلك ان فؤاد سليمان “شاعر له “درب القمر” خالد. لم يقلد. ولا افتعل واصطنع. لقد كان له نفسية الشعراء الملاعين. وكان له صفاء أبو شبكة ونقمة جبران”.
وكان للشاعرات عرس حافل بالغزل في قرص المقابلة الحافلة بالنقد. عن الشاعرات بصورة عامة قال أنسي بل أنشد: “ما عرفت شاعرة إلا وأحسست نحوها بشعور الاعجاب وبشعور آخر هو من ضرب التحيّز للنعومة بدافع اللياقة والشياكة. فأنا أقرأ النساء بشغف، خصوصا الشاعرات. وأكاد أقول الشاعرات وحدهن لأنه قلّ من وجد منهن إلا من كان بقلبها بلبل وفي شفتيها عطش الى جمال ورقصة لأغنية”. وقبل أن يُساءل عن أسماء الشاعرات المشغوف بشعرهن، أجاب: “أحب أفروديت وفدوى طوقان الوحيدة مع الأيام، وثريا ملحس المتمردة المتوحشة الغامضة التي قرأت لها ما ينعتونه بالطلاسم وفهمته كما أفهم نفسي، وعدت وادركت لماذا لا يفهمه أولئك”. وحين لفظ السائل اسم نازك الملائكة، حتى قاطعه أنسي قائلاً: “هذا النغم الخالد الساحر. نازك التي ما نقرت على وتر إلا وجدتني تحت النافذة أتسقط حبات الندى وأديرها في سقف حلقي كما يديرون حشيشة القنب”. وعندما طرح عليه السؤال الأخير والتقليدي: “هل لك أن تضيف على ما قلته عن الشعر والشعراء، أجاب: “أما الشعر، فقد نسيء إليه، وكم يسيء إلى نفسه. والحق ان خلقه الليلة وكل ليلة، لأروع من الدوران حوله والكلام عليه”. طبعاً، كان يمكن ان يزعم بعض الخبثاء ان لويس الحاج كتب لابنه الأجوبة، لولا ان المقابلة تمت بعدما زرع أنسي الكثير من مقالاته وقصائده على مدى عامين في عدد من الدوريات البيروتية بدءاً بجريدة “الأحد” التي نشر باكورة نتاجه “رمانة” في عددها 197 الصادر في 31 تشرين الأول 1954.
كان أنسي في مرحلة ما قبل “النهار”، يوقّع مقالاته باسمه الثلاثي الذي يتوسطه اسم والده لويس، الصحافي المشهور والمسؤول الرفيع في جريدة جبران اندراوس تويني. السؤالان الآن: ما هو سرّ استعانته باسم والده لدخول جنة الدوريات وبخاصة مجلة “الأديب”؟ ولماذا غاب اسم والده عن توقيعه عندما انضم إلى أسرة “النهار”؟ طرحت السؤالين عليه في أحد لقاءاتي معه شبه الدورية في مكتب الزميل اميل منعم في جريدة “الأخبار”، فكان جوابه: “قسم كبير من كتاباتي الأولى وضعته في المدرسة. كنت في السابعة عشرة وطموحي ان أنشر في كبرى المجلات الأدبية كـ”الأديب”. استعنت باسم والدي كبطاقة توصية. كنت أرسل مقالاتي بالبريد معتمدا على اسمه كواسطة دعم. وأعتقد ان ذلك كان نوعاً من الانتهازية. في ما بعد، حين انتقلت من الهواية إلى الحرفة، بدءاً بجريدة “الحياة” مع كامل مروة وباسيل دقاق، ثم في “النهار” تحت جناح والدي مباشرة، ظننت ان الاستمرار في استخدام اسم الأب سيحمل له بعض الحرج، فلم أعد استعمله”. على ذكر “الحياة” فقد دشن احترافه فيها بعمود دوري غير يومي تحت عنوان ساخر “مداعبة خبيثي القارئ” استهله بما يحرج، ليس والده فقط بل أيضا وأولا صديق والده كامل مروة، حيث قال: “انني اليوم هنا بسمّي وبضائعي وطلباتي، وأنت معي هنا وفي غير هنا، ببلهك وسماجتك واستبدادك… اني هنا لأرضيك أيها السارق راحتي. وساعة أرضيك بأقل مما عوّدتك وبأقل مما تريد، أطردني من زاويتي ولا تشفق لئلا أشفق أنا عليك” (الحياة 9 حزيران 1956).
أنسي الحاج في “النهار”
كان قد مضى على أنسي الحاج في “النهار” ثلاثة أشهر بالتمام والكمال حين نشر باكورة مقالاته الدورية في “الحياة”. وفي حين حال الاحراج الناجم عن الآراء النارية دون استمراره مع كامل مروة، فإن السبب نفسه كان وراء بقائه في “النهار” نحواً من 47 عاماً الى أيلول من العام 2003. تحت عنوان دائم “من زاويتي” وعنوان خاص بالحلقة الأولى، “على السطح” استهل أ. ح. السلسلة الطويلة في العدد 6209 الصادر في 9 آذار 1956 بهذه الكلمات الصريحة القاسية الساخرة: “كدنا نقول كل شيء عن مقابحنا… قلنا اننا فقراء في الكمية وفي النوع. وقلنا اننا أتباع. واننا تلاميذ ادب كسالى أو مغفلون. قلنا اننا غوغائيون ودجالون وسماسرة ومسوخ. ولكننا لم نعترف بأننا فواشون”. أضاف مصعداً من حقائقه الجارحة: “قد يكون السعدان على شيء من الأصالة. وتكون الببغاء خفيفة الروح أحيانا. أما نحن فالتقليد عندنا غباوة وجبن، والترداد طبيعة في العرق. نحن سطحيون. نخشى الاسراع في السباق مع التفاهة والملل. فيقضيان علينا ونظل كالسلحفاة. والسلحفاة سبقت الأرنب في الحكاية. إلا اننا أخذنا من الأرنب السطحية والحمق، وأبينا أن نترك للسلحفاة الاجترار”.
وكرّت السبحة. على سبيل المثال، في العاشر من تموز 1958 نُشرت في “النهار” رسالة من خليل حاوي الذي كان يعدّ دكتوراه عن جبران في مدينة كامبريدج البريطانية، والموجهة إلى الجبراني جميل جبر الذي لم يستأذن صاحب الرسالة قبل إمرارها إلى الصفحة الثقافية ونشرها في “النهار”. قامت قيامة حاوي عبر رسالة بعث بها هذه المرة إلى أنسي الحاج تساءل فيها: “ماذا يكون حال الأستاذ جبر لو نشرت رسائله إليّ وفيها الثرثرات والتوافه والأغلاط التي لا يجيزها سوى رفع الكلفة بين الأصدقاء. وبعد، فإني لم أطلع على نص الرسالة كما نشرت في “النهار”، ولكن رسائل العتب التي انهالت عليّ من لبنان تدفعني إلى الجزم بأنه قد استبيح الحذف من نص رسالتي واستبيحت الاضافة إليه”. نشر أنسي الرسالة في العاشر من تموز 1958، وقد توّجها بتعليق انحاز فيه إلى جانب جبر، حيث قال: “كنا قد أثبتنا قبل أيام رسالة بعث بها خليل حاوي صاحب “نهر الرماد” من انكلترا إلى جميل جبر. وقد تلقينا أخيراً الرسالة الآتية من خليل حاوي تعقيبا على إثباتنا رسالته في “النهار”. واننا بحكم ما كان وما يعرفه مؤلّف جبران تمام المعرفة، نحيل الأمر إلى الدكتور جبر، راجين ألا يكون في ذلك أي ازعاج. ثم اننا لا نجد بداً من الاشارة إلى ان خليل حاوي هو الذي طلب هذه المرة نشر رسالته”. أما جميل جبر فقد ردّ باقتضاب على حاوي في “النهار” العدد الصادر في 11 تموز 1958 حيث قال: “قرأت بدهشة رسالة صديقنا المشترك خليل حاوي، سامحه الله ألف مرة. فهو لو عدّ إلى العشرة لما خطّ هذا الكتاب المفعم بالنرفزة. ولا أخال صديقنا صاحب “نهر الرماد” إلا نادماً على ما كتب”. للمناسبة، إذا كان أنسي محقا في نشر رسالة أدبية موجهة من شاعر إلى باحث أدبي، فالشاعر مصيب في غضبه من نشر رسالته غير المعدة للنشر، ومخطئ في توقعه اجراء حذف واضافة على الرسالة من غير أن يقرأها منشورة. اما الدكتور جبر فيحتاج السماح من الله مرة واحدة لأنه لم يستأذن صاحب الرسالة قبل دفعها الى النشر.
لننتقل من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، الى جزيرة سانت أندروز في كولومبيا. في التاسع من شباط 1960، كان سعيد تقي الدين يسبح في بحر الجزيرة الكولومبية حين اصيب بنوبة قلبية أودت بحياته وهو في السادسة والخمسين. وفي 18 شباط نشر أنسي مقالا في الصفحة الاولى من “النهار” بعنوان “صعب عليه ان يعود حياً” قال فيه: “دائماً الذين بلا قلب يصرفهم قلبهم اخذا ونتيجة للصدأ. كان لساناً زفراً ودماغاً تحرقه شهوة الاستئثار”. وتساءل: “ماذا جنى لنا سعيد تقي الدين؟” وأجاب، ودائماً بمنهج نقدي بالغ السلبية: “اكبر الظن انه افضل على جيله لا علينا نحن. كان يقول انا لله. لقي حتفه خارج لبنان ليخلّص نفسه من مشهد الاحتراق الذي قاومه بكل شيء. هرب بصيته ومجده ليموت حيث لا شماتة تلحقه ولا شفقة تكويه”. على رغم ان مارك رياشي هو ابن اسكندر الرياشي المجايل لسعيد، فقد رد على أنسي في زاويته اليومية في “النهار” بتاريخ 19 شباط 1960 بما يفهم منه ان فضل ساخر بعقلين يشمل ايضاً ابناء مجايليه وأحفادهم. قال مارك، في سياق مقاله المعنون “انا الله”: “عتب انسي الحاج على سعيد تقي الدين لأنه كاد يقول انا الله. لكن يظهر ان انسي لا يراجع ما يقرأه. انما عتب أنسي على سعيد في غير محله. وما هو سعيد تقي الدين”. أجاب بثلاثة اسئلة: “أليس مبدعاً خلاقاً؟ أليس هو سيد من أسياد الابداع؟ أوليس هو من الآلهة النادرين الذين يزورون الارض كل ماية عام يزرعون الدنيا جمالا وخلقا؟”. ليس ذلك كل شيء. فقد نُشر في الصفحة الاولى من “النهار” بتاريخ 22 شباط 1960 مقال صغير بعنوان “سعيد تقي الدين وموقف النهار”، ورد فيه ان رئيس التحرير غسان تويني قام بزيارة آل تقي الدين معزياً بوفاة الاديب الكبير الشيخ سعيد، معرباً لهم عن أسفه للمقال الذي نشره أنسي الحاج في تلك المناسبة، وهو مقال لا يعبّر، بالطبع، عن وجهة نظر الصحيفة التي كانت احدى اولى منابر الفقيد، والتي استمرت تربطها به روابط عديدة لم تزعزعها رياح السياسة وظروفها. وستخصص (“النهار”) هذا الأسبوع صفحة عن سعيد تقي الدين يشترك في تحريرها عدد من الأدباء ويقدم لها غسان تويني”.
كان بين الأدباء بل في طليعتهم أنسي الحاج نفسه ولكن في 1966 حيث أكمل بعد ست سنين ما بدأه مارك رياشي في 1960. وفي حين انتقد مارك كل من ينفي صفة الابداع عن ادب سعيد، انتقد أنسي في “الملحق” الثقافي لـ”النهار” بتاريخ 27 شباط 1966 لمناسبة الذكرى السادسة لرحيل مؤلف “انا والتنين” خوف المسرحيين والادباء والقراء من الاقتراب من ادب سعيد لأسباب سياسية: “بلد سعيد تقي الدين الذي يخاف ادبه، يخاف مسرحه، يخاف مقالاته، يخاف ذكر اسمه وكأنه هو، سعيد تقي الدين، التنين. أنت هو التنين يا سعيد، أنت هو الجريمة والعقاب، وليس في اليد حيلة، فأنت قومي. ولو لم تكن في حياتك مؤمناً بشيء، لكنت اليوم سفيراً يا سعيد، لكنت وزيراً، لكنت اديب الدولة والشعب”.
في شباط 1964 بشّر “الملحق”
على ذكر “الملحق” الذي اشترك أنسي في تأسيسه، وكان محرره الاول عبر افتتاحية صفحته الأخيرة، لا بأس من طرح هذين التساؤلين: هل ولد “الملحق” مع ولادة الحلقة الاولى من سلسلة “كلمات كلمات كلمات” في 28 حزيران 1964؟ واذا تمت الولادة قبل هذا التاريخ، فما هو العنوان الدائم الذي توّج افتتاحيات أنسي ومقالاته؟
في 25 شباط 1964 بشّر أنسي في “النهار” بقرب صدور “الملحق” الذي هو “جريدة اخرى للقارئ الآخر… القارئ الذي يقرأ “النهار”، والقارئ الذي لم يكن يقرأ شيئاً لأن “الملحق” لم يكن موجوداً”. اضاف: “في لبنان نهضة فكرية وفنية وثقافية بوجه عام لا مثيل لحيويتها في اي بلد عربي آخر. هذه النهضة تفرض فرضاً الجريدة التي تلاحقها وتحبها وتتحدث عنها بفضول ومثابرة وتفتيش. هذا الملحق الصغير هو التتمة الصحفية لظاهرة النهضة. وهو مدعو، دون رحمة، الى النجاح”. اما العدد الاول من “الملحق الصغير” الذي تألف من 8 صفحات فقط، فقد ظهر في 1 آذار 1964 وكان يومياً، وقد افتتح به أنسي الحلقة الأولى من السلسلة الطويلة التي تمحورت على المرأة. ومما قاله في المرأة نثراً وكأنه قصيدة متمردة على الوزن والقافية: “انا المرأة في جسدي. ليس اكثر منها في جسدي. كراهية واحتقاراً وعشقاً وشهوة وعبادة. انتظرها في الليل. وانتظرها في ساعات العمل. وأنتظرها في الغد الذي هو النهاية. انها كل فهمي للأشياء، وكل جهلي بها، وكل انجذابي اليها، وكل تعلقي بها، وكل حقدي عليها. انا المرأة في جسدي، في حياتي وموتي، والأرجح بعد حياتي وموتي”.
في “ملحق” 5 آذار 1964 تساءل مع نضال الاشقر “هل فشل الإزميل” وأجابا: “الفاشل هو نوع من الأدب اللفظي، كان الشلل المسرحي أحسن منه، وكان هو اضعف الجميع. وقد بدأ انطوان معلوف يتخلص منه. وعلى هذا يستحق منير ابو دبس وفرقته التهنئة على رفع التحدي”. تحت عنوان “لو بالعكس” قال أنسي في “ملحق” 11 آذار 1964 بأسلوبه الساخر الذي ميّز بداياته: “من الأشياء التي كان يجب ان توجد بالعكس هذا الشيء: الفن الرديء الذي تحميه القوة. فقد كان يجب ان تكون القوة مع الفن الصالح. وعوض أن يتعرض الفنان الكبير للاهانة والناقد النزيه الذكي الجريء للضرب، يتوجه الضرب اوتوماتيكياً الى الفنان الفاشل والناقد المنافق والثقيل والجاهل”.
اضاف منوهاً بمن عاد وكتب عنه واقتدى به: “ذات مرة كتب صحافي تافه مقالة ادعاء وغلاظة واخطاء عن السوريالية، فلاقاه اندره بروتون في الشارع وضربه. انا من هذا الرأي. فضلاً عن ان الضرب اذا استعمله الفنان، رفعه الى مستوى الآلهة”.
عندما “دوبلت” صفحات “الملحق” لتصبح 16، “دوبل” أنسي من سخريته خصوصا في “ملحق” 24 ايار 1964، اضافة الى أنه بات يتوّج افتتاحياته بعنوان دائم هو “آخر فكرة 16”. أكد أنسي في تلك الافتتاحية “ان الشعب اللبناني وزعماءه هم انجح زواج في التاريخ، وسرير لبنان يضيق بالزبائن. اعلان هام: خلافاً للشائعات، وبالرغم من بعض التجارب التي لم يحالفها الحظ، ان سرير لبنان المصنوع من خشب الارز صامد للمحن يتابع سيره التاريخي، فلا تدعوا الفرصة تفوتكم، اعضاء عاملين كنتم ام متفرجين. ان 99 بطلاً في الداخل و99 في الخارج، ومليونين في المهاجر والمحافظات الخمس يتقاسمون هذه اللذة. وعند منتصف الليل تعزف الاذاعة النشيد الوطني لتذكّر الغافلين بأن الوطن في عرس شعباً وحكومة وزعماء. تزوجوا ايها المواطنون”.
في سجن الرمل
كان أنسي قد نشر في 21 ايار 1964 مقالاً عن فؤاد شهاب تعليقاً على عزوفه عن التجديد على رغم إلحاح الشهابيين عليه للاقتداء بالرئيس بشارة الخوري رغم أنه لم يتمكن من اكمال ولايته الثانية. قال أنسي مستشرفاً حضور فؤاد شهاب المشرق في ذاكرة اللبنانيين اذا لم يرتكب الخطيئة المميتة التي ارتكبها بشارة الخوري: “هناك ما هو اهم من الولاية وهو الحقيقة. وهناك ما هو اكثر اغراء من الحكم وهو ترك الحكم. وهناك ما هو ارفع من المقامات وهو النبل البشري. الزاحفون الذين ينصبون الاشراك لفؤاد شهاب يجددون في الحقيقة لأنفسهم لا لفؤاد شهاب. من الجريمة أن نحرم فؤاد شهاب تجاوز البطانة والحاشية. ومن الجريمة أن نحرمه الاتجاه نحو الاسطورة التي ستجعل منه اغرب رئيس دولة عرفه لبنان شذ الى فوق وظل يردد “لا” بهدوء وسخرية وادراك”. وصحّ ما توقعه وتمناه الأديب – الصحافي. فقد نفذ الرئيس شهاب ما وعد به، فغدا اغرب رئيس جمهورية، ليس فقط في لبنان، بل في عموم العالم الثالث. ولكن، ما لم يتوقعه أنسي، هو ان تثأر منه البطانة والحاشية بعد ست سنين وتحديداً بعيد صدور عدد “النهار” السنوي عن المكتب الثاني، وتتويجه بمقدمة لم تحمل توقيعه لكنها مصوغة بأسلوبه، حيث تساءل في ختامها: “ولماذا لا نعرف اخبار المخابرات؟ يحق لنا. ألم تقتحم هي حياتنا؟”. هكذا اقتحم المكتب الثاني منزل أنسي في 24 كانون الاول 1970 واقتيد الى التحقيق بسبب مقدمة العدد الخاص بالمكتب الثاني، وأودع “بيت خالته”. في 25 كانون الاول 1970 صدرت “النهار” وقد توّجت صفحتها الأولى بمانشيتات تنص اولاها: “بسبب ما ورد في عدد النهار السنوي عن المكتب الثاني: أنسي الحاج في سجن الرمل”، وتقول احداها: “غسان تويني: انه القسط الاخير من ثمن الحريات”. اما عمود ميشال ابو جودة “من حقيبة النهار” فاستعار “كلمات” أنسي عنوانا له. وفي اليوم الثالث 27 كانون الاول 1970 حيث تم الافراج عنه، كتب أنسي افتتاحية عدد “النهار” الصادر في 28 كانون الاول 1970 بعنوان “ظنّوني جئت ببشارة الحرية” وقال في الافتتاحية التي صاغها بمنهج الدفاع الهجومي: “صار للحرية اسم آخر هو الصحافة. بين المستغربين كثيراً، كثيراً جداً، كان سكان حبس الرمل، حيث اكتشفت، خلال زيارتي الخاطفة، ان في المحكومين والمجرمين صفات انسانية أنبل وأجمل وأكرم من صفات الكثيرين من اهل الفضيلة… قبل ليلة العيد فتحت ابواب السجن وخرج منها فؤاد عوض وشوقي خيرالله. ثم اوقفوني”. وختم مؤكداً حقيقتين: “العدالة اختراع بشري”. و”العدالة لا تمس الآلهة”.
لنعد الى “الملحق” الثقافي الذي احتضن الكثير من افتتاحيات أنسي الحاج التي اتسمت برفض جل – وأكاد اقول كل – ما هو سائد في السياسة والاجتماع والثقافة والفن. فقد اجمع كل الادباء والزملاء على المطالبة بتكريم المبدعين في حياتهم وليس بعد رحيلهم. لكن أنسي الحاج خالف زملاءه في الحلقة الاولى من سلسلة “كلمات” المنشورة في “الملحق” الصادر في 28 حزيران 1964 ولا بأس من استعادة بعض ما ورد في تلك الافتتاحية العميقة الرائعة كمسك ختام لهذه العجالة: “كانت هناك فكرة: تكريم الادباء وهم أحياء. اذا صحّت ستفشل. لا يمكن محبة الاديب الا وهو غائب. الشخص الغائب او الميت يصبح فكرة. ومع الفكرة يغدو الكاتب اكثر رحابة وتكون اعصابه في صحنها كما يقول الفرنسيون. وعندما يكتب الكاتب عن شخص غائب أو ميت انما يكتب بمعنى من المعاني عن نفسه. وبما ان ألذ شيء هو ان اكتب عن نفسي، ففكرة تكريم الادباء وهم احياء، فكرة فاشلة. الغياب والموت يُدخلان صاحبهما الى الملحمة ويجعلانه غنائياً. الواقع يجعله ابرص ومحدوداً كالخبر السياسي” وختم محبباً الموت خصوصاً بالنسبة لأهل القلم وهو منهم: “يكون حسنا لو يتدبر الادباء نفسهم مع الابدية ليقرأوا ما يكتب عنهم بعد الموت. سيرون كم هم خياليون وكم ان الموت ينفعهم”.
باختصار كان أنسي منذ “الأحد” حتى “الاخبار” مروراً بـ”النهار” و”النهار العربي والدولي” وبخاصة “الملحق الثقافي” ضد كل من هو مع، ومع كل من هو ضد.
أنسي الحاج “الرسول” بشِعره الطويل حتى الينابيع (1937 – 2014) – قالوا فيه
¶ سعيد عقل: (…) ما “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع” سوى كتاب الحب الذي سيقرأه الجيل على أنه كتابه. الحب، فيه، مغنّى كما ولا أجمل، ومغنّاة فيه قيم تنبع منه فتزيده توهجاً ومعمارية. ونتذكر أن قلم أنسي، الذي من نار، هو معماريّنا الأمثل.
¶ شوقي أبي شقرا: (…) وهو على هذا النحو، كيف يمكن الاوزان والقوافي ان تطيقه وان تتحمل مخالبه في أسرها، في أطارها؟ وكيف يمكن أنسي الحاج ذاته أن يبقى عند حدود المتعارف عليه، عقلاً وعاطفة وخيالاً، فلا يحيد الى مسافة شاسعة عن الحدود والامكانات البصرية والذهنية؟ وكيف يبقى “موزوناً” و”مقفّى”؟
فلا بد من النثر، وكان نثر أنسي الحاج تلك العاصفة، كان أجنحة فوق أجنحة، فوق أجنحة. وكان به ذلك السفر الى تحت وفوق وأمام والى اليسار واليمين (…)
وكان الحاح أنسي الحاج على النثر أنْ غدا النثر جوهراً في الشعر.
¶ محمد الماغوط: الحرب قد لا تُبكيني. أغنية صغيرة قد تبكيني، أو كلمة لأنسي الحاج. هو توأمي (…) أحترم أنسي الحاج لأنه بقي في بيروت تحت القصف، وأحبه شاعراً وناثراً وصامتاً.
¶ أدونيس: أنسي هو، بيننا، الأنقى.
… معك، يا أنسي، يزداد استمساكنا بحبل الرؤيا، يتسع أسلوبنا في التعبير عنها، وينمو ويغنى، يصبح لنا نوع آخر من الشعر، ومن النثر ايضاً. ومعك يزداد استخدامنا لحاضر الكلمة، ويزداد نسياننا لماضيها، وتخلينا عن تاريخها. ومعك يصير شعرنا حركة طلقة، فعلاً حراً، تناقضاً مدهشاً. أعني يقترب شعرنا، معك، أن يكون شعراً.
¶ يوسف الخال: انني أعزو هذه الغرابة في التعبير عند أنسي الحاج ونَعْت هذا التعبير بأنه غير عربي، الى كون أنسي الحاج قد أدخل الى المفردات الشعرية العربية تعابير غير متداولة في الشعر. وهو لم يدخل فقط الفاظاً جديدة، بل إنه أغنى القاموس الشعري العربي – إذا صح التعبير – بمفردات أدخل الكثير منها دفعة واحدة فظهرت غريبة خارجة على المألوف. لكنه لم يكتف بإدخال مفردات جديدة على التعبير الشعري العربي: ان الكلمة التي حملها، قد حمّلها أكثر مما تعوّدنا أن نرى. اللغة في “لن” تنفجر بمعان غير مألوفة، وهي موضوعة في سياق غير مألوف، هذا هو وجه الغرابة.
لولا الشعر تموت اللغة. تموت بالفعل. ومن هذا المنظار، أهمية “لن” أنها أدت خدمة كبيرة في احياء اللغة وتجديدها. وهذه الناحية تنعكس، بدون ريب، على طبيعة شعر أنسي الحاج وموقفه من الحياة. لقد رأينا أنه رافض. وهكذا رَفَضَ التقليد، رفضه شكلاً ومضموناً.
¶ نزار قباني: أنسي الحاج رفع قصيدة النثر الى مستوى الشعر الحقيقي. فلغته لغة حضارية، لماحة، متوهجة، ناضرة، شفافة. أنسي رفيقي على درب الشعر الطويل، وأنا فخور بكل كلمة كتبها أو سيكتبها. انه نموذج للشاعر الحقيقي حيث يلتقي الشعر والرسولية في جسد واحد. اني أحبه وأحلم دائماً أن أقتني واحداً من خواتمه.
¶ خالدة سعيد: أنسي الحاج ثائر قبل أن يكون شاعراً. شعره فعله الثوري الوحيد. شعره بالنسبة له هو الجنون… الجنون هو الوصمة التي يحملها من اختار أن يكون حراً، أن يتحرر من عبودية المفاهيم المعممة والسلوك المألوف والضياع بين تشابه الارقام. الجنون هو العزلة الفكرية الروحية، هو الاختناق الفكري، الوجع الفكري الذي يرفع الحواجز بين المجنون وشرائع الانسجام. الجنون هنا هو المنفى، منفى الروح، منفى السلوك والنظر. المجنون منفي بالقوة، بقوة دفع الجموع وبقوة إشمئزازه وهربه منها، لقد اقصته غرابته عن الساحة العامة. الشعر إذاً بالنسبة لأنسي الحاج فعل تحرر بالدرجة الأولى، فعل التقاء وانتقال الى الآخر (…) غادر أنسي الحاج مباهج الجسد الخارجية الآنية العارضة وتوغل فيه. لم تستلفته الأشكال ولا ظواهر المشكلات بل عاش الوحدة وتفكك العالم من الداخل. ولكن هل توغل بعيداً بعيداً حتى غاب عن الكثيرين؟ لغرابة عالمه وبعده جاءنا صوته غريباً. لقد توغل بعيداً عنا في العتمات التي لم نجرؤ على اقتحامها، لكنه هناك نسي الالتفات الينا، لم يغنّ، لم يوضح (…) قدّم لنا عطاء جديداً مرهقاً، شعراً متفحم المشاعر يضخّ مرارة، يكشف أدغالاً مجهولة عن نفس تتوهج بالموت. أليس عطاء الانسان الأهم، هو الكشف، الكشف، الكشف؟
¶ بول شاوول: … تلك الحركة الخارقة، من تصادم الصور بالصور والكلمات بالكلمات والكلمات بالصور، التي تلفّ الجزء الأكبر من “لن” وخصوصاً الجزء الاول، رغم عدوانيتها اللغوية، كأنما في سفكها الطازج للمتراكم والراسب والعادي والشائع، تخبئ وصولاً جمالياً خاصاً، يرسو في بقعة جمالية تتجاوز المدّ المخرّب الزاجر الهادم، الى بناء لغوي – شعري متهيئ وفاتح.
القصيدة ترفع الخراب (العدوانية) والتمرد والرفض – تطحن الكلمات لتسحب منها نشيداً، نشيداً حياً لا يلبث أن ينتقل في الجزء الثاني من “لن” من الاشكال الجسدية والحواس المستنفرة في فجاجتها الى الاشكال المجردة والغنائية، ذات المد المستلين على حدة، ليبرز نوع من “التأليف” هو أقرب الى كتابة ترجمة جوانية للتجربة الانسانية والنفسية، حيث يطل نَفَس تأملي عالٍ وفاجع، كأنما بعد تلك الرحلة المحمومة والمجنونة تراكمت كل اللحظات في لحظة درامية متفجرة وقف فيها البطل في خراب الزمن ليتلو نهاية المرثية، أو بدايتها.
¶ عبد القادر الجنابي: ثمة شيء يخيفني في تجربة أنسي الحاج، لا أعرف كيف أصفه. ربما على شكل سؤال: ما الذي كان يحدث لو أن أنسي الحاج كان مُسْلماً ويكتب باللغة نفسها وبالروحية نفسها التي كتب بها؟ حتماً لحدث تغيّر حقيقي في مسيرة الكتابة العربية، لأن تمرده حقيقي، وغاية كل تمرد حقيقي الباطنة هي ردم الدلالة الدينية للغة التي ترتكز عليها صلة ثقافة بتراثها. وكثيراً ما كان هذا مضمراً في كتابات أنسي الحاج. أقول مضمراً، لأنه آخر، غير مسلم، لا يحق له هَتْك سر المحرّم الاجتماعي (…)
أنسي الحاج ليس مجرد شاعر له دواوين. انه أشبه بشعرية – حركية لها النموذج والتنظير. ويجب أن يُقرأ شعره من خلال ما كتبه ويكتبه من مقالات تأملية أو تنظيرية. لكن هذه الحركية – هذا الشاعر المرفوض كآخر من قبل لاوعي جماعي مكبوت – ستظل مجرد أحلام يقظة تُشْغَف بشغاف المحرّم، تحتاج الى يوم صافٍ لكي نتنفسها هواء صحياً، شعوراً اجتماعياً تدركه أجيال جديدة (…)
¶ عباس بيضون: “لن” و”الرأس المقطوع” حدث في اللغة العربية لم تستوعبه بعد، أي لم تحوله الى تاريخها وتراثها. فهنا كتاب مضاد للأدب، وكتابة لا يمكن أن تُتناول بالمعيار الأدبي أو تقاس به (…) هي دعوة لجمالية أخرى لم يكن في وسع الجملة العربية المقننة المقطرة المعلبة أن تقبلها: كتابة تتم في تجاهل تام للأدب المكتوب بحقلي ألفاظه ودلالاته، بصلته بالمادة الاولى، بقيمه المتضمنة. هنا يسقط الحيّز الأدبي نهائياً فيتدفق قاموساً ومجازات لم تكن البتة في الاحتمال، وهنا تبقى الكتابة على صلة بالفم والعصب، فتتسع لنص يستمد ايقاعه من توتر داخلي ومن نضارة اللغة الشفوية ومفاجآتها.
… سعي الى كتابة شاملة، الى نص خارج على النوع، ويخلط بين الانواع.
… التجربة هي مثال أنسي الحاج الوحيد. ان شعره حصادها(…) انه يتلقى ويصغي ويتحف وكأنه ينتقل في دهاليز ومدن غريبة. يمدح انسي الحب ويخضع له بنبل السير الطوعي، لكن هذا لا ينهي أزمنة الضياع، لا لأن للحب مفازاته ولكن لأنه ايضاً لا يرحم. التجربة تكبر وتسقط على الشاعر عاتية. والشاعر دائماً وحيد فيها، طفل في وحدته. ملك في وحدته.
(…) قراءة أخرى لأنسي الحاج، ومرة أخرى كأننا لم نقرأ من قبل. ثمة الكثير الذي لا نعرفه عن ظهر قلب، لكن الأكثر الذي لا يسلّم سرّه بسهولة. قراءة أخرى لأنسي الحاج ترينا مع ذلك كم بات بعض شعره حميماً لنا. لقد جعلت سنوات الحرب من هذا العاصي على الشعر شعراً يُستظهر ويُقرأ بصوت مسموع وكأن الحرب الطويلة جعلته قريباً اليفاً، بل جعلتنا اشبه به. ولعل المستقبل سيجعلنا أكثر شبهاً. ذلك أننا اذ كنا نكاد نودع هذا البلد فإننا نغدو كلنا اشبه به. ومن العبث أن نتابع اثر أنسي الحاج في شعرنا. انه منعطف. واذا كان المنعطف كبيراً يصعب ان نحصي المارة.
¶ الياس خوري: هذا الشعر لا يُقرأ الا في المسافة التي تفصل المبنى عن المعنى. أين نجد هذه المسافة؟ حتى الشاعر لم يجدها، فحاول أن يخترع اشكالاً ووسائط وكلمات. هو الخائف الأكبر من شعره ومن ما قبل كلماته… مَكْرُهُ خوف وشجاعته خوف وتوحشه خوف وصراخه خوف وصمته خوف وعشقه خوف وخياناته خوف.
وفي هذا الخوف ولدت تجربة تسمح لنا بأن نمضي الى ذاكرة الفضيحة والعري ونأنس الى المجهول.
¶ أنطوان الدويهي: اما هو فنوافذه كلها مشرعة. يا لزرقة ما يرى، ويا لظلمة ما يرى…
… أنسي الحاج هو شاعر أريستوقراطي الروح، حيث ينتفي إمكان التنازل، وحيث يستحيل التعبير عن أي شيء لا ينتمي بعمق إلى مكنونات الذات، في هدأة الصفاء والشفافية كما في رهبة الظلمات واللجج. فسيادة الروح لا تقبل بغير ذلك.
فهذه الكتابة هي النقيض الأمثل لكتابات الفراغ الأدبي حيث لا ارتكاز على التجربة الداخلية، كما هي النقيض الأمثل لـ”الأدب الثقافي” إذا جاز التعبير حيث تتم إعادة إنتاج التراثات الأدبية الأخرى بهذه الدرجة أو تلك من النجاح (…). ومن مفارقات التاريخ. أنه في هذا المدى الطويل من الزمن، وكلّما ابتعد الزمن، سوف يبدو الأدب الأكثر ذاتية والأبعد عن الالتزام، أدب أنسي الحاج، كأنه الأكثر التزاماً.
ذلك أن روح الحرية التي تسكنه، بما تنطوي عليه من أنسنة وتحرّر وجودي وتعبير عن الذات الجماعية، تحمل في داخلها ما تحمله من بذور التحوّلات والنهضات.
¶ رياض نجيب الريس: هل صحيح أن أنسي الحاج في “الرأس المقطوع” شاعر يقوم بمغامرة سافرة مع الشعر؟ الجواب بلا تردد: نعم. إن الشعر عند صاحب “لن” و”الرأس المقطوع” مغامرة خطرة، متعددة الجوانب، واسعة الأفق، مذهلة الابعاد. والحديث عن أنسي الحاج في “الرأس المقطوع” ليس حديثاً سهلاً إنما هو مغامرة مرعبة في البحث عن شيء ما. وهذا “الشيء ما” هو اكتشاف مثير، ممتع ورهيب.
¶ سمير عطالله: منارة استطاعت الانزواء والتنسك وسط الساحة العامة.
¶ خليل رامز سركيس: “لن”، هذه الصرخة السلبية الايجاب، لا تعني، عندي، الرفض للرفض، بقدر ما تعني عمل الرفض في مصير الانسان.
¶ فؤاد رفقة: طريقة التركيب في “لن” ليست عربية. لم نعتد شيئاً مثلها. لم يسبقه أحد الى هذه الطريقة التعبيرية.
¶ أمجد ناصر: أنسي الحاج الشاعر الذي غيّرنا وغيّر الشعر العربي لا يملك من صفات الشعراء “الكبار” شيئاً… إنه العاشق الذي لا يزال ينتظر الحبيبة بقصيدة ووردة.
¶ رجاء النقاش: (…) وقد اختار أنسي الحاج كلمة “لن” عنواناً لكتاب من الشعر المنثور، فقد وجد في هذه الكلمة ما يعبّر عن رفضه للواقع وتمرده عليه. ومن اقوال هذا الكاتب: “أرى الطوفان خلاص البر”. انه لا يريد سوى الخراب والهدم الكامل للعالم الذي يعيش فيه (…) وبصرف النظر عن تفاهة ما في هذه الكلمات من أفكار، إلاّ انها تفوح مع ذلك برائحة وحشية تنبع من (…) نفسية قاتمة لا ترى أمامها إلاّ القبح والحرائق والدمار والعفن.
¶ ممدوح عدوان: أنسي الحاج، هل من المعقول أن تعثر على عقلك بعد أن جُنّ العالم؟
¶ جاك بيرك: هذا “التتويج للمرأة” (في “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع”) كان ممكناً ان يذهب في الاتجاه النقيض لرفضك الأول. رفض “لن” (1960)، بكل ما يتضمنه “تتويج المرأة” هذا من فرح وايجابية، هل نقول إنك كتبته “عكس الكلمة” (ص70)؟ كلا، لأن كلمتك تحب ذاتها وهي تقول ذلك، وأنت تحبها، وانك على كل حال وجدت تناغماً سلساً، تناغماً كأنه صافٍ، يلتقي فيه النداء الشهواني للمرأة والتقديس للعذراء – الأم. إنه، تجدُّد في وحيك، وفي ثبات “الغربة” الثورية التي تطمح دائماً الى “احراق العالم بشمس العودة” (ص88). وانه لحريّ ببلدك، وبالغرب عموماً، أن يصغوا الى صوت الشاعر الذي يدعوهم الى اعادة توحيد ما جُزّئ، والى الاستعانة بالوحدة ضد الانقسام، علّ هذا الدفاع عن الحنان يقنعهم، أو في الأصح – يُخْضعهم لعودتهم هم. شكراً لهذا الكتاب الرائع، حيث عظمة الموضوع تتجاوب مع جمال الكلمة.
¶ شوقي بزيع: هذا الشاعر الذي يكتظ بنفسه حتى لا يختلط بأحد ويشفّ حتى لا يعود أحداً، بل يصبح حالة مكاشفة بين الكائن وذاته، وبين الروح وصدئها المتراكم.
… ربما كان القلق واللايقين هما ابرز ما يميز تجربة أنسي الحاج الشعرية. لذلك هو شاعر المفارقات، يحمل في داخله الشيء ونقيضه ويتوزع بين المقدس والمدنس، بين الرقة والقسوة، وبين الطهر والاثم. وعالمه مزيج من وثنية قبل – دينية تقوم على احتفالية الحواس والرغبات، ومن نزوع لاهوتي مشرقي يجد جذوره في التوراة وغيره من الكتب السماوية (…)
في اليمن يتحدث الذين “يخزنون” القات عن ساعة الذروة التي يبلغونها اثناء مضغهم لتلك النبتة الساحرة التي تقع على الحدود بين الانتباه والخدر وبين الغبطة والتلاشي، ويطلقون عليها اسم “الساعة السليمانية” التي يتصالح ابانها الجسد مع الروح والملاك مع الشيطان. ولا اجد اكثر دلالة على شعر أنسي الحاج من مثل هذه الساعة. ولعل بين أنسي وسليمان اكثر من وجه شبه. ألم يكتب أنسي “نشيد انشاده” الخاص به في “الرسولة…” و”الوليمة” كما فعل سليمان؟ ألم يصالح مثله بين العناصر والكائنات، ويوشح “هيكل البغضاء بوشاح من حرير لبنان”؟ ومثله يعلن أنسي الحاج:
“كما لم يمت لي حب
لن يموت لي ثأر
حتى يصبح للحَمَل قوة الذئب
وللحماية قدرة العقاب الكاسرة”.
¶ Nadia Tuéni
J’évoque peut-être avec nostalgie le temps où Ounsi El Hage, tel un torrent que rien ne parvenait à canaliser, jouait de ses mots comme on joue de sa vie (…).
J’évoque peut-être avec nostalgie le temps où entre “Lann” et “le passé” des jours à venir”, un poète, l’insulte à la bouche et l’amour dans les yeux, la mort à la main, coupait en deux la vie comme un oiseau blessé.
¶ Salah Stétié
Par le langage de sa forme, le poème-qu’éloigné désormais de l’immobilité rituelle de la quaçida!- devient cet axe qui, tournant sur lui-même, crée le mouvement, brasse les données du temps et du destin et le projette comme autant d’éclas dans l’avenir. En cet élan du poème porté par une passion fiévreuse, les lignes du chant s’affolent et s’étirent, le paysage s’engouffre dans l’on ne sait quel vide vivant suscité par cette course aveugle et pure, par cette aspiration éperdue vers quelque fin qui pourrait bien se confondre avec le néant.
¶ بسام حجار: لِمَ يجعل أنسي الحاج اسير “لن” ومقدمته؟ ولِمَ لا تُقرأ تجربة هذا الشاعر في سياق ايصالها وانقطاعها وانكارها المتصل لما أنْجَزَتْهُ برفضها الحدود التي رسمتها لذاتها بداية ثم لم تكف عن الخروج عليها وعنها، على غرار القول الذي يُنشأ على استدراك لا يني يفضح نقصان القول اذ يقال.
¶ كمال خير بك: (…) هكذا لا يعبّر التمرّد والعنف الهدمي في عمل الماغوط وتوفيق صايغ وأنسي الحاج عن نفسهما على صعيد المفردات والدلالة وحسب، بل كذلك على صعيد الأداة التعبيرية التي تكشف، بالإضافة إلى هجران القافية والوزن، عن ابتعاد كبير عن المنطق الجمالي التقليدي.
وإذا كان الماغوط في قصائده “البرية” يبدو محافظاً على صفاء تركيبي وموسيقي معيّن لمصلحة صور “متناقضة” على نحو مصمّم وأخّاذ، وإذا كان يهمل، غالباً التشكيل الطباعي لقصيدته، فإن صايغ، وخصوصاً أنسي الحاج في قصيدته “الوحشية” يبدوان أكثر اعتماداً على الصدقة الناتجة من “فوضى” العمل الشعري، وذلك على جميع أصعدة التعبير: القاموسية والبنائية والدلالية و”الإيقاعية” والإخراجية والخطية، إلخ… وبتعبير آخر، إذا كانت النزعة الفوضوية للماغوط تكشف عن نفسها على مستوى “الكيمياء الداخلية” للقصيدة، فإن “فوضى” أنسي الحاج تبدو أكثر توهّجاً على مستوى “الآليات الجسدية للتعبير”. ومهما يكن من أمر، ففي استطاعتنا اعتبار القصيدة الفوضوية ليس فقط كـ”طباق” للقصيدة التقليدية، الرومنتيكية على وجه التحديد، بل كذلك بمثابة ردّ احتجاجي أكثر حداثة على الشكل المنظّم، المتجانس، والشديد الصرامة لما تتم دعوته، أحياناً، بالشعر المعاصر “الكبير”. ذلك أن رواد هذه “القصيدة الصرخة” ينتمون، سواء في رؤياهم الثقافية والفنية أو في موقفهم من العالم والإنسان والفن، إلى هذا “الجيل الغاضب” من الأدب العالمي.
¶ غادة السمّان: (…) عشت مع صفحات “كلمات كلمات كلمات” رحلة مذهلة مع الحلم والنبوءة والنوم والرؤيا، ووجدت “كلمات…” كتاباً راهناً أكثر من أي وقت مضى، كتاباً بالغ الجدة في زمن الكلام “الشيكلتس” والصداقات “الكلينكس” لا أتمنى أن تخلو منه مكتبة بيت لبناني أو جامعة أو مركز ابحاث عربي ايضاً، ومن رأى العبرة في غيره لربما اعتبر! كأي عمل ابداعي، “كلمات…”، نستطيع قراءته اليوم وغداً وأبداً، وعلى مستويات عدة. على مستوى سياسي وانساني واجتماعي ووجودي وشعري وقصصي ومسرحي. انه كتاب الحرية. كتاب ما قبل السقوط في الخطيئة. وكتاب الندم للذين لم يقترفوا أكل التفاحة بل أكلتهم هي! انه كتاب الظلام الدامس الساطع بعتمته لشجاع يقف في “قلب جثته عاصفة من الحياة يخرقها الوعد كما لا يزال البرق يخترق ظلام الليل وكما سيظل يخترقه الى الابد”.
¶ علوية صبح: يكتب قصيدته كمن يغسل ذاكرته ليفتحها على درجة الصفر الطازجة للشعر.
¶ موريس عواد: أنسي الحاج متل الشجرا بس تنزرع، كل ما كبرت، كل ما أخدت طلّي جديدي ولون جديد. (…) بعض الشعرا غيّروا الكاس، والبعض غيّروا الخمر. أنسي الحاج بدو يغيّر الكاس، والخمر، والمطرح. (…) وقفتو ع المدماك الرابع خلّتو يشوف كل شي ويطل خلف الأشيا. غطس كلّو سوا بنهر الإنسان والحب والأشيا، ومش باقي غير راسو ع جرح المي.
¶ علي حرب: انه يبدع أي ابداع في الكتابة عن المرأة. بل هو لا يبدع ابداعه إلاّ في الكتابة عنها أو عما يمتّ اليها بصلة. وانا لا أبالغ في ما أقول ولا أتعسف، فأنسي الحاج يعتبر أن المرأة هي “أرض الكلمات وفضاؤها”. ويعترف بأنه “لم يحب إلاّ ما فيه امرأة” كما جاء في أحد نصوصه “هذا العالم لولاكِ”. من هنا تحضر المرأة في كتاباته أجمل الحضور وأبلغه، وتبدو متعة البلاغة، في كلماته، الوجه الآخر لبلاغة المتعة.
¶ محمد العبدالله: “ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة” عنوان جميل، كلام جميل واقع في عنوانه. ثمة وشاية أولى، إنه خلاصة الكلام. خلاصة الكلام السؤال. انه شعر يحاول أن يصوغ سؤالاً، أن يصوغ السؤال، سؤاله، هو. الشعر إذاً دعوة كما كل سؤال دعوة. وأنت مدعو قصداً أو عمداً. الشعر إذاً ولد في عزلته القصوى مجال تواصل واتصال (…). ومن جمالات هذا الكلام (العنوان) أيضاً، هذا التقابل الثنائي بين الذهب (…) والوردة (…) والاحتراق الثنائي الملتحم بالإلتقاء النهائي (الغائي) يشكلان معاً وحدة جدل غني متعدّد الحركة خصيب ومخصّب بالتزاوج الذي هو الإختلاف والإتفاق، الإختراق والإلتقاء. فنحن إذاً حيال ثلاثية جدلية منبثقة من أصل واحد قائمة فيه. وهذا هو الشكل الأمثل للجدل الهيغلي.
¶ محمد جمال باروت: لم ينظر أنسي الحاج إلى الشاعر إلا كنبيّ ملعون، فالشاعر الحر هو النبي، العرّاف والإله، ومن هنا فإن “لن” هو مغامرة حدسية، استنباطية لأعمال الذات، يبحث الشاعر فيها عن رفض ولَعْن لكل ما يحيط به، إن “لن” في ذلك، هو كتابة فضائحية، وفيه أراد أنسي الحاج أن يكون شاعراً مارقاً ملعوناً.
¶ هنري فريد صعب: أنسي الحاج شاعر يقاسم اللغة الهدم… خط سيره عمودي. ألفاظه، بعضها أجساد غنية بذاتها (وهي قليلة) والبقية تغتصب غناها من علاقاتها وتراسلها في ما بينها… شعره مغامرة. تظن غموضاً، لأن كل مغامرة ضرب في المجهول. لكنه غموض لا يتواقح. فإن آنسته كاشفك بمشاهداته في اسفاره مع اللغة، وتركك بين مصدّق وغير مصدّق إنه كاشفك بالحقيقة. وهذه ميزة الشعراء ذوي الخط العمودي: إنهم مستودع النصوص المقدّسة.
¶ هاشم شفيق: أنسي الحاج صوت نادر في مسيرة الشعر العربي الحديث، ففي حين كان الرواد منشغلين في تأسيس حركة شعرية جديدة لم يمض على حضورها أكثر من عقد واحد، كان أنسي الحاج عاكفاً على كلمات غريبة ذات مذاق مغاير، وخاص، كلمات لا تمتّ لتركيبة الشعر العربي الكلاسيكي بصلة…
¶ حسين الشيخ: لماذا لا تموت يا سيدي الشاعر، لكي احاول نسيانك؟ ذاكرتي امتلأت بك. صرت احفظك عن ظهر قلب. ودائما، حين تكتب، “أخمّن”… لكنك تفاجئ الروح من حيث لا تدري. اريد ان اكرهك، كما احبك الان… لكن حروفك الملتصقة بي تغلق دوني الباب.
لماذا لم تمت يا سيدي البحّار حتى الآن؟ ام علينا ان نموت نحن لكي تتخلص ارواحنا من فيء روحك الغامق؟ (…) انك تربك روحي (…) كيف تدير مفاتيح الاصغاء لدينا، وتلخبط كل موجاتنا؟ انك تربك الروح حقا، وتشوّشها.
¶ شهادات وأقوال، هي خلاصة مقالات وأبحاث، سبق أن كتبها شعراء وأدباء في أنسي الحاج.
أنسي الحاج… لن يفسد الذهب، لن تذبل الوردة
عباس بيضون
سيكون صعباً علينا ان نستقبل الغد وفي بالنا أن أنسي الحاج قد غاب. سيكون صعباً علينا أن نصدق انه فعلاً فارقنا، سنفكر أنه هذه المرة أيضاً مكر بنا، وابتعد. طالما ابتعد أنسي الحاج الذي لم يكن مثابراً البتة، طالما دخل إلى حجرته واختفى فيها، طالما غاب في مكتبه، أنسي الذي لم يكن منضبطاً ولا نظامياً ولا مداوماً ولا محترفاً، الذي كان هاوياً كبيراً ومغامراً صرفاً وقلقاً وعصابياً ومشدوداً باستمرار كالوتر، ما كان في استطاعة شيء أن يحبسه أو ان يلزمه بالوقوف أو ان يسجنه في موقف أو عادة أو تقليد أو بداية. طالما نفض يديه من أي شيء، فكرة كان أو موقفاً أو حرفة أو مجالاً أو حيزاً. مثقفاً كبيراً كان لكن بإيمان شعبي، ارستقراطي مترفع ممشوق، إنما بشغب حقيقي وتخط دائم ولنفسه أولاً، غاضب لكن شغوف، عصابي لكن حنون، متمرد بإلفته، سلبي بسمو، وحيد لكن بين جميع الذين جعلوه وحيداً، فردي بقلب شغوف، شاعر مضاد ولكن نحو البراءة، وما وراء البراءة. عجن اللغة لكن بيدي طفل، هدم الهيكل لكن بغصن وريشة، عبس في وجه الجميع لكن بلطف زائد، كان دونكيشوت ممزوجاً بالمسيح، قديسا في أهاب خاطئ، عفريتا يلعب الشر ويتلاعب به، نبيلاً إلى حد العبث، ساخراً بكرم بلا حدود.
لم يكن أنسي مجمع المتناقضات كما قد يخطر لقارئ أن يحسب. لم يكن متناقضاً في الأساس، لم يكن حتى مزدوجاً. كان شاعراً في نص كما كان شاعراً في شخص. لو مثل الشعر شخصاً لكان أنسي، لو شئنا ان نجعل منه نموذجاً لقلنا هذا هو الشاعر، لكأن أنسي كان يحتاط لذلك، يريد للشاعر ان يسكنه، ألا يفارقه. كانت له طلة شاعر، أحرى بي أن أقول جمال شاعر، ترفع لا يصل إلى الصلف، طيبة لا تصل إلى البساطة. فتوة لا يجري عليها العمر، رشاقة وشباب حفظهما حتى السبعينيات، هذه الطلة كانت تقول وتفكر وتتصرف بما يلائمها وما يتسق معها، ما كان يمكن أن تند من أنسي حركة أو لفتة ليس فيها شعر، يكتب شعراً لكن حركة يده شعر وابتسامته شعر ولفتته شعر، وهذا الشعر يتزايد كلما تقدم في العمر، وكلما مرت العواصف الأولى وأمطرت ياسمينا، كلما لان حطب الغضب وتبدل إلى ريحان، وكلما تحول المزاج المشدود إلى لطف واعتذار وأريحية، وكلما تحول الشعر إلى كرم وكلما التمعت العينان بذكاء طافح بالدراية والفهم.
ما كان أنسي يتيح للشعر أن يغلب الإنسان. لقد جعل منه إنساناً قبل كل شيء، لكأننا ندفن الشعر كلما دفنا شاعراً كأنسي، لكأننا نفقد الشعر كلما فقدنا شخصاً مثله. لأنسي مع الشعر حكاية هي تماماً حكايته مع الحياة، لم يقدس أنسي شيئاً ولا حتى الشعر. لم يكن الشعر عنده أعلى من الحياة، ولا مختلفاً عنها. لم يكن الشعر تأليها لأسلوب أو لغة ولم يكن في وسع أنسي ان يرابط عند أسلوب أو لغة. لم يكن يستطيع أن يمنح نفسه لجملة أو إيقاع، ان يتعبد لجملة أو إيقاع. كان الشعر مغامرته وهي مغامرة لا تطيق الرتابة ولا تطيق الامتثال ولا تطيق الانضباط ولا المداومة. كل مجموعة لأنسي هي معركة، كل مجموعة له انقلاب على نفسه وعلى شعره، كل مجموعة هي امتحان جديد وهي اختبار واسع، لا نصدق ان شاعر “لن” و”الرأس المقطوع” هو ذاته شاعر “ماضي الأيام الآتية” و”ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة”، لا نصدق أن شاعر هذين الأخيرين هو شاعر “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع” و”الوليمة”، كان أنسي جواب شعر والشعر بالنسبة له قفزة تلو قفزة، كان أنسي يهدم بيديه ما سبق له أن عمّره وبناه. يخون نصوصه نصا بعد نص. يرفع نصبا وما ان يكتمل حتى يلقيه جانباً. يغادر الأشياء في عزها وفي ذروتها، لا يطيق أن يعود إلى عبارة وإلى كلام صنعهما، في الذروة كان يغيب وفي الذروة كان يترك. هكذا فارق الشعر نفسه وهو في عزه، هجر الشعر لأنه لم يعد في عصبه وجسده، لأنه بات حرفة بعد أن كان شغفاً، لأنه صار صنعة بعد أن كان مغامرة.
أما أنسي الذي كان في صداقته أميراً، والذي لم يغادر إلا بعد ان تمتم اسماء أصدقائه وحياهم بها فسيبقى. لطالما حضر وهو غائب وكم كان غيابه مفعماً.
أنسي الحاج المرشد إلى الضلال
محمد عيد ابراهيم
“أصبح ارتحالي من فصل إلى فصل
حجّةً لتدبير الغذاء بقصد ارتحال آخر
وكما تتّجه الطيور بحكمة
رحتُ أدبّ من محيطٍ إلى محيط
من القمم إلى الأغصان
من ليل إلى ليل إلى ليل
حتى ضربتُ بصِيتِ الجنون العذب”.
قد أكون أول من قرأ أنسي الحاج في مصر، فقد كان ممنوعاً وكلّ مطبوعات “مجلة شعر” طيلة فترة عبد الناصر، لكن، وما إن توفّي حتى انداحت المطبوعات في معرض الكتاب ساعتها، أذكر عام 1972، وكان المعرض في بدايته، بأرض الجزيرة، محلّ الأوبرا الحالية، والدكتورة سهير القلماوي رئيسة هيئة التأليف والنشر، التي صارت هيئة الكتاب في ما بعد.
قبلما أقتني أنسي الحاج، خاصة “ماضي الأيام الآتية”، لم تكن تستهويني كثيراً اللغة التي يكتب بها صلاح عبد الصبور أو حجازي، إلا في التنويع على القديم، وبثّ روح من الخيال أو الرقّة أو التعامل المهادن مع المجاز وشكل القصيدة ورؤيتها للعالم.
وهو رأي تخلّيتُ عنه بعدئذٍ، فقد كنتُ مغالياً قليلاً أيامها، لكنه وجد صدىً في نفسي تلك التي كانت تهفو إلى تقطيع أوصال اللغة، والحلم بحذف الروابط “السخيفة، كما كنتُ أسميها” كأحرف الجرّ والعطف وأسماء الوصل إلخ، فهي التي تمطّ حبل الجملة وتبعث فيها الترهّل والتبذّل والليونة، وأنا كلّ ما أريده من الجملة أن تكون مشدودة، على العظم، من دون أيّ شحوم قد تسيء لمظهر القصيدة العام.
قد يحلم الشاعر في بداياته أن يمتلك العالم، ويصفّيه في نقطة وكلمة، يختصره في أقصر طريق ممكنة، يحلم بأن يقتطف الغيم ويأكل السراب، كما كتب “بورخيس” مرة في قصة ترجمتها له بكتابي “مرآة الحبر”، عن شاعر أمره الملك بأن يكتب قصيدة تحوي كلّ ما في العالم من عجائب وغرائب، من سحر وفلسفة وجغرافيا وتواريخ، أديان وآلام وصراعات ومقاتل وممالك قامت إلى أن انهارت إلخ، لكنه اشترط عليه أن تصبح هذه القصيدة في كلمة واحدة، وأسكنه قصراً فيه مرايا وأعمدة بهية وغرف يتوه فيها، لكي يهيئ له الحال، ثم عمل الشاعر مجهَداً أياماً وأسابيع وأشهراً، ومرّ عام ثم عام وعام، وحين أخفق الشاعر في اختصار العالم في كلمة واحدة، جندله الملك.
وقد كتب أنسي نفسه عن هذه الحالة، يقول:
“سحقاً للشعراء!
لولا ضجري منهم
لما كتبتُ الشعر
ولو لم أكتب الشعر
لكنتُ بقيت
كما كنتُ في مطلع العمر
مجموعة أشعار غامضة
لا أسمح بالاقتراب منها
إلا لمن يعطيني كلّ شيء…”
لم يكن أنسي الحاج “آدم الشعر”، فقد كتب قبله كثيرون، لكني كنتُ أراه أقرب إلى قابيل، ذلك الذي أحبّ “إقليميا” امرأة هابيل، ولم يرتض “لويذاء” امرأته، كما جاء في الأثر العربيّ القديم، فلم يكن من طريق أمامه غير قتل هابيل لتخلُص له امرأته، وهو أول فعل عنيف في الحياة.
كما كنتُ أرى أنسي الحاج ذلك الغراب الذي أرشد قابيل كيف يواري سوأة أخيه، فلم يكتب أنسي الشعر لمجرد القتل، قتل تلك البلاغة القديمة الحائرة بين الشعر والنثر، بين السرد في فضاء لم يقتحمه أحد بلغات لا يحدّ من طيرانها قيد ولا شرط، وبين التحليق في فضاء موزون مقفىً يقصقص جناحيه القيد بما لدى الشاعر مما وضعه له السلف من دون معرفة ما قد يتطوّر إليه الخلف أو يؤول إليهم من أفعال جمالية قد لا تروق لهم.
الغراب
أما الغراب فهو الذي يُرشد الشعراء إلى مآل هو نفسه لا يعرف مبتداه ولا آخرته. الغراب صاحب الرمز العنيف للموت، الغراب أصل الحياة مع أن ريشة الموت على جناحه، الغراب لا يقتل، بل يُرشد القاتل إلى ضحيته، الغراب كما يقول أنسي الحاج هو الشيطان الأبيض “لكن الخريف الصخرةَ، وأنت، يا الراعي، تمضي ولا تصدّق؟ أعضّ الطهارة وراء تجاعيدك الكلاسيكية. أنا الشيطان الأبيض لم تسمع به. وإن تكلّمتُ فكي أُلهي القفر في الخلاء/ فأكمن للرعاة الصغار عند الأفق والقوارب تتكسّر على التجاعيد، والأجساد تتمزّق على الأهداف. وفي كلّ سلّة ينبض الشيطان الأبيض”.
وقد يكون أنسي الحاج أيضاً هو الهدهد الذي أرشد سليمان النبيّ الشاعر صاحب “نشيد الأَنشاد” إلى مهاوي القصيدة ومفاتنها، إلى الزهرة والظباء، إلى سوسنة الأودية وخريف الحياة بعد العشق، “لا تنبّهن الحبيب حتى يشاء/ فسيفه على فخذه من هول الليل، وشَعره حالك كالغراب”، ليتك أخ لي أيها الشعر، أقبّلك ولا يخزونني، فأسقيك من سُلاف رُمّاني. الهدهد هنا هو الغراب، مقلوباً، فهو المرشد إلى الضلال، لكنه ضلال الحياة، كما كان الغراب هو المرشد إلى فخّ وهيئة الموت، وهو نقيض الحياة، كلاً من الغراب والهدهد حيوانان سماويان يهديان الشاعر إلى الشعر، الشعر الذي لا سكّة له إلا في الموت ولا قلب له إلا في الحياة، نحن طلاّب حياة، نحن الشعراء لا نريد الموت إلا في القصيدة، فالقصيدة هي أنفاس الحياة وهي توافيق الموت في النهاية.
يقول أنسي الحاج:
“الكتابة التي كانت تسكنني ماتت
حلّ محلها، برياحه وأمطاره،
السيد الوقت.
صرتُ أستغرب الشعر
أقول عن الأطفال أطفال
عن ركبة امرأة ركبة امرأة
لا تكبّراً،
بل لأني كنتُ شاعراً،
وما كنتُ كما قلتُ
أسمي هذه الأشياء، بل أراها
وظننتُ صبحَ يومٍ من الأيام
أنني خالد،
حتى فاحت الكآبة التي كانت
والتي لم أعرف كيف
ماتت كالمسك”.
أنسي الحاج، شاعر يريد أن يبدأ الكون، لكنه ليس آدم، هو قابيل، فقد تملّكته الكآبة التي لم يعرف كيف ماتت، لقد سحرته الأشياء بمجرد لمسة، كما سحر هو الأشياء بمجرد لمسة، فلا هي دلّته على الطريق، ولا عرف كيف يدلّها على ما كانت عليه أو ما ستؤول إليه، لا الرائحة أشارت إلى رائحة، ولا دلّ الموت عينيه في النهاية على الطريق القويم التي يُفترض أن نسلكه لنكتب.
أنسي الحاج تائه في فلاة الكلام، لا أفق أمامه، ولا حتى سراب، لكنه يمشي ويمشي، الهدف هو الطريق والأمل هو السحابة التي فوقه كلّما عطش أو جاع أو يئس أو اقترب من الجنون، أنسي الحاج هو عرّاب قصيدة النثر، مع أنه هو نفسه لم يتسلّم هذه العرابة من أحد، كما أنه لم يسلّمها لأحد، فهي سراب طويل في صحراء لا تهدي إلى أحد قد يتبعه، ولا قصيدة عنده هي المقياس على أنه قد محا الحدود بين الشعر والنثر، فلم يعد السرد عنده موقّعاً إلا من الضرب على جلده هو، لكنه بضربه هذا كان يعذّب الآباء بتوبتهم وأنهار ندمهم، فهو يركض ويرمي المفتاح في البراري، وإن وجد المفتاح لا يأخذه، هو يهرب ليرجع، ويرجع ليهرب، وفي رأسه خلخال العذاب. القصيدة عند أنسي الحاج لم تفعل غير كتابتها، وهو لم يفعل غير قراءتها، يقول إنه “لم يفعل غير الجلوس فوق الحقيقة”.
محمد عيد إبراهيم
شاعر ومترجم مصريّ
أنسي الحاج.. الرائد، الخلاق، المتمرد
محمد دريوس
لم يكن الشعر قبل أنسي الحاج شعراً، فكيف سيكون بعد رحيله، لم تكن قصيدة النثر قد ترطّبت بعد بدم الشاعر فكيف ستورق مجدداً، كيف ستستمرّ تلك الجذوة المتقدة التي بدا أنه قابض عليها في حنجرته والتي كان سيموت إن لم يبقها (على حد تعبير شوقي أبي شقرا) لظى وألسنة لهب، كان الشعر (بل والكتابة برمتها) مرهوناً بأكمله في قوارير زجاجية لا رائحة تفوح من دمه النقي ولا ملمس لعصفه، لغة معقمة، مكرورة، خارجة للتو من موازين الصيارفة وعباءات الكهنة، لغة ترتدي أقنعة خلف أقنعة خلف أقنعة يكاد لا يظهر وجهها إلا ليُغطى بالوعظ، بالرغم من وجود شعراء معه وخلفه يشاركونه النظرة المغايرة إلا أنهم كانوا لا يزالون أسرى (الغرض الشعري) أمناء للمبنى والمعنى، فقهاء لا أكثر، ثم حصل أنسي الحاج….
في بيانه الصادم في مقدمة “لن” جلد الأرض بحزامه وقال، قال ما شكّل بياناً أولياً يصلح برنامج عمل لمنظمة ثورية تعمل على انقلاب أكثر مما هو مقدمة لكتاب شعري، بيان غاضب يصلح كوجهة نظر عامة لحداثة منشودة ومرتجاة، في اللغة وفي الفكر وفي النظر بعامة إلى الحياة كيف ينبغي لها أن تكون، قال إن اللغة كائن حي يسقم ويعتلّ وينمو وقد يموت، قال إن الفوضى أجمل من الترتيب وإن الخلاص بالشعر وبالحب وبحب الشعر وشعر الحب، قال إن العالم تنقصه أنوثة والأديان ينقصها حب، وقال إن سرطان الزيف يغشي المجتمع العربي.
لا حاجة إلى الأبطال ليكتب عنهم أنسي الحاج، لا حاجة إلى المنتصرين أيضاً، إذ إن المنتصر يُهزم لحظة انتصاره، يكتب عن عاشق خائب وجذل بخيبته مثلما هو جذل بوصاله، وعن الذين يسقطون من البرج ويرون في اللحظة عينها جمال العالم، رأى الشعر في مكان آخر، بعيداً عن ضجيج العقائد وصراخ الشعارات، رآه في قرية المهزومين والحالمين ومتسولي الشفقة، وضع على رأسه تاج الشوك وسيّره في أزقة متربة، كان قدّيس كلمة وراهب حرف، تعلم بالطريقة الأصعب كيف يخلّص قصيدته من الجاهز ويشحنها بالذهب السائل.
كان شاعراً من طينة أخرى، شاعراً قادماً من توتر لغوي وفكري وليس من عصاب عقائدي، ترك الجميع يتلهون بمعارك جانبية وجلس يدخّن مبتسماً، عارفاً أن الحقيقة ابنة التأمل البارد، ابنة النظر إلى الماوراء، ابنة العزلة والانفراد لا الجموع والصراخ، تركهم يتخبطون في تعريف المعرّف، في تبرير المبررّ وجلس ليكتب، نقل أنتونان أرتو فقال: إنه يسيطر علي، لا أستطيع الفكاك من هذا السرطان، قابل جاك برفير فأرهقه التفكير في القصيدة، حاور سلفادور دالي فأخذ يضحك، أنسي الحاج لا يُتعبك كثيراً في الحصول على معنى من كتابته، لكنه يرغمك على النظر بعمق، شاعر تؤلمه الضحالة ويجرحه التسطيح فيجبرك أن تنزع تلك الغشاوة عن عينيك لتجول في ما فكّر فيه عنك وأعطاك إياه، مجاناً، لتسعد.
أنسي الحاج الآخر، الذي أتعبه مبكراً التصادم مع الزيف والتسليع، مع كهنة المبادئ ومدرّسي المشاعر، استقر طويلا في خواتمه كأنه يصفي حساباً مراً مع اللغة والقيم والأديان، ختم باكراً تمرده وصخب احتجاجه وكتب “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع” كتب الحب كعاشق مكلوم وجائع، كتب المسيح كقديس أحمر، تصالح باكراً مع من يفترض أن يثور عليهم وظنّ بالكتابة سبيلا إلى احتمال قسوة العالم، كأنه قسم العالم إلى حكمة نافعة – بالمعنى الاستهلاكي – فكرهها وحكمة مجانية لا غاية لها إلا الغوص في الجمال، فغفا في حضن شجرتها.
كل النساء يشتهين أن يكنّ امرأته المكتوبة، يكتب عن امرأة تبيع الزهر في حانة لكحوليين فتصبح حلم الجميع ونروح نبحث عنها بشغف، يخفي بمهارة شياطين رأسه ويروضها، امرأته من شهوة ومعرفة، لن تقبض على صورتها حتى تتفلّت من صورة أخرى أدق وأكثر براءة وشهوانية، امرأة تستطيع أن تغادر جنتك لأجلها غير آسف، يكتب عن المرأة فيجعل ألطف شخص فينا، مقيتاً فائض الذكورة، يكتب خالقته وخائنها، يكتب عن امرأة يكاتبها وتكاتبه، يكتب عن والدته وأخته وعشيقته وابنته، يكتب نساءه بالتبر فننوح لضعفنا، يهدي: مغلوبك ِ، فنرضخ.
كنت حتى وقت قريب خلا أظنه أسطورة لا أكثر، رجل لا يحتاج إلى أن يشعر مثلنا، أن تنتابه المشاعر الاعتيادية، أن يضطر أن يجادل ويماحك ويصحّح ويعترف، حتى عندما كان يكتب عن خيبة أمل ما كان يجعلك تراها كتجربة روحية محضة، ساهم في ذلك ترفعه عن الضجيج الإعلامي وقلة ظهوره، لكن ربما الكتابة الصحافية أرغمته على الخوض في الراهن والحالي، أرغمته على الخوض في السياسة وهو من ترفع عن وُحولها طويلا، ألم يقل: قلمي ذهب أرفض أن يضيع في القتال، كأنه يعيش من دون بشر، من دون أبناء وبلا جيران، يعيش مع ناس رأسه، مع أبنائه الذين خلقهم من حدس وتلمّس في العتمة فأعادوا خلقه من حبر.
قاد أنسي الحاج الشعر من ذهب رأسه إلى حيث لن تجدي، بعد الآن، أية محاولة لحبسه، قاده إلى مأزق الحرية المتجدد وغير المعرّف، وضع نفسه ـ وأي شاعر آخر ـ على الحافة حيث ينبغي له أن يعيش، على حد النصل، حيث يتباهى بموته الوشيك ونجاته الوشيكة.
“الخلق الشعري الصافي سيتعطّل أمره في هذا الجو العاصف”: يقول، الخلق الشعري الصافي أي الشعر النقي الذي لا غاية له إلا النشوة، الذي يرفرف حولنا بجناح الخفة ودقة الإصابة، الذي يحيط بهالة رأسه والذي رآه هو وجعلنا نراه، إلى الأبد.
“أيها الشاعر/ أيها المعدن النفيس/ إنها الحياة التي في ذهب رأسك”.
(شاعر سوري)
خَــارِجَ الغابَــة، دَاخِلَهـا
صلاح بوسريف
لا يمكن الحديث عن الشِّعر المُعاصِر، دون ذِكْر أنسي الحاج. فهو واحد من الشُّعراء الذين لم تكن الحداثة عندهم مُجرَّد كلام نظري، أو مفاهيم انْتَقَلتْ من ثقافة إلى أخرى، بل إنه جمع، في وعيه ومعرفتِه الشَّعْرِيَيْن، بين الوعي النظري بالحداثة، باعتبارها انتقالاً، وخُروجاً من نسق فكري وشعري، أو جمالي بالأحرى، وبين المُمارَسَة النَّصِّيَة، باعتبارها أرضاً، من خلالها، حاول الحاج أن ينتقل بالكتابة الشِّعرية إلى مرحلة لم يَعُد معها النص الشِّعري، هو”القصيدة”، كما جاءتنا من ماضي الشِّعر، بكل تَبِعَاتِها الشَّفاهية، إلى الكتابة، كمُقْتَرَحٍ، هو في جوهره قَطْع مع القصيدة، وتوسيع لِدَوَالِّ الشِّعر، الذي لم يَعُد “الوزن” هو دالُّه المُهَيْمِن أو “الأكبر”. فمقدمة ديوانه الأول “لن”، رغم استعانتها بكتاب سوزان برنار حول “قصيدة النثر”، فهي كانت بمثابة البيان الشِّعري، الذي أسَّسَ من خلاله أنسي الحاج رؤيتَه واختيارَه الشِّعرِيَيْن. لا وزن ولا نثر، بالمعنى الذي حَدَثَ به الفصْل بينهُما في التصوُّر الثقافي العام، الذي فصَل بين النثر والشِّعر، واعْتَبرهُما لا يلتقيان، بل الشِّعر، بِكُلِّ مُمْكِناتِه التي يمكن اخْتِلاقُها، أو اجْتِرَاحُها أبَّان لحظة الكتابة. النثر هو حَدٍّ من حدود الشِّعر، وأحد الدَّوالّ التي استثمرتْها الشِّعرية المُعاصِرَة لِتُوَسِّعَ بها أُفُقَ النص، ما سيجعل من الوزن، بمعناه الكَمِّيّ، ليس شَرْطاً من شروط الشِّعر، لأنَّ الإيقاعَ، سيصبح هو الدَّالّ الأوسَع، لا “الأكبر” في هذه الشِّعرية، وسيتَّخِذ في تجربة الحاج، في “لن”، كما في غيرها من الدواوين اللاحقة عليه، صورةً مُغايِرَةً لِما كانت عليه في تجارب بعض مُجايليه ممن كان الوزن شرطاً من شروط كتابتهم. ولعلَّ في استثمار إمكانات اللغة، بِحَدَّيْها “النثري” و”الشِّعري”، أي بكسر الحدود بينهُما، ما أتاح لأنسي الحاج أن يخرج من القوالب التعبيرية، أو البلاغية التي بقيت ظلالُها حاضرةً في ما سُمِّيَ بـ”الشِّعر الحر”، في ما كتَبَه السياب، ورِفاقُه، ممن كان جبرا إبراهيم جبرا اعتبرهُم شُعراء بَعْثٍ. في هَدْم هذا الحَدّ، الذي كانت الشِّعرية العربية القديمة اعْتَبَرَتْه فاصلاً بين لُغَتَيْن، أو أسلوبيْن في التعبير، كانت شعرية أخرى، جديدة، تخرج من رَماد “القصيدة”، ولا تقبل بـ”مُساوَمَة” الشَّكل الجديد، بما يَشِي بقديم الشِّعر، أو ببعض دَوَالِّه التي بقيت راسِخَةً في هذا “الشِّعر الحر”، من مثل الوزن والقافية، رغم ما عرفاه من تعديلاتٍ، أو تخْفِيفٍِ من حُضورِهِما التناظري، الذي قامت عليه “الشِّعرية العمودية”. فما ذهب إليه الحاج، هو خُروجٌ من الغابة، من شَجَرِها القديم، من ظلالها، ومن هذا الهواء الذي كانت أنْفاس العابرين لا تزال موجودةً فيها. سيكون هذا الخُروج، بمثابة صَدْمَة في قلب الصَّدْمَة. ففي الوقت الذي كانت المعركة لا تزال قائمةً حول شرعية “الشِّعر الحر”، وحول “قصيدة النثر” التي كانت شَرَعتْ في الظهور، والانتشار، نَصاً وممارسةً، خرج أنسي الحاج على القارئ العربي، بكتابة، وضَعَتْه في حَرَجٍ، لأنَّ هذه الكتابة خرجَت عن كل المعايير التي كانت معروفة، ولها بنياتُها، أو ما تتأسَّس عليه، وفق مفهوم ابن طباطبا العلوي لـ”التأسيس”، ودَفَعَت بالنص الشِّعري خطوات أخرى إلى الأمام. صَدْمَةٌ في قلب الصدمة، هذا ما مَيَّز شعرية الحاج، ليس قياساً بالشِّعر الحُر، بل بقصيدة النثر نفسها. فنثرية الحاج، تَلَقَت لنفسها لُغةً خاصةً بها، والصُّوَرُ، في التراكيب التي اجْتَرَحَها الحاج، لم تَعُد هي نفس الصُّوَر التي يمكن الاستدلال عليها بحدود التشبيه، أو المجاز، كما كرَّسَتْهُما البلاغة القديمة، بل إنَّ صُوَر الحاج جاءتْ مُفارِقَةً للمألوف، وكأنَّها خَرَجَت من وُجودٍ لا سابقَ له، أو من غابات بلا كائِناتٍ. ما يُولَد للِتَّوِّ، مثل البَرْق الخاطف الذي يكشف كُلَّ شيء، لِيُخْفيه بنفس درجة انبثاقة وظهوره. لا يمكن التَّعامُل مع هذه الشِّعرية المُفارِقَة، بالاحتكام لِمَرْجِعِيَّة تعبيرية سابقة عليها، كما لا يمكن وضعها بالمقارنة مع غيرها، مِمَّا كان يوازيها من تجارب، كان لها حضورُها، وطريقتُها في صياغة “المعنى” أو اختلاقه. فأنسي الحاج، بقد ما كانت عينُه على الغابة، بقدر ما كان ينظر إليها من خارجها، وهذا الوضع، في اعتقادي، هو ما أتاح له أن يكشف السِّر في “الانزياح” عن الغابة، فالمسافة كانت كافِيَةً لفهم طِباع الرِّياح التي كانت تُحَرِّك شَجرَها. هذا ما لم يفعله بعض الذين بقيت تحربتهم “النثرية”، داخل الغابة، رغم ما كان لها من رغبة في الخروج منها. جُرْأة الحاج جاءت كبيرةً. وكانت نوعاً من التأسيس لشعرية مُخْتَلِفَة، ومُغايِرَة لِما كان بدأ يظهر من نمطية في “القصيدة المُعاصرة” نفسها. تجربة أنسي الحاج، تنتمي، في سياق ما كنتُ سَمَّيْتُه في كتاب “حداثة الشِّعر العربي المعاصر”، لـ”حداثة الكتابة”، لا لـ”حداثة القصيدة” التي انتَقَدْتُها، لأنَّها بقيتْ مُنْطَوِيَةٍ على ماضيها، وعلى الشِّعرية الشفاهية، أو الوعي الشفاهي، الذي بَقِيَ مُهيمناً فيها، بكل تمظهُراته النصية، التي لم تخرج من نسقية “القصيدة”. الإيقاع، في هذه التجربة، تتدخَّل في “صناعته” وفي صياغته، دَوَال مُتَعَدِّدَة، بما فيها ما قد يبدو للقاريء أنه تَفَكُّك في بناء الجملة، أو الصورة بالأحرى، التي لا يبنيها الحاج بنوع من الربط التعبيري الذي يُفْضِي رأساً لـ”المعنى”، بل إنَّ هذه الجملة، أو الصورة تأتي، في كثير من الأوضاع النصية، مُتَشَظِّيَةً، كأنَّها تفاريق، لا شيء يجمع بينها. هذا النوع من االكتابة، هو ما ينأى بشعرية الحاج عن الشِّعرية الشفاهية، التي تُسَهِّلُ إلقاء النص وإنشاده، وتذهبُ بها إلى شعرية الكتابة، أو الوعي الكتابي، الذي هو سمة الحداثة بامتياز، وسمة «حداثة الكتابة” لا “حداثة القصيدة”. ليست الجملة هي رهان الحاج على “المعنى”، فالنص هو ما يعنيه، لأنَّ وُجودَه خارج الغابة، كان كافياً ليُعَلِّمَه، كيف يحتوي الكُلّ في نظرة واحدة، أو بِما يخطف البَصَرَ، ويَشُدُّه لهذا الكُل في شموليته.
وعي هذه الشروط، في قراءة تجربة أنسي الحاج، سيجعلنا نعي ما تختزنه هذه التجربة من طاقات هائلة في توسيع الدَّوال، وفي تفتيق المعاني وتَشْقِيقِها. ولعل في تجربة الحاج، ما يفتح النظرية نفسها، على مراجعة مفاهيمها، بالإنصات لِما يقترحه النص، لا ما يأتي من خارجه. بمعنى أنَّ التأسيس للشعرية الكتابية، يخرج من طَيَّات النصوص، وما تَحْفَل به من اقتراحات واجْتِراحاتٍ. فمشكلة التجنيس، والتسمية، يزيدان، في هذا النوع من الكتابة الاختراقية، التباساً، وتضاعف مشكلاتهما النظرية، قياساً بالتَّوَسُّعات التي باتَتْ من سمات هذه الحداثة، التي كان أنسي الحاج من روادها، ومن الذين كانوا ينظرون لمستقبل الشِّعر، دون البقاء في سياق المُكْتسبات، التي لم يخرج منها عدد من مجايلي الحاج، ومن الشُّعراء الذين بقيتْ تجاربهم تُراوِح الغابةَ، دون أن تَجْرُؤَ على مغادرتها. [ شاعر من المغرب
أنسي الحاج.. الرائد، الخلاق، المتمرد
الرسولة تبكي
اسكندر حبش
“قولوا هذا موعدي وامنحوني الوقت.
سوف يكون للجميع وقت، فاصبروا.
اصبروا عليَّ لأجمعِ نثري.
زيارتُكم عاجلة وسَفَري طويل
نظرُكم خاطف وورقي مُبعْثَر
محبّتُكم صيف وحُبّيَ الأرض”، (أنسي الحاج).
لا أعرف إن كانت الحياة منحتك الوقت. كنّا نرغب في أن تبقى أكثر. لكن نقنع أنفسنا في نهاية الأمر وأمام هذا العجز الدائم الذي لا نقوى عليه، بأن هناك شيئاً يُسمى القدر، وبأن له الكلمة الأخيرة علينا، بالرغم من أننا لم نفعل شيئاً في حياتنا سوى التعاطي مع الكلمات وعجنها وتدويرها واختراعها واختراع حيوات عديدة عبرها. وسنقول أيضا إن الشعراء لا يموتون فكلماتهم باقية ولن نتوقف عن استعادتها، وإنهم حاضرون في وجداننا، إلى آخر هذا الكلام الذي يأتينا فجأة ونسكت أمامه، راضخين.
ربما هذا كله ليس سوى وهم من أوهامنا المتعددة والكثيرة التي لا تتوقف عن الاتساع يوما بعد يوم. لا بدّ من أن تنكسر فينا أشياء كثيرة عند لحظة الرحيل، ولا بدّ من أن نقف ونتساءل حول أيهما الأصعب: الرحيل أم اعتياد المرء على الحياة بعد أن يغادر من يغادر؟ لا أعرف جوابا واضحا. كل ما أعرفه أن “سفرك طويل” هذا اليوم، وأن زيارتنا “عاجلة” حتى لا نشاهد أنفسنا في مرآة الرحيل، أو على الأقل حتى نؤجله ولا نفكر فيه. كلّ ما سنفعله، حين نعود في المساء، نجمع كلماتنا ونكتب أسطراً عدة، وفي أحسن الأحوال، نتذكر بعض ما كتبته على أوراقك المبعثرة، لنمضي كي نحاول الاعتياد وربما النسيان، وربما أيضا اللحاق بما تبقى لنا من لحظات هذه الحياة التي لم تعد تمنحنا سوى مواعيد الغياب التي نترقبها “بنظرات خاطفة”.
هناك “حيث لا ألم ولا وجع”. هذا ما نقوله في طقسنا البيزنطي. لكن “هناك” هو أيضا هذا المخيف، هذا المجهول. ألم نكتب كي نخفف من وطأة احتمالات “الهناك”؟ وربما من احتمالات “الهنا” الذي يبدو أرعب في كثير من النواحي، تماما مثلما قلت ذات يوم: “ما عدت أحتمل الأرض/ فالأكبر من الأرض لا يحتملها/ ما عدت أحتمل الأجيال/ فالأعرف من الأجيال يضيق بها/ ما عدت أحتمل الجالسين/ فالجالسون دفنوا”. بالتأكيد لم تكن تقصد ذلك، وكنت تحاول أن “تخدعنا” ربما. لقد رحل الجالسون مبكرا، ولم يتبقَّ سوى هذا الصدى من الأغنية الذي يذكرنا يوما بمرور ما على الأرض.
لن أقول هنا، إنك خططت دربا في القصيدة العربية الجديدة، ولن أضيف إنك فتحت طريقا مع رفاقك لكل الذين جاؤوا من بعدكم. كل ما أرغب في قوله هو هذا التساؤل حول معنى الرثاء وهل ينفع بعد؟ ولا أكتب رثاء، بل حجة لأستعيد معها مقطعا كالذي كتبته ذات يوم: “وسوف تفتح لكم الحياة/ سوف تفتح الخزائن/ سوف تفتح الحياة/ ولن أكون بينكم/ لأنّ ريشة صغيرة من عصفور/ في اللطيف الربيع/ ستكلل رأسي/ وشجر البرد سيحويني/ وامرأة باقية بعيدة ستبكيني/ وبكاؤها كحياتي جميل”.
لا أعرف إن كانت الرسولة ستأتي لتضع شعرها فوق الذهب، أم أنها تأتي لك بوردة الينابيع. قد تجلس هي بيننا الآن لتبكي، ولن يشاهدك سواها وأنت تقف لتقول لها: “تقولين البكاء يغمر، كالضمة/ تعالي. سأكون أنا البكاء إلى الأبد”.
إسكندر حبش
سر الشعر أقدس من حقيقة المعرفة به
عبدالزهرة زكي
هذا العنوان مأخوذ من جملة لأنسي الحاج جاءت في (خواتيم) بصياغة أخرى لغرض آخر غير هذا الذي جاءت به هنا.
تجربة أنسي بين الشعر وبين المعرفة به والتنظير المبكر له تسمح بمثل هذا التحوير وتتطلبه، فبين أواخر خمسينيات القرن الماضي، حيث تقدم أنسي الحاج بمقدِّمة وديوان (لن) وبين سنواتنا هذه زمن من الشعر والأفكار، ومعهما التغيير حتماً، تغيير في الشعر وفي رؤيته والمعرفة به.
حتمية التغيير هنا مناسِبة، لا صلة لها بفهم راديكالي، لا تكترث كثيراً بادعاءات راديكالية، طمح رامبو إلى إمكانية تغيير العالم بالشعر، غيَّره الشعر، غيّر حياته الشخصية، كما تغيَّرت حياة ماياكوفسكي، قبل أن يغيِّر هو العالمَ بالشعر، حتمية التغيير حين يكون الحديث عن أنسي الحاج هي مناسِبة لاقترانها بمناسَبة الشعر، وأيُّ شعر..؟ ديوان (لن) ومقدمته الأشهر منه، وهذا مبرري لتقديم المقدِّمة على الديوان، وهي (مقدَّمة) في كل حال..
وفي عالم الشعر لا يضارع جمال الشعر سوى التفكير فيه.. أحياناً كثيرة يكون التفكير والتأمل في الشعر لا يقلّان قدراً وقيمةً ومتعةً عن الشعر نفسه، لكن في أحيان نادرة ثمة من الشعراء مَن يكفيه من الشعر ما يتأمله فيه وما يفكر.
لن يقل من قدْر الشعر أن لا يكون قادراً على تغيير العالم، قيمة الشعر هي في أن يتغيّرهو وأن يتبدّل ويتحوّل، ما لم يقوَ على ذلك، ما لم يستطع أن يغيِّر في طبيعته فإنه يكفّ عن أن يمتَّ إلى هذه الطبيعة بصلة.
وخلال أكثر من ستين عاماً في الشعر، كان شعر أنسي الحاج وأنسي ذاته يتحولان ويتغيران.. المسافة بين وعده الأول في (لن) وبين نشيده الطويل (الرسولة بشعرها الطويل..) هي مسافة مشحونة بالتوتر الشديد بين تواصل إشراق اللغة في العملين من جانب وانقطاع وظيفتي اللغة تعبيرياً من جانب ثانٍ عن بعضهما في الديوانين.
لن يكون عسيراً على قارئ أن يتابع ذينك التواصل والإنقطاع، وسيكون أيضاً بميسور القارئ ملاحظة ذلك حين يقرن (لن) بأي ديوان تالٍ لأنسي بالإضافة إلى (الرسولة..)، لكن هذه المقاربات كلها لن تمر عابرة على مقدمة (لن)، لن تقوى على أن تكون غير مبالية بمدى صلة شعر أنسي الحاج، سواء في (لن) أو في الأعمال التالية، بتلك المقدمة ذات اللغة التي يتمازج فيها التبشير الشعري بالطموح الثقافي الثوري.
أخلاقياً لن يكون ممكناً المرور بهذه الصلة من دون الابتداء باعتذار كان قد بادر به أنسي نفسه، ولن يضيره أنه اعتذار جاء متأخراً، لقد حصل هذا بعد عقود في مناسبة كتب فيها أدونيس مؤخراً عن شاعر شاب من اليمن، لم أتوقّف عن الإعتذار عما اقترفته من تنظيرات، ويصفها أنسي بالنتظيرات الاعتباطية، فيما هي ليست هكذا تماماً.
اعتذار أنسي لن يعود مهماً وضرورياً، وتأخره لم يقدم أو يؤخر شيئاً، فأنسي، سواء في (لن) أو في مجمل عمله الشعري، لم يمتثل كثيراً لفروضه النظرية. لقد كان أول العاصين لتلك الفروض التي إذا ما تجاوزت فيها المقدمات التي أراد فيها حشد أكبر ما أتيح له حينها من مسوغات الخروج من دائرة الشعر الموزون العربي إلى الشعر غير الموزون، دعك مؤقتاً من تسمية قصيدة النثر، فستصادف حماسة للتنظير لقصيدة النثر، وبمواصفات واشتراطات لها لم تكن بالبعيدة عن محددات الفرنسية سوزان برنارد في كتابها (قصيدة النثر من بودلير حتى أيامنا)، وكان الكتاب حينها حديث الصدور في باريس.
لكن ما هو محددات لقصيدة النثر لدى برنارد في كتابها بات اشترطات لهذه القصيدة لدى أنسي الحاج في مقدمته لـ (لن)، وسيكون بعد أشهر على صدور (لن) والمقدمة اشتراطاتٍ أيضاً لدى شاعر طليعي آخر مثل أدونيس ومقاله المشهور عن قصيدة النثر.
كانت برنارد بكتابها تقرأ وتكتشف المحددات من تراث متراكم في قصيدة النثر الفرنسية، وهو عمل قريب، مع اختلاف الحقلين والثقافتين، مما كان قد فعله الخليل بن أحمد الفراهيدي قبل قرون وهو يفحص تراثاً شعرياً ويستنطقه من أجل بلوغ أنظمته العروضية السائدة فيه، وقد بلغها ليضع قوانين نهائية للشعر العربي كما أتيح لبرنارد الوقوف على القوانين الفاعلة في قصيدة النثر الفرنسية.
قصيدة عربية
وفيما أراد أنسي في مقدمة (لن) وضع أسس لم تكن بالبعيدة عن محددات برنارد فإن نصوص (لن) نفسها ومعظم ما جاء بعدها، وهي نصوص لم تخضع لبحور وتفاعيل الشعر العربي إلا ما جاء منها عفو الخاطر، كانت تضع مستقبلاً آخر، فنيّاً في الأقل، لقصيدة نثر عربية لا صلة لها تماماً بالمعيار الفرنسي، كما قدمته برنارد.
كثير من شعر أنسي لم يستقر ويرضخ لهذه التحديدات الفرنسية واشتراطات القراءة العربية لتلك التحديدات، وإلا ما الذي احتفظ به منتج أنسي، ومن ثم أدونيس، وسواهما من التقييد التالي الذي يأتي مباشرةً بعد الإشارة لبرنارد وكتابها في بيان لن (لتكون قصيدة النثر قصيدة نثر، أي قصيدة حقا لا قطعة نثر فنية أو محملة بالشعر، شروط ثلاثة: الإيجاز (أو الاختصار) التوهج، والمجانية. فالقصيدة، أي قصيدة، كما رأينا، لا يمكن أن تكون طويلة، وما الأشياء الأخرى الزائدة، كما يقول بو، سوى مجموعة من المتناقضات. يجب أن تكون قصيدة النثر قصيرة لتوفر عنصر الأشراق، ونتيجة التأثير الكلي المنبعث من وحدة عضوية راسخة، وهذه الوحدة العضوية تفقد لازمنيتها إن هي زحفت إلى نقطة معينة تبتغي بلوغها أو البرهنة عليها. إن قصيدة النثر عالم “بلا مقابل).
لقد بقي أنسي الحاج وفيّاً لصيغة من الإنشاد التي يكثر فيها خطاب النداء، ولكنه إنشاد بقي يتنوع ويغتني، كلما تقدم به الزمن والتجربة، بصوفية ذاتية وإن تغذّت من تراثات دينية متنوعة ومن مصادر إشراقية دينية وغير دينية، بينما تمكنت قصيدة النثر العربية، في ما بعد، من تخليق أكثر من طبيعة لهذه القصيدة وسيكون نموذج برنارد واحداً منها.
لقد كان أنسي أكثر حرية وأشد إخلاصاً للطبيعة الخاصة بقصيدته، وهي طبيعة تنامت حتى باتت تجد فيوضها في (الخواتيم)، شذرات، بإشراق لغوي وتعبيري، من التأمل الذي يتسرب فيه الشعر بالحكمة.
(ليس في الشعر ما هو نهائي) يقول أنسي في تلك المقدمة التأسيسية ذاتها، وهي عبارة أهّلت أنسي في الكتاب ذاته (لن)، بما تضمنه من المقدمة ومن نصوص، لأن يخرج على الإطار النظري الذي صاغه في المقدمة والذي سيقول عنه في ما بعد وهو بصدد الاعتذار والتوضيح (وما جاء استنادنا، أنا وأدونيس، إلى كتاب سوزان برنار عن قصيدة النثر إلّا إغراقاً لنا في جملةِ أخطاء)..
ربما الشعر هو عمل مستمر في (الخطأ)، بل يبدو ذلك أكيداً.. لا قيمة عملية ومنتجة للعمل الشعري في الصواب، ولعل المساحة المتبقية من العالم لعمل الشعر هي مناطق الخطأ في هذا العالم، ومن حسن حظ الشعر ودواعي بقائه وعمله أن العالم منتج حيوي للأخطاء، الشاعر يعرف بهذا، وهذه معارضة لعبارة قال بها أنسي مؤخراً (الشاعر لا يعرف)، ولكن معرفة الشاعر هي معرفة استبصار باطني واهتداء لمَواطن الشعر حيث ينبغي رمي البوصلة وإضاعة الدليل.
لقد تحدث أنسي الحاج، مفكراً بالشعر وبسواه، عميقاً فيما كان يصغي لأعماقه بعمق أشد وهو يصنع (هداياه) من أجل زيادة مساحة الصواب في عالم ظلّ مفتوناً بالخطأ.
* شاعر عراقي
أنسي الحاج، محمد الماغوط، وقصيدة النثر: البرهة السيابية
صبحي حديدي
سبق لي أن ساجلت بأنّ شعر بدر شاكر السياب لعب دوراً ملموساً في تشجيع وتحصين الولادات المبكّرة والنماذج الأولى من قصيدة النثر في أواخر الخمسينيات ومطالع الستينيات(1)، وذلك على الرغم من حقائق ثلاث:
ـ أوّلاً، أن السياب لم يجرّب قصيدة النثر، واقتصرت تجربته الشعرية على العمود الخليلي ثم التفعيلة أو الشعر الحرّ حسب المصطلح الذي كان شائعاً آنذاك. ليس هذا فقط، بل يجب القول إن خياراته في التنويع التفعيلي تقوم على هندسة إيقاعية عالية وصلدة ومحْكَمة بما يكفي لدفع أي لبس حول موقفه من تجارب الإبدال الوزني لبحور محددة مثل المديد والمتدارك، هذه التجارب التي حاولت إشاعة مناخ من الارتباك الوزني، وخلخلة التربية الإيقاعية السائدة، فشكّلت بهذا القدر أو ذاك عتبة على طريق الولادة غير العسيرة لقصيدة النثر.
ـ ثانياً، أنّ موقف السياب من قصيدة النثر لم يكن غامضاً، وكان مناوئاً لها صراحة أو مواربة، كما نستدلّ من رسائله. ولدينا نصّ حلي واحد على الأقلّ، جاء ضمن رسالة إلى أدونيس نشرتها مجلة ‘شعر’، يعلّق فيها السياب على قصيدة أدونيس ‘مرثية القرن الأول’، ويقول:
‘أمس كنت عند جبرا. حدّثني عنكم كثيراً، وكانت شاعريتك الضخمة الحية وقصيدتك الأخيرة مدار الكثير من الحديث. كانت قصيدتك رائعة بما احتوته من صور، لا أكثر. ولكن هل غاية الشاعر أن يُري قرّاءه أنه قادر على الإتيان بمئات الصور؟ أين هذه القصيدة من ‘البعث والرماد’ تلك القصيدة العظيمة التي ترى فيها الفكرة وهي تنمو وتتطور، والتي لا تستطيع أن تحذف منها مقطعاً دون أن تفقد القصيدة معناها. أما قصيدتك الأخيرة، فلو لم تُبقِ منها سوى مقطع واحد، لما أحسستَ بنقص فيها. ليس هناك من نموّ للمعنى وتطوّر له. مازلت، أيها الصديق، متأثراً بالشعر الفرنسي الحديث أكثر من تأثرك بالشعر الإنكليزي الحديث، هذا الشعر العظيم، شعر إليوت وستويل ودلن توماس وأودن وسواهم’.(2)
ـ ثالثاً، أن محاولة استكشاف دور النصّ السيابي في الولادات الأولى لقصيدة النثر لا تنطوي على حكم قيمة حول هذا الخيار في الكتابة الشعرية، مثلما لا تشكّل أي مسعى لشَرعنة ذلك الخيار ومنحه ‘شهادة منشأ’ جديدة، تأتي هذه المرّة من شاعر معلّم وعبقرية فذّة صنعت القَسَمات الأبرز للحداثة الشعرية العربية. لقد حسمت الحياة هذه الحكاية في المدى الراهن على الأقل، وينبغي ألا يدور أي نقاش جدّي حول شرعية أو لا شرعية النثر كوسيط في التعبير الشعري، بل حول شعرياته كما هي على الأرض، في النصوص وفي وضح النهار، غثّة كانت أم سمينة.
وفي ضوء العوامل السوسيو ـ أدبية، التي تكتنف أية ثورة أدبية أو أية ولادات أسلوبية وتعبيرية كبرى، يكون السيّاب أحد الآباء الكبار الذين مهّدوا الأرض الوعرة لحركة تجديد معمّقة وراديكالية في السائد الشعري، وشقّوا الطريق العام الأصعب الذي ستتفرع عنه مسالك فرعية عديدة. وفي طليعة هذه العوامل تأتي مسألة الانعطاف الكبير الذي طرأ على مضامين وموضوعات نصوص روّاد الشعر الحرّ، بسبب من هذه الانعطافة السياسية ـ الاجتماعية أو تلك، أوالخيارات الجمالية ـ الفكرية النابعة من هذا الموقف الفلسفي الحداثي أو ذاك. وتكفي الإشارة إلى أن تعاقب الاستقلالات، ونكبة 1948، وإعلان قيام إسرائيل، وتأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي، وصعود البرامج السياسية للبرجوازية الصغيرة… كانت كفيلة بإحداث ارتجاج عميق في الوجدان العربي، وجَبّت الكثير الذي كان قبلئذ راسخاً وعريقاً. روّاد قصيدة النثر لم يكونوا خارج هذا المخاض، ولم يكن في وسعهم أن يكونوا خارجه حتى حين مالوا إلى التعبير عنه على طريقتهم. لنقرأ ما يقوله أنسي الحاج في مقدّمته لمجموعة ‘لن’:
‘بين القارىء الرجعي والشاعر الرجعي حلف مصيري. هناك إنسان عربي غالب يرفض النهضة والتحرّر النفسي والفكري من الاهتراء والعفن، وإنسان عربي أقليّة يرفض الرجعية والخمول والتعصب الديني والعنصري، ويجد نفسه بين محيطيه غريباً، مقاتلاً، ضحيّة الإرهاب وسيطرة الجهل وغوغائية النخبة والرعاع على السواء. لدى هذا التشبث بالتراث الرسمي ووسط نار الرجعة المندلعة، الصارخة، الضاربة في البلاد العربية والمدارس العربية والكتّاب العرب، أمام أمواج السمّ التي تغرق كل محاولة خروج، وتكسر كل محاولة لكسر هذه الأطواق العريقة الجذور في السخف، وأمام بعث روح التعصّب والانغلاق بعثاً منظّماً شاملاً، هل يمكن لمحاولة أدبية طريّة أن تتنفس؟ إنني أجيب: كلاّ. إن أمام هذه المحاولة إمكانين، فإما الاختناق وإما الجنون’.(2)
وباستثناء النبرة الرسولية المشبوبة في لغة أنسي، بمقدورنا العثور على مثل هذا التشخيص الاحتجاجي لدى عشرات الأدباء العرب، والشعراء بصفة خاصة، في الفترة الزمنية إياها. وكان السياب، في بيروت تحديداً وخلال إحدى ندوات ‘خميس مجلة شعر’، قد وصف علاقة الشعر بمتغيّرات الشارع العربي على النحو التالي:
‘لو أردتُ أن أتمثل الشاعر الحديث، لما وجدت أقرب إلى صورته من الصورة التي انطبعت في ذهني للقديس يوحنا، وقد افترست عينيه رؤياه، وهو يبصر الخطايا السبع تطبق على العالم كأنها أخطبوط هائل (…) وقد حاول الشاعر، مرّة تلو المرّة، أن يتملّص من الواجب الضخم الملقى على كتفيه: تفسير العالم وتغييره. ولكنها محاولات لم يُكتب لها ولن يُكتب لها أن تنجح وأن تستمر، فتهاوت مدارس وحركات شعرية بأكملها، غير مخلّفة سوى شاعر هنا وشاعر هناك، لعلّ لهما من القيمة التاريخية أكثر مما لهما من القيمة الفنية (…) إننا نعيش في عالم قاتم كأنه الكابوس المرعب. وإذا كان الشعر انعكاساً من الحياة، فلا بدّ من أن يكون قاتماً مرعباً، لأنه يكشف للروح أذرع الأخطبوط الهائل من الخطايا السبع، الذي يطبق عليها ويوشك أن يخنقها. ولكن ما دامت الحياة مستمرة، فإن الأمل في الخلاص باق مع الحياة. انه الأمل في أن تستيقظ الروح. وهذا ما يحاوله الشعر الحديث’.(3)
تلك كانت حقبة الهزّات الكبرى والتجديدات الأكثر عمقاً، حين ‘يتطلّب العصر صورته’ كما عبّر إزرا باوند، وحين يقع على عاتق الشعر جَسْر الهوّة بين اللغة اليومية وشعرياتها، وبين الشعر وانقلابات النفس… الإنسانية حتى ‘المأساة المنثورة’ بالمعنى الهيغلي. لقد توجّب على القديس يوحنّا أن يبصر الخطايا السبع في اللغة الطبيعية لعالم الكابوس وأفراد ومفردات عالم الكابوس، كانت هذه مختلفة تماماً عن أية ‘لغة طبيعية’ في أية بلاغة غير طبيعية. وتلك كانت أخطر عتبات ما يمكن اعتباره ‘تسوية تاريخية’ بين الوزن والنثر في أنساق التعبير الشعري: تسوية بمعنى التفاعل التبادلي بين الوسيطين، وتاريخية بمعنى وجودها في سياق ثورة شعرية جذرية يشهدها مجتمع (وذائقة جمالية) في حال عالية من الترقّب والتعطّش للجديد.
في هذه الفترة كتب السياب رائعته ‘مدينة بلا مطر’، التي يتخيّل في مقطعها ما قبل الأخير نشيد أطفال بابل وهم يحملون القرابين إلى عشتار:
قبورُ إخوتِنا تنادينا
وتبحثُ عنكِ أيدينا
لأن الخوفَ ملءُ قلوبنا، ورياحَ آذار
تهزّ مهودَنا فنخافُ. والأصواتُ تدعونا.
جياعٌ نحنُ مرتجفونَ في الظُلْمْة
ونبحثُ عن يدٍ في الليل تطعمُنا، تغطّينا،
تشدّ عيونَنا المتلفتاتِ بزندها العاري.
ونبحث عنكِ في الظلماءِ، عن ثديَين، عن حَلْمَهْ
فيامن صدرُها الأفْقُ الكبيرُ وثديُها الغيمه
سمعتِ نشيجَنا ورأيت كيف نموتُ..فاسقينا!
نموتُ، وأنتِ ـ واأسفاهُ ـ قاسيةٌ بلا رحمهْ.
وفي الفترة ذاتها كتب أنسي الحاج قصيدته ‘فَصْل في الجِلد’، التي يقول في مطلعها:
فليذهبْ ملكوتُ القشعريرة. أبا الهول! أبا الهول! خذ صمتيَ ، امنحني. يسوع
ديكك لا يصيح
ديكك لا يصيح
يسوع!
ديكك لا يصيح.
ريّش بسحرك تنديمه، أعتق لسانه، نجّه
يسوع أنقذْ نفسك إنّي
أرضع
ريق التماسيح.
كما كتب محمد الماغوط قصيدته المعروفة ‘أغنية لباب توما’، التي يقول فيها:
ليتني حصاة ملوّنة على الرصيف
أو أغنية طويلة في الزقاق
هناك في تجويف من الوحل الأملس (…)
ليتني وردة جورية في حديقة ما
يقطفني شاعر كئيب في أواخر النهار
أو حانة من الخشب الأحمر
يرتادها المطر والغرباء (…)
أشتهي أن أقبّل طفلاً صغيراً في باب توما
ومن شفتيه الورديتين،
تنبعث رائحة الثدي الذي أرضعه،
فأنا ما زلت وحيداً وقاسياً
أنا غريب يا أمّي.
والحال أنّ مضامين هذه القصائد تخرج من مشكاة واحدة، وجودية واغترابية، أو تموزية بمصطلحات تلك الأحقاب؛ ولكنها تتباين في:
1ـ الوسيط (وهو هنا التفعيلة أو النثر)، إذْ في حين يعتمد السيّاب على جوازات بحر الوافر (مفاعيلن) وهندسة عدد التفعيلات وفق الشحنة الإنشادية في السطر الشعري؛ فإن الحاج يعتمد على التكرار الإيقاعي لعبارة ‘ديكك لا يصيح’، وتنويع الخطاب التكراري بين ‘أبا الهول! أبا الهول!/يسوع! يسوع!’، فضلاً عن التحريك المقصود لأواخر الكلمات في السطر الأول (الطويل على غير عادة نصوص الحاج غير المكتوبة بطريقة التدوير)؛ أما الماغوط فيلجأ إلى التنغيم بين الحدّة والثقل (العلاقة النغمية بين الحروف الأخيرة في نهايات السطور والحروف الأولى في بداياتها) وبين نَفَس التموّج الذي يصنع الصوت وحال التمّوج الذي يقيم اتصال الأجزاء، لكي نقتبس مصطلحات الشيخ الرئيس ابن سينا.
2 ـ طرائق التوجّه إلى العنصر الخارجي، ففي حين يذهب بها السيّاب إلى التضرّع والتعبّد والإنشاد الغنائي الرفيع الذي ينهض على ضمير الجماعة ويكاد يطمس ملامح الأنا لصالح الأنا الجَمْعي؛ يعتمد الحاج على المزج بين التهكّم الخفي، أو المعلن بحيادية إبهامية مقصودة، والتوسّل بالسخرية السوداء؛ والماغوط يتضرّع بدوره، لكنه يسبغ على حال التوجّه الخارجي سياقا داخلياً ذاتياً من التوجّع الرومانتيكي والشكوى.
3 ـ طبيعة العنصر الخارجي كموضوع نداء، فهو عند السيّاب عشتار الكونية، الإلهة ـ الأمّ الرامزة إلى الخصب والنماء، والملجأ الجسدي والروحي، ومكمن الأمل واليأس، الرأفة والقسوة؛ وهو عند الحاج المسيح/أبو الهول (اسم العلم واسم الدلالة في آن معاً)، واهب النجاة والمحتاج إليها، الصامت الحاجب للفجر، المهدد بالكائن المتحرر من القشعريرة؛ وهو عند الماغوط الأمّ الطبيعية، المرضعة، والثدي، والاستعارة الممتدة من باب توما إلى الطفل، مروراً بقسوة الوحدة والغربة. والرضاعة هنا قاسم مشترك في التجسيد الفيزيائي لموضوع التوجّه: من الثدي والحلمة عند السيّاب والماغوط، ومن ريق التماسيح عند الحاج.
4 ـ التنويع في أصوات التوجّه وإنشاء ضمير السرد في النص، بين المخاطب المفرد/المتكلم بالجمع عند السيّاب، والمخاطب/المتكلم بالمفرد عند الحاج والماغوط. وهذا التنويع ينطوي على مغزى فلسفي وسياسي خاص، حين نسترجع سجالات الخمسينيات حول الوجودية والالتزام والذات.
وإذْ يضع المؤرخ الأدبي في الحسبان مقادير الاختلاف في قوّة علاقة هذه النصوص بالذائقة الأدبية السائدة آنذاك، إذ من الواضح أن نص السّياب وفق هذا المعيار تحديداً كان يتفوّق على نصّيْ الحاج والماغوط، فإنه لا يستطيع إلاّ ملاحظة النقاط التالية:
1ـ أنّ هذه النصوص تمثّل قطعاً جذرياً صريحاً مع لغة وتقنيات ومضامين النماذج الكلاسيكية والرومانتيكية والخطابية.
2ـ أنها تحقّق، بطرق مختلفة، درجة متقدّمة من الخطاب الأسطوري والتأمّلي والوجودي المختلف تماماً عن السائد التقليدي والقومي والطبقي.
3 ـ أن نصّ السياب يضفي حصانة فنيّة وفكرية منطقية على نصّيْ الحاج والماغوط، لأنه يتعايش معهما في الزمان وفي المضمون والهمّ والموقف الوجودي، ويؤمّن لنفسه ولهما هذا القدر أو ذاك من التغطية؛ الأمر الذي لا ينفي التوتّر المباشر وغير المباشر بين الوسيطيَن المستخدمين، ولا يبلغ بهما حدّ إعلان الإلغاء والإلغاء المضاد.
وإذا كانت هذه العوامل غير كفيلة بشقّ الطريق أمام قصيدة النثر، فإن من الصعب أن نتخيّل نصوص رامبو وبودلير ومالارميه وسان جون بيرس وهي تقوم وحدها بذلك الاستقلاب السحري وتلك الولادة العجيبة خارج الرحم، أي رحم. ومن العبث الحديث عن ثورة شعرية في الشكل والمحتوى استناداً إلى حفنة بيانات شعرية وتنظيرية اختزلت أو أساءت قراءة كتاب واحد وحيد (عمل سوزان برنار)، هو في الأصل اختزال لظاهرة بالغة التعقيد شملت قامات شعرية فذة من أمثال بودلير ورامبو. وهكذا أجدني أستنتج أنّ علاقة التأثر بين ‘الشعر الحرّ’ كما كتبه السيّاب و’قصيدة النثر’ كما كتبها الحاج والماغوط، كانت في الآن ذاته بمثابة ‘تسوية تاريخية’ بين التفعيلة والنثر في الكتابة الشعرية، الأمر الذي يبرهن على مآل ائتلاف داخل نسقَيْ الاختلاف.
‘ ناقد سوري يقيم في باريس
إشارات:
(1) ضمن دراسة مطوّلة، بعنوان ‘حداثات الشعر العربي المعاصر: أنساق اختلاف أم مآلات ائتلاف؟’.
(2) ‘شعر’، العدد 15، 1960، ص.146.
(3) أنسي الحاج، ‘لن’، دار الجديد، بيروت 1994، (الطبعة الثالثة).
(4) مجلة ‘شعر’، العدد 3،1957. ص.ص. 111-112.
وداعاً أيها المبدع الكبير
عبدالعزيز المقالح
بغياب أنسي الحاج عن دنيا الشعر تفقد قارة الشعر الأجد واحداً من أهم مؤسسيها وحراسها المتسمين بالإخلاص والتواضع.
شكلت أعماله الأولى وهي: ‘لن’ و’الرأس المقطوعة’ و’الرسولة’ زلزالاً في عالم الشعر وشدت إليها عشرات المبدعين الشبان من جميع الاقطار العربية.
كان صوتاً مميزاً في عالم الكتابة الشعرية المناوئة للتقليدية القديمة والحديثة، بجرأة ومعرفة عميقة لما ينبغي أن يكون عليه شعر القرن العشرين. لم يشغل نفسه بالدفاع عن تجربته الشعرية وتركها تنمو وتدافع عن نفسها، كما لم يكن مفتوناً بمدارس الأحدث في الشعر العالمي.
اكتفى بأن يكتب نصه بوحي من ثقافته وإحساسه تجاه هذا الفن الذي يكره التقليد والتكرار معاً ويحلم بالتجاوز.
لم ألتقِ به، لكن صلة مودة خالصة جمعت بيننا على بعد، كان يتذكرني ويشير اليّ في بعض كتاباته، وكنت دائم التذكر له، ودائم المتابعة لما يكتبه، ومن ذلك تلك الكتابات التي وجد لها في الأخير منبرا أسبوعياً في جريدة ‘الاخبار’ البيروتية.
ومنذ أسابيع افتقدته، وكنت أظن أنه في إجازة قصيرة من الكتابة، وسيعود إليها بشغف يعكس شغف قرائه وإعجابهم، ولم أكن أدري أنه كان يستعد للرحيل بعد أن أنجز مهمته الإبداعية والفكرية. وكان واضحا من كتاباته التي ظهرت في العامين الأخيرين أنه يعاني من حزن شديد تجاه ما يجري لوطنه الصغير لبنان، ولوطنه العربي الكبير. لم يكن يتوقع أن يصل المشهد الدامي إلى ما وصل اليه، وأن يتجرع العرب بأرادتهم المنحرفة عن مسارها الصحيح وبردود أفعالهم هذا القدر من الذلة والهوان.
شاعر يمني
أنسي الذي لا يرحل
شوقي بغدادي
احمد فؤاد نجم هو امتداد لبيرم التونسي ولفؤاد حداد ولصلاح جاهين، لكن في منحى اكثر شعبية ولذلك شكل مع الشيخ إمام في الستينات ظاهرة ثنائية نادرة في اختيار الكلمات الشعرية المناسبة للوضع السياسي مع الحان شعبية يسهل حفظها وهذا ما جعل منزل الشيخ إمام في تلك الفترة محجا لكل المثقفين والفنانين العرب الذي كانوا في ضيق من الانظمة السائدة في تلك الفترة.
لذلك يذكرني موت أحمد فؤاد نجم بواجبات كل فنان ومثقف ان لا يبتعد عن شعبه وعن نبض الشارع الحي في بلده تحت اي ذريعة كانت سواء باسم الحداثة او باسم الجمال الفني، لذلك انا حزين على نجم ،لانه برحيل هذا الشاعر ستنتهي ظاهرة تكاد تكون بلا امتداد حتى الآن، الا اذا فاجأنا الشعب المصري بشعراء وملحنين وأصوات جميلة قادرة على الاحتفاظ بالظاهرة الفنية الشعبية التي تزعمها بشكل عفوي الشيخ امام كمغن وملحن، واحمد فؤاد نجم كمبدع كلمات اصبحت سارية على الألسن اكثر من أي شعر آخر… هكذا يموت الشعراء.. يتركون وراءهم كلماتهم التي لا تموت.
وكل شاعر يحلم بالخلود يجب ان يفكر جيدا بهذه الظاهرة المصرية التي جسدها أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام اروع وأجمل تجسيد جعلتنا نحن السوريين في الستينات نحيي اجمل اجتماعاتنا في البيوت والمقاهي ونحن نجلس ونستمع ونصغي بخشوع ومتعة الى الشيخ إمام يغني كلمات أحمد فؤاد نجم… اما الآن ونحن نعيش في ظروف اصعب من ظروف مصر فنكاد لا نجد نموذجا لأحمد فؤاد نجم معنا ولا الشيخ إمام.. لا يوجد الآن في سوريا المنكوبة من يقوم بهذا الدور العظيم الذي قام به الراحل فؤاد نجم.
‘ شاعر سوري
ماذا صنعت بي يا أنسي…
منذر المصري
هل هناك داعٍ لبقية الاسم!؟
(ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة): دار النهار للنشر، 1970، /144/ صفحة، 8.ل.ل أو ما يعادلها: كتاب أنسي الرابع، ذو المقاس 17-21.5سم، أي أقرب ما يكون للمربع المتطاول، والغلاف الفيروزي، الذي لم يرسم عليه حفاظاً على صفائه، سوى العنوان، بخط فارسي أبيض، على سطرين.
أحضرته لي من بيروت، أستطيع أن أكشف الآن، الفتاة، التي سكنت مع أبيها وأختها الصغيرة، القبو المجاور لقبو صديقي الراحل محمد سيدة، فتوله بها، كما كان محتماً، وكتب عنها، أروع وأشد قصائده قسوة وألماً ويأساً. كانت أمها لبنانية وأبوها عاملاً سورياً في لبنان، أحبتني على نحو ما! وعندما طلبت مني أن أوصيها على شيءٍ من بيروت، طلبت منها، شرط أن أدفع ثمنه: (ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة). فأحضرته وقدمته لي دون أن ترضى بأي شيء بالمقابل، رغم حاجتها، كان ذلك في عام 1972. وكان أول نسخة من المجموعة تدخل اللاذقية، وربما سوريا، حسب معرفتي، التي كان بها أنسي الحاج، مع بقية جماعة شعر، ما عدا أدونيس طبعاً، أشبه بمجهول.
هناك أشياء كثيرة تقال عن: (لن) و(الرأس المقطوع) و(ماضي الأيام الآتية)، ولكن بالنسبة لي لا شيء يقارن بـ: (ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة). ولا حتى ما تلاه مباشرة، مطولة (الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع)، التي صبَّ بها أنسي خلاصة كلَّ تجربته، حتى وكأنه يريد بعدها أن يكفَّ عن الشِّعر، ثم بعد انقطاع (الوليمة)، التي كانت أقرب لبقايا من وليمته الأصلية.
علمّني (ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة) تقريباً كلّ شيء، وفي كلّ ما كتبت كنت أودُّ أن أكتب شيئاً خاصاً بي جميلاً ومؤثراً مثله، وحين يقول البعض بأن الشعر الحديث لا يحفظ، أجدني أقرأ لهم عن ظهر القلب، وها أنذا أفعل الآن:
1- فرِحَ على الأرض
(بدون العودة للكتاب)
بحثَ عنها كثيراً ولَمّا وجدها
احتار ماذا يفعل بها
فتركها تذهب
ثم عاد وبحث عنها كثيراً
ولَمّا وجدها
قال: يا إلهي
اجعلْ نظري كبيراً فيحويها
وحجري ماءً فيسقيها
طوِّقها بي كسجن
وطوِّقها بي كشكران
أو اكسرني يا إلهي عليها
كالصاعقة
في البحر.
/
كان ضائعاً فلَمّا وجدها
فرحَ على الأرض قليلاً
ثمَّ طار إلى السماء.
2- فردة حذائها
كي أرتمي فيها كعملاق يرتمي في كأسه، كي
أقبل عليها كغرباءٍ إذا استوطنوا يأكلون الوطن وفاءً.
كي أَنهار فيها مثل رجفان الجبال.
الغائبة القلب في اليدين، الغائبة اليدين في صدأ
العادة الجمري.
/
التي تفقد فردة حذائها من أجل أن يهتدي الأمير
إلى مصيره.
3- أنتَ
(بدون العودة للكتاب)
**
إذهبْ إلى الطبيعةِ، ثلاثةً
أنتَ، هوَ، هيَ
يتحابان
وأنتَ وحدَك
تتحاب
وتعشقك الطبيعة.
4- عندما يفتحونه عندما يغلقونه
سأطبع كتاباً
لتعرفي أنَّكِ
سأطبع كتاباً
ليقولوا عندما يفتحونه:
‘ كنّا نحسبه شخصاً آخر’
سأطبع كتاباً
ليقولوا عندما يغلقونه:
‘ لم نكن نعرف أنَّهُ
كنّا نظنُّ أنَّهُ’
سأطبع كتاباً
لأن عينيكِ لأن يديكِ
سأطبع كتاباً
لأنّي لا أصدق
لأنّي لا أصدق
لأنّي لا أصدق.
5- أوراق الخريف مريمُ العذراء
الكآبة التي كانت تسكنني ماتت
حلَّ محلَّها، برياحه وأمطاره،
السيد الوقت.
صرتُ أستغرب الشِّعر
أقول عن الأطفال أطفال
عن ركبة امرأة ركبة امرأة
وعن غصن حورة مقطوع غصن حورة مقطوع.
ولم أكن، عهد الكآبة
أتداول أسماء المسميات المتداولة
لا تكبُّراً وحدَه
بل لأنني كنت شاعراً
فكنت أُسمِّي مثلاً
أوراق الخريف مريمَ العذراء.
وآه كم كنتُ غنيّاً
كلُّ ما يلمسني يسحرني
كلُّ ما ألمس أسحر
ولم أكن أجهل
لكن لم أكن أعرف
وظننت صبحَ يومٍ من الأيام
أنني خالد حتى فاحت الكآبة التي كانت
والتي لم أعرف كيف
ماتت كالمسك.
سئلتُ كثيراً، وأقسم إني سئلت البارحة: ‘أيّ كتابٍ تحبّ ؟ سمِّي كتاباً واحداً لا غير.’ فلم أجد جواباً سوى: (ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة)، إنه كتاب، قلت، تقريباً، علمني كلَّ شيء، ولكن ما لم أقله هو أنه .. علمني الحب. فهل، ولو أنّي، لأي سببٍ في العالم، رغبت أن أسمّي كتاباً آخر، أستطيع أن أُسمّي… سواه .
‘ شاعر سوري
أنسي وحيدا
فاروق يوسف
كلما كتبت عنه أخشى أن أخونه، أن أربك وصيته، أن انحرف بصورته. أنسي الحاج ومنذ القصيدة الأولى التي قرأتها لم يكن شاعرا، ولم يكن ما يكتبه شعرا.
كان هو الآخر، المختلف، وحدته عدوى وشراسته حنين إلى إنسانية، كانت نضارتها درسا في تأليف الفصول. شعره (إن جاز القول) يعلم أشياء كثيرة تقع خارج المعاني.
لنقل إنه يرتاب بالموسيقى ليذهب إلى ما ورائها، يفتش في جذورها عن لمعة لم تغسل بمياهها هدب امرأة من قبل.
كانن الحب بالنسبة له رسالة، نبوة الكائن الذي لا يزال قادرا على محو أخطائه، لا بدمه ولا بدموعه بل بأثر من روحه لا يزال نقيا. ‘إنه الانقى من بيننا’ كان يوسف الخال يقول، منذ ضربة الحاج الأولى على باب مجلة (شعر).
لقد كتب أنسي ما لا يكتب ولن يكتب إلا من خلاله، ليبشر به مرة أخرى. جملته تسري مثل الهواء بين الكلمات ولا تقودها مثل الأغنام. لم يكن راعي الكلمات بل لصها. كان مفجر صخور من أجل زهرة رآها في حلمه.
أناقته الشعرية لم تكن غنجا ولا صبابة ولا رقة، بل هي الأثر الذي يتركه السهم الذاهب إلى الغيوم ليمزجها، وليستخرج منها تضاريس مرآته الشخصية.
مرآة الشاعر الذي وقف وحيدا، من غير أن تشكل وحدته عبئا على الآخرين ولا على الشعر. بغياب أنسي تكون اللغة، أية لغة قد فقدت مزاج عصفورها الذي ينظف بمنقاره رئتيها.
‘شاعر وناقد من العراق
أنسي الحاج: إرث النقاء الصعب
حسن داوود
لا أعلم إلى أيّ حدّ احتاج من يظنّون معرفة بأنسي الحاج إلى أن يقرأوا شعره. ذاك أن الرجل، من دون شعراء جيله، جمع في صورته الشخصيّة المتخيّلة كلّ ما كان كتبه. كما لا أعلم مَن من الذين عاصروا شعره، إبتداء من 1960 سنة صدور كتابه الأول “لن”، عرفوه عبر قراءته. كان يكفيهم مثلا تجلّي تلك الصورة التي، حقبة بعد حقبة، وكتابا بعد كتاب، ظلّت مبرّأة من كلّ ما كان يلحق بالشعر والشعراء من انتقاد، سواء ما يتصل بشعرهم أم بشخصهم. منذ كتبه الأولى، “ألرأس المقطوع” و”ماضي الأيام الآتية”، إضافة إلى “لن” كتابه الأكثر تأثيرا وبقاء، لم تتغيّر الصورة التي تشكّلت له، ونحن هنا إزاء زمن يكاد يكمل نصف القرن.
ربما كان ذلك عائدا إلى تواريه، وحصر حياته الشخصية والأدبية بين قليلين من معارفه. في أحيان أفكّر أن الديناميكية، في ما خصّ حضوره ككاتب ومثقّف في الحياة العامة، توفّرت له في سنوات الستينات والسبعينات، أيّام كان يؤسّس مع أدونيس ويوسف الخال “مجلّة شعر”، كما حين كان يصنع تياره الشعريّ الخاص من ضمن دعوة التغيير الكاسحة التي قامت المجلّة للدعوة لها. أما جيل الشعراء والأدباء الذي تلى جيله، فيذكر حضوره الطاغي في أفق بيروت الثقافي آنذاك حيث كانت مقالاته في ملحق النهار (بدءاً من 1964) تؤدّي دور المحرّض، وليس المثقّف فقط، على الإنتقال من ثقافة عربية تعاني ركوداً مزمناً، إلى ثقافة جدية وحيّة وطالعة من نبض الراهن وعمقه.
في “كلمات.. كلمات.. كلمات” لم نكن إزاء الدعوة إلى تصحيح الشعر وحده بل إلى تصحيح العالم. أذكر بأيّ حماسة كنا ننتظر ذلك البيان الأسبوعي لنتداوله بعد ذلك، متناقشين حوله وربما داعين إلى شيوعه. وكنا، إلى ذلك، مكتفين من شعر أنسي بما سبق أن قرأناه حيث، مثلا، ظلّت دعوة كتاب “لن” كافية لما يقوله في الشعر. “لن”، ذلك العنوان الأكثر إيجازاً بين كتب الشعر، والأكثر إعلاناً للرفض والتحريض على الرفض في الوقت ذاته. وكان هذا الكتاب، وكذلك كلّ من الكتب الأخرى التي أعقبته، تكفي مؤونة للسنوات الثلاث أو الخمس بينه وبين الكتاب الجديد، وهذه هي السنوات الفاصلة بين كتاب سبق وكتاب له جديد. كان أنسي الحاج مقّلاً، إذ إحتاج إلى سنوات من التأمّل والصمت حتى يظلّ الشعر صافياً لنفسه، طالعاً من حيث ينبغي أن يطلع الشعر وحده، نقيّاً لا يفيض نطقه عما ينبغي أن يكون أصله.
ذاك البحث عن النقاء الكامل، كثيراً ما كتب أنسي الحاج في وصفه. لم يكن ما كتبه في الشعر نقداً له، بل تعريفاً لقداسته. لطالما نسب الشعر إلى “ما فوق الواقعي”، كما إلى ما يتعدّى الحكمة الصادرة عن العقل. “أنا من الذين يعتقدون بالدخيلاء، واللاوعي، والمغناطيس، والعقل الباطن، والحلم، والخيال، والمدهش، والسحر، والهذيان، والصدفة…” كتب.
بين كتابه “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع”، الذي صدر في 1975، وكتاب “الوليمة” الذي تلاه، عشرون عاماً كان أنسي الحاج فيها متسائلاً عما يكتب. عشرون عاماً من دون كتابة إذ ماذا يمكن أن يضاف إلا ذلك القليل والشعر لا ينبغي أن يُدخل فيه ما ليس من طبيعته وصفائه. غير أنّه، في كتاباته التي لحقت مجموعاته، وقد نشرت تحت مسمّياتها الدورية: كلمات كلمات وخواتم، كان كأنّه يسعى إلى البقاء في تعاريفه الأولى، متكلّماً غالباً عن اللبّ. عن البذرة أو النواة فيما العالم يوسع الهوّة بين ما يجري فيه وما كان الشعر الأوّل يعد به. وهو، المنقطع المبتعد على الرغم من وجوده غالبا في خضمّ التحوّلات، بالنظر إلى عمله في الصحافة، كان عليه أن يخوض نضالاً متّصلاً لكي يظلّ على صورته، تلك التي شاءها له من قرأ شعره ومن لم يقرأه.
• رحل الشاعر والكاتب الكبير أنسي الحاج بعد صراع قاس مع المرض، عن عمر يناهز 77 عاماً.
كان أحد أبرز أعمدة جريدة “النهار” اللبنانية وصاحب مشروع في النهضة الشعرية والثقافية اللبنانية والعربية. ولد في 27 تموز/يوليو 1937. كان لا يزال على مقعد الدراسة، حين بدأ ينشر مقالات وأبحاثاً وقصصاً قصيرة في مختلف المجلاّت الأدبية، منتصف الخمسينات. اهتمّ بشكل خاص بالموسيقى الكلاسيكية. تزوج، العام 1957، من ليلى ضو، ورزق منها بطفلين: ندى ولويس. بداية عمله الصحافي كانت في جريدة “الحياة” العام 1956، ثم في جريدة “النهار” مسؤولاً عن القسم الثقافي. وتولى كذلك مسؤوليات تحريرية عديدة في “النهار” وأصبح رئيس تحريرها (1995 – 2003) ثم استقال منها، ورافق تجربة إعادة صدور جريدة “الأخبار” اللبنانية” العام 2006، وكان له فيها مقال أسبوعي كما كان مستشاراً لأسرة تحريرها.
في العام 1964 أصدر “الملحق” الأسبوعي لـ”النهار”، الذي ظل يصدر عشر سنوات، حاملاً مقاله الأسبوعي “كلمات كلمات كلمات”. أشرف على إصدار “النهار العربي والدولي” في بيروت. شارك في تأسيس مجلة “شعر” وفي إصدارها، وكان أحد أركانها منذ 1957 حتى توقفها في عهدها الأول، ثم في عهدها الثاني.
في 1960 ظهرت مجموعته الشعرية الأولى، “لن” عن دار “مجلة شعر”، مع مقدمة كتبها هو بنفسه في موضوع قصيدة النثر خاصة والشعر عامة. الحرب الأدبية التي أثارتها “لن”، اشترك فيها الشعراء والكتّاب من العالم العربي كله، وكانت حداً فاصلاً في تاريخ الشعر العربي المعاصر. في 1963 صدرت مجموعة “الرأس المقطوع” عن الدار ذاتها. في 1965 صدرت مجموعة “ماضي الأيام الآتية” عن “المكتبة العصرية”. وفي 1970 صدرت مجموعة “ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة” عن “دار النهار للنشر”. في العام 1975 صدرت مجموعته “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع” عن “دار النهار للنشر” وفي العام 1983 أعاد طبع كتابيه الأولين: “لن” و”الرأس المقطوع” عن “الدار الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع”. صدر له ديوان “الوليمة” لدى “دار رياض الريس” في العام 1994، وبالفرنسية في باريس لدى “دار أكت سود” العام 1997 أنطولوجيا “الأبد الطيار” التي أشرف عليها وقدّم لها عبد القادر الجنابي، وأنطولوجيا “الحبّ والذئب الحب وغيري” بالألمانية العام 1998، ترجمة خالد المعالي وهربرت بيكر.
صدرت له “خواتم 1″ في 1991، و”خواتم 2” في 1997 لدى “دار رياض الريس”. في نيسان 2007 صدرت أعماله الكاملة في مجلدات ثلاثة لدى “هيئة قصور الثقافة” في القاهرة.
ترجمت له قصائد عديدة الى الفرنسية والإنكليزية، واستوحى بعض المسرحيين من قصائد له فأخرجوها (منهم يعقوب الشدراوي وريمون جبارة)، كما استوحى بعض الموسيقيين قصائد له في أعمال موسيقية. وكثيرون من الرسامين اللبنانيين والعرب (بول غيراغوسيان، رفيق شرف، منير نجم، جان خليفة، وضاح فارس إلخ…) اقترنت رسوم لهم بقصائد له.
أنسي الحاج: هل أشاح وجهه عن قصد؟
ديمة الشكر
انطفأ كوكبٌ شعري برحيل أنسي الحاج، الذي كان شعره منبتّاً عن الشّعر العربي بصورته الكلاسيكية والحديثة ربما. أنسي الحاج ومعه بالطبع محمّد الماغوط، شكّلا حالةً متفرّدةً وقتها، وما زالت هالة تلك الحالة تضفي على قصائدهما نوعاً من التوّهج الأبدي. كان التفرّد في انحيازهما منذ البداية إلى كتابة الشّعر بالنثر، فالخيار- إن جازَ عدّه خياراً- لم يكن يتعلّق فقط بتلك القطيعة الباترة النهائية مع الوزن، بل يتعلّق أيضاً بالقطيعة مع اللغة السائِدة (الشعر الكلاسيكي) وتلك التي قيد التشكّل (تيار التفعيلة) وإن كانت تلك الأخيرة أكثر قدرةً على شرعنة خياراتها وتأصيلها، ويتعلّق كذلك بالقطيعة مع نظرة الشاعر إلى نفسه وإلى دوره في ذاك الزمان.
شيءٌ خاصّ جديدٌ، شرّع ريح التغّرب والتغريب والغرابة دفعةً واحدة أمام الشعر العربي الحديث، وأمدّه باقتراح مختلفٍ غير مسبوق. حيث إن تلك البدايات المفاجئة والمدويّة في خمسينيات القرن المنصرم، أثّرت بشكلٍ كبيرٍ في مسار الشعر العربي الحديث، وإن تفاوتت درجة التأثير ما بين الاتباع الأدنى للانسياق، والتقليد الفجّ، والنسج على منوال غدا متكرّراً. قليلٌ من الشعراء المتأثرين قصداً، أوالمعجبين، بأنسي الحاج أو محمّد الماغوط، يستطيعون النجاة عبر اقتراحات تضاهي شعرهما المتفرّد. هكذا كان رائدا قصيدة النثر العربية، رغم أن صنيع أحدهما يختلّف عن الآخر. فللماغوط بصمته الخاصّة القائمة على رفع الصوت المكسور والجريح العربي ضحية الأنظمة القمعية، وكانت صورة العربي وقتها، صورة المواطن الفقير المهمّش المقموع. كانت جمل الماغوط مترعةً بأدوات النداء، -وربما بشكلٍ زائدٍ-، يحفّ بها حزنٌ شفيفٌ، ورغبةٌ خفيّة بتحويل القصيدة و”الخطاب الثقافي” وراءها- إن جاز التعبير- إلى مانيفستو ومظاهرة، ولعلّ ذلك ما ظهر بصورة أوضح وأكثر جلاءً في مسرحياته الشهيرة.
أمّا أنسي الحاج، فبدت القصيدة عنده منذ البداية مكتملة الأركان، تقوم بالدرجة الأولى على استعمال تراكيب نحوية قادمة رأساً من ترجمات الكتاب المقدّس، إذ لطالما بدت لغته على الدوام إنجيلية الرجع وتوراتية الصدى، ولعلّ قصيدته “الرسولة بشعرها الطويل حتّى الينابيع” تمثّل شبه تناص، ولمحة استلهام لنشيد الأناشيد. وتقوم قصيدته أيضاً على تلك الصور الشعريّة المبتكرة التي لا تخطئها عين، الصور الطازجة، الأدنى إلى السريالية الشفيفة: “تجلسين على حافّة السرير، بالك في الريح وقدماك/ في العاصفة”، يربط فيما بينها سردٌ واهٍ، غير مرئي، خفيف، وتعلو القصيدة نبرة رسولية لرسولٍ زاهدٍ، يتصيّد الصور من الطبيعة والمرأة، ويغلّفهما بحكمةٍ لا تصدر إلا عن شاعرٍ حقيقي. والأهمّ أن كلّ هذا سمح لأنسي الحاج، أن يعطي تقنية الحذف وتقنية المحو، شرعيةً حقيقية، لتغدو واحدة من أهمّ الأدوات في القصيدة العربية الحديثة.
والآن يبدو الأمر غريباً، وقد انطفأ كوكبُ أنسي، فالناظر في مسيرته الثقافية والصحافيّة تحديداً لا يسعه أن يفسّر “انتقاله” من جريدة “النهار” إلى جريدة “الأخبار” من دون الكلام في السياسة. هكذا يجنح الكلام نحو “الالتزام” عند الكلام عن شاعرٍ كانَ على الدوام، على نقيضٍ صارخٍ مع تيار الالتزام وفقاً لصورته الشهيرة الصلدة، منحازاً بثباتٍ وتصميمٍ- كما هو معروف- إلى الحبّ وإلى الجمال ونقاوته في قصيدةٍ متفلّتةٍ عن قصد من “الواقعية” وشبهات “الالتزام”. لعلّها واحدة من أفدح المفارقات وأكثرها إثارةً للحزن في آن واحدٍ! وكيف لا؟ وقد بدا أنسي، وهو على وشك إقفال مسيرته الأدبية، منحازاً هكذا إلى تلك الممثلة التي ظنّت نفسها بطلةً وضحيّة في آن معاً، فكان أن حيّاها الشاعر، مشيحاً بوجهه عن آلاف آلاف آلاف الضحايا. هل أشاح وجهه عن قصد؟ أصحيحٌ أنه الرقيق الذي لا يقوى على رؤية قطرة دمّ واحدة، أغمض عينيه عن كلّ هذا القتل غير المسبوق؟ عن شعبٍ يُذبح بشتى الأسلحة؟ وعن براميل تهطل كزخّات مطرٍ معدني حاقدٍ على البشر والحجر؟ هل هذا هو “الالتزام”، وقد تخمّر عقوداً ليسفرَ عن هذه الصفعة المدويّة للضحايا؟ زعلنا منه على نحوٍ بدا زعلنا على رحيله – رغم كلّ زحمة الزعل السورية المستمرّة- مناسبةً أخرى لندرك كم خذلنا وجرحنا، وكم نحن “وحيدون وحيدون حتّى الثمالة”.
البطل السلبي بين الهالة والظلال
أنطوان أبو زيد *
لأكثر من أربعين عاماً خلت، وكنتُ بعدها في السابعة عشرة، أول سنة لي بعد خروجي من الدير، تلقيتُ أول هدية من فتاة صديقة بمناسبة إبلالي من المرض، كتاب شعر لمحمود درويش. ظللت أقرأ في الكتاب طيلة عام 1972 كأنه النيزك الذي سقط على أرض جرداء فنقبها وجعل عاليها واطيها، وأخرج الخصوبة الكامنة منها إلى الوجود. قلت هذا هو الشعر.
وبدأت أقرض الشعر على غراره. وحين تسنى لي أن أهبط إلى المدينة أواخر 1974، وقد صرتُ في كلية التربية، تسنى لي أن أقرأ عصام محفوظ، شعراً لا مسرحاً. ثمّ كرّت المعارف، فأمكنني، بفضل كتابات نقدية لي ألحّت عليّ بفعل دعاوى العدالة والتجديد ومعارضة الاستبداد اللاحق بزملاء قدامى، الكتابة في جريدة «النهار»، في بريد القراء، على ما أظنّ، وسمعتُ أنّ ثمة شعراء ولكني لم أجد الوقت ملائماً للدخول في علاقة. وبعد الحرب الأهلية وإصرار الشعر عليّ، على طريقة الشعراء الصوفيين أمثال سمير نصري، كتبتُ في جريدة «الأنوار»، وما لبثتُ أن غادرتُ هذا السبيل إلى كتابة الشعر المنفلت من الوزن متأثراً ببول شاوول، الذي كان له الفضل في تصحيح بعض القصائد التي كنت آتيه بها، وهو في «الهورس شو»، وأنا بين الجامعة وميدان الزراعة. أنسي الحاج صار لي، في ما بعد، من حيث شخصه المادي، إنساناً ذا اقتدار، وهذا ربما لم يشجعني على لقائه، فأنا ميال _عرفت نفسي متأخراً _ إلى المستضعفين. ومع ذلك، ظلّ نصّ أنسي الحاج الأصيل الأكبر بين نصوص قصيدة النثر. مكانته لا تكمن في أنه هزّ عرش الأوزان ولا أنه أبطل وحده الشعر الحرّ، إنما فضلُه، برأيي، في الصيغ والتراكيب العربية التي تلاعب فيها بالموروث وخربط الذائقة التقليدية، وبشحنات من المشاعر قوية موصولة تكاد تبدو لي مقطوعة عن أبعادها اللاهوتية. كانت شحنات شعر أنسي الحاج، لدى قراءتها، منتصف السبعينات تحدياً لنا، بل لي أنا الخارج من تراث الشعر الفلسطني العربي الصاخب ولكن على إيقاع، ولم أكن قد عرفت تراثاً شعرياً آخر كان يشق سبيله مع شعراء مثل عباس بيضون، ومن مناخ آخر ذاهب في اللغة الى محاكاة اليوميات، لكن بثقل فلسفي وتصاوير وتأثرات من السينما والمسرح والترجمة. أنسي ظلّ هنالك، أي أثره، في البدايات التي رسمت أعياد قصيدة النثر، مع فرسانها الأوائل، شوقي أبي شقرا الذي كان يكوكبنا، نحن الفقراء الشعراء حول كيسه وصفحته الثقافية، ويلقّمنا عن قرب. أما أنسي، فكان يلقّم عن بعد. وحتى لا يُفهم الأمر بحرفيته، كان أثر أنسي عليّ من بُعد، أثر اللوحة التكعيبية في من شاء الاستزادة من خطوطها والاستيحاء منها ومن غيرها، في آن واحد. ولربما ذلك الموقف البورجوازي، بل المتعالي، من العلاقات، الذي وقفه أنسي، أو هذا ما خيّل اليّ، كان بمثابة ردّ المعجب إلى النصوص؛ فكأني به يقول: «إذهبوا إلى نصوصي، ولاقوها، واحتفوا بها، أما أنا، فمحض ظلّ لها!» هناك تلقى «المرأة بشعرها الطويل حتى الينابيع»، وتلقى عواصف «لن» وبروق «الرأس المقطوع» حتى آخر المطاف. لم أكن تابعاً ولا جندياً تحت راية أحد من الشعراء الكبار مثل أنسي _حماني التعليم من هذا المجد_ وانما كنتُ معجباً بأنسي، وبشوقي وبول شاوول وفؤاد رفقة وسمير نصري وعباس بيضون، الذين احتفيت بهم في حياتهم، كاحتفائي بأدونيس أستاذي في كلية التربية، وخليل حاوي، ويوسف الخال، اللذين لم أعرفهما وعوّضت عن جهلي بهما بالإضاءة على أعمالهما. أما أنسي الحاج، فسوف يبقى موقعه، في قصيدة النثر، محفوظاً ومدروساً وموضع تقدير وتبيين تبياناً للأجيال الشعرية الجديدة التي غطّت الساحة وكادت أن تغطّي على الإنجازات في القصيدة (قصيدة النثر) الصائرة منارات يُستضاء بها، ولا يجوز التعتيم عليها، حرصاً على الشعر وذُراه، ومنها أنسي.
ما كان يُشاع عن أنسي أنه ذو نزعة الى التسيّد على الآخرين لم أكن لأسوّغه أو أدخل في تحليله، لأني لم أشأ مرة أن أكون في عهدة أحد الشعراء الكبار، أو تحت رعايته، لكن تلك الصورة، في شعر أنسي تكاد تكون نقيضاً من ذلك، أو ما استخلصته من شعره، منذ مجلة «شعر» وحتى آخر «خواتمه» المبتهلة في جريدة «الأخبار». إنها صورة البطل السلبي المضحّى به في سبيل الحبّ أو الصرخة أو الانتفاضة ضدّ التقليد والركون والبلادة وضدّ ضدِّ الحبّ. البطل السلبي هو إنسان العصر، المقيم في المدينة وليس قابلاً بشاعتها، والمنخرط في حراك الشعوب وهو الكائن الفرد فيها، والموافق على إيمانات الشعوب والكاره تعصّبها حتى حدود الكفر ولا كفر. هكذا كان أنسي الحاج، صانع أسطورته في شعره، ورافع نبرته حيال اللغة، مع حساب دقيق للجمالية في خط الرجعة. متمرّداً وصبياً حتى في شيخوخته، مع أناقة دهرية. هكذا كان أنسي الحاج.
* شاعر وناقد لبناني
استراح من شجَاره المدهش مع اللغة
حسين بن حمزة
حين كتب أنسي الحاج (1937 ـ 2014) باكورته «لَنْ» (1960)، كان الحرف الذي في العنوان يعني نوعاً من الامتناع أو الرغبة في التوقف عن الاستمرار في كتابة ما يُكتب. وكان في ذلك نوع من الازدراء للجملة العربية التقليدية. كان «لن» حرفاً واحداً ومتفرّداً وصادماً، وكان الحرف الواحد الوحيد المنقطع عما يليه تأويلاً للرفض ومديحاً له، تأويلاً للتلعثم والركاكة ومديحاً لهما أيضاً.
«إنني حقاً متلعثمٌ»، كتب الشاعر في ذلك الديوان الأول الذي سيصبح منذ إصداره بداية رسمية لقصيدة النثر العربية التي ستُكتب لاحقاً بطرق وأساليب وحساسيات مختلفة عما بشّر به أنسي الحاج، بل إن الشاعر الراحل محمد الماغوط كان قد سبقه بعام واحد إلى كتابة قصيدة نثر مختلفة في باكورته «حزن في ضوء القمر» (1959)، لكن ريادة قصيدة النثر التصقت بـ «لن»، ولعل المقدمة النقدية الشهيرة التي استُهلّ بها الديوان هي التي عززت هذا الانطباع عن ريادة أنسي وديوانه الأول. ما يهمنا في لحظة غيابه أن نسجّل أن الشعر الذي كتبه في «لن» لم يذهب بعيداً عن منبعه، وعن دفقته الأولى، وأن النبرة التي أراد بها تحطيم الجملة العربية الكاملة ظلت تتحرك في الموضع ذاته. في الموضع الذي أُريد للقصيدة أن تكون طفلة جميلة ومتلعثمة وشقية وغريبة عما حولها فيه.
لقد حفر أنسي الحاج في المكان الذي بدأ منه، وفي الجوار المحيط بهذا المكان. لم يذهب أبعد من ذلك في «الرأس المقطوع» (1963) الذي هو استمرار آخر لـ «لن» على أي حال، ولم يذهب أبعد حتى في دواوينه التالية، وكذلك في «خواتم» التي كتب آخر نصوصه تحت عنوانها. لقد ظلت تجربة أنسي محكومة بطفولة شعره، وصعقة ولادته الأولى. صحيحٌ أن جملته استراحت أحياناً من توترها وهجوميتها وجحيميتها، وتخففت أحياناً أخرى من شِجَارها المدهش مع اللغة ومع المخيلة، إلا أن ذلك لم يكن تصالحاً كاملاً ونهائياً بين الشاعر وجملته نفسها. لقد ظلت روحية «لن» حاضرة حتى في القصائد التي حظيت ببنية سويّة ومنسابة في دواوينه التالية. كان «لن» نبتاً شيطانياً، وكان مكتوباً لصاحبه أن يظل ممسوساً بتلك الروحية التي كُتبت ضدّ اللغة وضد البلاغة وضد الجماليات التقليدية. كان «لن» مجازفةً بمعاني الكلمات في القواميس، وتمريغاً لها في أرض وعرة. لعب أنسي الحاج بمصير الكلمات، وتعامل مع قصيدة النثر التي بشّر بها وكتبها كأنها مستشفى للأمراض والانحرافات. كان شيئاً مباغتاً ومُجفِّلاً أن نقرأ سطوراً مثل: «نُكحتُ من بؤبؤيّ وعلى الورقة كتبتُ بياضاً»، و«عوض أن تُقبل من أمكَ تزوّجها»، و«أُسرطنُ العافية»، ولكن ذلك كان يترافق مع صور أقل عصفاً وأكثر عذوبة مثل «لآكلكِ عشاقكِ أنضجوكِ»، و«غداً تقولون: أعماهُ شعرها الطويل»، و«أنا جائزةٌ باسمكِ».
خصوصية أنسي الحاج بدأت بالرغبة في كسر الفصاحة وإفساد الجملة واللعب بذائقة القارئ. صفاتٌ مثل هذه كانت تُفسد عليه هو أيضاً لذة إكمال الجملة وإشباع المعنى، وهو ما نجده في أغلب نصوص ديوانه الأول ومنها قصيدة «سِفر التكوين والهجر، حيث يبدأ السطر التالي قبل أن يكتمل السطر الذي قبله: «أراكِ وفمكِ الحرّ، بعيدة/ يمرّ دهرٌ عميقٌ ثم أرفع فمكِ/ وتمرّ هنيهةٌ/ مقيّدٌ في صرّة لا أزيح الباب عن قلبي/ شفتايَ شفة/ أيها الموطن الزّفر، إنك معها/ أمرّ قبل جرعها/ أتناول الحبر لأعميك/ مصطفى كي أسبح فيّ وحدي/ دهر أبوابك لدي/ يا رجلكِ ترتع في نظراتي النواحة، رجلك عند رجلي كاحتضان/ يا رأسكِ (متى؟) على رأسي/ يا هربي يُردُّ إليّ، ينام عليّ/ أرقبكِ، والضجرُ عارياً».
سيتوقف هذا القطع والاقتضاب والحذف والتلعثم في «ماضي الأيام الآتية» (1965) و«ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة» (1970)، ولكن المذاقات التي حملها «لن» ستظل تنبعث من جملته التي بات يُسمح لها بالاسترسال وإكمال المعنى، ولكن لا يُسمح لها بأن تنجو من حيرتها وترددها وعصبها الداخلي. هكذا، رحنا نقرأ صوراً مثل: «أنا شعوبٌ من العشاق»، و«جميلة كمعصية»، و«تجلسين على حافة السرير، بالكِ في الريح وقدماكِ في العاصفة»، و«كانت لي أيام ولم يكن لي عمر»، وهكذا، راح بعض الغناء والإنشاد الخفيف يظهر هنا وهناك، وراح الشاعر يدعونا إلى الباحة الخلفية للغته ومعجمه لكي يُرينا هشاشته ورقته ولطفه بعدما أوهمنا مروره العاصف بضراوته وجبروته وقوته، ولذلك كتب في «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع» (1975)«أنا هو الشيطان أقدّم نفسي/ غلبتني الرِّقة». نعم غلبت الرقة صاحب اللغة الشرسة والعارية من ماضيها، وراح في أواخر أيامه يمتدح تجارب إيقاعية وتفعيلية، ويستحسن ما فيها من شعر صافٍ وإن كان منجزاً بما ازدراه ورفضه طوال حياته. تصالح صاحب «الوليمة» مع الزمن ومع العمر ومع المرض، وكانت له إطلالات فلسفية على فكرة الموت، وتأملات آسية في فكرة الغياب. تأملات ظل يخلطها مع مقاطع شديدة النثرية ولكنها أشعر من الشعر. أنسي الحاج في النهاية كان لاعباً مدهشاً ومجرّباً كبيراً، وكانت قوة نصوصه متأتية من طزاجتها وتوهجها وقدرتها على نقل عدواها بطلاقة إلى القارئ، ولعل «خواتم» التي دأب على كتابتها كل سبت في «الأخبار» منذ صدورها، وقبل ذلك في مجلة «الناقد» كانت تأويلاتٍ واضحة وصافية لتلك الروح الصاخبة والفظّة التي بدأ بها، حيث كانت الكتابة، كما لدى مجايليه من الرواد الآخرين، محكومة بمهمات جليلة على جبهة التجريب والتجديد، وكان الصفاء الشعري مؤجلاً إلى المستقبل. في «خواتم»، فتح أنسي أرشيف خياله للقارئ، وكانت تأملاته وخلاصاته الشخصية أشبه بكنوز متواصلة يعثر عليها أثناء الكتابة ويُريها للآخرين في اللحظة ذاتها، والغريب والمدهش، أن تلك الكتابة المنتظمة أسبوعياً لم تصنع له قالباً مملاً أو تكراراً مضجراً، بل كان قادراً على تحويل أي فكرة صغيرة وعابرة إلى خلاصة ثاقبة ومبهرة. لم يكن اصطياد الشعر واستعاراته مقصوداً دوماً في «خواتم»، بل كانت فيها عصارة العيش والحب والشغف والقراءة والتنفس والتأمل وصداقة الكلمات. بعضنا كان ينتظر «خواتم» لتصنع نهاره ومزاجه، وبعضنا كان يقرأها ليظل على اتصال مع الكلمة الحية والحرة والنزقة والمتطيرة والفائرة.
كان أنسي الحاج يشبه لبنان، ويشبه صورة لبنان كجغرافيا للتجدد واللهو والخصوبة والأسطورة. نتكلم هنا عن معجم لبناني وحساسية لبنانية موجودة في الطبيعة والشعر والصحافة والغناء والمزاج. نتكلم عن مختبر الحداثة والتنوير والعصر الذهبي لبيروت. أنسي الحاج هو ابن تلك الصورة، وأحد صانعيها الكبار. وبرحيله اليوم، تخسر المدينة جزءاً من الاحتياطي الاستراتيجي للخيال والحداثة والتحرر.
أعدّ رحيله كأنه يشفق علينا
مهى زراقط
مساء الجمعة الفائت، كنت غارقة مع إميل منعم ويوسف عبدلكي بين صور أنسي الحاج، عندما انتفض إميل فجأة ونظر باتجاه باب المكتب، ليجد مروان طحطح واقفاً عنده. قال لي إميل: «نقّزني مروان… دعسة قدميه ذكّرتني بأنسي، اعتقدت أنه جاء».
كلّنا كان يحفظ دعسة قدمي أنسي، وكلّنا كان سـ«ينقز» لو أنه زار الجريدة مساء الجمعة. فقد كان الجميع ينتظر الخبر المؤسف بين لحظة وأخرى. لم يكن الأمر مفاجئاً، هو الذي حضّرنا لتلقيه منذ الوعكة الصحية الأولى التي ألمّت به قبل 7 أشهر. وها هو عبدلكي يبحث عن صور لأنسي ليعدّ غلافاً له، فيما أكّد لي إميل أنّ حالة صديقه الحميم تتدهور، وكانت راجانا حمية قد نقلت إلينا صباح ذلك اليوم إجابة ابنته ندى عن صحته «مش قادرة طمّنكم». العبارة نفسها كرّرتها أول من أمس، عندما جاءت إلى الجريدة. «ما في شي بطمّن، أنا معكم الآن، وخائفة أن أعود إلى البيت فلا أجده»، قالت.
لحقت بها، إلى مكتب والدها، الذي فتحته وراحت تجمع ما فيه من أغراض خاصة. سألتها: «ألن يتحسّن؟ أنا أجيب الجميع بالقول إنه سيفعل». هزّت رأسها مستسلمة. شرحت: «إنه سرطان… إنه الـ metastase».
كانت المرة الأولى، منذ دخل أنسي الحاج إلى المستشفى في آب (أغسطس) الفائت التي أعرف فيها أنه مصاب بالسرطان. لم يقل لي إن هذا مرضه، رغم أننا تحدّثنا كثيراً عن الأمر. كان يحكي بكلّ عفوية تفاصيل عن حياته مع المرض، لن يحبّ أن نذكرها هنا. يضحك وهو يذكر كم بات يخاف من ابنه لويس، الذي يدقّق في عدد حبات الأدوية «بطلت أعرف إذا أنا بيّو أو هو بيي». وما إن يرى رقم ندى على هاتفه، حتى يسارع إلى الردّ كي لا تقلق. يقول كلّ شيء، ولا يقول اسم المرض. ربما لم يكن يعرف، وربما لم يكن يرغب بأن يخيفنا، وهو يلاحظ أننا خائفون عليه فعلاً. مرة واحدة، مازح محمد نزّال، الذي طلب من رضوان مرتضى أن يلتقط له صورة معه، فقال له ضاحكاً: «بدّك تتصوّر معي؟ مفكّرني رح موت». ارتبك محمد، وقال له: «سلامة قلبك، انشالله أنا قبلك». ابتسم له قائلاً: «أنت طيّب يا محمّد»، ثم تأهّب لالتقاط الصورة.
بعد هذه الحادثة، كتب في نصّه «بلا منارة»، مقطعاً تحت عنوان «حزين»، جاء فيه: «بدل أن تدفع لي «الأخبار» راتباً، يجب أن أدفع لها». هذه العبارة كانت قد وردت في النصّ الجميل الذي كتبه إثر وفاة جوزف سماحة «موت كموتك قتل». خفت، دخلت إلى مكتبه مؤنّبة: «لا يحق لك أن تستسلم، وأنت الذي تحرّضنا على الحياة طيلة الوقت».
أرجع كرسيّه إلى الوراء، وقال: «انظري إليّ». كان قد كبر كثيراً خلال أسابيع، تغيّر لون وجهه، ونقص وزنه. قلت له: «سوف تتحسّن، أنا واثقة». منذ هذا اليوم، اتفقت مع محمد أن لا نتركه وحيداً، وخصوصاً بعدما غادر الجريدة عدد من الذين كان يحبّهم. إميل منعم، وزينب مرعي وشهيرة سلّوم. وقبلهم خالد صاغية، ثم ربى أبو عمو، ورشا أبو زكي. صرنا نحرص على أن لا يبقى وحيداً. إذا خرجت باكراً، أوصي محمد بأن لا يغادر قبل أن يجالسه. ولا ننسحب إلا إذا أعطانا إشارة إلى أنّه مشغول في الكتابة، أو دخل زميل آخر، أو رنّ هاتفه معلناً قدوم زوّار من خارج الجريدة.
عندما غاب في المرة الأخيرة، لم يعد يردّ على هاتفه. «انغلق» مطبّقاً ما كتبه في النص نفسه: «في آخرته يجب أن ينغلق الكائن، لا لأنّه لم يعد لديه ما يقول، بل لأنّ أحداً لن يعير كلامه أيّ اهتمام». لم يكن محقاً، وهو يعرف أن الآلاف ينتظرون منه كلمة. لكنه كان حزيناً ومستسلماً. احترمنا صمته، وصرنا نكتفي بصوت سميح، الممرّض الذي لازمه في منزله، يجيبنا باقتضاب عن صحته التي لا تتحسّن.
أمس، تعرّفنا إلى سميح وجهاً لوجه. كان جالساً يتقبّل العزاء في منزل أنسي في الأشرفية. هو الذي شهد على الرحيل. يكتفي بالقول إن أنسي توفي في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق. هل قال شيئاً؟ يرفض الإجابة «أفضّل الاحتفاظ باللحظات الأخيرة لنفسي». يقول له نعيم، شقيق أنسي: «أخبرني أنا»، فيرفض.
بكلّ بساطة يمكنك أن تحزر أن نعيم هو الشقيق، بسبب الشبه الكبير بينهما. «أشبهه بالشكل فقط، ليتني كنت مثله» يقول. تؤكد له نساء العائلة أنه مثله، فيما تلوم قريبته نفسها لأنها تأخرت أمس عن زيارة أنسي، فلم تودّعه، فتخفّف ابنته عنها. ندى، الجميلة، كانت هي من يواسي الذين لم يستطيعوا البقاء معه في اللحظات الأخيرة «لا. لا تزعلوا. كنتم ستتألمون لألمه». تحاول الابنة التي تحوّلت إلى والدة في الأشهر الأخيرة، أن تتماسك. فتروح تحكي كيف تلقّت الخبر، متفاجئة من وسائل الإعلام التي نشرته قبل أن تصل هي إلى بيت والدها «قبل أن أترك البيت اتصلت بشقيقي لويس أسأله عن وضعه، حاول أن يؤجل إبلاغي إلى أن أصل، ثم قال لي. المفاجأة كانت أني سمعت الخبر عبر الإذاعة في السيارة، ولم أكن قد وصلت بعد». تلتفت إلى مفارقة حزينة «أمي أيضاً توفيت يوم ثلاثاء، وكانت الساعة تقترب من الواحدة والربع».
روح أنسي الحاج انتقلت أمس إلى السماء، قال أفراد عائلته. روح أنسي الحاج تحلّق فوقنا الآن، وتذكّرنا بآخر خلاصات عمره، كما قال لي مرة، وكان قد كتبها في نصّ: «بعد هذا العمر، فهمت أهمية أن نتحلّى بالشفقة. الشفقة بوصفها الحبّ الكامل».
يصلّى على راحة نفس الشاعر في «كنيسة مار يوسف ـ الحكمة» (الأشرفية) عند الواحدة من بعد ظهر غد الخميس، قبل أن يوارى في الثرى في مدافن العائلة في بلدته قيتولي – قضاء جزين. وتقبل التعازي يومي الجمعة والسبت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر إلى السادسة مساءً في صالون الكنيسة.
عن تلك «العشبة الهوجاء»…
بيار أبي صعب
«ولن أكون بينكم
لأن ريشةً صغيرةً من عصفورٍ
في اللطيف الربيع
ستكلّل رأسي
وشجر البرد سيحويني
وامرأة باقية بعيداً ستبكيني
وبكاؤها كحياتي جميل»
(«ماذا صنعت بالذهب/ ماذا فعلت بالوردة»، ١٩٧٠)
في عام ٢٠٠٧ أطفأ أنسي الحاج شمعته السبعين، وكان قد تربّع على عرش صفحته الأخيرة في «الأخبار»، حاملاً إلى جريدة جوزف سماحة هذا النفَس الخاص، الأبديّ التمرّد، الذي كنّا نشتهيه ونطلبه ونعتزّ به. كانت الأسطورة قد ترجّلت في الطابق السادس من مبنى الكونكورد في بيروت، وصارت جزءاً من مشهدنا اليومي.
الذين لم يعرفوه من الزملاء إلا في النص، لم يتخلّصوا من انبهارهم رغم علاقة التماس اليوميّة… والذين كانوا قد ارتادوه فوق الساحة الثقافيّة والأدبيّة والإعلاميّة، بحكم علاقات المهنة أو الصداقة أو الشعر، كان أيضاً ينتابهم شعور الرهبة نفسه، ويعيشون كل مساء حالة استثنائيّة في جوار تاريخ استثنائيّ من الشعر والتمرّد وإعادة اختراع اللغة والكلمات. أحد شركاء «شعر» وساحر «الملحق الثقافي» لـ«النهار» في بيروت العصر الذهبي، وحلم الحداثة والعروبة والتغيير. غاب مراراً في الصمت، وكانت تعيده الصحافة إلينا، كما أعاده رياض الريّس كاتباً، أو أعادت الاحتفاء به ووضع شعره في متناول الأجيال «دار الجديد» مع رشا الأمير ولقمان سليم.
خلال سنوات «الأخبار» ـــ وقد أعطته صدارة لا تليق بأحد مثله، بعد قطيعة مريرة مع حكاية عمره في «النهار» ختمها بـ«رسالة استقالة إلى القارئ» ـــ كان أنسي نفسه دائماً. لا يشبه معلّماً ولا أسطورة، بل شاعراًًًٍ عارياٍ، ملعوناً، لا يعرف المهادنة. كان الشعراء العرب من أصدقائنا يحجّون إلى «الأخبار» لمقابلته. كان نفسه: مراهقاً، عاشقاً، ساخراً، ونقديّاً، وغاوياً، رقيقاً وقاسياً، ومخالفاً لأشكال الإجماع، ومزعجاً في بعض الأحيان لكثيرين منّا، زملاء وقرّاء، في مسائل خلافيّة تتسع لها «الأخبار» بحضنها الخصب في الفكر والسياسة والاجتماع. «مزعج» كما يليق بشاعر كبير، أخذ معاصريه على حين غرّة، ووقف دائماً، منذ بيانه الشعريّ الأوّل، حيث لا ينتظره نظام القيم السائدة.
في ذلك اليوم من ٢٠٠٧، نشرنا ملفّاً خاصاً عن أنسي الحاج، وأخفيناه عنه ليتفاجأ به في اليوم التالي مثل جميع القرّاء. كان يصعب على كاتب هذه السطور أن يقبل فكرة بلوغ الشاعر منعطف السبعين، فعبّر عن ذلك الرفض في كلمته الافتتاحيّة. غير معقول! أنسي الحاج عمره عشرون عاماً. أو بالأحرى توقّف عند الثالثة والعشرين، عام نشر باكورته «لن» التي زلزلت المشهد الشعري في بيروت قبل أن تتردد تأثيراتها في ديار العرب إلى اليوم. لم ترق لعبتنا الأسلوبيّة تلك لأنسي يومذاك، فعاد إليها في «خواتمه» السبت التالي، ليؤكّد على الملأ أنّه شديد الاعتزاز ببلوغه السبعين. عشرون، سبعون، ما الفرق؟ إنّها لعبة أرقام. واليوم نعرف أكثر من أي وقت أننا أصحاب حظ استثنائي، وفرصة تاريخيّة، لأننا عايشنا لسنوات روح التمرّد، عند ذلك الرؤيوي الذي كان قد بشّرنا من أوّل الطريق، في بيانه الشهير، بالأزمنة الآتية: «الشاعر الحقيقي، اليوم، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون محافظاً». ما زالت كلمته راهنة، ترنّ في أسماعنا كأنّها كتبت للعرب في زمن الردّة الحالي: «إن معارضة التقدم عند المحافظين ردة فعل المطمئن إلى الشيء الجاهز، والمرتعب من الشيء المجهول المصير. التقدم، لمن ليس مؤمناً بما يفعل، مجازفة خرقاء، وهكذا يبدو للمقلدين والراكدين. وبين المجازفة والمحافظة لا يترددون، فيحتمون بالماضي ويسحبون جميع الأسلحة من التعصب إلى الهزء إلى صليبية المنطق التاريخي، بل إلى صليبية منطق تاريخي زوروه بمقتضى سفينتهم».
كان أنسي مع التقدّم، مع كسر القوالب، وتجاوز الحدود، وإعادة اختراع اللغة كل صباح ومساء. توقّف طويلاً عن الشعر بعد «الرسولة بشعرها الطويل حتّى الينابيع» الصادرة عشيّة الحرب الأهليّة. لكنّه حمل علاقته الشبقيّة والصداميّة باللغة في كل فقرة نحتها، حتّى مقالته الأخيرة في «الأخبار» قبل أسابيع. كان أنسي فوضويّاً حتى النخاع، من دون أن يكون يساريّاً. كان متمرّداً في اللغة والحياة، ومتمسّكاً بنظرته الخاصة إلى العالم على حواف الرجعيّة أحياناً. وهذا كان يجعل منه مبدعاً، وصحافيّاً، وشاهداً استثنائيّاً لا يقبل التصنيف، وتضيق به الخنادق، وتعتمل في أعماقه التناقضات كأبطال دوستويفسكي: بين إيمان وغواية المحظور، بين انعزاليّة وراديكاليّة، بين محافظة وتمرّد وجودي وميتافيزيقي. كل هذه التناقضات تقف وراء نصّه الفريد، يضيق به اليمين التقليدي الذي ليس بعيداً عن بيئته، وينتفض لبعض مواقفه اليسار التقدمي الذي سبق الجميع إلى تبنيه والاحتفاء به.
لكن كل تلك التمييزات تسقط عند أبواب القصيدة، هنا تأخذنا قوّة خفيّة إلى حيث شيّد بودلير جنّته الفريدة. هنا تذوب التناقضات ولا يعود من معنى إلا للرؤيا، إلا للكلمات وقد تصفّت وتطهّرت من جاذبيّة اللغة القديمة. من خلال «قصيدة النثر»، ذلك الطوطم السحري الذي ما زال يقاتل من أجل شرعيّته كما لاحظ في وثيقته المقدّمة إلى «مؤتمر قصيدة النثر» («برنامج أنيس المقدسي للآداب» في الجامعة الأميركية في بيروت عام ٢٠٠٦): «أنا قصيدةَ النثر الصغيرة الدخيلة، عشبةٌ هوجاء لم يزرعها بستانيّ القصر ولا ربّة المنزل، بل طلعتْ من بركان أسود هو رحم الرفض. وأنا العشبة الهوجاء مهما اقتلعوني سأعود أنبت، ومهما شذّبوني لن أدخل حديقة الطاعة، وسأظل عطاءً ورفضاً، جليسةً أنيسة وضيفاً ثقيلاً، لأني ولدتُ من التمرد، والتمرد، التمرد الفردي الأدبي والأخلاقي، على عكس الثورة، لا يستكين ولا يستقيل حين يصل الى السلطة»… ستظل بيننا وبين أنسي تلك العشبة الهوجاء. أنسي في تاريخنا الثقافي المعاصر… هو بلا شكّ تلك العشبة الهوجاء…
كتابةُ الليل
عبد القادر الجنابي
في باريس، أواخر سبعينات القرن الماضي، كنت انتظر أنسي أن ينتهي من عمله الرتيب في “النهار العربي والدولي”، لكي ننزل نهر الليل المتدفق بشتى أنواع البشر. نخرج، هو بمعطفه الأسود وقبعته الروسية الشكل، وأنا بملابسي العادية… كنت ألاحظ أن علاقة ثمّة بين أنسي والليل… وكأنَّ الليلَ ميلادُه، أعماقُه، مُحاورُه بصيغة الشخص الثالث لطرد نعاس ميتافيزيقيّ. فـ”الناس تنام في الليل وتعمل في النهار”، بينما هو ينام في النهار ويعيش في الليل. ولِمَ لا؟ “أليس النهارُ أيضاً ليلاً مصبوغا بدهان الشّمس”!
لاحظت، فيما بعد، إن كلمة الليل تهمس كثيرا في بعض أشعار أنسي الحاج وخصوصا في “خواتمه”. لكنه ليس ذاك الليل الذي يتحيّن فيه الشعراء فرصة اللقاء بشياطينهم، وإنّما الليل بكل ثقله، وحجمه وبما يحمله من أسئلة وحالات من الأرق الشعريّ؛ بظلمته التي هي تعبير عن الأعماق بصور مدلولاتها. إنه ليلٌ آخرُ لا يسمح بسباق الانتهاء؛ إنه الجوهر، مركز الشعر، حيث ما إن تُغلق عينيك، حتى ترى. ومن شأنه أن يُفضي الى فجرٍ جديد؛ إلى حيث كلُّ شيءٍ يتوقّف، يتحرّك، يسبح، يُعيد انتاجَ نفسه. إنّه علامة صراع بين الأب والابن: “كان أبي نهارا وكنتُ ليلاً”، فتتبدل الأدوار: النوم أرق، الأرق نوم، والليل يتجاوزهما في فترة تركيبيّة. ليلٌ يترامى رمزَ بحثٍ عن كتابةٍ ذات نزعة ملائكيّة في نظرتها، تعيدنا إلى فجر العالم “يوم كانت الأرض ملعباً للنفْس المُرهَفَة”، وها نحن نستيقظ في ناصفة ليل التساؤلات التي ننام معا. إنّه الليل بامتياز؛ حلبة الصراع بين الكلمات والأفكار، تكون فيه نهايةُ الحلم موتَ الأنا، وبدايةُ سيادةِ الحلم ولادتَها الجديدة. ومن هنا، إنّ فعلَ التدوين، في كتابات أنسي الحاج، ليس عن الحلم وإنما عن التشاكل بين الكتابة والحلم؛ كتابةُ الليل علّ النقطة التي ينضم فيها الحلم بعالمِ اللاوعي الواسع؛ نقطة “التدامج بين الليل والنهار”، تنبجس من الرأس، ويغفو العالم في سريره الورقي، التنظير المعتاد.
في “آخر الليل” حيث “لا أحدَ لأحد”، كان لِلَيل أنسي الحاج ملائكته؛ إنّهم الأبرياء المنقّبون في تربة الظلمات عن بهجة الضوء؛ الاندماج بزحام باتت أحلامه محطة أخيرة في أمداء المكتوب. ملائكة بلا سماء، مصنفون بمختلف النعوت المبهمة: شحّاذون، عاهرات، ضائعون، حالمون، باختصار: محبّو كلِّ ما هو حيّ. كنّا نتساود معهم سوادَ الليل إلى أن “تتوهّج الحياة…”. فيتنفس الصُّبحُ، بين أضواء المصابيح والشّمس… وينتهي فصلٌ من الدرس.
جزء من دراسة أعمل عليها حول الليل في شعر أنسي الحاج،
نشر، اليوم، في جريدة “الحياة” اللندنية، في ملف خاص بوفاة الشاعر.
وحدكَ!
بول شاوول
… طويلاً ورحلتَ ويا لجلجلة الوجع يا أنسي. وطويلاً كنّا معاً. أكثر من عمر. وأكثر من ميلاد. وأكثر من ميتات ورجوع، وأكثر من شِعر. وأكثر من درب. وأكثر من صداقة. خمسة وأربعون عاماً يا أنسي. معاً. وكأننا نوازي نهراً لا نعرفه. وسماء غامضة. وأقداراً لا تُحسب لنا، وأرصفة تغير أسماءها. ومدينة كلّما مشت مشينا ومشيناها. وكلما توقفت أصاب حواسنا الحنين. أصاب أقدامنا الوقوف بلا إشارات… ولا قبعات، ولا مفترقات كأنما باتت الحياة طريقاً واحدة ضلّ حُرّاسها طويلاً.
كنت لي يا رفيقاً، وطويلاً، كنت لي المغامر وحدك، وحدك، في المنعطفات الخطرة. كأنما كنت دائماً على حافة هاوية مفتوحة على سماء. من «لن»، هذه القصيدة المحظية، الصرخات المتتالية، المتطاولة على ما هو سائد، وعائد والانفجار المتعاقب في قلب الواقع. أي اللغة. اللغة. جاءت من ورائك كقبائل تبحث عنه أعمارها ولا تجدها. الضربة الخاطفة، في «لن»، أو اللمسة كشعاع يتلمسه الهواء وتراه.
هكذا في وعورة خصبة، «لن» وكان المفتتح ليديك، والمفتتح لزمن جديد كدنا نخسر علاماته، أو يُفقدنا علاماته. لن «المعجزة» الشعرية البوابة التي شرّعت على لا معقولها. على خرائطها الغامضة، على غيلانها، وكائناتها، ولغاتها، وشعوبها، (واللغة عندك شعوب تخرج من تواريخها)؛ ومن «لن» يا صديقي الذي كان لي أن أقرأه وأكاتبه وأحاوره وأهاجسه واتواراه وأفتشه وأشمشمه وأقلبه، وأساوره، حتى قضني وأضنيته من نشوة نادرة وكتبت ما في النشوة، لكن أقل ما في الصفحات. ومن هذه الدُّرف، المتوغلة في درف، والمتشابكة في شبابيك، وأزقة، وصنوبر، وألم وخوف وشوارع، وتسيّب، ورعب، وسرطان، وقدر… ولغة لا تمشي إلا لتجتاح، ولا تجتاح إلاّ لتؤنس يا أخي. «الرأس المقطوع». يوحنا المعمدان. كل الرؤوس التي نسيت أجسادها. في الحقل. أو على المصطبة. أو في الشجرة. أو على أنهر. أو أمامك أو وراءك… وكان للرأس المقطوع أن ينشد، كما لم تٌنشد سماء التحمت بكواكبها بل كأن الاسترجاع هنا، وأكثر: استعباد العذاب، والموت، وانتهاكهما، على مساحات قصية من «ماضي الأيام الآتية». الشموس تراجع ثباتها. الحقائق تستعيد جذورها. النسمات شهقاتها. الزمن دورانَه. الموت عانّته. الحياة اختراقاتها البهية، وعوالمها بلغة تهزم القدر، تنعم بما هو آت، تكسر ماضيها، لتحيي ما في أوردتها، وشروشها، ولحمها وكائناتها. هنا الإيقاع أرحب لكن أصعب. هنا المدّ منقطع والصورة ملتاعة من وقتها، كأن تقول «الارض مستديرة للعاشقين». مستديرة؟ نعم؟ ولكن بأي نهش، بالاظافر، والاصابع والعينين، ليكسر دورانها الالفي في بهاء المُطِلّ، والراحل، والمجهول، والقادم، والغارب والسارب.. ثلاثية بأنفاس لهثى. بأجساد لا تتعب، بعشق لا يعرف سكانَه. كأنما الى الوردة. وما اعطبها. وكأنها الى الذهب. وما اشقاه. وماذا عساك فعلت «بالوردة والذهب». أبعد من الوشائح، والتناقضات، انها حكاية الروح في وتائرها العابرة، الذابلة لكن الملكة بتيجان الفقدان. انها حكاية الروح في وتائرها اللاحقة. حيث للذهب ان يذوب ببريقه في العبق. وليكون للذهب عبق. عميق كأنه من رائحة الجنة، وكأن للوردة ان تتطاول على الوقت بما اكتنزها المعدن، حوار الوقت والموت يا انسي. حوار الارض والسماء. حوار العمر والذبول. حوار الوهم والوهم. حوار ما يرحل وما لا يرحل… حوار النهر الذي جاورناه وما جاورنا.. حوار الحب والآخرة والسماء الآتية «برسولتها» حتى الينابيع. بشعرها الذي من عمر الوف السنوات. انه الحب، او الخروج الدائم الى الينابيع ولا قهقرى، بلا مجد، بلا اشياء الرسولة.. ويا لشميم العشق الجسدي الذائب، المرئي والشفاف، العاصي والمستحيل، كلغة الانبياء، بحرياتها الموروثة ولغاتها المفتوحة. وأي شفافية يا انسي. وأي غنائية. وأي سلاسة. وأي تجلّ. وأي صوفية شهوانية تماثلت الى العناصر، بل واي لغة صَفَتْ، واي قصيدة ملمومة، محمومة بهدوئها بشغولها بفضائها اللامتناهي، لكن لا تخفي الغرابة، ولا الفجاءة، ولا تصادم الصور، ولا عناد الكلمات، ولا بطش اللحظة الخاطفة، ولا انسياق الايقاع المائي، ولا سيولة الشعر الذي سار درباً الى الينابيع…
هكذا كنت يا انسي، وعلى الرغم مما حاولوا سجنك فيه، من عناوين، وألقاب، وحالات، ظللت متمرداً على كل شيء، على المجتمع، والعادات، ولصوص المعبد، والطغاة… تماماً كالحرية. والتمرد اخو الفوضى. والفوضى شقيقة الجنون. والجنون ابن المغامرة المفتوحة.. تمردت على كل ما من شأنه ان يأسرك بحالة، او بجماعة، تمردت على نفسك. نفيت نفسك مرات، وعاكستها مرات، وكم كانت اللغة في هذا التمرد، ابنة المجهول، مولدة اقدارها الجديدة. كنت وحدك يا انسي. ورحلت وحدك. هكذا. وقطعت جلجلة الألم وحدك. وصارعت الوحش وحدك.. تماماً كما كنت دائماً وحدك في شعرك الآخر، في شعرك الفريد، المتلاطم بمجازفاته الدائمة.
وماذا اقول اخيراً يا انسي؟ «كل الذين احببتهم سقطوا من القطار؟»… إمّا رافقوك أم ذهبوا بعد ان ذهب القطار… ولن يعود.
الرسالة التحرّرية
عبد القادر الجنابي
(كاتب وشاعر وناشر))
إنها الرسالة التحررية لشعر أنسي الحاج الخالي من اي تلميح ايديولوجي، تكمن، من جهة، في انه وضع توجهاً شعرياً كلاسيكي المنحى كان سائداً، على الرف؛ مرة وإلى الأبد. ومن الجهة الأخرى، في قدرته على زج اللغة الشعرية في معمعان التجريب الطليعي بنقل القصيدة من نطاق الدمدمة في الأذن الى صور تسمعها العين.
ان غياب الأيديولوجيا ورموزها في شعر أنسي الحاج، ساعد عدداً كبيراً من الشباب على تجنب الشعارات في شعرهم، والتركيز أكثر على وظيفة فكرهم الحقيقية، بل بتنا نرى، في الآونة الأخيرة، شعراً أنثوياً متخلصاً من نحو الذكورية، وخطاب البلاغة السلطوية.
لا أعني بغياب الوعي الأيديولوجي، ان أنسي الحاج لم يكترث لما كان يحدث في العالم من أحداث تحتاج الى تحليل وموقف. على العكس، كان نثره الأسبوعي في ملحق «النهار» تحت عنوان «كلمات كلمات كلمات»، يبين إلى اي مدى كان المجتمع اللبناني، وبالتالي العربي، يحقق الحرية أولاً. ذلك أن أنسي الحاج، بقدر ما كانت شاعريته تتبلور قصائد نموذجية خارجة على المالوف العربي، كان هو ملقى في خضم الحياة، في معمعان الحرية اللبنانية التي كانت تصل الجوار العربي هواء نقياً يعد بالف مستقبل مضيء. بل كان يعرض نفسه للخطر بسبب مقالات جريئة وواضحة، كتلك التي قرأها في طرابلس دفاعاً عن المرأة: «والرجل ما دوره؟ على الرجل أدوار لا دور واحد، عليه ان يحرض المرأة على الحرية، وعليه ان يكون لائقاً بها متى تحررت، وعليه، وهذا هو الأهم، ان يكون هو نفسه حراً». كم أود أن ارى، ذات يوم، ناقداً نزيهاً، غير متحيز، يقوم بمقارنة بين مقالات أنسي الحاج في ملحق «النهار» وبين ما كان يكتبه، مثلاً، ادونيس في «لسان الحال». وكم أتساءل: هل يجرؤ أدونيس على إعادة نشر مقالاته المتراكمة في «لسان الحال» في كتاب دون ان يكشف عن حقيقته كديماغوجي يتغوغأ وفق العوام. أنسي الحاج قال كلمته، بوضوح، في الوقت المطلوب، وليس عشرات السنين في ما بعد، أي عندما اصبح الادعاء بكل شيء بضاعة الجميع.
في الحقيقة، ان انسي الحاج استطاع أن ينجز ما لم يستطعه جورج حنين في أربعينيات القرن الماضي. إذ حنين، على عكس الحاج، لم يكتب بالعربية وانما بالفرنسية. لكن كليهما شاعر متميز، وكليهما كاتب مقال صحافي ذي أسلوب جديد لم يعهد من قبل، طبعاً كل منهما بحسب الواقع الذي يكتب فيه واللغة التي يتقنها والمادة التي يتناولها. لكن، كلاهما يتجاوز الثنائيات المميتة، خصوصا ثنائية شرق ـ غرب. إذ كلاهما ينطلق من موقف كوني حقيقي بأن الغرب ليس كموقع جغرافي، وإنما محور لتمردات الروح الانسانية كلها من أجل الحرية والشعر وحق الفرد في أن يكون صوته هو لا صوت سيد ما.
يكفي أن نقوم بمقارنة أسلوبية بين مقالات الحاج الأسبوعية في «ملحق النهار» ومقالات حنين التي كان يكتبها أسبوعياً في الصحافة الفرنسية، حتى نرى كم من تشابه بينهما في تغطيتهما لحدث، لكتاب، لفيلم أو ظاهرة أدبية بلغة ثاقبة ودعابة سوداء. ومثلما اليوم ما ان نقرأ مقالات جورج حنين التي كان يكتبها في خمسينيات القرن الماضي، حتى نشم هواء الحرب الباردة وكأننا في شتائها الرمادي وشمسها المشرقة، فإننا نشعر كذلك، حين نقرأ الجزء الأول من «كلمات كلمات كلمات»، بنبض السيرورة الطبيعية التي كان يمر فيها لبنان: الحرية، حركة المطابع من أجل التنوير، الرقابة بنموذجها الطبيعي وليس الأيديولوجي القمعي كاليوم؛ باختصار: لبنان ماضي الأيام الآتيةّ!
شعر أنسي الحاج ومقالاته في ملحق «النهار» واحد يكمل الآخر. ذلك انه عندما حلت حقبة «مصرع الوضوح»، وانتصر سوء استعمال اللغة، وبينما كان «أولئك» يحصدون الجوائز وينحنون امام تصفيق جمهور الرعاع. قرر أنسي الحاج ان يصامت اللغة؛ أن يمنح كلماته فرصة التأمل والصمت كي تعود اقوى في لحظة الكلام.
صمت انصهر فيه الشعر والنثر خواتم يدمع بها عالماً بلا أخلاق، شظايا بالروح النوفاليسية نفسها، تتوهج في أعالي الروح، ما وراء الأجناس الأدبية والهويات الطائفية.
(عن مجلة نقد)
غير مسبوق
شربل داغر
(شاعر وباحث)
تكاد أن تكون قصيدة أنسي الحاج بداية تامة، غير مسبوقة، طالما أنها مفاجئة، شديدة الاختلاف، مع ما سبقها. الشاعر الذي بدأ بجملة واحدة على سطر: (أخاف)، لم يكن متهيباً أمامها مثل عبادتها الكثر الذين يخشون حتى مداعبتها الخفيفة.
فرداني شعرياً منذ ضربته الأولى، فلا يميل على غيره، بل يقطع معه. قد نجد في قصائده الأولى صلات بشعر نقولا قربان، المجهول والمضيء في الشعر اللبناني الحديث. قد نجد له صلات مخففة بأناقة اللغة عند أمين نخلة، وإن يبتعد عن ريفيتها المتغاوية بنفسها أو بجمالها ساكن. إلا أننا نجد في شعره، بشكل مؤكد، البدء الفرداني، المديني، لما كانت عليه لغة جريدة (النهار)، بوصفها مختبراً وتجلياً للبنانية حديثة متحررة تماماً من لغة الفقهاء والديوانيين. بل هو المتقلب العصبي لهذه اللغة.
ما كتب إلا بنزق، أو باكتناز، بعد أن استرسل لوقت في غنائية (رسولية) لم نعتد عليها لا في بداياته ولا في نبذاته الكثيفة لاحقاً. كتب لنفسه في نوع من العيش في اللغة وبها. إنها تعبيره الوجودي. هذه قوته، وهذا امتناعه عن غيره، أو صعوبة وصوله الى غيره.
لهذا هو مثل كثيرين، قبله وبعده، لم يُعرف عربياً إلا بمقادير محدودة في العقدين الأخيرين، ما يشير الى أن فرادة بعض الشعر اللبناني بقيت سباقة وغريبة، مثل ما في الأيام الآتية.
وهو إن كتب فلقارئ، لا لجمع أو قضية، ولا لتوجيه إرسال أو رسالة، ما جعله غريباً ونادراً.
أنا أحد هؤلاء القراء ولا يسعني إذ يغيب أن أغيب فضله العميم على تجربتي، إذ يعود له الفضل في نشر قصيدتي الأولى في (الملحق) في نهاية صيف 1971: كنت أنتظر ورودها في الصفحة الثانية المخصصة للقراء بعد صفحة الغلاف، فإذا بي أجدها في الصفحات الداخلية (للملحق) مع قصائد ومقالات كتاب معروفين.
لهذا أقول إنه «مكتشفي». هذا ما جعلني أتجنب اللقاء الشخصي به، سواء في بيروت أو في باريس، ثم في بيروت. إذ طلبت دوماً الاحتفاظ بلحظة الامتنان الأولى، الحارة، الدافعة، من قارئ الى من كان يمثل في عينيه، ولا يزال: الشاعر.
المتمرد
لور غريب
(فنانة وصحافية)
أنا أعرف أنسي الحاج منذ الستينات، تعرفت عليه بمجلة شعر. كنا نجتمع معاً نهار الخميس وأنا كنت أصدرت ديواناً شعرياً ولم أجد حماساً من جماعة شعر ما عدا أنسي، على أساس أننا جماعة نكتب بلغة أجنبية.
حتى لما كتب أنسي «لن» يوسف الخال ما كان متحمساً للقصيدة النثرية التي كتبها أنسي، وأنا كنت معجبة جداً به وتفاعلنا معه إيجابياً وهو كان قد وقف الى جانبي حين قال لي يوسف الخال «إن الشعر مش شغلتي».
حين أصدر أنسي الحاج «لن» حدثت ضجة كبيرة في لبنان والعالم العربي، وكانت الضجة أكبر في بيروت كمدينة تكرس الشعر والشعراء.. كان أنسي الحاج ظاهرة، وكان يمثل بالنسبة لنا التمرد على كل شيء. المتمرد على الشعر المقفى وعلى الشعر الجاهلي، كان يشبه الهواء الذي يحض بفضاء آخر مستقل.
كنت معجبة جداً به وكذلك شوقي أبي شقرا وكذلك غالبية الشعراء المنضوين تحت لواء «مجلة شعر». حتى الجماعة الفرنكوفونية كان بالنسبة لهم أنسي الحاج يمثل ظاهرة، ظاهرة الحداثة في الشعر العربي. واستمر أنسي وفتح طريقاً وآخر في الشعر على الرغم من المأخذ والانتقادات على قصيدته النثرية.
وكان أنسي (يضحك) وهو كان يقول «شو في براسو». لم يكن الشكل مهماً كثيراً بالنسبة إليه، على الرغم من أن المفردات التي كان يستخدمها تذكر بأناشيد «الثورة».
علّمنا أنسي من دون أن يعرض أن نعمل مقاربة للخلق الشعري من دون المرور بزواريب القواعد كانت الكلمة بالنسبة إليه أهم بكثير من وقعها على الآخرين. كان أنسي يمشي بخط مباشر نحو فكرته الشعرية عشوائياً ولا يضبط إيقاعها إلا بعد الانتهاء.
ما طلع مثل أنسي الحاج بالقرن العشرين، ربما طلع أشخاص حاولوا أن يعملوا مثله، أن يتقربوا من منهجيته في حياكة القصيدة.
ما كان هم أنسي الحاج أن يكتب قصيدة. كانت القصيدة تخرج ربما غصباً عنه حين كنت أراه أقول له: يا أنسي إنتبه لحالك، لا تبدو مهتماً بنفسك ثيراً؟ وكان يردّ عليّ «أنا مشغول بالتفكير دائماً أخاف إذا كنت سعيداً أن أفقد لغة كتابة الشعر.. كأنه كان ملتزماً قضية المعاناة بالمعنى الوجودي وليس المعنى الواقعي. كان أنسي حتى خارج اليوميات ما عمل يوماً ليستميل أحداً.. كان خارج الشهرة، أبعد منها، كان مقلاً جداً بإطلالاته الشعرية وحتى الإعلامية. كان راهباً صوفياً ليس بالشكل المسيحي وهو مسيحي كبير، بل بمعنى أن قضية مأساته مع الشعر قضية وجودية.
كتب الشعر وكان أبعد منه، أتى كما النيزك.
قبل أنسي الحاج كان شيئاً..
وبعد أنسي الحاج الظاهرة، من الصعب أن تجيء ظاهرة أخرى..
سوف نفتقدك كثيراً..
لشعره
مي منسّى
(روائية وصحافية)
أحببت أنسي الحاج لشعره أولاً، «للرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع» أحببته بكل كلمة يكتبها لكني كنت دائماً أشعر بأنه يتحاشى أن يقترب من الآخر… هل كان خجولاً؟ هل كنتُ أنا من الذين لم يرق له ربما الاقتراب منهم. لم أستطع أن أصادق أنسي وأن أكون قريبة من روحه. اقتربت منه من خلال شعره، من خلال الكلمات النثرية التي كان يكتبها في «النهار» هل كنت أشعر بالغربة عندما استلم الصفحة الثقافية لمدة من الزمن؟ كنت أحب أن أتجادل معه لكنه كان مقفلاً، خجولاً ربما؟ غريباً ربما؟ لم أستطع بصداقتي له أن أبني جسراً بيني وبينه. ظلّ أنسي الحاج هو الكتاب الذي استطعت أن أتآلف معه وأن أدجّنه.
الدمع لا يكفي
علوية صبح
(روائية)
إني أشعر بحزن شديد لغيابه. كأن شيئاً قد رحل معه. بغيابه ليس من ذاكرتي وحسب وإنما في حياتي وجسدي.
أنسي الكبير كإنسان وكشاعر وكصديق لا يمكن أن يرحل فكلماته وحضوره وأناقته وشعره الكبير سوف يبقى معي وآراءه كل ليلة لأنام وأشعر أنه لم يمت أبداً.
نعم أنسي الحاج لم يمت، إنه يعيش وسيبقى حتى بعد أن نرحل.
أنا حزينة جداً ولا أملك أمام حزني سوى الشعور بالعجز، لأنني لم أستطع أن أودعه قبل رحيله. الدمع على غيابه لا يكفي ولا شيء يعوض غيابه مطلقاً.
لبنان والثقافة العربية خسرت شاعراً كبيراً وإنساناً عظيماً إن أنسي يسكن بنا منذ أن بدأنا القراءة وعلّمنا بكتابته كيف يمكن أن نكون شعراء في مشاعرنا ومن حواسنا وفي لغتنا وفي كل حياتنا. كان المعلم والحب والتمرد والحرية والصوت الذي لم يغب أبداً.
حزني لا يمكن أن أترجمه الى كلمات، ولا أستطيع فعل ذلك… إني عاجزة عن ترجمة حزني الى كلمات. فقط أتذكر الآن ما قاله: «كلما أحببتهم، أحببت أحداً سقط من الكتاب».
هذا هو أنسي الذي أحببت
محمد علي شمس الدين
(شاعر)
العالم أكثر وحشة من دون الشعراء.
انسي الحاج كتب شعراً خاصاً لم يكن مثل غيره ممن سبقوه وان كان بعض الذين لحقوا به تأثروا به. برأيي اهم ما فيه هذا الشاعر الذي احببته عن بعد فأنا لم اتكلم معه سوى كلمات قليلة عرفته يملؤه القلق والخوف والرغبة في المفارقة. انه حلم هذه المغامرة الخطيرة في اللغة ضد اللغة وفي الشعر ضد الشعر وكان بمثابة علامة كبيرة لمسألة البحث عن الذت من خلال الكلمات، وفي رأيي اكمل مع اضافة العصر والحداثة وكل توتراتهما ما كان جبران بالانكليزية قد اثاره في كتابه «رمل وزبد» ومضة القلق المكثفة او برق لخوف. هذا هو انسي الذي أحببته والآن الى القصيدة.
الفاجعة
شوقي بزيع
(شاعر)
في هذه اللحظة لا يمكن اي لغة ان تكون جديرة بفاجعة مثل هذه الفاجعة وان تكون قادرة على حمل هذا الالم الذي اشعر به الآن والذي يشبه طعمه طعم الرماد في الفن، قد يكون الصمت اكثر ملاءمة للموقف وهو وحده القادر على تجسيد لحظة تلقي الخبر. مثل هذا الرحيل لا يليق به سوى الخشوع وان كان لا بد من لغة فقد تكون اقرب الى صرخة الاحتجاج او علامة التعجب او تكرار كلمة «لماذا» الى ما لا نهاية.
لحظة صمت
جرجس شكري
(شاعر مصري)
انا حزين جداً. كان انسي مريضاً، لكني لم أتخيل ان اسمع هذا الخبر. مجرد ان تناهى الي هذا الخبر، دار في رأسي شريط سينمائي حول لقائي بأنسي الحاج في بيروت في مؤتمر قصيدة النثر. ظللت صامتاً استرجع هذه المشاهد كيف تحدثت معه للمرة الاولى. في هذه اللحظات نصبح اغبياء، لا نستطيع الكلام، نصاب بالشلل. حتى حين اتحدث اتخيل ان شخصاً آخر يتحدث. يجب علي ان اصمت في هذه اللحظة.
آخ!
عصام العبدالله
(شاعر)
يخرج الكلام بمثل هذه الحالات وكأنه هو المريض لا يليق بكتّاب وشعراء كأنسي الحاج، لا يليق بهم الموت. والارجح سيعاندونه ويظلون احياء في كتبهم والرفوف وفي صدور الاصدقاء الذين يتذكرون موهبتهم بملاك فاتن.
انسي الحاج معلم وعصفور وغزال. وانا من المبكر ان اشهد عليه الآن. انا ارمي عليه وردة الكلام، وفيما بعد سيكون لي ولمثلي كلام كثير عن هذه القامة التي تضيء عالم الكتابة وعالم الشعر.
عندما تودع الطيور مهاجعها لا اظن انها تعود وتستهدي عليه. اخاف ان لا تستهدي على انسي الحاج وهو في غيابه المبهر.
سلام على كل قصيدة
موسى حوامدة
(شاعر اردني)
سلام على كل قصيدة اكبر من الموت، وعلى كل شاعر منح قلبه للخسارة. كان انسي الحاج متقدماً على العرين جاء مبكراً سباقاً لعصره بعقود طويلة. تم الترويج لشعراء كثيرين غيره، بينما كان هو اول وأحق. سبق عصره في الرؤية التي كانت موجودة لديه. قصيدة النثر التي كتبها كانت انجيلا لقصيدة النثر العربية. الخسارة كبيرة برحيله للادب والثقافة العربية والانسانية. لم يخرج انسي الحاج عن التفعيلة فقط بل خرج عن انماط التفكير التقليدي. كان صاحب رؤية وبنبوءة مبكرة. نعزي كل الشعراء برحيل شاعر كبير مثل انسي الحاج. لم يكن يريد من الشعر سلطة ولا جاهاً الا روح الشعر. كان يبتغي من الشعر تحرير الانسان العربي من سلطة التقاليد والمفاهيم البالية. لم يكتب قصيدة فقط بل رؤية عربية حضارية.
خبر صادم
سيف الرحبي
(شاعر عماني)
خبر مفجع وكلما يرحل شاعر بحجم انسي الحاج يقيناً ان العالم ينقصه الكثير من الجمال والشفافية لصالح البشاعة والقبح والطائفية. ومنذ فترة اتصل بي الصديق عبده وازن واخبرني أن انسي في غيبوبة. حزنت كثيراً لذلك، والآن هذا الخبر عن غيابه النهائي، على الاقل جسدياً وليس روحياً وشعرياً، خبر صادم بالتأكيد. انسي الحاج «المحب والكارة العميق» حسب تعبيره، وجامع شمل النيابيع. الرجل منذ مطلع الستينات قاوم كل ما هو نمطي وسائد وموروث سيئ لصالح التحديث والتجديد والديموقراطية والانفتاح الثقافي والحضاري والروحي. كلنا حزين لغيابه وغياب امثاله عن هذا العالم الذي ينحدر سريعاً نحو قعر الهاوية.
كأنما الأرض بلا سماء
شارل شهوان (فنان وشاعر)
الأرض نفسها وكأنها بلا سماء
بيد أنها غيمة بحجم عينيك
هنالك فوق الجبال
مثل ارتعاشة، صرخة
الهواء لا يهتزّ
شجرة نشيج وزفرات
إن كان الحب لا يفشل أبداً
سوف يصحبك الى ما بعد الموت
اليأس جوهري
حين يختفي لون الشعر والعينين
ثمة ورود تطلق أحمرها
من لحظة أغمضت
سيكون العشب بين يديك
لن تتبدد كأي دخان
ستبقى الحروف ذهبية زاهرة
لست وحيداً في هذا الكوكب الميت
هذه النهاية ستطول.
إنها صرخة
غسان تويني
ليس أدل على وحدة تفكير، بل نظرة أنسي الحاج، من المقارنة، عبر ثلاث وعشرين سنة، بين هذا التوجه الى عاصي الرحباني ورد أنسي الحاج على رسالة بعث بها اليه المفكر السعودي الثائر عبد الله القصيمي عن لبنان، قال فيها:
ولبنان الذي جعلوه لا طعم ولا لون، والذي كنا جلسناه على هوى حبنا، فأفقنا لنجد أنفسنا دخلاء..»
انها صرخة.. لأن التاريخ، متى يكتب شعراً، فصرخة يكون، لا انشاء.. غضباً كالفرح… براءة وتمرداً.
جمال «كلمات»، كثباتها، انها صورة الزمن الذي يمر متقلباً، والذات دائمة. فيكون للتاريخ فيها بعد مزدوج: الثبات والتجدد، الصورة والحلم. وتكون مرآة الواقع هي، في آن معاً، مرآة الثورة عليه، فاذا عكست «كلمات» الروح الاجتماعي، فعن طريق الثورة عليه ورفض المجتمع الذي يعبر عنه، بدل تكريس هذا المجتمع بمحاولة تصويره عبر كتابة تجميلية أو حتى «انتقادية».
هكذا، تجيء كل سنة بداية جديدة لما سبق ان بدأه الكاتب ويئس منه ثم عاد اليه ثم مله ثم عاد اليه بمزيد من القوة: الأمل بالتغيير، تغير الانسان والعالم، لا بل الايمان بتغيير الحياة «نحو الجمال والسعادة».
ولنستعرض بعض هذه السنوات.
1965 اعلنها انسي الحاج ثورة على «هذه المعيشة الحقيرة التي يحياها الشاعر والفنان والمفكر في لبنان».. ثم اصبحت ثورة «لتغيير النظام والمجتمع» من أجل «الكتاب والفنانين ومن اجل كل فئات الشعب».
وتتخطى الثورة مجرد التحريض على الثورة لتصبح اعلانا للثورة يساوي في الادانة اليمين باليسار:
«يسارهم كذاب ويمينهم كذاب.. منذ ربع قرن وهم يجعلون من لبنان جمعية للصوص الاحتكار والمنافسة.. منذ ربع قرن وهم، رأسماليين وطائفيين واقطاعيين وعائليين، يستعبدوننا روحا وجسداً، يفرضون الخوة ويزورون الارادة، يتاجرون بالحشيش ويتاجرون بالسلاح ويتاجرون بالرقيق الابيض… هؤلاء هم اسرائيل».
بعد هذه الثورة التي توقفت بهدنة «أعلنها الذين لم يعلنوا الحرب»، طرح أنسي الحاج مشكلة الشعب نفسه:
والمشكلة هي وقوع الشعب في براثن الفخ الطائفي. لذلك، التحريض يجب ان يكون تحريض الشعب اللبناني على نفسه، والنقل يجب ان يكون نقل هذا الشعب من التباغض الطائفي والديني الى بغض تاريخه الأسود.. وفي سبيل بعث ازمة الضمير هذه نحن بحاجة الى مفكرين وفنانين وكتاب متمردين وثوار لا الى مفكرين وفنانين وكتاب قانعين بالامر الواقع. لهذا قلت اننا لا ننتظر شيئاً الا من العنف».
ونعود نتساءل: الى م ادت هذه الثورة؟
الى خيبة أمل. خيبة امل بالواقع اللبناني، فكرا وسياسة. وفي غضبته وقرفه بعد طرد عبد الله القصيمي من لبنان يكتب:
«نحن ابناء بلد بلا قضية. نحن مواطنو الاهدار والسخافة. نعيش في محرقة، نأكل بعضنا البعض، تافهون، منافقون، لصوص، نحن بنك، وكازينو، وشركة طيران، وسمسرة، وعمولة، وتهريب.. ليس في لبنان شيء حقيقي. حتى المجانين لم اعد اصدق انهم حقا مجانين. حتى الموتى يخيل الي انهم يموتون بشكل مستعار».
وكأن الخيبات اللبنانية لم تكن كافية، فجاء «حزيران 1967» الذي سماه عبد الناصر «نكسة». وتحت عنوان «هزيمة حضارية لا عسكرية» كتب انسي الحاج:
«العلة في الداخل»، داخل الروح العربي، داخل التراث والفكر، وما لم نعالجها بالصورة عليها فسنظل مهزومين»..
شهادات في رحيل الشاعر الكبير أنسي الحاج
لا يليق بك الموت
سامح كعوش
(كاتب واعلامي)
لا يليق بك الموت، كأن تودّعنا ونحن في أمس الحاجة إلى الوليمة قبل العشاء الأخير، بأمس الحاجة إلى أن نراك وأنت تصنع بالذهب وتفعل بالوردة، مع أننا نعلم يقيناً أن رسولتك هناك تنتظرك، بشعرها الطويل حتى الينابيع، لهذا نقف هنا باكين لا رحيلك، بل لأننا لا نرافقك في رحلتك المشتهاة.
لا يليق بك الموت، ولكنك به تحقق معجزة الشجر الذي وقوفاً يموت، ولا يرحل إلا بالقطع، ولن تتجرأ فأسٌ على انتزاعك منّا، من حياتنا وأحلامنا والكتب المخبّأة تحت وسائدنا، وفيها منك كثيرٌ كثير، الآن فقط، سيتكاثر البكّاؤون على قبرك، والواضعون الأوسمة على صدر خشب نعشك، وأنت كأنك في استقبالك لنا كما عهدناك، مرحّباً بابتسامة وقورة وكلام كثير تشي به العينان ولا تقولانه، كم أنت رائعٌ أيها العريق، أيها الصديق، أيها الفينيق أنت.
يحتاجك هذا اللبنان، يحتاج سيرتك وصورتك، كي يزداد انفتاحاً على أبنائه، كي يحبّهم فيحبّوه، ويحياهم فيحيوه، لبنان دونك يحتاج أكثر من مجرد أمنيات، يحتاج ألف أنسي ليعبر عنق الزجاجة إلى مساحات الحب والشعر والأمل والمستقبل.
ذهب الروح
هبة القواص
(مؤلفة موسيقية وسوبرانو)
لتبدأ رحلتك الى الخالق بسلام.
يا من صغت من الوردة ذهب الروح.
اللحظات الاخيرة معك هي ثمينة كالابد..
الى الحبيبة ندى والى لويس وجميع افراد عائلتك الصغرة والكبرى.. اخلص التعازي، والى لبنان والعالم العربي ارفع حزني لشاعر ومفكر كبير.
انسي الحاج باق مطلقاً.
حزني كبير
أنطوان ملتقى
(مسرحي)
خبر رحيله هزني كثيراً، انضرب راسي لهالخبرية،
أنسي الحاج مات
ما عندي شي قولو غير إبكي.. وإزعل
أنسي الحاج كان شخصاً مهماً،
كان شاعراً كبيراً،
كتب أشياء ما كتبها غيره شعراً
كنت أقرأ له.. كان «النهار»،
كيف طلع من «النهار» ما بعرف!
هذا إنسان كبير
هذا شاعر كبير
كنا سوا
كان يترجم لي مسرحياتي
وكنا نلتقي بمجموعة شعر..
صدمني كثيراً موت أنسي،
حاولت عبثاً الاتصال به..
حزني كبير، كنا نحكي سوا في الشعر والأدب والمسرح والترجمة وكل شيء..
ما عندي حكي..
أنا حزين..
كم سنشتاق إليك
إيفانا مرشليان
(كاتبة وصحافية)
غياب أستاذ أنسي أكثر من أن نحتمله جميعاً. أقول جميعاً، لأننا كنا كثراً حوله، نحن إعلاميو الثمانينات، وقد تربينا على كلمته وروحه، فعلّمنا التمرد والكبرياء على كل ما هو زائف ومخادع حولنا. أستاذ أنسي بالنسبة لي أكثر من أب، هو الأمل الذي كنت ألجأ إليه ولسنوات طويلة، كلما أحزنتني الشدائد أو أغلقت الحياة بابها في وجهي.
فكيف أنسى استقباله الأول لي في العام 1986، وكانت الدنيا حرباً وقنابل؟ يومها، قرأ مقالتي الأولى (أمامي) بغية نشرها لاحقاً في النهار العربي والدولي التي كان يرأس تحريرها: لماذا الخوف، قال لي؟ الكاتب لا يخاف! سنصحّح ونصحّح الى أن تستوي الأمور». ولا أغالي إن قلت أن أستاذ أنسي علّمني الكثير. علّمني كل شيء في سنواتي الصحافية الأولى: أي كتب أقرأ، أي كلمات أي أسلوب وأي تمرد؟ غالباً ما كنت أشعر أنه كان ولا يزال أستاذي الأول والأخير.
في العام 2006، عدنا والتقينا، إذ منحني الله مكافأة أن أعمل معه مجدداً ولسنة كاملة في مكتب واحد، فاسترجعته صديقاً وزميلاً ومعلماً، ولا أزال أذكر حتى هذه اللحظة حضوره الملائكي، خفره، نصائحه، تصحيحاته وإضافاته وكم كان يفرح من تسميتي إياها: «الإضافات الأنسية».. وفي المساء، كان يعود الى بيته سيراً على الأقدام الى أن فاجأني في اليوم الأخير: سأترككم لأنتقل الى جريدة الأخبار.
أستاذ أنسي، سنظل، تريز عواد وأنا، نسهر معك ونتابع ليلك الطويل، من فوق شرفتها العالية، تطل على نافذتك الحمراء المغلقة دوماً على أسرار الكتابة لديك والشعر والنبوءة. هي الصديقة المشتركة تقول لي كلما زرتها وزرتك في مساءات الأشرفية الطويلة: تعالي نشرب القهوة مع أنسي. هكذا كانت لقاءاتنا الأخيرة بعد المرض والإنكفاء: من وراء النافذة. وهكذا ستبقى.
أستاذ أنسي: سافر. لطالما عشقت الأسفار والبلدان البعيدة. سلّم لنا على كل من سبقوك الى غيابهم الموجع، وأنت تعرفهم جيداً.
الى أن نلتقي.. سأشتاق إليك كثيراً.. يا أبي.
غداً أشرب القهوة وحدي
جوزف عيساوي
(شاعر واعلامي )
كان يعبر المدينة طيفاً من الجسد. بذلة سوداء، قميص أبيض. وعينان مصوبتان الى الداخل. أنده عليه. أنسي. يرفع رأسه الى فوق مفتشاً عن الصوت. كأنما البشر يعيشون بين السحاب. فوق أغصان شجرة. أو في الآفاق البعيدة. لعله يتمناهم هناك. وهو على الأرض تحت. أو العكس. لعله عرف استمالة اللقاء مشقة الأخوة. وهم الحب. لذا بالغ في العشق تارة. والوحدة تارة. حتى الكلمات لم تخدعه. عجنها بالحبر والورق وعافها.. ترفق بها ثم جافاها. أنسي الحاج كان يعبر الساحة كما عبر الشعر وصفحات الجرائد التي أدار. وحيداً مستوحشاً. وبارقاً في مرضه. في المرحلة الحرجة منه. كنت أشرب القهوة معه. هو في بيته القريب. وأنا على طاولة المقهى. غداً أشربها وحدي.
أنسي كم كنت شبيه نفسك في الحياة. وكم لن تشبه من الموت إلا إحدى حبيباتك. تلك التي تبكيك اليوم. بقطرات المطر.
جودت فخر الدين
(شاعر وباحث)
للشاعر أنسي الحاج مكان بارز في الخارطة الشعرية الحديثة، وغيابه سيترك فراغاً كبيراً. ما أعرفه عنه ولو من بعيد، دماثته ورهافته وجهده، لقد أقام مملكته الخاصة بعيداً عن الزحام والتزاحم والافتعال. الى ذلك، كانت له لغته الشعرية المميزة التي تركت أثرها في الكثيرين من كتاب قصيدة النثر. قد أكون في موقع شعري مغاير، ولكن من موقعي هذا أعبّر عن إعجابي وتقديري لتجربة أنسي الحاج في الشعر والنثر.
رشا الأمير
(كاتبة)
… له لازورد هذه السماء
سقطت نجمة
شكيب خوري
(شاعر ومسرحي)
في لبنان سقطت نجمة ليست من العالم المعروف بل من عالم سيكتشف. أنسي كان درباً الى الحداثة، الى الشعر ما بعد الحداثة. كيف؟ لأنه يستشف كنجم كشمس ما وراء الغيم، يبحث عن الحقيقة لأنه شفاف. يشرب الماء ليطهّر نفسه وجسده ويرحل مع روحه الى الأعلى حيث الشعر.
أحب أن أضيف بأنه صديق ينسجم وفي الوقت نفسه ينسحب. لماذا الانسجام والانسحاب؟ الانسجام ليعانق الآخر، والانسحاب ليعود الى وحدته، الى ذاته، ويتصالح مع الكون، مع الواقع، مع الحتمية التي سقط فيها اليوم.
دواوينك مزارات
يسرى المقدم
(باحثة)
أنسي الحاج ذهبت الى الموت لا اكتفاء من الحياة ولا ضجراً منها، بل سأماً بجسد كرهته لأنه صار يشبه قبراً، على ما عبرت حرفياً ذات نهار سبت. ذهبت أنسي الى الموت مكللاً بدواوين شيقة مترعة بالجمال.
دواوين سنجعلها مزارات نؤوب إليها، كل ما اشتقنا إليك أنسي.
من وداعك نهيل عليها الشكر.. ونكثر.. لأنك الشاعر الذي اصطحبنا الى دهشات لا تحصى ونبادلك بالحب ونكثر أيضاً. ألست القائل نتقدم لأننا في الحب.
المعلم
كوليت مرشليان
(صحافية )
الشاعر أنسي الحاج لم يعد من هذا العالم… أن تكتب عن شاعر في رحيله ويكون هذا الشاعر هو «المعلم» و»الأستاذ» الأول فلن تعرف من سيسبق الآخر فوق الورقة البيضاء: الحبر أم الدمع؟
الشاعر انسي الحاج لم يعد هنا: فهل بيروت ستبقى بيروت؟ ستفتقده المدينة في بعدها الثقافي وفي بعدها الشعري العميق… وداعاً أستاذ أنسي الحبيب… في قصيدة لك كتبت: «ها هو العالم ينتهي والمدن مفتوحة… المطر أبيض… الأصوات بيضاء… قلبي أسود بالوحشة ونفسي حمراء… لكن لوح العالم أبيض والكلمات بيضاء». وهل «هناك» يشبه ما وصفته؟
ملاك الشعر فوق رؤوسنا… والقصيدة غمامة حب إلهية.
كان أنسي الحاج مدينة!
يقظان التقي
(صحافي )
كان انسي الحاج مدينة
كم بقي من هالة بيروت التي تعرفها؟
مجرد الأسم، الاسم الصعب، ناراً فوق الجبل والرجل الغامض وراء مكتبه في «النهار» يشعل سيجارة، ويكتفي بالرد بأجوبة مقتضبة على اسئلتي المعقدة والمكثفة أصلاً.
ما كان نجماً مثل النجوم العاديين في البلد.. ولا قمراً عادياً، يطل في الليال الاستثنائية. كانت احتفالية بيروت به في «مسرح المدينة» منتصف التسعينات أمراً معقداً جداً للغاية في المكان الذي شغلته الناس إلى آخر كرسي وزاوية إلى آخر ذرة هواء في المسرح العائم بالصبايا والشباب حتى الشارع والبحر إلا قليلاًّ! بالوجوه والنظرات، والأجساد المكتظ كجهاز عصبي حساس واحد أمامه وخلفه وعلى يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته.
كأنه الملك! كأن الشعر تحول الى جمهورية، بشغف الهواء الجديد وبهيولى المادة الشعرية والكلمة وبشبق الحرية ولطائف الأزاهير والحب والمؤانسة بأنفاس اختيرت حالة ايقونة شعرية.
الى الآن ما زلت أبحث عن ظلي بين الصور، الجسد على الارض، نحن «الهنود الحمر» الذين نفترش الى الآن ارض الشعر ونصغى الى اصوات مدينة بعيدة، حيث الثورة وحيث كبرنا في مؤانسة مدينة لم نعد نعرفها جيداً.
رفض التقليد
(…) إنني اعزو هذه الغرابة في التعبير عند انسي الحاج ونعت هذا التعبير بأنه غير عربي، الى كون انسى الحاج قد ادخل الى المفردات الشعرية العربية تعابير غير متداولة في الشعر. وهو لم يدخل فقط الفاظا جديدة. بل انه اغنى القاموس الشعري العربي اذا صح التعبير بمفردات ادخل الكثير منها دفعة واحدة فظهرت غريبة خارجة على المألوف. لكنه لم يكتف بادخال مفردات جديدة على التعبير الشعري العربي: إن الكلمة التي حملها، قد حملها اكثر مما تعودنا ان نرى. اللغة في «لن« تنفجر بمعان غير مألوفة، وهي موضوعة في سياق غير مألوف، هذا هو وجه الغرابة.
لولا الشعر تموت اللغة، تموت بالفعل. ومن هذا المنظار، اهمية «لن» انها ادت خدمة كبيرة في احياء اللغة وتجديدها. وهذه الناحية تنعكس بدون ريب، على طبيعة شعر انسي الحاج وموقفه من الحياة. لقد رأينا انه رافض. وهكذا رفض التقليد، رفضه شكلا ومضموناً.
يوسف الخال
أحبه شاعراً
الحرب قد لا تبكيني. اغنية صغيرة قد تبكيني، او كلمة لأنسي الحاج. هو توأمي (…) احترم انسي الحاج لانه بقي في بيروت تحت القصف، وأحبه شاعراً شاعراً وناثراً وصامتاً.
محمد الماغوط
لفتة متوهجة
انسي الحاج رفع قصيدة النثر الى مستوى الشعر الحقيقي. فلغته لغة حضارية، لماحة، متوهجة، ناضرة، شفافة. انسي رفيقي على درب الشعر الطويل، وانا فخور بكل كلمة كتبها او سيكتبها. انه نموذج للشاعر الحقيقي حيث يلتقي الشعر والرسولية في جسد واحد. إني احبه وأحلم دائماً ان اقتني واحداً من خواتمه.
نزار قباني
المملوء بالقصائد
والشاعر الذي يشبه الشاعر، الشاعر الذي يشبه أنسي الحاج، هو ذلك الشخص الذي يمكن أن نسمعه يحدث نفسه: أنا الرجل المملوء بالقصائد، أنا الرجل الذي سوف تخرج القصائد كلها من جسدي، أريد أن أمشي، أريد أن أفرغ جسدي مما يملؤه، ربما ساعتها أستطيع أن أطير. ولكن الغريب أن القصائد عندما تخرج، تخرج ناقصة، تاركة ذيولها التي تنمو مجدداً. حتى الآن لم أستطع أن أستمتع بجسد فارغ. حتى الآن لم أستطع أن أطير. ولما يصمت أنسي، تطاردنا الأمثال والأقوال، أنسي هو الأنقى بيننا، هذا ما ورد في رسالة أدونيس الى خالدة. كان أنسي في أثناء ذلك هو الشاعر الإنسان الهدام بامتياز، الراديكالي بامتياز، السريالي بامتياز أيضاً. بدأ من كتابه «لن» باحثاً عن بئره العميقة، وعن حريته وعن الوجازة، وعن التوهج، وعن المجانية. بدأ أيضاً باحثاً عن الكثافة، كثافة الصياد والفريسة، في ثقافة تحتفل دائماً، بالصياد فقط، ثقافة ذكورها ذكور، وإناثها ذكور. أنظر الى آخر نجومها الشعريين، استمر أنسي حتى ثمل وبلغ بسكرته «الرأس المقطوع» كتابه الثاني، وبعدها بلغ ذروته في الماضي، ماضيه هو، أو «ماضي الأيام الآتية». رأى أنسي ضرورة أن يخون، ونظر الى التقليد الشعري، وخانه، باعتبار أن هذه الخيانة عمل طبيعي، فعلاقة شاعر أيامنا بأسلافه الجاهليين الأمويين العباسيين النهوضيين هي علاقة إخلاص لا تصح إلا إذا انقلبت وأصبحت علاقة خيانة.
عبدالمنعم رمضان
حياة
ولد انسي الحاج عام 1937 في جزين. بدأ ينشر قصصاً قصيرة وابحاثاً وقصائد منذ العام 1954 في المجلات الادبية، وهو لما يزل بعد على مقاعد الدراسة الثانوية. دخل الصحافة اليومية («الحياة» ثم «النهار») العام 1956 كمسؤول عن الصفحة الادبية . في العام 1957 ساهم مع يوسف الخال وادونيس في تأسيس مجلة «شعر». واصدر في العام 1964 «الملحق» الثقافي الاسبوعي لجريدة «النهار«، والذي ظل يصدره حتى العام 1974. ترأس تحرير جريدة «النهار» منذ العام 1992 حتى 30 ايلول 2003، والى جانب ذلك تولى رئاسة تحرير العديد من المجلات، ومن بينها «الحسناء» 1966 و»النهار العربي والدولي» بين عامي 1977 و1989. ترجم الى العربية اكثر من عشر مسرحيات لشكسبير ويونيسكو وكامو وبريشت وسواهم، وقد مثلتها فرق مدرسة التمثيل الحديث (مهرجانات بعلبك) ونضال الاشقر وروجيه عساف وشكيب خوري وبرج فازليان.
ترجمت مختارات من قصائده الى لغات عدة، وصدرت له بالفرنسية في باريس لدى دار «اكت سود» عام 1997 انطولوجيا :الابد الطيار» (اشرف عليها وقدم لها: عبد القادر الجنابي)، وانطولوجيا «الحب والذئب الحب وغيري» بالالمانية مع الاصول العربية في برلين عام 1998 (ترجمة: خالد المعالي وهربرت بيكر). في نيسان 2007 صدرت اعماله الكاملة في طبعة شعبية (ثلاثة مجلدات) ضمن سلسلة «الاعمال الكاملة» التي تصدر لدى «هيئة قصور الثقافة». وكان يكتب مؤخراً زاوية اسبوعية في جريدة «الاخبار» اللبنانية تحت مسمى «خواتم 3».
له
شعر: «لن» 1960، «الرأس المقطوع» 1963، «ماضي الايام الآتية» 1965، «ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة» 1970، «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع» 1975، «الوليمة» 1994.
ثثر:
«كلمات كلمات كلمات» (ثلاثة اجزاء) 1988، «خواتم 1» «خواتم 2» 1997.
منتخبات شعرية ونثرية
منتخب «الرأس المقطوع» 1963
الفيض
ذهب غراب
يحوم فوق المسك الممضوغ والأجناس المطفأة.
اشعل الغلام المطل لفافة الاستمناء الكبيرة.
كلما احببتهم وقعوا من القطار
ابدال يديها بالضحك، وما هي إلا نصف ارتباك. لم يشعر به الفارس من قبل.
كانت الصالة مغنية تجهل الرجال وتؤجل الحكم في هذه القضية. وقفز الخادم يتوجه شعر رومنتيكي وبارك تلك الشجاعة وغادرها دون أن يضيف شيئاً.
المساكين!
كلما أحببتهم وقعوا من القطار!
وتوردت وجنتا الصالة وصاح الفارس: بحاجة الى عذر!
انه العصر الطويل، المناطيد تنأى بالحجارة. وشاء القدر ان الفارس وقع في حيرة
فاعترفت له المغنية بقلقها وقالت: اريد أن افهم..
وكبرا في الدير. غلب اليأس على المعجبين ورأت المغنية ان نبأ المغامرة سيزدهر،
وسمعت وقع حوافر عصي فقالت بحماسة: حسناً!
ولم يكن الفارس ناوياً ذلك، لكنه صاح فوق يديها: تقيمين طويلاً هنا؟
وراح يتحدث عن شيخوخته بعبارات بيضاء أي بلا حب فلم تسمع المغنية.
وانقضى النهار ساحراً تضحية جديدة.
إلى الغد يا أعزائي!
منتخب «ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة» 1970
ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة
قولوا هذا موعدي وامنحوني الوقت.
سوف يكون للجميع وقت، فاصبروا.
اصبروا علي لأجمع نثري.
زيارتكم عاجلة وسفري طويل
نظركم خاطف وورقي مبعثر
محبتكم صيف وحبي الأرض.
من أخبر فيلدني ناسياً
الى من أصرخ فيعطيني المحيط؟
صار جسدي كالخزف ونزلت أوديتي
صارت لغتي كالشمع واشعلت لغتي،
وكنت بالحب.
لامرأة انهضت الأسوار فيخلو طريقي إليها.
جميلة كمعصية وجميلة
كجميلة عارية في مرآة
وكأميرة شاردة ومخمرة في الكرم
ومن بسببها اجليت وانتظرتها على وجوه المياه
جميلة كمركب وحيد يقدم نفسه
كسرير اجده فيذكرني سريراً نسيته
جميلة كنبوءة ترسل الى الماضي
كقمر الأغنية
(…)
أعيروني حياتكم لأنتظر حبيبتي
أعيروني حياتكم لأحب حبيبتي
لألاقيها الآن وإلى الأبد.
لكم أنتم لتدق الساعات
لا تكبراً وحده
بل لأني كنت شاعراً
فكنت عهد الكآبة اسمي
(…)
منتخب «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع» 1975
… كتبوا الكتب ولفني هتاف عظيم
فلماذا أصعد؟
وحين مررت فوق الجبل وانحنيت
أدركت أن أحداً لم ينحن من قبل
فوق هاوية.
ولم تقولي اصعد
ولكني صعدت
لأنك عالية.
وحملت الهاوية
فلما رأتك اعتمدت في نهر الاردن.
وغيرتني
كزنبقة ارتميت عند قاعدة عرشك
أنت الملكة وأنا الفقير
وماذا الملكة تطلب من فقير
وأية تضحية ولم تفعليها
وأكبر تضحياتك أنك أجمل النساء
كيف أعطيك فلا يغرق عطائي في عطائك
وماذا أعطيك
يا صمت تفجر العطاء؟
ما اقل حبي بظنونه كالسيل ولكني عرفت ان صوته اكبر من صمته.
ما أهديتك شيئاً الا اهتدى بك.
كم افهم الآن شهوة الماءة أن تذوب في المحيط، شهوة المملوك أن يملك أشد، شهوة الغارق ان يغرق أعمق، وكم افهم حسرة الظل انه لا يقدر ان يصير أكثر ظلاًّ!
يا امرأة الأصل والبينات
ماذا أعطيك؟
تلوحينني بالضوء وتذرينني في الطيبة
تشمسينني في الحقول العالية
وتجعلينني تيناً وعنباً لتفرح بي العصافير.
(….)
منتخب «خواتم1» 1991
بعضهن تلفظهن النشوة الى شاطئ السرير كما يلفظ البحر سمكة لتموت.
كل المطارح ادعى من السرير للمداعبة.
الوقت هو ما بين انلفاظ الشهوة وتكونها من جديد.
من السمات المشتركة بين التجربة الشعرية والتجربة الجنسية انهما كلتاهما تغرزان بصمات دامغة على لحظة لم تكن تريد أن يدمغها شيء!
سأسكت وأنا أموت لكن وجهي سيظل يسأل: لماذا؟
هل يستطيع الله ان يبطل إلهاً
من تراه يأوي الشعر؟
يطل الشاعر برأسه خجلا، وجلاً، ويتساءل كالآبله: من، ترى، يفكر في، بعد، في هذه الدنيا..
ويحن الشاعر الى الشعر.
الشعر؟
كأن كل لحظة في ايامنا تبهرنا عنه، تشلحنا تحت عجلات الموت والحياة، وتنفش أجسامنا وأرواحنا بالقش. وما نحن بلا الشعر.
إني أنظر إلى ما أكتب، إلى ما يكتب، وابحث عن الشعر (…)
ويبدو كأن الأطفال انفسهم احمرت عيونهم من الدنيا، وصاروا رجالاً مبكرين. صاروا كباراً شرايين ايديهم غليظة وأعناقهم كالفولاذ. كأن الأطفال ادركوا اننا نعتبرهم اطفالاً لكي نضطهدهم، لكي نضطهدهم باحلامنا فيهم. فوقفوا فجأة في الزمان ورفضوا هذه المسؤولية!
ترى، ايريدون أن نكون نحن عنهم طفولتهم؟ ومن يكون طفولتهم في هذا العالم المجنون؟ من تراه يرضى، ولا وقت عند أحد؟
من تراه يأوي الشعر، وقد أخلى الصغار والكبار سبيله؟
عبدالمنعم رمضان عن أنسي الحاج: أنا شقيقه المصري
القاهرة ـ خاص
الشاعر المصري عبدالمنعم رمضان ارتبط بعلاقة وثيقة بالشاعر اللبناني أنسي الحاج رغم أنهما التقيا وجهاً لوجه منذ ثماني سنوات فقط. هنا يسرد لـ24 جانباً من تلك العلاقة الإنسانية الكبيرة.
حيَّاني في مرسم نجاح طاهر بقراءة قصيدة “أنت الوشم الباقي”
لم يسع أبداً إلى جائزة أو سفر أو شهرة.. وكان إحدى السماوات التي تقويني على ألا أتكالب على هذه الأمور
تعرفت إلى الشاعر الكبير أنسي الحاج في بيروت عام 2005، في هذا اليوم قامت الفنانة نجاح طاهر بإقامة مأدبة عشاء على اسمي، وسألتني إن كان بإمكانها دعوته، رغم أنها تعلم، بكل تأكيد، أنه لا يقبل مثل تلك الدعوات أبداً، وقلت لها إنني أحبه جداً فلم لا؟، وعندما أبلغتْه قال لها ببساطة “سآتي”.
التقينا في مرسمها، وأذكر أنه كان معنا عدد من الكتاب والمثقفين الكبار، ومنهم الناقد محمد دكروب، والروائية علوية صبح، وفاجأني بجماله الإنساني الكبير، صحيح أن شعره فيه وحشية، لكنه كشخص خال من الوحشية تماماً، وقد أسمعني في تلك الليلة من ذاكرته قصيدة “أنت الوشم الباقي”، ويبدو أنه قرأها ليحييني، وكانت تحية فوق العادة. بعدها بدأ الحضور يراقبوننا، ولاحظوا أننا لا نُكمل جملنا، كأن كلاً منا يفهم ما يقوله الآخر بدون أن يكمله، وقد أخبروني بذلك بعد اللقاء.
وقفنا على باب المرسم، وقال لي كلمات لا أزال أذكرها بحذافيرها: “أتمنى أن تكون صورتي التي رأيتني عليها كما تخيلتها”. كان أنسي الحاج رئيساً بتحرير جريدة “النهار”، وفي لعبة من ألعاب الصحافة قدم استقالته منها، وكانت جريدة “الأخبار” اللبنانية على وشك الصدور وقتها، برئاسة تحرير جوزيف سماحة، حسبما أذكر، وعرفنا منه وقتها أنهم طلبوا إليه أن يكتب صفحة أسبوعية. كان يستشيرنا في ذلك، وقد ظل يكتبها بانتظام حتى قبل وفاته بشهر.
أريد أن أنوه إلى مقالته الجميلة في 25 يناير عن الربيع العربي. أهداها إليَّ قائلاً: “إلى عبدالمنعم رمضان بالطبع”، وقبل أن يموت بمدة وجيزة كتب سلسلة من المقالات بعنوان “حميمية”، يودع فيها أصدقاءه ذاكراً إياهم بالاسم، وخصني بلقب أحبه هو “الشقيق المصري”.
لقد اتفقت في فترة ما، كان فيها أحمد مجاهد مسؤولاً عن سلاسل النشر بهيئة قصور الثقافة، على أن نطبع أعماله الكاملة، ولكنه رفض خوفاً من أن يتم تشويهها، بسقوط مقاطع أو بحذف أخرى أو بأخطاء نحوية وإملائية، ولكنني لكي أطمئنه اقترحت عليه أن نصوِّر النسخة اللبنانية تصويراً، أي أننا لن “نجمع” مجدداً، وهذا هو ما سيضمن عدم تشويه الأعمال وصدورها بالشكل الذي يروقه، ووافق، على أن يتنازل عن حقوقه المادية أسوة بما فعله أدونيس وسعدي يوسف الذي كنت وسيطاً بينه وبين الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولكن مع الأسف لم تصدر تلك الأعمال. أقصد أعمال سعدي. وعودة إلى أنسي أرسل إليَّ خطاب الموافقة والتنازل عن المقابل المادي، وصدرت الأعمال في ثلاثة أجزاء حسبما أذكر، ثم حُجبت، بسبب وشاية أحد العاملين بالمخازن الذي قال لرئيس الهيئة وقتها إن هذه الأعمال تحتوي على عبارات مسيئة للذات الإلهية وللأديان وستفتح عليك أبواب جهنم، ولكن لحسن الحظ أن أحد الأصدقاء شاهد تلك الأعمال في معرض القاهرة للكتاب الماضي، ما يعني أنهم قرروا الإفراج عنها مجدداً.
هذه العلاقة لا يمكن نسيانها، وهو دون كل الشعراء العرب بالإجماع، لم يسع أبداً إلى جائزة أو سفر أو شهرة، وكان إحدى السماوات التي تقويني على ألا أتكالب على مثل تلك الأمور، وهذه السماء سقطت برحيل أنسي الحاج.
أنسي الحاج… شاعر الدهشة والمجازات البسيطة
بيروت ـ ‘القدس العربي’ ـ من زهرة مرعي: تستكمل ‘القدس العربي’ نشر شهادات لشعراء لبنانيين وعرب في الشاعر الراحل أنسي الحاج الذي يعتبر من رواد الحداثة في الشعر العربي.
العابر للأساليب واللغات
وقد قال الشاعر اللبناني شوقي بزيع في الراحل: قد يكون رحيل انسي الحاج بالنسبة لي أقسى وأفظع ما واجهته خلال عمر تجاوز الستة عقود من الزمن، ليس فقط للصداقة الوثيقة التي ربطتني بأنسي والتي حملت أكثر من معنى وأكثر من دلالة باعتبار أنه من الطبيعي أن تكون صداقة بين متشابهين، لكن أن تقوم صداقة بهذا العمق وهذا الدفء بين متغايرين في الكتابة والأسلوب، فهو يعطي أمثولة حقيقية في قيام الصداقات. ويشهد لأنسي أنه كان عابراً للأساليب واللغات ولطرائق الكتابة والعيش، ومتصلاً بالانسان في أعمق ما يملكه وأعني به القلب. استعيد من خلال انسي الآن تلك الأناقة الباذخة في جسده وروحه. استعيد تلك الهامة المرفوعة، تلك الابتسامة التي سرعان ما تتحول إلى قهقهة عالية تشيع طاقة على الفرح أينما حلّت. وأستعيد من خلاله ذلك الوفاء لمن عرفهم.
استعيد تواضعاً، ودماثة، ومعشوقاً من الصغار. ذلك أن الكبار يمكن أن يخطئوا في حدوثهم وفي نظرتهم بعضهم إلى بعض، لكن الأطفال لا يخطئون أبداً، ويتصلون بأرواحهم البريئة والمجردة بمن يشعرون فيه محباً لهم، وهو ما كانت عليه الحال مع أنسي الحاج. بالنسبة لأنسي على الصعيدين الوطني والأدبي أرى فيه جزءاً لا يتجزأ من صورة لبنان التي طالما حلمنا بها، والتي عرفنا بعضاً منها في الستينيات، وكان شكل انسي نواة صلبة لها، وجزءاً من متنها وإطارها في آن. كلما فكرنا بأنسي الحاج فكرنا بتلك الصورة الزاهية بالمعنى اللبناني. فكرنا بالشعر المغاير والمختلف، وباللغة الثرية المتجددة. فكرنا بالمسرح والسينما والتشكيل. وبالمسرح الغنائي الرحباني وبصوت فيروز الذي احتفى به أنسي كما لم يحتف أحد بأحد.
ويجب أن نقول ان اللغة العربية قبل انسي الحاج لم تكن كما أصبحت بعده. بمعنى أنه سحب منها كل الزوائد. حماها من الترهل والانشائيات الرخوة، وأعادها إلى نصابها الحقيقي، حيث الجِدة والمغايرة والاختلاف. ليس فقط لأنه كان رائداً في قصيدة النثر، بل لأن قصيدته النثرية قد تأسست على غير قاعدة أو منوال. شعره كان غير مسبوق في حينه. حينما أحس أنه ذهب للحدود القصوى للجِدة وللحداثة، ومخافة من أن يتصل بالعدم المطلق أو بالصمت المجرد، أو بالقطيعة الكاملة مع المعنى، عاد في أعمال لاحقة مثل ‘ماذا صنعت بالذهب والرسولة والوليمة’ ليقيم مصالحة حقيقية بين الخيال السريالي والخيال التجريبي، وبين القلب المتدفق عاطفة وحنواً. وهذه المصالحة لم تكن لتتم لولا أنه وجد في الأنوثة الركيزة الأساسية للكتابة. أي أن الأنوثة أعادت إليه ذلك الالتحام الحقيقي بمادة الحياة. ولا يمكن أن تكتمل هذه الصورة أو هذا البروفيل لأنسي الحاج دون أن أعرج على نثر أنسي الذي يعتبر انجازاً وحده، أو يعتبر فريداً في بابه. هذا النثر كان من القوة وكان من الصدق ومن الإلتصاق بالحياة بحيث تحولنا جميعاً إلى مريدين له. بات له عشاق كثيرون ينتظرونه منذ أن كان أنسي يكتب في مجلة الناقد وقبلها في ملحق النهار وفي النهار ووصولاً إلى جريدة الأخبار، حيث باتت مقالته تنتظر انتظار بعض المذاهب لمهديها. ويجب أن أقول هنا أن كل من كتب مقالات دورية في الصحف كان يمكن الاستغناء لهم عن نص أو نصين. كان يمكن أن لا نقرأهم في هذا اليوم أو ذاك، وأن نستعيض عما فقدناه بقراءتهم لاحقاً. وكان بعضهم يكرر ما كتبه في وقت سابق إلا انسي الحاج فقد كان جديداً باستمرار، وراهناً باستمرار، ومليئاً بالشغف وبالحنو وبالدهشة، بحيث أنه استطاع بكلمات بسيطة ومجازات بسيطة أن يقدم لنا الحياة على طبق من شراينه وأوردته. كان يكتب بالسكين، وكان يكتب أيضاً بالأنفاس وبالأظافر. ولذلك أستطيع أن أقول الآن بأن لبنان ما بعد أنسي الحاج هو ليس لبنان ما قبله. وبأن اللغة العربية ما بعد أنسي الحاج هي ليست لغة العرب ما قبل أنسي أيضاً.
قصائد لا تموت
الشاعرة الشابة ومقدمة برنامج صوت الشعب والتي استضافت قبل سنتين الراحل انسي الحاج في حوار مطول على حلقات لوركا سبيتي قالت في معرفتها به: في سنة 2002 كان تعارفي الأول مع انسي الحاج، وهو أول من نشر لي شعراً في جريدة النهار، وشجعني، وأصر على استمراري في الكتابة بالجرأة التي أنا عليها، وبأسلوبي نفسه. لقائي الثاني معه كان في سنة 2012 من ضمن برنامج صوت الشعب في حوار شامل عرّفني إلى أنسي الحاج الإنسان، والذي هو خلف الشاعر. تعرفت إلى أنسي الحاج الذي لا يعرفه أحد، الطفل، المراهق، اليتيم، الزوج، الخائن، الصادق، المقامر. تعرفت إلى انسي الحاج الصفة التي تؤكد إيجابياته وحسناته، وكذلك هي كانت صفة تؤكد أنه انسان ولديه سيئات أيضاً. في خلال هذا الحوار ظهر كم هو صادق وحقيقي ولا يتخفى أبداً خلف أية قصيدة أو خلف أي مجد وصل إليه.
في هذا الحوار مع أنسي الحاج أسقط عليَ هذا الشعور بالشفافية والصدق. مع أنسي الحاج لا لعب بسؤال أو جواب أو دوران حول المطلوب، بل بكل سلاسة يبوح. خسارة غياب أنسي الحاج ليس كشاعر فقط، فقد تعلمنا أن الشاعر يموت وتبقى قصائده، بغض النظر عن كونه شاعراً فهو كإنسان صاف وحقيقي وجميل، في زمن تعم البشاعة على كافة تفاصيل حياتنا.
فقدان أنسي الحاج الجميل في هذا الزمن هو فقد صعب جداً. بكل بساطة هو مات وكل حي سيموت، ولا نستطيع حيال هذا الشيء إلا أن نحزن. هو بموته سمح لنا أن نحزن غير الحزن المقتفي أثر العابرين عليه، إنه الحزن الذي يأخذنا إلى انسي الحاج الحياة والكلام الذي لا يمضي.
اناقة الشعر
ايمان حميدان
من الصعب ان انسى المرة الاولى التي التقيت فيها بالشاعر انسي الحاج. رغم انه كان لقاءً قصيرا الا انه بقي في مكان ما من وجداني وحرّضني أكثر على الكتابة. كان ذلك عام 1993 سنة واحدة بعد عودة ملحق النهار الثقافي الى الصدور بإدارة الروائي الياس خوري.
كنت قد عدت من قبرص حيث اقمت لمدة ثلاث سنوات بعيدة عن بيروت، وهناك بدأت بنشر القصة القصيرة في جريدة ‘الحياة’ وثم في ملحق النهار. كانت الكتابة ما زالت بالقلم وعلى ورقة بيضاء ولم يكن الكومبيوتر أليفا لنا بعد. أمر من الصعب أن أفسره الآن لإبنتي. وصلت قبل الظهر إلى مكتب الملحق لزيارة الياس خوري ولم أجده في مكتبه. أطلّ أنسي الحاج على باب المكتب من مكتبه المجاور يسألني ان كان بإمكانه مساعدتي ودعاني الى مكتبه. لم أكن قد التقيت بأنسي الحاج سابقا لكن وجهه كان بالنسبة لنا، نحن الذين بدأنا نتلمس بدايات النشر نثرا ام شعرا، أليفا وودودا ولم يكن يحتاج الى تعريف. أذكر الوان البني والنبيذي التي ميّزت ثيابه، فقط ياقة قميصه الزرقاء لوّنت خريف ملابسه. جلست وفي يدي القصة التي أتيت لأنشرها في الملحق. طلب قراءتها. ثم جلس امامي صامتا وراح يقرؤها.
أحببت انكبابه على القراءة، قراءة قصتي، وعلى عزلته في مكتبه ذلك النهار. بدا لي شاعرا حقا، شاعرا بعيدا عن العلاقات العامة التي امتهنها بعض الشعراء. كانت القصة تحكي عن امرأة ما زال هاجس الحرب يقلقها رغم انتهائها. كذلك ما زالت تعيش حبا رغم غياب من احبت. انها قصة عن الوهم الذي يساعدنا على تحمل وجودنا وحياتنا. كانت بعنوان ‘سوء تفاهم’. رفع أنسي الحاج رأسه وقال لي معلّقا أن الكتابة هي هكذا، تخرج من سوء تفاهم مع الواقع، وإذا انتهى سوء التفاهم هذا أتت الكتابة مسطحة ناعمة خالية من أي معنى، ثم تابع مبتسماً ‘كذلك الحب يولد دائما ويستمر بسبب سوء فهمنا للحبيب’.
‘ روائية لبنانية
لنواصل اكتشاف انسي الحاج
عبد الوهاب الملوح
حقيقة لا اعرف ماذا أقول كلما سمعت برحيل شاعر كبير انتابتني حالة من الهيستيريا والصمت المفاجئ وغصة في الروح وفي الأصابع، أتحجر كدمعة ولا استطيع الحراك وكما ان حركة الكون توقفت، وأفتقد الإحساس بي، ينعدم كل شيء من حولي وكأني شبح في صورة فوتوغرافية على جدار آيل للسقوط.
حدث لي هذا مع خبر محمود درويش ومع خبر المسعدي والان مع خبر رحيل انسي الحاج ، بل إن وفاة الكبار والعظماء من رجال السياسة لا تعني لي شيئا على الإطلاق، سأقول أيضا إن الأمر نفسه لا يصيبني حتى عند فقدان احد أقاربي، رحيل شاعر يعني موت شيء في داخلي، في كل مرة يموت فيها شاعر يموت شيء مني، لست حزينا ولكنني مهزوز ولكنني مطعون، لست مهزوما ايضا ولكنني أريد إن أعرف أي قبر بإمكانه ان يكون له مقاس كل هذا الحب قال عنه أدونيس هو الأنقى فينا جميعا وقال عن نفسه :
‘أشعر أحياناً أنّي أكتب من وراء الكتابة كصوت من ينطق من وراء الموت’هو عراب الشعر العربي الحديث ترك كل الأبواب مفتوحة وطار إلى القصيدة التي لطالما طاردها من زمن، هو وريث جبران خليل جبران وحفيده الأوفى والأوحد ؛نبي الكلمات اللقيطة الشاعر المتوهج في الصمت المحارب في ساحات الحب من اجل الحياة الذي رسم بحزنه آلاف البسمات على جدران الأرواح المتصدعة وأعاد ترميمها بخواتمه المضيئة، حامل المشاعل في نفق العتمة الطويل، أنسي الحاج أول الشعراء نافخ الماء في زرقة السماء المعطلة، داهم الماء الآسن الذي كان يغرق فيه الشعر العربي، ودشن لغة جديدة في الكتابة الشعرية، بل هو أول من دشن الشعرية المغايرة، وقد كان الشعراء يعملون في فضاء الشاعرية، دخل للشعر من بابه الأوسع والأصعب وهو أن يحيا الشعر أولا وقبل أن يكتبه وعليه أن يمتلئ به من الشعراء العرب القدامى ومن الشعر الغربي، وهو أول من تصدى لترجمة الشعر الفرنسي الحديث في زمن تألقه رامبو وبودلير ولوتريامون، لوتريامون هذا الذي فتح زمنا مختلفا في الشعر وبقي مغمورا لزمن طويل.
كما يُحسب له انه أول من ترجم عمل سوزان برنار، هذا الأثر الذي أثار الكثير من الجدل وقد فتح عصرا جديدا في الكتابة العربية ؛ ساهم مع يوسف الخال وأدونيس في تأسيس مجلة شعر سنة 1957وأصدر سنة 1960مجموعته الشعرية الأولى ‘لن’ في منشوراتها وهي اول مجموعة قصائد تصدر تحت اسم قصيدة النثر، ثم تلتها مجموعة ‘الرأس المقطوع′ 1963 بعدها سنة 1965 أصدر ‘ماضي الأيام الآتية’ في سنة 1975 أصدر ‘ماذا صنعت بالذهب ماذا صنعت بالوردة’ لتجيء سنة 1975 مجموعة’ الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع ‘هذي المجموعة المثيرة للجدل شأنها شأن كتابات انسي دائما.
ثم اصدر ‘الوليمة’ سنة 1994 لكنه لم ينخرط في اللُغط الضاج الذي تورط فيه الكثير من الشعراء والنقاد حول قصيدة النثر وظل يكتفي بالكتابة الإبداعية إيمانا منه ان الشعرية الجديدة لا تحتاج الى تنظير ولا تحتاج إلى نظريات ومفاهيم بقدر ما تحتاج إلى مراكمة إبداعية. لم يكتب الشعر فقط بل كان متعدد الاهتمامات في الترجمة والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية.
هكذا هو الشاعر الحقيقي الذي لا يسجن نفسه في بيت أو أبيات ويتوقف عنده الإبداع هناك، بل كانت له الكثير من الآراء في الحياة الاجتماعية والسياسية وكذا كان رأيه فيما يحدث بتونس :
والآن تونس. ما أشبه التونسيّين بوجه صحّارة اللبنانيّين. إخوتنا من أيّام قرطاجة وأطيب منّا. لا يطالعك في وجوههم غير التمدُّن والنور. الآن ينعرونهم في اغتيال شكري بلعيد، شهيد اليسار العربي.
هكذا يرى أنسي الشاعرَ فاعلا ومتفاعلا دونما انفعال أو حياد دونما تخلٍ عن دوره الريادي وهو الطلائعي في مقدمة الريح من اجل الإعلان عن المطر في زمن القتل وزمن الجدب الإنساني لم يترك صاحب ‘لن’ فرصة تفوت عليه ليضم صوته لما هو إنساني بشري وليحول تراحيديته الكونية إلى فرح عنيف بالحياة ضد القتل الهمجي وضد كل ممارسات الإفناء كتب ضد كل ما هو طغيان، وانحاز الى صف الحب والجمال ‘لم يدفئني نور العالم بل قول أحدهم لي أني، ذات يوم، أضأت نورا في قلبه’ هكذا كان دائما يقول وسيظل كذلك فلم يكن متصوفا في صومعته كما نعته الكثيرون بل كان دائما مقاتلا شرسا بالكلمة في جميع الميادين، غير ان عمره انتهى وهو الذي قال ايضا : ‘كانت لي أيام ولم يكن لي عمر’.
لا يزال في انسي ما يجب اكتشافه لقد كان موسوعة فنية وطاقة ابداعية خلاقة فلا اعتقد انه مضى بل فتح لنا الباب مجددا لنحييه فينا إلى الابد.
‘ شاعر تونسي
انسي الحاج الحب عوض كل شيء ومكان كل مكان
محمد الهاشمي
لم يكن ليغلب أنسي الحاج الوقت، لكنه قرر لوحده أن يتحداه، وهو الذي قال حينما غيب الموت صديقه ورفيق أشعاره جوزيف حرب إن الأخير ‘قاتلَ الوقت حتى قتله لكن الوقت قبل أن يموت ترك له الحب’.
كان أنسي يعلم أن ‘أقسى ما في الأمر، عندما تتعذر الصلاة على صاحب المحنة، إذ يجف حلقه من فرط الفزع′ وأوصانا أن نصلي سلفاً، فباحتجابه تحت رداء المرض والألم نحن من كنا في محنة. الموت رداء كرهه لأنه أراد أن يبقى ‘عارياً’. ويبدو أن أنسي لم يعد يحتملنا، لذا فقد قرر الرحيل. ترك لنا شاهداً من شعر كتب عليه: ‘ما عُدتُ أحتمل الأرض، فالأكبر من الأرض لا يحتملها. ما عُدت أحتمل الأجيال، فالأعرف من الأجيال يضيق بها. ما عُدت أحتمل الجالسين، فالجالسون دُفنوا’. هكذا، قرر أنسي الحاج ألا يكون بيننا، وكللت رأسه ‘ريشة صغيرة تهبط من عصفور’.
ترك وقت أنسي الحب لنا نحن أيضاً، يحمله جميل شعره ونثره وتراجمه الخالدة، ولم يعد يعرفه إلا العميان ‘لأنهم يرون الحب’ كما قال في إحدى قصائده. أنسي عندما أحب كان الشلال الذي أعطى، وتواضع عندما وصف محبوبيه بالإبريق، وعدّ أن عطاء الإبريق أكرم لأنه أكبر من طاقة الشلال.
لم يكن السرطان وحده الذي سرق بعضاً من وقت أنسي، حتى إن كان قد شهد على أننا ‘في زمن السرطان: نثرا وشعرا وكل شيء’. كان الوقت ينزلق منه في آهات لبنان التي توجع لها ولحالها مراراً، كما غناها قصائد حب وعتب. وقد رفض هذا الفذ كل ما يمكن أن يقدس البراءة، لأنها لا تنتمي إلى حقيقة إنسانيتنا، رفضها ‘كأنها أتربة علقت بجسد من الأفضل أن يغتسل لنراه عارياً’ على حد وصف الشاعر عبدالمنعم رمضان. كان وهو يرى ما يحدث حوله يترقب عودة المسيح ليعري كل ما لم يعد بقداسته التي كانت فـ’الرهبان رهبان لأجل أنفسهم. الصليب نجم سينمائي. الأناجيل صارت كتاباً كجميع الكتب’.
لم يؤنس أنسي شيء أكثر من الأصوات، ففي نظره إن ‘بعض الأصوات سفينة وبعضها شاطئ وبعضها منارة’. لهذا، كان يرى صوت فيروز ‘السفينة والشاطئ والمنارة، والشعر والموسيقى والصوت’. ولما غنت له هبة القواس، شدت بكلماته ‘أغنيك حبيبي، من أجل أن ألامس حياتهم شيئاً مما تلامس حياتي’، ليوضح أن الصوت أيضاً أعمق عنده في الحب من ملامسة الجسد. ومما لا شك فيه أن الموسيقى كان لها شأن كبير في وجدانه، وقد رأى أنه ‘ليس بين الفنون ما يشبه الدين مثل الموسيقى.. لكنها دين بلا عقاب ولا حدود ولا عدو، و(تعصبها) يزيد الحرية’.
كان من المفارقة أن أتعرف أول مرة على نتاج هذا الشاعر العظيم من خلال ترجمته الشهيرة لكتاب أدولف هتلر الشهير ‘كفاحي’. أكثر ما لفت نظري كان اللغة والموسيقى الباهرتين، عكس كلٌ منها رشاقة قلمه وقدرته على مراقصة مشاعر القلق والغضب والكراهية والتعصب التي كان كتاب هتلر محملا بها. لا بد أن أنسي رأى في هذا الكتاب شيئاً ما دفعه نحوه، لربما أنه عُرْي هتلر الواضح في كل عبارة كتبها وهو يؤمن بها. ذلك العري حمله أنسي معه في ترجماته لمسرحيات شكسبير وكامو وقصائده النثرية التي نشرت في ست دواوين. بعد سبعة وسبعين عاما أضاء بها سماء الأدب العربي، ترك أنسي الحاج لنا إرثاً سنشتاق لتداعياته وعُرْيه كثيراً، وستهب دونه الريح التي ‘تذهب بالثلج، وبالثلج تعود’، بينما اتخذ شاعرنا آفاقاً عظيمة وجعلها حفراً. حفرة أخيرة اتسعت لجسد شاعرنا لتخلصه من وحشة الأرض، والآفاق بعد حبلى بعظيم إبداعه، لأنه اتخذ الحب عوض كل شيء ومكان كل مكان.
‘ كاتب وإعلامي إماراتي
أنسي الحاج وداعاً العراق يبكي طفولة الشعر
حسام السراي
بغداد | في علاقة الشعراء العراقيين بالشاعر اللبناني أنسي الحاج، استعادة لإطلالة كبرى على عالم من التجديد والحريّة في «زمن السرطان» كما عبّر عنها صاحب «لن» ذات مرّة، يوم شهدت أكثر من عاصمة عربيّة، من بينها بغداد وبيروت، تقديم نماذج رائدة في الكتابة وتأسيس الجماعات الطليعيّة في الأدب والفن.
وداعه عند شعراء العراق كان في منزلة وداع لروح من أرواح الحريّة التي تبدّت في كتابات الراحل الأدبية والصحافية، منذ أن قرأ له العراقيون مجموعاته الشعريّة، وواكبوا رحلته الصحافية.
الميدان الأكبر لرثائه واستذكاره، كان فايسبوك. منذ ظهر الثلاثاء الماضي، توالت التعليقات التي تؤبّنه وتستعرض قصائده ومسيرته في الكتابة والحياة. يكتب الشاعر العراقي زاهر الجيزاني: «علّمنا أنسي الحاج أنّ العالم الذي نعيشه جميل وواسع، وكفاحنا هو أن نحرّره من نظرتنا القبيحة والضيّقة»، مضيفاً إنّه «كلّما أعاد ترتيب كلماته، أعاد العالم الذي حوله ترتيب صورته. فبالكلمات تتغيّر حركة العالم. كان أنسي أهم من غامر بمصير الكلمات، ليثبت لنا جدارتها في تكسير صلافة النظرة القبيحة الضيّقة التي حطمت آمال أجيال. لن تموت أيّها المعلّم». بألم وحسرة، عبّر الشاعر عبد العظيم فنجان عن حزنه، كاتباً على صفحته على الموقع الأزرق: «مرّة أخرى، يثبت الموت نذالته. يتجدّد سؤال الوجود، وأهمية الشعر». وتابع: «مات أنسي الحاج، إذاً فقد خسر الشعر طفولته، وصرتُ مكشوفاً أمام أعدائي من البدو: لطالما كان شعر أنسي يحميني من التصرّف بحكمة الكبار. كان شعره يؤهلني للحبّ، متسامياً على كره السفلة، وعلى نوبات غضب الفاشلين. كان شعره يعطيني جرعة من خطر المراهقة لأجلس بالقرب من الهاوية! مات أنسي، يا لي من يتيم!». من جهته، نوّه الروائي والشاعر المقيم في الدانمارك حميد العقابي، بـ«درس عظيم» نتعلّمه من الراحل، هو أنّ «الشاعر في نصّه وليس خارجه. يتمرّد، ويلعن، ويثور، ويشاكس، لكنّه يفعل هذا ضمن فهمه العميق لإنسانيته وللفلك الذي يدور فيه. أما المهاترات والادّعاءات والنرجسية فهي أدوات الفاشل إبداعياً، يمارسها خارج النصّ ليخفي شكلانية نصّه الخاوي وادّعاءه. صعوبة هذا الأمر أنّه لا يتحقق إلا لمبدعٍ على خُلقٍ عظيم، وقد كان أنسي كذلك».
أما الشاعر المغترب باسم المرعبي، فقد استعاد شيئاً من الافتتان بشعر الحاج، يوم كان شاعراً شاباً يبحث عن كتبه كأنّها نفائس، قائلاً: «أحببت أُنسي الحاج كمغامر، ساحته اللغة، يذهب إلى مداه الأقصى في تحدّي السائد الشعري والثقافي، مجاهراً بعدائه له حدّ العنف، ومستهجناً سكونية الشاعر والقارئ على حد سواء، واستسلامهما لـ«قدرهما» التاريخي في الهرب من الجديد المتغيّر». واستشهد بما قاله في مقدمة «لن» (1960): «بين القارئ الرجعي والشاعر الرجعي، حلف مصيري».
ولا يغيب عن بال الشعراء العراقيين يوم احتفى أنسي الحاج في 2010 بصدور العدد الأوّل من مجلة بيت الشعر العراقي «بيت»، وخصّها بتحيّة في «خواتم ـــ 3»، قائلاً: «العراق الخلّاق يعلّمنا كلّ لحظة كيف يُمات الموت». وإذا كان الراحل قد كتب يوماً: «ساعدني/ ليكن فيّ جميع الشعراء/ لأنّ الوديعة أكبر من يدَيّ»، فذكراه اليوم لدى شعراء العراق والعالم العربي، وديعة أكبر من اليد.
أبي أنسي
أحمد محسن
لا يهم هذا أحداً. ولكن إن كان للصعوبة معنى فهو الكتابة. أقوله مرتعباً من أن لا يكون مؤلماً بما يكفي، ولا يعكس حقيقة ملامح العالم بعد أُنسي. وأجزم بأنه ناقص أكثر بكثير مما يجب أن يكونه. كان يسمّيه فرح الزوال، برهافة ستبقى هكذا إلى الأبد بلا تفسير. أهرب دوماً، كان يقول، وكنّا نصدق بسببه أن الموت يمكن أن يكون أكثر جذلاً، فقط إذا كتبه أُنسي.
أكتشف الآن معنى الخسارة: شمس تغيب وزيف المواساة. أكتب كما لو أني تلميذ وحيد في مدرسة، والسماء صبورة زرقاء، يتحتّم عليّ أن أملأها بالكلمات، في وداع الأستاذ الأخير. أنظر إلى هذا البياض الكبير أمامي وأراه مبتسماً. كل شيء أمامي الآن، أراه بوضوح تام، يمرّ كشريط لا تقصه ذاكرة، ولا تستطيع يد مسّ شيء منه. مكتبه الذي تتناثر حوله كتبُ وقصص. خط يده ينظف أخطائي الوافرة في لغةٍ أخذ معه مفاتيحها. سيره سير الهارب في ساحة ساسين إلى منزله القريب، قرب المقاهي والعابرين الذين يحبّونه ولا يعرفونه. شغفه برينيه شار والإله البعيد والشِعر الذي هو روح العالم. ماض بطيء لكنه برّاق كأضواء تتلألأ من بعيد، ومياه راكدة في لوحة تعشقها العين ولا تقوى على تحريكها. أكتب، كأني أعرج على حبل طويل من الأحرف، وأكاد أتعثر بينها خائفاً من الفراغ الذي يتسع. فراغ شاسع يصل إلى أعماق القلب. فراغ بمخالب صلفة تحفر آثار الغياب، يستكين هناك، يئن قصائد ونصائح وضحكات قديمة لا تتوقف. لا أعرف من أين أبدأ، وكيف أصل إلى خاتمة، أوقن أنها غير لائقة بهذا الألم العظيم. تمرّنت على رحيل أُنسي ولدي شعور أنه تمرّن على ذلك أيضاً حتى أتقنه كما أتقن صناعة فرح الآخرين.
لست ناقداً جيداً يكتب عن فضل أُنسي الحاج على قصيدة النثر العربيّة، ولا قدرة لي الآن على تتبّع آثار سحر العبور بين نصٍ وآخر. لست ناقداً جيداً، ولا قارئاً عادياً حتى. أكتب الآن عن أبي أُنسي. علّمني الكتابة، وأخشى ما أخشاه أن يفلت مني سطر أو تسقط كلمة، فيبتلعها فراغ الرحيل. أتخيّله الآن في الكوريدور. يمشي ببطء شديد وبسرعة شديدة. كالغريب الذي يعرفه الجميع ويعرف أنه الغريب. أجرّب المواساة. أحدثه قليلاً عن الحروب والأخلاق وأعصاب النصوص. يفاجئني في غيابه كما في حضوره بنبذ المحتربين، وصرامة الوصف وسلاسة الأمل القليل المتبقي. أفكر الآن كيف أكون على مقربة منه، ويضعني في موقع للأقوياء، بينما شاركني مديح الضعفاء بسعادةٍ ونقاء. ولا أفشي سرّاً إذا قلت، براحة ضمير، إن ما قيل عنه هو الأصدق في تاريخ الأدب: أُنسي، الأنقى بيننا.
بعد كل شيء لا أدّعي معرفته أكثر من الجميع. مثل الجميع أشعر أني أقرب شخص إليه، أعرفه كثيراً ولا أعرف عنه شيئاً. ومن جملةِ ما أعرفه أنه حرّضني على الكتابة. وأوصاني بما لا يمكن نكرانه إلى الأبد، رغم أنه من أعداء الأبد. أوصاني أن أنحاز إلى الأطفال ضدّ الدبابات، وأنّ أنتظر السماء: ستمطر فراشات وعصافير وأرواح شعراء. ستمطر يا أبي، وأنا أصدّق الشِعر، مخلصاً لكآبة طويلة، تقف على أبواب الربيع، ولا تدخل. ولا أحبّ الرثاء، ويمكنني الجزم بأن أنسي الحاج لم يكن يحبّه. كان يسمّيه فرح الزوال. ولا أحبّ العاطفة التي تفيض بعد الرحيل. لكن فليسامحني إن خيّبت أمله الآن. لا طاقة لي على هذا. كل ما أعرفه عن اللغة، عن الكتابة، علّمني إياه من دون أن أفهم لماذا فعل كل ذلك. فليسامحني، إنه مسؤول عن كل هذا، وأشعر أن موته حدث ضدّي. كأن الأمر خسارة شخصيّة، وكأني أكثر المتضررين.
لا ثورة لا امرأة لا كلمة
جان عزيز
يوم قرر قلب جوزف أن يحتكر حبه وأن يستأثر بتلك البسمة وأن يغدر ويغادر، كتب له عشية 25 شباط 2007 أنْ «موت كموتك قتل». على مسافة أسبوع من «جريمة» سماحة اليومية، ولمن لم تقنعه سباعيتها السنوية، قرر أنسي أن يترك لنا كل القرائن، أن يتركنا نقبض عليها في إغفاءة عينيه، وأن يتركنا، ويترك …
مع الفارق أن «قتل» أنسي اليوم يبدو مفهوماً أكثر. منطقياً.
مبرراً ومعللاً. فسباعية العجف الفاصلة بين الجريمتين كانت كافية لإقناعه. ماذا بقي لثائر مثله، في زمن تحول الثورات إلى ظلاميات، والثوار إلى مرادفي ثيران، وأحلام التغيير إلى فرمانات تعيين… ماذا يبقى لعاشق مثله، في زمن الحب المقنن والمقونن، زمن الحب المعتقل بين شرائع الطوائف وبربريات الأديان، وزمن الحب المبتذل بين مقاصل الأحقاد وتفاهات شاشات الواقع … وماذا يبقى لمدمن «كلمات» كالذي كانه، في عصر سبيها إلى «مواقع التواصل»، وتعهيرها بحصرية «كلام الصورة»، وتكبيلها بتعداد الحروف وقطع الرؤوس…
كم ضاق صدر أنسي بعالمنا. أو كم ضاق زمننا المجهري المقزم المأزوم بعملقته وكلمته وثورته المستدامة. أو كم ضاقت كلماته ذرعاً بفراغنا وخوائنا وعدمنا، حتى «قتل» ورحل. في آخر كتاباته، كان كمن يرهص بما هو فاعل. أكثر من مرة حاول دس الخبر لنا، بين خيبة وصدمة. بهدوئه. بروعته. بأناقة العبارة وجمالية التعبير. اعتقدنا أنه يتصالح مع الجميع. بينما كان فعلاً يودعنا، ويودعنا آخر حبه. كان يصفي حسابه مع أحلامه الخالدة. حتى لا تخجل منه أو تزعل، إن ضبطته فجأة يمشي عكسها. استعاد كل الأشخاص الذين لم يلتفت إليهم يوماً. استحضر كل الأفكار التي رذلها كل يوم. كشف مواقف في السياسة والسياسيين، ما كان ليرويها وسط الطريق. قال رأيه في الدين بوقاحة المرتدين الأتقياء الأنقياء. جعلنا بإيحاءاته نستعيد إدراكنا عداوة الطقوس مع الحرية. بؤس الإيمان الحَرفي وظلم مؤسسات بيع السماء وإيجارها. قال كل ما في قعر رفضه. كمن يستعد لمواجهة الديان، بريئاً من جرائم وكلائه الحصريين وذرائعهم باسمه. ذات يوم، قبل مدة، بدا كمن وقف قبالة جردته. اطمأن إلى تمامها. خط آخر زيح تحت صحة الحساب، وأقفل المحضر. عاد خطوات إلى الوراء، أعاد التفكير ثواني لم تطل: لا ثورة جميلة مثل امرأة، لا حب يختصر العمر مثل ثورة، لا كلمة تستحق قراءة متأنية مثل جسد أو مانيسفت. ماتت الرسولة وانتحرت الكلمات ونحرت لن بأمر جزم ماضوي … آن أوان «القتل»، وداعاً لكل الضحايا.
أفهمك، كما كل سبت. كما كل لحظة. كما أبداً.
شاعر القطيعة مخترقاً الحدود
محمد بنيس *
1
عندما صدر ديوان «لن» لأنسي الحاج سنة 1960، عن دار «مجلة شعر» في بيروت، أحس القارئ بصدمة مضاعفة في ذوقه الشعري. كان ذلك ــ من ناحية ما ـــ اعتيادياً في فترة الاختراقات التي عرفها الشعر العربي، منذ نهاية الأربعينيات في بغداد، ثم امتدت الشعلة إلى بيروت. صدمة مضاعفة، لأن أنسي الحاج أتى من أفق شعري يختلف جذرياً عن ذلك الذي أنشأه الشعراء المعاصرون في قصيدتهم، من حيث اللغة الشعرية وبناء القصيدة، أو من حيث الرؤية إلى الذات والعالم في آن واحد.
كانت قصيدته تنحدر من سلالة شعرية فرنسية في الأساس، بعكس النموذج الإنكليزي الذي استقاه بدر شاكر السياب من ت.س. إليوت وإديث سيتول. وأصبح، آنذاك، مشتركاً بين الشعراء التموزيين، بمن فيهم أدونيس، الذي كانت لغته الأجنبية هي الفرنسية وسط شعراء كانت لغتهم الثانية هي الإنكليزية.
شيئان جاءا مترابطين في ديوان «لن». أقصد المقدمة التي خص بها قصيدة النثر ثم قصائد الديوان. ولأنّ من الأفضل تجنب الربط بين توجه المقدمة وطبيعة القصائد، فإن المظهر الدادائي والسوريالي للقصائد كان السمة الأولى التي اكتشفها بعض الشعراء الشبان، وعدّوها نقطة انطلاقتهم في كتابة قصيدة متمردة على الثقافة الشعرية، التي كرسها الشعراء المعاصرون. أفضّل تجنب الربط بين المقدمة وقصائد الديوان بالنظر إلى أن المقدمة قراءة متسرعة لمقدمة كتاب سوزان برنار «قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا»، الصادر عن «مكتبة نيزي» في باريس في 1959، أي قبل أشهر معدودة من صدور الديوان، مما يؤكد أن كتابة القصائد استقـت نموذجها من الشعرين الدادائي والسوريالي، قبل أن تكون مدركة لقصيدة النثر، عبر تاريخها ومنعرجاتها النظرية. ذلك ما لم يكن ممكناً لأنسي الحاج أن يتعرف إليه في فترة قصيرة.
2
ما اكتشفه بعض الشعراء الشبان في ديوان «لن» ثم في «الرأس المقطوع» (1963) و«ماضي الأيام الآتية» (1965) أو في الدواوين اللاحقة، التي أصحبت متداولة بين هؤلاء الشعراء، الآتين إلى بيروت من العراق والأردن وسوريا، أو من الشعراء الذين تعرفوا عليه في مصر، أو البلاد المتاخمة، هو ما أصبح معروفاً بـ «قصيدة النثر». ولا أعتقد أن دواوين أنسي الحاج الأولى وصلت إلى المغرب ولا إلى الجزائر حين صدورها، مثلما لم تستطع مجلة «شعر» أن تصل إلى المغرب قبل أواسط الستينيات. وهو ما يفسر أن جيلي من الشعراء المغاربة أو شعراء الجيل السابق علينا، لم يكن لهم علم بما أقدم عليه أنسي الحاج في كتابة القصيدة، بل لم تكن لهم ثقافة شعرية، بالعربية، خارج مجلة «الآداب» ومنشوراتها، بما هي تمثل المرحلة الأدبية لما بعد مجلة «الأديب»، لكن النقد العربي نفسه لم يقدم على قراءة قصيدة أنسي الحاج، التي كانت ثقافتها شبه مفقودة. ذلك ما يجعلني أقول إنّ أنسي الحاج نسج عالماً محجوباً، لا نراه من خلال الخطاب النقدي بقدر ما نتعرف إليه من خلال الأمواج المتوالية للشعراء الذين رأوا في قصيدته مستقبل تمردهم وحريتهم، بل مستقبل تمرد القصيدة العربية على بلاغتها وتحررها من القداسة التي أحاطت بها. وربما كان الفعل الشعري لأنسي الحاج يزداد، اليوم، التحاماً بالتمرد. فما نعيشه من رجات في منظورنا الشعري والثقافي، في زمن الإسلام السياسي والأصولية الدينية، يضيء أكثر ما لم نستطع أن نراه من قبل في قصيدة أنسي الحاج.
3
التقيت أنسي الحاج أول مرة في الثمانينيات في مكتب «النهار العربي والدولي» في الشانزيليزيه في باريس. كنت آنذاك مراسلاً ثقافياً للمجلة، وغالباً ما أزور مقرها خلال زياراتي لباريس. وتجدد اللقاء في التسعينيات عندما زرته في مكتبه في صحيفة «النهار» في بيروت. في كل مرة، كنا نتقاسم كلمات المودة. كنت أتساءل، من قبل، عن سبب تجنب أنسي الحاج حضور المهرجانات الشعرية أو الندوات واللقاءات. وفي لقائنا في بيروت، تبيّنْتُ الجواب. سلوك أنسي الحاج الشخصي مخلص لتمرده على كل ما يمكن أن يعرض حريته لأي مضايقة، مهما كانت. بل هو سلوك يتطابق مع سلوك شعراء التمرد الأوروبي، الذين عاشوا في قطيعة مع المواضعات الاجتماعية في الحياة الثقافية. ما كان يشغل أنسي الحاج هو ما يكتب لا سواه. وهذا جانب يتفرد به، ويرفعه إلى مرتبة معلم التمرد في الحياة الشعرية العربية. وقد مكنه هذا السلوك من ممارسة حرية لا سبيل إلى تشويهها.
لكنني، وإن كنت تعرفت متأخراً إلى شعره، فقد سعيت إلى قراءته. من أول ما قرأت ديوانه «ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة» الصادر سنة 1970. شيئاً فشيئاً، حصلت على الدواوين الأولى، فيما كنت حريصاً على تتبع الجديد من أعماله. وفي غمرة قراءة الدواوين، اطلعت على ما كان ينشره في مجلة «شعر»، بعدما أهداني أدونيس مشكوراً نسخة كاملة من المجلة التي كان أنسي الحاج أحد أعضائها المؤسسين. في العدد الثاني، ربيع 1957، نشر مراجعة نقدية لديوان عبد الوهاب البياتي «المجد للأطفال والزيتون»، تلتها مراجعة دواوين لشعراء آخرين في الأعداد الموالية. ولم ينشر قصائده الأولى في المجلة إلا ابتداء من العدد الخامس، شتاء 1957، بعنوان «ثلاث قصائد»، لم يعد نشرها في أي ديوان، حسب ما أعلم. ويمكن النظر إلى الأسس النظرية التي استند إليها في مراجعاته النقدية كإضاءة للقصيدة المضادة التي كان يكتبها أو يعمل على كتابتها. وأكثر هذه الأسس إثارة للجدل في الخمسينيات هي الالتزام، الذي كان البياتي من أبرز ممثليه. إنها طريقته في الإعلان عن شعريته، بجرأة هي نفسها التي كتب بها رفقاؤه وأعطت مجلة «شعر» تلك الحدة في الاختيارات الجمالية التي اخترقت بعنفها (ومعرفتها) أوهام قصيدة مؤدلجة، لا تجرؤ على نقد ذاتها.
4
شعرية أنسي الحاج اختراق لم يتنازل عن الريبة في المُجمع عليه. لا أحصر هذا الاختراق في الماضي، ما كان وتم، في الدواوين والأعمال التي بدأ الشاعر في نشرها، منذ أكثر من نصف قرن. إن زمننا الشعري، اليوم، يدلنا على أن ما أنجزه أنسي الحاج ورفقاؤه، كل واحد بطريقته الشخصية، لا يزال يقف عند نقطة اللاوصول إلى الفعل الثقافي والشعري، عبر العالم العربي. ليس هذا القول من قبيل اليأس مما تعرفه الثقافة العربية، اليوم، في ظل الانهيارات الكبرى، ولكنه استنتاج خلاصة من تاريخ القصيدة العربية المعاصرة، من الخمسينيات حتى الآن.
عدم حصر الاختراق في الماضي يعني أن لهذا الشعر طاقة متجددة، وهي تنتظر زمنها، بغير إرغام الزمن على ما لا يحتمله الزمن ذاته. ومعنى الانتظار، هنا، الانتباه اليقظ لأركان تراها القصيدة بجسد كله عيون. ذلك ما أحتفظ به من شعر أنسي الحاج، وأنا أتأمله عبر عقود من الزمن، صاحبته فيها دون أن أتقاطع معه في رؤيته الشعرية، لأنني لم أكن، في حياتي الشعرية، على وفاق مع السريالية، التي انتقدتها في «بيان الكتابة».
والأبعد من هذا كله أنّ الشعراء، الذين قرأوا شعر أنسي الحاج، واعتبروه مرشدهم إلى التمرد على بلاغة القصيدة كما على قيم الطاعة، قاموا هم الآخرون باختراقات لا تتوقف عن المفاجأة. وأعتقد أن هذا ما يساعدنا على النظر إلى تجربة فتحت حداثة الشعر العربي على التعدد، الذي هو الوشم الذي لا يُمحَى في الكلام الشعري وفيه.
5
في العدد 14 من مجلة «شعر»، خريف 1960، نشر أنسي الحاج ترجمة 11 قصيدة من شعر أنطونان أرتو مصحوبة بدراسة. يفتتح الدراسة بمقولة لرامبو (من رسالته إلى بول ديميني، 15 ايار/ مايو 1871) أقتطف منها بدايتها «أقول إنه يجب أن يكون الشاعر عرافاً… أن يجعل من نفسه عرافاً… يصبح الشاعر عرافاً عن طريق إخلال متماد، هائل، واع، بجميع الحواس، يصبح بين الجمع المريضَ الكبير، والمجرم الكبير، والملعون الكبير ـ والعالم العظيم ـ لأنه يصل إلى المجهول.» يأتي أنسي الحاج بهذه المقولة (بتصرف) فيرى أن أمر الشاعر العراف هذا «لعله لم يعثر على فاعل ينفذه حتى الرعب، حتى الانتحار الشنج، وحتى مصير جُهل قبل ذاك، جُهل وقُوطعَ وخُنق وهو يبزغ إلا في أنتونان أرتو.» (يكتب الاسم الشخصي لأرتو بطريقتين مختلفتين) (ص. 92ـ 93.)
قراءتنا لهذه الدراسة في 1960، سنة نشر ديوان «لن»، تدلنا على أنها صورة الشاعر التي وضعها أمامه ليجسّدها في المستقبل. بهذه القطيعة الجذرية، التي تفرد بها أنسي الحاج، وضع قدمه على تجربة المخاطرة القصوى، بقيمها المضادة لجمالية القبول. ورغم أن الحياة الشعرية أخذت أنسي الحاج إلى حيث لم يكن ينتظر الذهاب، فإن كتابته في الشعر والنثر، أو ما ترجمه من شعر ومسرح، يشير إلى سلوك القطيعة الذي يظل الأشد ضرورة من سواه في حياة كل مبدع ينزع إلى أن يصبح حديثاً، قريباً من حلمنا الجماعي في حياة من الحرية.
* شاعر مغربي
ذلك الزمن المغلّف بالحلم والضوء
نضال الأشقر
أيام الطَيش، لم نكن طائشين، كنا نحبُّ الشعر. أيام الطَيش من زمان، كنا مختلفين بالنسبة إلى ذلك الوقت، بأفكارنا وأحلامنا وتطلعاتنا، كنا نحبُّ الشعر والشعراء، الأدب والأدباء، السياسة والفكر الجديد. كنا نحلُم. أيام الطيش. في أول مشوارنا مع الحياة كان بيت والديّ مشرعاً للجميع وكانت ديك المحدي، هذه التلة الجميلة المطلّة على البحر من جهة، وعلى صنين من الجهة الأخرى، كانت تستقبل السياسيين والمفكرين والمنظرين والشعراء والكتاب من لبنان ومن فلسطين وسوريا والعراق… وكان الباب مفتوحاً للجميع هناك على التلة المشرعة على الضوء والهواء والأفكار.
هناك في بيتنا رأيته لأول مرّة: شاب مُضيء. شاب نحيل شفاف ذو شعر طويل ناعم، شكله مختلف، سكوته لافت، وصوته خفيض هامس. شمعي البشرة واللون مختلف المشية. مختلف الضحكة الخاطفة. خجول. لم يكن مرتاحاً بثيابه الرسمية ولا مع نفسه ولا مع غيره. لكن ذلك كان خياره منذ البداية!
أنسي الحاج، عرفني بنفسه عندما استقبلته كما أستقبل الجميع من الأصدقاء الوافدين دائماً وبحرية وراحة تامة الى بيتنا.
أما الباقون من الشعراء، فكنت أَعرفهم جميعاً قبله: محمد الماغوط وأَدونيس، خالدة السعيد يوسف الخال، شوقي أبو شقرا… ثم لاحقاً، ومن بيت أدونيس حيث انطلق خميس شعر في ديك المحدي أيضاً، سمعت وتعرفت إلى نازك الملائكة وليلى بعلبكي وبدر شاكر السيَّاب.
أحببته كما تحب مراهقة شاباً مختلفاً ولا تعلم لماذا. شاب شاعر أديب صحافي معروف في ذلك الحين، ورغم حداثة سنه، رغم شبابه. لا شك في أنّ عبقريته كانت مبكرة. عرفته مع الكثير من الشعراء والأدباء لكنه هو الذي سكن مخيلتي. أحببتُ شِعره وخجله وابتسامته العابرة السريعة.
أنسي الحاج. الآن وبعد خمسين عاماً أظن أني أحببتك من النظرة الأولى. ولم أكن أعرف. وهو أحبني ولا أعرف إذا كان قد عرف. لم نكن نفكر في هذا كله، كنا نعيش حالة مختلفة من الوجود السوريالي.
في ذلك الوقت، كنت قد تخرجت من «كلية البنات الأهلية»، ولم أكن قد ذهبت الى لندن للاختصاص. كل ذلك حصل قبل أن أذهب الى لندن وقبل الانقلاب. في ذلك الوقت القصير، كنت أذهب إلى بيروت لأراه في الجريدة أو نذهب إلى ناديا تويني لنزورها قبل أن نذهب إلى المسرح بسيارة أجرة إلى ديك المحدي. لم أكن أعرف أنه لم يكن يريد أن أذهب وحدي بالليل إلى البيت، ولم أكن أعرف أنه معي خصيصاً كي لا أبقى وحدي، ذلك الوقت لم نكن طائشين أبداً، كنا مختلفين. ذلك الوقت كان مغلفاً بالحلم والضوء والحب. ذلك الوقت كان مغلفاً بالأَرق والسهر والمغامرة من نوع آخر.
زمن الطيش كان مليئاً بالآمال والأفكار والشعر والشخصيات المختلفة. ثم كان «لن» كتابه الذي ضجت به الأوساط الثقافية. وعرفت في ما بعد، بعد عشرات السنين أنه كان من وحيي ومن وحي الصنوبرات في ديك المحدي. وفي ديك المحدي، كنت أسمعهم يلقون الشعر في بيت أدونيس، فأسمع وأنبهر بهم وبجمالهم. لكن الشاب النحيل جداً، الجميل كان أحدثهم في شعره. وجاء «لن» ليثبت ذلك.
وبعد الزيارات إلى الجريدة في آخر سوق الطويلة، والمقاهي والجلسات في الجبل، سافرت إلى لندن إلى «الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية»، فكان سعيداً بجرأتي، وكان يكتب لي وعني ويتابعني ويعلم القراء أين أصبحت وماذا أفعل.
ثم كان الانقلاب وكنت أول سنة في لندن، وانقطعت عن أهلي وعن الجميع. لكن أُنسي كان يوصل إليّ الأخبار والرسائل (التي لسوء الحظ نهبت مع كل ما نهب في بيتنا).
لم يتركني وحيدة. تابعني كل حياتي بقلمه ومحبته. لما عدت من لندن وكان والدي أسد الأشقر في السجن، كان أُنسي قد بدأ بنشر مقالاته الأسبوعية تحت اسم «سبع بولس حميدان». وكان الناس ينتظرون الملحق كي يقرأوا مقالة «سبع بولس حميدان» ولم يكن أحد يعرف هويته الحقيقية، إلا أُنسي. كان الناس ينتظرون ملحق «النهار» كي يقرأوا مقالاته تحت اسم «سبع بولس حميدان». ثمَ جاء دور المسرح. وبدأنا بمسرحية «الآنسة جولي» لأوغست ستريندبرغ، وكنت وروجيه عساف نود أن نخرج هذا العمل. فاقتبسها أُنسي ونفضها وغيّرها حتى أصبحت عصرية.
وكانت، والحقُ يقال، من أجمل المسرحيات. وكان أيضاً هو المتفرج الدائم. فإذا كانوا عشرة متفرجين، يكون الاول، واذا كانوا عشرين، يكون الاول. فكان دائماً في الطليعة يدعم المسرح. وكنت كل ليلة في «مسرح بيروت» أَنظر من وراء «البرداية» كي أتأكد أنه هناك. فأطمئن.
واستمررنا في مسرحنا. واستمر هو في دعمه لنا ولغيرنا، فاقتبس وعرّب وأعاد كتابة المسرحيات اليونانية وشكسبير. بلغته التي لا تضاهى وحداثته المعهودة، جدد نفس المسرح باللغة العربية.
عندما أعود الى تلك السنوات المضيئة بحضوره، أذكره في الجريدة وفي المسرح ومع الشعراء ومع الكتاب. كان مالئ الدنيا وشاغلها. أُنسي الحاج أيها الصديق المقنَّع بالمحبة والشغف. أيها الفارس الشاعر الجميل. أحببتك وأُحبك، ولم أَبُحْ ولم تَبُحْ حتى مرّت كل هذه السنين. وضحكنا عدّة مرات على حالتنا، حالة البوح وعدَمِه. ولم نَبُحْ. أُنسي الحاج أنت الحافة. أنت حافة اللغة وحافة الحياة، تقف كأنك تريد أن تهوي في فضاءات أنت فقط تعرفها. وحافة الشعر التي ما زلت تدفعها حتى حافة أخرى وأخرى وأخرى
أيها الأَمير أكتب لك هذا البوح كي تقرأني.
* ممثلة ومسرحية لبنانية
إسهاماته في المسرح
بالرغم من غياب ترجمات أنسي الحاج المسرحيّة عن متناول القرّاء، إلا أن هذا لا يخفي إسهامه في نضوج المحترف المسرحي اللبناني خلال الستينيات، عبر ترجمات حديثة ولامعة لعدد من المسرحيات العالمية. وأبرز هذه الترجمات هي «كوميديا الأغلاط» لشكسبير، وترجمته المهمّة لمسرحية «الملك يموت» لأوجين يونسكو. كذلك عرّب «العادلون» لألبير كامو، و«القاعدة والاستثناء» لبريشت، و«رومولوس الكبير» لدورنمان و«الآنسة جوليا» لسترندبرغ. وتعاون على صعيد الترجمة مع بعض الفرق المسرحية اللبنانية مثل «بعلبك»، ومنير أبو دبس، وبرج فازليان، وشكيب خوري، وروجيه عساف، ونضال الاشقر. أما قصائده، فقد شكّلت بدورها مادّة لبعض المخرجين المسرحيين، كما فعل رضوان حمزة عام 2010، حين نقل ملحمته الشعرية «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع» إلى عرض أدائي راقص، والراحل يعقوب الشدراوي الذي إقتبس بعض قصائده في مسرحيته «اعرب ما يلي».
على حافة المستحيل… عند نهاية «لن»
عبد المنعم رمضان *
القدر الإنساني ـــ إذا كنت محظوظاً ـــ سيكافئك بأن تظلّ على حلم، كأن تعيش في مكان، وتهيم به، وتتعلق بمكان آخر وتشتهيه، ولقد أحببت القاهرة، مدينتي، ومدينتهم، ورفستها بقدمي، وحلمت ببيروت، مدينتهم ومدينتي، واشتهيتها بقلبي. وتصادف أن بيروت الستينيات، كانت أرض اليوتوبيا. في تلك الفترة حبستنا السلطة المصرية الحاكمة، وأنشأت حولنا أسواراً تمنع دخول الكتب والمجلات المعادية لها.
ولما سقطت الأسوار في بداية السبعينيات، وشاع الانفتاح، وتسرّب إلينا الصالح والطالح، ورفعت السلطة الحظر عن مطبوعات جماعة «شعر»، أيامها، كنت طالباً في الجامعة. وكنت في كل نهار، أتلمظ قبل أن يملأني الشيوعيون والناصريون والإسلاميون بالأسئلة المصابة بالنشاط والوخم، وقبل أن أصادف بعض الوجوديين فيملأوني بالأسئلة المصابة بالمسؤولية والالتزام. ولمّا أصل إلى الليل أو يصلني، أكتشف أنني أفرغت جيوبي، وأصبحت خالياً إلا من نفسي. وكنت أيامها أعبد نفسي، أعبدها بسذاجة وتهور، كأنني لن أقابل في ما بعد أنسي الحاج وشوقي أبو شقرا. هذه الحال تغيّرت عندما التقيت باثنين، أدونيس ومحمد خلاف: الأول هو الذي تعرفونه، والثاني هو الشخص المجهول الضائع في كل مسرحية، الثاني كان زميلي، وكان مفتوناً بأدونيس، وعن طريق أدونيس، وطريق خلاف أيضاً، تعرفت إلى العائلة كلها، على خالدة سعيد، ويوسف الخال، وفؤاد رفقة وعصام محفوظ، وتوفيق صايغ، ومحمد الماغوط، وتعرفت إلى شوقي أبوشقرا، وأنسي الحاج. كنا في السبعينيات، وكان أنسي قد أصدر أربعة دواوين، أولها «لن»، وآخرها «ماذا صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة».
الغريب أنني قرأت الدواوين الأربعة حسب ترتيب صدورها، هكذا مصادفة من دون قصد. الثلاثة الأُول تغنّت بالعفة والكبت، والأخير شفافيته جاوزت الحواس، الأربعة حققت تمييز أنسي بين الإيقاع المنظوم والإيقاع المنثور، وكان قد هجر الأول (الأصح أنّه لم يقربه قط)، ولاحق الثاني، لأنّه أدرك أنه لا بد من الإيقاع، وأن كليهما، الإيقاع والشعر، ينبع من روح الآخر، ولا معنى لكتابة، أي كتابة من دون إيقاع. أما القافية، فقد انقلبت عنده إلى صدمة ودهشة ومفاجأة. في خاتمة «لن»، يكتب أنسي: «نحن في زمن السرطان، هذا ما أقوله ويضحك الجميع: نحن في زمن السرطان: هنا، وفي الداخل. الفن إما يجاري أو يموت. لقد جارى، والمصابون هم الذين خلقوا عالم الشعر الجديد: حين نقول رمبو نشير إلى عائلة من المرضى. قصيدة النثر بِنْتُ هذه العائلة. نحن في زمن السرطان: نثراً وشعراً وكل شيء. قصيدة النثر خليقة هذا الزمن، حليفته، ومصيره». انتهى كلام أنسي المثير للدهشة. هو إهداء الديوان، ذلك الإهداء البتولي الخجول، (إلى زوجتي). في تلك الأيام، اتسعت روحي وانفتح عالمي، أدونيس كان أبي، الذي لم أفكر في قتله، لأنه بيده اليسرى شدّ على يدي اليمنى وأصبح أخي. أما أنسي، فمنذ اللحظة الأولى، ومنذ «لن»، ومنذ «إلى زوجتي»، أصبح أخي، حتى أنني استمتعت بالتوافقات التي غمرتني بعد قراءته، فشعره الذي استفز المصريين: عبد القادر القط، رجاء النقاش، أحمد عبد المعطي حجازي واللبناني المصري في ما بعد، إلياس سحاب، جعلني أنفجر بالبهجة لأنه استفزهم. كان رجاء يقول بثقة واعتداد إنّه ـــ يعني أنسي ـــ لا يريد سوى الخراب والهدم الكامل للعالم الذي يعيش فيه. أفكاره تفوح برائحة وحشية تنبع من نفسية قاتمة لا ترى أمامها إلا القبح والحرائق والدمار والعفن. وكنت أضحك، وتنقسم نفسي إلى نفوس كثيرة، أقودها، وأهتف فيها، يعيش الخراب والدمار. وتردّد النفوس الكثيرة، يعيش يعيش. تعيش الوحشية والعفن، يعيش يعيش، ثم أتهلل، ولما اعترفت لنفسي بأنني أحب فيروز، ولا أكره أم كلثوم، رأيتني أقترب من أنسي. كان يهمس في أذني، عندما تخون مرة، ستبقى خائناً إلى الأبد. بعدها، اعترفت بأنني أحب حميمية نضال الأشقر أكثر من شعبوية سميحة أيوب، ووجدتني أقف إلى جوار أنسي تماماً، ليهمس ثانية، لا أؤيد الديموقراطية في الفن، لا أؤيد المساواة، فتجاسرت واندفعت ورفعت أقدار ليلى بعلبكي، وحنان الشيخ، وهدى بركات لتكون أعلى كثيراً من أقدار لطيفة الزيات ونوال السعداوي وأخريات. عند ذلك، لاصقت أنسي، ولما هدأتُ، وشوشتُ نفسي بأنّ الشغف بالفن يعيد خلقنا ونعيد خلقه، وشوشتها ثانية بأنّني أحب نادية تويني، وأكتفي بالإعجاب بجويس منصور، ثم جهرتُ بوشوشتي، ثم قلتها عالياً، وكان أنسي سنة 1967 قد شارك تويني في كتابة حوارية «كم هو مر ولذيذ طعم الحرب في فمي» مثلما شارك شوقي أبوشقرا في حوارية أخرى (أين كنت يا سيدى في الحرب). أيامها كانت القاهرة الواقع والشعار والكل في واحد والخوف من الحرية، وكانت بيروت الحلم والشعر والكل في الكل واللعب مع الحرية، ومثلها كانت فيروز، ونضال، وتويني، وحنان، وشوقي أبوشقرا، وأنسي. قراءاتي الأولى لأنسي اختبرتني، وعلمتني أنّ الشاعر أمام الواقع محض عاشق فاشل. الشاعر والواقع مجرّتان، تبعد الواحدة عن الأخرى فراسخ أطول مما نظن. علمتني ثانيةً أنّ التاريخ أيضاً واقع فوق الواقع، علمتني ثالثاً أنّ الصمت عن الواقع شهادة وجدان، وأنه إما خوف وإما خيانة. كانت مقدمة «لن» تحجزني بعض الوقت عن الوصول إلى «لن»، وكانت «لن» تحجزني بعض الوقت عن الوصول إلى «الرأس المقطوع»، والرأس يحجزني عن «ماضي الأيام الآتية» الذي يحجزني بعض الوقت عن «ماذا صنعت بالذهب». وكنت عند كل انتقال، أحتاج إلى شهيق أعمق من شهيقي، وإلى زفير أعنف من زفيري. كائنات «لن» وموجوداته وأشياؤه السابحة في قصائده، لا أسماء لها، لأنها تستعصي على التسمية. كأن التسمية ـــ أي تسمية ـــ ستحيطها بالنجاسة والطهارة، فيما هي مكتفية بلانهائية وجودها، مكتفية بهيوليتها، منذ «ماذا صنعت بالذهب»، وبصورة أوضح منذ «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع». يتخفف أنسي ويغادر سفينته العاتية التي اختار مكانها في وسط المحيط كي لا تتيح له رؤية قرائه. غادر السفينة إلى قارب مطاطي كبير، أتاح له الرؤية والتواصل. أتاح له النظر بتحديق وإمعان. حكت لي إحدى صديقات أنسي وصديقاتي أنّه في فترته الأولى، أيام «لن»، كان يرتدي ملابس داكنة، بدلة سوداء، وربطة عنق حمراء وغير سوية ومدعوكة، صدره مغطى بقميصه وخجله. الملابس لها هيئة الملابس العتيقة، والحذاء أيضاً كان أسود وتقليدياً. كذلك كان شريطه أسود، ولحيته تكسو خديه، وخجله الظاهر يكسو جسمه كله، جسمه الذي كان نحيلاً كأنه راهب في ملابس افرنجية. لكنه منذ «الرسولة»، أصبح حريصاً على أناقته. بنطلوناته زرقاء فاتحة أو غير زرقاء فاتحة، قمصانه غالية ومفتوحة الصدر، حيث سلسلة ذهبية تتدلى. الحذاء حديث ولامع، واللحية مهذبة مشذبة خفيفة ولا تملأ الوجه كله، لا تخفي وسامته، الخجل تراجع، ربما اختفى، كأنه راهب منبوذ. حينذاك رجعت إلى فوتوغرافيا جماعة «شعر»، عموماً. ملابسه القديمة منذ «لن» كانت تشبه سفينته العاتية، وعليهما ـــ الملابس والسفينة ـــ ترتفع لافتة القطيعة. ومنذ «الرسولة»، أصبحت الملابس الجديدة على غرار قاربه المطاطي، وعليهما ـــ الملابس والقارب ـــ ترتفع لافتة التواصل.
السفينة كانت تمتلئ برياح تدوّم، لعلها رياح الحب، والقارب منفوخ بهواء أبيض يشبه هواء الغزَل. قبل «الرسولة» كان الحب، وبعدها كان الغزل. قبلها كانت السيادة للداخل، بعدها انتفش الخارج. هكذا أرشدتني خالدة، إن فتنة الحب الآسرة، أعقبتها فتنة الغزل الآسر. في سنة 2005، التقيت أنسي في مرسم الفنانة نجاح طاهر في الحمراء، لم يكن ملتحياً. كانت هالة النبي بمسوح الرجل الناضج، تحل محل هالة النبي بمسوح الطفل، اللذين كانهما، في أول قراءاتي لأنسي. قلت لنفسي، ثقافة الجماعة، الثقافة الوطنية المؤمنة جداً، ثقافة الملائكة، أو بلغة أخرى ثقافة الجنة، تحتاج دائماً كي لا تموت، تحتاج إلى النبي المسلح، النبي الشيطان الذي يربك الملائكة، ويفتن الجماعة، ويخرج بالجميع من الجنة، وثقافتنا الشعرية كانت توشك أن تموت على أيدي السادة الملتزمين، وكان أنسي أحد الأبالسة الضروريين لإعادة بعثها، لإنقاذها من الموت. ترجمات أنسي المبكرة لشعر أنطونان آرتو، أغرت البعض بالزعم أنه كان الشيطان الذي يشبه شياطين الدادائيين والسرياليين. زامله منذ البداية الشاعران محمد الماغوط وتوفيق صايغ. رحلة أنسي بدأت هكذا. السفر في أقاليم العتمة، السفر في الليل، السفر إلى الجحيم، السفر داخل أنسي. حتى صوره الشعرية كانت تنشعّ من الداخل. حتى لغته كانت تتهشم وتبتكر لتنشعّ هي الأخرى من الداخل. كأنه يعمل من أجل الذهاب بعيداً عن ماضي اللغة، عن تاريخها، عن سياقاتها المألوفة، لغة «لن» لغة عمياء، لا تقصد ولا تبوح ولا تعني ولا تدل. إنها فقط تكون. وعندما تكون، نحس بأننا لم نسمعها من قبل، لم نرها من قبل، لم ننطقها من قبل. اللغة هنا ترفض أن تكون مرآة أو آلة أو أداة، إنها الشيء ذاته، والفعل ذاته، زميلاه كانا فاتنين بتفاوتٍ، لكنهما كانا أقل جذرية بتفاوتٍ أيضاً. الماغوط شاعر محافظ إذا قارناه بأنسي. لذا مال إليه الشعراء المغنّون الكبار، ومدحوه، وتفادوا به تهمة معاداة قصيدة النثر. هكذا فعل محمود درويش. فوضى أنسي أعمق من فوضاهما (الماغوط وصايغ)، وهزيمة الماغوط كانت الأسرع، فمنذ ديوانه الثالث، خرج من فتنته بالفعل، إلى فتنته بالقوة.
المسافة بين شعر أنسي ومقالاته تشبه المسافة المفقودة. حتى كأنهما النار وحجر النار. لم يأبه أنسي بالتنظير حول النوع، فيقينه ويقيني أنّه لا ديمومة في التنظير، وأن كتابة النوع، والكتابة الخارجة على النوع، والكتابة العابرة للنوع، كلها معيارية، فيما كتابة أنسي، شعراً ومقالات، تتأسس وتتشكل على صورتها ومثالها هي بالذات، وبعد أن يفرغ أنسي من تدمير المثال العام، ينشغل بتدمير المسافة. يدمر المسافة مرة بينه وبين قارئه، ومرة بين ظاهر لغته وباطنها، ومرة بين معناها ومبناها، ومرة بين شعره ونثره، ومرة بين كتابته وأخلاقه. المعتاد هو إقامة المسافة من أجل إقامة الوضوح، غير المعتاد هو إقالة المسافة من أجل إزالة الوضوح، أملاً في الاحتفال بغموضٍ بطعم الخوف والمجهول والضياع، بطعم الحياة. هكذا يظل الشاعر طفلاً، هكذا يظل وحيداً، رافقت بعض شعراء تأثروا بأنسي ومشوا خلفه. في البداية، أدهشتهم وحدته، ثم لم يحتملوها لأنها سرعان ما أفزعتهم. أغلب هؤلاء حاولوا ترويضه أثناء قراءتهم له، أغلبهم ابتعد لأنّ قصائده ـــ أعني أنسي ـــ لم ترغب في المشي فوق رمل الصحراء. لم ترغب في البداوة، حيث الآثار الواضحة التي يستهدي بها قصاصو الأثر. قصائده رغبت في المشي على ماء البحر، لتغيّره دون أن تكشف عن أثره. ذات مرة، ذات مرات، حاولت تفكيك أنسي، لكنني فشلت، فانصرفت إلى محاولة أخرى، أن أرجع إلى السهم لأرتقيه، وأن أفرش على روحي القصائد والمقالات الأدبية، وأن أتناوم. سمعته يقول لي بأنّ العرب كُتّاب مقال أكثر من أي شيء آخر. العرب لم يصلوا في الرواية إلى سدرة المنتهى، باستثناء نجيب محفوظ، لأنه خالط الأعراق. المدهش أن البعض يزعم أن الرواية مختصر الأدب عند العرب. وهؤلاء بيضتهم لم تفقس بعد. كنت أثناء سماعي له، أفكر في مقالات المازني ويحيى حقي، وأفكر في مقالاته هو نفسه، لكنه فاجأني وسألني عن طه حسين، ثم قال: «طلبتَ مني أن أحكي كلمة، إذاً سأحكي، كان طه يسخر من الشاعر قيس بن الملوح، مجنون ليلى، ويُضحكُ قراءه، فهو لم يعرف عاشقاً أُغمي عليه كما أُغمي على قيس. لم يعرف عاشقاً شهق وزفر كما شهق قيس، وكما زفر، لم يعرف عاشقاً كان يقضي أكثر حياته ساقطاً على وجهه مغشياً عليه مثلما قضى قيس حياته. يرى طه أنّ قصة المجنون أشد القصص سخفاً وأخلاها من المغزى النافع والمعنى المفيد، مع ضرورة التشديد على الأخيرين، المغزى والمعنى، والحق الحق أقول لك، إن طه لم يفهم البعد السحري في الشعر، غلبته طبيعته الفولتيرية الهازئة، ولم تؤهله للتعامل مع الشعر والشاعرية إلا في نطاق الوعي الجراحي. طه لم يدرك أن المخيلة البشرية تصدّق الشعراء ولا تحب جراحيهم، تصدّق قصة قيس بن الملوح، ولا تحب وعي طه التاريخي، جميع الفنون شرطها التغريب، التغريب الساحر، أكثر من التغريب الساخر، تغريب رامبو وبودلير، وليس تغريب فولتير وموليير». قبل أن ينهي جملته، كنت أسمع باستغراب صوت تفتيح الأبواب، وهو الصوت الذي رافقني دائماً وأنا أقرأ قصائده، لا تزال قصائد «لن» وما تبعه هي المقدمة الأصلح لمعرفة أنسي. هي أمارته على أن الشعر توق إلى الحب، والحب توق إلى مزيد من الحب، والمزيد توق إلى المستحيل من الحب، وعلى حافة المستحيل وعند نهاية قصائد «لن»، عند آخر سطرين في الديوان، نسمع أنسي بصوت يشبه خاتمة الكريشندو: أغرق أو أحلق، أو أنام، لا وجهة لا وجهة، أسرطن العافية، أهتك الستر عن غد السرطان. حرية.
* شاعر مصري
ليست هذه مرثية
صلاح فائق *
أكتبُ عن صديقٍ يحتضر
ليست هذه مرثيةٌ، انما قصيدةٌ عن نخلةٍ
خرجت سالمةً من طوفان قديم
وظلت تمشي حتى وصلت الى منابع نهرٍ
وبقيت هناك.
أكتبُ عن صديقٍ يحتضر
سلواهُ، لزمنٍ طويل، نواعير تدور
هو الهارب من ظلمة مدنٍ
الذي له مظهرُ عاشقةٍ
وطفلٍ يرقص
أكتبُ عن صديقٍ يحتضر
لن أبكيهِ ولن أنتحب، أمجّدُ ميراثه ومآثرهُ
بكلماتٍ هي مرايا نرى فيها حيواتٍ كثيرة،
حيواتنا، وحياتهُ أيضاً
في إحداها يمضي في أرضِ مجاعاتٍ وحروب
لكنهُ يغني.
أكتبُ عن صديقٍ يحتضر
بعيدٌ أنا لأمسّدَ أصابع يديهِ
وكانت تلتهبُ في شتاء الجبال
بعيدٌ أنا، أمكثُ في أوهامي عن كهلٍ
يصنعُ تابوتهُ في منتصف ليل
ثم يرمي خاتمهُ الى الهواء
أصدقائي خانوني، كلهم خانوني
لأنهم ماتوا
تركوني بين غربانٍ شرسة
وسلالم لا أدري الى أين تؤدي
أكتبُ عن صديقٍ يحتضر
* شاعر عراقي
الرائي، والمبدع وصوت الحريّة
خالدة سعيد *
أنسي الحاج، هل هو الغروب حقّاً؟ وأنت القائل:
«في ظلام النهاية جلستُ أكتب البداية.
في دم الأرض غمَسْتُ ريشةَ السماء.
وأقول للموت الداخل:
أدخل! لن تجد أحداً هنا» (الوليمة ص 38)
كلاّ، لن يجدك الموت. لن ينطفىء ذلك الوهج وذلك الشغف بقيم الإبداع، وذلك التنسّك للحقّ والجمال والمحبّة، وذلك الاعتناق العنيد لمذهب الحريّة. وسيبقى لنا شعرك وتبقى أفكارك ومواقفك وتاريخك المضيء.
أنسي الحاج من أهمّ الانفجارات الشعرية في زمن التجدد الشعريّ العربيّ. هو الأكثر تطرّفاً وتجاوزاً والأوسع تأثيراً. ومع أنّه جانَبَ الوضوح والخطابيّةَ، فقد جاء شعره صرخة هي نداء اللوعة والتماس الحقّ وزعزعة المستقرّ وأمل الجريح.
بدأ تألّق أنسي الحاج مع تسلّمه الصفحة الأدبية في جريدة «النهار» مطلع الخمسينيات، وبرز حضوره مع انطلاقة مشروع يوسف الخال الذي تجسد في مجلة «شعر» وجماعة «شعر». تميّز بين أوائل المندفعين الداعمين للمشروع الطليعيّ. التجديد عنده كان يتجاوز مسألة الكتابة المختلفة وتطوير الأشكال الشعرية وتحرير الشعر من الخطابية؛ كان يصبو عبر حركة «شعر»، إلى ملاقاة الحلم والتماس الأفق الإبداعي الأروع، وإلى تجديد الصوت الإنساني والرسالة اللغوية. فالثورة الشعرية، بالنسبة إليه، كانت أكثر من ثورة على القيود اللغوية. كانت ثورة على معنى الفعل الشعري ذاته. لأنّ الثورة الشعريّة إمّا أن تكون كشفاً وتجديداً للصوت الإنسانيّ ولرسالة الكلمة أولاً، ومن ثمّ نهوضاً لإعلاء معنى الوجود، أو لا تكون.
من هنا أنه كان متهيِّئاً لكل عطاء.
ومع أنه كان في أوائل عشريناته، فقد ظلّ حضوره يغذي تجمّع المجلة الرائدة « شعر» برؤى جديدة مجازِفة كاشفة ومساهمات ملهَمة.
رائد قصيدة النثر، شاعر الحضور والخطاب النقدي المربك المتحدّي في «لن» و«الرأس المقطوع»، ثمّ شاعر الاحتجاب وخطاب التّعالي والهيام والغفران في «ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة» وما بعده، لكن ليست غنائيته في مرحلة هذا الكتاب الأخير غنائية التوبة، بل هول الاعتراف ونداء اللوعة. لأنّ ثورته الشعرية في «ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة» ترتدّ على الذات تدفعها إلى المحيط ليتمحور المحبوب حتى ليغدو الشعر تسبيحاً.
بقي، على امتداد خمسين سنة، في زواياه، ولا سيّما «كلمات كلمات كلمات»، منذ الملحق الأسبوعي لجريدة «النهار»، وصولاً إلى صفحته الأسبوعية في جريدة «الأخبار» يوجه ضوءه الرائي الكاشف الحاضن الشامل في حقول الإبداع والاجتماع والمحبة والمعرفة وسائر المواقف العامّة. فقد تميّز أنسي الحاج، على امتداد حياته الكتابية والشعرية، بالمغامرة عند النهايات، بالارتماء الكلّي في طرق الحقّ والشعر والحبّ، بالكلام الخطير المجازف. تميّز بعناق الخطر بلا دروع وعناق الحقيقة بلا حساب. ولم يعرف طرقاً للرجوع. إذ ما الحبّ والشعر عنده، إن لم يُعاين الهول ويرتفع «كروح من تحت الماء»؟ (الوليمة)
ليس بين كوكبة الأصدقاء التي أحاطت به، من لم يُكرَم بكلماته. تجلّى هذا الكرم الأدبيّ الخلقيّ منذ بدايات مجلّة «شعر». اكتشفنا شعراء وقرأنا عديدين من خلال كتابته أو بَعدَ كتابته. وتميزت كتاباته النقدية بالعمق واللمح والانفتاح والنفاذ والتماس الجمال الخفيّ.
كان رهانه الكبير على جيل الشبّان، لكنّ خنادق الحرب الأهليّة، التي لا تنفكّ تزداد عمقاً، قد أوجعت كثيرين وضيّعت كثيرين. كان الصوت العالي لحلم لبنان دولةً للثقافة والحقّ، دولةً للإنسان، وظل كذلك حتى كلمته الأخيرة. فهو لم يتنازل عن حلمه أو مقتضاه، على الرغم من توالي المحن واستمرار التمزق الأهلي.
إنه مع زملائه المفكرين والشعراء والكتّاب وبعض الطوباويين، الجيل الذي بقي على جزيرة المثُل الموعودة بعد تفكك جغرافيا الطموحات المثالية.
عَبَر الحروبَ اللبنانية ووحولها الطائفية وما مسّته ذرة من غبارها. عبرها ضوءاً وسراطاً شعرياً روحياً إنسانيّاً. فقد كان وسيبقى رجل الحب ومحبة الحرّيّة. رجل الصدق والخفر الأخلاقيّ.
إذا كان صوته، الذي جلجل بين الخمسينيات والسبعينيات، قد مال في الآونة الأخيرة إلى الحكمة والتأمّل والألم، فلأنّ الحرب المتواصلة المتعاظمة لتفكيك لبنان والمنطقة قد طعنت هيامه وأحلامه وتجاوزت كلّ حدّ.
أنسي الحاج، أيّها المتمرّد، الشاعر والمفكّر المضيء، عجّلتَ بالرحيل، لكنّ كلماتك الرائية باقية لنا، باقية في أفكار هذا الجيل والأجيال بعدنا، ومن سيأتي.
* كاتبة وناقدة لبنانية
فليُصْلَب على صُلْبان كثيرة
رشا الأمير*
إلى أنسي الحاج شاعراً ولبنانياً
تُريد الخرافة، ولعلكَ، بل الأرجح أنك شريك فيها، أنّك نؤوم الضّحى، لا تُغادر فراشك إلا عندما تطمئنّ أن البشر قد أحرزوا قصب السبق في الإعادة والتكرار؛ تتثاءب كثيراً قبل أن تقرّر أنّ المساء، ساعتك الأثيرة، قد دخل حقّ دخوله، فتتهندم كأنّك الضيف الشرف على احتفال سلطاني باذخ يقام مرةً، في العمر، واحدةً لا شريكَ لها، وتمضي إلى مكتبك، ومنه إلى ليلك الحاشد بالجنيّات والشياطين والمُستوحشين والكسالى وأحاديث قلّما يؤتى فيها على ذكر الشعر!
هذا ما تريده الخرافة، ولا سبب وجيهاً لوضعها على المِحك، أو لتمحيصها أو للشك بما تريده ــ أعني بما تريده الخرافة، وبما تريده أنتَ من الخرافة التي استَأمنت عليها سيرَتك وروايتَك، لا مُتكاسلاً، بخفر، بل بخفة النشّال، من تنقيحها كلما بدا لك ذلك، كأني بكَ بدا لك ذلك كلَّما أهلك الزّمانُ جيلاً من حوارييك وأهداك جيلاً جديداً.
لسواي أن يقولَ فيك غيرَ ذلك ولكن هذا، عندي، بعض ما يبقى منك من أول يوم طرقت فيه بابك الباريسيَّ في «النهار العربي والدولي» مُتلمسةً سبيلي في متاهات العمل الصحافي، إلى آخر يوم، قريب، أجاءتني فيه الصدف إلى تصفّح «ماضي الأيام الآتية». بل، كلّي يقين أن لسواي فيكَ غير ذلك، وكلّي يقين، أيضاً، أنَّ المسافة التي تعمّدتَ، دوماً، أن تخطّها خطاً مُبيناً بينك وبين شِعرك ــ (ولو أنَّه آثَرُ عندي، والأرجح عندكَ، أن أقولَ كلماتك) ــ طريقٌ إلى شِعرك، مِنْ طرق شتى، إليه. ليس أنَّ الشعر في مكان آخر بل إنه مكان آخر: مكان آخر تمضي فيه حياة أخرى، وأحيانًا آخرة، على رِسْلِها مُنْتَحِلَةً الحِكْمةَ أو بسرعة الطلقة مُعانقة الجنون، وتدعو، مِنْ غير أن تَدعو، كلّ من يعنيه الأمر، أنْ يحذوَ حَذوك فيمضي فيه، في الشعر، حياة أخرى، وأحيانًا آخرة.
هو كذلك، ولكن الشّعر هذا ليس بالمكان الموهوم أو بالمكان المستحيل؛ و«لن»، مقدمةً ونصوصاً وورثة ذوي استحقاق ـ ومتطفّلين، خير دليل على ذلك. وإن أنسى، لا أنسى يوم أعادت «دار الجديد» نشر الخمسة الأوائل من دواوينك ــ دواوينك «التاريخية» على افتراض أن للصلح بين «الشعر» وبين «التاريخ» محلّاً أو مجالاً ــ إن أنسى لا أنسى بكم من الدقة، بل بكم من الوَسْوَسة، كنت تُصحّح وتستأنف، المرة تلو المرة، تصحيح تلك المسوّدات على قلق متّصل كأن هذه الطبعة ــ أو تلك أو هاتيك ــ هي «الكتاب» الأخير بعينه ونفسه، أو قل كأنّها «الكتاب» الذي يحاسب عليه المرء، يومَ الشّعر، وعلى ما فيه، الحسابَ العسير.
وإنْ أخشى، وحقُّ القَلْب أن يتوجَّس الخيفات، فأخشى ما أخشاه على «الخرافة» أنسي الحاج أن تُصْلَب على خشبة «الشعر» دون سواها، أو أن تُودع في كتاب ــ كائنا ما كان هذا الكتاب. إنْ كان لا بدَّ من ذلك، فأنسي الحاج يستحق أن يُصْلَب على صُلبانَ كثيرةٍ ليس أخشنَها، ولا أقلَّها ارتفاعاً، صليب لبنانيته الهازلة المغرورة في آن واحد، ولو أنها قد تبدو اليوم، لبعضهم على الأقل، من زمن غابر.
أحب أن أتذكر أن أنسي الحاج، بوصفه المدير المسؤول لجريدة «النهار»، استُدْعِيَ ذات يوم، في عز «الوصاية»، أمام القضاء اللبناني، لمُساءلته عن نَشْرِ مقالات ذات صلة بالدّخْلل والحميمية بين «الأجهزة» اللبنانية والسورية (البعثية)، وأحبّ أن أتذكر أن أنسي الحاج، قبل التحاقه بـ «الأخبار» بسنوات، غادر «النهار»، بيتَ أبيه، مُحْنَقاً، فاحتكم في نزاعه ذاك «إلى القارئ»، في كرّاس نشرته «دار الجديد»… أحب أن أتذكر أن «الشعر»، على دِين أنسي الحاج وذمته، هو «العكس مِنْ كلّ ما يَقهر».
* كاتبة وناشرة «دار الجديد».
الإرادة ولادة دائمة
شكيب خوري *
ألو،أُنسي؟
شكيب خوري
– مرحبا أُنسي،
يا عاشق السَّهر.
هيدا اليوم هو الواحد والثلاثون من كانون الأوَّل. خَفّ البرد. يلا نمشي بحارات الأشرفية، في شمس. بعرف. بتحب شمس الظهيرة. بتخلصَك من أَرَق نص الليل وكوابيس النهار. باستمرار بتذكَّر لمّا تلفن لك عند الصبح وتكون بعدك نايم، تْـبَـحْبِش، وعيناك غـفْيانِه، عَ سمّاعة التلفون.
ويرنُّ الهاتف:
– مين؟
– شكيب.
– آ، شكيب؟
– مقالتك اليوم رائعة. «كلمات كلمات كلمات» منّها مجرَّد كلمات مألوفة. من وين بيجي هاالجديد؟ وين بتتصيَّدُ الـمُدهش؟
– من العذاب. الخوف. الجذور اللي عَمْ تضمر عَ إيقاع الصواريخ.
– بعتذر، ازعجتك.
– تقلَّصت ساحات اللقاء. منشرب قهوة بساحة ساسين.
وتَـلْـتَحِف غِطاءَ السّرير ناشداً قليلاً من الرّاحة والسّكون، أو ربّما الفرج.
-2-
وصلتُ إلى الموعد وكان أُنسي يجلس على طاولة يفصلها زجاج المقهى عن الرصيف. عيناه ذابلتان. ابتسمتْا عندما رأتاني. لكن سرعان ما عادتا إلى الصَّمت المذهل. سألته:
– في شي زاعجك؟ صار شي؟ عَـيْـلْـتَـك بخير، أُنسي؟
– آي صار.
– خير. شو صار؟
– أنا يائس. هاالحرب بين شرقية وغربية دمَّرت إيماني بفرادة بيروت.
تقلَّصت ساحات اللقاء، ساحات الإبداع. ما بقى في طرقات سالمة، مسرح، ندوات فكرية؛ نور النّهضة اللبنانية تحوَّل لدم. سيطر الدم بلونه الداكن عَ لوحات التشكيليين، شخصية العمارة اللي ميّزت مدننا، ضيعْـنا تدمَّرت، البرج امّحى. كل هاالأزقة القديمة اللي ريحتها أَنعشت رئتي زالت معالمها. لازم فِـلّ. پاريس غربة بس، ربّما، بتكون العلاج… الأمل بدل اليأس.
وسافرت. وكنت كل ما زور پاريس، تَـلْـفِن لَـك. وعادت حليمة لعادتها
القديمة:
– صباح الخير.
– ألو … مين؟
-3-
– بعدك نايم؟
– آ. شكيب، أهلا. أيمتى وصلت؟
ويكون موعد ولقاء. وبين الإثنين، يا أُنسي، كنت أتذكَّر انطباعات بعثتها علاقتنا. أولاً، حَياؤك الصّارخ عندما كنتُ أسدِّدُ ما يتوجَّب عليَّ دفعه لك لقاء ترجمتك لمسرحيتي «رومولوس الكبير» و«الصَّيف». نعم. حَياؤك كان يشعرني بأني أرتكب غلطةً مميتة مع صديق. نفسك كبيرة، يا أُنسي.
ثانياً، مَيْلُك… أو شغفٌ مكبوتٌ للتمثيل لديك. عبَّرتَ عنهما عندما طلبت مني أن أُسندَ إليك دوراً في مسرحية «رومولوس الكبير». واستجبت لرغبتك. وكيف لا. كانت سمعتك الشعرية والأدبية مكسبـاً معنويـاً للفرقة. وانطلقت ورشة العمل. وبعد بضعة تمارين، قرّرتَ الانسحاب. لأنَّ مشاغلك الإعلامية والأدبية لا ولن تسمح لك بتكريس الوقت الضروري لتحقيق «الممثِّل» فيك. كان صوتُك ينبض بالحزن. يومها خسرتُ والممثّلين رحابةَ صبرك وغنى ثقافتك. وحُرِمْتَ أنت تحرير خاصية إبداعية في ذاتك المتعدِّدة المواهب. ولنعد إلى الحاضر. سأجتمع بك قريباً، وآمل أن يتوقَّف غدرُ السيّارات المفخَّخة. إنها الموتُ المتربِّص بنا. على كل حال، عندما نلتقي، سأطرح عليك سؤالاً بدأتْ أجراسُه تطنُّ في رأسي منذ تعرّفت إلى حفيدتك لارا:
-4-
– هل انتقلت جينَةُ التمثيل فيك إلى حفيدتك البارعة لارا بو نصار؟ معها تجدَّدت لقاءاتي معك. البذرة الأصيلة تنمو وثتمر برفقة الجذور. وبكل عفوية رحت أراجع علاقة الممثّل الكائنة فيك بالترجمة وخاصةً للأعمال الدرامية. سطع صدق ترجمتك لمسرحية «الصَّيف». وأدركت توأمة شاعرين: أُنسي الحاج ورومان ڤينغارتن في عمل واحد. لمّا لغة الشاعر الـمُترجِم بتجسِّد رؤية شاعر أجنبي وبتكشُف عن المستتر بين السطور والموسيقى اللي فيها، وبتتصيّد المعنى الصحيح وبترسم دلالات الطبيعة والحيوان… لـمّا لغة المترجِم بتنقُش النص بإزميل مايكل أنجلو ساعتها بتتوحَّد المعاني وبتظهر الرموز والأحاسيس وشفافيّة البلّور. كل هاالعناصر ساهمت، يا أُنسي، برؤيه إخراجية لـ «الصَّيف» جسَّدت الحلم والشاعري. فجاء العرض أثيرياً متل «باليه» … وهيك زميلك نزيه خاطر وصف الإخراج.
اسمح لي بأن أكشفَ لك أيضاً عن تجربة لي كنتُ قد أخفيتُها عنك وعن رفاقنا: ذهبت إلى الفريكة لحضور حفل يحمل اسمك. جلست بين الحاضرين أنصتُ إليك تلقي شعرك، وأتخيّل صوره. وفجأةً أرى ريشةَ أمين الريحاني تمتلىء حبراً وشعرُكَ منها ينسابُ. اقترن الشاعر العريق مع الفيلسوف الأصيل. وفيما أنا مستسلم لهذه الرؤيا، أسمع من القبو العتيق المجاور، خوابي النبيذ تهلِّلُ.
هاالذكريات، يا أُنسي، بتفاجئني متل البرق اللي بيسبق الرَّعد وبفرح. ومع
-5-
طلوع الشمس بنط عَ التلفون تَـ عبِّر عن إعجابي المتجدِّد بزهورك اللي عَمْ تولد عَ صفحتك. وفوراً بسمع صوت إيدك عَمْ تْبَحْبِـشْ عَ سمّاعة التلفون وإنت بعدك نايم، وبأجّل الإتصال. وبصير شَـبِّه أفكارك بلمعان البرق، وشَـبِّه دعساتك السَّريعه وإنت لابس الكبوت بصوت الرَّعد.
بعدنا شباب، يا زَلـَمِه. السيارات المفخَّخة ما رَحْ تغلب إرادة الحياة. والساحات رَحْ يزيّنها إبداع ولادنا وأحفادنا. وإنت أنا، إلنا ساحتنا وعليها رَحْ يرقص المستقبل اللي كنا نخطِّط أهدافه وبعدنا مننشده.
«الإرادة ولادة دايمه»، ما هيك كنت تقول؟
* مسرحي وروائي لبناني
إلى الأمس إكليلاً من الغوى
شوقي ابي شقرا *
إنه الرحيل، إنها الساعة، إنّه أنسي الحاج ولَّى. ويحدث الانشقاق بين الشاعر وجسده، بين البركان والحمم، بين الشاعر ونفسه التواقة، بينه وبين الغد، بينه وبين الوصول إلى الترياق، إلى الأمس الذي هو ربما اكليل من الغوى، من الأزهار التي تذبل أو يغمرها الشحوب. ويغمرها الشاعر فيكون الرجوع إلى العافية، إلى الآتي من الأيام، وإلى تلك المغامرات التي كانت له، والتي كانت لنا. ونحسب الحساب، فإذا هي ملعب طويل العشب تنط عليه الكرة، وتنط الأمنيات.
ويكون الرجوع إلى النضارة، وإلى الأدق الأدق من الكلام، من الرضى وتربية الذوق، وترويض العقل الفاعل على أن يحمل الزاد، أن يحمل الأفكار وأن يتأبط القافية أو قامة الحرية. ونركض نحن على البساط الأحمر ومعنا الربابة ومعنا البيانو ومعنا الآلة التي تعزف للوطن، للشاعر الذي كالموج يروح ويجيء ولا يتعب ولا تديره الظنون. ولا غفلة عن الحقيقة عنده، بل هي الحقيقة ما ينبغي أن يكون وأن يتربع على الكرسي الكبيرة، وحيث الصولجان وحيث التاج وحيث السلطان هو يقرر. وهو يدعو إلى الاحتفال وإلى أن يرقص الراقصون وينزل المهرج إلى الساحة. وتكون الضحكة ويكون الحزن ويكون من ثم ذلك الانشقاق بين البارحة والشاردة.
بين الصحو الملهم والمطر الذي يفرقع ولا يمحو ولا يطفئ بل يزيد النار حين يحدث الشاعر عليها وحين يرمي لقمة الحطب على لونها الغامق، على الرماد الأصيل وعلى قدرة الالتهام بحيث ينتفض الطائر وجناحاه وينهض من العدم، ومن أي حثالة أو أي ثمالة. وهو سكران وعدواه تمس الآخرين وتصيب القراء طراً ولا ينزحون ولا يغضبون.
ولا انشقاق معه، ولا هو ولا أنا كنا تلك الحالة، تلك الأزمة بل تلك النزهة نحن منذ الخمسينات إلى الردح والبرهة والسنوات التابعة، إلى الحقبة الخصبة منذ حلقة الثريا إلى مجلة «شعر». ومنذ كنا هو في «النهار» وأنا الصياد أصطاد اللحظة العابرة والهنيهات والساعات الرخية، وكانت العذوبة والصداقة هما عصاي، وكنت أطرق الباب، باب الرفقة والشعر وهو ولي التوفيق. ونحن تلك القصيدة التي تهمي، وتلك الكلمة التي تمر ونكتب اسمها وهيكلها على بحبوحة الورقة وكنا نتداول الجيد والمرهف وما يندر وما لا يزول هباءً وضياعاً في خندق الرداءة، خندق المعتاد ولا تجدي الطبابة.
ومع الشاعر والشعر تلك هي الخطة والمنهاج والبرنامج. ولا نترك العروس أي الكلمة وحدها، بل نعمد إلى إخراجها من العش حيث هي دافئة، ومن الخدر حيث هي في الناعوسة ووراء الناموسية لئلا يتاح للبرغشة أن تؤذي الوجه أو ذلك البض، ذلك العري الهائم في مداره، في أحلامه. ولا ندع الجمال إلا نأخذه كأنه الغزال، وعلينا أن نحط عليه وأن نتلوث كما الفراشة من الزهرة، وكما لها فنها في التحليق وفي أن تعمل أعمال الفراسة وأن تنقل الرسالة إلى ما حولها، وأن تبث مهنتها للطبيعة طراً وللناس طراً حتى الفناء في مناخ الزوال في الاتحاد ثانية وكل مرة بالفضاء. وإنما هلاكها هو العلامة على الوجود والإياب إلى الأخضر إلى الأبهى إلى نعمة الظفر بالبقاء بالذوبان في ما يقوم على التجدد والصعود إلى حيث المملكة مملكة اللامرئي والصعب أن لا يدوم ولو في أحلك الأزمنة. نائية وقريبة هي الطريق إليه، إلى من نطل عليه، حتى يرانا إلى أنسي الحاج، وكنت أنا منذ مطلع الشمس ذياك القادم إلى منظره، إلى فتون إطاره باكراً، إلى سر اللقاء إلى عهد يتقادم ويطول. وكنت في خطواتي مسرعاً وبطيئاً ورويداً تلي رويداً. إلى أن أثمرت الزهرة في الأرض زهرة الصداقة وصعدت من التراب والإناء إلى السقف، إلى الفضاء الذهبي الذي يملك الرحابة ويملك القوة على ذلك، ويملك العاطفة التي تعبر أي سقف وتجتاح أي عائق وتقلب الخشبة من فسحة إلى فسحة ومن ضحكة إلى ضحكة ومن آخ إلى آخ ومن شاعر إلى شاعر. وما كنت سوى العفوي سوى المتطلع إلى الجدة المشتعلة.
والحق هنا أننا كنا في ما مضى، في بحر الخمسينات نرحل إلى الأوسع وإلى ما يؤلف السعة وما يجعل الكلمة طائراً صعباً لكنه يأوي إلى الدفء. كنا نهجم ونهاجم ونصطلي على الأصول على التراث على الوجود ونكتب الورقة وعلى الورقة وعلى حائط الوقت أحلى الصور وأحلى العبارات وأحلى القصائد، منذ تلك الأيام الغابرة ونحن في الشروق ولسنا في الغروب. وطالما حلمنا وسرنا وروينا وكان القلم في نضارته سيداً على المكان وكان في معظم أحواله منذ الحقبة الاولى، يفوح ويصل عطره إلى ما بعد الشميم الداني. إلى ما ينتظرنا إلى القارئ الذي يجلس في هدوء الحياة، وحوالى بركة الماء، وحوالى النافورة، لكننا نثور وهكذا كنا نضع النقد على الغلطة وعلى الأمر وعلى المرارة وعلى الجرح ونضع النقطة على القد المنتصب، حيث نحن نبصر أين هي وأين الصواب وأين هي الشبكة لتدخل الكرة أو لتدخل هي الكلمة المصطفاة والتي كانت كأنها الطفلة تركض إلينا ونحن لها نشرع الذراعين، نشرع ذواتنا لتهبط على مهل وبكل أناة وكل انبهار ودهشة. ونحن حينئذ نأخذ ونأخذ، والنحلة إنما هي كذلك ونحن كنا ذلك الراوي وذلك الشاب المتقدم إلى النيران، وذلك الفتى الذي من نبتة إلى نبتة يفعل ما تفعله النحلة الطروب وتلك العادة لديها، عادة أن تتغاوى وأن تكون غنية كل الغنى، اذ في فمها لا ماء بل عسل يشفي ويسقي. ورحنا ملياً في المشوار وفي الانتقال من الانغلاق إلى الانفتاح إلى الخصيب من الأيام من العطاء الأدبي. وأنا في حلقة الثريا، وفي «جريدة الزمان»، ثم انصرفت إلى مجلة «شعر»، وأنسي يحضر ويقول النص الذي يفور طويلاً ويهوى أن يكون الإلحاح إياه، وأن يكون الشك وعدم اليقين، وأن يكون الشاعر وقصيدة النثر التي تخرج من العلبة، من العتمة إلى المصباح إلى وهج الغد ومن القماشة الضعيفة إلى طرحة العروس وكثافة الفرح والحزن على السواء.
وإذ يبدو أنسي الحاج وإذ يصرخ أمام الجميع، أمام الرسولة وأمام نفسه، إنما يكبر دوره ويكبر الزاد الذي صنعه لطبقة القراء، لأي طبقة لأي فئة لأي مرحلة في مسار الشعر اللبناني ومن ثم العربي والآخر الشفاف ويلتفت دائماً إلى كل جهة من حيث الغناء ومن حيث الصدى الذي يتوزع ليكون الأرغفة في الرخاء والأحوال المتصادمة إلى وادي القوم المتحرك هنا وهناك.
وكنا معاً في البأساء وفي الرضى. وكنا، والحرب قائمة لا ننسى الأصالة، أصالة الجهد الذي صرفناه ولم نقامر به، والذي تعاظم إلى حدود الإبداع وداخل الإبداع وداخل الزمن الذي ما فتئ يداعبها لنتكلم في شباكه كالسمكة ولا نفنى، ونحن نداعبه ولا نرعوي. وأنسي أيضاً بهذه الصفة وجد الضالة، وجد الفعل وجد الجاذبية والمتعة في ما كتب واندفع به مجالاً تلو مجال، ليكون حرياً بأنه من شعراء لبنان في الطليعة وأنه، في ما يترك من أعمال، وما يزاوله من أفكار وآراء وأصوات، ذلك الهوس الفني، ذلك المتربص الشجاع وذلك الساهر ومعه سيفه والقلم. ومعه النخوة التي تمتشق العافية في القد المنسرح واللين الحركة ومعه دوام القنديل. ومعه نحن الذين نحبه، ونتمنى له أن يطرب دائماً وأن يغني لنا كأنه عصفور نزل من ضواحي الجنة، ونحن في الإصغاء، وفي صدد الاعتراف بأنه الوجد كاملاً كنجمة الصبح في ديارنا حتى الثمالة. وانه كلما انقلبت الأوراق من حقبة إلى أخرى، له العذوبة في الصراخ وله المنطق المزدهر يصيب به الغاية إلى عمق الدجى وعمق الهوى. ويصعب على شهرزاد والحقيقة والليالي المزدحمة بنا والمغامرة الناجحة أن لا نصف «النهار» بأنها كانت الميدان والمعاني المثلى والرسالة الدسمة عبر كلينا وعبر بعض الآخرين من الرعيل المقدام وحيث بضعة فرسان وحيث بضعة نبلاء. وفي الجريدة تراكمت معنا ومع أولئك حرية الكلام وحرية الأدب والغوص على الطريف والتالد. وحيث استقبلنا الأسراب الملهمة وشتى الفصول وكنا غالباً نحلق ويحلقون وننال لذة الارتفاع ونشوة البلاغ. وننال أقصى ما نريد وأسمى ما نريد. وأنسي الحاج عبر أبيه لويس وعبر غسان تويني وعبر فرنسوا عقل على الأخص وعبر اللغة وكونها المتمردة، كان يخلق أسلوباً في الصحافة وفي مطهر الأشغال ورمي السهام حتى مداها الثمين، كما هو الحب والاندفاع وجلبة الربيع ويقظة النيام من النوم.
* شاعر لبناني
قمر في سماء نهارية
عبلة الرويني *
قبل سنوات عديدة، تحديداً قبل عشر سنوات، وجدتني في معركة مع أنسي الحاج، أقصد في معركة حوله، أقصد في معركة بسببه، تراشق، وغبار، وروائح دخان، وبكاء، وغضب محموم . لا لشيء إلا لأن أنسي الحاج رفض بعنف وتعالٍ أن أجري معه حواراً لجريدة «أخبار الأدب»، مفسداً مهمتي الصحافية لإعداد ملف خاص عنه للجريدة. وكان غضبي أشد، لم أفعل سوى البكاء المتواصل وسرد الواقعة، وكان ذلك كافياً لإغضاب اللبنانيين، إلى الحد الذي تساءل فيه الشاعر عباس بيضون: «وما الذي أتى بها إلى بيروت؟».
وسألني الشاعر عبد المنعم رمضان بهدوء لا يخفي لوماً: «هل كنت تريدين تقديم أنسي الحاج إلى الجمهور المصري»، كأن لسان حاله يعني بوضوح: «هل كنت تقومين بإعداد ملف عن أنسي الحاج، بدعوى منح الشاعر الكبير الفرصة للحضور في مصر؟». وكان أحد أسئلتي التي أثارت غضب أنسي الحاج، فألقى بالأوراق في الهواء، في انفعال غاضب. كان السؤال حول غياب تأثير قصيدته على شعراء قصيدة النثر المصرية، وأنهم (الشعراء المصريون) في الأغلب أحفاد محمد الماغوط، لا شاعر آخر. سؤال رمضان أنطوى على التعريض بي بالطبع، برغم أن الكتابة عن أنسي الحاج في القاهرة، كانت ولا تزال محاولة للاقتراب من عالم شعري غائب وبعيد عن المشهد الشعري المصري.
حقيقة لا تنفي مكانة، ولا تنقص تقديراً، حقيقة لا تجهل قيمة، ولا تتجاهل تاريخاً أو إنجازاً، تماماً كما أن محبة الشمس والانتماء للنهار، لا تعني عدم القدرة علي رؤية الليل، وإدراك سحر القمر …
أختصر اللقاء في معركة، وأختصر السؤال في غضب وتراشق، تماماً كما يختصر أنسي الحاج في أوصافه وألقاب ، فهو الشاعر «الملعون، الأنقى، العاصي، المتمرد، الوحشي، آخر القديسين». كما أن شعره أيضاً اختصر في مقدمة ديوانه الأول «لن»، بل إن مقدمة الديوان التي أعتبرت البيان الأول لقصيدة النثر، ظلت الأكثر شهرة وحضوراً من الديوان نفسه، وربما من كل أشعار أنسي الحاج، كما كتب الشاعر حسين بن حمزة، بل كما كتب أنسي الحاج نفسه «بعد ثلاثين سنة من كتابتي الشعر، لا يتحدث الباحثون في شعري، إلا عن مقدمة «لن»..».
الذين يعرفون أنسي الحاج، الذين قرأوه، النقاد الكسالى وربما غير الكسالى أيضاً يختصرونه وينمّطونه في صورة محددة واحدة ووحيدة. والقراءة حول أنسي أسهل عادة من قراءة أشعاره، والحكايات المثيرة والغريبة حوله، أكثر متعة عادة وأكثر رواجاً وقبولاً. هكذا، انتشرت شائعة مصادرة الأعمال الشعرية لأنسي الحاج في القاهرة، بتهمه العيب في الذات الالهية برغم قيام «الهيئة العامة لقصور الثقافة» بطبع 5 آلاف نسخة لأعماله الكاملة عام 2007، وبيع 4000 نسخة بالفعل إلى أن انتشرت شائعة التحفظ الشفاهي على النسخ الباقية في المخازن، بعدما احتج الشاعر محمود الأزهري على رفض طبع كتابه بحجة خروجه عن القيم والأخلاق، فصرخ الأزهري محتجاً: «ولماذا تكيلون بمكيالين، تمنعون كتابي، وتصدرون أعمال أنسي الحاج الكاملة، وهي الأكثر خروجاً وانتهاكاً!». الأهم أن النسخ الباقية من ديوان أنسي الحاج جرى توزيعها على 540 مكتبة تابعة لقصور الثقافة عبر محافظات مصر كلها، وهو ما يعني بالفعل «نقيض المنع» وتعميمها بصورة أكثر انتشاراً وحضوراً، لكنها الحكايات المثيرة، والرغبة في ملاحقة الصورة، وإضافة ألقاب وأوصاف واسهام في تأكيد النمط. لا يُعرف أنسي الحاج في القاهرة. لا تجري قراءته وتداول أشعاره، ليس ثمة حوار حول شعره، وما من مراجعات نقديه لتجربته. ليس ثمة تأثر حقيقي بقصيدته، قصيدة النثر المصرية هي بالفعل أقرب إلى قصيدة الماغوط، أو هي ذات ملامح وخصوصية تبعدها بالتأكيد عن قصيدة أنسي الحاج، وربما عن قصيدة النثر اللبنانية عموماً. يكتب الشاعر ابراهيم داود «لم يقرأ أنسي في مصر بسبب الخيال التقليدي الذي يدير الثقافة الرسمية»، لكن أنسي أيضاً لا تعرفه الثقافة الشعبية، أو هو لا يقرأ خارج الثقافة الرسمية.
هل هناك ما يغضب في القول بأنّ تجربة أنسي الحاج هي تجربة خاصة جداً وفردية جداً، وداخلية جداً، ومسيحية جداً، أسباب كافية لوضعه في سماء بعيدة، ومسافة هو أول من يدرك هوتها؟ كتب أنسي الحاج بعد قراءة «الكتاب»: «لأدونيس كتاب مهيب، لا أجرؤ بعد قراءته على أن أعتبر نفسي كاتباً عربياً، كتاب كهذا يفضح أميتي، كيف يكون كاتباً عربياً ويجهل ما تنضح به عروق أدونيس عن الإسلام؟ وما يكابده؟ وما أقتطع شطراً عظيماً من حياته في استنطاقه ومجادلته والتصارع وإياه؟ تكاد كل ملاحظة فيه أن تكون معجماً مصغراً عن الإسلام؟ وعن الجاهلية وكل العرب. والأخطر في أوضاعنا المتفجرة أن هذه التفاصيل باتت جزءاً من الحديث المتداول للأجيال اليوم، وبمعانيها التي علي رؤوسها القتال. من السهل القول إن هذا العالم لا يعنيني، أنني مسيحي ولن تكون أسماء السلطة والخلافة والدم أكثر من رموز بالنسبة إلي، ولكن من أنا اللامسلم في هذا الخضم الفاجع؟ إذا كان هذا الخضم لا يمثلني، فأنا طبعاً لا أمثله مهما حاولت مجاملته، ومهما حاول التسامح معي». هكذا، اختار أنسي الحاج أن يكون، أو هكذا كان دائماً، خارج تلك الأرض، وخارج تلك الثقافة، شاعراً لا يشبه إلا نفسه، يسكن سماءً بعيدة ووحيدة، ولا يريد أن يغادرها.
* كاتبة وناقدة مصرية
كأنّه نسيم ذاهل فوق غابة من أعاصير
شوقي بزيع *
لوحة بريشة الفنان اللبناني فؤاد نعيم تحية إلى أنسي الحاج
مات أنسي الحاج. هكذا قالت الصديقة المتصلة عبر الهاتف، قبل أن تطلب إليّ أن أرثيه بما تيسّر من الكلمات. لكن ما أنا بصدده هذه المرة ليس نبأ موت عادي لأُطرق قليلاً في المعنى الساخر للحياة، ثم أدبّج مرثية في رحيل الشاعر سبق لي أن كتبت مثيلاتها من قبل. فالموت الآن ليس حدثاً يأتي من الخارج لكي أدرأه بالكلمات أو بالأيدي، بل هو يندلع من الأقلام الصغيرة للروح تاركاً للجسد أن يصاب بالشلل، وللغة أن تسقط في الهذيان. صحيح أن أنسي كان منذ سنوات يعاني من مرض ما، كان صاحب «الرأس المقطوع» حريصاً على إبقائه طي الكتمان، ولكن الصحيح أيضاً أن أحداً لم يصدق أن هذا الرجل الاستثنائي في جبروته ورقّته يمكن للموت أن يأخذه غيلة، وللحياة التي منحها كل ما يملك أن تسحب البساط من تحت قدميه. قيل عنه الأنقى، وقيل عنه الساحر، وقيل عنه الأمهر، وقيل عنه القديس الملعون. وكل ذلك صحيح بالطبع، وهو فوق كل ذلك الذكي اللماح، والماكر على بشاشة، والذي يشيع أينما حلّ فرحاً في الاماكن وجلسات الأنس قلّ نظيره.
وهو الشاعر والناثر والمحرر ورئيس التحرير. وهو الذي رتّب في ضوء حضوره وجودنا على الأرض، وعلاقتنا باللغة ونظرتنا الى الجمال. وانتظرنا دائماً ضحكته لكي نضحك ودموعه لكي نبكي، وشكواه لكي نتبرم بالواقع، وعشقه لكي نتدرب على العشق، وتواضعه لكي نتخفف قليلاً من أحمال الصلف والادعاء. ولم نكن نعلم أن كل هذه الحيوات التي عاشها كثيرة على رجل واحد، وأن ثمة شيئاً كالموت يهيّئ لذلك الجبين المرفوع الشرك الذي لا فكاك منه، والعثرة التي سترديه في نهاية الطريق. كيف لأحدنا أن يتصوّر لبنان بلا أنسي الحاج. منذ عقود ستة تقريباً وهو يعمل بدأب النساك وصبرهم على ترميم الحدود الفاصلة بين ما سمّي المعجزة اللبنانية المتصلة بشهوة العيش وألف الإبداع ورحابة التنوّع الأهلي، وبين العجز الذي يقارب الشلل عن إيجاد ظهير سياسي ورسمي لذلك الحلم الفردوسي الذي يتمّ وأده والتضحية به كلما آنس طريقاً إلى التحقق. كأن أنسي هو التجسيد الرمزي للمقال اللبناني الأعلى الذي شكّلت مجلة «شعر» في الخمسينيات والستينيات نواته الجمالية وعموده الفقري. إنّه فينا بقية ذلك العالم الذي كادت تطمسه نذالات السياسيين وسعار الطوائف المتناحرة وانغلاق العقول المتطاحنة على تحجّرها.
ومن دونه لا يمكننا قراءة المعنى اللبناني، ولا قراءة معنى التنوير، أو روح بيروت، أو نهوض الحركة المسرحية، أو فتنة شارع الحمرا، أو الصعود المباغت للمسرح الرحباني الغنائي. ومن دونه لم يكن صوت فيروز ليجد، على روعته، من يحيطه بكل ذلك الخشوع الابتهالي.
كيف لأحدنا أيضاً أن يتصوّر الشعر والنثر بلا أنسي الحاج. فهو أحد الروّاد المؤسسين، لا في اجتراح قصيدة النثر العربية فحسب، بل في تخليص اللغة العربية السائدة من ترهّلها وميوعتها وجنوحها إلى الإنشاء والإطالة. وهو الذي «فخّخ» الشعرية القديمة، لا بالديناميت القاتل والماحق، بل عبر تقويض الأسس الموروثة للذائقة الجمالية وخضّها بعنف توليداً لما تختزنه من احتمالات جديدة وخيالات غير موطوءة. وحين تشعر أنّ المجازفة في «لن» و«الرأس المقطوع» قد بلغت التخوم التي لا تفضي إلى غير الصمت والعدم، كما حدث لمالارميه من قبل، أعاد أنسي اللغة إلى مرمى القلب وحقنها بأوصال الأنوثة والحب البريئين من شبهة التكلّف والإبهام، كما هي الحال في «ماذا صنعت بالذهب/ ماذا فعلت بالوردة» و«الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع». ومرّة بعد مرّة كان الشاعر يؤاخي بين صراخ الوحوش في البراري وبين تنهدات الفراشات في الحقول، ويوائم بين شهوانية نيتشيه وجموح زوربا وطهرانية ريكله وعذوبة «نشيد الإنشاد».
أما في النثر، فقد تخفف أنسي من كل أثقال الشعر وضروراته لكي تنبجس كلماته كالينابيع من جوف العالم، ولكي تلتحم بالحياة التحام الشجرة بنواتها، دافعة كهرباءها الغامضة إلى إصابتنا برعشة المفاجأة أو بنشوة الافتتان.
لكن من أتحدّث عنه الآن قد مات، وخلَّى لنا بلداً كسيحاً وقاسياً ومهيضاً وخاوياً على عروشه. ورغم كثرة معارفه، فإنّ قليلين هم الذين عرفوه عن كثب.
القليلون وقفوا على قراءة تلك الكاريزما النادرة التي امتلكها، والتي تضافر على صنعها وجهه الوسيم، وجبهته العريضة المرفوعة، وعيناه الطامحتان بالرغبة والحنو، وضحكته التي كانت تفيض عن حاجة الفرح والفكاهة المجروحين، لتصيب بعدواها بلاداً كاملة من البؤس والتجهّم والشقاء. قليلون وقفوا على تواضعه الجم، وأناقته البسيطة التي لا يحسن تقليدها الملوك، وعلى الخجل الذي يعتريه كلّما باغته مديح مفرط، وعلى الأنفة التي يبديها إزاء الجوائز والمناصب وحفلات التكريم. والآن وأنا على مرمى دمعة حارقة من غيابه أتساءل إذا ما كان أنسي الحاج مصنوعاً كسائر خلق الله من لحم ودم مجردين أم من غيوم بيضاء شرَّدها نسيمٌ فوق غابة من أعاصير.
* شاعر لبناني
ينابيع «الخواتم»
علي الديري
يعرف صديقي، الفنان التشكيلي البحريني عباس يوسف، عشقي لـ «خواتم» أنسي الأسبوعية، في جريدة «الأخبار». ويعرف أكثر أن مرسمه، هو مكاني المفضل لقراءتها. في حروف أنسي دوماً الجمال والحب، وأجدهما دوماً في مرسم عشتار ورباب، وهما المكانان اللذان يرسم فيهما أبوصبا.
الحب والجمال قيمتان مولدتان في المرسم وفي تجربة أنسي. نرتشف القهوة هناك ونستلذ بتقطيع نصوص الخواتم وقراءتها وكأنها آيات منجمة أو محكمة أو متشابهة، نهيم في ظلال الألوان على وقع مذاقها.
في هذا المكان (المرسم) الذي هو في معناه أكثر من مرسم وأضيق من محترف وأمتع من مكتبة وأعمق من مجلس وأجمل من مقهى وألذ من حانة، قرأت قصيدة أنسي “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع”. كانت متعة اكتشافها تشبه لحظة الوقوع على ينبوع ماء وسط البحر، لا وسط الصحراء، وهي صورة لا يعرفها إلا من عرف ينابيع البحرين التي تنفجر وسط البحر. الجمال وسط الجمال، جمال البحر المالح وجمال الماء العذب لحظة الالتقاء من دون أن يبغيا، في مشهد طبيعي نادر. هكذا تبدو لي نصوص أنسي، ينابيع ماء وسط بحر جميل، لها قوتها وفرادتها وخصوصيتها ومذاقها.
منذ ثلاث سنوات أي منذ مغادرتي البحرين، وأنا أتشوق لطقس المرسم، وقراءة أنسي فيه. كثيرة هي الأوراق التي تحمل «خواتم» أنسي تركتها هناك. أعرف أن صديقي عباس يحب قراءة الخواتم مطبوعة على الورق. لعله حدس ما، كنت أهجس به، أنها ستستحيل يوماً لوناً أو خطاً أو لوحة. أعرف تماماً أن الألوان في تجربة عباس يوسف مفتونة بالكلمات، الكلمات تشم ألوانها، وجدران المرسم شاهدة على ذلك. نكتب عليها الكلمات الفاتنة في لحظة مرح اكتشافها، إنها مختومة على الجدران كفصوص خواتم جميلة.
قبل أسبوع يصلني عبر «الواتس آب» من مرسم عباس “صديقي هذه اللوحات لم تعرض ولم يرها أحد غيرك ورباب الأعمال نتاج 2013، بمقاس 50/70 سم” انظر في اللوحات، فإذا هي خواتم قصيدة “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع”:
أيُّها الرّبُّ إلهُ الخواتم والعُقود والتنهّدات
يذهب الناس الى أعمالهم
ومن حبّها أذهبُ إليك
هي تنظر فأراكَ
بقدر ما كنت منتشياً بختم تشكيل اللوحات التي ستخرج في شكل كتاب يدوي فني، كنت لحظتها قلقاً أن أخبره أن أنسي على وشك أن يختم حياته، كما ختم درويش حياته قبيل أن يعرض عباس لوحات قصيدته «كاماسوترا». صباح الأمس، أرسلت له ما يشبه النعي المبكر لأنسي من أحد الكتاب، كنت أهيئه لاحتمال أن أنسي لن يتمكن من رؤية حروفه ألواناً فاتنة في لوحاته.
«خواتم» أنسي هي النهايات لكن ليس بمعنى الإقفال بل النهايات بمعنى الذروة في الجمال، والإيجاز والفرادة، والأثر الذي لا يُمحى، هي أشبه بالفص المكتمل التكوين، وهي بهذا المعنى أقرب إلى “فصوص الحكم” ابن عربي، كلاهما ينابيع للحكمة والجمال والحب.
* كاتب بحريني.
لقد خسر الشعر طراوته في غيابك
عماد استيتو
الرباط | ما عاد يحتمل الأرض، وما عاد يحتمل الجالسين، مثلنا نحن ربما، كما قال في إحدى قصائده. هكذا اختار أنسي الحاج أن يغادرنا فجأة بعد صراع قاس مع المرض، لم يعد بيننا لأن ريشة من عصفور في اللطيف الربيع كللت رأسه، كان للشاعر الكبير جمهوره العريض. ليس في لبنان وحده فقط، بل في كل بقعة من بقاع الوطن الذي يتنفس العربية. لذلك اتشحت جدران جمهوره المغربي بالسواد بمجرد أن وصل الخبر الحزين.
صحافيون، كتاب، مدونون، ناشطون شبابيون، ومتذوقون للشعر، وحّدهم الحداد على رحيل أنسي. الفايسبوك المغربي غطته “لن” وزينه “الرأس المقطوع “. الصحافي والشاعر المغربي محمد أحمد عدة كتب على صفحته على الفايسبوك: ” أيها العالم، مات أنسي الحاج، بمقدمة ديوانه “لن” يكون أنسي الحاج الشاعر العربي الوحيد الذي كتب بياناً أصيلاً ومؤسساً لقصيدة النثر العربية، خارج قطيع سوزان برنار، وداخل شرنقة الشذرة المختزلة لليومي، خونه كثيرون ممن أرادوا ان يكون الشعر بياناً إيديولوجياً، وأبعده عن مملكة الشعر آخرون أرادوا صلب الشعر الى عمود القصيدة، وطارده سفلة التفعيلة. وداعاً يا صاحب الوليمة”.
الصحافي محمد أحداد كتب غير مصدق موت أنسي الحاج ” هل فعلا رحلت دون أن تكمل رحلتك في أعالي القصيدة؟ أنت من خارج الأرض جئت شفافاً، رسولاً للكلام الطيب، صمتّ عن الكلام الرديء” ماذا صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة؟ القدر انتقم مد “رأسك المقطوع” وصعدت إلى حتفك باسماً… وداعاً أنسي”. أما رسام الكاريكاتور المغربي خالد الشرادي، فكتب: «فقدان الكبار المؤلم. عملاق جديد يرحل، يبدو أنه لن يبقى سوى الرديئون على هاته الأرض”.
بينما تعيش الدار البيضاء معرضها الدولي للكتاب هذه الأيام تؤبن روح “الفاجومي” الراحل أحمد فؤاد نجم، سقط خبر الخسارة الفادحة. الشاعر محمد عابد لخص كل شيء في جملة واحدة “لقد خسر الشعر طراوته في غيابك يا أنسي”. صديقه الشاعر محسن العتيقي هو الآخر قال إنه لا شفاء من إدماننا على أثر أنسي الحاج، وأضاف “حقق النجومية في مجال لا نجومية فيه، فجعلنا نستلهم ميزان جملته الشعرية، تقديمه وتأخيره للكلمات، قرار العبارة كما لو كانت مقاماً موسيقياً. لم نسلم من صورة المريدين، ولم يشأ في المشيخة الشعرية. لكننا تبعناه كما يتبع الجمهور المغني، وكذلك كان منشداً للحياة والحلم، متصوفاً وعازفاً على الربابة اللغوية، أفقده الجمال جماله، فأيقن الشعر التام في نسيانه، ولا شيء أوقفه، فجعلته القناعات معلماً نبيلاً”.
العزاء واحد. قلة هم الشعراء الذين استطاعوا أن يخلقوا حولهم إجماعاً من المحيط إلى الخليج، وأنسي الحاج كان واحداً من هؤلاء فلا عجب أن يكون موته صادماً لمحبي قصيدته في كل مكان، هوواحد من أولئك الذين يزلزلنا موتهم، يكون موتهم قاسياً علينا لدرجة الإنكار، أنت لم تمت يا أنسي، كلما تعبنا سنستحضر “خواتمك”، وداعاً يا معلمناً، لك من المغرب سلام.
الحوار الأخير… إيه في أمل
■ سأبدأ حديثي عن زمن عبر، عن الطفولة. أخبرني عن أهلك وصف لنا المكان الذي سكنت وتربيت فيه؟
أنا من بلدة قيتولة في قضاء جزين (جنوب لبنان). لكنني ولدت في بيروت في «مستشفى الدكتور جورج حنّا»، وسكنت مع أهلي في حيّ خندق الغميق. كان الحيّ مزيجاً من كل الطوائف، من الأرمن، الأكراد، السريان، المسلمين شيعة وسنة، ومن المسيحيين.
وكان في فيه كنائس وأديرة، ومازالت كنيسة السريان قائمة إلى اليوم، وأيضا مدرسة الفرنسيسكان للراهبات. أذكر دكاكين بائعي الخضار، وعلى بعد أمتار منها الـ«غران تياتر» (المسرح الكبير) الذي يمثل تاريخاً مهماً، وفي مقابله توجد «دار المكشوف» التي نشرت الكثير من الكتب اللبنانية المهمة. كانت بيروت حينها «ملمومة» على بعضها، وكان شارع واحد يضم كل الناس.
أمي توفيت عندما كنت في السادسة، وكانت قد أنجبت أربعة أولاد؛ صبيانان وبنتان. ثم تزوّج والدي وأنجب ستة أولاد، فأصبحنا عشرة. أبي كان من الآباء الكادحين، وعمل في أماكن عدة ليؤمّن تكاليف تعليمنا في مدارس راقية. لم أره يوماً بلا عمل، فحتى في البيت كان يعمل. كان يكتب، ويترجم، ويمارس الصحافة بين جريدتي «النهار» و«المكشوف».
لا أدري إن كانت طفولتي سعيدة أم حزينة، لكنّها كانت مخطوفة. لم أكن أملك الوعي الكافي لأضع «اتيكيت» تقول ما إذا كنت فرحاً أو حزيناً. لكن حين توفيت أمي، قرّرت ألا آخذ علماً بوفاتها، وقرّرت عبر نوع من النسيان اللاإرادي أنّها لم تمت.
■ أما زلت تعي تلك اللحظات التي توفيت فيها؟
أجل. ولا زلت أراها مسجّاة وقد أمسكتني أختي «ليلى» كي أقبّلها قبلة الوداع. كانت أصعب وأقسى اللحظات في حياتي.
■ كنت مدركاً ما حدث؟
الموت لا يحتاج إلى الكثير من الفهم. أعتقد أنّ الطفل هو أكثر من يشعر بالغياب. هو لا يحس بغياب من يحبّهم فقط، بل يترك فيه بصمات لا يمكن أن تزول. فالطفل عجينة.
■ إلى أي مدى كانت علاقتك بها قوية؟
يخبرني إخوتي أنّني كنت الطفل المدلّل عند أمي وأبي، ولا أدري إن كنت أستحق هذا الدلال الذي اعتبرته حينها حقاً طبيعياً رغم أنّه مؤلماً للآخرين بسبب التمييز الناتج عنه. أحيانا يقرّر الأهل أن يمنحوا دلالهم لطفل معيّن.
■ هل تستطيع أن تصف ما قالوه عنك وأنت طفل؟
لا أحب أن أذكر هذه الأمور. كل الأهل يلاحظون في أبنائهم أشياء غير موجودة في الواقع، بل هي إسقاطات ناتجة عن المحبة. وتداول هذا الإسقاط يثير الضحك، فالأذن الغريبة الموضوعية ستتعجّب لو سمعتهم.
■ ألا يعجبك ما قيل عنك؟
لا. لقد كنت أفضّل أن أكون طفلاً مهملاً، وإذا واتاني الحظ في ما بعد، أستطيع أن أقول أنّني وصلت إلى ما توصّلت إليه بفضل جهدي الخاص، على أن أكون طفلاً مدللاً لن يستطيع تحقيق ما توّقعه منه أهله، مهما فعل.
■ هل كانت أمّك سيّدة جميلة بنظرك؟
كانت أمي جميلة جداً بحسب ما تبرزه الصور. وكانت شاعرة تكتب الشعر باللغة الفرنسية. أهلها من عائلة «عقل»، أقاموا في «قيتولة»، لكنّهم ولدوا في مصر. فجدي لأمي هاجر إلى مصر حيث كان يعمل في استوديو للتصوير الفوتوغرافي في المنية، وأنجب أولاده هناك، وهم يمتازون بطباعهم المصرية.
لقد كانت أمي على جانب كبير من الثقافة، كما تمتعت بالحس المرهف، وتركت كتابات احتفظنا بها أنا وشقيقتي الكبرى. وهي عبارة عن كتابات رومانسية حزينة يغلب عليها طابع الكآبة والألم.
■ هل تألّمت في حياتها؟
أصيبت بالمرض لكنّها سريعاً ما وافتها المنية، ولم يُتح لها المجال للتعبير عن ألم المرض. لكن الألم تخلقه الحياة؛ من مراهقتها إلى التربية المحافظة التي تلقّتها إلى القيم والمثل العليا، إلى حلم الحب الواحد والإخلاص الأبدي، ثم ما لبثت أن رزقت بأربعة اولاد وهي لا تزال يافعة.
■ هل تزوّج والداك عن حب؟
طبعاً ولهما قصة. كانت أمي مخطوبة من عمي، أخ أبي، الذي سافر إلى الشام ووكّل أبي ــ أخوه الأصغر ــ بالإهتمام بـ«ماري» (أمي)، فاهتم بها أبي إلى درجة أنّه عشقها، ثم خطبها وتزوّجها (يضحك).
■ إذن أنت ثمرة علاقة حب؟
أكيد، فأبي كان يعشق أمي، كما أنّه أحبّها واحترمها كل من عرفها من الوسط الصحافي من زملاء أبي واصدقائه في العمل. أحدهم هو كامل مروة، صاحب جريدة «الحياة»، وأخته «دنيا». لقد كانا من أصدقاء العائلة، وقد حدّثوني عنها وعن كيف كانت تستقبلهم، وأثنوا عليها.
■ وفقاً لعلم النفس، إذا توفي أحد والديّ الطفل فإنّه يشعر شعوراً عميقا بالذنب. وهذا الإحساس يتجسد كآبة و حزناً دفينا، أو أنّه يولّد عدم الإستقرار مع النفس أو رعباً من الحياة في مكان ما، لأنّه إذا اعتبرنا أنّ الأم هي الحياة، فكيف تموت؟ أنت أنسي الحاج خلال حياتك، هل نمت معك هذه المشاعر أم رافقتك مشاعر أخرى؟
أتعلمين أنّه يصعب على المرء أن يسترجع ذكريات ومشاعر وانطباعات نشأت في السادسة أو السابعة من عمره؟ أنا أشعر أنّها فترة غائبة، وأنّ شعور الذنب يسيطر عليها مئة في المئة، وهو يُعزى إلى سبب واضح جداً وجارح بالنسبة إليّ. أمي لم تكن تعلم ما الذي أصابها، والطب في تلك الأيام كان أرحم من أيّامنا هذه. فالطبيب ما كان ليُخبر المريض بمدى خطورة مرضه بل كان «يكذب» عليه على أمل أن يساعده ذلك في مقاومة المرض. وأمي كانت ذكية إلى درجة أنّها شعرت بأنّهم يخفون عنها الحقيقة. وذات يوم، ربما كان يوم أحد، وبينما أنا في البيت وحدي معها حين كان أبي في العمل، نادتني وطلبت منّي أن أدسّ يدي في جيب معطف أبي المعلّق لأعطيها ورقة كانت بداخله. أعطيتها الورقة التي كانت عبارة عن «رابور» (تقرير) طبي، فعلمت بحقيقة الأمر. وعندما حضر إخوتي، أنّبوني على فعلتي، علماً أنّني كنت طفلاً لا أحسن القراءة ولا استطيع أن أرفض لأمي طلب.
■ ممً كانت تعاني؟
عانت من سرطان الرحم، وكان ذلك في عام 1944 حين لم يكن العلاج متاحاً.
■ كم كان عمرها آنذاك؟
كانت في العشرينيات، ربما في السادسة والعشرين. لم أعد اذكر بالتحديد. موتها لا يمكن أن أنساه إطلاقاً، وقد تربّى معي رغم الدلال الذي عشته. فإذا حدث زلزال في اليابان، أشعر بأنّني مذنب. وطوال الحرب الأهلية اللبنانية شعرت أنّني مذنب تجاه الجميع، وهذا الشيء يحمل نوعاً من الجنون، كما فيه تضخماً للـ«إيغو» (الأنا)، لكنّه ضد صاحب الـ«إيغو» وليس تدليلاً للذات. بل على العكس، فيه قتلاً مستمراً للذات. وعندما ينتابني شعور معاكس أشعر بذنب مضاعف، فكيف أكون سعيداً في الوقت الذي لا ينبغي أن اكون كذلك؟ وهذا الشعور يرافقني طوال الوقت، وهو أساس كل ما أفعله، وكل ما أكتبه، وكل علاقاتي.
■ هل شكّل مسرحاً لحياتك؟
شكّل القاعدة لحياتي كلّها.
■ من ربّاك بعد وفاة الوالدة؟
أختي الكبيرة كانت بمثابة الأم لنا كلّنا، وحتى لأخي الأكبر منها سناً. تعلمين النزعة الأمومية التي تكون عند البنت، وقد كانت أختي مُحبّة، ومتفانية، وكريمة جداً، وقوية أيضاً، وكانت تملك القدرة على تحمّل المسؤولية رغم أنّها كانت في بداية عمر المراهقة. وقع عليها العبء، ونجحت في تحمّله بشكل ممتاز جداً.
■ أبوك، ماذا فعل؟
بعد موتها، لعب أبي الدورين، فكان الأب والأم معاً. وأذكر أنّني لم أكن أنام إلّا على يديه، يحكي لي الحكايات ويُسمعني الأغاني. وقد ورثت عنه أشياء لم يقصد أن يورثني إيّاها، وهذا هو الإرث الأعمق. لقد كان رجلاً موهوباً ومتضلعاً لغوياً. قدرته على الكتابة البسيطة والمباشرة كبيرة جداً، ويا ليتني ورثت هذه الطريقة منه لكنني عكسه. هو مشهور بأسلوب ابن المقفّع السهل الممتنع، أما أسلوبي فممتنع وغير سهل. شخصيتي معقدة في حين كان أبي شفافاً ومباشراً وواضحاً ونيّرا، وكان صاحب شخصية متفائلة ومحبة للحياة، ومعطاء ومتواضعاً وقنوعاً.
■ هل ترك فيك أثراً؟
أثّر فيّ كثيراً عندما بدأت أعي الحياة وأرى أساتذة اللغة العربية في المدارس التي ترددت عليها يبدون اتجاهي اهتماماً متزايداً عندما يعلمون من هو والدي.عندما توفيت أمي، هبطت روح أبي إلى الهاوية، وانهارت أشياء كثيرة في نظره. لم يعد للحياة قيمة عنده، لذا صار مستهتراً: يكتب مقالاً بدون توقيع، ويرضى بأي راتب يُعرض عليه، ووصل إلى حد القرف. لم يكن يعبّر عن هذا الشعور أمامنا فقد كان يجمعنا ويطلب منا أن نغنّي له، وكان يبدو سعيداً جداً «قد الدني». أبي مجاز في الحقوق من «جامعة دمشق»، وكان يفترض أن يكون محام. هو مؤهل لهذه المهنة وكان يتقن اللغة القرنسية. أما العربية، فكان إتقانه لها أكثر لذلك كان مترجماً، وترجم الكثير من الكتب في مختلف حقول الكتابة من الطب إلى السياسة إلى الأدب.
من هنا، وحين صرت كاتباً صار لدي رغبة بالإنتقام له. صرت أكتب إسمي مشفوعاً باسم والدي في الجرائد، بهدف منحه الشهرة رغم أنه كان مشهوراً حينها ومعروفاً في الاوساط الصحفية. لكنّني أعتقدت دوماً أنّه مظلوم في المجتمع.
■ هل لعب حساسك بالذنب دوره؟
أجل. كنت أحزن حين أنظر إلى جريدة «النهار» وهي تباع على الطرقات ولا أرى إسم أبي بل إسم عائلة تويني. علماً أنّ أبي وشخصين أو ثلاثة معه كانوا يصدرون الجريدة. ففريق العمل آنذاك كان قليلاً جداً. لم أكن أعلم حينها أنّ أبي هو من لا يرغب في ذكر اسمه وليس مظلوماً من أي أحد. حتى أنّ غسان تويني كان يعتبره أباً ثانياً ويكنّ له حباً كبيراً. صرت أرغب في منحه الشهرة بكل غرور الفتى.
■ أخبرني عن علاقتك بأخوتك؟
أخي الأكبر «عدلي» ساعدني على نشر أولى مقالاتي وهو صحافي عريق مارس المهنة قبلي، وأختي الصغيرة من أمي «دنيا» تحتل مقاماً مهماً في حياتي، هو مقام الأخت الصغرى التي ليس لها أم. كنت دوماً أشعر برغبة في حمايتها، ولكن كان الأمر صعباً. فكيف أحميها وأنا عاجز عن حماية نفسي؟! وبرغم أنّنا كنّا نعاني الفقر، شعوري بأنّها ظُلمت كثيراً لحاجتها إلى عطف الأم كان يفوق حاجتي بأشواط كثيرة. أنا لدي «إيغو» يحميني، أما هي فحتى الـ«إيغو» لم تحظ به.
اليتيم مقطوع الرأس والقلب، ويظل يتيماً طوال حياته حتى لو صار جَدّاً. وحتى لو أعطي «دون جوان» كل نساء الأرض، فلن يشعر بالشبع. ليس لأنّه «أزعر» بل لأنّ في داخله صحراء مهما رواها الماء ستظل عطشى. وسيظل جائعاً طوال حياته.
■ حزين هذا الحديث .
لا هذه هي الحقيقة .
■ حقيقة جارحة ولكن ألسنا جميعا يتامى؟
كل إنسان منّا يتيم ونحن يتامى من الأساس، وليس اليتم أن يفقد الإنسان ابويه جسدياً. أحيانا يكونان موجودان فقط وجوداً جسدياً، وهو ليس وجوداً حقيقياً حين لا نرضع منهما الحليب الآخر أي الحليب المعنوي والعاطفي. نحن الشرقيون خصوصاً، ربما لدينا جوع عاطفي يفوق الجوع الموجود لدى شعوب أخرى.
نحن نتربى على فكرة الأسرة فلا نستطيع أن نحيا من دون الأم والأب. الأسرة هي معطف الروح، وإذا خلعها المرء أو شعر أنّ الأبوين مشغولان عنه سيشعر بالبرد.
■ الصبي خصوصاً إذا ماتت أمّه فإنّ ذاتيّته ومحوريّته حول نفسه ينموان، لأنّ الأب ينمّي شخصيّته الإجتماعية والجماعية. أنت كونك يتيم الأم هل دفعك هذا الوضع إلى الإهتمام بنفسك على حساب الآخرين؟
في مراحل متناوبة، كلعبة «يا طالعة يا نازلة»، أحيانا ما عدت أرى سوى نفسي وبشكل سادي، وأحيانا تكون ردة الفعل عكسية تماماً فيحدث الإنمحاء من أجل الآخر. لكن الفترة الطفولية كانت فترة ضياع روحي يشبه قطع الرأس كما قلت سابقاً. كنت أشك بأنّني سأنجح في مدرستي. وكان أبي يمازحني بالقول: «طالما أنّك فاشل في الحساب ستصبح صانعاً فرّاناً»، مشيراً إلى الفرن الذي كان بالقرب من منزلنا في منطقة النويري (بيروت). كنت حين أذهب لشراء الخبز منه أشعر بالسعادة لأنّني أجد الدفء عنده، لأنّ منزلنا لم يكن مجهزاً بوسائل التدفئة، وكنت أطيل المكوث فيه والعائلة بانتظاري.
■ هل كان أبوك يتمتع بحس الفكاهة؟
طبعاً، كان يمازحني ليحمّسني على الإجتهاد أكثر.
■ قلت لي أنّه تزوّج بعد وفاة أمك، متى تزوّج؟
لم ينتظر طويلاً نظراً لوجود أربعة أولاد صغار لا يستطيع الإهتمام بهم في الوقت الذي هو ملزم بالذهاب إلى العمل. لذا تزوّج بعد فترة قصيرة.
■ كيف كانت علاقتك بزوجة أبيك؟
كانت علاقة جيدة جداً. خالتي «أليس» إمرأة تمثل مزيجاً من الطيبة والإرادة. والإرادة كانت ضرورية في تلك الحال. كانت تكبر أخي الكبير بسنوات قليلة وكانت جميلة أيضاً. وامتلاكها لهذه الصفات مجتمعة مكّنها من القيام بأعباء العائلة مع الأطفال الستة الذين أنجبتهم. كانت طيبة إبنة القرية بإرادة فولاذية للقيام بالأعباء بشكل صاف.
■ كانت تحبّكم رغم أنّكم لستم أولادها؟
طبعاً. لم تشعرنا يوماً بالفرق بيننا وبين أولادها، بل على العكس، رغم الأوضاع الصعبة والفقر الكبير الذي عانيناه. لكن في السنوات العشر أو الخمسة عشر من حياته المهنية، استطاع أبي شراء منزل في منطقة عين الرمانة (جبل لبنان). كان ثمن البيت يومها ثلاثون ألف ليرة لبنانية، وكان حدثاً مهماً جداً ومدهشاً.
■ هل أثّر الفقر على شخصيتك؟
أجل، لكن ليس بشكل مأساوي. فأنا لا أدلّل على أنّنا فقراء، وهذا شأن شخصي وليس موضوعا للكتابة.
■ هل كنت تشعر بالفرق بينك وبين أصحابك؟
أكيد كنت أشعر بالفرق.عندما كنت أدخل إلى بيوت أصحابي، كنت أخجل كثيراً. وقليلاً ما حدث أن زرت أحدهم، ربما مرّة أو مرّتين. وحدث ذات مرّة أنّ دخلت مع أحدهم، وهو من آل البساتني، إلى بيته الكائن في «البسطا الفوقا» فوجدت سجاداً على الجدران ولم أجرؤ على الدخول، وتساءلت في نفسي أنّه لا يعقل أن يكون هذا منزل بل معبد! (يضحك). رأيت صواني نحاس، فتعجبت حدّ الإندهاش، وشعرت بهيبة ساحقة إذ سحقني ترف البيت وظللت واقفاً، ولم أجلس. أحسست أنّه من العيب أن اجلس. كان صديقي شامي، والشوام يعتنون كأهل بيروت وأكثر بأثاث المنزل وبالزينة.
■ هل شعرت بالفروق الطبقية؟
أحسست بالفرق، لكنني كنت معجباً ولم أكن مقهوراً أو حسوداً. فهؤلاء الناس مميّزون حتى يمتلكوا هذه الأشياء، وهم يستحقون أن يكونوا أغنياء. أنا لا أحسد بل أُعجب، ومن أُعجب به أحبّه، وبالتالي فما لا أملكه لنفسي أحبّه لغيري. أنا أحب الأغنياء وأخاف على أموالهم ، وعليهم من الإفلاس، ولا اشتهي الحصول عليها، فأقول مثلاً: «إن شاء لله الحريري ما ينقصوا مصرياتو» (يضحك). أشعر أنّني أخاف على النبع، وسواء كان لي أم لغيري فهو يتدفق، واخاف عليه أن يجف سواء كان من يشرب منه ماعزاً أم بشراً أم عصافير أم بقراً أم وروداً.
■ لديك إذن شعور بالشفقة والخوف على الآخرين؟
الخوف على الآخرين تماماً
أبوك قام بدور الأم والأب حسب قولك. رؤيتك إيّاه في البيت عندما كان يهدهد ويغني لك ويهتم بك، هل دفعتك إلى اكتساب صورة أنثوية عن الذكر؟
لا أبداً، فأبي كان ذكراً «ومكتّر». وهذا الشعور غير موجود أبداً. فتدليله إيّانا لم يكن يحمل في طيّاته صفة خنثوية أو أنوثة، بل كان تدليل رجل. أما مزحه ومرحه فكانا الجانب الطريّ من شخصيته، وليس إنحلالا أو «هرقة».
■ هل كانت لديه هيبة؟
هيبة غير عابسة بل ضاحكة. وأتمنى أن يكون لدى كل الأولاد آباء يمتلكون هذا النوع من الهيبة. هو يمازحك ويخاويك قدر ما تشائين، إلا أنّك تظلّين تشعرين بأنّ «الحائط أعلى منك». وهو شعور تلقائي وليس هيبة مفروضة باسم العادات والتقاليد.
■ هل كان والدك يحب النساء ويعدّد علاقاته؟
يُقال. ولكن أمامي كان يتحفّظ، ويبدو حريصاً على الحشمة لأنّني كنت بريئاً جداً. وهو شعر أنّني معجب جداً به، فلم يرغب أن يخدش هذا الزجاج الجميل، واستمر هذا الوضع إلى ما بعد زواجي وحتى موته.
■ وجودك أنت بالتحديد؟
أجل. يبدو أنّني كنت أذكّره بأبيه. يُقال أنني كنت شبيه جدي الذي كان شيخ الضيعة. الشيخ «نعيم» كان قاضي صلح، ولديه هيبة ومصداقية، وكان الناس يحتكمون له. وكان عندما يشعر أبناؤه أنّه قادم إلى البيت، وبمجرّد أن يسعل، يهرولون إلى الداخل: «إجا الشيخ نعيم». ما كانوا يقولون «بيّنا». رغم كونه لطيفاً، كان لديه هيبة مستحقة وليس هيبة الإرهاب التي تحرّض على التمرّد عليها، فالصرامة الإرهابية ليست مقبولة. أما هذه الهيبة، فمستحقة وكأنّ الأمر يبدو تسليماً. فهذا الشخص يصبح مرجعاً ولا نقاش في الموضوع. سلطة طبيعية وليس سلطة مفروضة.
■ هل أثيرت غيرتك عندما تزوج أباك إمرأة ثانية؟
لا أعرف، ولا أستطيع أن أحلل الأمور في ذلك الحين، فأنا كنت طفلاً صغيراً. لكن أعتقد أنّه كان هناك شعورين حينها: شعور بأنّ الفراغ قد تكرّس في داخلي. رغم أنّني تناسيت موت أمي إرادياً، لكن الزواج الثاني نبّهني في وعيي، وتحت الوعي، أنّ الفراغ سيحلّ إلى الأبد. وفي الوقت نفسه، شعرت بالإمتنان لوجود شخص مؤنس وقويّ يحملنا ويرعانا في البيت.
■ من المؤكّد أنّ أحداً لم يملأ هذه الفجوة؟
أكيد لا أحد، وهذا شيء مستحيل
حوار مع لوركا سبيتي على “صوت الشعب”
المشاعر الإنسانية:
■هل تكره؟
نعم ولكن لا أكره أناساً بل حالات. حين لا يفهم أحدهم ما أريد أو ما أشعر أغضب. كنت أكره حين كنت غبياً وولداً صغيراً، لا ليست الكلمة «غبياً» بمكانها الصحيح بل كلمة «أحمق» بالتحديد. غبي ربما ما زلت كذلك، ولكن الحماقة تتكسر مع العمر. كنت أكره عن عجز وعن شعور بالضعف اتجاه من هو أقوى. حين كنت ولداً كرهت من له سلطة عليّ ومن يمارس قوّة حين لا أقدر أن أغلبه.
■وهل قتلت أحداً خارجك؟
في الخيال نعم. أثناء الحرب قتلت كل المسؤولين الذين يقتلون الناس، ولكن في اليوم التالي أفرح حين أراهم على قيد الحياة، أشعر أنّهم لا يستحقون الموت. أو ربما يوماً ما أحدهم سيقتلهم عملياً وليس في الخيال.
■عرفت البشرية في بداية تاريخها في قصتين: حين قتل آدم الله في داخله واستبدله بحوّاء، وحين قتل قابيل أخوه هابيل. كيف تشرح فعل القتل أنسي الحاج؟ كفيلسوف؟
لا لست فيلسوفاً بل أنا لست شيئاً، أنا إنسان عادي حين يغلبني شعور ما أجرّب أن أكتبه كي أستقوي عليه وأقتل شياطينه فيي. لا أعتقد أن آدم قتل الله. أنا في كتاب «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع» جرّبت أن أقول أنّه إذا كان هناك خطيئة فهي خطيئة السلطة. حين جرّب آدم أن يكون مكان الله، وفكر أن الله نائم في مكان ما وهو الآن الزعيم، وملكه على الحيوانات والعشب والأرض وأعطاه حق التصرف، وكل الأشياء تحت أمري، فقرّر أن يكون الآمر. هذا رمز لسلطة الرجولة ورجولة السلطة التي استوجبت بحكم طموحها وطبيعتها وتطلعاتها التضحية بالآخرين وأوّل ضحية كانت حوّاء وليس العكس، كما يعلموننا في الأديان أنّ حوّاء هي التي جرّت آدم إلى الخطيئة، وكيف ذلك، فالجنس هو التعويض عن البؤس وهو نعمة وليس خطيئة. الخطيئة هي الانقلاب على السلطة.
■إذا آدم ثار منذ السماوات وورثنا هذا الشيء؟
طبعاً هو الثائر الأوّل. أنا جرّبت في كتاب «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع» أن أقول أنّ النزعة السلطوية موجودة في الإنسان والحيوان على السواء، فهاجمة الأسد والنمر غزالاً ومحاولتهم قتله وتمزيقه أليست جريمة؟ ولكنّي لا أصدّق كيف أنّ هناك من يقتل ويأكل غزالاً!
الشرّ هو عدم القبول بالضعف. أن تكون أضعف من الآخر، حين يكون الآخر فريستك فقد تحوّلت إلى قاتل وتحوّل هو إلى قتيل. الفضيلة أن أكون القتيل بل بمعنى أدق المضحي. أن أحب، فالحب هو السمو بهذا الكائن الميال إلى الإنحطاط ، الإنسان، لا يسمو به إلا الحب. فالحب يجعله إله. فيقتل فيه ثلاثة هم الشرّ والطمع والسلطة، وهم بهامية البشر، الإلهية أن تفدي الآخر بالحب.
■هل نسطيع القول أنّ الإنسان قاتل بالفطرة؟
لا أظن. الطفل ليس بقاتل هو ملاك. والإنسان يخلق طفلاً، ولكن المجتمع وقوانينه تجبره أن يكون ذئباً. المثل الشعبي الذي حفظناه هو: «إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب»، تخيّلي أننا تربّينا على هذا المثل الأخلاقي الشعبي، وهذا يعني أنّ النضج يخربنا حين نكبر ونمتلك ونملك ونبني وننشأ العائلة ونود أن ننشهر.
فعل الإماتة عند المسيحين مهم جداً، أو التضحية بالذات. فعلى قدر ما تميتي نفسك تظل تحتاج للأماتة لأنّك إن تركتها فسيعود الرفاص إلى طبيعته. ومن هنا نتعلم من حياة الرهبان، من كل الأديان، تشفيف الذات، أبشع شيء في الحياة هو الكثافة.
الدين والعلاقة مع الله:
■ كيف تفهم الله، وهل تمارس طقوس دينية؟
علاقتي بالله جدلية. أحيانا تخفّ وأحيانا تشتّد. أحيانا تكون سلبية وأحيانا إيجابية.عندما يغلب الإيمان على الشك أو بالأحرى على عدم الشعور بوجود الله، غالباً ما يكون مشوباً بشيء من التمثيل كمن يؤدي دوراً على المسرح: يا إلهي! حيث توجد غنائية مصدرها الخوف والضياع. ففي حالة الضياع يبحث الإنسان عن مسند وإلا فإنّه يتشتت في الخلاء. لا أعلم إن كنت مؤمناً أم لا. مع أنّني أفضّل أن أكون مؤماناً.
■ لماذا تفضّل الإيمان؟
في مكان ما، أشعر أنّ الإيمان بكائن منظّم للوجود وللكون هو في الحقيقة إيمان بالنفس. بمعنى أنّه يمنحني الشعور بأنّني الإله، وبالتالي فإنّ الموت لن يقوى عليّ بالمعنى الوجودي للكلمة وليس الجسدي. أي اللحم والعظام والدم، التي تندثر لتصبح طعاماً للحشرات. لكن بالمعنى الروحي والفلسفي والديني معاً.
■ أيحتاج الإنسان إلى فكرة الإله؟
المسألة ليست أنّه يحتاج بقدر ما إن الله انعكاس للإنسان وبالتالي الإنسان انعكاس لله. فعندما أقول أن الله غير موجود، هذا يعني أنّه ليس لدي قبس ولا نور، لا في كتاباتي ولا في فكري ولا في عقلي. فهل أنا مجرّد آلة بيولوجية، هل يعقل أنّ الآلة البيولوجية تنتج إنساناً كموزار وبيتهوفن؟ ما هي الموسيقى وما لغتها، ومن أين نشأت؟ زرياب من هو، هل هو كائن عادي؟ هل هو حيوان تحوّل إلى إنسان ثم إلى عوّاد ثم إلى مغن من الطراز الأوّل وزاد وتراً على العود؟ فضلاً عن الرسامين والعباقرة كمايكل أنجلو. لا أدري إن كنت زرت روما وشاهدت ما ابدعه مايكل انجلو من عجائب، أو رأيت دافنشي وعجائبه أو رافاييل، إنّه شيء مذهل. لا يعقل أن تكون هذه الأمور من إنتاج بشر. هناك فن، والفن أكبر دليل على وجود شيء يتجاوز الإنسان، ولكن في داخل الإنسان.
يتجاوز الإنسان كما يتجاوز النور المصباح. فالنور يضيء الشارع بأكمله. سمّ هذا الشيء ما شئت: كهرباء، طاقة. فكما يوجد نفط في الأرض، وحقول مغناطيسية كما علمنا من الفيزياء، إذا زادت درجة توّترها يحصل ما يشبه البرق أو الصاعقة أو الشمس التي أعتبر أنّها ليست مجرد كوكب. فأنا عندما أدركها وأعيد إنتاجها، أي إعادة إنتاج الموجود وهذا ما يسمى شعراً. فالشعر، إعادة خلق المخلوق، وبالتالي اكتشافه يعني إعادة خلقه وإعادة كتابة اللغة. لماذا البقرة لا تقوم بهذا الشيء؟ الأسد ملك الغابة، وما أجمله، لماذا لا يقوم بهذا الشيء؟ لماذا يمتلك الإنسان هذه القدرة، ومن أين أتى بها؟ قد تقولين الجينات.
■ العقل والمنطق؟
هذه الأمور تفسّر، لكن لا تولد، أنستطيع أن نفسر معطيات موزار؟ أن كنت تعاني من الكريب فهذا يعني أنّك ستسعل، هذا تفسير الموجود لكن من أوجد الوجود؟ من أوجد الخارق في الموجود؟ أنا أقبل نظرية التطوّر في الإنسان أنّه كان قرداً ثم تطوّر. العالم الذي اكتشف الأمور العلمية والطبيب الذي اكتشف الأمصال ضد الأوبئة، باستور أو غيره من أين أتوا؟ ليس المجهر من أوجد الأشياء إنّه أداة. الخوارق هي البرهان على الخالق وإلا لكنّا جميعاً أم كلثوم وفيروز وعبد الوهاب وأسمهان.
■ عادة ما نجد أنّ من يتجه نحو الدين يتعصّب في ممارسة طقوسه الدينية وإذا نظرت إلى حياتهم لا تجد الأمان فيها، ما رأيك؟
التعصّب الديني سخيف جداً، وهو أبشع ما في الإنسان.هناك تعصّبات جميلة كتعصّب الحب، وتعصّب العشق، وتعصّب الفن، والتعصّب للحقيقة. لكن أبشع أنواع التعصّب هو التعصّب الديني لأنّه ولّد مجازر بشرية ولا يزال إلى الآن.
أنا أتحدّث عن الإيمان في علاقتي بالغيب أو المجهول الذي نسميه الله. الأديان ساعدت على توضيح الأمور وعلى تعبيد الطرق للإنسان الضائع الحائر الذي يبحث عن يد تساعده. لا شك إنّي لا أستطيع الإدعاء أنّي وصلت إلى الإيمان المجرّد «الاغنوستيكي» الذي هو خارج الأديان، لولا مساعدة الأديان . فعندما أدركت كم تتشابه الأديان في جوهرها، الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والكونفوشوسية والعقلانية تساءلت عن أهداف هذه الأديان وعن كل هذه الأحزاب ولماذا لا نأخذ الفكرة الموجودة لدى الجميع؟ أنا أخذت الفكرة لكنني مررت ببعض الطقوس. أنا أؤمن ببعض القديسين لأنّهم وسطاء. أنا اؤمن بوجود إنسان وسيط بيننا وبين العالم الغائب.
■ الوسيط؟ كيف ولد إيمانك هذا؟
ألا ترين الأشياء أحياناً قبل أن تحدث؟ هناك بشر يخافون من أنفسهم من شدّة الرؤيا التي يتمتعون بها. كالأولياء والقديسون والوسطاء لأنّ الإنسان لا يتحمّل دائماً وقعة الإنصعاق في مواجهة الفكرة الإلهية. رمز ذلك موسى والعليقة، عندما صعد موسى جبل سيناء وطلب من الله بحسب التوراة أن يراه، فأجابه أنّك لا تستطيع أن تراني، وإذا رأيتني ستعمى، فأنار له العليقة أو العوسجة الملتهبة. هذه القصة رمز فهل تستطيعين أن تنظري إلى الشمس؟ لن تستطيعي، وهي شمس وليست من أوجد الشمس.
■ هل تؤمن بالحياة بعد الموت ؟
لا أدري.
■ هل تؤمن بوجود حياة بموازاتنا؟
أكيد. أنا أحب الجنيات الصغار التي تخبرنا عنها الأفلام وتصير كالفراشات وأعتقد بوجود كائنات في الهواء حولنا ونحن لا نراها. فلماذا لا يكون بين هذه الكائنات أرواح وملائكة؟ هل نعلم ماذا تخبىء أعماق البحر؟ حتى الغواصين لا يزالون يكتشفون عوالم وحيوانات وأسماك لا علاقة لها بما يعرفونه. كل هذا والبحر قريب منّا وهو مستعمرة للبر ولا نعرفه، فكيف نعلم ما في الهواء ؟!
■ عينك تجعلك ترى ما تريد أن تراه أو ما هو موجود؟
أرى ما ينبع منّي وما يأتي من الخارج يظل حيث هو. فالإنسان موجود داخلي، وأحياناً أفكّر في نفسي بأنّ طوبى لمن ليس له داخل لأته قد يكون سعيداً. المسيح يقول: طوبى لأنقياء القلب أو البسطاء لأنّهم أبناء الله. إنّهم أقرب الخلق إلى الله لأنّهم بسيطون ولا «يفذلكون» الأشياء. بينهم وبين الإيمان توجد الصلاة، والصلاة جميلة جداً.
■ هل صليت ذات مرة ؟
كثيراً ما أصلي.
■ على الطريقة التقليدية؟
لا. عندي صلواتي ومع ذلك فأنا أحب الصلوات التقليدية. فبمجرّد أن يقول الإنسان: أبانا الذي في السماوات، أو بسم الله الرحمن الرحيم، ينفتح قلبه. عدنا إلى ما ذكرناه عن التواضع والضعف فعندما يضعف الإنسان يركع، وأجمل مشهد هو مشهد الإنسان الراكع. دائماً نلاحظ في الرسم أنّ الراكع عليه شعاع من نور وهذا ليس صدفة لأنّه يعبّر عن البصيرة والحب واشتماله بمن يرعاه.
■ أمام من ركعت أنسي الحاج؟
ركعت لوحدي كثيراً. وصلّيت للآخرين من أجل الآخرين ومن أجل نفسي أكيد.
■ كيف تدعو لهم وماذا تقول؟
من أحبهم، أخاف عليهم ومن أخاف عليهم أصلّي لهم.
■ هل تستعمل عبارة «الله يخليهم»؟
أجل أنا أدعو وعندي إيمان كامل بقديسة تدعى سانت ريتا وكتابها لا يفارق جيبي.
■ أخبرنا عنها.
لا أحب لأنّني أشعر أنّني أقوم بالترويج لشيء أرفع من أن نتحدّث عنه.
■ لماذا تحب هذه القديسة؟
لأنّها أحدثت لي معجزات وحققت لي طلبات مستحيلة وهي تدعى شفيعة القضايا اليائسة. لذا أؤمن أنّ الوسيط شخص عظيم. ألا تتوسلين وسيطاً للحصول على وظيفة؟ أو للعفو عن قريب لك وتخليصه من السجن؟ هذه الأشياء نستطيع أن ننقلها على صعيد معنوي. لماذا نؤمن بالوسيط مثل النائب أو الوزير؟
■ لأننا نراه؟
أنا أراها. طبعاً!
■ ماذا طلبت منها وأعطتك ؟ مم كنت يائساً؟
لا أستطيع أن أذكر ما طلبته نظراً لتعلّق بعض المسأئل بآخرين. وسأطلعك على أمر. الإيمان هو الحب. الإيمان ليس تعصباً لأنّ التعصب بغضاً. الإيمان هو حب وتفاني واضمحلال في الحب، هو التلاشي. إنّ مشكلة الإنسان إذا تحدثنا عن السلطة هي الـ«إيغو» أي الأنا، وهذه المشكلة لها حل.
■ ما هو؟
الحب. ولماذا حلّها الحب؟ لأنّ الحب هو إيصال الـ«إيغو» إلى عرش العروش لأنّ الإنسان عندما يحب فهو يحب نفسه من خلال الآخر. صحيح أنّه يحب الآخر لكنّه يحب نفسه من خلاله. فمن يحب الآخر بهذا القدر يكون قد انتزع الـ«إيغو» الذي يشبه المسمار، ومن على القمة رماه في البحر حيث اضمحلت في الأنا الكونية الأكبر. الأنا موجودة دائماً. عليه أن ينقل الأنا من ضلوع الصدر الصغيرة ليرميها في الأنا الكبرى، عندها سيشفق على الفقراء ويناضل من أجل البؤساء، ويحزن مع المضطهدين ولا يتحقق هذا الشيء من خلال التظاهر بل بالإحساس بالوجع لدى الموجوع أشد من إحساس الموجوع نفسه، حتى لو لم يقدّر الموجوع هذا الوجع.
■ هل يمكن لغير القديسين أن يتحلّوا بهذا الشعور؟
أجل الكثير من الناس. هل تعتقدين أنّ الممرضة تعمل فقط من أجل الحصول على 300 أو 400 دولار شهرياً؟ هل تعلمين مدى التعب الذي يعانون منه والسهر، والمعاناة مع المرضى وحتى مع الأطباء؟ ماذا تعتبرين كل ذلك؟
■ هل تعتقد أنّه ناتج عن الحب؟
إنّها نزعة الخدمة. إنّ البعض من الذين ينتسبون إلى الصليب الأحمر والدفاع المدني لا يقومون بهذا الفعل لعدم توفر فرص عمل أخرى أمامهم. صدقيني أنّ بعض الأطباء لا يحصلون على أجورهم من المرضى لعلمهم بأنّ هؤلاء لا يملكون المال. هذا النوع من الناس كالجنود الذين يقتلون على الحدود أو في المعسكرات، كان بإمكانهم أن يكونوا سائقي تاكسي ليحققوا أرباحا أكثر ويصبحوا زعماء. إنّ بعض الناس لديهم نزعة الخدمة الإنسانية والعطاء المجاني. العطاء حيث يحققون أنفسهم، كل يحقق نفسه بطريقة .
الرضى والخوف:
■ هل تشعر أنّك راض ومرضي؟
عندما أعذب نفسي كثيراً أشعر أنّني راض أي عندما أكون قد ضحيت كثيراً، لا يعني هذا أنّني «مازوشي»، بل بذلت ما بوسعي بحيث تحققت لدي الطهارة الذاتية.
■ ومرضي ؟
لا ليس الأمر بهذا الشكل. في مرحلة ما كنت أنتظر الحصول على المقابل كما يفعل الآخرون، وأقول إن الحياة مراحل وهنيئاً لمن يختصرها بسرعة فيصبح حاله كما هي حالي اليوم بعد فوات الأوان. وبعدما عشت أنانيتي لفترة طويلة وبطريقة شريرة، الآن وصلت إلى مرحلة أشعر فيها أنّني لست متضامناً فقط مع المتألّم بل مذنباً ومسؤولاً عن ألم المتألم وكـأنّ المسؤولية تقع على عاتقي.
■ هذه المشاعر تحتاج إلى زمن ولا أحد يخرج إلى الحياة ومعه هذا الشعور؟
للأسف. نعم تحتاج إلى وقت، لكن بعض الناس يمتلكون هذه الفضيلة منذ صغرهم وهذا شيء رائع جداً جداً وخصوصاً في مجتمعات حديثة تذكّي الأنانية وتذكّي تجاهل الآخر، لأنّ التنافس قائم على «اللقمة» وعلى كل شيء، فمن يُخلق وهو يمتلك هذه الفضيلة يكون قديساً.
■ مم تخاف؟
من كل شيء.
■ من الأماكن المرتفعة، من الماء، من؟
من كل شيء. أخاف من الخروج من المنزل، أخاف من الشارع ومن الناس. أخاف أن ألتقي بشخص أحبّه وأخاف أن ألتقي بشخص أكرهه. وأخاف أن ألتقي بمن يخدعني، وأخاف ألا ألتقي بأحد وهذا أفظع ما يكون.
■ ما هو الاحتمال الذي تخاف منه؟
أنا أخاف، وأول كلمة كتبتها في أوّل كتاب ألّفته هي: «أخاف». ولم يكن الأمر صدفة، وأنا لا أؤمن بالصدفة أبداً فكل ما يحصل أقدار. أنا أخاف من كل شيء وكثيراً ما أخاف على من أحبه وليتني لا أحب أحداً.
■ هذا الخوف له علاقة بالموت، أتخاف الموت؟
لا أعرف، أخاف الموت بكل أنواعه: الموت الفيزيولوجي، الموت العاطفي أي موت العلاقة، موت الوهم وموت الخيال، موت التوقع.
■ كم من الميتات عشت في حياتك؟
أوف.
■ لا تحصى؟
لا ليس إلى هذه الدرجة. كل لحظة تنقضي تموت وأحياناً تمر لحظات لا نتمنى انقضائها، وأحياناً تمرّ لحظات نود رحيلها بسرعة لكنّها تمر ببطء.
■ هذا الخوف يعطيك القوة أم يضعفك؟
الخوف هو الذي جعلني أكتسب إنسانيتي، ولولاه لشطحت في غروري وفي وهم القوة التي تغنى بها «نيتشه»، هو نبي الدعوة إلى القوة، وأشعر أن القوة التي لديه هي نوع من خداع النفس: أنا قوي إذاً أنا أضحك. بينما حقيقة الأمر أنّه مدمراً من ملايين الجهات في ذاته، وقد أوجد هذه الطريقة ليستقوي بها على آلامه.
■ لكنّه حظي بأتباع كثر من البشر؟
طبعاً، لأنّ هذه الطريقة تعتبر حلاً من الحلول ولا شك في ذلك. في فترة من الفترات طبقت هذا الحل على نفسي ودعوت إلى الضحك حتى وإن كان مصطنعاً. ثم وجدت أنّ هذا الوضع غير صحيح وأنّني لست كذلك لأنّني لا أستطيع أن أكون كذلك فأبسط الأمور تجرحني.
■ كنت تمثّـل؟
لم أكن أمثل بل كنت أستعين بخشبة الخلاص الإصطناعية في الوقت الذي لم أكن أمتلك سواها.
■ «إذا رأيتم أحدهم يتهاوى للسقوط فادفعوه بأيديكم وأجهزوا عليه». هذا ما يقوله «نيتشه». لقد تطرّف كثيراً في أقواله، صح؟
لا تنسي أنّه تألّم كثيراً. «نيتشه» شاعر وليس فيلسوفاً فقط. ليس هناك شاعر شرير إطلاقاً، بل هناك شاعر مقهور وشاعر منتقم وفي أغلب الأحيان يكون انتقامه من نفسه. بودلير كان شريراً لكنه كان طفلاً إذ كان يركع ويصلي للعذراء ويطلب منها أن تحفظ أمه. كان يركع وقد تجاوز الأربعين من عمره يصلي ويبكي ورغم ذلك كان يقول في قصائده: «أريد أن ألعن أريد أن أفعل كذا. وكذا». ولم يكن ذلك صحيحاً، فالشاعر طفل مقهور: يصرخ ويرفس وبعد قليل يبكي ثم ينام.
الحرية؟
■ هل أنت إنسان حرّ؟ حتى من نفسك؟
لا. الحرية موضوع طويل، لقد بدأت (كتاب لن) بكلمة «أخاف» وأنهيت آخر قصيدة بكلمة «حرية» أي أنّني لا أريد غيرها لأنّه لا يوجد غيرها. وفي إحدى قصائدي أقول أنّ الحرية أجمل من الحب، وبمعنى من المعاني هذا صحيح. الحرية أكثر راحة من الحب فلا غيرة ولا ما يشبهها.
■ ما معنى أن يكون الإنسان حراً؟
يعني غير مرتبط وغير مجذر بشيء يجعله ثابتاً في مكان واحد، كالشجرة الثابتة في مكانها، وإذا انسلخ من مكانه، سيذبل وييبس كما تيبس الشجرة المقتلعة من جذورها. الحب هو العناصر الأربعة مع بعضها بالإضافة إلى عنصر خامس لا أعرفه، الماء والهواء والنار والتراب. إذا اقتلعت الشجرة من التراب فمهما سقيتها بالماء ستيبس وحتى لو تعرّضت لكل الهواء فما دام عنصر التراب ناقصاً لن تحيا. لذا الحب هو هذه العناصر مجتمعة.
■ أليس لفعل الحرية علاقة بفعل القتل؟ بمعنى أنّك إذا تحرّرت من الآخرين الا تكون قد قتلتهم بداخلك؟
أكيد .
■ هل تحررت من نفسك؟ من أهوائك؟
قصدك تغلبت على نفسك وليس تحررت منها. النفس تستعبد الفرد أحياناً وتقوده إلى مكان بحيث أنّه لا يملك القرار الحرّ ليكون فيه. أنا أفهم الحرية بمعنى متطرّف فقط، بالمعنى السياسي والإجتماعي وبالمعنى الأخلاقي أي التعبير عن الرأي، بمعنى الكينونة المستقلة الحرّة ضمن المجتمع. فلا حق لأحد أن يتدخل في رغبتي بفعل شيء ما أو عدمه، هذا ما أقدّسه، وكذلك عدم اقتحام الحياة الخاصة للأشخاص فلهذا الأمر قدسية عندي تفوق قدسية المعبد. أما الحرية بمعنى الإستهتار فليست حرية هذا مفهوم مهروق للحرية، كحرية الإنتحار، فإذا كنت أحب شخصاً ما لا أدعه ينتحر.
مثلاً الشعب السوري، أنا لا أفهم أي شعار يثور لأجله سوى الحرية وبقية المطالب أعتبرها سخيفة ولا تستحق الموت. أجل، أنا أريد أن أنتخب بحرية، أريد أن أمارس حياتي السياسية بحرية، أنا أريد أن أكتب مقالاً في جريدة. هذه الأمور تستحق النضال والثورة. لكن حرية قتل الجار ليست حرية. الحرية هي ان لا أزعج أحدا ولا يزعجني أحد.
الإدمان:
■ لكل منا أمور يدمن عليها، فعلام تدمن؟
كثيرة هي الأشياء التي أدمن عليها، فكل شيء أتعود عليه أصبح مدمناً عليه ولا أستطيع العيش بدونه حتى لو كنت لا أحبه. مثلاً أنا لا أحب القهوة، لكن بمجرد أن أصل إلى العمل أشعر برغبة قوية في الحصول على فنجان القهوة وإلا فتنتابني رغبة في النوم مع أنّني لا أكون قادراً على النوم. هذه عبودية وليست إدمانا فقط. عندما كنت أدّخن كنت أستهلك ثلاث علب من دون أي سبب. فأنا لا أحب التدخين لكنني تعوّدت، ثم تركت التدخين.
■ هذا يعني أنّك تستطيع التخلي عن إدمانك؟
لا. تركت التدخين لأنّه وصل إلى حد الإزعاج، لكن إذا طلب مني الآن أن أتبع نظاماً معيناً في تناول الطعام «ريجيم» فلا أستطيع. أنا توقفت عن تناول الكحول لكنني سأجن.
■ لماذا ؟
أوامر طبية .
■ هل تؤذي الكحول؟
في حالات معينة. مثلاً الشخص الذي يعاني من ضعف في الكبد أو من ضعف بنيوي عام.
■إدماناتك إذاً مجرّد عادات. ما هو الشرس منها؟
لا يقال… ليس كل شيء يقال (يضحك).
■هل انت سعيد بهذا الشيء؟
سعيد عندما تكون الفرصة سانحة لممارسته، مع شراكة حرّة بممارسته معي وهو نادراً ما يحصل.
الحرب الأهلية اللبنانية:
■ خلال الحرب الأهلية اللبنانية كنت تكتب في جريدة «النهار»، أي قضية تبنيت وقتها؟ وما هي المبادئ التي كنت تحملها؟ أخبرنا عن تجربتك في الحرب.
أنا من أوائل الذين كتبوا متغنين ومادحين للمقاومة الفلسطينة، حتى قبل ظهور ياسر عرفات علناً. وأوّل عملية مقاومة حدثت كتبت عنها في مجلة «كلمات» واستمريت في مديح المقاومة الفلسطينية إلى حد أنّني اعتبرتها الحلّ لكل الأنظمة العربية المهترئة التي يجب عليها أن تتعلم من هذه المقاومة حتى تصبح شبيهة لها. ليس فقط من حيث السلاح إنّما أيضاً من حيث الثورة والشباب الطاهر. هكذا كنت أنظر إلى المقاومة الفلسطينية في بدايتها، ولم تكن هذه نظرتي وحدي، فقد كونت لها شعبية هائلة في الوطن العربي.
ولكن حين حدث ما سمي حينها بـ«التجاوزات الفلسطينية» أحسست بالخوف. كان خوفاً على الفلسطينيين من قيام مؤامرة لبنانية ضدهم وبالتحديد مؤامرة لبنانية مسيحية من جهة. وخوفاً من أن يصبح رد الفعل فعلاً في أماكن معينة كالدفاع الذي يصبح هجوماً. الحواجز التي أقامها الفلسطينيون في تل الزعتر والنبعة وغيرها، والذبح على الهوية، علماً أنّهم (الفلسطينيون) هم الضحايا فكيف أصبحوا جلاّدين؟!
حينها أحسست أنّني انقسمت شقفتين لم أعد أعلم أين أنا. إذ أنّني كنت أعتبر نفسي «كتير لبناني». ليس بمعنى التشوف بل بمعنى أن لبنان بلد صغير إلى درجة أنه دائماً يكون ضحية، تماماً كالولد. فكيف يمكن لأي كان أن يكون ضد هذا الولد ؟ كتبت حينها افتتاحية في جريدة «النهار» بعنوان: «كلنا ضحايا».
أنا مع الضحية أين ما كانت، مع الضحية اليوم في سوريا. والمصادفة في لبنان أن كلّهم ضحايا، وعيب عليهم أن يتقاتلوا وقد وقعوا معاً في الفخ بمنتهى السذاجة والجهل.
■ ما هو سبب الحرب الأهلية اللبنانية برأيك ؟ هل هو مؤامرة خارجية ام حتمية داخلية ؟
أكيد مؤامرة خارجية. عن أي حتمية يتحدثون؟ لقد ثبت مع مرور الزمن أنه عندما كفّ المسيحيون عن الوقوف ضد مواجهة الفلسطينيين، وفهم الفلسطينيون أن المسيحيين ليسوا ضالعين في مؤامرة لإلغائهم بل أصبح الفلسطينيون الحكام الفعليين للبنان، وهذا ما أكده عرفات حين قال: «كنت حاكماً فعلياً للبنان»، انحسرت القضية بين المسيحيين والفلسطينيين، ووكل بالتنكيل بالفلسطينيين أطراف مسلمون وعرب وليس المسيحيون اللبنانيون. كان لبنان المستهدف دائماً والفلسطينيون بالدرجة الاولى. فحرب المخيمات من نفذها؟ الكتائب؟ حرب المخيمات نفذتها «حركة أمل» ومن خلفها الجيش السوري، هذا الأمر أصبح معروفاً ولم يعد سراً، لقد كانت حرباً رهيبة، لا تبرير لها، وكيف يمكن للعالم أن يبررها؟ مسلم يقتل مسلماً وعربي يقتل عربياً. من هو الطرف المؤهل للقيام بهذه المهمة، ومن كان يموّل كل هذه الحروب؟ أطراف عرب يملكون المال واليوم يموّلون أشياء أخرى.
■ ماذا فعلت في الحرب؟ كم خفت؟ وكم بلغ خوفك آنذاك؟
لم أخف من القتل، ليس بفعل شجاعتي بل لإنتهاء مخزون الخوف عندي، لم يبق عندي خوف، صرت شجاعاً، ويائساً. توقفت عن الكتابة والعمل عام 1976، اعتبرت أن الصحافة انتهت بمجرّد أن دخل الجيش السوري إلى لبنان. أنا أتحدث عن الأشياء كما هي لأن التاريخ كتبها ولم نعد قادرين على أن نخاف، (ما عادت تحرز انو نخاف) والرصاصة أكثر راحة من المستشفى، ورصاصة أو رصاصتين ثم أصبح شهيداً!
عندما دخل الجيش السوري إلى لبنان وقام الرئيس اللبناني آنذاك سليمان فرنجية بالإعلان عن وثيقة دستورية مع نظيره السوري حافظ الأسد اعتبرت حينها أننا انتهينا ولم يعد هناك «لبنان». أو بالأحرى لم يعد لدينا صحافة وبأحرى الأحرى فقدت جريدة «النهار» حريتها، وهي التي تعتبر الحرية مبرراً لوجودها، فكيف ستكون حرّة في ظلال بنادق الجيش السوري؟ في سوريا لا يعرفون ماذا تعني حرية الصحافة وهذا المفهوم غير موجود عندهم.
البلد عانى حينها من أزمة مالية هائلة وانخفضت كمية المبيعات ولم يتمكنوا من الوصول إلى المناطق لتوزيع الأعداد فبقيت في بيروت. لم يكن ممكنناً إيصالها إلى المناطق في ظل وجود الحواجز والمسلحين، صرت أتقاضى حينها نصف معاش ثم أصبح ربع معاش «ويكتر خيرهم» لأنهم ظلّوا يدفعون لي .
■ ألم تنتسب الى حزب ما ؟
أعوذ بالله! أنا أخاف من السكين…
■ هل سبق لك ان اوقفت على حاجز ؟
عندما توقفت عن العمل بقيت في البيت ولم أخرج منه كي لا أصل إلى الحواجز. لم يكن للمبنى الذي كنت أسكنه ملجأ، بل كان هناك مجرد قبو مطلّ على الشارع لا يشبه الملجأ بشيء.
الزعماء والطائفية:
■ هل سبق أن صدّقت زعيماً ما أو هل تصدّق مسؤولاً سياسياً في أيّامنا هذه؟ أم أنك تؤمن أن لا مبادىء في السياسة؟
لا أنتمي إلى أي زعيم، فالزعامة عندي فقط للكتابة، ليس عندي زعماء أشخاص بل زعماء شعراء كالمتنبي وبودلير، وفيكتور هيغو وشكسبير هؤلاء «على راسي». فالزعيم السياسي حتى يكون زعيماً حقاً عليه أن يمتلك عقلاً شموليّاً ليس بالمعنى التوتاليتاري بل أن يحب كل الناس. أنا لا أرى زعيماً واحداً (اليوم) يحب الناس ولا أرى أحداً بمستوى أي كتاب اقرأه فكيف أعجب بهم!
هم لا يشعرون بما أشعر به اتجاه الناس ولو كانوا يشعرون مثلي لأشفقوا عليهم. هناك مئات الألوف من اللبنانيين ينامون بلا عشاء فمن يحسّ بهم ومن يسأل عنهم من الزعماء.
■ إذاً لمَ يتّبعهم الناس؟
من قال أن الناس تتّبعهم، هذا فقط بالمظهر. الناس تتبعهم لأن الغريزة تتبع الاقوى ونحن نمتلك الكثير منها وأبرزها الغريزة الطائفية والمذهبية ولا عقل يتحكم بها، وبدل أن يسيطر عليها الزعماء فإنهم يستثيرون الناس بهذه الغرائز. أين هو الزعيم الذي يقول: تبّاً لطائفيتكم أيها الأولاد!
■ ألا تعتبر أن الطائفية هي الحلّ في ظلّ غياب الدولة لأن المواطن لا يخدمه إلّا زعيم طائفته؟
هذا حكّ للغرائز، الدولة هي التي تشجّع الطائفية وبغيابها واضمحلالها تقول للمواطن الجأ إلى الزعيم وإلى رجل الدين فأنا لست موجودة.
■ إذن لا حل للطائفية إلا بحلّ مشكلة الدولة؟
هذا أكيد. فالطائفية ليست هي المشكلة. الطائفية السياسية هي نوع من الديمقراطية، فبدل أن تتمثل الاطراف بأحزاب يسارية أو يمينية فهي تتمثل بالطوائف. لا مانع من ذلك شرط أن لا تصبح الطائفية على مستوى الشارع والتعصّب الديني. هناك الكثير من البلدان موزّعة طائفيّاً أو موزّعة عرقيّاً، ففي بلجيكا هناك عرقين متوافقين مع بعضهما: العرق الهولندي والعرق الفرنسي، وهناك لغتان ويمكن أن يكون هناك دينان وماشي الحال. أما سويسرا ففيها ثلاثة أعراق: طليان وفرنسيين وألمان.
المشكلة تربية الشعب أوّلاً، وتأهيله للديمقراطية وللعلمانية وإلغاء دوائر النفوس الدينية، فأنت مثلاً لستِ موجودة إلا إذا كنت مسجّلة عند الشيعة.
■ تقصد الأحوال الشخصية؟
أنت لست موجودة كمواطنة لبنانية إن لم تكوني مسجلة في الأحوال الشخصيّة، لا يعترف بك ولا بأبنائك ولا بزواجك. يجب أن نبدأ من هنا من الزواج المدني من الزواج المختلط وليلغوا الأحوال الشخصية، فلماذا يتحكم بي رجل الدين؟ أنا لا أريد أن يتحكّم بي رجل الدين. أريد أن أكون في سجل مدني. إلى الآن لا زعيم ينطق بهذا المنطق. حاول الرئيس اللبناني الراحل الياس الهراوي تشريع الزواج المدني فقامت القيامة عليه.
■ هل ترى أن هناك أملاً في أن يصير لبنان وطناً؟
أكيد. لمَ أنت «بنت غير شكل» عن غيرك؟
■ لأن عندي أمل…
لأنّك قرّرت أن تكوني «غير شكل» عن غيرك، إذن عندما يكون هناك شخص واحد ضمن المليون ولم يكن هذا الشخص فاسداّ فهناك أمل… أكيد.
■ نعرف أنّه في البلاد الراقية كأوروبا إن تعرض المواطن للخوف الشديد أو للحرب أو السجن وقبل أن يعود إلى حياته الطبيعية في المجتمع فإنه يخضع للعلاج النفسي أو لإعادة تأهيل، أما هنا في لبنان وبعد فترة الحرب الطويلة كيف يعالج الناس أنفسهم برأيك؟
من يفكّر بهم؟ إذا ظهرت على التلفاز وتحدثت عن التأهيل النفسي فسيستهزؤون بك.
■ من أجل ذلك الناس على استعداد دائم للحرب لأنها لم تعالج ولم تجر عملية نقد ذاتي أليس هذا صحيحاً؟
لا يوجد أب للشعب، ليس عندنا آباء بل ملاّك وإقطاعيين يمتلكوننا. هذا الزعيم يأخذ جماعته إلى حيث يريد، والجماعة تروح معه إلى جهنم لو أراد، فكيف تعالجين هذا؟ فبنظرهم منتهى الشرف ولاؤهم لهذا الشخص فهم يضعون فيه كل آمالهم وثقتهم.
الجيل الجديد:
■ إن جيلكم الذي عاش بيروت بعزّها وعظمتها حين كانت «سويسرا الشرق» أعطاها لجيلنا، الجيل الجديد، مدمّرة مغبّرة ولا تزال رائحة الجثث تفوح إلى الآن، ماذا تقول لهذا الجيل؟
جيلكم حلو وأنا عندي أمل. رغم ما أسمعه ممّن حولي عن أنهم متعصّبون أكثر من آبائهم. أنا لا أرى ذلك بل أرى هذا الجيل متمدّناً، متعصرناً، وحديثاً ولامعاً وعم يطلّع صبايا وشباب متحرّرين كليّاً من التعصب الطائفي أكثر بكثير لأنّني عشت المرحلتين. ودائما نجد أن وراء كل جيل هناك مآس، ستقولين: أن وراءكم الحرب الأهلية، وسأقول وراءنا حوادث العام 1958 والحرب العالمية الثانية ووراء أبي الحرب العالمية الأولى، ووراء أجدادي مذابح العام 1860. هذا قدرنا طالما نحن متخلّفون سياسيّاً، أمّا اللبناني على صعيد فردي فهو ليس متخلّفاً بل هو أغنى إنسان في العالم، إذا أردت إعتبار الغنى نبوغاً، فأهم أطبّاء القلب وجراحته كانوا لبنانيين. اللبناني على صعيد فردي موهوب.
الصحافة:
■ لنعد إلى الصحافة. هل تذكر أوّل نصّ نشرته؟
أجل أذكر. أوّل نص نشرته كنت حينها في الصف الثالث أي البريفه، وأرسلته إلى مجلّة شهيرة كان اسمها مجلة «الاحد» وقد وضعت اسم أبي خلف اسمي كي أجعله جسراً، وحتى يقال هذا ابن لويس ! فلنسايره إذن. ولم أكن أعرف أحدا لأنني كنت طالباً وذلك بدا جليّاً من خلال خطي، وكان عبارة عن جمل صغيرة، كتلك التي تنشر هذه الأيام في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان «عابرات». هكذا بدأت كتاباتي وقد كان نفسي قصيراً ولم يكن المقال طويلاً متماسكاً بل عبارات وجمل، أشياء مشابهة بدائية وطفولية. وقد نُشر في صفحتين، خفت من العنوان لكنّني كنت سعيداً ومخجولاً في آن. أحضرت المجلّة وخبّأتها ولم أجرؤ على إطلاع أهلي عليها. أخي الكبير هنأني وأخبر أبي الذي ارتبك وشعر بأن التشجيع أو عدمه سيكونان عبئاً عليه، فتظاهر بعدم المعرفة لكنه كان سعيداً ونظر إلى المسألة من الناحية الإيجابية فأنا استعملت اسمه لأفتخر به، وهذا صحيح لكنني كنت انتهازياً أيضاً.
■ هل دخلت إلى عالم الصحافة من باب الوراثة؟
لا. أنا لم أفكّر أبداً في الصحافة. عندما وصلت إلى صفّ الباكالوريا فكّر والدي بإرسالي إلى باريس، إلى «السوربون»، لمتابعة الإختصاص الذي أرغب به. وقد أغرمت حينها الغرام الأوّل الذي لا يقاوم. وكنت أشعر أنّني يجب أن أصل بهذا الغرام إلى نهاية المطاف، يجب إعداد القصر والخدم، علماً أنّني لم أكن أملك شيئاً. ثم تطوّر الحب مع ليلى زوجتي بفعل الشهامة والمروءة والفروسية، وقد كانت رائعة الجمال ومدللة ووحيدة أهلها. أحببتها وجعلتها تحبني رغم أنها لم تكن تفكّر بالأمر لأن أباها كان يعد نفسه بأن تتزوج إبنته بمحامٍ أو طبيب أو بشخص موفور الحال. تمّت الخطبة وكنت لا أزال طالباً بعمر ثمانية عشر عاماً. وعندما أصبحت في صف الفلسفة تركت المدرسة إذ لم يكن الغزالي ولا إبن رشد يستهوياني، واتجهت نحو التعليم الخصوصي وكنت أتقاضى ثلاثين ليرة شهرياً وكان مبلغاً زهيداً، فطلبت من والدي أن يساعدني في الحصول على عمل أفضل. عرض عليّ العمل في جريدة «النهار» فرفضت لأنه كان رئيس تحريرها، لقد كنت أفضّل أن أعمل عند شخص لا أعرفه. وقد أعجب والدي بالفكرة وكان يريد أن يطرحها ضمنا لكنه شعر بالخجل. بدأت اتدرب عند كامل مروّة في جريدة «الحياة» التي كانت حينذاك من أكبر الجرائد اللبنانية والعربية، وكانت في المرتبة الثانية بعد «الأهرام». تدرّبت عنده وتعلّمت الصحافة على يديه، ولمّا خطبت ليلى كان راتبي في جريدة «الحياة» مئتي ليرة. بعد ذلك استدعاني غسان تويني وسألني: «كم تتقاضى في الحياة؟ أنا سأعطيك ثلاثمائة ليرة على أن تستلم القسم غير السياسي في النهار. اهتمّ بالصفحات الأدبية وكلّ ما لا يتعلق بالسياسة»، أي أن أكون رئيس قسم في حين أنني كنت عاجزاً عن قراءة جريدة، فتعملّت.
■ أحببت إذاً هذا العمل؟
ليس كثيراً، لم يكن هذا هاجسي فالحب هو الذي كان يسّيرني، كان الكل.
الرجل والمراة والزواج:
■ هل تشبه زوجتك أمّك في بعض المزايا؟
من الناحية الجسدية شعرها أسود وعيناها سوداوان، لا أذكر أمّي كثيراً. زوجتي كانت مزيجاً من الأنوثة وقوّة الشخصيّة وتتميّز بالغموض، وأنا أحبّ المرأة الغامضة بدون إفتعال، بدون حركات خارجيّة بل طبيعيّة جدّاً. كما أنها تمتلك شيئاً لا يقبض عليه، فهي تكون معي لكن في نفس الوقت أعجز عن استهلاكها. الحبّ يولد من هنا، من هذا الشعور أن ما بين يديك جسد وسراب في الوقت نفسه.
■ أي أنها معك وليست معك …
هي معي وهي كليّة، تحبّ حتى النهاية، أو أنها لا تحب أبداً، هذا هو نوعها. إلا أنّني كنت أشعر أن لديها بعداً لا أستطيع الإمساك به أوحبسه ضمن سلطتي. هذا هو الحب، فالمرء عندما يمسك الأشياء ويضعها في جيبه يسعى للحصول على غيرها، ومن يبحث عن شيء يظل في سعي دائم وفي حلم دائم.
■ كم سنة عشت معها؟
كلّ العمر، من عام 1957 جتى عام 2005، وكنّا صغاراً عندما تزوّجنا، لا نعرف شيئاً ولا حتى الجسد وهو عارٍ. وفي الحقيقة فقد تعارفنا بشكل طفولي حتى أنّنا بقينا أيّاماً نفتّش عمّا يجب فعله.
■ أليست جميلة هذه اللحظات؟
لا تنسى، مثل آدم وحوّاء في أولى لحظات وجودهما.
■ كنت بتول أليس كذلك؟
طبعاً طبعاً، في كل شيء.
■ هل تعتقد أن الحب واحد في جميع الأزمنة أم أنّه يختلف؟
لا، كما الإنسان ليس هو نفسه، فهناك جوهر لا نعرفه، والإشعاعات التي يرسلها إلى السطح تختلف. ففي مرحلة ما يكون الحب شهوانيّاً، أي إكتشاف الجسد وتدفّق الهورمونات، هذه مرحلة لا يسيطر عليها الإنسان وستلعب دورها وقد تحدث في البداية أو في الوسط أو في الوداع. وأحياناً يمكن أن تحدث في المراحل الثلاث، وأحياناً في المرحلتين في البداية والنهاية، وأحياناً في الوداع حيث يكون الشعور كإنتفاضة الديك الذبيح الذي يودّع، فتصبح لديه شراهة فظيعة.
… وحين يصبح عجوزاً وبسبب التجربة التي إكتسبها، بالمعنى المعنوي والمجازي والنظري يصبح أنسب ما يكون لإقامة علاقة، نضرة، يقدر أن يحب كألف شاب في الوقت الذي لا يُحب… وغالباً ما يكون كذلك. هناك عجائز كبيكاسو إمتلك حظّاً جعل النساء ينهمرن عليه كالمطر رغم أنه كان بشعاً وعجوزاً وثقيلاً … لا شكّ أنّه كان فناناً كبيراً لكن على الصعيد الشخصي كان أنانياً ونرجسيّاً. كن يحببنه لشهرته، فالمرأة تتغلّب أحياناً على الحساسيّة الجسديّة والشكليّة الجمالية لأن النجم يستهويها والشهرة. عمر الشريف مثلاً لا يزال إلى اليوم يستهوي الفتيات رغم بلوغه الثمانين، الشهرة تستهوي المرأة كالفراشة التي يستهويها الضوء. المرأة إجتماعية في حين أن الرجل قد يحب خادمته، الطبقية لا تفعل في هذا الوضع.
■ الرجل يحبّ المرأة التي تستهوي فكره أما المرأة فتحب الرجل الذي يرغب جسدها؟
احسنت فالمرأة تنبهر! تنبهر بالمظهر والسلطة والمجد والشهرة، فقد تتعلق بوزير بخيل وقبيح لكنه وزير … يا لطيف!
أمّا الرجل فقد تستثيره خادمة تحسن إستمالة خياله، لأن سهولة الحصول من عوامل إثارة الرجل، السهولة وليس الصعوبة، المرأة تبحث عن الترقي في العلاقة أمّا الرجل فيرتاح مع المرأة العاهرة بلا ولا مشكلة، فمعها يستطيع أن يسرّح غرائزه كيفما شاء.
■ يُعجب بالمرأة القويّة لكنه يفضل أن يحظى بإمرأة طيّعة؟
من الناحية الجنسية لا يرغب الرجل في إجراء ديباجة فيستسهل المرأة السهلة، وفي الحقيقة السهولة فضيلة ولا أرى أنها عمل بشع، صعوبتنا تكمن فينا فلا داع لاصطناع صعوبة في الخارج.
■ دائماً نجد في الزواج «طلعات ونزلات»، مشاكل، شغف، هدوء، غضب، أحياناً يكون الآخر صديق، وأحياناً يكون عشيق، وأحياناً لا يكون، أنسي الحاج الشاعر كيف كان زواجك، وهل خنت زوجتك يوماً ما؟
الزوجة في البداية تكون العشيقة والمعشوقة، لكن الزواج مع الوقت يقتل الشغف. أفضل نهاية له أن تصبح الزوجة رفيقة وصديقة وألاّ تحوّل إلى عدوّ وإلى اسوأ من عدو: كائن لا يبالى به. في البداية يكون الزواج نتيجة الحب ومن المؤكّد أن الحبّ سيستمر، ولا يمكن أن يستمرّ إلّا إذا تزوّجا عن نضج وفي عمر معين، بحيث أنه وصل إلى الشبع وتقلّب على الحالات المختلفة، ففي مثل هذه الحال يدوم الزواج مع الحب والعشق إلى الأبد. الإثنان وجدا نفسيهما وهذا هو الإمتلاء الكامل وهو يحصل. أما إذا اختلفت الظروف فالأفضل أن يتصادقا بعد العشق من أن يصبح هو بانتظار شيء لن يحصل عليه منها، فالحلم تبدّد وجاء الواقع، أمّا هي فتتساءل عن سبب امتناعه عن معاملتها كما في السابق عندما كان يخاطبها: يا حبيبتي، أحبّك، وتفكّر لم انتهت هذه المواقف؟
■ إذا عاش الرجل معها، امرأة في داخله، وإلى جانبه، في مثل هذه الحال لا يحصل إستبدال لأن أحداً لا يحلّ مكان آخر، ولكن هل يسمح لها أيضاً بأن تستبدله؟
هذه الأمور ليست خاضعة للإذن فهي تحصل بين الإنسان ونفسه ولا أحد يكون رقيباً عليه.
■ هل تقبل بهذا الأمر كرجل في هذا الشرق؟
ليس ضرورياً أن أعرف. هل تعتقدين أن هناك أحداً يمارس مع شخص آخر العلاقة الجنسية وفي عقله الباطني وخياله لا توجد صورة مثالية لشخص آخر؟ لا أعتقد ذلك. مع الشخص الواقعي هناك في خيالنا شخص غير واقعي، أحياناً هناك ظلّ لا يشبه الأصل أبداً، وأحياناً أخرى يشبهه، أو يكون إنعكاساً له أو أصله. على الأقل هناك شخص واحد واحياناً هناك أكثر من شخص.
■ هل علمت زوجتك بخيانتك لها آنذاك ؟
أفضّل أن لا أتحدّث عن هذه المرحلة لأنها تؤلمني كثيراً وتشعرني بمدى حقارتي حينها، كما تشعرني بعدم جدوى الخيانات كلها. هناك أماكن تكون فيها جدوى وذلك عندما يحب الشخص أحداً ما، فالحب يطهّر وحيث يكون الحب يكون الغفران والفضيلة والأخلاق، فالحب قربان ولا فساد فيه. لكن ليست كل الخيانات ناتجة عن حب للأسف، أحياناً تكون على حساب الشخص الذي تحصل الخيانة معه وليس فقط على حساب أمانة النفس والزوجة، فأنا لم أكن أسعى سوى وراء هدف عابر وغالباً ما تدفع المرأة الثمن.
■ هل تشعر بالندم تجاه زوجتك؟
طبعاً، ليس ندماً فقط، إنما بتفاهة هذه الأمور التي كان سببها الأساس الضجر والهروب إلى الأمام وسطحيّة القرارات التي يتخذها المرء والتي هي بمثابة سقطات وليس أكثر، ليس بالمعنى الإجتماعي إنما بمعنى خيانة الذات.
■ خيانة الذات أصعب من خيانة الآخر؟
خيانة الذات هي الأساس. أصعب شيء، وأجمل شيء أن يتصرف الإنسان وفقاً لطبيعته، وأن تكون طبيعته جميلة، فإذا كانت طبيعته شريرة وتصرّف على أساسها سيكون مجرماً، ما أقصده كما الطفل إذا مارس دوراً أكبر من عمره. أنا كنت طفلاً ولا أزال وأحياناً كنت أظهر لنفسي أنني عملاق وجبّار وهذه أمور سخيفة وليست صحيحة فأنا من الداخل لست كذلك، كنت أهرب إلى الأمام.
■ أحبّتك النساء؟
لا، لا أستطيع أن أقول ذلك فكل رجل يجد من يحبّه من النساء.
■ أنت شاعر ولسانك جميل وحساس …
لا، فقد كنت إستفزازياً وقد «ربيت سكسوكة» حتى يكرهني الناس، وكنت أضع نظارات بنيّة كي أبدو كالوطواط، وكنت أكتب كتابات إستفزازية حتى يكرهني الناس. يمكن أن يكون هذا التصرف تعويضاً عن سلطة غير متوفرة في شكلي الناعم، فقد كنت ولداً صغيراً ولكي أوحي بالهيبة صرت أتصنع، فقد كنت سمجاً جدّاً ولا أدري كيف أحبوني. ربّما أحبّني البعض بسبب (ثقالتي ).
■ بعض الناس كشفوا ما تخبئه وراءالنظارات البنية …
لا لم يكتشفوني.
خواتم:
■ سنتحدث الآن عن «خواتم»، هل تناجي هذا الجيل؟
صدّقيني أنني عندما أكتب لا أفكر لأي جيل أكتب، وقد فوجئت بشكل مفرح جداّ أن أكثرية القرّاء الذين يقرأونني في جريدة «الأخبار» همّ من الشباب والصبايا، وبردودهم عبر الإنترنت وجدالهم حول المقال، جدل حرّ جداً من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومن أقصى المحافظة إلى أقصى التحرّر. البعض من الجيل السابق يعتبرونني غامضاً ولغتي معقّدة وغير مفهومة، أمّا هذا الجيل فهو يفهم تماماً ما أقول وليس لديه أي مشكلة على الإطلاق.
■ هل يجد فيما تكتبه هموماً تمسّه؟
هموم مشتركة. إذا طالعت مواقع الإنترنت الخاصّة بـ «الأخبار» ستتفاجئين بعدد الصبايا وبالإختلاط الطائفي من كل الطوائف، وانا سعيد جداً لآنها المرة الأولى التي أختبر فيها هذا الامر. في الماضي كانت تصلني الرسائل، أمّا الإنترنت فهو كالمرآة الصادقة لأنهم لا يكتبون للمجاملة، والأصدقاء الذين أكتسبهم، أكتسبهم بعد الكتابة لذا لا مشكلة عندي مع هذا الجيل وأنا ممتنّ جداً لهذا الشيء.
الثورة السورية:
■ لاحظنا أنّه منذ بدء الثورات وبالأخصّ السورية منها كتبت مرّتين أو أكثر عن الموضوع فلماذا لا ترافق هذه الثورة في الوقت الذي يحتاج فيه الناس الى قراءة رأيك؟
أنا لست معلّقاً، بل كاتب وجداني والوجدان يعبّر عن نفسه مرّة أو مرّتين أو ثلاث مرّات، ثم ماذا يفعل هل يكرّر النشرة ذاتها؟ أنا كتبت ما أردت قوله في مقال تحت عنوان «ما تستحقه سوريا».
وكان ذلك في بداية الثورة في شهرها الأوّل أو الثاني، وسبقه مقال آخر عبّرت فيه عن ضياعي حيث لم أكن أعلم ما هو الموقف الذي يجب تبنيه لأن البداية كانت «مضيّعة»، وكان الأمل معقود كلياً على أن بشار الأسد سينقلب على نظامه ويجدّد الدولة السورية. وما كتبته في مقال «ما تستحقه سوريا» هو بمثابة دعوة لهذا الأمر. فماذا كان يريد الشعب السوري؟ في ذلك الوقت لم يكن الشعب يطالب بإسقاط النظام بل بتغيير المحافظ في منطقة معينة وأشياء مشابهة.
■ تعني إصلاحات؟
ناشدته أن يعطي حرّية الرأي للشعب السوري لأن كل ما يطلبه هذا الشعب يختصر بكلمة هي: الحريّة، أمّا الباقي فلا يهمّه. فهو يريد أن يعيش كبقية الشعوب التي تكتب بحرّية كما هو الحال في لبنان وفي مصر، للأسف لم يحدث هذا الشيء.
■ هذا يعني أن المقال الذي كتبته يختصر كل ما أردت قوله عن هذا الموضوع؟
أجل لقد كتبت كل ما أردت قوله عن سوريا في هذا المقال.
■ هذا يعني أنّك لم تكن بعيداً ؟
لا أعوذ بالله…
■ البعض يتهمونك بكتابة موضوعات تجريدية هي مجرد موضوعات برجوازية مخمليّة بعيدة عن الأرض؟
أنا لست معلّقاً سياسيّاً…
■ ولكن ألست صحافيّاً؟
لا أبداً لست صحافياً، ولكنّني أكتب في الصحافة أي أنّني لا أشعر أنه ينبغي عليّ أن أكتب اليوم عمّا حصل في «بابا عمرو»، فماذا سأكتب «الويل لكم أيّها الطغاة»؟ فمثل هذا المقال ماذا سيقدّم أو يؤخّر؟ أنا أتبنّى موقفاً وأعتقد أن موقفي كان شجاعاً، ففي ذلك الوقت لم يكتب أحد (عن الثورة السورية). مثلاً لديّ صديق شهير جدّاً كتب مقالاً في إفتتاحية جريدة «السفير» دعا فيه إلى عدم حصر السلطة في سوريا بحزب البعث، هذا كان أقصى مطلب له. فهذا الأمر لا أعتبره حلّاً، فحزب البعث لم يعد موجوداً في سوريا منذ زمن، فهو مجرد يافطة لشيء غير موجود. أما الموجود فعلاً فهي السلطة ورئيسها وما تبقّى، فهم مجرّد منفذون. فالحق ليس على حزب البعث، فهو ليس كالحزب الشيوعي في الإتحاد السوفياتي الذي كان يحكم البلد.
■ هو تحوّل إلى سلطة؟
تحوّل إلى صراع على السلطة وهو إحدى أدواتها، فإذا تخلّصنا من حزب البعث وأتينا بالحزب الشيوعي فهل هذا يعني أن مشكلة سوريا قد حلّت في ظلّ الأنظمة الدكتاتورية؟ يجب أن تمنح الحرية لا مجال للبحث، وما تبقّى ليس سوى كذب ودوران حول الموضوع وخوف من تسمية الأشياء بأسمائها.
أنا سمعت وقرأت على الإنترنت، واستجابة لتوبيخ الضمير سأكتب غداً مقالاً عن الموضوع لأن لدي ما أقوله غير ما قلته سابقاً.
■ صار في تطورات؟
ليس تطوّرات، فكل يوم تحدث تطوّرات في المحور ذاته. فبدل أن يسقط خمسون قتيلاً يسقط مئة أو أكثر، القتل ماشي، والتهم ذاتها: إنها مؤامرة وإسلاميون متعصبّون، ودولة فاضلة ممتازة أو رجعية، فهل سنظلّ نكرّر هذه الأقاويل؟
■ هل سبّب لك المقال الأوّل مشكلة ؟
لا.
■ هل تتوقّع أن يستفزّ مقالك الذي ستكتبه أحداً؟
لا أنا لا أتطاول على الحق ولا أكتب «لأنعر» بل لأشهد، وما على الشاهد سوى الشهادة وما على الرسول سوى البلاغ. هل تعلمين من يكره؟ الكاتب الذي تشعرين أنه مأجور أو مغرض حتى لو كان مجانيّاً، لحساب حزب ما أو لحساب زعيم أو سلطة. أما أنا فلا غرض لديّ فأنا أحب الحياة والناس وأشفق عليهم. أنا مع الضحية حتى لو كان الضحية صدام حسين، بشع هو منظر الضحية، حاكمه بدلاً من ذبحه. معمّر القذافي كان مجنوناً ومعتوهاً لكن ليس هكذا كان يجب أن تكون نهايته، بل كان يجب أن يحاكم وليس أن يسحل ويذبح عندما يصبح ضحية، عليهم أن يكونوا أفضل منه.
كل قاتل يجد أقتل منه يصبح ضحية والأقتل يصبح جلّاداً، ومع الأسف أحياناً يصبح الضحايا أجلد من الجلّادين وأقتل من القتلة.
■ لو كنت في هذه المرحلة في سوريا مكان بشار الأسد فماذا كنت تفعل؟
أعطيهم كامل الحرية.
■ هل تعتقد أن لديه متسع من الوقت للقيام بذلك؟
لا اعلم إن كان سيستطيع. مع الأسف أعتقد أن الدستور الذي صيغ والذي ينطوي على أمور إيجابية كثيرة وسيجري الإستفتاء بشأنه، يتضمّن مادّة تنصّ على دين رئيس الدولة: يجب أن يكون رئيس الدولة مسلماً. في بلد كسوريا متعدّد الطوائف والأعراق وحيث أصبح المسيحي اللبناني فارس الخوري رئيساً لوزرائه ذات يوم، وحيث مؤسّس حزب البعث ميشال عفلق، والذي أعطى قسطنطين زريق أبا العروبة، فهل يجوز أن ينص الدستور على دين الرئيس؟ عيب. ثم يقولون أنهم تراجعوا أمام الإسلاميين فكيف تتراجعون أمامهم؟ هذه لطخة في تاريخ سوريا العلمانية. هذا لا يجوز أبداً.
■ تقصد من سيء إلى أسوأ؟
الرجل يحاول، لقد ألغى تفرّد حزب البعث بالسلطة وهذا رائع وعظيم، ولكن متى فعل هذا؟ بعدما سال كلّ هذا الدم، كيف سينسى الناس بعد أحد عشر شهراً من الأزمة؟ الآلة بطيئة، آلة سوفياتية تعود الى أيام ستالين تتنفس كل عشر سنوات مرة، الأمر يستلزم مبادرات صاعقة وليس مدافع صاعقة، ومع الأسف لا توجد.
الأعمال الادبية القصيدة الحديثة والمواهب الجديدة:
■ هل تتابع الأعمال الأدبية الجديدة؟
قدر الإمكان.
■ المواهب الجديدة والشعراء الجدد؟
أنا أتشوّق إلى إكتشاف مواهب جديدة، إلى الإعجاب. وأحبّ أن أعجب وأظلّ أفتّش عن شيء أعجب به وأبالغ في إعجابي حتى يدعوني البعض إلى التروّي، ولا أريد أن أسمّي من أعجب به لأنّني كثيراً ما أنسى وأخلط بين الأسماء .
■ هل وجدت من يضاهيك شعراً؟
لا، أرجوك. أنا شاعر فاشل، كنت أحب أن أكتب شعراً موزوناً لكنّي لا أستطيع. أحب أن أكتب الأغاني لأنها جميلة لكنني أعجز عن ذلك إذ يطغى على ما أكتبه الفكر.
■ لكن هناك من غنىّ لك.
لا رغبة لديّ في هذا الشيء، لأن ما كتبته ليس للمغنى بل للكتابة. وعلى كل حال أنا اشكر من غنّى لي وجازف بشعبيته لأنني لست شعبياً. كنت أحب أن أكون شاعراً يكتب الموزون، شاعر تفعيلة. لديّ شعر تفعيلي لكنّه ناتج عن الصدفة (الخطأ).
■ يعرف عنك أنّك لا تحبّ القصيدة العامودية؟
هناك فرق بين أن لا أحب القصيدة العامودية، وبين أنني كنت أطالب بحيّز شرعي لقصيدة النثر. لم أكن أريد لقصيدة النثر أن تلغي الشعر الموزون. وعندما وصلنا إلى وقت تأزّم فيه الوزن وانعدم، دعوت في حديث مع صديقي الشاعر والناقد والكاتب الكبير عباس بيضون لمجلّة «الوطن العربي» التي كانت تصدر آنذاك في باريس، دعوت إلى إعادة ضخّ الحماسة في الوزن وإعادة الكتابة بالوزن.
■ ألا ترى أن القصيدة الكلاسيكية العامودية ليست حرّة، بمعنى أنها مسيّجة برويّة وصدر وعجز؟
لا ليس الأمر على هذا النحو. لذلك يجب أن نشجعها حتى ينضبط من يكتب شعراً، فكل من يكتب كلمة على سطر ، مثلاً:
ذهبت/ جلست/ دخّنت/ شربت/ القهوة/ في/ مساء/ الأربعاء، صار شاعراً نثرياً…
ماذا يحاول هذا الشاعر إخبارنا، إذا كتب هذه الكلمات جنباً إلى جنب سيكون الحال أفضل. هناك إستسهال، وأفكار خاطئة عن قصيدة النثر ولا نستطيع دائماً أن نذّكر بمبادئ قصيدة النثر. حتى وصلنا إلى حدّ أن كل من يرغب في كتابة مذكّراته يعتبرها قصيدة نثر، أو كلّ من يريد أن يرسل رسالة إلى حبيبته يعتبرها قصيدة نثر، وكل من يريد أن يقول «نكتة» في مقهى على نحو «مرّت ذبابة فوق رأسي وكانت خضراء وليست سوداء» يعتبر ما يقوله مبررّاً كافياً لوضعه في كتاب وإعطائه عنواناً.
الأمر ليس كذلك والكتابة ليست نهفة، فالفن عدوّ النهفة وعدوّ النكتة. لا يمكن إنشاء الشعر بناء على نكتة، يستطيع أن يكون ساخراً او هازئاً أو عبثيّاً ولكن ليس صاحب نكت «كنجيب حنكش». لا يمكن الإستناد إلى نهفة لإنشاء قصيدة. القصيدة تحتوي على الطفولة وهناك فرق بين الطفولة والبراءة والسذاجة، التي هي رائعة في الكتابة والفن، وبين من يسعى لإضحاك مستمعيه. هذا الشيء لا ينتج كتابة ولا فنّاً بل «سهرة» حول النارجيلة ليس أكثر.
النقد الأدبي:
■ برأيك هل لدينا نقد صريح ؟
لا يوجد، فالمشكلة تكمن في غياب النقد. لكنني لا أريد أن أبالغ إذ أن هناك نقاد جديّون وهم أساتذة جامعيون ممتازون، لكنهم وللأسف منهمكون بالتدريس والإشراف على أطروحات طلّابهم، وهم نادراً ما يكتبون. بعضهم يعدّ من النخبة إلى درجة أنك لا تصدقين أنهم موجودون في بلادنا سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو في مصر . الحقيقة أن هناك نخبة عظيمة جداً وقد أتيح لي أن اقرأ بعض ما كتبوه في مجلّات متخصّصة وأتعرّف إلى أصدقاء منهم. حرام أن يظلّ هؤلاء مدفونون في التعليم أو الصحافة، فالمواهب الخلاّقة يجب أن لا تحصر بوظيفة. ولكن ليس كل النقّاد دائماً منهجيين ومرجعيين، فمثلاً على ذلك سانت بوف في القرن التاسع عشر، الذي كان يكرّس من يمدحه وينهي على من ينتقده ويهاجمه، وحتى لو كان أحياناً على باطل وليس على حق. فسانت بوف لم يعجب ببودلير، وقد أخطأ في ذلك، مع هذا فقلّما أخطأ وقد كانت أحكامه في أكثر الأحيان صحيحة، وقد كان مرجعاً. وعندما كان يكتب عن شخص ما فهذا يعني أن هذا الشخص يستحقّ الكتابة.
■ سواء قال ما هو سلبي إو إيجابي؟
طبعاً، أما نحن فليست لدينا هذه المرجعية. عندنا نقّاد يمكن إعتبارهم في الجوهر أعظم من سانت بوف، لكنّهم لا يمارسون النقد ممارسة منهجية، أي أنّهم لا يحصون كلّ الكتب المنشورة بحيث أنهم يتركون ما لا قيمة له ويعالجون الكتب القيّمة. إنهم لا يتّخذون من هذا العمل مهنة رغم أنه كذلك.
■ ألا تعتقد أن السبب يعود إلى الصداقات القائمة بين الكتّاب والنقاد والصحافيين؟
أجل، هذا ما لا بد منه. حتى سانت بوف كان كذلك. هذه طبيعة البشر، فالعلاقات الشخصية تمارس دورها ولا يستطيع الشخص أن يعيش في صومعة. ولكن الناقد الحقيقي لا يتجاوز حدوداً معينة من المجاملة. في بداية القرن العشرين وفي القرن التاسع عشر كان لدينا نقّاد عظماء في لبنان والعالم العربي. إبراهيم اليازجي كان ناقداً مهما جداً، وبطرس البستاني وأحمد فارس الشدياق، كان لدينا سوابق في العصور العباسية والأموية، الجرجاني كان ناقداً عظيماً. العربي يعتبر ناقداً، لكن تفتّت الدول العربية وانقسامها أثرا في العلاقات من جهة، ومن جهة أخرى أصبحت العلاقات بين الناس شخصيّة وليست موضوعيّة، وانتفَت مهنيّة النقد إلا في الجامعات حيث يمارس الأساتذة هذا الأمر برسولية رائعة.
■ من المعروف أنّك ناقد إضافة إلى كونك صحافياً وشاعراً.
لقد جنّت عليّ مجلة «شعر» حيثن بدأت أكتب كناقد. أتذكر حين طلب مني يوسف الخال رحمه الله قبل صدور العدد الأوّل أن أكتب شعراً فقلت له: لا أكتب شعراً، فضحك وقال: كيف هذا وبالأمس قرأت لك في مجلة «الأديب» قصيدة. وبالفعل كان ألبير أديب رحمه الله قد نشر لي قصيدة.
كانت مجلة «شعر» مختصّة بالشعر فقط، وكان يكتب فيها شعراء كبار كأدونيس ويوسف الخال وميشال طراد وجورج صيدح وبدر شاكر السيّاب وعبد الوهّاب البيّاتي ونزار قباني، كنت متهيّباً منهم، فأين مقامي بينهم، لذا أجبته بالنفي: «لديّ شعر ولا أريد أن أنشره». فقال لي: إذاً هيّئه للعدد الثاني. صدر العدد الأوّل بدوني، وحين حان وقت صدور العدد الثّاني، عرض عليّ يوسف الخال أن يضمّني إلى هيئة التحرير فعارضت الفكرة و طلبت منه أن يعطيني كتباً لأقدّم نقداً لها.
■ ولكنّك من مؤسّسي مجلة «شعر»؟
نعم أنا من مؤسّسيها، ولكنّي كنت متوارٍ عن العدد الأوّل كناشر وعملت في الإدارة، وعند صدور العدد الثاني كتبت نقداً تناول شعراء عرب من كل البلدان العربية. واستمرّيت في كتابة النقد في عدّة أعداد. ومع اقتراب موعد صدور العدد الثالث أصرّ يوسف الخال على الشعر. هكذا تورّطت في هذا الأمر ولم ألبث أن نشرت المجموعة الأولى التي لا أحبّ أن أسمّيها ديواناً، وحينها خضت معركة قصيدة النثر والشعر الحديث مع أصدقاءنا الآخرين.
■ هل حدث ذات مرة أن «هزّك» نصّ كتبه أحدهم؟
كثيراً ما يحدث هذا الأمر، عباس بيضون «يهزّني» كثيراً، فهو يمتلك شجاعة لا أمتلكها وأحسده عليها، كما يمتلك وعياً مفترساً وحقلاً يهتمّ به، وأنا أعجز عن دخوله: الأدب الإجتماعي السياسي. أنا لا أجيد هذا النّوع من الكتابة، وأشعر بنقص يملؤه شخص كعباس لأنه يجمع هذا الوعي الإجتماعي السياسي التاريخي الموضوعي، ويجمع إحساس الشاعر ورؤياه وهذا شيء عظيم جدّاً. وعبده وازن أيضاً أحبّ كثيراً ما يكتب، وشوقي بزيع، أنا أعجب إلى حدّ «الشهقة» بكتاباته الشعرية الموزونة والنثرية فهو متمكّن من لغته، بحيث أنه يتصيّد العبارة ويصيب بذكاء مطلق، وعنده إحساس نقدي، فالشاعر عندما يكون ناقداً هو أهم ناقد، وشوقي لديه الميّزتين: شاعر كبير وناقد عظيم. حتى أنك تحبين النص الذي يتحدّث عنه وهذا هو الناقد، إذ يجعلك تتبنّين شيئاً لا تعرفينه من خلال نقده لهذا الشيء، أو ترفضين شيئاً لا تعرفينه من خلال هذا النقد.
■ أخيراً، أريد أن تعطيني المعنى الأوّل الذي يخطر لك عند سماع هذه الكلمات:
■ ليل:
الشيء الذي أنتظره كلّ يوم بمنتهى الخوف.
■ ألا تنام في الليل ؟
أبداً، هو الشبح الذي يرعبني لذا أرافقه بطوله كي يضمحلّ وطالما أنّه ليل فأنا بانتظاره، ومن ينتظر الآخر لا أدري.
■ النهار:
بشع ويعيش في داخلي، الليل والنهار يقيمان فيّ. الليل كائن موجود أما النهار فتصحبه الضجّة، والغبار، والمازوت، والبنزين، والشارع يكون جميلاً أثناء النهار لمرور الصبايا الجميلات فيه وخصلات شعرهن التي يتلاعب بها الهواء و «التنورة» التي تتمايل، ويشعرن بعيون تحدق بهنّ. هذا المنظر يحيي النهار ولا يكون في الليل حيث يخرجن منتعلات حذاء عالياً وبصحبتهن أزواجهن أو أصحابهن.
■ الجسد:
ليس الجسد بل الجمال. الجسد قبيح ما لم يصبح خيالاً وجزءاً من المخيّلة، عندها يعاد خلقه وهكذا نكون قد عدنا إلى الشعر. فالشعر إعادة خلق المخلوق والمرأة كائن مثل الرجل لها مشاكلها، وحاجاتها البدنيّة فهي ليست جميلة إذا لم يبدعها الخيال ولكنها أكثر من يعطي الخيال المجال لإعادة الخلق، أكثر من أي شيء في الطبيعة. مهما تغزّل الشاعر بالقمر لا يستطيع إعادة خلقه، لا الشمس ولا القمر ولا النهر ولا البحر كلّهم تنتهي بهم الأفكار. أما المرأة فلا تنتهي لأنها تجدّد في الإنسان كالحب.
■ هل تحب جسد المرأة؟
أحبّ ما توحيه لي ويتجاوزها، لحسن الحظ يتجاوزها ويتجاوز جسدي لكنّه لا يتجاوز خيالي وحلمي. الإنسان غير موجود في الواقع لأجل الواقع: الحمّام وعالمه، والمطبخ وعالم الطبخ، والكلام الذي نتبادله والشتائم التي نتبادلها والضرب الذي نمارسه، والملابس والصحيفة والإذاعة والتّلفاز، هذه الأمور لا يحيا الإنسان من أجلها.
■ هل نعيش فقط من أجل الحلم؟
طبعاً.
■ يد:
القلم.
■ الرسولة بمن تذكّرك؟
إنّها كائن خرافي يستطيع من حين إلى حين أن يتجسّد في الواقع.
■ شكراً لك أنسي الحاج على هذا الحوار الحقيقيّ والشامل.
الشكر لك لوركا لأنك طلّعت مني كل هذه الذكريات والآراء.
حوار أجرته لوركا سبيتي مع الشاعر أنسي الحاج في برنامج «صوت الشعب»، عبر أثير إذاعة «صوت الشعب»، بتاريخ 24 آذار (مارس) عام 2012.
الليلة خلته مراهقاً
عيسى مخلوف
تسألينني عن الشاعر الذي جاء ومضى، وهو في ما يكتب يسعى إلى أن يكون خارج التسميات التي ما عادت تعني شيئاً. خارج الشعر الذي تغيّر معناه. حتى الكتابة ذاتها، هل نعرف ماذا تعني؟
من طفولتي جاء ومن دهشتي الأولى بالكلمات والأشياء. الليلة خلته مراهقاً يستظل النمش المنثور تحت نظرك. نظرك المشرف على الجمع، متدفقاً وحاراً. يستمد نوره من زيته الخاص، ومن انتباه يطوّقه ويحتفي به.
أخبرني في مسائه الباريسي الأخير، وكنا نجتاز المدينة من أولها إلى آخرها، أنه كتب قصيدة يتحدث فيها عن طفل يلتهم ثدي أمّه. أو أنه يلتهم أمّه بأكملها. لستُ أدري. حين سمعتُ هذه الكلمات القليلة، بات الصوت مبعثراً، مشوّشاً وغامضاً. لم ألتفت إليه لأتأكد مما جاء على لسانه. لم أجرؤ على الالتفات. كنتُ أفكر في ما يمكن أن يقوله رجل مثله فقدَ والدته وهو لا يزال طفلاً. وكنتُ أتساءل في نفسي: هل تلفّظ هو فعلاً بتلك الكلمات؟ ما الذي قاله بالتحديد؟ أيّ كلام لفرط وضوحه يعصى على الإدراك؟
تابعنا طريقنا. عبَرنا الجسر إلى الضفة الأخرى. عبَرنا الكلام الذي يُشعل حرائق. كأنني لم أسمع شيئاً. أو كأنني، بلا وعي مني، لا أريد أن أكون شاهداً على مجاعته إلى أمّ. إلى الأمومة. إلى أن يكون هو الأم والابن معاً. الثدي الذي يُرضِع والرضيع في آن واحد.
إنها الحاجة إلى الافتراس، سواء أكانت المرأة أماً أم لم تكن. وهل تنفصل الرغبة في المرأة عن جسدها؟ تلك الرغبة التي “قد لا تكون سوى نزوع مقنَّع إلى اللحم البشري”، بحسب نوفاليس، أو كما كتب بودلير تحت رسم امرأة:
Quaerens quem devoret
هكذا يمسي الحب، لعبته، لعبةً على حافة العدم، أو شكلاً من أشكال الاندماج فيه والاتحاد به.
من هنا أراها طالعة غيومه. كلماته.
كيف يمكن كلمة أن تحمل هذا الذي يحمّلها إياه ولا تنوء؟ هكذا يأتي، من وراء الكلمات، عارماً، بدائياً ومتوحشاً. مكلّلاً بالأسرار لأنه يعرف سر الألم. ألم الرضيع الذي لم يرضَع. وإذا هو لم يفِ بوعده، فمن أين للحب أن يفي بوعده؟ ليس المقصود بالحب هنا ذلك المطوَّق ببداياته ونهاياته، وإنما الكنز الضائع في أعماقنا منذ بداية التكوين.
باقترابه من المرأة، يقترب من المقدّس. كالهنود الحمر، أبناء الحضارات البائدة. أولئك الذين يعرفون المقدّس ولا يعرفون الدين. عن المقدّس يتحدثون وكلمة دين غير موجودة في لغاتهم.
إلتهام الآخر، أتعرفينه؟ افتراس الآخر وأكله! كان أفراد بعض القبائل الإفريقية إذا ما فقدوا أحداً منهم أثناء رحلة طويلة، يضعون رماده في حساء ويشربونه، ثم يتابعون المسير، وهو في داخل كل منهم. شيء أشبه بالقربان، أليس كذلك؟
عزلة الشاعر في ابتكار مراياه
خليل صويلح
سوف نستعير أولاً، عنوان ديوانه الأخير «الوليمة» (1994) لفحص تجربته المتفرّدة في الحداثة الشعرية العربية، ذلك أن مائدته غنية ودسمة ومدهشة في ابتكار نص يشبه صاحبه. اللهاث وراء مقدمة ديوانه الأول «لن» (1960)، لم يتوقف منذ ذلك التاريخ، فهذا البيان الشعري الاحتجاجي، كان وما زال العتبة الأولى لاكتشاف وتوصيف معنى قصيدة النثر، جيلاً وراء جيل، كذلك علينا أن نتأمل تلك الصورة المشهورة بالأبيض والأسود التي جمعت فرسان «مجلة شعر»، والسجالات الصاخبة التي أنجزت ذلك الانقلاب الشعري في الذائقة العربية، قبل أن يتباعد أصدقاء الأمس في جغرافيات شعرية متنافرة.
وحده أنسي الحاج ظلّ متمرّداً ومخلصاً لبيانه الأول لجهة التوتّر وإعادة النظر في تربة القصيدة وحراثتها من الداخل بمعول رشيق، بقصد تخليصها من مقدساتها القديمة المتوارثة نحو فضاء حرّ وشاسع ومفتوح، من دون أسوار بلاغية قديمة تقيّد حركتها، أو مشاغلها المختلفة. هكذا سطعت قصائده الطليعية مثل حقل من عباد الشمس في ديوان الشعر العربي الجديد، من دون أن تتراجع إلى الظل، رغم تعدّد التجارب الشعرية اللاحقة وتنوّعها واختلافها، فهذه التجربة كانت أحد المنابع الأصيلة والمرجعيات المؤسسة لقبيلة شعراء قصيدة النثر. وإذا كانت تجارب محمد الماغوط وشوقي أبي شقرا وأدونيس قد وجدت مريديها ومقلديها، فإن تجربة أنسي الحاج بقيت عصيّة ونافرة ومتمرّدة؛ لأن نارها ظلت موقدة، من طريق الهتك الدائم لبلاغتها واستقرارها اللغوي، وكسر قالبها باستمرار، وصعوبة التقاط مسالكها السريّة المتأرجحة بين السريالية والنفحة الصوفية، الصمت ولهيب النار، الجذوة العاطفية والطهرانية، ومعانقة الأسئلة الكونية، بأدواته السحرية، ونبرته المغايرة، وسجادته اللغوية التي ابتكر خيوطها على مهل، في محو مفردات «التراث الرسمي» ومقارعتها بمعجمٍ آخر، والتأسيس مبكراً، لسرد شعري حميمي، سوف يكون بعد حقبة طويلة ملاذاً لتجارب شعرية أخرى، وجدت في السرد ضوءاً لعزلة القصيدة وانغلاقها على نفسها.
ليست الريادة وحدها من وضعت مغامرة أنسي الحاج في إطار مذهّب، إنما تلك الدمغة الخاصة في قماشته الشعرية، من دون وصايا لاحقة، أو كما يقول عنه محمد الماغوط «شعره ساقية صافية، وليس نهراً مسموماً». كأن بيان «لن» هو النسخة الأصلية الوحيدة، بصرف النظر عن ارتحالاته التالية التي كانت على الدوام من داخل تجربته، وليس من خارجها، عبر زجّها المتواصل واللامرئي في أرضٍ جديدة، حتى في عبوره إلى أرض نثر أخرى، كما في «كلمات، كلمات، كلمات» التي أتت بوصفها بياناً آخر موازياً لندائه الشعري الأول، ومنافحاً عن موقفه من قضايا عامة، لا تدخل في مشاغله الشعرية، بل تستعمل الأدوات نفسها. أما في «خواتم»، وهي الحركة الثالثة، في تجربته، فقد كانت الخلاصة الناصعة لمسيرته، أو المغزل الذي صقل العبارة أكثر، وذهب بها إلى الكثافة القصوى، على هيئة شذرات وحكم وتعاليم، نابذاً ما هو فائض ويحتاج إلى الشرح أو التعليل، كأننا حيال أحجار كريمة تلمع في العتمة، أو ندوب في الروح، وطعنات غائرة في الجسد. هذا الهدم المحتدم للكلمات هو برزخ التجربة الأخيرة؛ إذ تتناوبها الروحانية من جهة، والشبقية من جهةٍ أخرى. الشبق هنا لغوي في المقام الأول، قبل أن يحيل إلى الحسيّة المخبوءة في المتن العميق، أو الجوانية المطلقة، بالإضافة إلى أفكار لا تتوقف عند حدود، بل تتشظى إلى كل الجهات، كصرخة موجعة، وألم، وحلم، وصمت، وعاصفة. عند هذه المنطقة، على وجه التحديد، تتداخل نثرية صاحب «الرأس المقطوع» بشعريته، وطهرانيته بآثامه، وما هو دنيوي، بما هو ميتافيزيقي. جموح يهتك المتوقع نحو المفاجئ والمباغت والمدهش بضربة مدية واحدة، فالاقتصاد اللغوي يشفّ إلى طبقة الحرير، خصوصاً، في خواتمه الأولى والثانية. أما خواتمه الثالثة، فكانت ضرباً من المتناقضات، تبعاً لمزاجه وانخراطه بقضية عابرة أو أصيلة، من دون أن يتخلى عن الجماليات الدنيوية بوصفها مطلقاً آخر موازياً للمقدس.
الآن، ونحن نفحص كنوز أنسي الحاج، وميراثه الطويل، ودروبه المتعرّجة، ومعجمه النفيس، قد نلتقي، في محطةٍ ما، بنسخة أخرى من جبران خليل جبران، من دون وقائع مؤكدة، فلكلٍّ منهما نبيه وصوفيته وجنونه، وإن اختلف لون الحبر، وإيقاع الكلمة، ودرجة الروحانية. لكن ما هو مؤكد، أنهما حاولا زعزعة الأعراف، وحفر مسالك مبتكرة في اللغة، وقد أتيح لأنسي أن يصرخ بصوتٍ أعلى، وببسالة أكثر هتكاً لما هو مستقر وسكوني وصارم. في كل الأحوال، سيقودنا أنسي الحاج أخيراً، إلى عزلته، عزلة النص في تشكّله، وعزلة الشاعر في ابتكار مراياه الفردية، ونزقه وعناده وعشقه المرتبك، وأنثاه المشتهاة التي تتمرّد على صورتها، كلما اكتملت في المرآة، وسعيه المحموم إلى اكتشاف ألغازها، ذلك أن جانباً أساسياً من تجربته، يضعه في مقام الحب بكل طبقاته، من فرط توقه إلى النشوة، نشوة البلاغة المتفلتة من أجراس الأسلاف. ولعل هذا ما سوف يبقي نصوص الشاعر الراحل حاضرة على الدوام، في عنفها الخفي، ومشهديتها المتجدّدة، ومصيدتها المباغتة لطرائد اللغة الناصعة. أنسي في غيبوبة؟ نعم، ولكنه لن يغيب.
أنسي وأساطيره الحرة
محمود قرني*
الحضور المتجدد والحي لأنسي الحاج في الشعرية العربية، يعني أن الشعر مدعو لإقامة احتفالية دائمة. وهي، رغم عوارض الذائقة العربية، غالبة وحادثة. يتبدى ذلك بوضوح في تهتهات وشقشقات المبتدئين والراسخين على السواء. ومن يستعيد مقدمة “لن”، سيتأكد من نجاعة الحدس الذي جعل لأنسي مكاناً في كل مستقبل.
الرجل لم ينس أن يترك لنا فرجة تقود من يريد إلى حرية وانعتاق أبديين حين قال: ليس في الشعر ما هو نهائي، وما دام صنيع الشاعر خاضعاً أبداً لتجربة الشاعر الداخلية، فمن المستحيل الاعتقاد أنّ شروطاً ما أو قوانين ما أو حتى أسساً شكلية ما، هي شروط وقوانين وأسس خالدة، مهما يكن نصيبها من الرحابة والجمال”.
إن الحرية لدي أنسى الحاج بقدر ما هي نمط للتفكير، تبدو جذراً إنسانياً يمنح الحق في الجنون، في الانفصال والاتصال، والتوحد والسفور في وجه عتمة القبيلة وتبجح مقدساتها. كان ذلك الوصف المبكر للشاعر مفارقاً، وتتأتى فرادته من وصفه بالاعتباطية عندما يقول: “إن قصيدة النثر عمل شاعر ملعون في جسده ووجدانه. الملعون يضيق بعالم نقي، إنه لا يضطجع على إرث الماضي. إنه غاز. وحاجته إلى الحرية تفوق حاجة أي كائن إلى الحرية. إنه يستبيح كل المحرمات ليتحرر”. وما يقوله أنسي هنا يجعل من الخطل إغفال القداسة التي حازتها تلك المقدمة شبه المعصومة لديوان “لن “. فقد تحولت بدورها إلى برزخ أخير تلتقي عنده نوافل الشعر وفرائضه. وقد كانت تلك المواصفات التي قدمها أنسي وأقرانه مبكراً، نقلاً عن سوزان برنار، قد تحولت إلى براهين ومشاعل للأبناء والأحفاد، وما زال البعض – من مجايلينا – ينظر إلى المواصفات الثلاث الرئيسية لقصيدة النثر “الإيجاز، التوهج، والمجانية” باعتبارها صكوك “الفردوس” المسمى بقصيدة النثر. هذا رغم أن أنسي الحاج نبه مبكراً إلى أن تلك الخصائص قد تم تجاوزها في ما بعد، وفي ما قبل وربما لدى شعراء سوزان برنار نفسها. إلا أن ذلك لم يعصم عامة الشعراء من الخلل، ولم يعصم الخصائص نفسها من الوصول إلى درجة عمياء من المعصومية.
في الوقت نفسه، يبدو ذلك التحول إلى المجانية التي أدركها أنسي مبكراً وعياً مضافاً لذلك الاكتشاف المذهل للغته المتفردة التي استمسكت بمستويات محسوبة ودقيقة من تاريخيتها وأسطوريتها وطبقاتها التركيبية، وهو الأمر الذي احتفظ لها بحياة تضمن لها التجدد، عبر ذلك الوعي المفرد بزمنية النثر المحض الذي تحول إلى وشائج تتحلل من ذلك الرباط غير المقدس مع فكرة الراهنية.
* شاعر مصري من جيل الثمانينيات
مقدمة “لن “
أنسي الحاج
هل يمكن أن يخرج من النثر قصيدة؟ النثر محلول ومرخي ومبسوط كالكف، وليس شد أطرافه إلا من باب التفنن ضمنه. طبيعة النثر مرسلة، وأهدافه إخبارية أوبرهانية، إنه ذو هدف زمني، وطبيعة القصيدة شيء ضد. القصيدة عالم مغلق، مكتف بنفسه، ذو وحدة كلية في التأثير، ولا غاية زمنية للقصيدة.
النثر سرد، والشعر توتر، والقصيدة اقتصاد في جميع وسائل التعبير، النثر يتوجه إلى شيء، يخاطب وكل سلاح خطابي قابل له. النثر يقيم علاقته بالآخر على جسور من المباشرة، والتوسع، والاستطراد، والشرح، والدوران، والاجتهاد الواعي- بمعناه العريض- ويلجأ إلى كل وسيلة في الكتابة للإقناع. الشعر يترك هذه المشاغل: “الوعظ والإخبار والحجة والبرهان، ليسبق. إنه يبني علاقته بالآخر على جسور أعمق غورا في النفس، أقل تورطا في الزمن الموقت والقيمة العابرة، أكثر ما تكون امتلاكا للقارئ، تحريرا له، وانطلاقا به، بأكثر ما يكون من الإشراق والإيحاء والتوتر.
أما القصيدة فهي أصعب مع نفسها من الشعر مع نفسه. القصيدة، لتصبح هكذا، يجب أن تقوم على عناصر الشعر لا لتكتفي بها وإنما لتعيد النظر فيها بحيث تزيد من اختصارها وتكريرها، وشد حزمتها. القصيدة، لا الشعر، هي الشاعر. القصيدة، لا الشعر، هي العالم الذي يسعى الشاعر، بشعره، إلى خلقه. قد يكون في ديوان ما شعر رائع ولا يكون فيه قصيدتان، بل يكون كله قصيدة واحدة، فالقصيدة، العالم المستقل الكامل المكتفي بنفسه، هي الصعبة البناء على تراب النثر، وهو المنفلش والمنفتح والمرسل، وليس الشعر ما يتعذر على النثر تقديمه، فالنثر منذ أقدم العصور وفي مختلف اللغات يحفل بالشعر حفلا إذا قيس بشعر النظم يغلب عليه.
النثر، تقول العرب، خلاف النظم من الكلام. النثر، يقول الفرنجة، كل ما يقال ويكتب خارج النظم. القصيدة من أبيات، بل يذهب العرب إلى الاشتراط: ما فوق السبعة أو العشرة أبيات؛ والتحديد الكلاسيكي للقصيدة عند الفرنسيين هو أن تكون مجموعة كبيرة من الأبيات. بكلمة: النثر خلاف الشعر (لأن الشعر، لا القصيدة وحسب، هو النظم في نظر التقليديين) والقصة، وهي كائن نثري، خلاف القصيدة التي هي كائن شعري. وهنا يبدو البحث في قصيدة النثر هذيانا.
لكن التحديد الكلاسيكي للأشياء خاضع للتطور، وما يشتقه أو ما يبدعه التطور ويبقى حيا أي ملبيا لحاجات الإنسان لا محض موجة تكسرها في أثرها موجة، يحتل مكانه إما بجانب المفاهيم السابقة أو على أنقاضها. وما يجوز على المفهوم يجوز على العطاء. قصيدة النثر احتلت في أدب كأدب فرنسا مكانها الطبيعي حيث تمثل أقوى وجه للثورة الشعرية التي انفجرت منذ قرن. أما عندنا فأخف ما تنعت به، على العموم ، أنها هجينة، وأرصن ما يقول فيها المترصنون أنها سحاب زائل يغشى السماء الأزلية. خارج بضعة من المرافقين المتفهمين، يمكننا أن نرى المهلل الذي يهلل لكل جديد سعيا خلف إرواء ظمأ سطحي إلى إثارة كإثارة الزي، والصعلوك الذي يعلق كحشرة بجسم كل انتفاضة تعشقا منه للتهريج والظهور، المعرض، المهاجم، المتشكك، والمتشكك الذي يرجح أكثر ما يرجح، أخيرا، في كفة الأعراض. هل للتحفظ مبرر هنا؟ أجل، ما دام مدعو قصيدة النثر على جهل تام بها وإساءة إليها وإسفاف فيهم، يتصدرون الواجهة، وما دام لم ينقض على معرفتنا الجديدة بقصيدة النثر عامان، وما دام العطاء الحقيقي ضمنها، لا التقريبي والصدفي، لم يأخذ بعد طريقه إلى الناس. إننا نتحفظ لكن هل يحق لنا رفض الشيء قبل رؤيته؟ أليس انغلاقا على الذات وغرورا أحمق وموتا، أن نصرخ: “قصيدة النثر غير صالحة”و”قصيدة النثر ستموت” وليس بين يدينا نتاج للحكم؟ “الشعر” يقول قائل، هو الموسيقى كعنصر أول، والنثر خلو من الموسيقى التي يخلقها الوزن والقافية. موسيقى الوزن والقافية هي التي في الدرجة الأولى، تحث في القارئ الهزة الشعرية”. لكن لا. موسيقى الوزن والقافية موسيقى خارجية، ثم أنها، مهما أمعنت في التعمق، تبقى متصفة بهذه الصفة: إنها قالب صالح لشاعر كان يصلح لها. وكان في عالم يناسبها ويناسبه. لقد ظلت هذه الموسيقى كما هي ولكن في عالم تغير، لإنسان تغير ولإحساس جديد. حتى في الزمان الذي كان زمانها، لم تكن موسيقى الوزن والقافية وحدها ولا أهم ما يزلزل القارئ. وقارئ اليوم لم يعد يجد نفسه في هذه الزلزلة السطحية الخداعة لطبلة أذنه. ثم إن الشاعر يأتي قبل القارئ، لأن العالم المقصود هو من صنعه. والشاعر أعلم بأدواته، والشاعر الحقيقي لا يفضل الارتياح إلى أدوات جاهزة وبالية، تكفيه مؤونة النفض والبحث والخلق، على مشقة ذلك. والشاعر الحقيقي، اليوم، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون محافظا. إن معارضة التقدم عند المحافظين ردة فعل المطمئن إلى الشيء الجاهز، والمرتعب من الشيء المجهول المصير. التقدم، لمن ليس مؤمنا بما يفعل، مجازفة خرقاء، وهكذا يبدو للمقلدين والراكدين. وبين المجازفة والمحافظة لا يترددون، فيحتمون بالماضي ويسحبون جميع الأسلحة من التعصب إلى الهزء إلى صليبية المنطق التاريخي، بل إلى صليبية منطق تاريخي زوروه بمقتضى سفينتهم، فلم يروا في تاريخ الشعر غير ما يؤيد رجعتهم ويحك العواطف القشرية للجماهير، وجعلوا يستخدمون المنطق- منطق اللغة والتراكم الأدبي وحاجات الشعوب العربية وظروفها السياسية والاجتماعية والروحية- وفقا لما يدعم نظرتهم المبتسرة إلى الأشياء إرادتهم البقاء حيث هم، وإنقاذا لأنفسهم من عجلات النهضة.
أي نهضة؟ نهضة العقل، الحس، الوجدان. ألف عام من الضغط، ألف عام ونحن عبيد وجهلاء وسطحيون. لكي يتم لنا خلاص علينا- يا للواجب المسكر!- أن نقف أمام هذا السد، ونبجه.
بين القارئ الرجعي والشاعر الرجعي حلف مصيري. هناك إنسان عربي غالب يرفض النهض والتحرر النفسي والفكري من الإهتراء والعفن، وإنسان عربي أقلية يرفض الرجعة والخمول والتعصب الديني والعنصري، ويجد نفسه بين محيطيه غريبا، مقاتلا، ضحية الإرهاب وسيطرة الجهل وغوغائية “النخبة” والرعاع على السواء. لدى هذا التشبث بالتراث “الرسمي” ووسط نار الرجعة المندلعة، الصارخة، الضاربة في البلاد العربية والمدارس العربية والكتاب العرب، أمام أمواج السم التي تغرق كل محاولة خروج، وتكسر كل محاولة لكسر هذه الأطواق العريقة لجذور في السخف، أمام بعث روح التعصب والانغلاق بعثا منظما شاملا، هل يمكن محاولة أدبية طرية أن تتنفس؟ إنني أجيب: كلا، إن أمام هذه المحاولة مكانين، فأما الاختناق أو الجنون. بالجنون ينتصر المتمرد ويفسح المجال لصوته كي يسمع. ينبغي أن يقف في الشارع ويشتم بصوت عال، يلعن، وينبئ. هذه البلاد، وكل بلاد متعصبة لرجعتها وجهلها، لا تقاوم إلا بالجنون. حتى تقف أي محاولة انتفاضية في وجه الذين يقاتلونها بأسلحة سياسية وعنصرية ومذهبية، وفي وجه العبيد بالغريزة والعادة، لا تجدي غير الصراحة المطلقة، ونهب المسافات، والتعزيل المحموم، الهسترة المستميتة. على المحاولين، ليبجوا الألف عام، الهدم والهدم والهدم، إثارة الفضيحة والغضب والحقد؛ وقد يتعرضون للاغتيال، لكنهم يكونون قد لفظوا حقيقتهم على هذه القوافل التي تعيش لتتوارث الانحطاط، وها هي اليوم تطمح إلى تكريس الانحطاط وتمليكه على العالم.
أول الواجبات التدمير. الخلق الشعري الصافي سيتعطل أمره في هذا الجو العاصف، لكن لا بد. حتى يستريح لمتمرد إلى الخلق، لا يمكنه أن يقطن بركانا، سوف يضيع وقتا كثيرا، لكن التخريب حيوي ومقدس.
هل يمكن أن نخرج من النثر قصيدة؟ أجل، فالنظم ليس هو الفرق الحقيقي بين النثر والشعر. لقد قدمت جميع التراثات الحية شعرا عظيما في النثر، ولا تزال. وما دام الشعر لا يعرف بالوزن والقافية، فليس ما يمنع أن يتألف من النثر شعر، ومن شعر النثر قصيدة نثر.
لكن هذا لا يعني أن الشعر المنثور والنثر الشعري هما قصيدة نثر، إلا أنهما- والنثر الشعري الموقع على وجه الحصر- عنصر أولي في ما يسمى قصيدة النثر الغنائية. ففي هذه لا غنى عن النثر الموقع.
إلا أن قصيدة النثر ليست غنائية فحسب، بل هناك قصيدة نثر “تشبه” الحكاية، وقصائد نثر “عادية” بلا إيقاع كالذي نسمعه في نشيد الإنشاد (وهو نثر شعري) أو في قصائد شاعر كسان جون برس.
وهذه تستعيض عن التوقيع بالكيان الواحد المغلق، الرؤيا التي تحمل أو عمق التجربة الفذة، أي بالإشعاع الذي يرسل من جوانب الدائرة أو المربع الذي تستوي القصيدة ضمنه، لا من كل جملة على حدة وكل عبارة على حدة أو من التقاء الكلمات الحلوة الساطعة ببعضها البعض الآخر فقط. ولعلك إذا قرأت قصيدة من هذا النوع (هنري ميشو، انتونان أرتو..) قراءة لفظية، جهرية، للالتذاذ والترنح، لعلك تطفر وتكفر بالشعر لأنك ربما لا تجد شيئا من السحر أو الطرب.
التأثير الذي تبحث عنه ينتظرك عندما تكتمل فيك القصيدة، فهي وحدة، ووحدة متماسكة لا شقوق بين أضلاعها، وتأثيرها يقع ككل لا كأجزاء، لا كأبيات وألفاظ. ومن هنا ما قاله إدغار ألن بو عن القصيدة (أي قصيدة) إذا أنكر عليها أن تكون طويلة. إن كل قصيدة هي بالضرورة قصيرة، لأن التطويل يفقدها وحدتها العضوية. وهذا ينطبق أكثر ما ينطبق في النثر، لأن قصيدة النثر أكثر من قصيدة الوزن حاجة إلى التماسك، وإلا تعرضت للرجوع إلى مصدرها، النثر، والدخول في أبوابه من مقالة وقصة ورواية وخاطرة..
لكن هل من المعقول أن نبني على النثر قصيدة ولا نستخدم أدوات النثر؟ الجواب أن قصيدة النثر قد تلجأ إلى أدوات “النثر من سرد واستطراد ووصف لكن، كما تقول سوزان برنار، ” شرط أن ترفع منها وتجعلها “تعمل” في مجموع ولغايات شعرية ليس إلا” وهذا يعني أن السرد والوصف يفقدان في قصيدة النثر غايتهما الزمنية، يبطلان أدوات الروائي والخطيب والناقد توصلهم عبر تسلسل من الآراء والحجج إلى هدف واضح ومعين، إلى الحسم في شيء.
هنا العناصر النثرية تدخل في “كتلة لا زمنية” هي قصيدة النثر، وتغدو مجردة من وظائفها السابقة.
كل هذا بحاجة إلى تفصيل وتحديد أوضح لا يتسع لهما المجال. النثر وارتفاع مستواه كان، عندنا، التمهيد المباشر، ومما ساعد أيضا ضعف الشعر التقليدي وانحطاطه والإحساس بعالم متغير يفرض موقفا آخر، الموقف الذي يفرض الشكل على الشاعر. ثم هناك الوزن الحر، القائم على مبدأ التفعيلة لا البيت، الذي عمل منذ عشر سنين على زيادة تقريب الشعر من النثر. ونلاحظ هذه الظاهرة بقوة عند جميع الشعراء العرب الشيوعيين، والواقعيين، الذين اقتربوا من النثر لا في أسلوبهم ولغتهم فحسب بل في الجو والأداء، بينما نلاحظ عند فئة أخرى هي فئة شعراء “المستوى” اقترابا من النثر من حيث تبسيط الجملة والتركيب والمفردة، وتبقى التجربة أو الموقف في “عصمتهما” الفنية الصعبة.
هذه العوامل وسواها كالترجمات عن الشعر الغربي خاصة، جعلت بزوغ النوع الجديد ممهدا بعض الشيء، على صعيد الشكل بالأقل، وإن لم تتهيأ له الذواق حتى الآن التهيؤ الطبيعي.
يحتاج توضيح ماهية قصيدة النثر إلى مجال ليس متوافرا. وإنني استعير بتلخيص كلي هذا التحديد من أحدث كتاب في الموضوع بعنوان “قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا” للكاتبة الفرنسية سوزان برنار.
لتكون قصيدة النثر قصيدة نثر، أي قصيدة حقا لا قطعة نثر فنية أو محملة بالشعر، شروط ثلاثة: الإيجار (أو الاختصار) التوهج، والمجانية. فالقصيدة، أي قصيدة، كما رأينا، لا يمكن أن تكون طويلة، وما الأشياء الأخرى الزائدة، كما يقول بو، سوى مجموعة من المتناقضات. يجب أن تكون قصيدة النثر قصيرة لتوفر عنصر الأشراق، ونتيجة التأثير الكلي المنبعث من وحدة عضوية راسخة، وهذه الوحدة العضوية تفقد لازمنيتها إن هي زحفت إلى نقطة معينة تبتغي بلوغها أو البرهنة عليها. إن قصيدة النثر عالم “بلا مقابل”.
وفي كل قصيدة نثر تلتقي معا دفعة فوضوية هدامة، وقوة تنظيم هندسي. لقد نشأت قصيدة النثر انتفاضا على الصرامة والقيد، أليست هي وحتى الآن تلك التي طالب بها رمبو حين أراد “العثور على لغة (…) تختصر كل شيء، العطور، الأصوات، والألوان”، وبودلير، عندما قال أنه من الضروري استعمال شكل “مرن ومتلاطم بحيث يتوافق وتحركات النفس الغنائية، وتموجات الحلم، وانتفاضات الوجدان” إنها الرفض والتفتيش، تهدم وتنسف الغلاف، القناع، والغل. انتفاضة فنية ووجدانية معا، أو إذا صح، فيزيقية وميتافيزيقة معا. لكن هذه الفوضوية كانت لتبقى بجناح واحد عند رمبو لو لم يعطها الجناح الآخر: الهيكل. ومن الجمع بين الفوضوية لجهة والتنظيم الفني لجهة أخرى، من الوحدة بين النقيضين تنفجر ديناميكية قصيدة النثر الخاصة. هذه الملامح تسمح لا بتبين النوع الجديد فحسب بل كذلك بتجنب ما ليس قصيدة نثر. على أن ثمة وجوها نسبية ظهرت وتظهر متبدلة وفقا للتطور، وهذا التبدل هو من ضمن ما توفره قصيدة النثر من حرية شاسعة وإمكانات لا تنحصر في عمل الخلق وطلب اللانهائي والمطلق.
لا نهرب من القوالب الجاهزة لنجهز قوالب أخرى ولا ننعى التصنيف الجامد لنقع بدورنا فيه. كل مرادنا إعطاء قصيدة النثر ما تستحق: صفة النوع المستقل. فكما أن هناك رواية، وحكاية، وقصيدة وزن تقليدي، وقصيدة وزن حر، هناك قصيدة نثر. لا نريد ولا يمكن أن نقيد قصيدة النثر بتحديدات محنطة. أن أهميتها لا بالقياس إلى الأنظمة المحافظة في الشعر وحسب بل بالقياس إلى أخواتها من الانتفاضات الشعرية كالوزن الحر، إنها أرحب ما توصل إليه توق الشاعر الحديث على صعيد التكنيك وعلى صعيد الفحوى في آن واحد.
لقد خذلت كل ما لا يعني الشاعر، واستغنت عن المظاهر والإنهماكات الثانوية والسطحية والمضيعة لقوة القصيدة. رفضت ما يحول الشاعر عن شعره لتضع الشاعر أمام تجربته مسؤولا وحده وكل المسؤولية عن عطائه، فلم يبق في وسعه التذرع بقساوة النظم وتحكم القافية واستبدادها، ولا بأي حجة برانية مفروضة عليه. ومن هنا ما ندعوه القانون الحر لقصيدة النثر. فعناصر الإيجاز والتوهج والمجانية ليست قوانين سلبية، بمعنى أنها ليست للإعجاز ولا قوالب جاهزة تفرغ فيها أي تفاهة فتعطي قصيدة نثر. لا إنها الإطار أو الخطوط العامة للأعمق والأساسي: موهبة الشاعر، تجربته الداخلية وموقفه من العالم والإنسان. وهذه “القوانين” نابعة، كما يخيل إلي من نفس الشاعر ذاته. لقد استخلصت من تجارب الذين أبدعوا قصائد نثر، ورؤي، بعد كل شيء، إنها عناصر “ملازمة” لكل قصيدة نثر نجحت، وليست عناصر مخترعة لقصيدة النثر كي تنجح.
لكن حتى هذا الانسجام بين الشروط والشاعر ليس نهائيا. ليس في الشعر ما هو نهائي. وما دام صنيع الشاعر خاضعا أبدا لتجربة الشاعر الداخلية فمن المستحيل الاعتقاد بأن شروطا ما أو قوانين ما أو حتى أسسا شكلية ما، هي شروط وقوانين وأسس خالدة، مهما يكن نصيبها من الرحابة والجمال. القاعدة القديمة: العالم لا يتغير، باطلة. ومثلها جميع المواضعات المتعلقة بالإنسان. الشاعر ذو موقف من العالم. والشاعر في عالم متغير، يضطر إلى لغة جديدة تستوعب موقفه الجديد. لغة “تختصر كل شيء” وتسايره في وثبة الخارق الوصف إلى المطلق أو المجهول. أقل عقدة شكلية تعطل انطلاقه وتحرف وجهته. أبسط هم خارجي يسرق من وحدة انصبابه على الجوهر.
وأخطر من ذلك كل العقد والسنن حين تكون جاهزة، وذات تراث طويل، أي ذات قوة أقدر على إيقاع الشاعر في حبائلها بما لها من إغراء (إغراء الراحة) ومن سلطان (سلطان التراث الطويل). وهذا ما يحدث للشاعر العربي مع الوزن والقافية وشعره القديم، وقطع هذه المرحلة يقتضي جهدا فائقا لا من أجل الرفض النظري لها فقط بل كذلك النجاح في التخلص من رواسيها، ورواسبها شكلية وضمنية. وإذ يجتاز الشاعر عقبة العالم الميت يفر من الأقماط. غير أن أبواب الشعر الصافي، عالمه الجديد الذي عاد إليه، لا تنفتح أمامه ما لم يحسن مخاطبتها، أو هي، إذا انفتحت، لا بد للشاعر أن يضيع في الداخل ما لم يكن يعرف تبين عالمه وبلورته. اللغة.. أنه في حاجة دائمة إلى خلق دائم لها. لغة الشاعر تجهل الاستقرار لأن عالمه كتلة طليعية.أجل في كل شاعر مخترع لغة. وقصيدة النثر هي اللغة الأخيرة في سلم طموحه، لكنها ليست باتة. سوف يظل يخترعها. ما يسمونه الأزمنة الحديثة هو انفصال عن زمن العافية والانسجام. إنه تكملة السعي الذي بدأ منذ قرن لا من أجل تحرير الشعر وحده بل أولا لتحرير الشاعر. الشاعر الحر هو النبي، العراف، والإله. الشاعر الحر مطلق، ولغة الشاعر الحر يجب أن تظل تلحقه. لتستطيع أن تواكبه عليها بالموت والحياة كل لحظة، الشاعر لا ينام على لغة.
شاعر قصيدة النثر شاعر حر، وبمقدار ما يكون إنسانا حرا، أيضا تعظم حاجته إلى اختراع متواصل للغة تحيط به، ترافق جريه، تلتقط فكره الهائل التشوش والنظام معا. ليس للشعر لسان جاهز، ليس لقصيدة النثر قانون أبدي.
نكتب لتقطع مرحلة، وما نكتبه يطوى، يحرق، ما لم نكتبه ولم نعرفه ولم نغص بعد فيه، هو الهم.
يجب أن أقول أيضا إن قصيدة النثر- وهذا إيمان شخصي قد يبدو اعتباطيا- عمل شاعر ملعون. الملعون في جسده ووجدانه الملعون يضيق بعالم نقي. إنه لا يضطجع على أرث الماضي. إنه غاز. وحاجته إلى الحرية تفوق حاجة أي كان إلى الحرية. إنه يستبيح كل المحرمات ليتحرر. لكن قصيدة “النثر” التي هي نتاج ملاعين، لا تنحصر بهم. أهميتها أنها تتسع لجميع الآخرين، بين مبارك ومعافى. الجميع يعبرون على ظهر ملعون.
نحن في زمن السرطان. هذا ما أقوله ويضحك الجميع. نحن في زمن السرطان: هنا، وفي الداخل. الفن إما يجاري أو يموت. لقد جارى والمصابون هم الذين خلقوا عالم الشعر الجديد: حين نقول رمبو نشير إلى عائلة من المرضى. قصيدة “النثر بنت هذه العائلة.
نحن في زمن السرطان: نثرا وشعرا وكل شيء. قصيدة النثر خليقة هذا الزمن، حليفته، ومصيره.
خريف 1960
ربيع أنسي العربيّ
مهاب نصر*
أين هو الشعر الآن؟ لا أعني أين دواوين الشعراء، ولا منابر القصائد، بل أين هو كممارسة إبداعية تجاوزت حدودها، عقوداً، لتمثل رأس حربة في التمثيل الثقافي، وصراعات النخبة؟ ربما كان صراع الأجيال الجديدة أكثر مباشرة، وربما ابتدع لنفسه رموزاً شعبوية انتقلت بالشعر وألعابه إلى الميادين.
لكن في عهود الاستبداد، خصوصاً ما تلا ما يسمى بحركات التحرر الوطني، كان الشعر معركة، وكان الشعراء يخرجون علينا في جلال زعامة مناقضة ومقابلة للزعامة السياسية. كانوا حراس الجمال، في مقابل حراس السلطة، المدافعين عن جنون الخلق، مقابل عقلنة الاستعادة والتكرار. ولأنهم تفرغوا تقريباً لمناقضة السلطة، فقد حملوا قدراً لا يستهان به من صفاتها. أنسي الحاج كان واحداً ممن دخلوا هذه المعركة مع “لن” و”الرأس المقطوع”. الأول صدّر ببيان قوي عن قصيدة النثر كأنها أكبر من أن تكون “قصيدة”، إنها بيان ثوري. بيان ليد تحطم وتهدم، ولكلمة منفلتة من أضابير اللغة الكلاسيكية، عارية كالجنون. تحدث أنسي في بيانه عن “الف عام من الضغط” كأن قصيدته، جاءت لتنهي تاريخاً كاملاً مترامي الأطراف من السياسة إلى الدين إلى الثقافة، ولم تجئ لتقر نوعاً أدبياً جديداً. كان أدونيس يفعل ذلك أيضاً، ولم يفق حتى اليوم من هذا “الدور”، ولا من تلك المرحلة التي مثل الشعر فيها، غموضه وهيجانه، استعارة كبرى لثورة لم تقع أبداً في الواقع، بل كان الواقع يسير باتجاه عكسي تماماً لها، ليكشف حتى بعد ثورات الربيع العربي كم هو معقد، وكم التاريخ أكبر من صفحة تطوى، ومن قضية نوع أدبي يركل آخر في خاصرته! لكن أنسي الحاج مع حفاظه على المرتكزات الإنسانية نفسها للمعاني المتقابلة للحرية والاستبداد، الجنون، والعقل الأداتي، والإبداع والبلادة، عاد خطوة “إلى الوراء، هي في الحقيقة قفزة إلى الأمام، عاد إلى ما يمكن تسميته “الجوهر” ليصنع قصيدته الخاصة شديدة التفرد والحساسية. خرج أنسي الحاج من مظاهرة قصيدة النثر، أو من التلويح بها كقبضة في مظاهرة، لتكون عَيْناً للتأمل هادئة أحياناً، وفي أحيان أخرى عمياء تماماً، تدفع الجسد إلى أن يتقرى بملامسه معنى الحياة كجسد وروح. الحب كان بانتظار أنسي الحاج. الحب كما عبّرت في مقال قديم عن ديوان “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع”، دفعه إلى صداقة الأرض، أي الانتباه إلى الثالث المرفوع في التناقض بين السلطة والجمال. تديّنت لغة أنسي الحاج إن صح التعبير، تديناً علمانياً. شفّت وتنبهت واندهشت دون أن تصرخ. يكتب أنسي: “التخلص من شهوة الانتقام يخفف من حدة اللغة، ويعوض عنها بكثافة الألم. وحزن الاحتقار ـ إن لم يكن الصفح ـ أكبر من هيجان النقمة، الذي إغراؤه الأول يبقى “الحيوية” الخارجية لا جوهر المعاناة. الغريب أن الشارع العربي في ثوراته أحيا النمط الصراعي القديم للتناقضات من دون أن يتعلم من درس القصيدة. أعاد الأخطاء نفسها باستخدام رموز من الشارع. لكنه أيضاً لم يرفع سوى قبضات في مظاهرة، بدلاً من أن يقدم اعترافاً بالمشاركة في الذنب، ولذلك أبدل سلطة بأخرى ووجد نفسه أمام حائط مصمت.
* شاعر مصري مقيم في الكويت
طقس للتطّهر من الذنوب
سيد محمود
قبل ربع قرن، قرأت «لن» ولم أحبه. شغلتني المقدمة عن النص. وقبل عشر سنوات، اكتشفت موقعاً إلكترونياً لقصائده وكتاباته النثرية، فقررت أن أقرأه كاملاً. وفي أول زيارة لبيروت، عدت بأعماله الكاملة. زرت جريدة «النهار» ومررت إلى جوار مكتبه وخفت أن التقي به، فيعتدي اللقاء على جمال الصورة.
حين انتقل إلى «الأخبار»، وقفت أمام صورته كمراهق والتقطت صورة تجمعنا بكاميرا الخلوي لا أعرف أين ذهبت الآن. لكني كنت أريد هذه اللحظة لأعوض لحظة فقدتها إلى الأبد، لأن عمري لم يمكنني من التقاط صورة مع صلاح عبد الصبور الذي مات محتفظاً بلقبه كشاعر حزين. ما أعرفه أنّ أنسي قرر بعدها أن يكون ملازماً لي. كانت نصوصه «قراءة طالع». أقرأه فجر السبت كمن يبحث عن مصير، من يريد أن يغطي ألمه ويطمئن له. لا أعرف إلى الآن لماذا كان شريكاً في منعطفات السنوات الأخيرة ؟
ربما احتجت إلى نبرة الإنشاد التي تصون شعره من التكرار، احتجت إلى هذا الإيمان القلق الذي يجعل من الحب وقوفاً في «المطهر» أو أرض الأعراف. لم يكتب أنسي عن الحب إلا بوصفه «ألفة» أو «حوار»، ضبطاً لإيقاع اللحظة الغامضة التي تقتحم حياتنا وتغير قوانينها بعذوبة محاطة دائماً بالألم. لغته الأليفة المتاحة، القريبة البعيدة، الأنيقة كملابس سهرة. أرادها هكذا مغايرة للغة التي كان يكتب بها من بدأوا معه وفارقهم إلى حديقة تخصه. لغة زاهية تصلح للمناجاة، قوامها الحياة اليومية التي يعجنها بحسّ صوفي ألق يجعلها وسيلة كشف، وأداة لمواجهة الذات بالندوب.
قبل سنوات، كنت في قطار قادماً من الإسكندرية وإلى جواري امرأة جميلة أخرجت من حقيبتها كتاباً، وظلت تقرأه طوال الطريق. وحين طلبت شاياً وأسندت الكتاب إلى حجرها، نظرت بتطفل فوجدت «الرسولة بشعرها الطويل كالينابيع». لكن حين استقرت في مكانها من جديد، قررت أن أسألها من أين اشترت الكتاب، فروت لي تجربتها معه. تألقت عيناها كأنها تصف غراماً لم يكتمل، تضع يدها على جرح لا تريد لأحد أن يراه. لذلك صمتت فجأة وظلت تخفي وجهها بالكتاب. وحين وصلنا، عرضت أن تهديني نسختها، فأخرجت لها الكتاب ذاته من حقيبتي.
كان معي يذكرني بلحظة لم تغادرني قطّ عشتها مع امرأة أخرى. استمعت إلى قصيدته بصوتي ثم طلبت مني أن أتوقف، ظننت وقتها أن أخطائي في القراءة أفسدت الطقس، لكنها أجابت بالدموع. قالت: «لا يمكن أن أتحمل هذا» ثم غادرت المكان بارتباك. وفي المساء، لم تعتذر وقالت: «أنسي يصلح طبيباً نفسياً، ونصه مصحة للعلاج». هذه المرأة تشبه «الوديعة» أغازلها بما كتبه واهتف: «ساعدني/ ليكن فيّ جميع الشعراء/ لأن الوديعة أكبر من يديّ». سأخبرها بمرض أنسي لتصلي له. وحدها تعرف أنه كان دليلاً إلى تجربة في الكشف والمواجهة، حفرت في ذواتنا بعمق حيث لم يعد للدموع مساحة في أرواحنا؛ لأنّ قراءته كانت درساً في الاغتسال وطقساً للتطهر يمكن بعده التصالح مع كل الذنوب.
أنسي الحاج في «مؤتمر قصيدة النثر»: أدعو الكتابة إلى وليمة الخلاص
افتتح أنسي الحاج «مؤتمر قصيدة النثر» الذي نظمه «برنامج أنيس المقدسي للآداب» في الجامعة الأميركية في بيروت (19 ـــ 21 أيار/ مايو ٢٠٠٦)، بنصّ طويل يلقي الضوء على نصف قرن من عمر قصيدة النثر في لبنان والعالم العربي، ويفتح بها آفاقا شعرية جديدة. ننشر في ما يلي هذه الوثيقة التاريخيّة
أنسي الحاج
بيروت ــــ ١٩ أيار (مايو) 2006
أيها الكرام،
الجواب، أمام دعوة الى مؤتمر حول قصيدة النثر، الجواب الفوري هو: لماذا، وقد انتقلنا الى الجهة الأخرى من المرآة؟…
لكن الجواب واهمٌ، رغم انه صادق. صادقٌ كما هو صادق كل مأخوذ بعالمه الداخلي. فهو يغوص، حتى يقطع صلته أو يكاد بالعناصر الخارجية. وفجأةً يكتشف انه هو قطع، انتقل الى الضفة الاخرى، ضفة الكينونة الصافية المأخوذة بشروطها، لكن الأرض الخارجية، ارض الواقع والسوابق، أرض الأقدام التي على الأرض، لم تنسَ، وأنها تنتظره، تنتظر وقتها لتسائله. لتفحصه. لتعود وتسأله: من انت؟
انا، تجيب قصيدة النثر، مخلوق دخيل أراد أن ينتزع وجوده بالقوة، لألف سبب شكلي ومعنوي. انا، تتابع قصيدة النثر، أعترف بالوزن لكنه هو لا يعترف بي. أنا، تقول أيضاً، ليس همّي مباراة الإنشاء، بل أن أكون على صورة خالقيَّ ومثالهم، متمردة وصارمة، حرة ومسيَّجة، متنوعة حتى التناقض، إيقاعية وفالتة، متوترة ومنفرجة، غنائية وناشفة، وقائلة ما لا تقوله الأوزان.
وتمضي قصيدة النثر قائلة للباحثين فيها: ظننتُ أن مسألة البحث في أمري حُسمت، وها هي تعود الى التداول. كنتُ واهمة وكنتم على حق. فأنا المخلوق الدخيل سأظل، مهما أجلستموني بين أنواعكم الأدبية، مخلوقاً دخيلاً. أو في أحسن الأحوال مخلوقاً مقبولاً على مضض. يبدو أن هذا هو جزء من هويتي، بل من قَدَري. لأني بنت التمرد، لا التمرد على الأوزان فحسب، بل التمرد أيضاً على أوزان القضاء والقَدَر. فأنا قصيدةَ النثر الصغيرة الدخيلة، عشبةٌ هوجاء لم يزرعها بستانيّ القصر ولا ربّة المنزل، بل طلعتْ من بركان أسود هو رحم الرفض. وأنا العشبة الهوجاء مهما اقتلعوني سأعود أنبت، ومهما شذّبوني لن أدخل حديقة الطاعة، وسأظل عطاءً ورفضاً، جليسةً أنيسة وضيفاً ثقيلاً، لأني ولدتُ من التمرد، والتمرد، التمرد الفردي الأدبي والأخلاقي، على عكس الثورة، لا يستكين ولا يستقيل حين يصل الى السلطة.
على افتراض أنه يصل.
ولكنه لا يصل.
لأن السلطة التي يصل اليها التمرد هي سلطة التمرد، ولا علاقة لها بتلك السلطات، فهي كوكب للحرية، وللحرية المتجاوزة على الدوام نفسها حتى الاستهتار بالذات.
وهل كثيرٌ، بين هذه المجرّات المنتظمة بثباتها ودقتها ورتابتها وصلادتها، مجرات النظام والتشابه والتراتبية العسكرية، هل كثيرٌ ان ينفرد كوكبٌ صغير بالانحراف عن المسارات، ويغرّد خارج السرب ولا يعبأ بزمجرة الحكّام، واستنكار الآباء، ولعنات الدهور؟
■ ■ ■
والآن، الى شيء من التأكيد.
أيها الأحباء،
طويناها صفحةً من عهد الكتابة. طوينا صفحة الغرفة الممنوعة وفتحنا الغرفة الممنوعة. بالاستحقاق والاغتصاب، لا بأس. بالسلاسة وبالوحشية، لا بأس. بالهمس والفضيحة، لا بأس. بالنعمة والانقضاض، لا بأس. لا شيء كان سيتم بسلام. كانت حرباً ولولاها لما دخلنا تلك المساحة الحديثة، ذلك المجهول المتلاطم الاحتمالات. ارتكبناها خطيئةً كُتبت علينا. خطيئة تجاوز الخطوط الحمراء، خطوط الشكل واللغة والفكر والمعتقد والذوق والمحرَّم والمقدَّس. طويناها صفحة. صفحة بمئات السنين، وما أتينا به أردنا ولم نُرد له أن يلغي شيئاً، فنحن في صميم مجيئنا مأخوذون أيضاً بأسرار وكنوز من الماضي، ومع هذا نحن “تقليديون”، تقليديو الفنون المرذولة والعلوم السوداء، تقليديو السحر، والآن تقليديون خوارج من عائلةٍ ماضيها حاضر وحاضرها مجهول.
وكما قلنا، لا ندّعي إلغاءً للوزن ولا للقافية، بل نحن من عشّاق الأغاني، كثيراً ما نفضّلها على كتاباتنا. فكيف ندعو الى إلغاء وكلّ حملتنا حملةُ غرسٍ وإيجادٍ وإكثارِ حياة؟ ليكتب كلٌّ على هواه، ولينقل الهواء ما يحلو له نقله. لقد أردنا مكاناً لما لم يكن له مكان، أردنا جسداً لإيقاع لا يضطرب به روح النثر العربي فحسب بل يضطرب به روح الشاعر العربي ولا يريد سكبه في الأطر القديمة، بل يتطلع الى شكل أكثر ملاءمة لمناخه، أقلّ عسفاً حيال فكره وشعوره، أكثر قرباً من أصواته الخارجية والداخلية، أقلّ تفريطاً بحذافير تجربته، أكثر استيعاباً لحوادث لحظته وأوزان كيانه. لو لم تُرد قصيدة النثر التعايش مع قصيدة الوزن لما سُمّيت قصيدة نثر بل لزعمت لنفسها تسمية قصيدة، قصيدة فقط، بلا تمييز.
قال بعض النقاد ان ثمة قصائد نثر تنطوي على إيقاعات واضحة يمكن استخراج أوزان منها تضاف الى الأوزان المعروفة. وهي نظرية وجيهة. وليُسمَح لنا بأن نضيف اليها فنقول: أياً تكن الأوزان التي قد يستخلصها علماء الغد من قصائد النثر، نرجو ان لا تكون حدوداً ولا قيوداً، ونؤمن إيماناً راسخاً بأن إيقاعات جديدة ستظل تطل في تجارب جديدة ومعها احتمال أوزان جديدة. وهذا هو الهدف من بحر النثر، أن يكون بلا حدود ولا نهاية، وأن يظل حقل الحقول الذي كلما وطئتْه قدمٌ أحست أنها تمشي على غابة عذراء.
■ ■ ■
عهدَ الفظاظة كنتُ سأقول: عقابٌ لقصيدة النثر أن يأويها مؤتمر في جامعة. وكان سيكون ذلك كاذباً. اليوم أقول: لا ضير عليها من ذلك. وسيكون ذلك أيضاً كاذباً. الكذبة الأولى استفزاز، والثانية مجاملة. وتظل الحقيقة، مع هذا، خارج الكذبتين.
ومع الشكر للذين نظّموا هذه الحلقة الدراسية، أعتقد ان المبرر الأكبر لمؤتمر كهذا، هو ان يكون انطلاقةً نحو أبحاث نقدية وتقييمية لما أنتجه هذا النوع منذ تأسيسه قبل نحو نصف قرن. الحاجة ماسة الى النقد. حاجة القارىء، وهو ضائع وزاهد، وحاجة الشاعر، وهو الضائع والمضيِّع. لم تصبح قصيدة النثر العربية، كالمعلّقات، وثيقة للتاريخ حتى نستريح من قراءتها أو من كتابتها ولا تعود صالحة إلاّ للمراجعة الأكاديمية. ولم تُقرأ بعدُ كفايةً، لا بعين الفضول ولا بعقل التمحيص. من هم شعراؤها؟ ما هي أنواعها؟ أين هي جذورها الظاهرة والخفية؟ ما هو مستقبلها؟ ما هي الاحتمالات بعدها؟
الحاجة الى النقد هي اليوم أشدّ الحاجات الأدبية إلحاحاً. وإن كنا نعتقد مع المعتقدين أن الشعراء هم أنبه النقاد، ويظل أكبر مثال على ذلك بودلير، فلا يعفي هذا النقّادَ النقّاد من مسؤوليتهم. كان بودلير الناقد شاعراً معلناً، ولكن كم من ناقد معلن هو شاعر سرّي.
وإني أرجو لهذا المؤتمر أن يكون مناسبة ليقوم المشاركون فيه – وكذلك غير المشاركين من كبار الشعراء والدارسين – بعملية إعادة نظر تكون هذه المرة إعادة نظر لقصيدة النثر في ذاتها من الداخل، وقد كان معظم النظر النقدي اليها في السابق هو من خارجها، او من ضفاف مخضرمة.
■ ■ ■
ليُسمح لي الآن، وقد ازدحمت في رأسي خواطر كثيرة عن موضوعنا الليلة، أن اكتفي ببعضها، وسأورده على سجيّته، بدون ضبط تسلسلي:
قصيدة النثر شغل وِحدة. شغل من يدرك أو يشعر أن هذا الذي يكتبه ليس موجهاً الى جمهور معروف بل الى شخص واحد ربما، وأحيانا الى مجهول. رسالة في زجاجة يتقاذفها الموج. موجهة الى مجهول مرغوبٌ الوصول اليه رغبةً حارة، ولكنه قد يظل، بل على الأرجح سيظل كجهولا ولو عُلم.
قصيدة تكسر عزلتها ما ان تنكتب كلمتها الأولى، ولكنها العزلة الخارجة من ظلام واضح الى وضوح مبهم. الكاتب هنا قانع بزاويته الصغيرة، لا يمد ذراعيه أبعد من أفياء سطوره. هو يعرف انه ليس مطرباً، ويعرف أنه يقف على رصيف الذاكرة. هذا المصير الفقير هو الذي اختاره حين اغترب عن الاوزان المباركة والقوافي السعيدة وهبط ذلك الهبوط المدوّي خارج النعيم، منقذفاً على خطايا نثره من جيل الى جيل، تجرّحه عظامه وعروقه قبل ان تجرّحه صخور الآخرين وجبالهم، فيما هو يسبح بين الأجرام، تتشلّعه التيارات كما تتشلّع كل من يخرج على مدار الجاذبية.
■ ■ ■
في اساس قصيدة النثر، فضلاً عما قيل ويقال، بديهة نكاد ننساها. وهي، بكل بساطة، حبّ النثر. ما يجده الناظم في الوزن أجده في النثر. موسيقى الأوزان تناسبه، موسيقى النثر تناسبني. الامتحان الذي يخضع له في تطويع الوزن، أخضع له في تطويع النثر. استنباط الايقاع من النثر هو أشبه بتحويل المعدن الرخيص الى ذهب. ليس هذا فحسب، بل الكتابة كلّها هي هذه العملية الخيميائية، ولا قيمة لها الا بمقدارها، وبمقدار تحدّيها شبه اليائس لاستحالة النجاح في هذه العملية. ليس هذا فحسب، بل الفكر، مجرد الفكر في مجرد الرأس، ان لم يكن توقاً، وبكل جدية التوق ومأسويته، الى تحقيق تلك العملية الخيميائية السحرية التي تشتقّ الشيء من خصمه والنبل من الوحل والوجود من العدم والجمال من الغياب، فأي معنى له ولصاحبه؟
فلنعد الى الخواطر حول قصيدة النثر.
ان الطاقة التي ولّدت قصيدة النثر في اواخر الخمسينات – مطلع الستينات من القرن الماضي وحملتها كالاعصار مفجّرة في وجهها حرباً هي الأخرى اشدّ من الاعصار، تلك الطاقة وازتها طاقة لا تقل زخما في ارادة بناء عضوي لقصيدة النثر وهندسة لكياناتها يحميانها من الذوبان في نهر الانحلال او من التساقط تحت خيول الانفلات.
ان أي قصيدة هي كيان متوهّج قائم بذاته، وقصيدة النثر لا تشذّ عن هذا الوصف. لكن يجب الاقرار بأن اللحظات الشعرية ليست متساوية، وقد تبتعد قصيدة عن مفهوم الكيان المتكامل السيّد وتقترب أخرى، وتستوفي قصيدة الشروط جميعاً وتنحرف اخرى. وإذا كان في هذا الانحراف وهن فليس بعارض قاتل ولا بخطيئة مميتة إن توافرت صفات شعرية أخرى تُغرق الفجوة التقنية أو الشائبة العضوية بفيض من الدفق الشعوري أو الجمالي أو ما لا يحصى من ميزات الفيض.
ويؤخذ علينا، أنا وسواي من المؤسسين، اننا حددنا شروطا ومواصفات لقصيدة النثر عدنا، أنا وسواي، وخرقنا العديد منها. من ذلك حجم القصيدة. قلنا بالقصيرة، ثم اكتشفنا بالممارسة ان لا ضير في الطويلة، حتى لو تنافرت، حين تدعوها تجربتها الى الافاضة، او حين يجرفها سيلها فيمنعها من الانحصار في ساقية تحت طائلة التشويه. وغيرها قليل، خيانات ارتكبناها، انا وسواي، ولكنها خيانات من نوع الشذوذ المثبّت للقاعدة، بل من نوع توسيع الحدود. لم نفرّط في مفاهيم القصيدة، بل طوّرناها وجعلناها أرحب مما أريد لها في القرن التاسع عشر الأوروبي والأميركي يوم كانت مجرّد رفيقة صغيرة فقيرة لصاحبة الجلالة قصيدة الوزن.
فالشعر يبتدع أصوله كما يبتدع السائر ظلاله. ويتلوّن ويتجدّد كما يتلوّن الاغراء ويتجدد. لم يخطىء العرب في تسمية روح الشعر بالشيطان. شيطان الشعر هو اكسير المفاجأة. شيطان هائم في الطهارة والنقاء كما هو هائم في الرذيلة والتهتّك، ودوما فمه مضرّج بماء التفاحات، ينهش فيها ويثمر أطيب منها، وعند قدميه المصابيح، وعلى خطاه المعرفة، معرفة الاطفال، المعرفة التي تتقدم الحياة وتسخر من ذاتها وتصنع الحياة والخيال والرغبة والجمال، ولا تدّعي انها عارفة بل تتجلى كالظهورات وتكون في أول المفاجأين بذاتها، تلسع وتمطر وتُشعل وتؤنس وتلعب، والشعراء لا يتبعهم أحد ولا حتى ظلهم، لأنهم ارواح ترفرف على وجه الحياة وامام عيون الابرياء وجرحى الوجود واحلام الصبايا، مثلما قديما قيل ان روح الله في البدء، قبيل النور، كان يرفرف على وجه المياه.
■ ■ ■
خاطرة اخرى: من الحق أن يُسأل شاعر النثر لماذا لم يكتب نظما؟ عن عجز ام عن رغبة في التنويع؟ والاجوبة باتت معروفة. ولكن لماذا لا نسأل ان لم يكن هناك وراء اختيار النثر كيانا شعريا، نقصٌ ما في قدرة الأوزان على ملاقاة ما يريد الشاعر قوله – ملاقاته بأمانة ورحابة، بطواعية وتناغم، بعدما فتحت اطوار الحياة الحديثة أبواب الانقلابات والاحتمالات على مصاريعها، وحتى تلك الأشد عجباً والأكثر استدعاء لا لأساليب تعبيرية جديدة فحسب، بل للغة جديدة؟
لا عبرة في القول ان كثيرين من ادعياء الشعر يختبئون وراء مسمى قصيدة النثر او الشعر المرسل، لصفّ الكلام وطلاء العقم تارة بالفراغ المنقّط وطورا بإنشائيات سقيمة تعمّق الهوّة بين القارىء والشعر، والشعر منها براء والقارىء فيها مظلوم. لا عبرة في مثل هذا القول، فهو صحيح، كما هو صحيح القول إن كثيرين من ادعياء الشعر اختبأوا ويختبئون وراء مسمى قصيدة الوزن او الشعر العمودي لصف الكلام والخ. انما العبرة في قياس الشعر – بل الخلق عموماً – بحجم القَدَر الذي يصارعه. ولا ألعب هنا على اللغة، فالالتباس مقصود: لأن الخلق يصارع القدر، كما أن القدر، رغم مظاهره غير العابئة أو قناع اختفائه، هو ايضا، هو خاصة، هو دائما يصارع الخلق.
ان اغراء السهولة الذي تلوّح به قصيدة النثر إن هو إلا سراب، اكثر ما يشبه سراب الانخداع بسهولة الحرية. ومرة أخرى لا أستعمل التشبيه صدفة، بل هو مفروض تبعاً لقاعدة السبب والنتيجة. فقصيدة النثر بنت الحاجة الى الحرية، والحرية النثرية هذه حرية انعتاق من قوالب وحدود اكثر بكثير مما هي حرية قول أي شيء نريد باي شكل نريد. ولأنها حرية الانعتاق من العبودية، فسرعان ما تلمّست اشكالا وضوابط من نوع آخر، من صميم التجربة الجديدة، تقيها تشوّهات الفوضى. ولا أقاوم هنا استعمال تشبيه غريب لمحاولة وصف العلاقة التي تربط قصيدة النثر بصاحبها وصاحبها بقارئه وقارئها بها: اراها علاقة جدلية سادية مازوشية، طرف فيها يقسو وطرف يلين.
■ ■ ■
ومع هذا، مع هذا،
سنتظل الأوزان المعروفة مرغوبة لأن ايقاعاتها استراحة للوجدان ونزهة راقصة للذاكرة والقلب، ولأن في اتقانها براعة تنتزع الاعجاب، وكم يحتاج الانسان الى الاعجاب بما لا يستطيعه شخصيا، ففي هذا ما يريحه في مقعد التلقّي، يطربه ويهدهده ويحمله على أجنحة النغم السائغ الى الضفاف الهنيئة.
ستظلّ الأوزان مرغوبة وقبلة أسماع الكثيرين، وربما الأكثرية، بمن فيهم أحياناً العديد من شعراء النثر. ستظلّ ما دامت الحاجة إلى الرقص المضبوط الإيقاع حاجة للذاكرة والحواس كما هي حاجة للجسد بأعضائه جميعاً.
لا أعرف إن كان أحدنا في زمن الاندلاع الأول، أو ردّ الفعل قد قال مرّة إنه يريد بقصيدة النثر إلغاء الوزن. ربّما. لكنّ الحقيقة هي أن قصيدة النثر لم يَخْلقها تحدّي الإلغاء بل حاجة مطلقة إلى الانوجاد. حاجة بدوافع وعوامل وعناصر كثيرة، ولّدها الانفجار بين كبت الماضي ونداء الحياة. حاجة إلى التمرّد الكياني والتعبيري، وحاجة إلى لغة وفيّة. حاجة إلى نبش تراب الكتابة حتى جذوره الخفيّة الرطبة في أديم الشعور. حاجة إلى الانبثاق لا تخضع نتيجتها إلا لامتحان القدرة على الصمود بعد الانبثاق.
هل أردنا من حيث لا ندري إعادة ربط صلة ما لا نعرفها بنثر عربي قديم، يقال إنه لم يكن موجوداً، وبعض الظواهر، فضلاً عن عقلنا الباطن، يومئ لنا بأنه كان موجوداً؟
أم كانت فقط حركة حداثة صافية، أرادت اللقاء بإيقاعات العصر والعالم، ولم تذكر بعض الجذور المحتملة لها في التراث إلا من باب التشنُّع؟
على كلّ حال، من جهة، كائن مستقرّ ومرغوب وشعبي هو الوزن. ومن جهة أخرى، كائن متمرّد وشقي ومبهم هو قصيدة النثر.
زواج شرعي، في وجهه علاقة غير شرعية.
الحلال والحرام.
واحدهما يستدعي الآخر.
الحرام يفقد نكهته الانتهاكية، إذا تلاشى الحلال،
والحلال يصير موتاً إذا لم يكمن له الحرام.
وهكذا نحصل على نوع جديد من التعايش الأدبي نستطيع أن نسمّيه تعايش الخير والشرّ، والجريمة والعقاب، وآدم القانع بمصيره، وآدم الآخر الرافض مصيره، وطبعاً حوّاء الزوجة العاقلة، وحوّاء الأولى، ليليت العفريتة، المتمرّدة التي فضّلت حرية اللعنة، أو لعنة الحرية، على دموع الاستقامة وقداسة الأمومة وتاج الآخرة.
■ ■ ■
أيها الكرام،
هل يكره الخالق الخليقة؟ إذا أجبنا عن هذا السؤال بنعم، نفهم لماذا الموت. إذا أجبنا بلا، يتعاظم اتهامنا للخلاّقين: فإن كانوا يحبّون خلائقهم فكيف يتركونهم يموتون؟ وإن كانوا يعجزون عن حمايتهم فلماذا يخلقونهم؟
وقد يكره الخلاّق خلائقه لسببين على الأقل: الأول حسداً منها إذا رآها وقد ابتهجت بوجودها أكثر مما يحتمل، والآخر تبرّماً منه بالمقلّدين إن اعتبر أن مخلوقاته تستنسخه.
والخلاّق معذّّب في كلّ الأحوال. فإن هو لم ينجب سلالة، يُصلب على عزلته. وإن أنجب، يُصلَب على حرمانه صفة الوحدانيّة.
وخلاصه ما كان سيكون إلا ببقائه مغلقاً، يُعفيه عقمه من النَدَمَين.
■ ■ ■
كلّ تكوين إنما ينبثق من حلم. وما ينبثق من التكوين قد لا يكون حلماً أو تحقيق حلم. ومرّات، من التكوين تنبجس الكوابيس. وذلك هو أحد آلام الأحلام. الحلم كالحرية كالحبّ، إما تأخذ به وبكلّ نتائجه، أو تعتذر منه وتستقيل. الحلم لا يرحم. ولستَ أنت من يحدّد ثمنه. لا أعرف مَن. ولكن لستَ أنت.
لا يقتحم أحد ميداناً إلا وفي قرارة نفسه رغبة بأن يكون البادئ والخاتم. حتى ولو تظاهر بالعكس. أتحدّث هنا عن الخلاّقين لا عن الأنواع. الأنواع تتعايش ولكن بذكائها الخاص لا بإرادة خلاّقيها.
أفظع ما في الأمر ليس مقدار التبجّح ولا شغف السلطة ولا حمّى الإلغاء عند الخلاّقين، أفظع ما في الأمر أن القدَر يشاء، بين مفترق وآخر في التاريخ، أن يحقق بعض المقتحمين هذا الحلم، وغالباً بعد موتهم، فيكون للبشرية، مثلاً، سوفوكل وأفلاطون وشكسبير ودانتي وميكل آنج ودافنشي وموزار وفان غوغ وبيتهوفن وبودلير ودوسيتوفسكي ونيتشه… هؤلاء، وغيرهم من طينة مشابهة، حلموا وكوّنوا، وإن كانوا قد تركوا الحلم مفتوحاً فإنما أغلقوا التكوين. كيف؟ بوحشيّة إبداعهم. وحشيّةٌ ترغب في التقليد، ولكنها لا تُقلَّد. وحشيّة طبعت الزمن كما طبع الإنسان الأول الأرض والبشر حين انبثق. ونحن إذ نغبط هذه الوحوش الذهبية الإلهية، فليس فقط لتركها لنا جمالات توقف قليلاً سير الموت فينا، بل لأننا نحبّها أو نكرهها ولكننا لا نستطيع أن ننتسب إليها إلا كعشاق أو كارهين، لا كأنداد ولا حتى كمقلّدين.
ولكن أنّى لنا، نحن الأقزام، مثل هذا المصير الرائع المروّع؟ لقد حُكِم علينا، وقد سربلونا بتسمية الروّاد، أن نفتح الأبواب ولا نستطيع إغلاقها. هل يؤلمنا هذا الوضع؟ يؤلم بعضنا بالتأكيد، إذا توكّلنا على نوازع النرجسية. ويؤلم بعضنا الآخر إن اعتبرناه، أو اعتبر هو نفسه المرجع الأكبر. وفي هذا ما فيه من أنانية الأبوّة التي لا ترى خيراً في الأبناء إلا لأنهم يذكّرونها بنفسها وهي كانت تريد لنتاجها أن يكون مستودعها الأخير. وضعٌ مؤلم لمن ينسى أنه هو أيضاً كان طارئاً ودخيلاً قبل أن يغدو مقيماً وأصيلاً، ومؤلم لمن يكره العودات، ولمن يكره البدايات إلا على يد ذاته، ولمن يكره أن يضيف إليه أحد، فكيف بمن يتجاوزه أو يطويه.
هذا الوضع المؤلم، أنا شخصيّاً عرفتُه. عرفتُه من زمان، ويومها لم أكن قادراً أن أحبّ من الشعراء والأدباء إلا من لا يشبهني في شيء. كنت أغترب بواسطتهم. أهرب. كان ذلك علامة مألوفة لدى جميع كارهي ذاتهم.
لم أنقلب من هذا الموقف إلى عكسه. كلّ ما حصل هو أني، بالإضافة إلى استمتاعي بقراءة اللامشابهين، تعلّمت أن أكتشف، أن أكتشف جميع مَنْ تتاح لي مطالعته، بدون حبّ جاهز ولا بغض جاهز، بل بملاءة ذهنيّة ونفسيّة، يطغى عليها ميل إلى الإعجاب، وتعطّش إلى الفرح بالموهبة أو النبوغ فرحي بالنعمة وكأنها مُنحت لي.
نحن الأقزام هذه مكافأتنا. نجدها هنا، على حياتنا، وفي أبنائنا وأبناء سوانا ممّن تخطّانا بعضهم ونريد لغيرهم لا أن يتخطّانا فحسب بل أن يدفنونا دفناً ذات يوم.
■ ■ ■
شيء يجعلنا لا نرغب القيام من أمام فيلم سينمائي، من أمام شريط متسلسل لا ينتهي إلا ليبدأ تخديرُ شريط جديد، واستسلامنا الكلّيّ إلى براثن أحضانه.
عندما كنتُ طفلاً كنت أبكي في صالة العرض حين ينتهي الفيلم، وأتشبّث بالمقعد رافضاً الانصراف، ظنّاً منّي أن بقائي سوف يعيد الحلم.
هذا الحلم هو نفسه ما يعدنا به الفن، والشعر، وما تعطينا إيّاه السينما بسخاء لا يكدّره أبداً طابعها الصناعيّ ولا حسابها التجاري. هذا الحلم، هذا التهرّب من قدرنا ورعبنا، طلبناه من الشعر، كما طلبنا منه أن يكون سلاحنا عند الاضطرار إلى المواجهة مع تلك الوحوش أو أولئك الآلهة. كلا الفرار والصراع، هما في أساس قرعنا لأبواب النثر. لقد كانا كلاهما منذ فجر التعبير، طبعاً، ومنذ فجر التعبير وأساليب هذا التعبير تتحرّك وتتغيّر تبعاً للحياة. وهذا هو أيضاً ما أحسسنا بالحاجة إليه في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، عندما راحت نداءات الداخل وعوامل الخارج تستحثّنا لاكتشاف أثوابنا الجديدة، وصناعة مفاتيحنا الخاصة، والدخول بخطانا نحن لا بخطى مستعارة إلى حقول لم نعرف، والأمل أن نظلّ لا نعرف، أين تؤدي، شرط أن يبقى الدافع إلى السير عليها هو تلمّس لحم الروح وتجرّع شراب لحظةٍ تُصعدنا كالأولاد العابثين فوق ظهر الموت، وعدم إحناء الظهر، بل الظهر والرأس واللغة والأرض، إلا لشيء واحد، لشيء واحد يتكرّر ولا يتكرّر، يتكرّر ويظلّ معلومه مجهولاً، يتكرّر ويظلّ هو المفاجأة، شيءٍ واحد يضع حدّاً لحرب الخير والشرّ، شيءٍ واحد هو فضيحة الفضائح وشريعة الشرائع، شيءٍ واحد أجمل من الجمال، شيءٍ واحد هو الحبّ.
■ ■ ■
كان غوته يقول: “الشعر هو الخلاص”. وقال دوستيوفسكي: “الجمال سيخلّص العالم”.
هذا السباق الى الخلاص، أريد أن أختم تحت رايته.
وبعيدا عن الأنواع والأجناس، ومعارك القديم والجديد، وجهود المعبّرين في البحث المتواصل عن لغة أكثر أمانة في تقمّص التجربة، اسمحوا لي أن أعقد أمنية.
أنا صاحب الهدم والصلاة، أتطلع، وقد أَضنيت وأُضنيت، إلى كتابة تشفي.
لا أقصد كتابةً تُلهي، وأنا أحبّها، وفي مرحلة طويلة ما هربت إلا بها.
بل أقصد الكتابة التي تشفي، التي تُنقذ، التي تخلّص، كما تشفي المعجزة وتنقذ وتخلّص.
لا أتنكر لكتابة الغضب واليأس، ولا لكتابة الهدم والإطاحة، بل اتبنّاها وأنا من جنودها، وسوف تظلّ، كما تظلّ كلّ كتابة صادقة وحيّة، ضرورية ضرورة الحقيقة وضرورة الحياة وما فوقهما.
لا تنكّر ولا انقلاب، بل إضافة. إضافة نعمة. نعمة تنير الليل الكوني كما تنير الليل الفردي.
إن للبشر في ماضي الكتابة روائع حقّقت معجزات.
والكلمة في الأساس معجزة.
وما أتمناه هو أن يستعيد الكاتب، شاعراً كان أم روائياً أم فيلسوفاً وناقداً وخطيباً، أن يستعيد لا سلطة التكوين التي هي له فحسب، بل سلطة الشفاء من أمراض الوجود.
في مطلع الألفية الثالثة، وعلى هامش حديث الشعر الذي هو جوهري دائماً، ومن هذا المنبر العريق في التفاؤل أدعو الكتابة إلى وليمة.
إلى وليمة القوة التي تغلب البؤس، تغلب اليأس، تغلب العجز، وتغلب الاختناق.
إلى وليمة الخلاص بسحر المعجزة الشعرية. والمعجزة، أيها الكرام، هي دائماً شعرية.
«لن»: لعنات لزمن قادم
يزن الحاج
في البدء كان الخوف، وفي الختام كان التمرّد، وبينهما عاش أنسي الحاج. ليس غريباً أن يبقى أنسي متفرّداً وموشوماً بلعنة مجايليه، ومرجوماً بحجارة الباحثين عن «الاستقرار». لم يكن لهذا النبيّ حواريّون أو أتباع؛ ولعل هذه السمة هي ما ميّز أنسي عن «شعراء مجلة شعر»، وما جعله (إلى اليوم) شاعرها «الملعون».
ليس ثمة مبالغة في القول إنّ شعر أنسي لم يُدرس دراسة نقدية حقيقيّة إلى اليوم. بقي شعره دوماً على هامش «الحركة» النقدية العربية المحكومة (في معظمها) بفصل تام بين تطرّفَيْن: مديح مفرط أو ذم هدّام، أما ما يشذ عن هذين التصنيفين، فلا يحاول التأسيس لبناء نقديّ مستقل أو حتى «منزلة بين المنزلتين»، بل يستند إلى «ثقافة عربيّة» مديدة شغوفة بالمقارنات. وقد كان معظم نقّاد شعر أنسي الحاج من أنصار الاتجاه الأخير، حين عجزوا عن التقاط فرادة هذا الشاعر فألحقوه بـ«مدارس» أو «تيارات» مكرّسة، كأن يقارنوه بالمدرسة الرؤيويّة الأدونيسيّة أو «القصيدة اليومية» الماغوطية، وإنْ كان ذلك لإظهار بأنه «هجين» بين هاتين المدرستين. أو عمدوا إلى القول إنه سليل المدرسة الفرنسيّة لقصيدة النثر، دون الأخذ في الاعتبار التيارات المتباينة والمتمايزة في القصيدة الفرنسيّة وشعرائها.
وربما يعود هذا التردد النقدي إزاء أنسي إلى أيام تأسيس مجلة «شعر» (1957)، إذ كان من بين الأسماء التي واكبت تقلّبات المجلة الشعرية الأشهر والأبرز في القرن العشرين، ابتداءً بتأسيسها الجريء، وانتهاءً بإغلاقها المتكرر عدة مرات، مروراً بالمعارك والجدالات التي شنّها كثيرون ضد تلك المجلة، ومن بينهم «أبناء» لها، بدأوا مسيرة «ردّتهم» بإعلان التنصّل من تلك «الخيمة» التي آوت جميع البذور الشعرية التي ستُزهر بتنوعات شتى في السنوات اللاحقة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن السنوات الثلاث التأسيسيّة للمجلة (1957ــ1960) لا تزال حقلاً بكراً لم يقاربه النقد الجاد إلا في استثناءات نادرة. كانت تلك السنوات هي الحامل الأبرز لمعظم الدواوين الأولى للشعراء الذين سيصبحون الشعراء الأبرز في السبعينيات، وكانت أعداد «شعر» ومنشوراتها هي البوصلة الفعليّة في الكشف عن «الشمال الشعريّ» الذي ستتجه إليه القصيدة العربية في مسيرتها المضطربة.
خلال تلك السنوات، وصولاً إلى المحاولة المخفقة لإحياء مجلة «شعر» في الثمانينيات، كان أنسي هو الشاعر الوحيد (إذا استثنينا المؤسس يوسف الخال) الذي شهد «تقلبات» المجلة، ومضى يكتب وينظّر لقصيدة النثر. ويمكننا القول إنّ باكورته الشعرية «لن» (1960)، بقصائدها ومقدّمتها النظريّة، هي المعبّر الأفضل عن الأفكار الفعليّة لمجلة «شعر»، قبل أن تعاني تلك الأفكار، لاحقاً، من تعديلات وانحرافات ترافقت مع ابتعاد شعرائها عن تلك «الخيمة»، ليؤسسوا خيمهم الخاصة التي بقيت مرتبطة عضوياً بالمجلة الأم وأفكارها، وإنْ اختلفت سبل أبنائها.
في ديوان «لن»، سنجد روح قصيدة النثر وعمودها الفقري النظريّ. أنسي كتب مقدّمته الشهيرة تلك وهو مدرك أنّه يؤسّس لعالم شعري جديد. وللمفارقة، يمكننا اعتبار أن تلك المقدّمة عاشت أكثر من القصائد المرافقة لها، إذ لا تزال مقدّمة «لن» هي البيان الأشد توازناً ووضوحاً لقصيدة النثر، حتى بعد مرور أكثر من نصف قرن على كتابتها. بينما لن تجد معظم قصائد ذلك الديوان مكاناً متقدماً لها اليوم إذا وضعناها تحت عدسة نقد صارم. كانت تلك القصائد ابنة لزمن كتابتها، بينما كانت المقدمة النظرية ابنة لزمن قادم. وقد كان أنسي مدركاً لهذه المسألة، برغم نفوره من التنظير الشعري، لذا كانت دواوينه اللاحقة، بخاصة «الوليمة» (….)، مختبراً شعرياً لتلك الأفكار النظرية، مبتعدة عن الصرخة الأولى في «لن»، دون أن تتخلى – في الوقت ذاته – عن «الثوابت» الأبرز في شعر أنسي؛ أي، التمرد والخوف و«خيمياء» اللغة (بمعنى إخضاعها الدائم لثورات متلاحقة)، والروحانية الشفيفة.
ومجدداً، ليس ثمة مفر من تكرار القضية الجدليّة الدائمة بين الإبداع والنقد، ولا أعتقد بأنّ ثمة مبالغة في القول إنّ شعر أنسي متقدّم على نقّاده بمراحل عظيمة. كان شعر أنسي الحاج (ونثره بصورة أوضح) أعمق بأشواط من الكلام المعتاد في المقالات والدراسات «شبه النقدية» التي تحاول مواكبة مسيرة الشعر العربيّ. كان أنسي يُذهل قرّاءه ونقّاده دوماً بقفزات يتزايد عمقها مع كل ديوان جديد. حتى المرأة، التي تعدّ «الثابت» الأهم في شعره، تظهر بصور متعددة ومتناقضة في كل قصيدة جديدة؛ هي القديسة أحياناً، العاهرة أحياناً، الكون بأسره تارةً، والتفصيل المنمنم تارة أخرى، والإيروتيكيّة دوماً. ولا يمكن فهم شعر أنسي دون المحاولة المثابرة لفهم صورة المرأة لديه. ولعل تغيّر هذه الصورة وتباين أصدائها لديه كانا السبب الأكبر في تهمة «الغموض» التي أُلصقت بأنسي، دون أن ننسى «المختبر اللغويّ» الدائم لديه في كل قصيدة؛ «فالشاعر لا ينام على لغة»، كما عبّر في مقدّمته الشهيرة.
إن فرادة أنسي الحاج (شعراً ونثراً) تكمن في كونه يعيش دوماً على التخوم، ما جعله عصيّاً على التصنيف. إنه يتأرجح دوماً بين الهوامش: هوامش الروحانية، التمرد، المسيحية، السوريالية، التصوف، الإيروتيكية، واللغة. وتلك هي الصفة الأهم للنثر، كحالة كتابيّة وحياتية في آن واحد، ولذلك أوغل أنسي الحاج في النثر كداء وترياق في الوقت ذاته في «زمن السرطان» الذي لا فرار منه، ولا حياة فيه، إلا للمتمردين والخائفين والمجانين والملعونين.
ثورة أنسي الحاج الخاصة/ حسام عيتاني
انتقد ناشطون سوريون كثر الشاعر الراحل أنسي الحاج لموقفه من الثورة على نظام بشار الأسد. أدرجوه في خانة المؤيد للنظام، استناداً إلى مقالات قليلة كتبها وتناول فيها ما يجري في بلدهم.
وعلى جاري عادة النقد الغاضب، مزج الناشطون هؤلاء مسيرته الشعرية بمواقفه السياسية، قصائده بمقالاته، آراءه بمكان عمله… والحال أن مستويات عدة من التناول يجدر استخدامها عند التطرق إلى شخصية أنسي الحاج وأعماله. ومن التبسيط المخلّ النظر إلى الرجل من خلال إشادته بممثلة سورية أعلنت ولاءها لبشار الأسد الذي يتفنن في قتل مواطنيه، على رغم ما أثارته الإشادة تلك من استياء بين سوريين ولبنانيين كثيرين. ولا يستقيم تقييمه بالاقتصار على مقال دعا فيه إلى قيام حكم مستبد في لبنان (وكان كاتب هذه السطور من المعترضين عليه).
لعل أنسي الحاج من بين الشعراء اللبنانيين، أكثر من يذكرنا بالسجالات التي بدأت في أوروبا ثم انتقلت إلى بلادنا، عن دور المثقف وموقعه وعلاقته بمحيطه. نقاشات انطلقت حول مقولة «الفن للفن» أو الفن كوظيفة في التقدم الاجتماعي، وشاركت فيها أسماء كبيرة مثل غوتييه ومالارميه في فرنسا وطالت في الزمن لينخرط فيها والتر بنجامين وأنطونيو غرامشي وتتحول إلى علامة من علامات الصراع الثقافي الموازي للحرب الباردة مع مدرسة «الواقعية الاشتراكية».
لم ينته النقاش بعد، فها هو جاك رانسيير يساهم فيه عبر عدد من المؤلفات النقدية المهمة («أدب السياسة»، «الخطاب الأخرس»، مالارميه»… إلخ)، مجدِّداً مواقف اليسار ومقدماً أفكاراً جديدة حول دور الأدب والثقافة، يقابله ربما رينيه جيرار، اليميني المسيحي، منذ كتابه «الكذبة الرومانسية والواقعية الروائية» ومؤلفاته عن بروست ودوستويوفسكي وغيرها. وقد يكون من المفيد التذكير مثلاً، بأن رانسيير يشير إلى أن شعار «الفن للفن» استخدمه مالارميه رداً على شعراء وفنانين سبقوه ووضعوا الفن في خدمة السلطة وكوسيلة للتكسب المادي. بهذا المعنى، يكون مالارميه بسعيه الى تحرير الفن، أكثر «تقدمية» ممن وضع نفسه في خدمة السلطة.
المهم أن للجدال أبعاداً تتجاوز الموقف السياسي المباشر. ومن الضروري في هذا السياق التمييز بين أمرين: الأول وعي المثقف للدور الذي يؤديه، والثاني محاولته البقاء في «قوقعته» التي طالما تعرضت إلى الانتقادات، وفي عالمه الوهمي.
في حالة «الوعي» بخدمة الاستبداد والدعوة إلى الطغيان تجوز محاسبة المثقف كجزء من آلة الدعاية السياسية التي يحركها طرف سياسي. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أداء المثقف هذه الخدمة من دون دراية كافية منه أو قلة مبالاة بالسياسة وعالمها.
إعجاب أنسي الحاج بالممثلة السورية الموالية للأسد وببشير الجميل وميشال عون، ليس مما يعزز مواقعه بين الجمهور السوري، لكن يتعين الانتباه إلى أن أنسي الحاج لم يقدم نفسه يوماً ثائراً سياسياً. ومن يقرأ مقدمته لمجموعته الأولى «لن»، يلاحظ بسهولة أن «الثورة» التي حمل الشاعر الراحل لواءها تتركز في ساحة الشعر و «الخطاب». مواقفه الاجتماعية التي يمكن استنتاجها من سلسلة طويلة من المقالات في «النهار» وغيرها، لا ترسم له صورة الداعية الثائر، بل العكس هو الأقرب إلى الصواب، أي صورة حامل الآراء المحافظة في مجالات العائلة والدولة والمجتمع.
على رغم ذلك، يظل أنسي الحاج شخصية ثقافية إشكالية، فمن جهة أقام الشاعر عالمه الخاص وانزوى فيه تقريباً، ومن هنا يصدر انبهاره بكل ما يقع خارج هذا العالم. ومن جهة ثانية، رفض قوانين الخارج شعراً وقولاً و «خطاباً»، ورفض أكثر قوانين التغيير والثورة إذا تعارضت مع صورته الخاصة إلى العالم. لقد رغب بالخروج عن المألوف والسائد لكن في اتجاه لم يوافق طرق الخروج الجذرية التي سار الآخرون عليها. ثورته الهادئة في اتجاه اختطه لوحده.
رسالة إلى أنسي الحاج قبل الوداع
عقل العويط
أعرف أنكَ نائم.
كلنا يعرف أنكَ أمضيتَ الليلة السابقة ساهراً. وأنكَ سهرتَ النهار كلّه أيضاً، خلافاً للعادة.
كلنا يعرف أنكَ عندما تؤوب إلى النوم بعد ليلٍ أبيض، لا تسمح لأحد بأن يوقظكَ. فكيف بعد نهار وليل؟! لكني لا آبه. يجب أن تستيقظ لتقرأ هذه الرسالة. ضروري، يا أنسي.
نومكَ لن يخدعني. ولا انتظاري سيضجر.
لقد عرفتُ أن الدولة قد هالها غيابكَ الفادح. وأنها سترسل، بعد ساعات، من يمثّلها في حفلة الوداع الأخير. شكراً للدولة.
لكنْ، عندي طلبٌ سخيّ، اليوم، أطلبه من الجمهورية اللبنانية، بإلحاح واحترام: لا تمنحي أنسي الحاج وساماً أيتها الجمهورية!
إكراماً لأنسي الحاج، أسألكِ أيتها الدولة أن لا تبادري إلى هذه التحية الرسمية المشكورة!
بدلاً من ذلك، ليت السلطة التنفيذية، في أول اجتماع للحكومة، توزع على الوزراء نسخاً من دواوينك الستة، ومن “كلمات كلمات كلمات” بأجزائه الثلاثة، ومن “خواتم” 1 و2.
ليت السلطة التشريعية عندما تعقد جلستها الموعودة لمناقشة البيان الوزاري، توزع على أعضاء مجلس النواب نسخاً من كتبكَ هذه.
لكن، ما لي وللأمنيات.
فلأكتب هذه الرسالة، وليقرأها أنسي الحاج.
* * *
هذه الرسالة هي لكَ شخصياً، فاستيقظْ يا أنسي. واقرأ.
لقد تناهى إليَّ أن الدولة تحضّر، مشكورةً، وساماً تعلّقه على صدرك. شكراً للدولة. لكني أرجو أن لا يكون هذا الخبر صحيحاً. لأنه إذا صحّ، فلا بدّ أن يكون الأمر قد اختلط على المعنيين اختلاطاً فجّاً.
من جهتي، لا أريد أن أصدّق. بل الأكيد أني أفضّل أن أتوهّم. ففي لحظات مزلزِلة كهذه، لا بدّ لمَن يكون مثلي، أن لا يصدّق أن أحداً – ولا الجمهورية اللبنانية – سيعلّق وساماً على صدر أنسي الحاج.
هي غلطة. بالتأكيد. لكنها ستكون غلطة قاسية، في حقّ الشاعر أنسي الحاج، إذا صحيحة.
أعرف أنه ليس مسموحاً لي، ولا لأحد، بأن ينغّص أوجاع الموجوعين في هذه اللحظات. كما ليس من الجائز التفلسف على أحد. ولا المزايدة على أحد. لكنكَ، يا أنسي الحاج، لو شئتَ أوسمةً ونياشين، لكنتَ اخترتَ طريقاً غير الطريق الذي اخترتَه، ولكنتَ كتبتَ كلمات أخرى غير الكلمات التي كتبتَها، ولكنتَ عشتَ حياةً غير التي عشتَها.
لمَن تحضّر الجمهورية الوسام إذاً؟
لم تفعل، يا أنسي، شيئاً تستحقّ من أجله وساماً – عقاباً كهذا العقاب. فلماذا يقاصصونكَ؟
كان الأحرى بالدولة التي قد تكون تحضّر لكَ تكريماً في مناسبة هذا الرحيل المفجع، أن تتدارك مسألة كهذه منذ شهر، منذ شهرين، بل أشهر، وأكثر، فتستمزج رأيكَ. أو تجد طريقة أخرى لتقف على خاطركَ، وخاطر المنزلة الشعرية الكبرى.
كان عليها مثلاً أن تكون قد قرأت أدبكَ جيداً، لترى هل من الضروري أو المناسب أن يُكرَّم هذا الأدب بالأوسمة البروتوكولية الرسمية؟!
أصرخ معتذراً. فسامِحوني. لكني أعتقد أنكَ، يا أنسي، لا تطيق مثل هذا الوسام!
أنتَ الذي لم تكن تقبل أحياناً تحيةً من الهواء، كيف تتحمّل تحية كهذه؟
لم يُعرَف عنكَ أنكَ كنتَ رجل مناصب أهلية أو رسمية. لم تكن شخصاً عاماً. ولا شخصيةً عمومية. لم تكن رجل أحزاب. ولا كاهناً في مؤسسة. لم تتطلع إلى تصنيفٍ من هذا النوع. ولا إلى مجدٍ كهذا المجد الزائل. لم تربّ صداقةً “اجتماعية” مع أقرب المقرّبين إليكَ، فكيف مع جماعة الشأن العام.
لم تكن، يا أنسي الحاج، قريباً من أحد، ولا حتى من شخصكَ العمومي بالذات، ولا من الشعراء. فكيف يتقرّب وسامٌ منكَ، مهما كان وفيّاً، معترِفاً، ومشرِّفاً للجمهورية التي تمنحكَ إياه؟!
كيف يتجرأ وسامٌ أن يستريح على صدركَ، الذي لم يلامسه إلاّ حفيف الحبّ والحرية؟!
أنتَ، يا أنسي الحاج، شاعرٌ فقط. بكلّ ما تنطوي عليه كلمة شاعر من خروج على كلّ تصنيف. وأنتَ الآن، شاعرٌ فقط. وستظلّ شاعراً فقط. والشاعر أوسمتُه كلماتُه. فقط كلماته. دونها لا شيء يستحق الذكر. فكيف بالنياشين والأوسمة!
أنا فظّ. فلتسامِح الجمهورية وعائلتكَ، فظاظتي.
أنتَ، يا أنسي الحاج، تستحقّ الحرائق كلّها. فلنشعل لكَ حرائق القلوب والكلمات.
أنتَ، يا أنسي الحاج، تستحقّ الهواءَ كلّه. فلنجعلكَ تذهب خفيفاً في اللطيف الهواء.
¶ وجّه الزميل عقل العويط هذه الرسالة إلى أنسي الحاج، صباح أمس الخميس، قبل ساعات من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الشاعر الكبير. وكان موقع “النهار” الألكتروني قد بثّ هذه الرسالة في حينه.
انسي
نصري الصايغ
مات أنسي.
هذا وجع نعرفه، وجع يتصل بالغياب وفداحة الفقدان وتهافت البقاء على قيد حياة، لا تنبت فيه وردة أو قصيدة أو يستعاد حلم.
مات أنسي.
بدا لي أن «العالم صندوق»، وأن الغناء جنازات، وأن الزمن الباقي لا يستحق أن نحصيه، فهو لا يخصنا وهو ضدنا، فما كان، لن يكون، وما سيكون اجترار لوطأة السحق. كل آتٍ بعدُ، ماضٍ نشفق عليه.
مات أنسي وقبله عاصي.
عندما ودع أنسي عاصي الرحباني سأله في غيابه: «ألهذا نعيش ونموت؟ لهذه النهايات، لهؤلاء الرجال، لهؤلاء النساء؟ ما أغبانا، أليس كذلك يا عاصي؟… لا أحد يقدِّر خيبة أملك أكثر مني… أأقول نيالك. كدت أقولها، لولا أني أكثر جبناً من أن أعنيها. ولكن بالفعل نيَّالك، فلا البلد بلدنا ولا الناس ناسنا ولا الحياة حياتنا».
مات أنسي؟ نيَّاله. أليس كل ما كتب من أجله قد مات من زمان، وان كان لم يدفن بعد؟ ألم يمت الحلم من عقود؟ ماذا ظل من الوطن؟ في أي كمين وقعت الحرية؟ ألم ينطفئ الجنون؟ والتمرد ماذا بقي منه؟ والجمال، أي قبح متوحش ينهشه في وضح الفجيعة؟ مات أنسي؟ من قبله، مات كل ما آمن به، باستثناء القهر الذي لازمه، والخيبة التي نذوق طعمها، كلما اكتشفنا أننا بضاعة بشرية وأن الشعر يفر من كلماتنا إلى أقصى العبث وفداحة الألم ولغة لا جدوى من كذبها وافتتانها بذاتها.
كان أنسي، في موقع الضد دائماً. يتحسس ويدرك أن البلد يُهدر وأن السخف خبزه اليومي. أراد أن ينقذه بالحلم. ما أجمل ذلك الحلم إن قورن بذلك الواقع: «نحن بلد بلا قضية، نحن مواطنو الإهدار والسخافة. نعيش في محرقة. نأكل بعضنا البعض، تافهون، منافقون، لصوص. نحن بنك وكازينو وشركة طيران وسمسرة وعمولة وتهريب… ليس في لبنان شيء حقيقي. حتى المجانين لم أعد أصدق أنهم حقاً مجانين. حتى الموتى يخيل إليَّ أنهم يموتون بشكل مستعار».
«لن» تشبهه. عاصياً كان. معتصماً بالحرية، يتقن فن الصراخ والغضب، ببراءة المؤمن، أو بنبوءة التغيير… عنون صفحته في «ملحق النهار» بـ«كلمات، كلمات، كلمات» لوليم شكسبير… كان لكلماته إيقاع وصدى وتموّجات. كانت عابرة لحواجز الطوائف وصنوف السياسة. يتلقفها جيل من الشباب، تربى على تغذية الحلم بالقبضات والتظاهرات وحيوية الأيام… كلماته العابرة، لم تكن عابرة. تولد من قلمه وتبقى. مدماك يعلو مدماكا. كان صخبه هداماً فظيعاً ومدويا، فيه بلاغة الثورة وعبقرية الجنون، فكل ما حوله، ما حولنا أيضاً، كان مزوراً وكذاباً: «يسارهم كذاب ويمينهم كذاب… (جعلوا) من لبنان جمعية للصوص الاحتكار والمنافسة… منذ ربع قرن (وهو عمر لبنان آنذاك) وهم، رأسماليين وطائفيين وعائليين، يستعبدوننا روحاً وجسداً، يفرضون الخوة ويزورون الإرادة، يتاجرون بالحشيش ويتاجرون بالسلاح ويتاجرون بالرقيق الأبيض… هؤلاء هم إسرائيل».
لأنسي الشاعر، سيرة سياسية ثقافية كتبها بحد السكين. خرَّب القصيدة حتى استقام نثرها شعراً مصفى. تغلَّب على الوزن وبحور الشعر والتفعيلة. افتتح للشعر العربي حقبة إلى جانب محمد الماغوط، وسار عليها بعده كثيرون. أنصفته خالدة سعيد، واعتنت به أقلام النقاد، ولم يحفل باتهام التآمر على اللغة وعلى الحضارة العربية… كان متآمراً فذاً، وإمرته من ابداعه لا من خارجه… خرَّب اللغة، فاستقامت شعراً جديداً، فيما الخراب اللبناني لم يستقم في مسار البناء…
قصيدته تخصه. أما «كلماته» في الملحق، فكانت غذاءً أسبوعياً لجيل يحلم ويعمل. أنسي يحرض والشباب يختزن. هل نمدحه عندما نقول عنه، كان أقوى من كل الأحزاب. «كلماته» منشور سياسي فضّاح ومؤلم ومثير ومهيج ومتطلب… شغفه بالحرية دفعه إلى ابتداع حالة من الرفض، إلى ممارسة القطيعة التامة، مع ماض متخلف وحاضر معاق وسياسة منافقة، وقادة دجالين، وطوائف معيقة وعاقة. وتورط أنسي ببرءاة الحالمين، حيث اعتبر ان لا حل ولا يمكن أن ننتظر شيئاً إلا بالعنف. العنف خلاق شرط أن يقترن بالحرية، وإلا تحوّلت الثورة كابوساً:
ولقد تحوَّل العنف إلى مذبحة، واستحالت الثورة كوابيس، ولا تزال.
هنا، في هذا المقام، يقيم وجع بلا نوم. رجل «العواصف الهوجاء» انتهى به المقام، إلى أن أصبح رجل الأطياف. ثقيل الوطء كان، خفيف الظل صار. هذا الشيطان، انتقل في ما بعد إلى مصاف الملائكة، كأنه انفصم… كان يدرك أكثر من سواه، أن ما ينبه اللبنانيين من أحلام، وما ينجزونه في حياتهم، إنما هو بناء فوق الهاوية، وليس على حافتها. لقد سقط كل ما كان جميلا، كل ما كان حلماً، كل ما كان إرهاصاً بجديد، في هاوية الحرب اللبنانية.
رسول العنف هذا، هل يلام على دعوته وتحريضه؟ هل يعاتب أو يعاقب على ثورته؟ هل كنا سنطلب منه أن يعتذر منا وأن يتلوَ فعل ندامة وأن يتراجع عما كتبه؟
عنف أنسي لا يشبه العنف اللبناني السابق واللاحق والقادم. كان عنفاً خلاقاً مرتبطاً بالقيم والوطن والحرية والإبداع… عنفهم، هو عنف «الثورة المضادة» دائماً. خمسة عشر من عمر الحرب اللبنانية، كانت لتأبيد الطائفية، وقتل الأمل، واستنفاد الحلم، وتحويل البشر إلى قطعان يقودهم من يسوقهم إلى الذبح.
ثم إن عنف الكتابة لا يشبه عنف الخديعة. قال: «قد أسأل عن موقفي من الهدم، قد أسأل عن معنى احتجاجي على الإجرام والعنف، بل على الحرب كلها، فيما ان كتاباتي منذ الخمسينيات لم تتوقف عن شحن العنف… بأي حق أنصب الآن نفسي داعية تأمل وحكيم تقريع هل فقط لأن الذين نفذوا العنف هم الآخرون».
يحيل أنسي الجواب إلى تلك المشكلة المأساوية، مشكلة الفرق بين المثال والواقع وبين الكتابة والحياة… فهناك «شرك التوهم بأن العالم سيتجاوب وروح الكلمة وان الإنسان سيلبي نداءها من دون إساءة تفسيرها»… غير أن السذاجة هي «في عدم التفطن لقناصي التاريخ، قطاع طرق الحياة، الذين يرثون اليوم، بكفاءة مرعبة، تقاليد عريقة في الاستعمال والتحريف والتشويه».
عنف أنسي، عنف بريء. ليس من جنس مختلف: «انه من غليان الحق وهدير الحلم»، وهو أعلى من السماء… «أما الحروب التي استعمل لبنان مسرحاً لها فليست تظاهرات عنف إنما أعمال وحشية وبهيمية، لم يسجل فيها أثر واحد لذلك الجمال المخيف، الذي هو جزء لا يتجزأ من العنف الحقيقي».
لم يكن عنف أنسي ينتمي إلى معسكر الموت والقتل، كان عنفاً ينتمي إلى تأصيل الحياة وتحريرها من عنفها المهترئ، والتحريض لتكون في مرتبة الجمال والإبداع والحرية… وشتان ما بين العنفين: عنف مجرم لا يريد غير تغذية القبور، وعنف مغرٍ يستجيب لنداء القلب واستفزاز الخلق.
يبرئ أنسي نفسه من لوثة العنف المدنس. يقول: «وبعدما كانت اللغة سلاح الأحرار أضحت عاهرة الثعابين والسعادين وقناع المزيفين، مختبراً للعقم ومصنعاً لجيف التقليد وجثث التجديد على حد سواء… لم تُقهّر الكلمات فحسب بل أفرغت من سحرها وجعلت جلداً خاوياً جافا».
وكأنه في هذه البراءة التي أغدقها على نفسه، يعلن انسحابه من المشهد. «إني لا أقول بهذا الكلام كله أكثر من كلمة واحدة هي الخيبة». ويختم شهادته في مسيرته: «كلمات كلمات كلمات. خيبات خيبات خيبات… فما من شيء أعمق من الخيبة… الخيبة هي النهاية»… أليس هذا حكم من أنسي بإعدام أنسي بالذات؟
مات أنسي. وفي غيابه نسأله كما سأل عاصي الرحباني في وداعه: «ألهذا نعيش ونموت؟ لهذه النهايات؟ ما أغبانا يا أنسي. لا أحد يقدر خيباتك أكثر منا، نحن الذين بلغنا الجحيم وأقمنا فيه، منذ اندلاع العنف، حتى اعتيادنا عليه، والتصفيق له، واحترام أصوله، والتبني لفروعه، وصولاً إلى انتشاره في جسدنا وروحنا ومستقبلنا».
ألهذا نعيش يا أنسي؟ كنت تقول: «ما من بلد أجمل من الشوق إلى بلد». نحن لم يعد عندنا اشتياق. لم يكن عندنا بلد ولسنا بصدد تصديق ان يكون لنا بلد. نحن من جنس التوحش الديني، والبربرية الأسطورة وتقديس القتل واعتبار الذبيحة البشرية قربانة الطوائف والمذاهب والديكتاتورية والأصولية وإسرائيل والغرب. ونحن كذلك، بكل ما أوتينا من أحقاد تربت على الثأر وفجور المذبحة.
ألهذا نعيش ونموت يا أنسي؟
كان أنسي رائياً لنفسه ونبيّاً منذراً لنا. في خاتمة مقدمته لـ «لن»، فاتحة الشعر الحديث، وما كان مثلها من قبل، يقول أنسي:
«نحن في زمن السرطان… هنا، وفي الداخل. الفن، إما يجاري وإما يموت. لقد جارى، والمصابون هم الذين خلقوا عالم الشعر الجديد… نحن في زمن السرطان، نثراً وشعراً وكل شيء. (خريف 1960).
حتى هذا السرطان، خاننا. لقد خرَّبنا حتى باتت عوارض السلامة والصحة مفاجأة غير متوقعة وغير محسوبة. البلاد في حالة «الميتاستاز». السرطان، بكل أديانه ومذاهبه وطوائفه وعنفه وقتله ووحشيته، غزا جسد البلاد… سرطان الشعر خرب اللغة واستولد نسلاً جديداً، جماله في إبهامه وتشتته وابتعاده عن الينابيع. اللغة التي تفجرت على يدي أنسي، تنتمي إلى ينابيع المستقبل. من هذا المجهول ترتوي وتحيا… أما السرطان العادي، فقد أخذ أنسي، وأخذ بلاداً وشعوبا وفتتها عن بكرة وجودها، فما عادت تتحد وتتفاعل وتنسجم وتحيا.
ألهذه النهايات كنا نعيش؟ ألهذه النهايات سنعيش؟ في وداع أنسي نسأله: أين نلتقي؟ يجيب: «في وداع آخر». فلننظم هذه الوداعات قبل أن تستدعينا الملائكة إلى الضفة الأخرى… من العدم الساحر.
أنسي في اثنين من أوجه ابتكاراته المديدة
كاظم جهاد
كتب أنسي الحاج الكثير، شعراً وتفكيراً ومقالات. وبالرغم من ضغوط الصحافة وما في الكتابة الأسبوعية من إكراهات، كان دائم الحرص على أن يسبغ حتّى على أبسط مقالاته لغة شعريّة وأن يهبها طبيعة فكريّة عالية. كتب الشعر بلغة مشاكسة ذهب فيها أحياناً، عن وعي وإرادة، إلى تخوم اللّامعنى، واعتنق في الكثير من أشعاره غنائيّة شيّقة جعل اللّغة السائرة، لغة الكلام اليوميّ، تحبل فيها بمعانٍ فذّة. كرّس أغلب شعره للمرأة، لجسدها خصوصاً بما هو مرآة لروحها ولشيء آخر قد يكون هو الكون، صانعاً منها ألوهة ثانية، دون أن يحرم نفسه متعة التجديف بها، تجديف مفارق لعلّه الشقيق التوأم للعشق المتولّه، لا بل قد يكون من آياته، مثلما قال إليوت بخصوص بودلير إنّ تجديفاً باللّه يتخلّل أشعاره بمثل هذه الكثافة وهذا الإلحاح يكاد يكون تعبيراً مستتراً أو مفارقاً عن الإيمان.
وعلى ما حظي به شعره، على مرّ الأعوام، من تلقٍّ واسع مستحَقّ، ومن محاكاة هي بلا شكّ أمر طبيعيّ في نشوء الأجيال الشعريّة، أحسب أنّ شعر أنسي قد أساء إليه كثيراً بعض مقلّديه. حوّل بعضهم نزعته الاستفزازيّة، أو التهكّميّة، التي لا تشكّل إلّا إحدى نبرات صوته المتعدّد الأداءات، أقول حوّلوها إلى إلى موضة. أمّا “تكسيره” المتعمّد والحاذق لنحو اللّغة ومنطق الكلام، وممارسة الحذف التي لا يلجأ هو إليها، وببراعة، إلاّ كعنصر بين سواه من عناصر عدّته الفنيّة، هذا كلّه استحال لديهم إيماءات مكرورة وتذاكياً مقصوداً لذاته. وإنّما يمارس أنسي الحذف لا عن رغبة في الإثارة (شعر وإثارة؟!)، بل على سبيل الإضمار، وليترك لمخيّلة القارئ أن تملأ فراغاً سيكون في تعبئة الشاعر له نافلةٌ في المعنى وتضييقٌ للكلام. كتب في قصيدته “عندما يفتحونه عندما يغلقونه”: “سأطبع كتاباً/ لتعرفي أنّكِ/ سأطبع كتاباً/ ليقولوا عندما يفتحونه:/ “كنّا نحسبه شخصاً آخر”/ سأطبع كتاباً/ ليقولوا عندما يغلقونه:/ “لم نكن نعرف أنّه/ كنّا نظنّ أنّه”/ سأطبع كتاباً/ لأنّ عينيكِ لأنّ يديكِ/ سأطبع كتاباً/ لأنّي لا أصدّق/ لأنّي لا أصدّق / لأنّي لا أصدّق.” (“ماذا صنعتَ بالذهب، ماذا فعلتَ بالوردة”، بيروت، 1970، ص 133).
شاعر حقيقيّ يعرف بالضرورة صنعة الشعر، أو الفنّ الشعريّ، ويثبت قدرته على التعبير عنه لا في إنشاء تهويميّ سقيم بل بمفردات مخصوصة. منذ مقدّمته الشهيرة لمجموعته الشهيرة “لن”، هذه المقدّمة التي لا يتّكئ فيها على كتاب الفرنسيّة سوزان برنار “قصيدة النثر من بودلير إلى أيّامنا” بالقدر الذي يتصوّره البعض أو يريدون الإيهام به، وضع أنسي فاصلاً دقيقاً بين قصيدة النثر وما سبقها من أنماط شعريّة. أدرك بادئ ذي بدء أنّ مشكلة تلقّي العرب للشعر (ولعلّ الأمر نفسه في كلّ الثقافات التقليديّة) كان وما يزال إلى حدّ بعيد كامناً في الحاجة المتوارثة إلى “التطريب”. كتب أنسي متكلّماً عن قصيدة النثر: “ولعلّك إذا قرأت قصيدة من هذا النوع (هنري ميشو، أنطونان آرتو…) قراءة لفظية، جهرية، للالتذاذ والترنّح، لعلّك تطفر وتكفر بالشعر لأنّك ربّما لا تجد شيئاً من السِّحر أو الطرب. التأثير الذي تبحث عنه ينتظرك عندما تكتمل فيك القصيدة، فهي وحدة، ووحدة متماسكة لا شقوق بين أضلاعها، وتأثيرها يقع ككلّ لا كأجزاء، لا كأبيات وألفاظ” (مقدّمة “لن”، بيروت، 1960، ص 10).
من تجارب أنسي الحاج العريضة، التي توقّفتْ عندها أجيال من النقّاد، أودّ التوقّف هنا وقفة بسيطة أمام جانبين اثنين، هما بمثابة حديقتي السريّة التي اخترتها لنفسي في أعماله، مثلما لديّ حدائق سريّة في أعمال من أتردّد على كتبهم من شعراء وكتّاب.
مترجم استثنائيّ
قليلة هي ترجمات أنسي الحاجّ، يكفي لاحتوائها كلّها كتيّب واحد. على أنّها ثريّة بممارسة ترجميّة بالغة الرهافة ومدعّمة، إلى ذلك، بوعي نقديّ حادّ يُحسن بفضله تقديم ما يترجم، ويجيد تعيين فرادته والتعقيب عليه.
ولئن جاز لي الرجوع بذاكرتي إلى سنوات الفتوّة الأولى، فأنا لن أنسى أبداً كيف وقعتُ يوماً، بمحض الصدفة، وأنا في سنّ الخامسة عشرة، في أوّل عهدي بقراءة الشعر وتجريب كتابته، على قصيدة “الاتّحاد الحرّ” لأندريه بروتون ترجمها أنسي الحاج هي واثنتي عشرة قصيدة أخرى للشاعر ذاته. لم أستوعب يومذاك صوَرها الدفّاقة كلّها، لكنّ فرادتها أسرتْني. قصيدة غريبة تُستهلّ أغلب عباراتها بصيغة “زوجتي التي…”. ولأنها بقيت تسكن ذاكرتي، كان البحث عن نصّها الأصل من أوّل ما قمت به في أعقاب انتقالي إلى باريس. ما زال الشوق يحدوني إلى إعادة قراءتها بين الفينة والفينة، لكنّ ضرباً من عالم سحريّ كان قد انفتح لي بصورة صاعقة وغامضة في ذلك الأصيل البعيد الذي وقعتُ فيه على ترجمتها الأنسية: “زوجتي التي شَعرها نارُ الحطب/ التي أفكارها بُروق الحَرّ/ التي قامتها ساعة رمليّة/ زوجتي التي قامتها ثغل مائيّ بين أسنان النَمر/ زوجتي التي فمها شارةٌ وباقةُ نجومٍ من أكبر طراز…” (مجلّة “شعر”، العدد 24، خريف 1962، ص 73ـ 74).
ولقد رجعت البارحة إلى الكلمة التي أرفق بها أنسي ترجمته، فوجدت من جديدٍ، في حرارته ذاتها، فهمه الدقيق للصورة الشعريّة، يعرّفها بأنّها “لا تفسيريّة ولا منطقيّة وقبل كلّ شيء غير محدّدة. يجب أن تكون التباسيّة وتحتمل مئة مدلول كلّ واحد منها قد يكون عكس الآخر. يجب أن تضرب الفهم العاديّ وتزعج العرف وتغيم على العقل. صورة مجّانيّة وصاعقة”؛ ثمّ يحيل عى قولة بروتون الشهيرة: “يكون الجمال تشنّجيّاً أو لا يكون” (نفسه، ص 104).
إلى هذا أضيف وعي أنسي المبكّر والصاحي بـ”لا جدوى الشعر” وبضرورته المطلقة في آنٍ، وهذا كلّه انطلاقاً من فهمه العميق والذي لا محاباة فيه لتجربة بروتون الشعريّة: “وضع بروتون شعراً يرسل الشرر ويقذف الحمم، بعدما كان قد أُشرب كلّه بالتنافر والتناقض. لكن ما همّ؟ وهل من نجاح للشعر؟ ألم يفشل ـ كما يقال ـ رامبو؟ وماذا تخطّى بودلير؟ ولماذا مات آرتو؟ ما همّ؟ ألم يغنّ بروتون أعظم الأشواق؟ ألم يجعل هذه الأشواق في حالة دائمة من الاستنفار والتهيّج؟” (نفسه، ص 106).
الخطوة الحاسمة التالية لأنسي في ترجمة الشعر (ولعلّ له ترجمات أخرى لم يتسنّ لي الإحاطة بها) تتمثّل في نقله إحدى عشرة قصيدة لأنطونان آرتو، تصحبها دراسة مسهبة وعميقة لكلّ عالم آرتو المعقّد، الرهيب، الموّار. يصعب أن أقاوم رغبة الاستشهاد بإحدى هذه القصائد، قد تكون هي أكثرها تمثيلاً للغة آرتو، بترجمة أنسي. هي قصيدة بلا عنوان. يبدأها آرتو بضربات متوالية تصوّر فصاماً جذريّاً وفعّالاً لعلاقته بجسده: “كنتُ حيّاً/ وكنتُ هنا دائماً// هل كنتُ آكل؟/ كلّا/ لكن عندما كنتُ أجوع كنتُ أتراجع مع جسدي ولا يأكل بعضي بعضاً./ لكن ذلك كلّه تفكّكَ/ حدثت عمليّة غريبة/ لم أكن مريضاً/ سوف أعود فأغزو العافية/ دائماً بإرجاع الجسد إلى الوراء…// هل كنت أنام؟/ كلاّ لم أكن أنام/ يجب أن يكون الواحد طاهراً ليعرف ألاّ يأكل”. ثمّ يختتم بقراره المتواتر في أشعاره و”هذياناته”: “سوف أعيد بناء الإنسان الذي أنا هو” (مجلّة “شعر”، العدد 16، خريف 1960، ص 72 ـ 73).
هنا يكمن سعي آرتو كلّه إلى ضرب من إعادة تربية الأعضاء توقّف عنده دريدا في إحدى دراساته عنه، يجرّبه الشاعر لا من أجل متانة هرقليّة بل لاكتساب ما يدعوه آرتو نفسه “جسداً بلا أعضاء”، هذه الصيغة التي يعْلم قرّاء جيل دولوز وفيليكس غواتاري كيف أقاما بالاستناد عليها فلسفة كاملة في العلاقة بالجسد وبالرغبة.
وهنا أيضاً، ترجع إلى الدراسة التي أرفق بها أنسي ترجمته فتقف على فهم شامل يؤسفني أن يضيق المجال أمام عرضه بكامله. كتب أنسي: “هذى السورياليّون وتشنّجوا لأنّهم اشتهوا الحياة فمُنعوا عنها، ثمّ راحوا يشنّون هجماتهم على الأسوار. إنّ ذلك هذيان الطالب لا الرافض، هذيان رافض الشيء والمطالب بشيء آخر، من نوعه. أمّا آرتو فقد هذى هذيان الميت، وكان تشنّجه الموتيّ الدلالة الوحيدة على أنّه “حيّ” يتنفّس” (المصدر نفسه، ص 95 ـ 96). ويضيف: “هكذا يتعذّر علينا أن نحاوره. لقد قطع السبيل عندما رفض العلائق والصلات واندلق خارج الكون، والكلمة، إلى الفراغ. وما كتبه هو ما تمكّن من إحرازه على العدم، ولذلك يبلغ الشعر معه حدّ الامتناع عن الانتقال، عن الفهم، ولا يُرَدّ تخلّفنا عنه إلى انعدام الدلالة فيه بل إلى ضعفنا عن التقاط مبلغ الدلالة في الصرخة…” (نفسه، ص 99).
صانع خرافات وحكايا شعريّة
الجانب الآخر الأثير عندي في شتّى تجارب أنسي يتمّثل في قدرته على التخييل السرديّ البارع داخل القصيدة، وعلى ابتكار أمثولات أو حكايا وخرافات تجد أمثلة شيّقة عليها في شعر ماكس جاكوب وهنري ميشو بخاصّة، وأحياناً لدى أندريه بروتون ورنيه شار. هاكم قصيدة “الذئب”، ولعلّها القصيدة الوحيدة لأنسي الحاج المكتوبة شعراً تفعيليّاً، والأرجح أنّه جعلها كذلك لأنّه ألفى الإيقاع التفعيليّ أوفر أداءً للغتها الطفليّة الظاهريّة. تصوّر القصيدة في الحقيقة، وكما ترون، انسحار الطفولة الذي لا ينفكّ يسكن الكبير، حاسّة الخطر لديه تبكي لاضمحلاها، والخوف الذي استحال شوقاً وحنيناً جارفَين:
“في قصص الكبار للصغارْ/ ذئبٌ يكون دائماً/ وراء أحجارٍ/ وراء أسفارٍ/ وراء أشجارٍ/ وراء بستانٍ من الأزهارْ.// ويهجم الذئبُ/ في قصص الكبارْ/ ليأكل الصغارْ/ / وذهبَ الكبارْ/ وأقبل الصغارْ/ وذهبَ الصغارْ/ ويوم لم يعدْ/ يأكلني الذئبُ لكي أنامْ/ بكيتُ عشرين سنةْ/ ومتُّ من شوقي إليكْ/ يا ذئبُ/ من شوقي إليك!” (“ماذا صنعتَ بالذهب، ماذا فعلتَ بالوردة”، ص 96 ـ 97).
ولعلّ أطرف حكايا أنسي الشعريّة، وفي الأوان ذاته أكثرها إيلاماً، القصيدة المعنوَنة “الدينار القمر”. هي حكاية تتوالد من ذاتها أكتفي بذكر مقطعها الأخير الذي ينهض بمفرده بثقل حكاية شائقة تنتهي نهاية مفاجئة تنوّه بعظمة الحبّ وتساميه: “رجلٌ اسمُه حافظ/ علّقوا عليه الآمال فوقعتْ/ وقعت عليه امرأة/ علّقت عليهم آمالها فوقعت/ وقعت عليه امرأة/ حفظها كالدينار/ صار الدينار بحجم القمر/ صار القمر تعليقة/ علّق عليها حافظ حبّه/ علقّت عليها المرأة حبّهما/ فوقع من التعليقة/ حجرٌ/ شقّ الأرضّ/ تحتُ/ احتقاراً” (نفسه، ص 120 ـ 121).
لعلّ التصوّر الجادّ والمبدع لقصيدة النثر، لا كما فهمتها سوزان برنار، التي أكل الدهر على كلامها وشرب، بل كما تضافرت لتعريفها أجيال متعاقبة من الشعراء والمحلّلين، يكمن ههنا، ويواجهنا وهو في حالة عمل، أي رهن الممارسة: لغة سائرة، قوّة مفارقة، تخييل بارع، وإيقاع ولا أرهف.
بلا أسلاف
هنادي زرقه
إذا مات الشعراء من يبكي علينا؟
مات أنسي الحاج, لم يكن الخبر مفاجئاً, فأنسي مريض منذ فترة, لكننا لم نتصالح مع فكرة الموت بعد. أنسي الشاعر المتمرد الحرّ, لا أسلاف له, لا يشبه غيره من كُتّاب الشعر في زمانه, فقد اجترح فضاءً خاصاً به في قصيدة النثر, ليس تحدّياً ولا استفزازاً للأنماط السائدة, بل إعادة خلق جديدة للشعر, وحين شقّ طريقه في الشعر لم يلحق به أحد, لم يتقيد بمدرسة شعرية, ولم يكن ذا مريدين, بمعنى آخر, لم يخلق تياراً شعرياً, كان أنسي الحاج شاعراً متفرداً في أسلوبه الشعري وفي موضوعاته.
وربما من الشعراء القلائل الذين لم يُصنّفوا إيديولوجياً, وهذا ما منحه حرية في اختيار موضوعاته, فلم يكن أسير قضية ما, كان منحازاً إلى الحياة, قضيته الإنسان, وإن كان بشكل من الأشكال منحازاً إلى الأنوثة والرقة في شعره. شاعر ذو مواضيع معاصرة تقرأها دائماً بالشغف نفسه, لا تتقادم لغته وموضوعاته, بل تتوهج في كل مرة تعيد قرءاتها.
من الصعب, بالفعل, تصنيف أنسي الحاج, هو الذي قال: إنك تظلمه بتوصيفه كما تظلم التوصيف. أنسي الذي ضرب أسواراً من العزلة حوله, دليلُك إليه قصائدُه ومقالاته.
كنتُ مأخوذة بعناوين مجموعاته الشعرية: “ماضي الأيام الآتية, الصمت العابر كالفضيحة, ماذا صنعت بالذهب؟ ماذا فعلت بالوردة؟ والرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع”, كيف لشاعر أن يستخدم المفردات نفسها التي يستعملها عامة الناس ويصبغ عليها فضاءات جديدة فتخلق معنى مغايراً غير مألوف لدينا, يحيل ترابها ذهباً.
أعترف أنني قرأت أنسي الحاج بدافع المتعة على خلاف أدونيس الذي قرأته بدافع التثاقف والبحث, فلم يكن مقبولاً لدى أبناء جيلي ألا تكون قد قرأت أدونيس. وفي كل مرة أعيد قراءة أعمال أنسي لا تنفك الكلمات تفتح أمامي مغاليق اللغة, شاعر صعب متوتر, ينحت قصيدته النثرية وتتدفق بسلاسة منقطعة النظير, قصيدة مرنة لا تحتاج أدوات لفكفكة مجاهيلها.
لم تكن المتعة هي دافعي الوحيد لقراءة الشاعر أنسي الحاج, ربما الأهم من ذلك في رأيي, هو إخلاصه لفكرة الأنثى التي تستحق أن توهب الحياة “في بلادنا أنا وأنتِ.. العاشق لا يهدي حبيبته أقل من حياته”. لم يحتفِ شاعر بالأنوثة كما احتفى أنسي الحاج في “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع”, فهو يعيد كتابة أسطورة الخلق مرة أخرى مسبغاً على المرأة صفات الكمال, هي المرأة الآلهة التي يرضى قانعاً أن تسيّره وفقاً لشهواتها, ولطالما منحتني هذه المجموعة اعتداداً بنفسي وفي الوقت نفسه الرغبة بألا أرضى عشيقاً أقلّ من أنسي الحاج.
رحل أنسي بمرض السرطان, هو الذي قال “نحن في زمن السرطان, نثراً وشعراً وكلّ شيء, قصيدة النثر خليقة هذا الزمن, حليفته ومصيره”.
أنسي الحاج شاعر الأخلاط والأضداد
أحمد زين الدين
درج العمل النقدي العربي أن يقف عند المانيفستو الشعري ـ النثري الذي طرحه الشاعر أنسي الحاج منذ أكثر من نصف قرن، في مقدمة ديوانه “لن”. بيد ان المراوحة عند هذه العتبة التاريخية، تفترض ان الشاعر أسير بواكيره، من دون ان تسري عليه مفاعيل النضج وقوانين التحوّل والتغيّر، لا سيما اذا كان المسار الشعري الذي سلكه طويلاً ومعقداً. وفي هذه النظرة المبتورة إغضاء عن الصورة الشمولية والبُعد الكلي لتجربته التي لم تستنزفها الأيام، على أهمية ما انطوى عليه هذا المانيفستو من آراء متقدمة في حينه، وما انبنى عليه من أعمال شعرية، بدءاً بديوان “لن” نفسه، ثم ديوان “الرأس المقطوع” وما أعقبهما. ما حصل كان نقطةَ انطلاق نأى فيها الشاعر عن تمثّل السنن الكتابية العربية الموروثة والسائدة، وكان تمرداً على الأصول، وعلى التصنيفات والأعراف المتداولة، في التمييز بين معايير النثر ومعايير الشعر. كانت رؤيته الجديدة لكتابة قصيدة النثر او التعريف بها، او الحضّ على احتذاء خطاها، جزءاً من سياق العصر الحديث، ومحصلة صراع طبيعي بين القديم والجديد، أوجبته قوانين التطور الاجتماعي والتاريخي، وأسهمت فيه رياح التحديث التي هبّت على المنطقة العربية حاملة معها لواقحها المخصّبة. كانت خطوته طبيعية من هذا المنظور. وكانت الحاجة ماسة لإرساء قوانين حديثة، او تصور جديد لمفهوم الشعر العربي ودوره، بعد أن مسّت الحداثة بعصاها السحرية كل مناحي حياتنا. ولأنسي الحاج فضل السبق والمبادرة وشحذ الهمة لخوض غمار هذا الطريق الوعر والشائك. وإن كان أرسى منظوره الشعري، كما هو معروف، على أطروحة سوزان برنار حول الشعر الحديث، فإنه أقرّ بأن ريادته هذه التي قطعته عن الجذور الشعرية العربية القديمة، لم تثنه عن تقدير أهمية هذا التراث في التاريخ. وكان وصله بسياق الشعر الفرنسي الحديث، وقصيدة النثر التي تبنّتها ذرية من الشعراء الفرنسيين الذين سبق ان طوروا حساسية شعرية جديدة، حررتهم من رواسب البلاغة السابقة، كان هذا الوصل بمثابة مغامرة، أفضت إلى مخاض ولادة عسيرة تجاهلها كثيرون، أو ارتابوا منها، ووقفوا في وجهها ورموها بشتى النعوت الشائنة. وكان تبنّي هذا النمط من الكتابة الجديدة بحاجة إلى الشجاعة والجرأة والمجازفة، وإلى الخروج على قوانين الجماعة، وإلى الحرية الفكرية التي تحطّم في طريق تحقيق مأربها كل العوائق والسدود. كان أنسي الحاج في وجه من الوجوه ابناً عاقاً لماض منمّط ومقنن. وفي وجه آخر كان ابناً باراً لمنطق الحياة والعصر. ومع ذلك عندما تصدى أنسي إلى هذه المهمة الصعبة، لم يكن وحيدأ. لم يكن عازفاً منفرداً، وإن كان في الطليعة. ولم يكن الظرف الذاتي هو الفيصل في هذا الموضوع، بل أسعفت الظروف والعوامل الموضوعية على هذه الولادة. وآزرته في حركته الاعتراضية قابليات ومناخات ثقافية، وسياقات فكرية متقدمة عرفتها المحافل الأدبية العربية في الشام وفي مصر وفي العراق، احتضنت بواكير بناء القصيدة الحديثة الحرة المتفاعلة مع طروحات الحداثة، وما حملته من تطور النظرة إلى الشعرية العربية. اعترفت بعض هذه الأصوات بشرعية قصيدة النثر بالصمت حيناً، أو بالتشجيع العلني في أحيان أخرى، في وجه من رأى، في الجمع بين الروح الشعرية والإطار النثري إشكالية ومأزقاً وفضيحة، وفي وجه من أنكر او ازدرى هذه الظاهرة الناشزة عن خط الكتابة المألوفة، التي اغتصبت الذوق العربي المشكّل منذ قرون. واستوجبت هذه الحركة التي تخطت الذاكرة الشعرية العربية التقليدية وعياً جديداً، وأدوات نقدية أسهمت في رعاية هذه الظاهرة، والتنظير لها، تمهيداً لبناء الثقة والأرضية الصالحة لتجاوب القراء مع هذا الضرب من الكتابة الجديدة، وكان على رأس المنظّرين والنقاد الكاتبة خالدة سعيد. وشكّلت تجربة مجلة “شعر” المظلة المعنوية لنمو هذه الظاهرة وازدهارها. وإذا كان انسي الحاج لم يغمط حق من سبقه في كتابة قصيدة النثر، مثل أدونيس وجورج حنين وأورخان ميسر ومحمد الماغوط، إلا انه قدّم نفسه على أنه أول من تجاسر على عنونة ديوانه الأول باسم قصائد نثرية.
الكتابة الصادمة
لكن الكتابة الصادمة هذه لم تجد في حينه سوى أقلية ضئيلة تحتملها، على ما باح به أنسي الحاج في بعض مقالاته. ومع الزمن غدا هذا الخط يكتسب أعداداً متزايدة من صفوة القراء. لكنه ظل محدوداً في الفترة الأولى، وما لبثت ان استساغته طائفة أكبر، حينما تطورت نظرة الشاعر إلى الكتابة، وتطورت تجاربه ومحاولاته التي ما تزال قائمة حتى اليوم.
الطور الأول لكتابات أنسي الحاج حملت لنا وجه الشاعر المخالف لذاته. النزق الثائر، المتفلت من كل قيد أو حدّ. الشاعر الذي يقول ما لا يقال، وفق العبارة التي نَعت بها المتنبي، والتي تنطبق عليه. هو الشاعر المتعوي، الهائم، الصوفي الشبق، الذاتي الهش. المكوّن من خيوط أحلام، المنسوج بتراثات الوجدان والخيال والنعومة والنوم والصلاة والحب والكفر واليأس والتمرد، حسب سلسلة مجدولة من التناقضات يحب ان ينسبها إلى ذاته، لتجعل منه شاعر الأضداد والأخلاط العجيبة.
هذا الشاعر المتوهج بالأحلام، وحب الاكتشاف، وتأسيس السلالات الملعونة في الأدب. كان يرتعب من تخيّل عالم يموت فيه الشعر والفن بكافة أشكاله، ويسوده نظام برمجة المشاعر والأفكار والغرائز. نظام تضمحل معه اللذة الداخلية الخاصة، الفريدة العاصية.
جعل أنسي الحاج من جوهر الكتابة القائمة على التحديق والتركيز الداخلي والهجس والتفرس والانخطاف، الأساس الذي تنبني عليه أعمدة الحياة والعالم والإنسان والتاريخ. فالكلام صنو الوجود. وهو نبذ أية كتابة قانعة مستكينة مقلدة أو منسوخة أو جاهزة. وفي “خواتم” التي استأنف الكتابة فيها بعد صمت طويل، أضحت جملته التي تقوم على شعرية الشذرة “poetique du fragment” المنسوبة إلى آرثر رامبو، كما ترجمها كاظم جهاد، متخففة من بعض فوضويتها وعبثها، وباتت عبارته لمّاحة وأكثر شفافية. حاملة رغم ثورتها على اللغة الضحلة المبتذلة، وعلى النمطية اللغوية، وجعاً انسانياً، وتمزقاً، واحتراقاً داخلياً، وصوتاً صوفياً، مشفوعاً بصمت المتأمل والمفكر والمحنك والمجرّب الذي يخوض في موضوعات الموت والجريمة والألوهية والتجديد والتقليد وثورة اللغة، ومتوّجة بموضوع الحب المتواتر في شعره الذي يشكل درة قصائده، والموضوع الأثير لديه، والمحتبك بذاته الوجودية والشعرية.
ومع انه استلهم في كتاباته المنظور الغربي لصورة الشعر، غير انه ما لبث ان سلط غضبه على الغرب، فانتقد ما آلت إليه الحضارة الأوروبية، وذكر مثالبها، وعلى رأسها، هيمنة الحياة الآلية، وذيوع المفاهيم والقيم الاستهلاكية، ونمطية السلوك والتصرّف والتعبير، والفصل بين عاطفة الحبّ وتجلياتها الجسدية.
حبر الواقع
الشاعر الذي كان يدعو في شبابه إلى الجنون، وإلى التخريب المقدس، وإلى استباحة التابوهات، لم يتخلَّ في مرحلة ما بعد “الخواتم” عن توتره وجسارته. ولم يتحوّل إلى واعظ أو إخباري أو برهاني، كما هي صفات الشاعر المرذول لديه في مقدمة “لن”. بيد انه بمرور الأعوام، رقّت حاشيته، وانسابت لغته. وتحلل في السنين الأخيرة، عبر تعليقه الأسبوعي كل سبت في صحيفة “الأخبار” عن اللغة المستفزة العدوانية التي كتب على ضوئها مقالاته، منذ الخمسينيات والستينيات في الصحف اللبنانية. اللغة التي كان يلكم بها عقل قارئه بدون وعي، على ما يقول هو عن نفسه. بات سماعه بأن القارئ لا يفهمه تصيبه بالخجل. لكنه مع ذلك لا يزعم انه غدا واضحاً إلى درجة متناهية. وهو يقرّ في هذا المقام، بأن لا طاقة له على الكتابة الغزيرة والمبسطة، ولا قدرة له على الإحاطة بالأخبار والأحداث وسبر دقائق الأمور. ويرى في ذلك عبئاً ثقيلاً يصعب ان يقوم به. غدت لغته التي لم تخرج عن مدار الغضب نهائياً، مأنوسة، وأكثر ليونة، وأقرب إلى المتلقي، وإلى ذائقته، وإلى ملامسة معاناته المؤلمة. ما دام يغمس قلمه في حبر الواقع المجبول بالسياسة والأدب والمجتمع، وبالمسرح والتمثيل والغناء والموسيقى. ما دام يمد يده لمواهب أدبية وشعرية شابة، او يفتح ذراعيه لاستقبال من يفد منهم من سوريا والعراق ومصر وسائر البلاد العربية. مرحباً بالحاضنة الأدبية والشعرية المتوفرة في بيروت التي كانت وستبقى عاصمة روحهم. “مدينة النجاة الهالكة” حسب وصفه.
لكنه رغم لمسة التشجيع التي يبديها إزاء الأقلام اليانعة، ولهجة المجاملة التي تندّ عنه أحياناً، من دون ان تبلغ حدّ المحاباة، إلا أنه يُعلي من شأن الموهبة الحقيقية، لا سيّما تلك التي تبتعد عن الكتابة الامتثالية والخطابية والجماهيرية، والتهويمات الغنائية، وعن الابتذال التعبيري والبلاغة الكلاسيكية المقيدة.
في تعليقه الأسبوعي تبلورت لديه لغة الشيخوخة المجرّبة والمحنّكة، وتجلّت جاذبية كتاباته، وومضاته الحكمية، وموسوعيته، وعشقه القراءة، ورصده كل الفنون الساعية إلى بناء عالم بديل متخيل، أجمل وأرقى من هذا العالم الواقعي المغلول والمجهض.
العائد إلى الحكاية
ألين موراني
لا أذكر أنّك قلت لي وداعاً عندما التقينا آخر مرة صدفة في نزلة السارولا. قلت لي “متحلاّية”، ولمَعَت عيناك، وابتسمت تلك الابتسامة الفائضة بالمعاني… ثمّ سألتني “شو صاير معك”؟ ابتسَمتُ. كما في كلّ مرة، ومنذ أول مرة التقيتك في جريدة “النهار” (21 آب 2001)، تطير الفرحة من عينيّ عند رؤيتك رغم محاولاتي الفاشلة في قمعها. انتبهتَ. عرّفتني على صديقاتك الجميلات اللواتي تنوي تناول العشاء معهنّ. ثمّ انتبهتَ… “من قدّم لكِ هذه الوردة الحمراء”؟ ونظرتَ إليّ بـ”ملعَنة”. ضحِكتُ. تعرفني متحفّظة. قلتَ لي “أنا في انتظارك، تعالَي مع هنادي… لا تتأخري!”. لم أتأخّر. قصدتك مرّتين في جريدة “الأخبار”. قالوا لي في المرتين “لم يأتِ اليوم”. أرسلت إليك رسالتين قصيرتين. لم أتلقَ ردّاً. عرفتُ بعدها صدفة أنّك متوعّكٌ. كنت مواظبة على قراءتك كل سبت إلى أن ابيضّ الحبر. عندها لجأت إلى “خواتمك” و”كلماتك” و”ولائمك” و”رسولتك” و”ذهبك ووردك”… كما دوماً، في حضورك وغيابك: أنتَ الشخص الذي ألجأ إليه، وإذا لم أجدك لجأت إلى نصوصك.
كُنتَ… ها أنا أستخدم الفعل الناقص! أعترف ضِمناً بأنّ غيابك فعلٌ ناقصٌ في حياتي. كنت تقول لي “جملتك مكثّفة”. أجيبك: ماذا عن فائض الحب الذي زرعته في كل نفس قرأَتْكَ أو التقَت بِك؟ “ماذا تقرئين”؟ أحاول قراءة “نهج البلاغة”. لا أدري إن كنت سأصل إلى الصفحة الأخيرة. تصمت… يطول صمتك وترتسم في عينيك علامات الدهشة تلك. لطالما قلت لي “والداك عظيمان”، لأنّ انتمائي بنظرِك إلى الإنسان، عفوي وطبيعي لم يشوّهه دين. كيف تُمضي أيّامكَ؟ “في المنزل”. ماذا تفعل؟ “أقرأ. أعشق المطالعة منذ كنت في الرابعة عشرة من عمري… الكتاب رفيقي الدائم، لم أفعل أيّ شيء آخر أساساً. الخروج من الكتاب يؤذيني دوماً، لأني أخرج من الحكاية إلى الواقع، لكني لا أطيل غُربتي فأعود إلى الحكاية… أحلى شيء. الكتاب يدفئني، في الخارج أشعر بالبرد”.
قرابة ظهر الثلاثاء الفائت، تلقيت رسالة تنتهي بعلامة استفهام من صديقتنا المشتركة هنادي الديري، تسألني فيها عن صحّة موتٍ استراح في جسدك؟ شعرت بالبرد. اتّصلت تلقائياً بابن أخيك أنطوان عدلي الحاج. كان قال لي إنّ الطبيب أمهلك أسابيع لا عشرة أيام! سألته: “كيف صحة أستاذ أنسي اليوم”؟ أجابني بصوت حزين: “يحتاج إلى صلاتنا”. هكذا… رحلتَ وكنّا تعاهدنا على اللقاء.
تذكّرتُ لقاءنا الطويل والمسجّل معك، وأستعيد هنا مقتطفات منه. كنت تبتسم عند رؤيتنا وتغمرنا وتضحك. كنت تسألني عن ديالا (شحادة) ومي (اليان). كنّا نشعر بالدفء عندما نراك ونتحدّث عن لقائنا بك في ما بعد، كي نحفظه من شبح النسيان. كان ذلك اللقاء في 22 كانون الأول 2012.
يومها أمطرناك أسئلة ولم ندرِ لماذا. يومها لم نتطرّق إلى رأيك في الحب. نعرفه. “الربيع يعني الحب، يعني الشهوات، يعني التفتّح”. “الحب يصنع المعجزات، حتى البليد يتغلّب على بلادته إذا أحب”. ولم نخبرك عن فشلنا العاطفي وأحاديث الغرام التي تعشقها. ولم نُعمّم لعناتنا على الرجال ونتفنّن بدعواتنا عليهم… وأنت تضحك. لم نطلب نصائحك. كنا فشلنا في تطبيق ألف بائها:
1- على المرأة أن تكون أنانيّة لأنها حتى لو بلغت الحد الأقصى منها تبقى أكثر عطاءً من الرجل.
2- على المرأة التمسّك بالرجل الذي يحبّها دون أن يملكها أو يغار منها. هو الرجل الذي بقربه ستشعر بأنوثتها وبأنها مثل الفراشة.
كان عليّ سؤالكَ حينها: هل هذا الرجل موجود؟ عدتَ الآن إلى الحكاية وصارت الأسئلة الكثيرة المؤجّلة معلّقة.
يومها تحدّثنا عن “استوديو بعلبك”. قلت إنك لا تعتقد بإعادة إحيائه، رغم قيمته في تلك المرحلة الغابرة التي استمدّها من كونه الوحيد في المنطقة الذي نافس مصر، بفضل معداته التي كان يجدّدها القيّمون عليه باستمرار نتيجة قدرتهم المالية. “لأ الإشيا اللي بتموت ماتت خلص”. قلت ذلك بقناعة تامة. وكعادتك فاض كرمك علينا بالمعلومات، ورحت تسرد الوقائع بأسلوب يصعب نسيانها.
ماذا عن فيروز وعلاقتها بـ”الاستوديو”؟ نسأل ببساطة. تَبتَسم وتستريح إلى مسند كرسيّك كمن يشحن نفسه بالذكريات وتقول: “بعد في شاهد وحيد على استوديو بعلبك: فيروز”. نسأل هل ثمة إمكانية لإجراء مقابلة معها في هذا الخصوص؟ تجيب بحزم: “لا. هي مقلّة في الكلام”.
دوماً ثمة رهبة ما تحضر كلّما تحدثنا عن موضوع الرسولة ذات الشعر الطويل نشعر بهيبتها، وبتمنّعك عن التوسع بالكلام. “أصحابُها المقرّبون مثلي لا يتحدثون عنها لأن ذلك يزعجها. ونحن نُحبّها”. كنت تفضل أن ننتقل إلى موضوع آخر، لكن ذلك لم يحدث. أخبرتنا عنها برقّة وحب. مرّرت معلومات تزيد من إنسانيتها وتنزلها قليلاً من قدسيّتها.
هي المرأة اللغز بالنسبة إلى عامة الناس، وهي كذلك بالنسبة إلى أصدقائها. قلتَ “إنها مقلّة الكلام. تمضي نهاراتها تستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية، وأم كلثوم وغيرها. لا تتوقف الموسيقى في منزلها. تقرأ وتتابع الصحافة وتعشق السهر”. سألتها “ما بتضجري”. أجابتك: “لأ. وإذا ضجرت شو عليه”. تعقّبُ: “لديها نقاط ضعف مثلنا، غير أنّها تتمتّع بقوة رهيبة، تسمح لها بالتغلّب على كل الصعاب. هي جبّارة. وما اختبرَتْه في حياتها أكبر دليل على جبروتها”.
قلتَ لنا “إنها تعيش في حصن. لا تقصد الناس دون موعد ولا تستقبل أحداً بلا موعد. من النادر أن تخرج من المنزل وحين تفعل فكي تقصد الأشخاص عينهم منذ صباها إلى اليوم. تزور صديقتها في الحمرا بديعة الأعور التي ترافقها في حفلاتها وتخيط ملابسها (توفيت منذ فترة قريبة) “أصحابها أصحابها ما بِتغيّر… فظيعة شو ثابتة”. أخبرتَنا أن “لا ثبات مثل ثبات فيروز”. لم تلتقِ بمثلها قط. أمّا صداقاتها فإما قديمة وإمّا شخصيات معتبرة. في حضرتها يشعر الجميع بالمسافة. “في داخلها مغناطيس، يجعل الآخر يلتزم هذه المسافة في العلاقة رغم قربها وحميميّتها، لأنها مسافة طبيعية غير مصطنعة”. وأضفت: “رغم المسافة هي شفافة وثمة مساحة كبيرة في حياتها “للنكتة”. حدثتَنا كيف أنها ما برحت تتفاجأ بمحبة الناس الكبيرة لها، وأنها أحياناً لا تصدّق، معلّلة الأمر بأنهم يمدحونها كي تفرح… لكن فيروز خسرت اثنين من شعرائها الكبار، جوزف حرب وأنت.
… لَمْ تجتحني الذكريات كما جرى في اليومين السابقين. أستعير مقتطفات من الزمن لأعيدك قليلاً إلى الحياة. مرّ الوقت سريعاً… وغدر بإرادة البقاء. أستاذ أنسي كنت بطلي… قالوا لي “البطل ما بموت” فاطمأننت. راهنت على البقاء وأسقطت اللحظة الخاطفة، فلم أتمكن من إخبارك بأنك كنت أساسياً ومحورياً في حياتي، منذ بداياتي في جريدة “النهار”. كل أصدقائي كانوا يعرفون ذلك. ربما أنت الوحيد الذي لم يعرف. لست أدري. لكنك سوف تبقى كتاب الحب الذي ألجأ إليه كلما شعرت بالبرد!
عنف أنطولوجي
إسكندر حبش
يرحل الشعراء، بيد أن ما يعزينا أن زمن الشعر يبقى حاضراً في أغلب الأحيان. ثمة كلمات حفرت مكاناً ومكانة. ما بين الذهب والوردة، هناك حقول فسيحة، تجيء وتحضر. أزعم أن هذا هو الشعر، يتوالد ولا نعرف من أين، يكبر، يتعتق، وتبقى الكلمات هي الكلمات.
يذهب الوقت والزمن، لا الشعر. عقود منذ أن صرخ أنسي الحاج احتجاجاً بـ”لن”. وبالتأكيد لم نكن بحاجة لأن يذكرنا رحيله أن مسيرته مع الشعر بدأت من تلك الحقبة. من هنا، لا معنى ـ أعتقد ـ للزمن الحقيقي، الوهمي، إذ إن زمن القصيدة، غالباً ما يخبرنا كأنه ولد البارحة. إذ ثمة الكثير من الشعر لا يزال حاضراً، وإعادة القراءة تبدو كأنها تعيد اكتشاف معنى الأشياء من أولها. لأقل ثمة لذة بعدُ تدفعنا إلى قلب رحلة جميلة، تتوالد مع “الأيام الآتية”. هل لأن الماضي ليس في النهاية سوى هذه الأسطورة التي تنبثق منها الكلمات؟
وفي قراءته من جديد، لازمني تساؤل: كيف يستطيع المرء أن يقترب من أقاليم الكلمات والأحاسيس والصور التي تبدع نفسها من خلال قصائد أنسي الحاج، التي لا تنتمي راهناً إلى أي شخص كان؟ من خلال أي زاوية للنظر، ومن خلال أي أسر للروح؟ ربما، وبشكل مخالف المتوقع، علينا أن نأسر الأقاليم هذه من خلال هذا الدفاع الذي يسِم هنا الامتناع نفسه لكل مأخذ ولكل شغف باللامألوف: أقصد أسر هذا الدافع في التكسير والتفتيت. في واقع الأمر، لا يؤكد مناخ شعر أنسي، نفسه، إلا حين يقطع ذاته. يتوالد ويولد من تمزقه الخاص: إنه الانفصال الذي يعيد اختراعه، والذي يسأل ويتساءل بدون توقف حول طريقة العدوانية الأساسية: الموت، القتل، القطع، صرير عظام، التحطم، النار، السحق، المحق، الأرامل… هذه هي بعض الأدوات، وبعض الصور التي يحلم بنفسه من خلالها، انه ذلك الهجوم الديناميكي القادر على فض الأشياء، داخل رهبتها الأولى.
نجد في شعره أيضاً، ما أميل إلى تسميته بـ”قوى الهجوم الأخرى” التي أجدها أكثر تخاتلاً وأقل ظهوراً، وأقصد تلك القوى التي تأمر نتوءات الكلام الخاصة. أي أن القراءة تعني أن نرتضي مشروع “هذا العنف” (وأخصص بذلك الكتب التي سبقت “الرسولة” بخاصة) ما يعني أن نقبل ترك ذواتنا تتدافع داخل عالمها النحوي واللفظي، داخل مفرداتها وبلاغيتها، وحتى في داخل اللعبة التي تستعاد دائماً في قلب قطيعتها. تأخذنا القراءة أيضاً إلى ثقل غموضها وعتمتها، ومن ثم تتركها تجترح قوة تدميرها وتهديمها: أي الإذعان في نهاية الأمر ومثلما يدعو ذلك الناقد الفرنسي جان بيير ريشار في احد مقالاته “اللامقروئية الوفيرة والقاتلة”.
والحال أن هذه اللامقروئية المتوالدة، لا تهب أي شيء بشكل مجاني، فهذا العنف لا يتعلق بإرادة قاسية. بل هو وبشكل جليّ، حدس “أنطولوجي” لأن الشعر يعطي نفسه مشروعاً إفشائياً: إقلاق، زعزعة، توبيخ، ومن ثم في نهاية الأمر، عبور من خلال صنيع نوع من الذعر الكلامي. ذعر هو في الوقت عينه، تقلص وانقباض ومن ثم تفجير وتشظ، مدّ وجزر، أو، والتعبير لريشار أيضاً، إفراط ونقص في نسيج البداهة اليومية.
أميل إلى قراءة شعر أنسي الحاج على أنه “تعلق بأمان سلبية” (التعبير لأونغاريتي)، وهي أمان تبدو وكأنها تدعم اليوم بعض التجارب الشعرية العربية. لكن النغمية التي تطغى على شعر الحاج، تمكث داخل كثافة عبارته المشدودة وفعاليتها المتخيلة. فمن حركة التدمير تظهر الماهيات الأقسى والأطهر: أي حالات من مثل الأجيال والظلال والحب والمدينة والبكاء.. الخ وهو حين يتحدث من داخل منطق القساوة لا يرغب إلا في جعل هذا التفتيت نوعاً من الانهيار.
صحيح أن الكائن في شعر الحاج منذور للاختفاء، لكنه منذور أيضاً للانبعاث، أي سيعود وسيولد وينبثق ثانية من غيابه ذاته. القصيدة هنا، ليست سوى فعل ارتكاز، كذلك هي فعل قلب للمعاني وللقيم المتخيلة التي لا تتوقف عن التفكير فيها، وعن صنعها مجدداً، لكن بشكل مختلف في كلّ مرة.
يحيا المعنى الشعري في قصائد الحاج، من خلال قساوته الخاصة، يتموضع على حدود التماس الذي يهدده في وجوده. القصيدة تنبعث، تنثقب في افتراضها الخاص، أي في تلك القدرة التي تبدعها في كل لحظة. من هنا لا يبدو هذا المعنى سوى موت خاص، أي ولادة خاصة، إنها ولادة قاسية، مثل الموت عينه.
زمن مضى منذ أن قال أنسي الحاج قصائده. لكن الزمن الحقيقي، يبدو وكأن لا معنى له. لأن الأساس هو زمن الشعر. وزمن الشعر لا يمضي. إنه الذهب الذي يبقى ذهباً، إنه “ماضي الأيام الآتية”، لأن شعره، كان حركة أساسية في حياة القصيدة الجديدة.
الصعود إلي ملكوت الشعر من الباب الضيق
جرجس شكرى
لا تكتب عن أنسي الحاج، فهذا الشاعر يبدو قاسياً حزيناً مثل نبي طرده أبناء وطنه فلجأ إلي برية بعيدة ليصرخ فيها وحيدا، يلبس حول حقويه جلد ماعز، يأكل جراداً وعسلاً ويكتفي بالصلاة للكلمات المجردة، الكلمات الأولى، شعرت بقسوة اللغة، أو قل اللغة العارية التي تجردت من كل غايتها التي نعرفها ولجأت إلي غايات جديدة، طليعية تصطدم كل من اقترب منها، فشعرت بالخوف وأنا أقرأ (لن) لأنسي الحاج، أنا الذي قرأ شعراً يبدو جميلاً غارقاً في البلاغة، إذ قرأت قبل أنسي الحاج قصائد نثر ترتدي ملابس الشعر، قصائد تضع علي رأسها قبعة البلاغة وتنتعل المجاز والموسيقي، فكثيرون كتبوا ومازالوا يكتبون قصيدة النثر بمنطق الشعر التقليدي، بمنطق الأسلاف لغةً وبناءً ولكنه آمن بالنثر الخالص، الطبيعي فمنحه شعراً خالصاً وخاصاً، منحه أسراره وفتح له أبوابه المستعصية، فهو يؤمن أن أدوات النثر تعمل لغايات شعرية ليس إلا، فهو لا يستعير من تراث الشعر شيئاً يتوكأ عليه في قصيدة النثر، لكنه يخلق من النثر شعراً، هو يعرف أكثر من كل الشعراء أن النثر وحده فيه كل مقومات الشعر.
أدوات النثر
وكما أن الأشياء حين تصعد إلي خشبة المسرح تتجرد من غايتها في الحياة وتصبح أشياء المسرح، فالكرسي الذي نجلس عليه حين يصعد إلي خشبة المسرح يُصبح كرسي المسرح، ربما كرسي قيصر أو الملك لير أو كرسي يوجين يونسكو، أو كرسي الزمن، هكذا كل أدوات النثر حين تدخل قصيدة أنسي الحاج تصبح أدوات الشعر تعمل لغايات شعرية، وهذا ما أدهشني ومن قبل جعلني أشعر بقسوة شعر أنسي الحاج حين قرأته لأول مرة، لأنه ذهب إلي الشعر من طريق جديد، ذهب من الباب الضيق إلي ملكوت الشعر.
أنسي الحاج عكس كل الشعراء دخل إلي القصيدة مسلحاً بأدوات النثر وليس بأدوات الشعر التي نعرفها، دخل وهو يثق تمام الثقة في النثر أن يمنحه شعراً خالصاً دون دعم أو مساعدة من أدوات الشعر التي نعرفها ، ربما حاوره طويلاً وسأله لا تخذلني يا صديقي، فأنا أؤمن بك.
بطاقة هوية
في يناير عام 1965 كتب أنسي الحاج تحت عنوان هذه هي الحياة: أنا من الذين يعتقدون بالدخيلاء، واللاوعي، والمغناطيس، والعقل الباطن، والحلم، والخيال، والمدهش، والعجيب، والسحر والهذيان، والصدفة، وما فوق الواقعي، وكل ما هو مشبوه فوق الواقع، ولي اهتمامات بالجوانب المثيرة من الانحرافات العصبية والعقلية والنفسية. واعتبر منطقة النفس البشرية أعمق وأكثر تفوقاً من أن يحيط بها أو يحصرها طب نفسي يظن في يده المفاتيح لأبواب هذه المنطقة والعلاج لأمراضها.
ربما تكون هذه الكلمات جزءا يسيرا من بطاقة هوية أنسي الحاج الذي قال إنه يرفض شرطة الجمال وحشرات التزييف الشعري والفني والعقائدي !لأنه يعرف الكلمات في جوهرها لا في مظرهها الزائف! تخيلته يسأل الكلمات وربما العابرين، الاسلاف والمعاصرين.. هل يخرج من النثر قصيدة؟ أنسي الحاج أجاب بمفرده والآخرون أجابوا أيضاً، هو أجاب وانحاز إلي النثر وقال: قصيدة النثر عالم بلا مقابل، فقصيدة النثر كي تكون قصيدة حقاً لا قطعة نثر فنية أو محملّة بالشعر تتوافرفيها شروط ثلاثة، الإيجاز والتوهج والمجانية وظل هكذا في كل أعماله، عاش أنسي الحاج يسأل الكلمات العارية مثل سفسطائي إغريقي يستيقظ من نومه ليسأل السماء عن أصلها والعالم عن المحرك الأول، و في خريف 1960 كانت مقدمة – لن – مانيفستو قصيدة النثر وفيها كان يسأل النثر عن الشعر، وجاءت الإجابة حافلة بالقلق في – الراس المقطوع، ماضي الأيام الآتية، الرسولة بشعرها الطويل حتي الينابيع – وبعد ثلاثين عاماً في مقدمة – خواتم – راح يكفر بالكلمات نثراً وشعراً، فلم تعد الكلمات تبلور الحقائق وتبدعها، يقول: لقد أصبحت الكلمات تنقل إلينا بلاغتها، في أي لغة كانت، لكنها لاتقيم بينها وبيننا تواصل الحب. القربان انفصل عن رمزه. هل ماتت الكلمة؟ وكان يسأل عن نفسه لا عن الكلمة، كان يسأل عن موته بعد أن توقف عن الكتابة( لكوني عدت واستأنفت الكتابة وكأني عدت واستأنفت الحياة بعد موتي)
طقس سري
في شعر أنسي الحاج الكلمات التي كانت في البدء، الكلمات العارية كحواء وآدم قبل طردهما من السماء، كلمات لا تشعر بالخجل من عريها تستطيع أن تواجه العالم دون أقنعة وتقف في القصائد مرفوعة الرأس بلا زينة، فهو حليف الكلمات قبل أن يكسوها الأسلاف بملابس المجاز والاستعارة وكل عباءات البلاغة ! وظني أن هذا ما جعلني أشعر بالقسوة وأنا أقرأ شعره للمرة الأولى كان لا بد من أن تتخلص ذائقتي من تاريخ طويل من الأقنعة. فالكلمات عنده تتخلص حتي معانيها التي نعرفها، فالشعر كلام الصمت (ما من فرق بين الشعر والحب إلا كون الأول كلام الصمت والآخر فعله) والكلمات عند الآخرين صاخبة ترتدي سراويل ومعاطف وأحذية وتضع كل أنواع المساحيق ! لهذا أقرأ شعر أنسي الحاج في صمت، ولا أناقش الآخرين حوله، لا أتحدث مع أحد عن شعره، وكأنه طقس سري ممتع، أتامله، أفكر في هذه السطور وفي قسوة المعني، أهمس لنفسي بكلام أنساه بعد لحظات وأقول لي: لا تكتب عن أنسي الحاج، ولا تتحدث عنه، احفظه كمحبة لا تسقط أبداً.
الشعر
كان يكتب وينشر نصوصه ولا يسميها شعراً إلي أن طلب منه يوسف الخال أن يساهم في مجلة شعر.
– أنسي: وما دوري
– الخال: أنت تكتب شعراً
– أنسي: ليس عندى ما يفيدك
– الخال: كيف فأنا قرأت لك شعراً منشورا في مجلة الأديب والحكمة والمجلة، فهذا ما أريده منك، هذا شعر.
فهل كان أنسي الحاج مفرطاً في التواضع أم كان بالفعل لايضع ما يكتبه في خانة الشعر؟ وأنا أرجّح الإحتمال الأول، فهو يعرف أن ما يكتبه شعر، ولكنه لا ينتمى للقوالب المتعارف عليها (من تحت الشوق ومن فوق الشهوة، من بين أمواج الضجر والقهر، من ثنايا التذكارات الموجعة، من طريق الكلام، الذي هو أيضاً جسدٌ من أجسادنا) فحين قرأت كلمات – ثلاثة أجزاء – دفعة واحدة عرفت أن الشعر عنده مملكة ألعاب، فهو يلهو بالكلمات كما يلهو الأطفال وأن نثر أنسي الحاج شعرخالص، ثمة أختلاف فالكلمات هنا ليست كالكلمات التى نعرفها، كلمات تعلّم قارئها الجنون وتصيبه بالدهشة ويقع في غرامها من النظرة الأولى.
في 1 تشرين الأول 1972 كتب يصلي من أجل عاصي الرحباني وقال :(مريم العذراء لم تؤلف كتب الفلسفة، لكنها تركت لنا أمثولة حنان وعاشت في القلوب شفيعة، ألستم في حاجة إلى حنان الأم أكثر من حاجتكم للفلسفة؟ وحين تعتّم عليكم الأرض، قولوا للعذراء تشفّعي لنا. اضعفوا! المكابرة ليست قوة، والسخرية فراغ، والادّعاء قناع على وجه الشقاء. إذا كنتم تحسبون الصلاة ضعفاً فهلمُّوا اضعفوا.) وكان أنسي ضعيفاً أمام اللغة يصلي لها يطلب منها الحنان لا الفلسفة، ولا يستعرض عضلاته الفكرية معها مثل فحول الشعراءالعرب قديماً وحديثاً، وإن كان يبدو قاسياً! وفي أحيان كثيرة أجد الشعر في نثر أنسي الحاج أجمل من الشعر فى نصوصه الشعرية، فتقريبا لا حدود فاصلة بين نصوصه (فلا شيء يخرج عن طاعة الشعر، ومن يخرج من طاعة الشعر يسقط) وهو يرى أن الفنون كلها تنهض من وحي الشعر، فالشعر في البنية العميقة لكل الفنون وإن ما يخلو من الشعر يخلو من الإبداع، يخلو من الحياة.
مونودراما
فجأة وجدتني أمام أنسي الحاج الذي كان يقف وحيداً في بقعة ضوء كأحد أبطال المسرح جاء بعد ما يقرب من نصف قرن ليعرض على جمهوره مونودراما، عنوانها أنا وقصيدة النثر، أو قل أنا قصيدة النثر، كان يتحدث بلسانها، كان مؤتمر قصيدة النثر في بيروت 2006 والذي افتتحه انسي الحاج بكلمة أقرب إلى صيغة المونودراما منها إلي كلمة الافتتاح وكان ممثلاً مدهشاً، وبعد دقائق اختلط علىّ الأمربينه وبين قصيدة النثر فقد تقمّصها وراح يؤدى عنها ويصف حالها بعد هذه السنوات (أنا اعترف بالوزن، ولا يعترف بي، أنا متمردة، صارمة، حرة ومسيّجة، ومتنوعة حتى التناقض، أنا المخلوق الدخيل سأظل، مهما أجلستمونى بين أنواعكم الأدبية، مخلوقاً دخيلاً) وكأن قصيدة النثر تتحدث للجمهور لا هو، في لحظات قليلة كان يكسر الإيهام ويتحدث بلسانه هو للحضور ويعترف (يؤخذ علينا أنا وسواى من المؤسسين، أننا حددنا شروطاً ومواصفات لقصيدة النثر.. وخرقنا العديد منه) ثم يعود إلى الدور وتقمّص الشخصية لتقول لنا قصيدة النثر أنا عشبة هوجاء لم يزرعها بستاني القصر ولا ربة المنزل، بل طلعّت من بركان أسود، ثم يعود إلي نفسه إلي شخصيته ويتحدث عن أدعياء الشعر الذين يختبئون وراء مسمى قصيدة النثر أو الشعر المرسل لصف الكلام وطلاء العقم بالفراغ، وكأنه يتجول في أنحاء الزمن عبر نصف قرن، يذهب بعيداً ويعود إلينا في قاعة الجامعة الأمريكية في بيروت، كان هو وحده الممثل والمخرج والمؤلف ونحن الجمهور الذي يشاهد هذا العرض وأغلبه من الشعراء، لم نكن نسمعه فقط، بل كنا نشاهده يبنى فضاءاً مسرحياً من الكلمات، كان يحاور شخصية غائبة، لم يلجأ إلى مؤثرات سمعية وبصرية لينتقل من زمن إلي آخر كما يفعل المسرحيون، بل كانت الكلمات وحدها تفعل ذلك من خلال التداعيات الذاتية للشاعر، كنا نتطلع إلي النهاية وكيف سينتهى هذا الصراع، ليفاجئنا قبل النهاية بقليل بمديح الوزن (ستظل الأوزان المعروفة مرغوبة، لأن إيقاعتها استراحة للوجدان ونزهة للذاكرة) وقبل أن نفيق ونصفق.. كان الممثل والمؤلف والمخرج في صوت الشاعر قد وصل إلى الذروة وهو يحاور الزمن، حين راح يدعو الكتابة إلى وليمة الخلاص بسحر المعجزة الشعرية، والمعجزة أيها الكرام دائماً شعرية، وللوقت تلاشت الإضاءة!
أن تعرف أنسي
أن تقرأ شعر أنسي الحاج وكلماته فهذا مدهش، ولكن حتى تعرفه لا بد من أن تلتقي به في بيروت، وبيروت دون غيرها من المدن، وكنت محظوظاً لأننى التقيته هناك في مؤتمر قصيدة النثر، وكانت سعادتي غامرة حين تحدثتنا كثيراً ولا أذكر ماذا قلنا سوى أنه كتب لي عنوانه البريدي الذي مازلت احتفظ به، ولم استخدمه أبداً، كنت أكتب له رسائل كلما قرأت له شيئاً، أكتب فقط في مخيلتى، وفي اليوم الأخير ذهبنا جميعاً إلى – جدل بيزنطي – كل الشعراء وجاء أنسي الحاج في مشهدٍ مختلف، كان هادئاً بعد أن تخلص من ملابس الدور، تخفّف من نصف قرن من الأسئلة، أو هكذا تخيلته وهو يقف في الحانة تحيطه محبة الشعراء، يومها حدثت أشياء كثيرة قرأنا شعراً، وكنت كلما قرأت أنظر إليه، أيضاً كان يجلس وحيداً تقريباً، هذه المرة هو الذي كان يشاهدنا من مقاعد المتفرجين، نقرأ الشعر، نشرب ونلهو، فهل كان يشاهدنا نؤدي جملة أدوار في عرض ينتمي لمسرح العبث في تلك الليلة؟
[ نُشر جزء من هذا النص في جريدة أخبار الأدب
أنسي الحاج: “لا أعتنق شيئاً أتبع ندائي الداخلي”
كامل صالح
يعود عمر هذا الحوار غير المنشور مع الشاعر أنسي الحاج إلى خريف العام 1994، إذ التقيته آنذاك، أكثر من مرة في مكاتب جريدة “النهار” في الحمراء، قبل أن تعود إلى وسط العاصمة، بهدف نشره في عمل أكاديمي. وقد أشرف أنسي نفسه على إعادة صياغته، وتحرير بعض جمله آنذاك.
تشعبت محاور اللقاء إلى أكثر من موضوع، فدار حول رأي أنسي بالشاعر يوسف الخال ودعوته إلى “اللغة العربية الحديثة”، وتجربة أنسي في ديوانه “لن”، وعلاقته بمجلة “شعر”، ونظرته الخاصة إلى الدور الذي أدته آنذاك، كما تطرق أنسي إلى الشاعر أدونيس وسبب تركه المجلة، ومفهومه الخاص للشعر الحديث عموماً وقصيدة النثر خصوصاً، وغيرها من العناوين. فإلى تفاصيل الحوار:
أكتب لغتي
■ دعا يوسف الخال إلى “اللغة العربية الحديثة”، التي كان شعارها “اقرأ كما تتكلم”. ما رأيك أنت بهذه الدعوة، ولمَ لم تكن من أنصارها على الأقل، مع أنك مسكون بالتمرد؟
{ أنا أكتب لغتي، ولا أتوقف عند تصنيف قديم أو حديث. أكتب لغتي التي أعتقد أنها حية. همّ الكاتب أن يعبّر بلغة تشبهه، وليست تشبه “صاحب دعوة إلى لغة”، كائناً من كان، وكائنة ما كانت هذه الدعوة، عظيمة أو غير عظيمة، صحيحة أو غير صحيحة، المهم أن تشبهك. لعل دعوة يوسف الخال للكتابة بـ”لغة عربية حديثة” موجهة إليه على الأغلب، لأنه كان يعاني من هذا الموضوع الذي كان يعني له الكثير، أنا لم يكن يعني لي شيئاً، ولا أزال. أما بالنسبة لي فاللغة هي المهمة وليس اللسان، أي أن قضية اللغة كصرف ونحو وتطوير عملي لا تعنيني. من الممكن أن تكون دعوة يوسف الخال وسعيد عقل على حق، ويجوز أن يكونا على غير حق. لا أعرف. هذه قضية لا أنظر إليها بمنظار عقائدي كي أؤيدها أو أعارضها، مثلما اعتاد الناس في بلادنا، إذ ينظرون إلى الأشياء نظرة عقائدية، أو بالأحرى نظرة دينية، مؤمن بها أو غير مؤمن، أنا لست هكذا. وهذا السؤال وجهه لي يوسف الخال في منتصف الستينيات، عندما ترجمت مسرحية لشكسبير اسمها “كوميديا الأغلاط”. لبننتها، وكانت تعتبر في مطلع التحديث المسرحي اللبناني. كتبت المسرحية بلغة عربية فصيحة، فصيحة ولكن حية، لدرجة أن الجمهور الذي شاهدها آنذاك لم يتوقف عند كونها فصحية، بل أتى وشاهدها بشغف واهتمام، وكأن لغة المسرحية غير منفصلة عن لغة الناس اليومية، لكن يوسف الخال وقتئذ وجه لي رسالة عتب، “إذ كيف تكتب بلغة نريد أن نخلص منها… إلخ”. وحدث جدال بيننا، فقلت له: أنا لا أشعر بمشكلة في اللغة الفصحى، ما دمت أستطيع أن أعبر بها مثلما أريد ومن دون مضايقة، وعندما لا تتمكن اللغة الفصحى من تحقيق ما أريد، أكتب عندئذ “الدارج”، ألقحها بكلمات ربما هي موجودة في اللغة الفصحى أيضاً.
لغة “لن”
■ ولغتك الشعرية في ديوانك “لن”؟
{ ربما أنني في عقلي الباطن لا أريد حلاً لهذه المشكلة، ولو حُلّت ستلغي عاملاً من عوامل التأليف ـ الخلق، وتلغي عاملاً من عوامل التحدي الإيجابي… هذه اللغة لو “ميؤوس” منها تماماً، نخرج منها، ونخترع لغة بديلة. لكن هل أثبتت اللغة العربية أنها ميؤوس منها تماماً؟ لا أظن ذلك، والدليل الصحافة والتلفزيون، التي هي وسائل إعلام أكثر جماهيرية بكثير من الشعر وحتى من المسرح، إذاً، ليس هناك من معنى للإلحاح على اعتماد ما سماه يوسف الخال “اللغة العربية الحديثة” وما سماه الآخرون “اللغة الحية” أو “اللغة المحكية” أو “اللغة العامية”… إلخ.
■ ذكرت أن يوسف الخال كان يعاني مع اللغة، لم تحدد لي ما هي هذه المعاناة.
{ معاناة “الخال” مع اللغة كانت، إلى حد، أنه عندما أغلقنا مجلة “شعر” كتب هو افتتاحية العدد التي تحدث فيها عما سماه “جدار اللغة”. أما بالنسبة لي، فلم يعنِ لي هذا الأمر، وبرأيي ليس هناك “جدار”. ومع ذلك كنت من محبّذي توقيف المجلة، حتى أني وضعت على الغلاف “العدد الأخير” توكيداً لتوقيفها، ونحن كنا نعرف أنها ستتوقف، لأن مهمتنا كفريق مجلة انتهت. ولكن السبب عندي، أعود وأقول، ليس له علاقة بمشكلة اللغة، ولا أجزم أنه لم يكن عند أحد من أفراد المجلة هذه المشكلة.
■ لكن لم توضح لي نوع المعاناة…
{ يوسف كان يريد الكتابة باللغة الدارجة. لم يمنعه أحد، وكتب محاولات عدة ونشرها في المجلة، لم أعد أذكر إذا نشرها بمجلة “أدب” أو “شعر”، وكان من الصعب أن يحقق هدفه من المحاولات الأولى، ربما لو أتيح له من العمر أكثر، كان من الممكن أن يحقق أعمالاً مهمة أكثر، المؤسف أنه لم يتح له الوقت الكافي، ولم يأخذ مجده في الكتابة، ولم يعد هناك مجلة “شعر”، ولم يعد هناك الجو الذي كان موجوداً في الستينيات، مع ذلك صدر له في لغته الحديثة عملان أو أكثر، لم أعد أذكر. أعود وأكرر، لا أناقش صوابية هذه الدعوة أو عدم صوابيتها، فليوسف الخال ملء الحرية أن يدعو لهذه الدعوة، وللزمن أن يحكم في النهاية. تثبت اللغة جدارتها بالحياة بمدى حيوية الآثار المكتوبة بها.
الأغنية اللبنانية بصوت فيروز استطاعت ان تصل بلغتها العامية إلى كل العالم، وكذلك الأفلام المصرية، استطاعت أن تُدخل “اللغة المصرية” إلى كل العالم العربي وأن يفهمها كل الناس. إذاً، جمال الأثر الأدبي أو الفني هو الذي يفرض اللغة وليس العكس.
همومي داخلية
■ يوسف الخال لم يستطع أن يبدع حتى يؤثر “بتغيير اللغة”…
{ لقد عمل في المجال النظري، ولم يبدع الإبداع الكافي الذي يقدر أن يواكب دعوته ويجسدها بالواقع الأدبي. أطلق دعوة وجيهة، وعقلانية، وهي بسيطة مبسطة، لا تتطلب أن يكون القارئ متبحّراً باللغة لكي يفهمها.
أنا أجيب عن سؤال متعلق بي: “أعتنق أو لا أعتنق..”، أنا لا أعتنق شيئاً، بل أسير وراء نداء داخلي. أنا همومي داخلية وليست خارجية، وأعتبر الهم اللغوي هماً خارجياً.
لقد كتبت مرة باللغة “اللبنانية” برغبة خاصة.. “مزاج”. وما كتبته موجود، لم أستح مما كتبت، ولكني لم أصل مع اللغة الفصحى إلى الجدار الذي وصل إليه يوسف الخال، من الممكن أن تكون العلّة عندي، لأن ليس عندي الوعي الكامل لمشكلة اللغة، فأنا لا آخذ اللغة كعلم، فاللغة هي عندي صوت داخلي ولا أفكر في شكله الخارجي.
الذهنية السخيفة
■ قبل البدء بإصدار مجلة “شعر”، سافر يوسف الخال إلى أميركا، وعمل في مجلة تابعة للأمم المتحدة، كما شارك في البعثة التي انتدبتها هيئة الأمم المتحدة لتهيئة ليبيا للاستقلال، إضافة إلى أنه سافر مع شارل مالك لطرح قضية لبنان في الأمم المتحدة، وهناك إهداء كتابه “البئر المهجورة” إلى عزرا باوند، الذي أدى إلى ردات فعل سلبية تجاه الخال، نعيمة مثلاً لا حصراً. ما أريد قوله، أن هذه المتابعات، إضافة إلى غيرها، أدت إلى التشكيك والاتهام أيضاً في نية الخال وبدعوته لـ”تطوير اللغة”. والجدير بالذكر أن الخال ردّ الاتهام عنه أكثر من مرّة.
■ ماذا تقول عن هذا الموضوع، وأنت كنت من المساهمين الفعليين في حركة تجمع مجلة “شعر” وتوجيهاتها؟
{ هذا جزء من الذهنية السخيفة التي تتهمك بمظاهرك، إذا أنت اشتغلت في الأمم المتحدة يعني أنت عميل أميركي! عيب هذا الكلام، وبكل الأحوال لم يعد أحد يتكلم بهذا المنطق الآن. وظهر أن الذين اتهموا يوسف بالعمالة ثبت أن معظمهم كانوا أكثر عمالة ولا يزالون. الأمم المتحدة غير الولايات المتحدة، خصوصاً في تلك الأيام. أما إهداء قصيدة لعزرا باوند فهذا العمل ليس تهمة. “باوند” شاعر كبير…
■ قال يوسف الخال في القصيدة المهداة: “نحن عراة” أي نحن الشرق، وأنت الماء التي ستروينا…
{ ليست هذه القصيدة وحدها ما يعبر عن هذا الموقف عند يوسف الخال، بل إن معظم شعره أو كله يعبر عن ذلك، ويمكن أن أقول إن موقفه الفلسفي قائم على هذا الأساس.
■ إن تطورنا سيأتي من الغرب..
{ يوسف كان مؤمناً بالغرب إيماناً كبيراً، وعبر المسيحية، وإيمانه بالغرب ليس إيماناً بالتكنولوجيا أو بالوثنية بل بغرب عقلي ـ روحاني، وربما هذا الغرب المثالي غير موجود في الواقع كما كان يتراءى لذهن يوسف الخال، وكما يتراءى المثال، دائماً، للحالم به.
■ تأثراً بإليوت؟
{ طبعاً، إليوت شاعر مسيحي كبير، ويوسف تأثر به كما تأثر به عدد كبير من الشعراء، بينهم شعراء مسلمون، إذ إن المسيحية تتخذ عند إليوت معنى حضارياً وليس محض ديني. يوسف الخال بالمعنى الديني لم يكن ذلك الورع التقي، فالمسيحية عنده هي الخصب الحضاري المتواصل توارثاً في التاريخ، وعلى امتداد كل الحضارات السابقة أيضاً كالكنعانية والفينيقية… إلخ، بما في ذلك الإسلام.
في الخمسينيات نشأ المد الناصري الذي أعطى حدة لمضمون العروبة والقومية العربية، فولّد ذلك اصطدامات، ولعلها كانت أحياناً اصطدامات إيجابية، وبخاصة الثقافية منها، رغم أنها كانت تصل إلى حد الاتهامات والشطب..
■ الشتم…
{ الشتم والشطب المعنوي.
■ مجلة الآداب مثلاً…
{ “الآداب” من جملة الذين اتهمونا، وليس “الآداب” فقط، بل كل المجلات التي كانت تصدر في مصر والعراق وسوريا. لقد شنوا علينا حملات عقائدية وسياسية وأدبية، وكأننا جهاز الاستخبارات الأميركية، أو “جيمس بوند”، أو إسرائيل، ونحن بضعة فقراء لا نملك إلا أحلامنا.
القرار الصحيح
■ لماذا توقفت مجلة “شعر” عن الصدور سنة 1964، وبالتالي ما الذي تغير لكي تعود إلى الصدور سنة 1967، لتتوقف نهائياً سنة 1970؟
{ كان قرار توقفها الأول القرار الصحيح، ورجوعها إلى الحياة كان محاولة من “أليعازر” ليحيا من جديد، ولا تستطيع أن تمنع أحداً كان ميتاً أن يعود ويعيش إذا استطاع، وهي محاولة مشروعة.
■ لكن أنت رجعت إلى مجلة “شعر” عندما صدرت مرّة ثانية
{ كان عندي مجموعة شعرية، جاهزة للصدور فنشرت في “شعر” العائدة.
■ لكن أنت شاركت في التحرير ونشرت بعض إنتاجك في المجلة
{ نعم، شاركت في المجلة في المرة الثانية. يوسف كان صديقي، وأنا من أحضره إلى دار “النهار”، وسلمناه النشر، والمجلة صدرت عن دارنا، طبعاً سأشارك معه. لكن عودتها لم تكن نتيجة نداء مصيري كما صدرت في المرة الأولى. كانت تريد أن تثبت وجودها بالقوة، أنها ما زالت حية، ولكنها لم تضف جديداً، لم تخلق تياراً، أو حركة أو أسماء جديدة. ظلّت تعيش على أسماء الأشخاص أنفسهم، مع بعض الاستثناءات. ما الذي تغير؟ لذلك عادت وتوقفت.
■ قال الخال في إحدى المقابلات إن المجلة لو وضعت صورة زعيم عربي لاستمرت.
{ قال هذا الكلام عن مرارة، وهو مقهور، وأنا أفهمه. مع ذلك عاد مرّة ثالثة ليجرب إصدارها، فاجتمعنا أنا وهو وأدونيس وفؤاد رفقة ونديم نعيمة، في بيتي في الأشرفية، ومرّة ثانية في الغاليري الذي أعاد فتحه في “الزلقا”، ومرّة ثالثة في غزير مع أدونيس، وكان أدونيس مستعداً للعودة إلى المجلة…
■ لكن أدونيس كان يصدر مجلة “مواقف”…
{ مع ذلك، كان أدونيس مستعداً لأن يوقف مجلته وينضم معنا، كان متجاوباً إلى حد كبير، ومرّة اجتمعنا في منزله للتباحث في إصدار مجلة “شعر” أيضاً. وكانت هذه الاجتماعات قبل موت يوسف الخال ببضع سنين. لكن وجدنا أننا أصبحنا متطلبين أكثر من السابق، لم يعد من السهل القيام بهذه المغامرة، فبعد مرور عشرين سنة لم نعد نستطيع العمل بلا وعي البدايات، بل بوعي المسؤولية والنقد الذاتي، الذي هو مقيد. نريد أن نصدرها، لكن نعمل كذا، ولا نعمل كذا… لقد بتّ تعرف سلفاً ماذا يجب أن تعمل، ماذا يجب أن تكتب.
■ ماتت الدهشة…
{ ليست الدهشة فقط، بل قُتلت الطفولة، “الغشمنة” الخلاّقة، فإن لم تكن طفلاً لا ترم نفسك في التجارب المجهولة، وهكذا قضيناها مناقشات ومناقشات… بدون فعل.
■ لم يكن هناك أسباب أخرى؟
{ لا، كنا جميعاً قلباً واحداً.
يوسف وأدونيس
■ ترك أدونيس مجلة “شعر” في المرة الأولى، وهناك من يعتبر أن ثمة خلافاً حاداً وقع بين أدونيس والخال، مَن السبب، وماذا حصل؟
{ حصل خلاف بين يوسف وأدونيس، وأنا لا أحب أن أتكلم في هذا الموضوع لأني كنت من دعاة التوفيق بينهما، لكن فشلت، وفي الحقيقة نسيت الأسباب.
أدونيس لم يعد يريد الاستمرار معنا في المجلة، أحب أن ينفصل، ونحن لسنا حزباً لنمنعه، إضافة إلى أن لكل واحد منا عالمه الشعري المختلف عن الآخر، مثلاً: ما يجمع شعر شوقي أبي شقرا وأدونيس؟ كل ما في الأمر أنه كانت تجمعنا رغبة التجديد ومغادرة عالم قديم إلى عالم جديد.
■ هل بإمكانك أن تطلق على كل تجربتك وتجربة الخال، وأدونيس وشوقي أبي شقرا وفؤاد رفقة تجربة الشعر الحديث؟
{ هناك غيرنا أيضاً، في العراق وسوريا ومصر والأردن وغيرها. كانت تجربة الشعر الحديث، قد بدأت قبلنا، ولكن مجلة “شعر” ذهبت أبعد بكثير مما قبلها، وتوّجت مغامرتها بتجربة قصيدة النثر.
■ ألا يمكن تسمية مجلة “شعر” مدرسة؟
{ من الخطأ أن نسميها مدرسة، لأن المدرسة لها نهج واحد ومواصفات، وخلفية أيديولوجية، لكن في المجلة لم يكن هذا. كان فيها مسيحي وملحد ومسلم وواحد لا شيء. واحد محافظ مثل يوسف الخال وواحد مجنون ومتمرد مثلي. لا يجمعنا سوى الصداقة وروح التجديد. كتب يوسف الخال بلغته الدارجة ولم يكتب أحد منا مثله. أيضاً، كان بيننا قوميون سوريون وقوميون لبنانيون وأناس لا يعنيهم هذا ولا ذاك.
الشعر الحقيقي
■ هل نستطيع القول إن للخال نظرية في الشعر العربي؟
{ من الممكن أن نقول إن له نظرية… ولكن من الصعب تحديدها الآن، لأنه يجب استخلاصها من الكتب، ولعلني أستطيع أن أحدد عدداً من الأمور التي قامت عليها دعوته الشعرية، وأظن “دعوته” أفضل من “نظريته”، وبعض هذه الأمور هو الاستغناء عن الحشو في الشعر. يبدو هذا الكلام اليوم عادياً، ولكن في الخمسينيات عندما قدّم “الخال” محاضرته في الندوة اللبنانية “مستقبل الشعر في لبنان”، قبل تأسيس مجلة “شعر”، كانت هذه المحاضرة وقتئذِ صرخة ثورية، تنقد ماضينا الشعري بجرأة ووضوح، هذا الشعر القائم في معظمه على اللفظية والخطابية والوصف الخارجي.
■ وعدم ارتباطه بواقعنا…
{ ليس هذا فقط، بل بجوهر الشعر الحقيقي، سواء كان لبنانياً أو سورياً أو انكليزياً، ليس الواقع الاجتماعي فقط، وليس من الواجب أن تقف عند المعطيات السوسيولوجية في الشعر وحسب، بل هناك المنحى الروحي بالمعنى الوجداني، هذا لا يحده زمن ولا مكان. خصوصاً، في ذلك الوقت. كان سعيد عقل يطرح نظرية جديدة في الشعر. وعقل بالنسبة لما قبله ثورة. لكن إلى أي مدى هو حديث؟ جاء يوسف الخال وقال له: هذا ليس حديثاً، بل هذا في قلب الشعر التقليدي. هذه ناحية، وناحية أخرى، التقشف في الكتابة، الذي اتسم به أسلوب يوسف الخال، كان جديداً على عصره. كتب لغة بسيطة، كتب بها في الصحافة في جريدة “النهار” و”صوت المرأة” كما عبّر بها في مجلة “شعر” وكتبه. لغة نظيفة حيّة نابضة. أستطيع أن أشبّه الخال بأنه دخل إلى شجرة الأدب العربي وأزال الحشائش من حولها، كي تظهر الشجرة جميلة وصادقة.
عندما بدأنا بقصيدة النثر، يوسف لم يكن معنا، كان ما زال يكتب قصيدة التفعيلة. أنا دخلت مباشرة إلى قصيدة النثر، ولم أغادر من الوزن إلى النثر. لذلك لم أشعر بأني انتقل من معلوم إلى مجهول، بل من مجهول إلى مجهول. أما الخال فجاء من الشعر الموزون، فمن هنا له الفضل أنه كسر على نفسه ودخل في مجهول هو قصيدة النثر، وأدونيس كذلك جاء من قصيدة الوزن. فهذان الشاعران “قبعا” جذورهما القديمة ودخلا نحو الجديد.
■ إلى أي مدى نستطيع أن نعتبر أن التقشف وعدم الحشو في الشعر، والدخول إلى قصيدة النثر يميز شعر الخال؟ فهذا الأمر كان موجوداً إلى حد ما في شعرك، وفي شعر شوقي أبي شقرا وأدونيس…
{ هذه صفات جزئية جداً. يجب أي يُقرأ يوسف الخال قراءة جدّية ومنصفة. تجربته الروحية والفكرية متميزة. فضلا عن أن ما يميز يوسف الخال لحظته التاريخية، ولعبه دور المحرّض ذي الثقافة الأنكلو ساكسونية، فقبله كانت السيطرة للثقافة الفرنكوفونية: إلياس أبو شبكة، صلاح لبكي، أمين نخلة، سعيد عقل إلخ…
■ ويمكن أن نقول إن جبران أنكلوساكسوني أيضاً؟
{ جبران انكليزي التعبير، لكن تأثراته الثقافية واسعة وشاملة. ثم إنك تقرأه فتحس بالشرق. لكن يوسف مختلف، تقرأه فتحس لفحاً غربياً.
مفهوم الحداثة
■ الحداثة الشعرية كمفهوم، تحمل الماضي لترفضه وتتخطى الحاضر لتكون رؤيا.. إذاً، ما مدى تقاطعها مع واقعها وهموم مجتمعها؟
{ الحداثة ليست حزباً، الحداثة هي رؤيا وهي ملمح من ملامح المعاصرة، ممكن أن تكون معاصراً ولا تكون حديثاً، وممكن أن تكون معاصراً وأهم من الحديث. الشاعر الحقيقي هو لكل زمن. وليس هناك شاعر مطالب بالتعبير عن الواقع، هناك الجريدة من أجل هذا. الشعر ليس فقط مرآة لعصره، بل هو مزيج من الزمني ـ في أي زمن ـ والأبدي. إنه كيان العابر الدائم.
الحداثة جاءت كردّة فعل على التحجر والتحنيط والتعصب والسلفية. الحداثة بهذا المعنى مرادفة للحياة وللتجديد. الحداثة حاجة وليست مطلباً، والشخص لا يُروّض نفسه ليصبح حديثاً. يكون أو لا يكون.
■ يعتقد البعض ممن تابعوا مجلة “شعر” أنكم تبنيتم رؤى ثقافية لها أزمات، الغرب تحديداً، وبهذا فقد بعدتم عن رؤية التراث والواقع العربيين كمرآة لتحديث أصيل محاور مع الغرب ندّاً لند. فمثلاً في مقدمتك لديوان “لن” نراك مستشهداً بمراجع أجنبية عدّة…
{ هذا ليس صحيحاً، لقد ذكرت فؤاد سليمان ويوسف الخال وعبد الوهاب البياتي والياس خليل زخريا وهؤلاء عرب..
■ أقصد النظرية في كتابة “قصيدة النثر”
{ ليس هناك من مرجع عربي، استشهدت بسوزان برنار لأن كتابها هو الوحيد الذي وصل إلينا أنا وأدونيس، ويتكلم على قصيدة النثر، وليس هناك من مرجع عن قصيدة النثر سوى باللغة الفرنسية، هل نخترع مرجعاً عربياً؟
■ لكن قرأت لأدونيس أنه يعتبر بعض ما كتبه “النفري” يمكن أن يمثل قصيدة النثر في التراث العربي.
{ تقصد أن تقول إن هناك نماذج عربية من قصيدة النثر، ممكن، لكن أنا أتكلم على مرجع يتطرق إلى قصيدة النثر من الناحية النظرية. وأما النماذج القديمة في التراث التي يمكن اعتبارها قصائد نثر، فقد تكون هكذا وقد لا تكون. لا أشعر بضرورة استنباط مرجعية تراثية لأعطي قصيدتي شرعية.
■ وأدونيس؟
{ أنا أختلف مع أدونيس في هذا الموضوع، فهو يريد أن يجد جدوداً له في الشعر العربي، وكأنه متهم. أنا لا أشعر أني متهم. وإذا كنت متهماً ـ وقد كنت، وربما لا أزال ـ فأنا لا أتبرأ من تهمة اختراع نوع أدبي لم يكن موجوداً في التراث العربي.. إذا كان التجديد جريمة، فأنا مجرم. إذا النفّري كتب قصيدة النثر بالصدفة، فما علاقته بالموضوع؟ قصيدة النثر لتكون قصيدة نثر يجب حين كتابتها أن تكون واعياً أنك تكتب قصيدة نثر. وهذا ما قلته في مقدمة “لن”، وهذا هو الفرق مع أمين الريحاني مثلاً بشطحاته النثرية. وجبران خليل جبران. ومي زيادة.
ما كتبه علي بن أبي طالب ليس قصيدة نثر. وأما المتصوفون فهمومهم دينية ولغتهم مغلقة على رموز ومفاتيح مذهبية ودينية. لماذا الرغبة في افتعال مراجع عربية لحالات حديثة؟ الذي يبدأ هو الذي يقتلع الجذور، لكن يصبح هو الجذور. أنا لست في حاجة إلى أن أجد “أباً” قبل ألف سنة لأقول أنا عربي. وهل هو عربي أكثر مني؟
عاد وحيداً كما يكون دائماً
منذر مصري
هذه المرة سأكتب عنه مباشرة، سأذهب إليه من أقصر الطرق، لن أقول له مجدداً: أستطيع أن آخذ للوصول إليك طريقاً طويلاً. لأنه، أولاً، ليس لديه وقت!؟ ولأنه، ثانياً، هذا ما كنت أفعله منذ أكثر من أربعين سنة، منذ أن أحضرت لي تلك الفتاة والتي أولع بها محمد سيدة وكتب عنها أشد قصائده تفجعاً، أول مجموعة وقع عليها ناظري لأنسي: (ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة) سنة /1972/، ورفضت رغم عوزها الشديد أن تأخذ ثمنه. ثم إني يوماً، خلال مؤتمر قصيدة النثر الذي أقيم في الجامعة الأميركية، في بيروت، عام /2006/، وقد جمعنا عشاء مشترك، آثرت أن أجلس بعيداً عنه، مع عباس بيضون ويوسف بزي ورشيد الضعيف.. لماذا؟ أستطيع الآن أن أدبّج كذا سبب، ولكني في الحقيقة لا أدري. كنت في آخر كتبي، قد قدمت له قصيدتي: (ثعلب بداخل مشمشة) من دون ذكر اسمه: (إلى من كان يسمّي أوراق الخريف مريم العذراء)، كما أنه قد ذكر اسمي وهو يعدد أسماء بعض الشعراء السوريين في مقال له في صحيفة النهار، آخر أيام رئاسته تحريرها، لا أذكر بخصوص ماذا. أذكر، وقتها، أنني شعرت بغرابة ذلك لدرجة أنني كنت موقناً بأن أحداً ما، زوده به، وكذلك بقية الأسماء!. لم أقترب منه، ولم أصافحه حتى، وأظن أنه كان متاحاً لي معانقته، ولم أقل له: (أنا منذر مصري.. أحبك منذ الأزل!؟)، على أمل أنه سيعرفني من دون إضافة أوصاف أخرى، لماذا لم أفعل!؟
سآخذ عينة من دمه، عينة، لا على التعيين، صفحة قديمة ممزقة الأطراف، صفحة /39/ من مجلة لا أعرف عنها شيئاً سوى أنها صادرة عن دار النهار، يدل على هذا رأس الديك الصغير في زاويتها اليسرى. وليس عليها ولا على وجهها الثاني ما يشير إلى تاريخها، ربما في سبعينيات وربما في ثمانينيات القرن الماضي. عليها /14/ مقطعاً شعرياً، نثرياً، فلسفياً، لا يهم، لأنسي الحاج. أعرف أنها لأنسي الحاج، وليس عليها لا اسمه ولا صورته، احتفظت بها طوال هذه السنين وأنا أعرف أنها له، من سواه دمه هكذا. ليس لأن أحللها، من أنا لأفعل ذلك، بل لأنسج عليها، لأمسك منها بطرف هذا الخيط أو ذاك، وأربطه بخيط من ذكرياتي، من علاقتي الحميمة معه غائباً وبعيداً عني، من أول معرفتي به. أو إذا اعتبرتها يداً مدّها أنسي إليّ يوماً، وأبقاها عندي، فها أنذا، وبعد كل هذا الزمن، أحاول أن أمسك بطرف منها، أمسك بهذا الأصبع أو ذاك، وأذهب معه إلى حيث، إلى أيّ مكان في الكون، هو الآن ذاهب.
ترى، إذا كان بالمستطاع علمياً أن تستنسخ حيواناً بواسطة إحدى جيناته، هل من الممكن أن تستنسخ شاعراً بواسطة قصيدة مجهولة، أو مقطع من نص ضائع؟:
1ـ (تجسُّدكَ الأخير.): تبدأ الصفحة بهاتين الكلمتين اللتين تحتلان الزاوية العليا. ترى من كان يخاطب حينها؟ أي إله؟ أي مسيح؟ أم أنه يخاطب نفسه كعادته، مشغولاً بآخر تجسداته الغامضة. فها هو الآن أمامي، من دون اسم أو وجه، متجسداً في كلماته.
2ـ (أن أكذبَ عليكَ لأنقذكَ، بناءُ خلاصٍ رائعٍ من الكذب): أذكر أنسي في مقابلة تلفزيونية نادرة، في أواخر التسعينيات، لم أر له سواها في حياتي، ماذا يجدي شخصاً مثله أشياء كهذه!، أنه رداً على سؤال: عمّ يشغله الآن؟ أجاب: (الخلاص). أيّ خلاص يبغيه صاحب (لن) وقتها تساءلت مستنكراً. ولكني هنا، أكاد لا أميز، هل أنسي يقرظ الكذب المنقذ، برغبته المعروفة بقلب المفاهيم السائدة والمعاني الرائجة للكلمات، إلى ضدها؟ أم أنه يبدي رفضه لأن يكذب أحد ما بحجّة إنقاذ أحد ما، فيبني له خلاصاَ من الأكاذيب، يصفه بالروعة ساخراً؟.
3ـ (بحيرةُ الظلمات تحبًّ ذويها): نعم هكذا تفعل بحيرة الظلمات، وكائنات الظلمات، وبشر الظلمات، يحبون ذويهم، وينادونهم، ليعملوا معاً في توليد الظلمة ونشرها..أي أمثولة بودليرية سوداء هذه.
4ـ أحضرت لي حبيبة محمد سيدة وملهمته، كتاب أنسي (ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة)، ورفضت أن تأخذ ثمنه /8/ ل.ل. أو ما يعادلها، مكتفية بكتابة كلمة (هدية) على زاوية صفحته الأولى، هي التي كان أبوها يبيع جسدها للحشاشين، مقابل بعض المال. في القبو الملاصق لقبو محمد سيدة: (تأكّد لي شيءٌ لم يفرد عليه طائر الشكّ جناحه بعد، بأني سأدخل الحلبة للفوز بقلب حبيبتي مع حشّاش، يريد أن يجعل من جسدها البريء مرحاضاً لشهواته، وسوف تلبس حبيبتي للحشاش ثوبها الجديد، على مرأى من عين قلبي الذائب). كان كتاب أنسي بغلافه الأزرق الفيروزي هدية حب، قدمتها لي فتاة، ما كان يمكن لي بذلك الظرف أن أبادلها أية عاطفة، سوى الشفقة، التي لم تكن في اعتبارها أبداً. لطالما فكرت وتساءلت عن معنى كل هذه الروابط بين الأشخاص والأشياء؟
5 ـ (ما يخيفني في أنظمة القوة العضلية والعسكرية أنها تتعامل مع الفكر كما تتعامل مع الموت: باحتقار… إذا قبض النظام العضلي على شخص، فإنه عاجز عن تخيّل معاناته في لحظة التوقيف. نظام بلا خيال. الخوف من الموت في نظر نظام كهذا، عيب، انعدام رجولة. الرجولة لهذا النظام هي نباح قائد الجنود بأوامره، وامتثال الجنود للنباح. الرجولة هي الرأس الحليق من خارج ومن داخل، الثكنة. هي اختصار العالم إلى حدود ما يجهله المتعصب الأحمق. وما زاد كان الحذف والقتل): لا أستغرب أن يكتب أنسي شيئاً كهذا في نهاية عقد السبعينيات أو خلال عقد الثمانينيات من القرن المنصرم، رغم أن لبنان، يوماً، لم يحكمه هذا النوع من الأنظمة العضلية العسكرية، لكنه عرفها، عرفها وعاش تحت وطأتها خلال سنوات التدخل العسكري لأحدها حقبة طالت إلى ما يقارب الثلاثة عقود من الزمن! إلاّ أن ذلك كله، كما يبدو، لا يكفي ليعرف أنسي كل شيء عنها، أو لأقل ليعرفها فعلياً على نحو حياتي، لا صوري، لا ذهني، فالأنظمة الذي ينفخ جنودها عضلاتهم هذه الأيام كالبالونات، وإن كانت بلا خيال بالمعنى الأدبي للكلمة، فهي ذات خيال إجرامي بعيد، وتعرف جيداً، وبالتفصيل، أشياء كثيرة، أقربها معاناة من تقبض عليهم، وخوف المعتقلين من الموت لحظة اعتقالهم. لا بل تقوم بكل ما يلزم لتؤمن لهم هذا الخوف وهذه المعاناة بأعيرة وكميات تصل لحدود ما بعد الموت. كما أنه ما عاد لائقاً بهذه الأنظمة وقد تراكمت لديها كل هذه الخبرات، وبات لها كل هذا الباع، أن توصف بكونها متعصبة وجاهلة، بل، يمكن القول إنها، بأجهزتها الأمنية، التي لا حصر لعددها، ولا لمجالات اختصاصها، باتت وكأنها عالمة بكل شيء. ولكنه صحيح أيضاً، أن ما يزيد، ما يتخطى، ما يخالف، حدود هذا العلم الذي يرسم وجودها واستمرارها في الحكم، لا ريب مصيره الحذف بكل الوسائل الممكنة، وأقربها النفي والسجن والقتل.
6 ـ (كلما أردتُ أن أهدم حدوداً… أجدني استعمل كلمة الله، أو الجنون، أو الموت، أو الجنس بأقوى حالاته. كلها أبواب مفتوحة على اللانهاية ـ أو العدم، أو الغياب، أو الهوة، أو الهاوية… التي نبدأ بتعلم مذاقها من خوف الليل): إنها وظيفة الشاعر، هدم الحدود. أنسي شاعر يتنكب مهامه إلى أبعد حد. مستعيناً بالله، والجنون، والموت، والجنس. ولكن لماذا لم يقل الحب، أو العشق؟ لماذا فضل الجنس بأقوى حالاته؟. أ لأنه بالنسبة له، باب مفتوح على العدم، أو الغياب الكلي، أو الهاوية.. التي نبدأ بتذوق طعم السقوط بها من خوفنا من الليل. أي تدريب على الموت هذا!؟
7 ـ (الشر قوته في يأسه. في نشوة يأسه) لا أدري إذا كان أنسي في فتوته قد تلبس الشر؟ هل قالوا يوماً إن شاعر (لن) شرير؟ شرير يائس؟ حيث لا قوة للشر إلاّ في نشوة يأسه، أو كأنه يقول: (الشر نشوة اليأس).
لست أنسي الحاج (لن)، فأنا لم أقرأها، ولم أقرأ أيضاً مقدمتها الشهيرة، إلاّ بعد صدورها عن دار الجديد، في أواسط التسعينيات، وحين فعلت كان أغلب ما فيها منتهي الصلاحية بالنسبة لي، لكني أيضاً لست أنسي الحاج (الرأس المقطوع) الذي أبتعته مع (ماضي الأيام الآتية) بطبعتيهما الأصليتين، من مكتبة السائح في طرابلس، في أواسط السبعينيات، أنا أنسي الحاج (ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة)، مع اعتبار (ماضي الأيام الآتية) تمهيداً له، و(الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع) ملحقاً طويلاً له. أما (الوليمة) في تجميع فتات شاعر، تحول لنبي بطريقة أو بأخرى. أو لأقل بتعبير أدق، صار إلى نبي، لأن هذا الطريق الذي مضى به من (لن) إلى (الوليمة) لم يكن ليؤدي إلى أي مصير آخر. إلى نبي برسالة غامضة، مضطربة. إلى نبي ألقى بنبوءته على رؤوس قلة من الأشهاد، وصعد الجبل لا يلوي على شيء.
8 ـ (أيتها الوردة الحمراء ذات القلب ابيض كالموت): لا شيء كالموت يشغل أنسي. لكن موته أبيض، كالموت!
9 ـ (جمال مؤلم، حارق، شبيه بالنعرة المفاجئة التي تصيب القلب عند التماع ذكرى عنيفة): نعم، أعرف هذا عنه، أخبرتني به امرأة!. أنسي يؤلمه الجمال، يحرقه، يهزه بعنف كالتماعة رب، هو الذي أحفظ له: (الجمال.. ما أن ينام حتى يستيقظ)!؟
10 ـ (كم من ضحكة أجبرتني على العفو عن صاحبها أكثر مما لو كان بكى): لماذا لا؟ أ ليس أنسي القائل: (زنبقة الكآبة الزرقاء الضاحكة الضاحكة الضاحكة).
11 ـ (أرفض صورة التي تظهر الله مشيئةً ضد رغبتي، وحدّاً مانعاً إرادتي. أريده معي في كل رغباتي، في روحانيتي وفي وحليتي. لا أريد أن أهجره لأتحرر من قمعه، بل أريده أن يتحرر من لعنته لي، لنتبارك في خطانا، على مدى الحرية. أريدكَ، كهذه المرأة، متأطئاً، لا ديّاناً): في الدرب الذي اتخذه أنسي إلى الخلاص، كان لا بد من الله. كان لا بد أن يطلب نجدته ومؤازرته. إلاّ أنه يريده، أريد، يكرر، معه في رغباته!، وكما في روحانيته في وحليَّته! يريده معه على مدى الحرية، الذي لا يحده أفق، لا على الطريق الضيقة، التي تحفُّ بها جدران اللعنة والقمع والدينونة. يريده مورطاً، كهذه المرأة، التي أحضرت لي كتابه، يريده، متواطئاً، مثلي، عندما أخفيت علاقتنا عن صديقي، إلا أنه كما مرة أخبرتني، كان يشكّ بنا، وربما كان هذا السبب الحقيقي لمعاركه المستمرة معي.
12 ـ (لم أجد الله كما وجدته حين لم أعد أحتمل أفكاري) وجد أنسي الله الذي يبحث عنه، لا الله الذي كان يعرفه سابقاً، بل الله الذي عرفه، حين ما عاد يحتمل أفكاره، حين توحد، حين تولّه، حين جنّ.
ماذا صنعت بالذهب
كتبت مرة عن (ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة)، بأنه كتاب أكرهه وكأنه كتابي. ذلك لأني أعرف بدقة وتفصيل كل شيء فيه، بأية قصيدة يبدأ، وكيف تتسلسل قصائده، وبأي كلمة ينتهي!. مثله مثل أي كتاب من كتبي، وربما أكثر، وخاصة الأخيرة منها. قلت إنه علمني، ليس الشعر فقط، ليس الحب فقط، بل تقريباً كلّ شيء. وإنه في كلّ ما كتبت كنت أودُّ أن أكتب شيئاً خاصاً بي جميلاً ومؤثراً مثله. منذ (آمال شاقة) كان علي الاعتراف بديني له، فأهديته، كما فعلت مع شوقي أبي شقرا، ومحمد الماغوط، وتوفيق الصايغ، أحد أقسامها: (يلتصق بي الحب كثياب مبللة – إليك يا أنسي)، من دون ذكر بقية الاسم، فأي أنسي آخر يمكن أن يكون، ذاك الذي آثار خطواته تعبر على طول الكتاب. وحين يقول البعض بأن الشعر الحديث لا يحفظ، أو إذا كنت تحب شاعراً ما، أقصد تحب شعره، فإنه محتم عليك أن تكون ذاكراً، إن لم أقل حافظاً، لبعض قصائده، وإلاّ فأنت كاذب!!؟ كما مرة وصفني أحدهم وأنا أقول إني أحب شعر سعدي يوسف!؟ أجدني، أقرأ لهم، كما أحفظها عن ظهر القلب، وليس تماماً كما في الكتاب:
(اذهبْ إلى الطبيعةِ، أنتَ، هوَ، هيَ. يتحابان. وأنتَ وحدَك، تتحاب، وتعشقك الطبيعة.): التي أسميها (الفاتحة) لأنها مثل (بسم الله الرحمن الرحيم)، و(بسم الآب والابن والروح القدس)، سورة، مؤلفة من خمس آيات، تشرح الثالوث المقدس.
(بحثَ عنها كثيراً ولَمّا وجدها، احتار ماذا يفعل بها، فتركها تذهب. ثم عاد وبحث عنها كثيراً، ولَمّا وجدها، قال: يا إلهي، اجعلْ نظري كبيراً فيحويها، وحجري ماءً فيسقيها، طوِّقها بي كسجن، وطوِّقها بي كشكران، واكسرني يا إلهي عليها، كالصاعقة في البحر.): آه يا أنسي، الجميع يعلم أنك عندما وجدتها، للمرة الثانية، استجاب الله لدعواتك، وكسرك عليها كالصاعقة في البحر!؟.
13 ـ (إذا أنتِ شبيهتي، فلكِ أيضاً ما ينقصني. وإذا أنتِ نقيضي، فأنا هو من له صفات نقيضه…): إذن هو من نقائص وأضاد. ومن المحتم أنها، أنا، أنتَ، أن نكون هو. لأن لنا أيضاً نواقصه، ولأننا نقيضه الذي هو. من تأثري بهذه الآية! أ لم أقل إنه نبي؟ كتبت بدوري: (أكره من يشبهني، إنه يكشف عيوبي، التي عشت دهراً أحاول إخفاءها).
14 ـ (لم يعودوا، حين أقرأهم، يوقفونني على قدميّ: ساد، بودلير، بروتون، سارتر، كامو، نيتشه. ولا موسيقى بيتهوفن وفاغنر. كانوا يُنهضونني. اليوم أشعر أني أكثر يأساً، وفي الوقت نفسه أكثر قدرة ذاتية على القيام من دون مساعدة كتاب أو موسيقى.) مرة أخرى يمدح أنسي اليأس. وكأن ليس لديه سواه!. كونه أكثر يأساً صار يغنيه عن مساعدة كتب بودلير وبروتون، وموسيقى بيتهوفن وفاغنر، لينهض.
ما عاد بحاجة أحد.. فقد:
(عدت وحيداً كما أكون دائماً وأنا أموت)..
اللاذقية 18/2/2014
الشاعر النائم عاد إلى طفولته
مهى زراقط
هذه المرة، تغيّر السيارة وجهتها في الطريق إلى زيارة أنسي الحاج. عوض أن نصعد يميناً لدى الوصول إلى مستديرة «مدرسة الحكمة»، نلفّ الدواليب يساراً، ونتّجه إلى كنيسة المدرسة التي تعلّم فيها قبل أكثر من ستين عاماً. الراحل هو من طلب أن يصلّى على جثمانه في هذا المكان، رافضاً أن تُفتح له الصالونات الواسعة. بتواضعه المعروف، رفض أيضاً أن يتميّز جنّازه برقيم بطريركي، كما يروي المستشار الإعلامي لأبرشية بيروت المارونية جورج سعد.
«هو كان وجيهاً، لا يحتاج إلى رقيم بطريركي لكي يثبت موقعه. يكفي العجقة التي حصلت في الأشرفية اليوم لتعرفي حجم محبّيه». لم تكن هذه الطلبات مفاجئة بالنسبة إلى سعد، «فأنا أعرف تواضع الأستاذ أنسي، هو ربّانا». ولولا العلاقة التي كانت تربط أنسي الحاج بالمطران بولس مطر، لكان يمكن أي أب آخر أن يترأس القدّاس، «لكن سيادة المطران بولس مطر سيتلو الكلمة لأنه كان قريباً من الراحل. وهو إذا حكى عنه، فهو يحكي عن معرفة» يضيف سعد.
يدور هذا الحديث في الباحة الخارجية للكنيسة التي غصّ صالونها الصغير بالمعزّين. هنا، كانت الفرصة لكي يتلاقى أصدقاء أنسي الحاج، زملاؤه ومعارفه. ولم يكن لافتاً أن يضمّ الجمع أشخاصاً من مختلف الأعمار، تجد بينهم مجايلي أنسي الحاج، كما تجد الشباب الذين تعرّفوا إليه في «الأخبار». حضر وزير الثقافة روني عريجي ممثلاً الرؤساء الثلاثة، ووزير الإعلام رمزي جريج، ونقيب الصحافة محمد البعلبكي، ونقيب المحرّرين الياس عون، ونقيب الممثلين جان قسيس، والفنانون نضال الأشقر وماجدة الرومي وهبة القواس وجورج الصافي، والشاعر طلال حيدر، إضافة إلى عدد كبير من السياسيين والفنانين والكتاب والصحافيين. وقد وضع الوزير عريجي على نعش الراحل وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط الذي منحه رئيس الجمهورية ميشال سليمان للشاعر النائم بهدوء في صندوق خشبي، أحاطت به أكاليل الزهور البيضاء التي حمل أحدها توقيع فيروز تحت عبارة «وداعاً أنسي».
كلمة الوداع تكرّرت على ألسنة من أتوا لوداع أنسي الحاج. فقد كان هو محور معظم الأحاديث التي دارت في فضاء المكان. يسرد كثيرون ذكرياتهم معه، التي كان هو يذكّرهم بها، خصوصاً في حال كانت جميلاً أُسديَ إليه، ويرغب في الاعتراف به. أما تجربته في «الأخبار»، فقد مثّلت مادة لحوار ممتع مع زملاء في «النهار»، عرفوا وجهاً مختلفاً لرئيس تحريرهم السابق عن الذي عرفناه نحن في «الأخبار». حوار يستحق إضاءة منفصلة، لما قد يكشفه من اختلاف بين صحافة تسمي نفسها «كلاسيكية»، وأخرى تدّعي «كسر التقليدية». وقد لا تكون صدفة على الإطلاق أن يكون القاسم المشترك بين هاتين التجربتين: أنسي الحاج.
هذا الأمر لم يلتفت إليه المطران بولس مطر في عظته، أو من كتب تلك العظة، إذ خلت من أي إشارة إلى مشاركته في تأسيس «الأخبار»، وعمله فيها حتى رحيله، في إطار سرده لسيرة الفقيد مع الصحافة. هذا الإغفال أحزننا، نحن تلامذة أنسي الحاج وزملاءه، على الصعيد الشخصي. لكنه يفترض أن يُحزن أكثر الحريصين على تجربة الراحل المهنية واكتمالها. ونفترض أنه سيُحزن الحريصين على الاقتداء بأنسي الحاج الإنسان، المحبّ والصادق، الذي لم يعرف الزيف في حياته، كما جاء على لسان مطر نفسه: «نحن جميعاً مأخوذون بعمق التزامه الحقيقة والمحبة وكلاهما قبس من أنوار الله». لكن من استمع إلى عظة مطر تُلقى من على مذبح كنيسة، لم يشعر بأنها كانت مأخوذة بهذا الالتزام. فجاءت حياة أنسي الحاج الصحافية على الشكل الآتي: «… كان من المنتظر أن يبدأ حياته العملية في جريدة «النهار»، وأن يكمل الدرب فيها طويلاً قبل أن يطوف وحيداً في محراب الوجود طوافه الأخير… وكان له أن يسلك في العمل درب والده الصحافي الشهير الأستاذ لويس الحاج الذي رافق النهار منذ نشأتها على يد جبران تويني الأول، ومع عملاقها الفكري الأستاذ غسان رحمه الله، وصولاً إلى جبران شهيد الوطن الذي نزل إلى جحيم الحب الأعمق ليطلع منه متجلبباً حلّة بيضاء وقد غسلت بدم الحمل. وما من شك في أن علاقة خاصة نسجت بينه وبين غسان المفكر، لا لأن أنسي قد اعتنق الفلسفة النظرية أو العملية، بل لأن غسان كان هو أيضاً على مثاله محبّاً للفكر المتفلت من الكلمات والرامي إلى تذوّق الحقيقة بمكاشفة العشق لها والتوحد بها في نشوة الإيحاءات». وأضاف: «هكذا ندرك فرادة العمل الصحافي الذي اندرج فيه أنسي، فهو لم يبتغ منه خدمة الخبر السائر، ولو كان صحيحاً وبنّاءً، بل لأنه أراد من خلاله خدمة الإنسان في أدبياته وفي توقه إلى الثقافة الفضلى، فجمع بذلك بين الشعر الذي كاد أن يلهيه عن كل لاه، وبين الأدب الذي رأى فيه اكتمال الحقيقة وعرساً لها». وختم «في أسبوع الأبرار والصدّيقين، أي هذا الذي نحن فيه، ينتقل أنسي العزيز من الموت إلى الحياة. ولنا كلّ الرجاء في أنه سينضم إلى صفوفهم مصحوباً بشفاعة العذراء والقديسين، لأنه كان في دهره رجلاً صادقاً، ولا يمكن هذا الصدق إلا أن يصله بالله الذي هو الصدق كله. فأنسي لم يعرف الزيف في حياته ولا توسّم الوجهين ولا اللسانين. ولم يعتنق نرسيسية كان يكرهها حتى الأعماق، بل راح يتلمّس طريقه إلى الله عبر القيم الإنسانية الفضلى وجمالات الوجوه العاكسة بهاء خالقها ومرسلها إلى الوجود. وهو أراد أن يبني في الدنيا بيتاً من خيوط الحقيقة التي تقدر وحدها أن تحرّر. لذلك كنت تراه مع الناس بعيداً على قرب وقريباً على بعد، إلا عندما كان ينشده للنزاهة ساطعة فينحني لها إجلالاً ويرى نفسه أمامها عابدة لا معبودة، فليس من معبود إلا الله وحده. بهذه الروح يقرأ ترفّعه عن المناصب والمكاسب وميله إلى تواضع النفوس الكبيرة التي لا مكافأة لها إلا من ذاتها».
وبعد العظة وتقبّل التعازي، نقل جثمان أنسي الحاج إلى بلدته قيتولي الجزينية، حيث ووري في الثرى بعد إتمام مراسم قروية هادئة، وعظة لطيفة غلبت عليها استشهادات من كتابات الراحل.
تشييع بالدموع والأكاليل البيضاء
وسام كنعان
للموت مهابة وقداسة وصمت، لا يكسرها جميعها إلا المبدعون في رحيلهم. هذا بالضبط ما فعله الشاعر الكبير أنسي الحاج (1937 ــ 2014). خلال اليومين الماضيين، لم تهدأ المرثيات، التي كُتبت في مناسبة رحيله. أمس، عاشت بيروت يوماً غير عادي. في تمام الساعة الحادية عشرة، أتى الازدحام المروري في منطقة الأشرفية مبكراً على غير العادة، بسبب الصلاة على روح الراحل، وتأبينه في «كنيسة مار يوسف الحكمة».
هناك، أوصى الراحل بأن تكون الصلاة عليه على نحو متواضع، يشبه تفاصيل حياته، من دون أي مظاهر مبالغ فيها، حتى «خشب التابوت أراد أن يكون من النوعية العادية»، يخبرنا أحد المقربين منه، بينما تنهمك عائلته بتلقي التعازي، ويُشغل أصدقاؤه في غمرة حديث ذكريات طويل عن الراحل. في الفسحة السماوية للكنيسة، تجمهر عدد كبير من المثقفين والمبدعين والفنانين، من بينهم: ماجدة الرومي، وطلال حيدر، ورياض الريس، وعلوية صبح، ونضال الأشقر، ورندا الأسمر، وكارول عبود، وجيزيل خوري، ومارسيل غانم، وبول شاوول وآخرون. يتسيّد أسود الحداد المشهد، فيخترقه بياض أكاليل الورود، وبعضها نصبت عند أبواب الكنيسة على شكل صليب، كتب على أحدها اسم السيدة فيروز، مسبوقاً بكلمتين لا أكثر «أنسي وداعاً»، عسى أن تعوّض الحروف القليلة عن غياب صاحبة الصوت الملائكي. نلمح على أكاليل أخرى اسمي تمام سلام، وستريدا جعجع، ومسؤولين وسياسيين لبنانيين كثيرين. يعلو صوت التراتيل الكنسيّة، مكرّساً عمق اللحظات الجنائزية القاسية، قبل أن يتخللها تناوب قاطني الأبنية القديمة المحيطة بالكنيسة على إطلالتهم الفضولية من شرفات منازلهم، فيما تدور في ساحة الكنيسة همسات المشيّعين من الأصدقاء والمحبين. «العوض بسلامتكم» هو أقسى ما يمكن أن يقوله أصدقاؤه المثقفون، فليس من السهل الخوض في بحر من الأحداث، أو استحضار تفاصيل أيام خلت، أو الاسهاب في وصف المشاعر الحقيقية عند وداع حقبة كاملة من تاريخ لبنان الثقافي والإعلامي. طلال حيدر يرفض الحديث أولاً، ويبرر ذلك بحجم الحزن الكبير الذي يشعر به، لكنه يضيف: «لم نودعه بعد. أشعر بأنني بحاجة إلى أيام حتى أتمكن من الكلام بحرية، أو أتمكن من رثائه كما يستحق الرثاء. أما الآن، فما زلتُ تحت سطوة المشهد. نحن هنا أمام وداع من نوع خاص، لأنه كان شريكا ورفيق عمر. أنا حزين جداً ولا أجيد الكلام الآن». الحالة ذاتها تنسحب على الشاعرة والصحافية جمانة حداد، التي أسرعت منذ وصولها نحو المذبح وجلست في مواجهة النعش. وعندما همت بالرحيل، اقتربنا منها نتبادل التعازي، فطلبت أن نعذرها عن عدم الكلام «على الإطلاق، لا يمكنني أن أحكي شيئاً وتحديداً عن أنسي». المسرحية نضال الأشقر استمهلتنا وقتاً قصيراً، وسرعان ما عادت لتقول لنا: «أنسي الحاج لا يمكن أن يكون غياباً، ولا يمكن أن نحكي عنه كجزء من ماض، هو عابر المسافات والأيام والسنوات». وتضيف عن تجربته «محبته وتألقه وإنتاجه وإبداعه سوف تكون خميرة وسياج موهبة، فهو كما سميته عريس دائم سيبقى في عز عطائه، ولن يتمكن الموت ولا غيره من تغييبه». أما الناشر والكاتب رياض الريس، فقد فضّل أن يبتعد عن الإسهاب في الكلام ليحتفظ بمشاعره، لعله يكتبها لاحقاً، ويخبرنا أنه «كتب الكثير عن الفقيد، وجزء كبير مما كتب لم يكن في المستوى المطلوب، لكن ماذا يمكن أن يقال اليوم في هذه الدقائق العصيبة، سوى أن أعمدة الشعر تتهاوى واحداً تلو الآخر: يوسف الخال، ومحمود درويش، وجوزف حرب، وها هو أنسي الشاعر المتعدد الأوجه يلحق بهم. لذا لم يبق شعراء حقيقيون في الوطن العربي». بعد الصلاة، يستنكر الناشر اللبناني خطوة الرئيس ميشال سليمان بإيفاده وزير الثقافة روني عريجي ليقلد الراحل وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، ويسأل: «ماذا كانوا يفعلون عندما كان على قيد الحياة؟».
أما المخرج المسرحي موريس معلوف، فيقول لـ «الأخبار»: «الناس عرفوا أنسي شاعراً وأديباً وصحافياً، لكن لم يتح لغالبيتهم أن يتعرفوا إليه كمسرحي، برغم أنه ترجم نصوصاً، وفتح مجالاً لتسهيل اللغة المسرحية وتخليصها من جلافتها في بعض الأحيان». وعن تجربته معه، يضيف معلوف «كان لي شرف العمل معه في أول مسرحية له وكانت بعنوان «كوميديا الأخطاء» لشكسبير، قدمت في مهرجان «راشانا». بعدها أكملنا معه تجربة خاصة بحضور بروفات وتمارين وعروض مهمة. لذا فإنّ من المنصف القول إنّه كان صاحب فضل في نجاح الحركة المسرحية اللبنانية أداءً ونصاً». على بعد أمتار من المخرج المسرحي، تقف سيدة مصدومة تسحب سيجارتها وتشعلها على عجل وارتباك. نقترب منها لنكتشف أنها الروائية علوية صبح. نسألها عن شهادة بالراحل أنسي الحاج، فتصمت طويلاً ثم تنهمر دموعها وتقول كلمة واحدة «تعبانة». ربما هي الحالة المثلى لوداع قامة مثل أنسي الحاج، تعب ممزوج بالكثير من الدموع.
إكليل “حب” بين فيروز والشاعر أنسي الحاج
لندن- كمال قبيسي
بعض اللبنانيين يعلمون أن برعم حب أفلاطوني طاهرعميق نما واستمر في الماضي البعيد وفي الحاضر القريب بين فيروز والشاعر والكاتب اللبناني أنسي الحاج، الراحل الثلاثاء الماضي بسرطان في الكبد غيّبه عن الدنيا بعمر 77 سنة، كان في معظمها أسير حب بريء للمطربة التي يؤكدون بأنها بادلته المشاعر.
أمس الخميس ودّع لبنان أنسي الحاج بتأبينٍ حضره في بيروت أصدقاؤه ورفقاء دربه، إضافة لابنيه وأحفاده، مع أكاليل بالعشرات أرسلها من حزنوا على رحيله، إلا أن واحداً منها كان مختلفاً، وعكس الأسى الحزين بطريقة حملت معظم المشاركين بالتأبين الجنائزي إلى الوقوف للحظات أمامه ليقرأوا “أنسي وداعاً.. فيروز” وسط وروده البيضاء.
كان الإكليل بكلماته الثلاث، وهو الذي تنشر “العربية.نت” صورته التي تداولوها في لبنان وفي مواقع التواصل الاجتماعي، من الملهمة الدائمة للشاعر الذي تزوج في 1957 وأصبح أباً وأرملاً وجداً، إلا أنه بقي عاشقاً بالروح من القلب دائماً لفيروز طوال أكثر من 55 سنة.
في المقاعد الخلفية كي لا يراه أحد
آخر ما كتبه عنها كان في جريدة “الأخبار” يوم 20 ديسمبر الماضي
وللاختصار، فإن من يبحث عن “أنسي الحاج وفيروز” في خانة البحث بالإنترنت، سيعثر على كثير مما وجدته “العربية.نت” أيضا عن ذلك الحب الطاهر، لكن تبقى دائماً تفاصيل لا يدركها إلا المقربين.
ويبدو أن أنسي الحاج كان يلتقي بفيروز، يحمله إليها حب أفلاطوني صاف تماماً. وكان مدمناً على حضور حفلاتها يومياً حين تحييها، فيجلس في المقاعد الخلفية كي لا يراه أحد، وهناك يغيب وحده في عالم من الحب صنعه لنفسه، ومنه استمد شخصيتها كموحية أساسية لكتاباته.
“أرى الموضوع يكتبني عوض أن أكتبه”
كتب إليها طوال سنوات، وليس عنها أو لها، ما يبدو بوضوح بأنه نابع من قلبه حقيقة، ومما اختارته “العربية.نت” من كتاباته مع شيء من الاختصار يقول: “بعض الأصوات سفينة وبعضها شاطئ وبعضها منارة، وصوت فيروز هو السفينة والشاطئ والمنارة، هو الشعر والموسيقى والصوت، والأكثر من الشعر والموسيقى والصوت، حتى الموسيقى تغار منه”.
وكتب مرة: “.. وعندما أكتب عن فيروز أرى الموضوع يكتبني عوض أن أكتبه، ويملؤني إلى حد أضيع معه في خضم من المعاني والصور والأفكار، لا أعود أعرف كيف أبدأ ولا أعود أرغب أن أنتهي. وغالباً ما قيل عن كتاباتي عن فيروز إن فيها مبالغات، وأقسم بالله أن ما يراه البعض مبالغات ليست في الواقع غير شحنات لفظية صادقة”.
أحبها بإرهاب
وزير الثقافة اللبناني روني عريجي وضع “وسام الأرز الوطني” من رتبة ضابط على نعش أنسي الحاج، وبدا خلفه ابنا الشاعر لويس وندى
وأحد أهم مقالاته إلى فيروز، واحد كتبه بعنوان “أحبها بإرهاب” وفيه يقول: “في حياتنا لا مكان لفيروز، كل المكان هو لفيروز وحدها. ليكن للعلماء علم بالصوت وللخبراء معرفة، وليقولوا عن الجيِد والعاطل، أنا أركع أمام صوتها كالجائع أمام اللقمة، أحبه في جوعي حتى الشبع، وفي شبعي أحبه حتى الجوع”.
كتب أيضا: “أقول “صوت فيروز” وأقصد “فيروز” تلك المرأة اللامحدودة العطايا، التي ليس لجمالها نهاية، كلها بكاملها، متحركة وجامدة، كلها، بأصغر تفاصيلها. إني لا أعرف فنا غيرها، وأحبها بإرهاب، أي بالشكل الحقيقي الوحيد للحب”.
وبين ما كتب، يقول: “ليتني أستطيع أن ألمس صوتها، أن أحاصره وألتقطه كعصفور، كأيقونة، أن أكتنفه وأشربه وأكونه، أن أصير هو (..) إن ما يحدث لي تجاه صوتها ليس فعل السحر، إنه اجتياح، إنه فعل الاتحاد التام، عندما أسمعها أصبح إنسانا ناقصا صوته، أصبح بصوتها”.
عشرات كتبوا عن أنسي الحاج في الأيام الثلاثة الماضية، لكن أحدا لم يتذكر ما يسعده أكثر بعد رحيله، وهو أن يذكره بقصة حب طاهر عاشه وثابر عليه من قرن إلى قرن، وقد لا نتعرف إلى تفاصيله إلا في رواية تتحول ربما إلى مسلسل تلفزيوني.
أنا أنسي الحاج أريد العودة الى رأسي
عقل العويط
أريد رأسي.
لم يكن لأنسي الحاج من مطلبٍ سوى هذا المطلب، وقد كان مشتهاه الوحيد الدائم. وها، الآن، أنا أراه، من حيث هو، مستعيداً رأسه، هارباً به، مكلّلاً بغار أسراره وكلماته، ملغّزاً، شفّافاً، أبيض حرّاً، إلى آخر ما يمكن ان تحمله الحرية من معنىً.
الآن، يستلقي أنسي الحاج على الغيوم، بين النور والظلام، وقد تعانقتْ في صدره الحياةُ وأشباحُها، ومن رأسه إلى رأسه يرتمي، ليصير مكانه في تلك الأحضان الوسيطة، في يد المعجزة. جامعاً المتناقضات، متناقضات الواقع والكلمات معاً، النثر والشعر معاً، محقِّقاً برحيله المزلزِل، ما كان كتبه يوماً: في كلّ مرةٍ رميتُ نفسي من أعلى الجبل ليبتلعني الوادي، كانت الغيوم الوسيطة تستلقيني. العيون – وأنا أزيد الغيوم – هي أحضان المعجزة.
الآن فقط، في مقدور الشعر المطلق أن يتباهى بتجسداته، ومنها أن يكون أنسي الحاج على الغيوم، وبيننا، وأن يصير طعاماً، وبيننا، طعاماً للحبّ، وللعشّاق و… الكلمات، معاً وفي آنٍ واحد.
والآن، أكثر من كلّ كتابٍ، بل أكثر من أيّ وقتٍ مضى، ها هي وليمتُه تُقام، ويصير سرابُ العارف هذا، شعوباً لامتناهية من العشّاق، بل شعوباً مثلها من الأشعار، مستجاباً ما طلبه في مستهلّ ديوانه الخامس، بنبرة الخاشع المصلّي، لكن الآمِر أيضاً: “ليكن فيَّ جميع الشعراء لأن الوديعة أكبر من يديَّ”!
وإذا كان أنسي الحاج قد قال يوماً “لا تبحثوا عنّي في كلمة، لست في شيء”، فقوله ذاك ليس “صحيحاً”.
فقد “وصف” أنسي الحاج أين مرّ، وماذا رأى. ولم يكن في مقدور النفي أن ينفي، بل أن يحسم. وها هو يفعل.
أعرف أن أنسي الحاج لا يعرف “كيف” مرّ، وماذا رأى. أعرف أنه لا يعرف كيف ظلّ يحتمل الشعر، وكيف ظلّ يحتمله هذا الشعر. لكني أعرف أنه مرّ، ورأى. وأنا، بل نحن، نرى أين مرّ، وماذا رأى.
أعرف أن أنسي الحاج ليس وليد جيل بل “أنا الزوايا المختلفة، سلفاً، في ما بعد، من قديم الزمان والمستقبل./ منذ لحظات متّ، وقمت متّ، وقمت متّ، وقمت. أنا جميل”.
يستولي الذهول الشعري الماحق، وأنا أسأل: كيف يحتمل هذا الشاعر أين مرّ، وماذا رأى، وهو القائل “حين كنت ولداً/ كنت أسمع كالنائم وأرى/ ولمّا ما زلت ولداً/ تكدّس العالم في عينيّ”؟
أليس هو المستفهم “أيّ جلدٍ يستوعب هذه الروح؟”، هذه الروح التي تستلقي على جروحها وترى، بعيداً بعيداً عالم أحلامها يتحقق تحت سلطتها الوحيدة، أو لا يتحقق…؟”.
كيف لا أعرف، كيف لا نعرف، وهو القائل: “عشتم عواصفي وما بعدها، وستعيشون معي عواصفكم وهدوءكم. أحيا فيكم دون سلام ولا خطر عليّ. أموت مطمئناً وأقوم مطمئناً”.
وأنا، كيف لا أعرف، بل كيف، نحن الشعراء، لا نعرف، وهو الموقّع اسمه أدناه “أنا الموقّع امّي أدناه/ أسمع المطر ينزل/ جافاً على الاسفلت/ وممّا قلت الآن وقبل الآن/ لن تذكروا كلمة/ لكنّ فمي ارتوى قليلاً/ وهو يروي لمن يريد/ ماضي الأيام الآتية”؟
أليس هو الشاعر الذي كتب لنفسه؟ أليس هو القائل “كتبتُ لنفسي. كلّ كتاب لي هو لشخص واحد. المجد لله الذي أنعم عليّ بهذه القوة”؟
أليس هو الذي وقع على شوك الكلمات، من قلبه وقع كعصفور؟ أليس هو القائل: “وما لا يحدث أحدثتُه فحدث”؟
فكيف يحتمل أنسي الحاج، كيف يحتمل أن يكون الرجل الأمّ، وهو القائل “من كثرة الخبز أطعمت، ومن قطرة الماء غمرت، ومن الألف إلى الياء حملت./ أنا الرجل الأم”؟
والآن، إذ يهرب الشاعر برأسه، إلى حيث يعثر على النوم اللطيف، لَيشرّف هذا “الملحق” الذي أسّسه أنسي الحاج في أحد الأيام الذي كان فيها العالم جميلاً، أن “يردّ” إلى شاعر “لن”، و”الرأس المقطوع”، و”ماضي الأيام الآتية”، و”ماذا صنعتَ بالذهب ماذا فعلت بالوردة”، و”الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع”، و”خواتم”، و”كلمات”، أن يردّ إليه، لا رأسه المقطوع، بل رأسه مكلَّلاً بغار أسراره وكلماته، وأن يفسح له المكان، وهو دائماً له.
لا يسهر وحده بل أكثر من الكلمة وأكثر من القمر
شوقي أبي شقرا
-1-
أشعر بك في بهو الصراخ وفي فن الصياح، وفي مقولة الديك الذي يتطاول ويرتفع عنقه كلما دنا الفجر وتم الزفاف.
وأشعر بك كلما الليل جنّ وكلما أنت في مدارك، وكلما لك ذلك الحضور وذلك الاندفاع الى هنالك. الى مرمى الكلمة، والى حمامة الرموز. والى ذاتك في هبوبها من العدم، من القتام الصامد والغارق في قنينة النبيذ، في تلك الفتحة ولا ألذ. وفي أنك ضممت الجميع، وهم الأصدقاء والذين حواليك كانوا يطيرون ويسقط من ريشهم بعض الريش. وأنت تحفظ كل ذلك، وترتضي أن تكون لك المثابة الشديدة السياج والرفق والقاعدة وأن تكون لك الابتسامة وأوسع منها، وأن تكون لك الموهبة في النقد الصريح وفي أن تعمر السطور وأن تشيد المعاني موسيقى على موسيقى ولحناً على لحن.
وطالما، من العذوبة التي فيك، ومن الحدة وكأنها الخنجر في خصرك، رحت تلقط الرجاء ثم الرجاء، وانت على تقواك وعلى الجرن الذي فيه ماء القدّوس. وكنت، بين هذا الوقت الجلل وذلك الوقت الحائر، تطمع أن تذهب الى الغاية، غايتك في كونك الساعي الى الشعر بدءاً من النثر. والى أن تبعث الجمود من رصانته، وأن تعاتب من لا يكون كما أنت تكون حرّ الذؤابة وكما أنت تشاء أن يحصل الطائر على رزقه، وأن يحصل على الوقود الخفي والحي من خلال القصب ومن خلال الأغصان ومن خلال الحصاد.
وأصغي اليك وأدرك أن صمتك يزداد والأناء لا يسعك وتخرج منه لأنك لا تطيق الأمر، أمر أن تثبت الزهرة في مكانها، وأنت لا تفعل. بل حملت الأناء وحملت الزهرة الأبدية الى البيت، الى القصيدة التي تنتظرك وينتظرك الكوخ، ويرقب وصولك الصيادون. وحملت حبّة الحنطة التي تدخل في الثلم، وحملت في ما لديك من الأسباب، من الظواهر ومن العلامات، كتابك الآخر الى المدفأة والنار نار الشباب، نار الصبابة ونار التوق الى المستحيل، والى قربانة الإله.
-2-
سيضحك الليل، سنضحك نحن. ومعنا، شتى الظلام وخضم اللون وخضم الضوء المارد الذي ينبثق من أحوالنا، من عقولنا، كما من الشارع ومن الحانوت ومن السوق.
ومعنا أنسي، كلما انتهى العمل في الصحافة وفي أدراج الأسرار، أدراج القصائد، هو يختار ونحن نختار وأنا أختار. وننصرف الى الليل العميق العباءة، والرقيق القلب واللذيذ، إذ كله حلوى وغناء في ضرورة المقهى وفي ملعب السيارة المعلقة على الأسفار. ونأخذ أنفسنا كأنها الخيل والليل الذي نعود اليه الى خارج القرطاس والى أبعد من الضجة ومن الحياة الدارجة. ونروح لماماً وجزافاً الى الآراء والى النظرات نطرحها على الموضوع، على الكتاب، على البنين وعلى زينة الدنيا أي الكلمة التي نروضها وكأنما هي دائمة الوجود. ونلعب بها ونضع النقطة حيث ينبغي ونضع الفاصلة، ونضع الوردة في سباتنا، في العجب وفي الأرق، الأرق من الحجاب ومن الطرب. ونصل طوال الأيام، الى الأهم الأهم والى النشوة التي نريد ولا نحترق بها وانما نظل رماداً تحته الجمرة ونظل نتوارد وكأننا الطيور تطلب الماء وتطلب الغذاء من المستنقع الذي نجهل انه كان وأنه لا يفنى ولا يفنى الشعب الآتي من السماء.
-3-
ونضحك ثانيةً على الليل، كما سنبكي ونرتدّ الى الحياة وكيف هي قائمة، وكيف هي عاصفة ولو أصابنا الهدوء وحلّ الروح القدس على الرسل ونحن من هذا القبيل ومن القبيلة التي تعطش نحو الأزل من جراء الخيال ومن جراء النعمة التي بها نبقى، وبها يكون الشاعر ويكون البارئ ويكون أنسي أحد المختارين في الفندق الرحب، وفي التراث الذي يدعو اليه، الى حضنه الضيق بعض النجباء، وبعض الموهوبين. وهو واحد من هؤلاء ومن القلة. ومن السرب الجميل وعيناه طالما نظرت الى الغد، وطالما كان التحديق الى المدى، انطلاقاً من الجريدة ومن مجلّة “شعر” ومن السنوات السمان حيث النبوءة اللطيفة كانت، وحيث ارتدينا السيف والقلم.
-4-
ونلجأ الى الليل لنبكي الآن، والى القمر الذي ايضاً يبكي الآن على الذي سامره مديداً والذي ساهره مديداً، والذي كان أكثر منه يفعل ويسهر في ايوانه. وكان النهار هو الأرجوحة، هو الغياب القصير. وكان أنسي كل ذلك، وكان شاعر النثر وكان الحنين أبداً لديه، الى واحات الأدب، الى الحبّ والمحبة، الى الذي هو فوق، والى التي هي همسات، والى الورقة حيث، على الأمد المتاح وعلى طبق من الرعشة ومن ذرّات الفلسفة، انتقى وأكل وكتب. وإذا الكتابة عنده خضراء القوام ومثقلة بالخطر الجمالي وفيها الخشونة كما الحرير.
… وأكثر من الكلمة، من هذه العاشقة وهذه الطفلة، كان يسهر لها وعليها ما عدا الملاطفة والمؤانسة. وله تلك الهجمة على كونها ايضاً هي الأم وهي التي، تحت يديه، تحت قلمه، تنتابها الرعشة، ولا يخجل من جسدها إذ يجسدها، وإذ يضعها في الوظيفة اللائقة. ودائماً هو في موضع المراودة وموضع الشفقة وموضع الحنان وأن ينسكب تحناناً ويهزّها كأنها الشجرة وهي في الاستجابة وفي أنها الخطيبة الأزلية، ويفعل هو ما يفعل العشّاق أمثاله، وتنساب هي من المهجة ومن الأعماق. وكان الذي نجح في أن يخطفها من الأبجدية وأن يركع لها وأن يجأر وأن يزأر وأن يخدم الكاهنة القدّوسة وأن يشرب كلاهما كأس الملائكة وكأس التراث وكأس الوطن الذي عمل له وجهد له وامتدت الآية خلف الآية.
… بل هو، في نمط له وسلوك خاص وحميم، جعل القمر يغار، والعاشقة تغار، ومعظم القوم غيارى.
لأنه كان يسبق القمر الى الليل، والى أن يعانق الساعات السوداء، والى أن ينسج الغلالة والمريول والقصيدة. ولا سيما هو، في ضروب حركته وفي أفانين لغته بلغ ما بلغ من الشغف. وبلغ الليل الذي صار رفيقه وخادمه يهبط مسرعاً من غرفته العمياء الى ضوء غرفته، مبلغه المطلق وحيث هم يندرون من يتمكنون من الجاذبية في سطوره وفي عقله الذكي وفي أنه أحرز الحرية وأحرز القصبة وأحرز الدرع والرمح فارساً من القرون الجديدة.
ولا ينتهي الشغف ولا ذلك الموقف موقف الحبّ من قبله نحو الآخرين، ومن ذلك الغضب ومن صفات الاعتراف وأن يبوح بما ربما عدّ أساءة أو ذنباً من كتلة الذنوب.
وما غاب عنه أنه بين عذاب وملهاة وبين هوى وهوى، وبين رسالة ورسولة، هو يلبث وحده طوال الوقت الطويل وطوال الكتابة الغزيرة.
ويلبث في جفوننا ونراه كأنه الفلاح أو كأنه التفاحة، وكأنه قادم في الآونة الملهمة والخصبة وليس عنده سوى الأريكة والجودة، سوى أريكة الارتياح، سوى الحلم بالألوهة وسوى الصلاة في معبد الصمت. وسوى النجاة حاملاً كتابه والفاكهة التي لا تغادره وهي التي غرسها في أرضه المشتاقة، في أرضه حيث ينام الأتراب وجماعات السلف والخلف، وحيث ينضم الى القافلة المتينة. الى الذين يحاربون الجهل ويزاولون المنطق. والذين يهبّون من الرقاد كلما رنّ جرس الملكوت وكلما تزلجت الأقلام المجيدة من الألف العظمى الى الياء الكبرى والى الأقصى القصيّ أكثر من عمارة الدهر ومن بساتين الداهرين.
وكما نكتب ولا نستفيق من السبات، سبات الحرفة، سنجعل الأمر أقوى وأصلب، ونطلع بالصخرة، هذه المرة، ولا تهمّنا الاسطورة، وهو أيضاً الى مجلسها الأكيد على رأس التلة.
في ضوء هذه الشعلة نهضنا
خالدة سعيد
أنسي الحاج رائد الينابيع، شباب الشعر وعنفوانه، الشعلة التي أضاءت جيلنا ولم تطفئها رياح العنف ولا إجحاف العمل، ولن يطفئها الموت. شعلة ستبقى لمن يكمل طريق الحرية والإبداع.
مثّل أنسي الحاج فتوّةَ الشغف والرهان على الشعر طليقاً متألِّقاً طالعاً من الأعماق، حاملاً للرؤى، متحرّراً من الغايات المباشرة. مثّل الرهان على الكلمة الجريئة الصادقة المجرّدة، وعلى الانخراط في كل طريق قِبلتُه القضايا العليا.
إنّه الشاعر الطليعيّ الذي عاش اللقاء الرائع للثلاثيّ الإنساني الحضاريّ الأعلى: الحرية والإبداع والمحبّة، ثلاثيّ الإنسان في حضوره الأبهى. وهو الشاعر المتمرّد الذي سيبقى في أفقنا الروحيّ والثقافيّ.
تقدّم أنسي الحاج بين طليعة مَن رسموا ملامح التاريخ التحرريّ الإبداعي في زمانه. مثّل التجديد والتألّق في الشعر، والطليعية في الفكر، وصوت الحقّ في القضايا. وكان الصديق الوفيّ والمثقّف المبدئيّ الإنسانيّ وحليف كلّ صاحب قضية.
الزمن أكسبه النضج من دون أن يسلبه الفتوّة والجدّة والإيمان بالأجيال الجديدة، وحتى بمستقبل أكثر إنسانيّة. تحرّك فوق صراطٍ ثقافيّ اجتماعيّ ـ سياسيّ، وكان في مقدمة الذين رسموا ملامح مرحلة متوثّبة، طامحة، متطلّعة، وإنسانيّة، وبين طليعة الذين رسموا تاريخ التجدّد الإبداعيّ العربيّ في القرن العشرين. ما عرفه إنسان إلا احتفظ منه بشعاع.
خلال ستين سنة لم تبدر منه لحظة تنازل أو صمت أو مهادنة. ما تجاهل أحداً ولا استهان بأحد. لكنه لم يساوم ولا عرف المحاباة. وكان الغاضب الحكيم إذا غضب، والشاعر المرهف المحلّق إذا أعجب أو افتتن.
خلال ستين سنة في الصحافة الأدبية، كان المبادر الكريم، بل السبّاق لاكتشاف المواهب أو تكريم المعروف منها. الصديق الوفيّ والمبدئيّ، الإنسانيّ وصوت التجدّد.
لا أحد يكتب اليوم كما كتب جبران أو طه حسين. ولكن ليس بين المستنيرين مَن لا ينتمي إلى هذا أو ذاك، وإلى الأفق الذي افتتحه كلٌّ منهما. في هذا المعنى، نحن أبناء أنسي الحاج ورعيله، رجاء أن نليق بذلك الصدق وذلك الوهج والنبض وتلك الرؤيا النفّاذة العالية المتجاوزة.
من زوربا البعلبكي
طلال حيدر
22 شباط 2014
شو باك ما عم تردّ؟
بدوِّر عليك ما بلاقيكْ
بتضلّك تقلّي سمِّعني
اسماع
أوّل ما شفت الروح
خمّنت الخريف
بس علّق تيابو الهوا بين القصب قالوا حفيف
وبس رفّ قلبي ما حدا سمع الرفيف؟!
متل الدني إنتَ غزالة سارحه ونوما خفيف
منديل الغطيطة عَ ريف العين
عالي وعم يلوّح لتاني ريف
عيونَك فِيُن ريحة شتي
وبمراية الدمع
شفت الطقس كيف
مَ دامها حلوه
بكل نهر المي
سألّي البحر جاب الملح من وين؟!
سألت الدمع قلّي سآل العين…
خلّو الشتي بالغيم
بلكي تأخّرو الرعيان
بس يوصل الصوت
بتخبّركن الوديان
باقي على وجّ الصبح من الليل يلّي كان
متل ما بيبقى من البنّ عَ الفنجان
والوقت قدّ ما ركض
رح يلهتو الغزلان
يمكن تكون مدوّره هَ الأرض
عَ قدّ الزمان.
صداقته أن تكون لك حصّة من نُبْل النفْس والذكاء الإلهي
عبد القادر الجنابي
كان أنسي الحاج أكبر مني سناً وتجربةً، حين التقيتُه في باريس أواخر السبعينات. تعرفتُ، أولا، إلى كتاباته في جو الستينات العراقية، وفي ظروف اعتبرها مهمة في حياتي؛ ظروف صراعات بين قصيدة حديثة وقصيدة أسيرة للتقليد. وكان عليك كمبتدئ أن تحدد موقفك، والشعور الحدسي هو الوسيلة الأولى للاختيار. كان هناك، وكانوا كثيرين آنذاك، مَن يعادي أنسي الحاج لأنه يكتب قصائد نثر، أي قصائد تستقي وزنها من إيقاعات الشاعر نفسه، وليس من إيقاعات مرسومة مسبقاً يكتب هؤلاء عادة، وفقها. فوجدتُ نفسي، أنا الذي لم يكتب بعد شعراً، أميل إلى أنسي الحاج أكثر مما إلى شعراء التفعيلة كباراً وصغاراً. وهكذا، بات، قبل أن ألتقيه شخصياً، أحد المكوَّنات الأولى للثقافة النقدية التي ستكون سلاحي الحقيقي في عالم الكتابة: ثقافة التكوّن الفرداني المستقل والحرّ بكل معنى الكلمة.
تعرفتُ إليه في مكتب “النهار العربي الدولي” في أحد أزقة الشانزيليزيه، بواسطة الشاعر الراحل عصام محفوظ. بعدها، بتنا- وكلّ واحد منا كان يشعر الشعور نفسه بأنّ “صداقة حقيقية تشبه ثمرة بدأت تنمو بيننا ببطء” (ارسطو)- نلتقي، تقريباً، كلَّ يوم، أو بالأحرى كلّ ليلة، أي عندما ينتهي من عمله في “النهار العربي والدولي”، فنتقاسم رغيف الوقت ليلاً تحت أضواء المصابيح وتباشير الفجر، نثرثر أفكاراً في شتى الأمور، نتبادل الآراء في هذا الشخص أو ذاك الموضوع. وعندما نفترق على أمل أن نلتقي غداً، كان كلّ منّا يشعر بأنه تقدّم خطوةً في أعماق صداقة واضحة الأهداف: “لا تمشِ ورائي، فقد لا أقود؛ لا تمشِ أمامي، فقد لا اتبع. امشِ فقط بجانبي وكنْ صديقا” (ألبر كامو)! ذلك هو ألف صداقة الحاج وباؤها.
إنّ الشيء الذي لاحظته في لقاءاتنا هذه أنها كانت مبنية على الندّ للند، تالياً كانت تمنحني قوّةً وشعوراً بفردانيّة متحرّرة. لم يُشعرني على الإطلاق بأنه أكبر وأهمّ، وإنما بالمستوى نفسه. كان يفضّل أن يسمعني أكثر مما أسمعه. وعندما كان يتكلّم، كان كلامه خالياً من نبرة الوصايا الأبوية. لم أصدّق نفسي أني بصحبة شاعر له مكان في الشمس، وأنا لا أزال أنسج أول خيوطها… هذه الصداقة التي أشعر بوهجها إلى اليوم، لم أجدها مع آخرين، فمعهم، رأيت العكس؛ رأيت صداقات ملؤها، في أغلب الأوقات، الغَيْرة والصغارة… بعضها مجرد مسايرات، والآخر ظلَّ معلّقا من حبلٍ واهٍ في سرداب الذكريات.
كان كلُّ لقاء معه ينتهي فعلاً، لا أقصد بقطيعة أو بحادث، وإنما أقصد: يتمّ، يقطع مداه، ويُنجَز… ذلك لأنه على الصداقة، أن تتجنب التكرار، أن تكون دوماً للمرة الأولى… غداً أو بعد غد سيكون لقاء آخر، جديداً وكأننا نلتقي “أوّل مرّة”، حتى المضمون يتغيّر ويأخذ شكلاً جديداً، والصمت يحفر صمتاً آخر. هكذا يجري النهر نحو أعاليه. فالصديق الحقيقي لا تختاره، واللقاء به ليس مسألة مصادفة أو إعجاب، وإنما مسألة جوهرية تتعلق بمصيرك. إنه مكتوب عليك. لم تكن صداقة أنسي الحاج كتلك التي نتعلمها في المدرسة بوعظٍ جافّ، وإنما كانت الإحساس بتصبّب العرَق وكأن يداً تنتشلك من غرقٍ ما! كلّ الطرق التي قررتُ أن أسلكها في مطلع تجربتي، كانت تؤدي إلى صداقته. لا يمكن لتجربة شعرية أن تكتمل من دون أن تعيش صداقة عميقة مع ندٍّ لك أو مع رائد. وكان أنسي الحاج الاثنين معاً.
هناك من يلجأ إلى السحر، والآخر إلى الشعر، لكي يُظهر أفضل ما لديه… أما أنا فكنت ألجأ إلى أصدقائي بصيغة المفرد: أنسي الحاج، آخر المسيحيين العظماء الذين أناروا العربية بتراثٍ صافٍ وحرّ على أمل أن تصير هذه اللغة إلى معنى محدد، أي أن تقول شيئاً جوهرياً، تالياً أن تُحدث سلوكاً اجتماعياً متطوراً… لا أن تبقى مجرد فقاعة، انفجارُها لا يقدّم ولا يؤخّر شيئاً.
أن يكون أنسي الحاج صديقاً لك، يعني أن تكون لك حصّة من نُبْل النفْس والذكاء الإلهي، أي شيء من طفولة العالم. لقد ساعدتني صداقته (وهي لا تعني بالنسبة إليَّ على المستوى الشخصي فقط، وإنما خصوصاً على المستوى الكتابي) أن أنظر إلى الأشياء بحبّ متسامح. لقد دهشتُ عندما أخبرني كيف أنه كتب عن شاعر أصدر ديواناً معظمه انتحال من “الرسولة بشعرها الطويل…”، مقالاً يمدح فيه هذا الديوان ويبارك مؤلّفه… على عكس أي شاعر آخر. نحن المسلمين، لا نعرف هذا…لأن هذا، بكل بساطة، مبدأ مسيحيّ عميق، ينمّ عن أخلاق عالية.
أنسي الحاج، لربّما، هو الشاعر العربي الوحيد الذي لم يحاول أن ينتفع– بل لم يفكّر في هذا البتة– من لقائه مع الكتّاب والشعراء الفرنسيين الذين كان يتعرّف إليهم من خلالي أو من خلال فينوس خوري غاتا، لترجمة أشعاره ونشرها… وإنما كان يكتفي بالتعرف بهم والإصغاء إليهم والنقاش معهم… وأحيانا كان يهرب. نعم! إننا أمام كبرياء العرّافين، وليس أمام جمهرة الشعراء العرب، خصوصاً “الكبار” منهم، الذين، في أيّ لقاء كان مع أيّ كان، لا يفكرون سوى: إلى أيّ مدى يمكن الانتفاع من هذا الجالس أمامهم، وليس بشيء آخر قط.
قبل ربع قرن، حاولتُ أن ألخص أنسي الحاج كصديق وكإنسان على نحو لا يفصل بين هاتين الصفتين. فكانت النتيجة قصيدة نثر شبه هرمسية نشرتها في ديواني “حياة ما بعد الياء” تحت عنوان “سراب العارف”، وهو الاسم الذي كان يوقّع به أنسي الحاج معظم مقالاته في “النهار” بين 1976 و1980، وها هي كاملة:
سراب العارف
إذا حاقت بك كتلةُ الضوء، اصعد الجبل، اعتل كلَّ شيءٍ، الجلامدَ الجرداء والسارحين أنبياءَ فوق الشعوب وذراهم العاليات، فكأنك سماءٌ تمتد فوق قباب الخطب ونوافل الكلام، ووميض أشبه بانعكاس يَنْسرِب من مرآة الذات، يبترق شاشة الذاكرة حيث تعتركُ الأفكار، السنوات؛ حيث حاضر يتنفّس الصُّعداء. انه مسلكٌ يزفر بالضُحائيين على الطريق، ريحٌ من الشمال يذهب الجنوبُ أدراجها، اِصعد درجةً فدرجة، حتى تبلغ باباً فُتح مصراعُه على مستغرقٍ في التفكير بماضي الأيام الآتية. ستراه جالساً تتماوجُ فيه انهارٌ من الغبطة تغرف منها بكلتا يديك قبضةَ ماء، وأنت محمول على أجنحة النظر إلى ابعد الأفاق، إلى برج الأسد ذاك… تجده منسلخا عن ذاته انصهاراً بتيك الذات الأخرى: المرأةُ، مِخدع اللاتناهي، محبّة تشيع في كل شيء وفي كل موجود…. تجده يقتضي من تذاوت هذا الاختلاف وليمةً للجميع في مأدبة المطلق. فالأفق سطرٌ في راحة الواحدة الأحد. إليك، إذا، بـ”كلمات كلمات كلمات”، بل بسُلّم يحملُك إلى سدرة ألـ “لن” أبدا حيث الصورة فكرةٌ تفكّر وها هي الذاكرة أنقاض. ما أجملَ حضوره! من منّا لم يرَه فوق مدارج الأحداث، يتقفّى في أحشاء الحرب الأهلية عدواً أزرقَ لا أعداء باهتين، خواتمَ رقدت طويلاً في باطن الأرض تلقّت غزير الأسرار، إذ تشرّبت بالمطر، السماد وما امتزج بالأرض من رميم الطير وأشلاء الكلام. اِصعدْ. وما إن تتراءى المعرفة، حتى يتثألل سرابٌ حواليك. لألاؤه يطوف بالكلم مسجدَ “الرأس المقطوع”. جوار النطفة، فوق أغصان الطلح العالية، في غرف الحسّ المشرعة النوافذ، اِصعد، إذا حاقت بك كتلةُ الضوء من كلِّ هذه الينابيع، درجةً درجةً، صوبه، تأبّطه، طر به عَبْر المدن والقارات، هناك. أمامك، فيك، بك، في بساتين النوم، انّه تبرُ هذا الدهر وفضّة المكان.
يلتهم جسدَه ويحلم بامرأة تمرّ فوق الجبل وتنحني
ألفراد الخوري
لا يُذكَر اسم أنسي الحاج إلاّ تُستجلَب معه كلماتٌ مثل التمرّد والرفض واللعنة والعزلة والجنون والسورياليّة وغيرها من التي رافقت تجربته، وتردّدت حتّى أصبحت من الكليشيهات المفرغة من معانيها ودلالاتها. سنتوقّف عند هذه الكلمات-المحاور في تجربته، التي تمتدّ على أكثر من نصف قرن، محاولين أن نعيدها إلى إطارها الذي يتعيّن بنصوص الحاج، الشعريّة والنثريّة، منذ “لن” حتّى “خواتم”.
لم يأتِ أنسي الحاج من جهة الطرب، لم يطلع من كاتدرائيّة الجزالة والجماليّة المهادِنة، ولم يمتطِ فرس البلاغة البيضاء. لم تفتنه جدليّة “الموت والبعث”، الثيمة التي طبعت المرحلةَ آنذاك وهيمنت على روّادها. لم يكن لكتاب أنطون سعادة “الصراع الفكري في الأدب السوري” (1943) عليه ذلك التأثير الذي مارسه على شعراء حداثويّين آخرين، كخليل حاوي وأدونيس وغيرهما. كذلك، لم يكن لإليوت وملحمته “الأرض الخراب” في الحاج تلك البصمة التي تركاها في شعراء آخرين. لم يكتب الحاج بوعي المثقّفين واستعلائهم، بل كتب، دائماً وأبداً، بنقاء الأولاد واستهتارهم، بشغف المراهقين وتمرّدهم، بجنون العشّاق ويأسهم. لم يتبنَّ خطاباً إيديولوجيّاً متقوقعاً. لم يتّخذ موقفاً سياسيّاً مباشراً. لم نعرف هل هو يمينيّ أم يساريّ. كان مباغتاً هنا وهناك. كان حالةً عصيّة وغريبة بالنسبة إلى كلّ الإيديولوجيّين والمنقسمين، الغارقين في الواقعيّة البليدة. وفيما اصطفَّ المتخندقون في خنادقهم، كان هو وحيداً، في غرفةٍ منكوبة، يلتهم جسده ويحلم بامرأة تمرّ فوق الجبل وتنحني. تجربتُه هربٌ وانتظار، إقامة في المستقبل، تمسُّكٌ بالحلم والجنون والذاتيّة والهرطَقَة المتحرّرة من عقدة الرسميّ والشرعيّ. هكذا شكّل أنسي الحاج ظاهرةً مغايرة في تاريخنا الأدبيّ، ومعضلةً بالنسبة إلى كثيرٍ من النقّاد، الذين إمّا لم يتقبّلوه فشتموه، وإمّا تقبّلوه لكن بشرط أن ينزعوا عنه مغايرته، أن يعيدوه إلى طريق الخير، عبر البحث عن فصامٍ ما ضمن تجربته. من الأقوال الطريفة في هذا المجال، قولٌ لعاصم الجنديّ: “إنّ الناقد العاديّ الذي تعوّد المقاييس التي هي غالباً جاهزةٌ في قناني رفوف صيدليّة النقد الغبراء، يستحيل عليه أن يكتب شيئاً عن أنسي، سوى الشتيمة. وأنا بدوري سأشتمه”.
شعريّة الرفض
من أولى المقالات الجديّة التي تناولت الشعر الحديث، مقالةٌ لخالدة سعيد نُشرت في العام 1961 في العدد التاسع عشر من مجلّة “شعر”، عنوانها “بوادر الرفض في الشعر العربي الحديث”. تقسم الكاتبة الرفضَ عند شعراء الحداثة أربعةَ أنواع، وتضع أنسي الحاج وحيداً تحت راية “الرفض العدميّ اليائس”: “الرفض الذي لا يأمل، لا يعانق، لا يستسلم، لا يبحث عن حلّ”. فما يميّز الرفض عند الحاج من الرفض عند غيره، بحسبها، “هو أنّ هؤلاء يواجهون العالم وهم كلٌّ متّحد، أمّا هو فيقف على حافّته منشطرَ الذات”. وقف الشاعرُ في “لن” (1960) ضدّ العالم أجمع، مستمطراً الغضب، مستنزلاً اللعنات، ورافضاً الرحمة والتقريظ والمساومات: “لا توزّعوا حرارتكم عليّ تُغيروا مثل القيء تُوَقّعوا خُطاكم في ضميريَ كالشهادة”.
قد يقول قائلٌ إنّ مجموعة “لن”، وتالياً كلام خالدة سعيد، قد تجاوزهما الزمن. فالحاج قد ارتدّ، وهدأ غضبُه، ولانت عبارته، وتصفّت لغته، وخرج من عزلته ليصالح العالم (فأصبحت “لن” ميناءً مهجوراً أو صفحةً طُويتْ)، وذلك بدءاً من مجموعته الثالثة “ماضي الأيّام الآتية” (1965)، وتتويجاً بقصيدة “الرسولة بشعرها الطويل حتّى الينابيع” (1975). وقد يكون في ذلك قسطٌ من الصحّة. لكنّ من يتتبّع تجربة الحاج منذ بداياتها، متلمّساً مفاصلها ودوائرها، أمواجها وارتداداتها، تمرُّدها واستكانتها، سطوحها وأعماقها، يكتشف أنّ الحاج لم يتخلَّ عن رفضه وتمرُّده، ولم يرضَ لحظةً أن يتنازل للعالم عن أحلامه وهواجسه ووساوسه وطموحاته. عزلته، بمعنى ما، لم تنكسر، فهو لا يزال، في “ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلتَ بالوردة” (1970)، ينظر إلى الخارج من ثقب الباب نفسه، كما كان يفعل في “لن”: “الناس طيّبون من نافذة إلى نافذة./ الحياة حرّة من ثقب الباب”. لكنّ تعامل الشاعر مع عزلته هو ما طرأ عليه تغيّرٌ، وذلك بتدخّلٍ باهر ومفاجئ وجامح لعنصر أساسيّ في تجربته، احتلّه كبحرٍ وسكنه كهاوية: الحبيبة. فالشاعر الذي قال في “لن”، حادساً بما سيجيء: “على أصفى أراضيكم أشكُّ يأسي. وغداً تقولون: أعماه شعرُها الطويل! والليلة أفضح باطلكم”، رأيناه، في “الرسولة”، يعانق حبيبته، ليقف، وإيّاها هذه المرّة، في وجه العالم مجدّداً، رافضاً أن يحمل هاويته ويرفع عينيه، إلاّ بعد أن تمرّ الحبيبة فيتحرّر العالم على يدَيها: “والتي تُحرّرني وهي المكبّلة بأهلها وشعبها/ تحرّر العالم/ والتي تلمسني أنا المعتَّق في الخطيئة نعمتُها/ تلمس نعمتُها العالم”.
زحزحة حدود الواقع
حين مرّت الحبيبة على العالم إذاً، تغيّر وجهُ العالم. فالحلم بتغيير العالم هو المحرّك الرئيسيّ للرفض عند أنسي الحاج، الذي لم يتوقّف عن المطالبة بـ”حقّ الإنسان أن يعيش على قياس أحلامه”. لذلك نجده رافضاً كلّ ما هو دون هذا الحلم الشاهق. ذلك لا يشفي غليل الحاج بتحقيق تغييرٍ ما “في” الواقع، وإنّما بتغيير الواقع نفسه. ولن يتمّ ذلك طبعاً إلاّ “عن طريق إخلال متمادٍ، هائل، واعٍ، بجميع الحواس”، وفق “وصفة” رامبو الشهيرة في رسالتَيه إلى إزامبار ودوموني عام 1871، اللتَين ستُعرَفان في ذاكرة الأجيال اللاحقة بـ”رسالتَي الرائي”. حلمُ رامبو هذا بـ”تغيير الحياة” استعاده السورياليّون في أوائل القرن العشرين، وقرنوه بحلم ماركس “تغيير العالم”، ليشكّل هذان الحلمان (هما، بحسب بروتون، حلمٌ واحد في النهاية) ركيزتَي الثورة السورياليّة.
أنسي الحاج، كما السورياليّون، يرفض واقعيّة العالم، يضيق بالأسوار والحدود والأوزان والتقاليد “العريقة الجذور في السخف”، يضيق بالمنطق والاتّساق والتسلسل الرتيب، يخاف، يختنق، يحترق تحت جلده، يريد أن يخرج من هذا الصندوق، من هذا “القبو الدهنيّ”.
رأيناه يجيء من جهة التخريب والنفي والهدم والهلوَسَة والتشويش واللاوعي والحلم والعَصَب والتوتّر والقهقهة. رأيناه يطلع من مخيّلةٍ لا يحدُّ شيءٌ من شبقها وعنفها وانفلاتها وجنونها وجنوحها: “نزلتُ وانحنيتُ على الأرض/ قرّرت عقرها بمخيّلتي”، يقول في “لن”. ويقول في قصيدة “للدفء” الشهيرة: “عوض أن تُقبل من أمّكَ تزوّجْها./ الأحرف تتلاحق. عوض ذلك يجب أن تتداخل. الصمت يشبه حروفاً يسكن يركب بعضها بعضاً بالتصاق تحت غارة”.
الطريق إلى هذا التحويل يمرّ بالكلمة، لكن ليس أيّ كلمة. إنّها الكلمة المجلودة، المعذَّبة، المفتوك بها، المُهلَكَة الهالكة، كما عند كافكا وآرتو. يقول في مجموعته الأولى: “أردتُ نعمة القدرة على القتل لأفتكَ بالكلمات من فجرها إلى أبدها”. ويعلن في قصيدة “المهرّج” من مجموعة “الرأس المقطوع” (1963): “نبشتُ القبور وحفّار الكلمة بثأر عقلي!” أمام هذا الطموح الباسق، لا مفرّ من الخيبة، تجيء مدوّيةً لئيمة: “من متجر السحر رجعتُ إلى القفر لأنسلخ./ ظالمٌ حضورُك في لياليَّ/ ظالم طموحي إليكِ/ أبحثُ عن ضحية عذراء همهمةً طائشة لا أجد”. فالحاج كان يُفاجأ من أنّ كلماته وقصائده، “رغم نشرها في مجلّة أسبوعيّة رائجة، لم تسبّب نتيجة، لم تغيّر شيئاً!”، وظلَّ يشعر أنّ ما كان يتوقّعه لم يحدث. لكنّ الخيبة لم تكن إلاّ لتزيده تمسُّكاً بالحلم ورغبةً في تحقيقه.
ملاك الليل والنهار
رأى رينه حبشي، في محاضرةٍ له عنوانها “بحث وجيز للشيطان في الشعر”، ألقاها في “الندوة اللبنانيّة” عام 1957، أنّ رامبو كان ملاكاً للنهار وملاكاً للّيل في الوقت نفسه، يتأرجح بين القمم واللجج، بين اللعنة والخلاص، بين الشهوانيّة والنورانيّة، واعتبر أنّ كلوديل كان محقّاً عندما وصف صاحب “الإشراقات” بأنّه “صوفيّ على هيئة وحش”. هكذا أنسي الحاج: شيطان أبيض، ملاك أسود، نفْسُه بيضاء برغم الشرّ، وهو “هائم في الطهارة والنقاء وفي الرذيلة والتهتّك”. يقول في قصيدة “المهرّج”: “حنجرتي الشياهُ الضالّة رمادُ المراثي والمزامير شَعري. آكل القنديل أنفخ الشبح. أتسطّح على روابي الكلمة”.
يرفض الحاج التجزؤات الأخلاقيّة والدينيّة والثقافويّة التي تشيّد أسواراً بين الخير والشرّ، بين الروح والجسد، بين الجنس والعفاف، بين الطهارة والشهوة، حائلةً بذلك دون تحقيق الإنسان رغبته وإنسانيّته بالصورة الأكثر امتلاءً واكتمالاً وتوهّجاً. من هذه الناحية، يمكن اعتباره سورياليّاً بامتياز، لأنّ “السورياليّة، كما يقول جـ. هـ. ماثيوز، تحارب صورةً صنعها المجتمع للعالم وللذات، وتحثّ على معارضة القوى التي تقمع الرغبة وتحوّلها ضمن قنوات مقبولة اجتماعيّاً”. ظلّ الشاعر على رفضه هذا، منذ “لن”، حيث غلب العنفُ والسخط، حتّى “الرسولة”، حيث غلبت الرقّة. ظلّ يبحث عن كلمةٍ تشفي، عن نقطةٍ عليا تذوب فيها كلّ هذه التناقضات. يقول في “الرأس المقطوع”: “أطاردُ هذا الحبّ/ أطارد هذا الحبّ/ مع السماء لي زوج كلام! ستنزاحين لأنّي أعرف عقولهم – غيّرتُ نعل الشرّ”. هذه المطاردة التي بدأت في “لن” وانتهت مع “الرسولة” (هل حقّاً انتهت؟)، لا يمكنها إلاّ أن تكون مطاردة خلاصيّة، نورانيّة، تطهُّريّة، تزحزح حدود الأرض وتغيّر نعلَي الخير والشرّ. يقول في قصيدة “الصمت العابر كالفضيحة”: “لأنّنا شُفينا ونحمل حقوق الآلهة المغسولة بأوجاع الوحوش!/ استسلمي لعطائي. أكلّمك كلام المضطهد بحنانه”.
فردانيّة ولعنة ومَرَض
من أبرز سمات تجربة أنسي الحاج وخصوصيّاتها: الوحدة. فما جاء به، في “لن” وشقيقاتها، إنّما جاء به وحيداً. قصيدة النثر هي “شغل وحدة”، كما أعلن في مقدّمته، وأكّده في الكلمة التي افتتح بها “مؤتمر قصيدة النثر وأسئلتها” الذي أقيم في الجامعة الأميركيّة ببيروت، أيّار عام 2006. فإذا كان مرضُ الكوليرا قد رافقَ تمخُّض قصيدة التفعيلة على يد نازك الملائكة في الأربعينات، خالقاً هذه الهمهمات الغامضة في نفس الشاعرة التي كَسَرتْها قضيّةٌ جماعيّة، قوميّة، ميتافيزيكيّة، فإنّ المرض الذي “نُسِلَت” منه قصيدةُ النثر هو مرض السرطان: مرضٌ فيزيائيّ وفرديّ إلى أقصى حدّ، غير مُعدٍ، يصيب جسداً محدّداً لأسبابٍ عبثيّة، فيفتك به ويفكّكه من داخل. وقد تنبّهت خالدة سعيد، في مقالتها عن “لن”، في العدد الثامن عشر من مجلّة “شعر” (ربيع 1961)، أنّ “الأوبئة حالة جماعيّة وهي تنتقل. السرطان يبقى منعزلاً. وهو أصلح للتعبير عن حالة الإنسان، عن وحدة الشاعر ذاته”.
للفارق بين المَرَضين رمزيّةٌ جُلّى إذاً. في هذا الفارق يكمن جوهر الحداثة الذي لم تستطع الملائكة أن تقبض عليه. لم تستطع تقبّل الفردانيّة واللعنة والمرض في التجربة الحديثة، فظلّت ضمن فضاء الطرب، مشغولةً بما تستسيغه “الأذن العربيّة” وما لا تستسيغه! ذلك أنّ قصيدة النثر لم تولد من تجربةِ تعاضدٍ قوميّ ونشوةٍ سياسيّة، بل من رحم التفكّك والخيبة والعزلة طلعتْ، “عشبةً هوجاء لم يزرعها بستانيّ القصر ولا ربّة المنزل”. إنّها، بكلمات أنسي، اغترابٌ “عن الأوزان المباركة والقوافي السعيدة” وهبوطٌ مدوٍّ خارج النعيم.
من هنا السّحرُ الذي مارسته على الحاج شخصيّةُ أنطونان آرتو، هذا “الملعون الكبير” و”المريض الكبير”، سليل رامبو ولوتريامون وإدغار ألِن بو والماركي دو ساد، والممهِّد لهنري ميشو وغيراسيم لوقا وجيم موريسون وغيرهم. هؤلاء الذين قالوا الشعر صراخاً واختناقاً، جنوناً وتوتُّراً، هرطقةً وهذياناً، انجرافاً وهَدْهَدةً، تَأْتَأَةً وارتجافاً، سخطاً وحناناً، خوفاً وافتراساً، لعنةً وخلاصاً، انتحاراً وتشبّثاً مستميتاً بالحياة. قالوا الشعرَ مصادفةً، لأنّهم وجدوه على صورتهم ومثالهم، وجدوه لجوجاً ورؤوفاً وفردانيّاً وكئيباً وغريباً وحارّاً وحرّاً. قالوا الشعر كرهاً بالشعر والشعراء، بالأدب ورجال الأدب الذين “كلُّ دأبهم أن تبقى اللعبة الأدبيّة مستمرّةً”، كما يقول بروتون. ها أنسي يعترف في “وليمته”: “سحقاً للشعراء/ لولا ضجري منهم/ لما كتبتُ الشعر”. ويقول في دراسته عن آرتو في العدد السادس عشر من مجلّة “شعر” (خريف 1960): “الأدب هنا ثانويّ حقّاً، ثانويّ لا لأنّ آرتو عاش حياةً فاقت بامتلائها ضمور الكلمات، بل لأنّه مات، لأنّه مات حياته، ورافق موته، وفتحه، وفلعه، وفتّته تفتيتاً، وجزّأه، ثمّ انتهى حين لم يعد للموت جزءٌ يجزّئه”.
تحت راية التمرّد
تحت راية التمرّد، نريد أن نختم مقالتنا، وبإيضاح مفهوم أنسي الحاج للثورة، كلّ ثورة. فقد انتُقد الحاج كثيراً بسبب مواقفه من الثورات العربيّة، أو ما عُرف بـ”الربيع العربيّ”، وبخاصّةٍ مواقفه ممّا يجري في سوريا. فاتُّهم تارةً بـ”ممالأة الأنظمة” وطوراً بـ”المواربة على الطريقة البعثيّة”! لكنّ أحداً لم ينتبه، في دوّامة هذا الانقسام الحادّ والتهليل الأعمى، إلى أنّ الحاج لطالما نفر من الثورات، موارِباً ورافضاً الانحياز، لطالما توجّس من كلمة “ثورة” وهرب منها مذعوراً إلى كلمة أخرى وجدها أكثر لصوقاً بشخصيّته وطموحاته، هي كلمة “تمرّد”. هذا التوجُّس نقع عليه على امتداد تجربته، من كتاباته المبكرة في مجلّتَي “شعر” و”أدب”، وصولاً إلى “خواتمه” في جريدة “الأخبار”.
ففي دراسته عن آرتو، توقّف عند مسألة الخلاف بين هذا الأخير والسورياليّين، التي أدّت إلى طرده من المجموعة عام 1927، معتبراً أنّ “من أعمق الأسباب التي أبعدته عنهم أنّ السورياليّين جهدوا إلى تضمين ثورتهم غايتَين حين أرادوها أن تشمل المجتمع والسياسة، بينما فهم آرتو الثورة ثورةً إنسانيّة. إنّ الثائر السياسيّ لا يمكن أن يكون مع حريّته الفرديّة لأنّه لا يمكنه أن يكون مع حريّة خصمه الفرديّة”. فالحاج، كما آرتو، لا يكتفي بالثورة بمفهومَيها السياسيّ والاجتماعيّ، وهو مع الحريّة الفرديّة ضدّ كلّ عسف إيديولوجيّ أو مؤسّساتيّ. لذلك، لا تلبّي طموحاته الثورة التي تصل، ولحظةَ تصل، تستكين. الثورة، بالنسبة إليه، هي ثورةٌ إنسانيّة شاملة، هي تمرُّد دائم وجذريّ وهدّام، لا يوفّر شيئاً أو أحداً، ولا تنفع معه جوائز الترضية. إيضاحاً لمفهوم الحاج للتمرُّد، نعرّج على نصٍّ له بعنوان “نقاش في مفهوم الثورة” نُشر في مجلّة “أدب”، شقيقة “شعر”، في عددها الثالث (صيف 1963)، حيث نقرأ: “التمرُّد رفضٌ حركيّ لما هو قائم خطأ. وما هو قائم خطأ؟ تركيب الحياة. تركيب المفاهيم. دورة التمرّد متواصلة لأنّ ما يصارعه متواصلُ الوجود. والمتمرّد الكامل هو الذي لا تخدعه المظاهر وهو الذي يعرف أنّه لن يصل إلى نتيجة. ومع هذا يتمرّد. ومع هذا يحيا بتمرّده. التمرّد قيمة كبرى”.
ظلّ أنسي الحاج مؤمناً بقدرة الشعر، وبقدرة الحبّ، على تغيير الإنسان واجتراح المعجزة. ظلّ متمسّكاً بفرديّته الملتهبة في زمن الطُّغَم الطاحشة والجماعات المهتاجة. ظلّ على عزلةٍ مترهّبة في زمن الاستعراض والتجارة واللهاث، متّحداً بتطوافه الليليّ، بمقاومته الانحياز في زمن الانحيازات الفاقعة والتعصّب الفاحم. ظلّ يبحث عن كوّةٍ للضوء خارج تشظيات العالم وما تفرضه الأسواق العالميّة. ظلّ منغلِقاً، مُستغلِقاً، قاطعاً الصلةَ، على زُهدٍ مرهفٍ وتبذيرٍ طفوليّ، في زمن “المحافظين الجدد” و”التقدّميّين الجدد” و”البرابرة الجدد” و”الرومان الجدد”. وإذا كانت ثورتُه من قبيل الحلم والشعر واليوتوبيا، فإنّ هذا بالتحديد ما يمحنها خصوصيّتها وجماليّتها ولعنتها المباركة.
شهرزاد الغضب
محمد أبي سمرا
كيف نقرأ اليوم كتابات أنسي الحاج في زاويته الثابتة “كلمات كلمات كلمات” في “الملحق” الأسبوعي لـ”النهار” ما بين 1964 و1974؟ وهي جُمعت في ثلاثة أجزاء نُشرت في 1247 صفحة من الحجم الكبير لدى “دار النهار” العام 1987؟ هل هي شريط طويل، متقطع، من فن الكتابة الحرة، من اللحظات أو المتواليات الكتابية المتمردة على الأشكال المحددة للكتابة؟ أهي مزيج متدافع مفتوح لا يعبأ بأصناف الكتابة وحدودها، حتى بين النثر والشعر؟ قد يكون فيها من الشعر دفقه ونبرته الحاسمة، ومن النثر سعته ورحلته في أرجاء ظواهر الاجتماع والحياة اليومية، لكن من دون روايتها، والاستعاضة عن الرواية بالهجوم على العالم بحساسية شعرية، أو بمزاج شعري.
أحياناً يقول القارئ إن الاعترافات والشهادة والتعليق والمتابعات هي الغالبة على هذا المزيج الكتابي. فجأة يطالعه النقد والسجال الثقافي والفكري والسياسي، لكن من دون التزام أي من المعايير السائدة في النقد والسجال، كالعرض والمداورة، وإعادة الأفكار إلى مصادرها، تبويبها ومعارضتها بغيرها.
رجعي يعيش في الماضي
يفتتح أنسي الحاج “كلماته” في 17 أيار 1964، فيكتب في أعلى الصفحة: “أنا رجعي”، ثم يضع نقطة، ويعود إلى أول السطر الثاني، ليكتب: “أنا: شخص يعيش في عصر الشعارات المرعبة التي تخجل كلها بالرجعية”. ثم يقفز إلى أول السطر الثالث: “شعارات التقدمية والطليعة والتحرر”. لا يعرض هذه الشعارات، لا يناقشها، بل يكتب متابعاً: “كل فنان لا ينضوي تحت هذه الشعارات يسقط من الشجرة”. قد تكون الشجرة هنا في هذا السياق كناية في غير محلها، ففعل يسقط وحده يُتِمّ المعنى ويحسمه حسماً قاطعاً يتلاءم مع لغة الشعارات “التقدمية” الساحقة التي يشهد الكاتب بأن “الرجل الذي لا يزعمها، محروم حتى الفوز بامرأة!”. هنا يتخذ أسلوب أنسي الحاج أبهى صوره، في استدعائه المفاجئ لغير المتوقع.
ثم بلا مقدمات يكتب: “أكره التقدم وما صنعه، وأكره التمدن لأنه ليس غير إباحة الأسرار”. في جملة واحدة صغيرة حاسمة، يختصر مقولة بحثية كاملة في علم اجتماع التمدن والمدينة. وذلك فيما هو يشاكس التقدمية الرائجة بوصفها موضة العصر ودرته، آنذاك، ويعاكسها باعترافه الحاسم بأنه رجعي. المشاكسة والمعاكسة هاتان لا تحتاجان إلى حجّةٍ ولا برهان ولا شرح، بل تتجنبان وترفضان الخوض في الحجج والبراهين والشروح، لصالح الاكتفاء الصريح بإعلان الكراهية الذاتية أو الشخصية للتقدم، من دون توضيح. هو على المنوال نفسه يعترف: “أعيش في الماضي”. وبعد تعداده رموز الماضي الغابرة، كـ”القلعة، والحصن، والجزيرة الغامضة”، يكتب: “أيام كان الناس رومنتيكيين قبل أن يجيء شعراء الرومنتيكية”. هذه جملة تكاد تختزن مقولة كاملة في النقد الأدبي وفي علم اجتماع الأدب والجماليات. وكان أنسي الحاج قد سبق الروائي التشيكي – الفرنسي ميلان كونديرا في كراهيته التمدن وسلطة الدعاية والإعلان والشعار والكيتش التي أفرغت الكائن الانساني من كينونته الذاتية الخاصة، ورمته في صحراء الاستهلاك السريع، كائناً مفرغاً خاوياً بلا خصائص. كتب كونديرا متحسّراً على الأيام الخوالي في زمن البطء القديم، حينما كان الشعراء الجوالون يتنقلون على الدروب، وينامون تحت النجوم.
كخاطر يسكن الأبدية
أجوبة كثيرة، تأويلية واحتمالية سريعة، عن السؤال الآتي: لماذا يقول أنسي الحاج إنه رجعي، يكره التقدم والتمدن، ويعيش في الماضي؟ وهل حقاً هو كذلك؟ الأجوبة هذه قد تشكل خيطاً من الخيوط التي تخترق كتاباته في “كلمات”.
هناك أولاً الشعر والمثال الشعري الضاربة ينابيعهما في الطفولة بوصفها خزان الرؤية الشعرية للعالم. دليله الذي لا رادّ له في هذا الأمر، هو صوت فيروز الذي كثيراً ما كتب أن صوتها “نعمة”، ويردّ العالم إلى براءته الأولى، لكن معترفاً في المقابل بأن شعره غالباً ما يعاكس البراءة، بوصفه شعر اللعنة.
هناك ثانياً صوت فيروز نفسه الذي جعله أنسي الحاج حجة شعرية، وكرَّس النظرة إليه كطاقة شعرية، فتلقف الوسط الثقافي هذه النظرة واستلهمها، فدخلت فيروز الصوت والدور أيقونة شعرية في كثير من قصائد الشعراء. الحق أن صوت فيروز ليس طالعاً من الحنين، بل هو الحنين الشعري مجسَّداً في صوت يأتي حياً من الماضي ومن جهات الزمن الأخرى، ليوقف الزمن.
هناك ثالثاً لبنان، لبنان الفكرة والمثال الشعري الذي قد يكون حاضراً حضور الطيف الدائم خلف معظم المتابعات والاعترافات في “كلمات”. لبنان المثال الشعري هذا، مقيم غالباً في الماضي المتخيل، في تخييل الماضي، وفي المستقبل الآتي من الأحلام، من أحلام اليقظة السعيدة، لكن ليس من الحاضر قطعاً. الحاضر اللبناني في كتابات أنسي الحاج، غالباً ما يحضر حضور التمدن الذي افتتح “كلماته” بإعلانه الكراهية له. لذا فإن لبنان المجتمع والدولة والإدارة والحكم لا يحضر في ستينات مؤسس “الملحق”، إلا بوصفه أقرب إلى مأساة أو تراجيديا لا أمل في خروجه وخلاصه منها.
الدليل الحاسم هو ختام “كلمات” في 14 آب 1974. “عندما كنا صغاراً كان الصيف عطلة. كان البحر وكان الجبل، لكن البحر كان غالباً يكون رصيف الجبل، فالجبل هو حلم الصيف (…) وكان لبنان صغيراً معنا. (…) لا أحد يتكلم فيه عن الحرية غير خطاطي الشعارات ولا أحد يتكلم عن الطمأنينة غير أدباء يوم الأحد. فالحرية كانت ملء الفرح وملء الحزن (…) وكانت السلطة موجودة بضآلة ورفق (…) وابعد من السلطة كنا دائماً نحسّ بلا وعينا إحساساً ايجابياً عارماً وخلاّقاً بلبنان، كأننا كنا نحدس (…) أن لبنان رقعة روحية وسهل نفسي وجبل أخلاقي (…) متى كان ذلك؟ متى؟ قبل عشر سنين، قبل مئة سنة. وأين أين؟ أين صار ذلك البلد الذي كنا نقطع فيه مسافة البرق فنصبح في الجنة؟”.
“كان اسمه لبنان. لم يكن أحد يخاف من لبنان”. ألا تحضر فيروز هنا، وكذلك ميشال شيحا ولبنانه المتوسطي الذي نعاه في شذراته التأملية الصحافية، لكن الشعرية، في مطالع الخمسينات، لينعاه أنسي الحاج في أواسط السبعينات: “أبكيك يا وطني لأنك تبكي (…) ولأن زمان القسوة طال عليك (…) لأنه يعزّ عليك أن يزورك الجميع ولا تزور نفسك، وأن تأخذ البشاعة حريتها فيك (…) أبكيك لأني أبكي أعماراً لنا جفلوها في بدايتها (…) فيوم كنا صغاراً (…) كنا نسكنك لا كمن يسكن بلداً بل كخاطرٍ يسكن الأبدية”.
هناك رابعاً وأخيراً، بناءً على ما تقدم، ما يستبطنه الكثير من “كلمات” أنسي الحاج، وخصوصاً تلك الأخيرة: بروز الطفرة الجماهيرية الصاخبة وفوضاها الاجتماعية والعمرانية المدينية في لبنان الربع الثالث من القرن العشرين، وحلول الأرياف في المدن. قبل ذلك كانت البنى والأطر الاجتماعية والسياسية اللبنانية، لا تزال قادرة على استيعاب الحراك والتناقضات الاجتماعية والسياسية، إدارتها وتدبيرها، في إطار من المصالحات والتسويات العائلية والبلدية. فالمجتمع اللبناني، كان لا يزال بلدياً وأهلياً، وكذلك العائلات السياسية التي كان في وسعها إدارة شؤون ذلك المجتمع البلدي والأهلي في مؤسسات الدولة والحكم. هذا ما بدأ يتأكل تدريجاً ويتمزق تحت ضغط الطفرات الجماهيرية التي عجزت الأطر السياسية والاجتماعية القديمة عن تنظيم شؤونها كافة، فأخذت هذه الجماهير المتذررة والمسيّبة تنظّم حياتها على هواها وتدير شؤونها ذاتياً، وصولاً إلى الحرب الأهلية. هكذا لم يبقَ من لبنان سوى “حرية البشاعة” في لغة أنسي الحاج. اما الحرية الأخرى، الحرية في معناها الذاتي والوجودي والشعري، فشأن آخر، ولبنانها لبنان آخر: “خاطر يسكن الأبدية”.
الحرية والتباساتها
خيط آخر متصل بمسألة الحرية، يخترق “كلمات”. إنه الغضب المشاكس المتمرد متلوّناً في مزاج الكاتب وأسلوبه الكتابي. ما هو مصدر هذا الغضب الذي حمل أحدهم على وصف أنسي الحاج بـ”بائع الغضب الأحدي”، ويمكن القول ايضاً إنه شهرزاد الغضب في الستينات اللبنانية، لكن من دون حكاية ولا رواية، لأنه ينبعث من حساسية شعرية؟
لننطلق من المقولة العامة الشائعة التي تعتبر الستينات اللبنانية والنصف الأول من السبعينات، حقبة “أيام العز” أو “العصر الذهبي” للتفتح الثقافي والفني والاجتماعي والإزدهار الاقتصادي. هناك من أطلق على تلك الحقبة اللبنانية تسمية “النهضة الثانية”، عوداً على بدء “النهضة الثقافية والأدبية العربية” الأولى في مصر ولبنان في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات العشرين. معروف أن نهضة التعليم وتوسع قاعدته طوال النصف الأول من القرن العشرين، وكذلك التحرر الاجتماعي والحريات السياسية، كانت العوامل البارزة في التفتح والإزدهار في لبنان الستينات، ومن علامات تميزه عن محيطه العربي الذي سيطرت على مجتمعاته ودوله إيديولوجيا عروبية قوموية شمولية، وأنظمة عسكرية وديكتاتورية.
أنسي الحاج في مشاكسته وغضبه، إبن بارّ للتفتح والإزدهار والتميز والحريات اللبنانية التي بلغت ذروتها في الستينات التي سال حبر كثير في مديحها بوصفها درة القرن العشرين الثقافية في لبنان. فالاسترسال في المشاكسة والغضب وفي أعلانهما في دوائر العلانية العامة الثقافية والصحافية، شرطهما الضروري هو الحرية. لا بل إن هذه الدوائر الناشئة والمزدهرة بقوة في الستينات اللبنانية، جعلت من التعبير الحر عن الأفكار والمشاعر والأهواء المختلفة، علّة وجودها وتمايزها عن اختناق الحريات وخنقها وسحقها في المجتمعات والدول المجاورة التي حمل غيابُ الحريات فيها وتغييبها، اللبنانيين، وخصوصاً المثقفين والكتاب الليبيراليين وغير العروبيين، على اعتبار الحرية ولبنان حقيقة واحدة لا تنفصم عراها. هناك من يقول إن عبادة الحرية حتى السكر والتغني الفولكلوري بها في أوساط ثقافية لبنانية، أفقدها الكثير من مضامينها لأن تلك الأوساط اعتبرتها منجزة سلفاً في لبنان منذ كان، وحازها اللبنانيون وبلدهم سلفاً. كأنها في هذا، خارج التاريخ وخارج نطاق الفعل والممارسة التاريخية والاجتماعية، أي أقرب إلى صنمٍ أو خرافة أو اسطورة. والحق أن الحرية اللبنانية ليست على هذه الصورة، أي ليست سلفية وصنمية ولا وهمية، بل هي قائمة وموجودة، لكن الوعي التاريخي والاجتماعي بها لدى اللبنانيين ضعيف.
الغضب الجمالي
هذه الحرية اللبنانية كان أنسي الحاج إبنها المشاكس والغاضب عليها ومنها، لأنها فاقدة مضامينها الذاتية والفردية، واقرب إلى شعيرة اجتماعية في ممارستها. في مواجهة هذا النوع من الحرية الحسيرة والعسراء، والشبيهة بالكيتش، أراد صاحب “لن” اكتشاف حرية داخلية، سيزيفية ودونكيشوتية، تحرّر الوعي واللاوعي. حرية زئبقية مشاكسة، ومستمدة من مثال شعري وجمالي فريد وشريد، أراد صاحبه استدخاله غريزياً في نثر الحياة اليومية ولحظاتها العابرة.
من التصادم بين هذا المثال الغريزي، الشعري الجمالي، وإرادة توطينه المستحيلة في تفاصيل الحياة والعلاقات الإنسانية اليومية، وفي النظر إلى لبنان المجتمع والدولة والحياة السياسية، وبين الواقع الاجتماعي والسياسي وقيمه السائدة في لبنان الستينات، ولد الغضب الشعري والجمالي في النثر الأسبوعي لـ”كلمات” أنسي الحاج الذي أقحم الشعر والرؤيا الشعرية في نظرته إلى واقع العلاقات الاجتماعية والسياسية اللبنانية، وفي كتابته النثرية الأسبوعية المتحررة من منطق النثر لصالح منطق، بل لا منطق الغريزة. ربما كان صاحب “الرأس المقطوع” يدرك وأمثاله من ابناء جيله من أصحاب تلك الرؤية، أنهم صنيعة التفتح الثقافي والاجتماعي اللبناني، قدر ما هم أيضاً أبناؤه غير الأبرار، المشاكسون المتمردون والغاضبون. فالمشاكسة والتمرد والغضب ما كان لها أن تنشأ وتنمو، لولا ظهور مسرح جديد للحياة الاجتماعية والثقافية اللبنانية الناشطة في بيروت الستينات. وهو مسرح له سوابقه في عاصمة لبنان الكبير وحواضر جبل لبنان، منذ 1920، وفي حقبة ما بين الحربين العالميتين، وصولاً إلى الخمسينات.
أنسي الحاج مع كوكبة من أمثاله ومجايليه، ساهموا، شعراء وكتّاباً صحافيين ومنشّطين ثقافيين، في نشأة ذلك المسرح للحياة الثقافية البيروتية، وفي توسيع رقعته وفضائه. فـ”الملحق” النهاري، الثقافي الأسبوعي، الذي أسسه الحاج وترأس تحريره، كان مساحة أساسية و”نجماً” جاذباً في فضاءات ذلك المسرح الذي شكلت الصحافة الثقافية الناشئة والمزدهرة قطباً فاعلاً فيه، ومرآة حية لنشاطاته المختلفة المتفاعلة.
مخزون الغصب والتمرد
المزاج الكتابي النثري الغاضب والساخط الذي لم يتوقف صاحب “ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة” عن بثّه أسبوعياً في “كلمات”، كان وليد نزوع المثال الشعري والجمالي إلى التصادم مع الواقع لتحقيق تفرّد ذاتي مشاكس مطلبه حرية لم يستهلكها الكيتش الاجتماعي السائد.
الإطار العام لنشوء الذاتية والفردية، هو الحراك والتحولات الاجتماعية اللبنانية التي أتاحت لفئات وبيئات اتسع إقبالها على التعليم والمدينة ونمط الحياة الحديثة، منذ عشرينات القرن العشرين، أن ترتقي وتتفتح على الثقافة والفنون، وبواسطة الثقافة والفنون والصحافة، بعدما صارت دوائر لعلانية عامة جديدة وغير مسبوقة. في هذه الدوائر نشأ مثال شخصي، فردي وذاتي، في النظر إلى النفس والعالم والعيش والعلاقات والقيم والإجتماع والسياسة والوطن والوطنية، وصولاً إلى الأهواء والرغبات والجسم والتعبير عنها في الحياة العامة والخاصة، وفي المجالات الثقافية والفنية. لكن المثال الفردي الجديد الناشئ في المجتمع اللبناني ولد مرضوضاً وغير مكتمل وظل مثلوماً، وتعرض لكبح السلطات والمؤسسات الإجتماعية والسياسية التقليدية وقيمها الموروثة.
في الستينات والسبعينات بلغ التصادم بين المثال الفردي للذات والعالم والقيم والأهواء، وبين انماط العيش التقليدية الموروثة، ذروته، فنشأ عن ذلك غضب وتمرد شبابيان وثقافيان شكّلا ظاهرة عالمية عبّرت عنها بقوة لافتة الحركات الطالبية، وحركات تحرر المرأة وتحرير الرغبة الجنسية، التي وصلت اصداؤها قوية إلى لبنان الستينات، فتلقفتها الحركة الطالبية ودوائر الحياة الثقافية اللبنانية الناشطة في بيروت، على نحو لم يتوافر له مثيل في العواصم العربية كلها.
أنسي الحاج دفع الغضب والتمرد هذين حتى الأقاصي في “كلماته” التي اختزنت التمرد الجبراني، تجربة مجلة “شعر” في الخمسينات، وأسلوب المدرسة اللبنانية في التعبير الأدبي، ولا سيما كتابات فؤاد سليمان في “تموزياته النهارية”.
لكن ذلك الخزين الثقافي والتعبيري لا يكتمل إلا إذا أضفنا إليه تراث مجلة “المكشوف” التحرري الذي ساهم فيه والده لويس الحاج في الثلاثينات والأربعينات إلى جانب “عصبة العشرة” من الشعراء والقصاصين. أما صوت فيروز الشعري أو الشاعر، الطالع من لبنان المثال والحلم مضرجاً بالحنين، فقد شحذ بدوره طاقة صاحب “الرسولة بشعرها حتى الينابيع” على الغضب والتمرد اللذين لا تكتمل مصادرهما الثقافية والتعبيرية إلا بإضافة الإستلهامات المحلية هذه إلى أعلام من الشعر والثقافة الفرنسيين في حقبة ما بين الحربين العالميتين وما بعدها، من السوريالية والوجودية والعبثية والعدمية.
هذه المروحة من المخزونات والاستلهامات التي استلّ منها أنسي الحاج غضبه في “كلماته” النهارية، هي محفزات ثقافية وأدبية تساعد في الكشف عن التوتر بين صورة للبنان المثال بوصفه قريناً مفرداً ووحيداً للحرية في محيطه، وبين لبنان الواقع الإجتماعي والسياسي في هذا المحيط الذي غالباً ما يكبح فرادة المثال اللبناني، ويدفع أوساطاً من مثقفيه وجماعاته إلى أسطرة الحرية اللبنانية وإخراجها من التاريخ ومن التاريخ الاجتماعي وحوادثه ومنعطفاته. لكن التاريخ المنسي أو المكتوم والمكبوت سرعان ما فاجأ اللبنانيين جميعاً وأدخلهم في حروب مدمرة لا يزال التأريخ الفعلي لها ضعيفاً، وكتب أنسي الحاج قبل أيام من بدئها: “لم نعد ننتظر شيئاً من أحد/ إننا ننتظر من الله/ وبانتظار معجزته، هناك (…) طلب واحد: دعونا نعيش بكل تفاهة (…) لم نعد نطلب أكثر،/ بكل تفاهة”. ثم كتب في مقدمة “كلماته”: “إن خيبتي/ بالحياة والفن، بالرجل والمرأة، ترافقت مع سقوط لبنان”.
كلّما أحببتُهم
محمد سويد
قبل تعرّفي إليه في المبنى القديم لجريدة “النهار” في أول شارع الحمرا، عام 1992، قرأت لأنسي “لن” و”الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع” و”الرأس المقطوع”. وجدته آخذاً قصيدة النثر إلى منتهى الاحتمالات، مشعل الحرائق في “بلاد متعصبة لرجعتها وجهلها لا تقاوم إلاّ بالجنون”، شاعراً لاعناً ملعوناً ساخطاً شفّافاً نزقاً فاحشاً ورعاً ناثراً نشيد الإنشاد مدجّجاً بالأناجيل، “يعلو” إذ “تنخفض السماء” طارقاً بوّابتها مرتجفاً مرتمياً “لها لها، أحيني يا الله”، على قوله في مقدّمته الأقرب إلى بيان استهل به ديوانه البكر، “لن”، لدى صدوره خريف العام 1960.
قارئٌ في مقتبل العمر كان أعجز من أن يفكّ لغز صاحب كل ذاك السخط وشراسة اللغة. في سني الحرب، كبر القارئ وأمسك الشاعر عن الشعر. علمتُ أن “سراب العارف” كان الاسم المستعار لمقالاته في مجلة “النهار العربي والدولي”. غاب الشعر، حضر الكاتب. في إحجامه عن إصدار دواوين جديدة وتخفّيه في “سراب” الكاتب بدل “العارف”، لم يعن “صمت الشاعر” غير صدودٍ عن كتابة الشعر أو عزوفٍ عن نشره فحسب. كان صمت أنسي محيِّراً وساحراً في آن واحد. حتّى إن مريديه أحالوا صمته على الشعر وجعلوه صنو الشاعر.
منذ عملي في الصحافة المحليّة، لم أجد في ما كُتب عن أنسي أو نُشر نقلاً وترجمة عن دارسين لشعره من الخارج، إلاّ تحريضاً على اكتشاف نصّه وعشقه العشق المعصوم من الشوائب، عشق الجمع والجماعة للمصطفى بين الشعراء، للمتحفّظ عن الظهور، للمتواري في الأسماء، ذلك أن الشاعر الحرّ ليس إلاّ “النبيّ، العرّاف والإله”، على حدّه. في ذلك، لم أفرّق أنسي في قامته الشعرية وتعاطي محبّيه لها عن فيروز وقامتها الصوتيّة. تمثّل في نظري صوت الشعر أكثر من كلمته ورنين الكلمة أكثر من حفرها على الورق. سحره صنيعة الصوت والرنين من شعر توّاق إلى موسيقى ترفرف به. استهوى مريديه حفظ عبارة، ولو من كلمتين، مما استُل من قصائده ومقالاته وحواراته. رددوها تردادهم لنغم. نبذوا “كلمات، كلمات، كلمات” من ذاكرتهم المعلّقة على هاملت وأمست مشدودة إلى وتر أنسي وتوتره، وعنواناً لنصوصه في أيام عزّ “النهار” وملاحقها الأسبوعية. تقليداً له، شاعت عبارات وردت إما على لسانه في حوارات صحافية وإما في قصائده. من “الرأس المقطوع”، اخترتُ “كلّما أحببتُهم وقعوا من القطار”، مستلهماً من وقعها على السمع فيلماً تجريبياً قصيراً.
ظلّ أنسي في حسباني ذاك الصوت الحائر في صورته وزادني حيرة في تهيؤ صورته وتشخيصها من بعيد، أو “بعيد البعيد”، حتّى انتقل بي المطاف من جريدة “السفير” إلى “النهار”، حيث شاركتُ في إحياء “الملحق” الثقافي في حلّة جديدة وفقاً لتصوّر الروائي الياس خوري. تولّى خوري رئاسة تحرير “الملحق” وتوزعت أمانة تحريره بيننا، الشاعر بسام حجار وأنا. في أحد الاجتماعات التأسيسيّة، أجْلَس غسان تويني أنسي إلى جانبه معرباً عن حرصه الدائم على سماع رأيه واصفاً إياه “ضمير النهار”. وجدت أنّي أمام وجه آخر وأصيل لأنسي، وجه الصحافي. في حوار أجرته مجلة خليجيّة في العام الفائت، قرأتُ لعبّاس بيضون أن مزاولته كشاعر لمهنة الصحافة قرّبته من القارئ الحقيقي وأثّرت في كتاباته لأن الشعراء لا يفكّرون في القرّاء ويجزمون أنهم من القلّة ولا سبيل إليهم، لكنهم حين يعملون في الصحافة يصبحون على احتكاك بهم. وأنا أقتبس من بيضون، مردفاً أنّ لقائي وأنسي كان لقاء قارئ بشاعر أطلّ في ملبس صحافي محترف ومرهف في أشيائه الصغيرة وفي التفاصيل البسيطة الظاهرة مثل طيّة شاله ومقالاته القصيرة المكتوبة بأحرف كبيرة على أوراق تزيد عدداً على حجم المقال.
في الطبقة التاسعة من مبنى “النهار” في الحمرا، تجاورت المكاتب. غرفتان لنا، ثانية لمحرري صفحة “قضايا”، ثالثة للنسخة العربيّة من مجلة “المختار”، رابعة للإخراج الفني،وخامسة لأنسي. كانت غرفته الأهدأ، شبه مقفلة قبل الظهر وبعده. لم أره مرّةً في الصباح. توقيته المتوقّع أول المساء. يخرج من المصعد الكهربائي القديم الطراز المتهالك وتقوده خطاه مباشرة إلى غرفته. ذات يوم قال لي باسماً إنه لا يفهم كيف أن كائناً ليلياً مثله يعمل في جريدة اسمها “النهار”. في أحاديث جرت في لحظات مسروقة ما بين استراحةٍ وخروج من غرفنا للدخول إلى إحدى الغرف المجاورة، حافظ على نبرة أزلية من تمرّد وبرم وتأفف وانفعال وفوران عاطفي. أنت لا ترى أنسي وتبادله حديثاً قدر ما تقرأه وتسمعه صوتاً جارحاً من شعر منصرم. في حضرة الشاعر، بقيتُ ذاك القارئ. وأمام الصحافي الذي كانَهُ أنسي وحاول أن يكون عليه ويستمرّ فيه جنبًا إلى جنب مع غسان تويني وملحق، حمل بصمته في الماضي،ووجده يحيا مجدّداً في جريدةٍ ما عاد في ميسوره أن يعلن نفسه في حلٍّ منها مذ طُوِّب ضميرها. كان الأمر أشبه بماضٍ يحيي نفسه. قطعاً، ليس “ماضي الأيام الآتية” مثلما تناوله أنسي قديماً. فهو، بعد الحرب وخرابها، ماضٍ من خارج الزمن الشعري، وليد الواقع وليس سليل الخيال. لبنان ضحيّة افتتانَيْن، افتتان الموت في الحرب وافتتان الحياة في السلم، تحديداً فترة الحريرية. في الحالين، غلب الإسراف في الموت كما في الحياة. ربّما لذلك شكّلت ثنائية الموت – الحياة الهمّ الجامع بين أصحاب مشاريع فنية وثقافية عدّة طوال ربع القرن الفائت، من غير أن يكون في مستطاع أحد الإرتقاء بمشروعه إلى ما يتجاوز سقوط معنيي الموت والحياة. لكن هذا الهمّ كان دون مزاج أنسي. بدا لي، في أول أعوام “الملحق”، أن أمور أنسي تجري على مضض. ففي معرض تعليقه على شريط إعلاني أنتجته “النهار” ترويجاً لعودة “الملحق”، وكان جاذباً وطريفاً في إظهاره ديك “النهار” متبختراً فوق كومة من الصحف، فاجأني برأي يتخذ من الشريط مثلاً عن إمكان تحوّل القصيدة إلى أشكال حديثة تملأ فضاءنا على منواله. في حدود معرفتي به، لم يدل أمامي بأكثر من رأيه هذا في الشعر. وله ما يبرره. يومذاك، انتشر فنّ الغرافيكس كالفطر وكثر طلاّبه في كليات الفنون وانتعش مكتسحاً فضاء البلد بازدهار التلفزيون وإعلانات الطرق. أوحى المنظر العام بإقبالٍ على نمط معاصر من حياة كان يعاد اكتشافها في بدايات الخروج إلى السلم الأهلي، وهو نمطٌ على صورة الإسراف السائد في حياة ما بعد الحرب. غدا الإعلان تعبيراً خاطفاً في نظم كلماته المقتضبة، الجاذبة، القابلة للترداد في لغتها المحكية أو المهجنة مع لغة أجنبية أو أكثر. وعلى افتراض أن قصر الجملة يمثل أساس النصّ في الإعلان،وإن كان مرئيّاً، يجوز تالياً اعتبار النصّ نوعاً من “النثر” القائم في ذاته وشرطه وغرضه، له وقعه وإيقاعه كقصيدة. في مقدمة “لن”، وانحيازه العنيد إلى الشعر الحرّ، رأى أنسي أن شرط قصيدة النثر قصرها “لأن التطويل يفقدها وحدتها العضوية”، ولأنها “أكثر من قصيدة الوزن حاجةً إلى التماسك، وإلاّ تعرّضت للرجوع إلى مصدرها، النثر، والدخول في أبوابه من مقالة وقصّة ورواية وخاطرة”. حين علّق أنسي على إعلان “الملحق”، لم يعن أن الشعر تحوّل شكلاً من الإعلانات. الحقّ أن الشعر زَحَل عن مكانه، زحوله عن سبب وجوده، عن حبره وورقه، منتقلاً من جموح العقل إلى جنون العين. وددتُ اعتبار رأيه ذريعة أخرى من ذرائع الكفّ عن الكتابة، لكن همّه الشاغل كان في مكان آخر، قصور الكتابة وقد أمست متعتها وجه ألمها،وشبقها وجه انكفائها،واشتهاؤها وجه حرمانها. بَرمه من الكتابة، أو الأصحّ فرض الكتابة، كان من وجوب الوجود. عبر ظهور تلفزيوني نادر خصّ به جيزيل خوري في فاتحة برنامجها الشهير،”حوار العمر”، أطلّ قائلاً إن طرد الله لآدم من الفردوس أخرج فكرة العمل إلى النور. بمعاقبته آدم على خطيئته، صبّ الرب عليه لعنته كمن يقول، “لست مسؤولاً عنك بعد الآن. عليك أن تتدبّر أمرك بنفسك. اعمل!”
حُمِّل أنسي من محبِّيه أكثر مما حمّله الشعر وتحمّل منه. على وفرة المراجعات النقديّة لأعماله بالثناء والوقار والإطراء، زاد المكتوب عن أنسي ما كتبه الشاعر نفسه. مُيِّز عن مجايليه وفُوِّق عشقه على سواه من فرسان مجلّة “شعر”. على مرّ الوقت، تُرِك الآخرون لإرثهم. صُنِّموا. ظلّ هو الحيّ الذكر والمتحرّك الأثر. ربّما أدونيس أفلت من صنميّته بإثارته الضجيج في مواقف وإطلالات وتوقّعات خائبة في حصد جائزة نوبل، لكنه ضجيج حرّكّ رأياً عاماً ضدّه وحرّر كثراً من التحفظّ عن نقده وتعريته من أقنعته، فيما هالة أنسي وهّاجة أبداً. ما برحت العودة إلى آثاره طقساً مُنتظراً في كلّ آن. وتشفّ الزيارات المتكرّرة لأعماله عن أنه واحد في كلّ،وكلٌّ في واحد،لا بل الواحد والكلّ معاً. ممارسةٌ قلّ نظيرها في الصحافة العربيّة، وكذلك الأوساط الأدبيّة، إذا أُخِذ في الحسبان أن القيّمين على الصفحات الثقافيّة والأدبيّة في معظم الصحافة اللبنانيّة وبعض الإصدارات الأدبية العربية ودورياتها وحوليّاتها، هم من صانعي الحياة الأدبيّة والفنية. غير أن طقس العودة إلى أنسي وتجديد شعره عبر الزمن يكاد نطاقه اليوم يكون حصور في الصحافة اللبنانيّة. كأن العودة إلى أنسي، الآتي من صدى حقبة اتسعت فيها المدينة الصغيرة، بيروت ستينات القرن العشرين ومطلع سبعيناته لأدباء العرب ومعتركاتهم وسجالاتهم وحركاتهم الحداثوية، وضعت أنسي أخيراً في الحقيقة اللبنانية، وجعلته يكتب خواتمه في جريدة “الأخبار” باسمه الصريح، وإن استحق الراهن “سراب العارف” أكثر ممّا مضى. كأن أنسي طُرِدَ هو الآخر من جنّته وكان عليه أن يعمل.
يوم صدور العدد الأول منه، خصّ أنسي “الملحق” بافتتاحية وردت في متنها حسرته من أن “أشياء الإنسان أطول عمراً منه”. ما كان تأفّفه واستياؤه وغضبه وأناشيد إنشاده مشاعر موقوفة ومراوحة بين الموت والحياة. هو الداعي إلى “بجّ السدّ” كيف للحياة أن تضيق به أو للموت أن يصدّه ويخدعه؟ لن. “أهرب أين وأنا الأفق؟” لن. كان يعلم أننا نعيش في زمن السرطان وأنه آت من “زمن السرطان”، على قوله في مقدّمة “لن”. الموت حقيقة، الحقيقة الثابتة الوحيدة، والحياة عقوبة قاسية نلقيها على أنفسنا. كلما كنت في سفر بعيد، سفر يحملني إلى بعيد البعيد، أذكره في طيّة شاله ونظراته الحادّة الوثّابة. أنسي واحدٌ ممّن يغلبني الشوق إليهم، يمرّ في خاطري واحداً من كلّ. و”كلما أحببتُهم وقعوا من القطار”.
في الحاجة إليه
أحمد المديني
ثمة أسماء في عالم الفكر والأدب، يكفي ذكرُها، أو الإحالةُ إليها، فكيف بالوقوف عندها بأناة وإسهاب، لتثير مواقف للتأمل، وتستدعي عملية استرجاع ذاكرة جمعية كاملة، ومرجعية ثقافية شاملة، في قلب زمنية حضارية شمولية، ترى أعلامها إما يقعون في مركزها، أو هم من أقوى الخلاّقين أطلقوا شُهُبها الأولى، وبأعمالهم، وبمتسع رؤاهم وصنيع نصوصهم وإشعاع بصيرتهم النفاذة وقوتها، أمكن فعلا المعرفة، والإبداع أدباً وفناً، أن يؤكدا دائماً ضرورتهما القصوى وجدارتهما المثلى لقول الجوهري في الإنسان، وإعادة اكتشافه وإبرازه، من أجل ترسيخ الإنسانية وإعلائها فوق مستوى الغرائز والحاجات الأولى، ابتغاءَ مُثل وقِيَم عظمى هي قطب الوجود، حتى ولو ظلت بعيدة المنال. وما الإبداع العظيم والخلاّق إلا بعض هذا المطلب، منذ بواكير الحس الإنساني، إلى مشارف استحالة التعبير عنه.
الشعراء منبوذون ومطرودون من بعض الكتب المقدسة ومصنّفات الفلاسفة، لأنهم منافسون حقيقيون للخالق، بدعواهم، برؤاهم وتمثلاتهم. بالعبارة، باللغة أداة أخرى تعيد تشكيل الحياة، وبثّها أرواحاً وأجساداً غير مألوفة، هي من عبقرية، من إحساس الشاعرـ الكاتب، ومضمار خيال الإنسان. باللغة والخيال يبدد الإنسان بداهته، وينتزع معنى خلقه بيده، وفيما يفصح عن هويته، يأتي قولُه الشعري والديني والصوفي وباقي استيهاماته لتمثل التجلي الأقوى لحضور الكائن الخلاق في الوجود، فكأنه هو خالق نفسه وإلهه، ولا أحد، لا شيء ينافسه في هذا التشكيل، وكلما اصطدم بما يحول دون تحقيق كينونته، وامتداد أفق أحلامه، زاد قلقه أضعافاً، وهواجسه أكداساً، وراح يسعى ليستبطن ذاته، ويفكّك علامات الوجود عوداً على بدء، من غير أن يستقر على يقين، فاليقين عدوّ الشعر، هو والثبات، لذلك تراه يطوف دوماً في دائرة المحال، وفي كل مرة يجرّب أدواته، وينزاح عن أشكاله، ويطوّر جوهره. الفرق بين النص المقدس ونص الشعر أن الأول كامل، ونهائي، وقداسته من أعلى بينما الثاني في صيرورة دائمة وبنيته مفتوحة لغةً وبلاغةً وخيالاً وتصورات، لا تقدس إلا الجديد، لتعود فتنقلب عليه حين يتحول إلى قيد ودوغما. لذلك لا يكون الشاعر، المبدع، كذلك وفي انسجام مع الموقع الحقيقي الذي ليس له غيره، إلا وهو في تجاوز مستمر، ونقض دائم حتى الفناء، لمقدراته وإنجازه بنفسه، وهو يبتغي نيل محال مراده، محال!
أنسي الحاج من هذه السلالة، حتى وهو لا ينتمي إلا لسلالته الشعرية الخاصة، لاعتقادي أن الشاعر مفرد، وهو صوته، قبل أن يكون صوت الجماعة (القبيلة، مثل شاعر الجاهلية)، هو إذا نطق باسمها، أو هتفت من حنجرته، نبَست من شفتيه، أو باح وتحرّق بلواعجها، فهو يتجوهر في هذا الصوت، صاحب النداء لا الصدى، الرسول لا التابع، الشيخ وليس المريد. أنسي، الذي لم أقابل يوماً، لم أعرف شخصاً، رغم أن علاقتي بلبنان، ببيروت تخصيصاً، أضحت جزءاً من علاقتي بنفسي، كلما حللتُ بهذا التراب وجدتُه حاضراً معي، يمشي برفقتي، أشمّه في الهواء، أراه يتلبّس السحاب، والمتوسط يزداد زرقةً من نظرته، أو أمواجه هديراً من غضبه، وهو صاحب الغضب الهادئ، والصبر النابض، والخفقان المتئد، مثل من يمشي في منامه، يحسبونه سكران، وما هي إلا خمرة الوعي الحاد، وعناد طائر الفينيق، ما هو بسكران، إلا بيقظة إله يحس بمسؤولية ضرورة تدبير كون بكواكبه وخلائقه، فيترك النهار للعابرين والعاديين ومقايضي الصكوك من كل نوع، يتفرّج بنصف عين على تفاهات الحياة وترهات أشبه الأحياء، وعند الغروب يتوضأ بأرجوان روحه، ويشرب أول كأس من شغف المعرفة، وحدوس الوله، كي تبدأ قصيدة، وينبثق سؤال لم يفطن إليه أحد، وليس عند غيره الجواب. في لبنان آلهةٌ وأساطير وخوارق ومقامات وهذه كلها تحميه وتبجّله، لا يتبيّنها إلا المهووسون، والممسوسون، أنسي أحدها، ولذلك هو يَرى وفي الآن لا يُرى، وكل من قابله إنما شُبِّه له، لأنه يقيم في ذُرى شعره الذي مذ بدأ وهو شلاّل يهدر وينهمر من الأعالي.
هو الرائد، ولذلك تراه في معتقده الفكري، ومنظوره الأدبي، لا يؤمن إلا بالرواد، وهؤلاء قلة بالطبع، هم المؤسسون والفاتحون، وغيرهم التابعون والأصداء والنسخ المكرورة، لا يُعتدّ بها. من هنا بعض خطورة من يريد أو يزعم أن يصبح شاعراً، كاتباً، لا توسُّطَ في الأدب. إما تكون شاعراً أو لا تكون. ومن هنا، أيضاً، جحيم الشاعر، أن تبقى نارُه مشتعلة إلى أن يُوارى الثرى ليقبِس منها من أصابهم مسٌّ من جنِّه. يقول أنسي إن الشعراء هم المتنبي وأبو تمام وأبو نواس وبودلير ومالارميه، وأضراب هؤلاء، وكفى. وهو بدأ رائداً، لا متمرناً، مع جماعته الشعرية، في مرحلتها الأولى التأسيسية وكمؤسسة (مجلة شعر 1957، يوسف الخال، أدونيس، وأنسي الحاج). وفي الآن يقترن بالفردي، بالنواة الواحدة، الجوهرة، إذ الشاعر مهما تضامن وتكافل نظرياً وحول مبادئ ومعايير إبداعية، لا يُعرف إلا بقصيدته، هي هويته ومرآته. لذلك قال في هذا المعنى: “ليست البداية مشيئة محض فردية ولا محطة زمنية تعقبها محطات، وليست الريادة طلائع وموجات، بل هي بداية وكأنها صفر؛ بداية في غير معنى المتابعة والإكمال، فليس للفجر متابعة وإكمال، وكل فجر هو البداية”.
أظن قيل كل شيء هنا، بالنسبة لمن انخرط في حركة شعرية، وانبثق من أتون حقبة تاريخية وثقافية هي بمثابة منعطف، بأحداثها وبالوعي الذي تبلور لدى أعلامها، رادتِها، في حقول التعبير الأدبي، والتفكير المعرفي التنويري، من جهة، كما العمل التحرري، المشروع الديموقراطي، من جهة ثانية، وهذا في مجموع العالم العربي. من قلب هذه اللّجج والتيارات مجتمعةً، أنجب أنسي الحاج قصيدته لتعلن على طريقتها “مشروعه” الذي يمكن تسميته بعباراته: “أكثر ما يخفف القهر ليس الصراخ والغضب بل الرقة”. لنذكر فقط أن هذه القصيدة، التي مثّل ديوانه “لن” (1960) باكورتها (بدأ النشر منذ 1954) وضعت في زمنية أدبية عربية تميزت ببداية تغيرات مهمة مسّت تشكل الأجناس الأدبية الحديثة، روايةً وقصة قصيرة وشعراً، ومنظورات الواقع ومفهوم الواقعية، وعلى صعيد الشعر خاصة كانت قصيدة التفعيلة قد طرحت بأسماء روّادها المعلومين (لا يعنيني هنا السجال حول أسبقية رائد أو إسم على آخر، ولا سيما حين يتعلق الأمر بظاهرة، لا يمكن أن ينشئها نص واحد، وتحتاج إلى تراكم وانتظام، وسياق، وحين تشرع في الاستقرار يصبح لها نَسَق، وهذا المعول عليه) نصوصاً اتجهت في بنائها وموسيقاها ولغتها إلى اجتراح بنية بديلة للشعر العربي الكلاسيكي، علما بأن تنويعات تجديدية طرأت عليه قبل ما سُمي بحركة الشعر الحر أو التفعيلي (حركة “أبولو” المصرية مثلاً، أو الشعر المهجري،الخ)، وتحولت فعلا وبالتدريج إلى نموذج مضاد وبديل للشعر القديم، ترافق مع تبدل متواتر للذائقة الأدبية وعملية التلقي، ومع مزيد انفتاح على الثقافة الحديثة، كله في إطار التحولات الحثيثة والموضوعية لبنيات المجتمع العربي.
بيد أن قصيدة أنسي الحاج، هو والحركة التي انتمى إلى مزاجها وجماليتها الشعرية، جاءت وفي وقت متزامن، أو غير بعيد على الأقل عن كتابة التفعيليين، لتطرح نصها، انطلاقا من تصورات معلومة للدارسين، بمثابة إبدال، لما قبلها وما يجاورها في آن واحد. نظرت إلى الثانية وكأنها تستنسخ سابقتها ببضعة رتوش وتحويلات طفيفة لا تمس البنية العميقة، نظماً ومبنى. قدم النص الشعري الحاجِيّ، حتى من غير أن يتخذ له توصيفاً بالتعيين الفني أو المذهبي، وبطبيعة حاله كاختيار، كبراديغم شعري مختلف عن النسقين الموروث والوارث، فهو قطيعة، القطيعة التي اقترحتها للشعر العربي وعنه هي المسماة “قصيدة النثر” التي لا سابق لها في تراثنا، والمنقطعة عنه، والمأخوذة كلا من نمط الشعر الغربي، في نماذج محددة له ومكرسة لها بلا جدال، تقريباً، ذلك أن التعرف على هذا النمط احتاج إلى وقت، ولا كان المنتجون العرب يومئذ، خلا مواهبهم وطموحهم الأكيدين، يمتلكون الثقافة الشعرية الحديثة المتينة والمتراصة التي تؤهلهم حقا لجعل نصوصهم ممثلة حقا للحداثة التي أصبحت شعاراً لكتابتهم ونزعتهم الأدبية، قبل أن تأخذ هذه التسمية ما لا حصر له من المعاني ويضيع بعد ذلك دمها بين قبائل الشعراء؛ شعراء قصيدة النثر، كان لها روّادُها، في مقدمهم أنسي الحاج، ونصوصها المثال الذي ترسخ وتراكم في أدبنا العربي، وظهرت فيه طرائق وتعبيرات، هنا وهناك، لكن، من غير أن ينتزع إلى الآن اعتراف الذائقة الأدبية العربية التي ما زالت تميل إلى التفعيلة والإيقاع البين، ولا تكاد تميز، بسبب اكتساح العادي والرديء والركيك والمتطفل، بين ما هو نثر، أو نثر فني، أو شعر مرسل، أو تصفيف كلام على عواهنه، أو قصيدة نثر حقيقية وضع لها أنسي الحاج شروطاً في التخلق حددها في قوله المعياري: “لتكون قصيدة النثر قصيدة حقا لا قطعة نثر فنية، أو محملة بالشعر، شروط ثلاثة: الإيجاز، والتوهج، والمجانية”. لاحظوا كيف أنه يسقط الإيقاع، الموسيقى، المرتبطة بالقصيدة النشيد، ويبقي العنصرين الأخيرين ملتبسين، أو قابلين لتعدد الفهم. الحق، لم يكن أنسي الحاج في حاجة إلى التنظير والإسهاب فيه، فهذا شاغل أدونيس وبلواه، اكتفى بإرادة أن يكون نصّه مثاله، صورته من غير أن يفرضه نموذجاً على أحد. لكن، هل في وسع أحد اليوم من شعراء قصيدة النثر الجديين، المحنّكين، لا اللاهين والعابثين ممن أفسدوا “سوق الأدب” أن يزعم أنه لم يتتلمذ على القصيدة الحاجّية. إلا بطر أو مخادع لنفسه ولتاريخ الأدب، وهو تاريخ حيّ ويقظ في ذاكرة الدارسين، كم من هؤلاء في حنجرتهم وعلى طرف لسانهم نداء: لَكَم الحاجة إليك قوية اليوم يا أنسي، لَكَم!
* شاعر مغربي
أنا المدين لكَ
جوزف صايغ
أنسي، يا صديقي، وأخي، وشاعري الأثير، يا أحد اثنين من أقلامي المفضلة، ويا واحد الكلمة المبتكَرة في كل كلمة، المستجدّة والمجدِّدة في كل مقال وكل سطر وكل قصيدة…
تحية من جريح بجرحك، مألوم بألمك، مُستفقِد بفقدان صفحتك الأسبوعية جميعَ الصفحات.
منذ ما يزيد على ربع القرن، كانت صفحتك صفحتي، وكلمتك كلمتي غير المكتوبة. لا أملك اليوم سواها، الكلمة، كي أُكبر بها واحداً من كبارها الكبار، وأفيك بعضَ ما لك عليّ. أعترف لك، في هذه الساعة العصيبة، بأنني مدين لك بثمين من حياتي: فضلاً عن المودة الغالية والتقدير المتبادل، مدين لك بأجمل كلمة كُتبت عني. إليك يعود دخولي الصحافة: “النهار”، “الأنوار”، “الجديد”، “النهار العربي والدولي” أيامَه الباريسية… الله! ما ألذّها رفقةً كانت لنا في تلك المقالات الغاضبة، الثائرة، القتالية من أجل لبنان، قبيل الكارثة وفي أثنائها…
وأخيراً مدين لك باستعذابي، لأول مرة، قصيدة النثر كما لم يكتبها سواك. كُنتَ موهوباً، عبقرياً، في إعادة المألوف من الكلام غير مألوف، وفي تجديد المستهلَك من الصور بتصوّر استطلاعي يكاد يكون خارقاً.
ويا شاعري الكبير وصديقي الحبيب: حرقة في قلبي ألاّ أكون قريباً منك في ساعاتك الحاسمة.
وداعاً يا ملاك الحرية
إدمون صعب *
«لا تستطيع أن تكون قنديلاً
إلا إذا حملت الليل على كفيك»
أدونيس
أنسي،
أيها الملاك الطاهر،
يا ملاك الحرية والبراءة.
أيها الرفيق الشريف في النضال من أجل العدالة والإنصاف والكرامة الإنسانية.
لقد سقطت صريع الخيانة،
قبل أن يفترسك الوحش الذي لم يرحم طهارتك وصدقك، ونبلك وسموّك.
قليلون يا أخي وصديقي، بل يا معلّمي، يعرفون مدى صدقك وعمق الجرح الذي أصابك جراء الخيبة التي أصبت بها من أعز الناس لديك.
قليلون يا أنسي، يعرفون سرّك، بل سر مرضك في «النهار» حيث كان سرطان المال بدأ يتفشّى في ذلك الكيان الحر الذي كنت واحداً من أركانه، وصانعي مجده.
لن يصدّق أحد في العالم الذي كنت جزءاً منه، أنك يمكن أن تفكر يوماً بمغادرته وأنت رئيس لتحرير أكبر صحيفة في لبنان، وينعم بأعلى راتب في العالم العربي يوفّر لك حياة كريمة ومرفهة، لكنك فعلتها، وقلت «لن» رافضاً التنكّر للأمانة، بعدما جاء من رهن استقلالية «النهار» وحريتها لحساب مال تفوح منه رائحة النفط. مال حاصرها حتى كاد أن يخنقها. ثم جاء من يرهن ما تبقى من هاتين الاستقلالية والحرية لحسابات لا علاقة لها بالدور الرسولي للصحافة من جماعات طالما شبّهناها بتجار الهيكل الذين جاء المسيح وطردهم منه.
أيها الفارس الشجاع الذي رفض الانحناء أمام سلطة المال، وآثر الانسحاب بصمت، الى صومعة الفرادة، ناسكاً متعبّداً للجمال والحرية.
قد لا يصدق أحد أن السرطان الذي تفشّى في جسم «النهار» كان من النوع القاتل لأمثالك. لذلك كنت تكثر من تناول الأدوية المهدئة بعد مراجعتك بعض المقالات التي كانت تفوح منها روائح غير مألوفة، فكنت تحيلها عليّ مع عبارات مثل: «هذا تقرير استخباراتي»، وهذه «فاتورة»، وهذه «فرشاة للجوخ» وهذا «تسديد حساب».
وازداد مرضك شدة عندما تواجهت مع من بدأ يتلاعب بعناوينك في مانشيت الصفحة الأولى، من وراء ظهرك، فقررت يومها المواجهة، دفاعاً عن عزتك وكرامتك وشرف المهنة الحرة التي تنسّكت لها.
يومها نصحت لك بالروية، وبألا تواجه ربّ عملك، ووليّ نعمتك، ووالدك الروحي، وألا تخيّره بينك وبين ابنه، وشبّهت وضعك آنذاك بوضع المربية التي تصرّ على الجلوس في المقعد الأمامي في السيارة، على أن يجلس الابن في المقعد الخلفي، بينما يصرّ والده على إجلاسه في المقعد الأمامي، لتجلس المربية في المقعد الخلفي.
وواصلت عنادك على أساس أن صاحب الصحيفة قد تنصّل من العقد الأدبي القائم بينه وبينك، فشعرت بأن ثمّة من استباح حقك في حريتك، وهي مقدسة بالنسبة إليك، وأصررت على إسقاط عبارة «مستقلة» من شعار الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس «النهار»، والذي كان: «النهار حرة، مستقلة». فعاندت في ضرورة إسقاط «مستقلة»، لأن الصحيفة لم تعد، في نظرك، مستقلة، الأمر الذي جعلك في حلّ من التزامك الوجداني حيالها وحيال صاحبها، ولم تنفع معك مبررات صاحبها بأنه إنما فعل ذلك من أجل المحافظة على استمرارها وعلى ديمومة العمل فيها.
وإني لأذكر أنك منتصف السنة 2003، قررت الامتناع عن مراجعة المقالات السياسية وأحلتها جميعها عليّ، شفقة منك على صحتك.
وتغطية لهذا التحول، وجّهت رسالة في 10 حزيران 2003 إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العام تعلمه فيها بأنك فوّضت إليّ جميع القضايا الإدارية والمالية المتعلقة بالمحررين، على أن أشكل هيئة معاونين من المحررين تساعد في تحمل هذا العبء، «مما يُشعر المحررين بأن مطالبهم وحقوقهم مرعية دائماً على نحو مسؤول ومنصف». ولم يفدك ذلك كثيراً، إذ كانت حالك الصحية والنفسية تزداد تدهوراً مع طلوع كل «نهار»، إلى أن عزمت أخيراً على الرحيل بعد اتصال هاتفي بصاحب الصحيفة في حضوري، لم تبق فيه «الستر مغطّى»، وأسمعته كلاماً لا يصدق، وختمت بالقول على ما أذكر «لقد مرّضتني، وأنا الآن أتناول أربعة أنواع من الحبوب المهدئة، وأظنني سأتوجه إلى المستشفى بعد إنهاء هذه المكالمة». وبعد أيام قليلة، فتحت عليّ وقلت لي: «أنا هنا لأودّعك غير آسف، لأن كرامة الحرية أغلى عليّ من أي مال، وقد أعدت ما لقيصر لقيصر، ومشيت مع حريتي إلى باب الله. لقد فزت بحريتي، وهذا يكفيني». أيها الملاك الطاهر، لقد تحررت روحك وعادت إلى باريها في السماء التي كانت مقفلة في وجهك، لكنها فتحت لك إثر الزلزال المدمّر الذي تعرض له لبنان أواسط الخمسينات، فوجدت نفسك، وأنت الملحد آنذاك، في الكنيسة وجهاً لوجه مع زميلك مارك رياشي الذي سبقك إلى السماء. ومذ ذاك رحت تتعبّد للعذراء، وتقفل مكتبك يومياً في أوقات معينة ليلاً للصلاة. وزاد إيمانك بعدما تراءى لك أن السيدة العذراء قد أرسلت إليك من أنقذك من الموت رمياً بالرصاص في أحد أقبية زقاق البلاط ذات فجر من عام 1975، بعدما كنت خطفت مع زميليك فرنسوا عقل وإميل داغر. وقد أرسلت إليكم العذراء، بحسب ما تراءى لك، لكثرة ما صليت آنذاك وتضرّعت، أرسلت شيخاً يشبه الملاك إلى ذلك القبو، فتصدّى للمسلحين وأخرجكم إلى الضوء وقادكم محروسين إلى سيارتكم. فاطمئن يا رفيقي الحبيب، إنك ستلقى في السماء ترحيباً خصوصياً من زملاء لك سبقوك، وهم بانتظارك بعدما أعدّوا العدّة لإصدار جريدة هناك، ستكون حقاً «حرة ومستقلة»، لأن هاتين الصفتين لم تعودا موجودتين إلا في السماء، بعدما أفسدت الأرض كل شيء.
وستجد فوق: كامل مروّة وسليم اللوزي ورياض طه وغسان وجبران تويني، وسمير قصير، والياس شلالا (الماكيت والتصحيح) كلهم ينتظرون رئيس تحرير جريدة السماء. فنم قرير العين يا أنسي، لأن السماء هي التي ستنصفك، بعدما غدرت بك الأرض، وأنت الذي لم يحد عن درب القداسة.
* رئيس التحرير التنفيذي سابقاً
لجريدة «النهار»
وحيداً عاش… وحيداً مضى
عبيدو باشا
لم يستطع أنسي الحج إلا أن يفرض عنفه اللامتناهي على اللغة والناس. أنجاه تشفير العنف نفسه، من العنف الممارس على الآخرين. لا معادلات رياضية في ذلك. إجراء سلمي أمام القصيدة والآخرين لأن الشاعر، السامع أصوات الشعر المبهمة في أذنيه، أدرك أنّ الطرق المضمونة في الخروج من إبهام الأصوات الشعرية إلى القصيدة، لا تحتاج إلى بناء منطقة حرة ولا إلى سلطة تنتصر بالطريق إلى فرض إرادتها.
أدرك أن طريقه المضمون إلى ذلك، بتجسيد قوانين الفيزياء، بالدفاع عن النفس، لأن الكيمياء، أو قوانين الإختلاط، يستعملها البشر العاديون، بيسر لا يحتاج إلى رقابة، سواء في الحياة أو في كتابة القصيدة. لم ينضوِ الرجل في شبكة، من جراء ذلك. وجد أن الضلوع في الكون أسهل بكثير من محاولات تكسير الشيفرات السائدة. هذا مظهره الأساسي، هذا اعتراضه على من يسيطر على الشبكات الإفتراضية، المصنوعة بالترابط السلفي بين الناس والشعراء. ما اختار الأسهل. اختار الشجاعة والفطنة، لا المقاومة أو التضامن. مقاومة الأشياء والتضامن مع الآخرين. امكانياته موارده، من دون أعذار تتنصل من كل مطلب بالكلام، لا بتجفيف القنوات القديمة بملئها بالماء الجديد. لم يرغب أنسي الحاج بترميم التاريخ، لأنه أراد كتابته. كتب تاريخه بالخوف الدائم على نفسه وعلى شعره. كلما قرأ ديواناً سابقاً على خلفية صدور ديوان جديد، قرأ القديم بزمنه الجديد، مذعوراً من الهتافات والنداءات القديمة. مضى بعيداً، لأنه لم يمضِ باتجاه واحد. قرّاء دواوينه القديمة، لن يصعب عليهم إقتفاء الألحان الجنائزية الشرسة في القصائد. كلما كتب، كشف قوانين الشعر في الديوان، قوانين العالم المثالي، ما عاش الحاج على أنقاضه، حين وجده في إتمام القصيدة العربية على كمالاته. هكذا، بقي يبحث عن استقلاله الدائم. استقلال حقيقي. وإذ تعب، كتب خواتمه. الأخيرة لا يعوّل عليها وحدها في قراءة تجربة الحاج الأخيرة، بنقاءات اللغة فيها، لأنها كونفوشوسية، لا اصطدامات بروق فيها. ذلك أنّها خطت مساراً آخر في لجان الشعر. لغة فتل لا متناه، ضد لوالب اللغة في «لن» و«الرسولة» و«ماذا فعلت». غير أن التنقيب عن الكنوز القديمة في الصناديق القديمة، لا يفضي إلا إلى نعف الغبار عن الصناديق ونعف اللغة بعقدها السمعية والحفرية، على رسالات بدت بعيدة وغير صالحة للأيام المطلبية. تتفارز الأصوات على بعد سنوات من سباحة الأصوات في فضاءاتها الجديدة. شاهد الحاج ذلك في أحد أحلامه، بذلك طارد نفسه في اللغة وطارد اللغة في النفس، حتى أُنهك الإثنان. قصيدة الصباح البعيد، قصيدة المساء الراهن. لم يختل توازن الشاعر في منحه نفسه نذائر الاكتشاف عبر ملايين العمليات اليومية، البسيطة، الأشبه ببساطة الأيام. منحه ذلك سلطةً على سلطة. لن يحلم بذلك كثيرون، لأنّ كثيرين يفوتون المعلومات الأصيلة، وهم يتصفحون إنتاجاتهم بغامر الرضى والمودة، بالتخلي عن عمليات التنقيب. شعره من عالمه الحقيقي لا من تسهيلات التجارب السابقة. تسهيلات التخزين. أقام الحاج على مفهوم اللاتوازن، على مفاهيم الإختلال، ضد تطبيق المعلومات والأفكار والمعاهدات الشعرية. لم يرابط على شاطىء شعري ولا على كتف العالم الحقيقي، حيث بنى عالمه الخاص، الأكثراً تعقيداً وتطوراً، ضد تقفي الآثار من أجل تنمية الثروات المادية والروحية. نشوء دائم. ميزة لم يتمتع بها الآخرون القادرون على التأثير في العمليات الحياتية. لبّ الموضوع. لم يبقَ سري الحضور في طوافه بين علم الكلام عند المسلمين وعلم اللاهوت عند المسيحيين.
الأكيد أنّ أنسي الحاج ميّز تماماً بين الإيمان والمنظومة الدينية في الحياة والشعر. مؤمن لا جيزويتي. بين الإثنين بونات واسعة. وجد في الأديان تعبيرات ثقافية عن نهود الإنسان إلى المطلق. وجد وحدتها الجوهرية فيها. انتبه كثيراً إلى أنّ وحدة الأديان لا تستقيم خارج مفهوم تنازل الأديان عن مكون رئيسي فيها، هو ادعاء امتلاك الحقيقة. لاقى ذلك بأريحية الشبعان من الحياة والشعر. كتب حقيقته بالشعر، بدون ادعاء امتلاك الحقيقة في كتابة الشعر. كل ما حقّقه، تحقيق النسبية اللامتناهية، ما بدا للآخرين أنه إخضاع الأشياء إلى المزاج. لا صحة بذلك، لأن أكثر الخائفين من مزاج انسي الحاج هو أنسي الحاج، معبراً عن هذا الخوف بإعلان نفي الآخر منذ اللحظة الأولى، حتى لا يتكلف الخيبات المتتاليات من حروب أنسي الحاج على نفسه، معكوسة على كل ما هو من صنع الناس الآخرين. لا حدود لمزاج أنسي الحاج، لا حدود لضجره. لا يعبر صوته إلا عن ذلك. جرف الصوت الصوت إلى دائم الطفولة، بدون أن يسمح بأن يجرفه التاريخ. ترك صوته في الظن لا في التحقق. لم يتصف صوته بالتعالي، في حين بدا حضوره مطلق الحكمة وجسده مطلق القدرة. بقي الأخير على قوته الفائقة من ضجر أنسي الحاج من الوافد الجديد إلى جسده. كيان شعري، بروح حرة وجسد لم يعبّر البتة إلا عما يعتقد. شيء غير قابل للتوفيق باستمرار، إلا مع أنسي الحاج. قوة غير مذكورة في الكتابة عن الشعر، في حين استعملها الحاج في شعره كثيراً. قوة الجسد تقرير الله في شعر أنسي الحاج. حقيقة كيانية مستمرة. ما يشبه تحرير الروح من الحرف وتحرير الحرف من طرقاته المسلم بها. بواحدة من آخر لياليه، لم تبن مرافق الإختلاف بين الجسد والمرض. إذ فوجئنا بحضوره الأصولي في نزلة «أوتيل ديو». لم يسمح للمرض أن يمارس إرهابه عليه. انتصرت قوته على غريزة المرض. لا مرض في عينيه، لا مشكلة في قدراته. لم نبحث عنه في وقفته، حتى لا نجدها. لن نجدها، ما دام صاحبه، لا يجد سداد حياته إلا بالعيش على فوهات القصص الدائمة. ساير وسار. قصد محلاً قريباً من «الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا». هناك شرب عصير الرمان. داوم على ذلك في أشهره الأخيرة. وبدون أن يفكر مرتين، طار بدون عجز، إلا عجز المشاهد حوله، رقيقاً مثل شعرة، إلى مطعم. أكل ومضى، بدون أن يغوص في رعب الحالة، تاركاً خلفه علامات لا تعوض. لا انطباعات خاطئة معه. لأنه ليس فرداً. أنسي عدد، لا يكرر نفسه بالعدد. لا ينكر الرجل رنين الآخرين، يكتمه ولا ينكره، بقوة غيرة الآخر. لا يبحث عن ذلك، لأن سلوكه لا يجيء من النفس، بل من الآخر. وحيد نفسه لا يرغب بالآخر. وحيدٌ بقي وحيداً. هكذا عكس ضوءه على مرآة الكون بطنين مأنوس. ولكي يغذي شمسه، بدون استنفاد قوى، هب دائماً بالحفيف العصبي للآخرين. تحول إلى جذع، لا غصن، في تجربة الأخوين رحباني وفي صور فيروز الجانبية، وهي تتوارى في الجزء المظلم في العالم. لم يسترخِ في الترجمات المسرحية، أوَدَ خصور النصوص الأصلية، بمزاجه المتبختر صوب النجوم. بابتسامة تدوخ، عبر الفضاءات الشاسعة، لا في الشعر وحده، في المسرح كما في الشعر. روى أنطوان كرباج أنّ الحاج أخرجه من ظلال التمثيل إلى الأدراج، بعدما كتب عن أدائه في « الملك يموت». لا تزال نساء كثيرات يئنّن من بركاته. لم يشر إلى مؤامرة في حياته وهو يعبر من مغيب إلى مغيب.
بمداه الخصوصي، جاء إلى معرض الكتاب العربي. وجدني معلقاً على أكتاف الرواد كي لا يراني. لوّح، وإذ فعل، تولد تناغم في انحائه، لا أزال في ريحه الدائرة على عجلات العذوبة. رمزه الجديد. كماء سال في اللقاء الأخير وهو يقترب باليد من اليد وبطرف الخد من الخد الآخر. كماء سال في الموت. لن يطوى رأسه الماكر في عشب أو تراب، ما دام النور الأعظم، لا يزال يطوف بأزرقه الفاتح في الملحق/ الأساس. وحيداً عاش، وحيداً مضى، على ظن الآخرين بأنهم مواقيته وخطراته وخطواته وفروضه ووصفاته وجمله الأخيرة المقتضبة، غاية الإقتضاب. لا يعرف أحد أنسي الحاج. مات في نومه. أكل حبته الأخيرة ومات. خفض من إطالة بقائه باتلاف صحوه. أزاح عبء الموت بالموت. لا يزال قوياً، لا يزال ماهراً بامساكه بحياته حتى اللحظات الأخيرة. مات انسي في حلمه. لا يزال حياً إذن. لأن الموت بالحلم، ليس موتاً. الموت بالحلم خشونة مؤقتة، لا تنتهي إلا بالبكاء.
* كاتب ومسرحي لبناني
أُنْسِي نَائِم
حبيب يونس
كان كمثل ما وصف الكتاب المنشور: وردة في حقل ألغام.
أنسي الحاج ما كان سوى كتابه… وما ابتسامته إلا تلك الوردة. ويبقى، كتاباً وابتسامة وغياباً، الطفل في حضوره الكثيف حتى الأراجيح:
أَلْبَسَ النَّبْعَ «خَوَاتِمْ»
وَأَعَدَّ الْوَرْدَ لِلشِّعْرِ «وَلِيمَهْ»
ثُمَّ فِي التَّرْحَالِ غَابْ
وَهْوَ قَادِمْ…
مِنْهُ لَمْ يَبْقَ سِوَى ثَغْرٍ شَفِيفٍ
كَتَبَ الْعِطْرُ عَلَى الْعِطْرِ فُصُولَهْ
بِالْمَبَاسِمْ…
بِالنَّيَاسِمْ…
مِنْهُ لَمْ يَبْقَ سِوَى شَمْسٍ قَدِيمَهْ
كُلَّمَا أَشْرَقَ حِبْرٌ فِي كِتَابْ
أَيْقَظَ النَّبْعُ «الرَّسُولَهْ»،
نَهَضَتْ، قَالَتْ لِشَعْرٍ،
أَرْخَتِ الْأَيَّامُ لِـ»الْكِلْمَاتِ» طُولَهْ:
خِصْلَةٌ مِنْكَ وِسَادٌ
خِصْلَةٌ ثَكْلَى… غَطَاءْ.
صَمَتَتْ…
حُزْناً جَرَى نَهْرُ الْبُكَاءْ:
رَتِّبِ التُّرْبَ سَرِيراً
رَاقِدٌ أُنْسِي… وَنَائِمْ.
حبيب يونس
18 – 2 – 2014
يا ألله…
أهو الخريف تتساقط أوراقه الصفر شاعراً تلو شاعر؟
أم هو ربيعنا… الذي علمتنا صلوات زهره في عظة الشعر، فصلينا.
أنسي الحاج «لن»… ترحل.
* شاعر وصحافي لبناني
مرثيات على جدار الفايسبوك
■ أصنّفُ شعر أنسي الحاج ضمن رفّ خال إلا منه. لا يشبه أحداً، ولن يمس تخومه أبداً. والسرّ، سرّ أنسي الحاج أنّه يكتب بمشاكسة الهواة، لا بخبرة المعلّم: إنه مخلص لشعوره أكثر من إخلاصه للقصيدة وشكلها. إنه شِعر محض، لا يُحيل إلى أب أو إلى نسق ما، لكنه يجسّد التوتر بأنقى أشكاله، والعمق بأصفى ما فيه.
سهل وصعب، ومشع بشكل يجعل القارئ مؤمناً أنه قريب من اللؤلؤة، وما من
لؤلؤة!
عبد العظيم فنجان (شاعر عراقي)
■ أنسي الحاج غادر. ينبغي أن نعيد قراءته. أحسبه لم يُقرأ بما يكفي. كان نصّه دائماً موصوماً بالاستغلاق. مَن يقرأ «ماضي الأيام الآتية»، لن يجد نص أنسي مستغلقاً. سيجده بالعكس قريباً وعارياً ومباشراً. إنه يكاد يكون نصاً برياً، عودة الى نوع من براءة اللغة. وداعاً صديقي
عباس بيضون (شاعر لبناني)
■ اذهبْ إلى الطبيعةِ
أنتَ، هوَ، هيَ
يتحابان.
وأنتَ وحدَك
تتحاب
وتعشقك الطبيعة.
أنسي، لا داعي لبقية الاسم!؟
أسمّي هذه القصيدة: «الفاتحة» لأنها مثل «بسم الله الرحمن الرحيم»، و«بسم الآب والابن والروح القدس»، سورة، مؤلفة من خمس آيات، تشرح الثالوث المقدس.
منذر مصري (شاعر سوري)
■ شاعر «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع» ها أنه عاد الى النبع، من حيث الثراء كله
أنطوان أبو زيد (شاعر لبناني)
■ أكثر من 70% من السوريين كانوا معجبين بجورج وسوف. وأخمّن أنّه ما زال نصف هؤلاء على الأقل حين يسمعونه يطربون له رغم أنه يستحق لقب «شبيح». أنسي الحاج كان شاعراً. لم يكتب مدحاً بآل الأسد، لا بالأب ولا بالابن.
كان له موقف خاص به. لم يشبح، لم يشتم الثورة، لم يسئ للسوريين، لم يقتل السوريين، لم يتحدث بالسياسة، لم يؤيد القتل. إن لم تعلمنا الثورة احترام الرأي المخالف والمختلف فنحن في مصيبة كبرى، ثمة من يعتبرهم كثيرون رموزاً في الثورة أساؤوا للثورة ولسوريا عميق الاساءة.
نصف من يسمّون أنفسهم ثواراً ما زالوا حتى اللحظة يعتبرون صدام حسين بطلاً قومياً، وهو لم يكن أكثر من ديكتاتور مجرم وقاتل، وثمة من يريد نسف تاريخ إبداعي كامل لأحد بسبب جملة أو كلمة. شخصياً، أحبّ شعر أنسي الحاج واعتبر رحيله خسارة. وما زلت حتى اللحظة أستمتع بموسيقى زياد الرحباني ويأخذني صوت فيروز إلى عالم الاسترخاء،
ويعيدني صوت وديع الصافي إلى سوريا. وربما لو كانت أم كلثوم حية إلى الآن، ربما كانت تقف في صف الطاغية وكنت سأظل أسلطن على صوتها وتسكرني أغنياتها، وكنت سأنتقد موقفها السياسي بقسوة وأسجّل اعتراضي عليه.
رشا عمران (شاعرة سورية)
■ وداعاً أنسي، آخر أنبياء لبنان الحقيقيين
زياد بركات (كاتب فلسطيني)
■ أنسي الحاج، ابن مصحة قصيدة النثر. أخذ من السماء واﻷرض شوق اﻷمس. وقبل أن يقولوا لا، قال «لن». ولم تهدأ الطبيعة بعد.
زاهر الغافري (شاعر عُماني)
■ خسارة الشعر والأدب هائلة، وخسارة لبنان أكبر هولاً
وفاة أنسي الحاج. رحل الذي قال «لن»!
دخيل الخليفة (شاعر كويتي)
■ أنسي الحاج بالنسبة لي مقترن بالحب. مع أنني منذ ذاك لم أعد أحبه. وليس بسبب آرائه. الآن أذكر ما كان يعنيه لي. ما كان يعنيه الشعر.
حازم العظمة (شاعر سوري)
■ أنسي الحاج، ألستَ أنتَ القائل إنّ الشعراء يعيشون أكثر من الأحياء ويموتون أكثر من الموتى؟ باق أنت في مَن يشبهكَ!
عيسى مخلوف (شاعر لبناني)
■ لا أعرف إن كانت الرسولة ستأتي لتضع شعرها فوق الذهب، أم أنها تأتي لك بوردة الينابيع.
قد تجلس هي، بيننا الآن لتبكي، ولن يشاهدك سواها وأنت تقف لتقول لها: «تقولين البكاء يغمر، كالضمة/ تعالي. سأكون أنا البكاء إلى الأبد»
إسكندر حبش (شاعر لبناني)
■ كم موتاً مشابهاً لموت أنسي الحاج يلزم بعضنا… لكي يُدرك؟
شاكر لعيبي (شاعر عراقي)
جمعية الشعراء الموتى/ عباس بيضون
لم يعد الموت موضوعاً شخصياً، انه القانون. لكأنه يحدث خارجنا، لكأنه يحدث بعيداً عنا. لم يعد للكائن لم يعد للحياة كنهها التراجيدي، معناها البطولي على نحو ما. كان الناس يغيبون في معركة أو هكذا يتخيلون. كانت الحياة بطولها هذه المعركة. الآن نراهم يتعثرون فحسب، الآن لا يستحق الأمر أن نواجه. البراميل المتفجرة لا تترك مجالاً لمعركة. انها تخمد فحسب. الناجون الذين ربحوا حياتهم بدون أي صراع، يعرفون انهم قد يخسرونها في المرة القادمة. لم يستحقوها. لم يكسبوها بحق. كل ما في الأمر أن الحظ أسعفهم. مع ذلك يبقون في عهدة الموت. هم ولو نجوا أموات بالقوة. انها فقط صناعة الموت، الطائرات والمدافع تشتغل ذلك طوال النهار، تنقله من جهة إلى أخرى لكن الشغل مستمر، الجميع تحت رحمته. انه لا يسمح بأن نعاني، يحدث ذلك بوميض لحظة. لا يملك الواحد أن يفكر حتى يصبح نصفين، حتى يتحول رمة، حتى يختنق تحت الردم، لا وقت لأن يفكر، لا وقت لأن يواجه. حظه يسقط عليه بغتة، وبغتة حتى عن نفسه، يغدو حطاماً، التمثيل بالجسد لا يحتاج إلى أكثر من برميل متفجر. الجسد عندها يغدو أمثولة. لا يبقى له الوجه الذي يقابل به ربه، لا يعود له حتى الجسم الذي سكنه طويلاً. يكفي أن نرى رمه كهذه، حتى نفهم أن بوسع الجسد أن يصبح هكذا، أن في وسع الحياة أن تغدو هكذا. لا سبب لننفعل، لا سبب لنحزن. لا سبب لنتأسى، الحياة تظهر ما عندها، الجسد يخرج ما عنده، انهما مرصودان لهذا التحول.
حين يصرخ رجل، حين يصل أنينه إلى السماء، لن يسمح أحد. لن يعتبر أحد حتى هؤلاء الذين يسمعون. الجسد فقط يقول حقيقته. الحياة تقول حقيقتها، لا شيء يحدث استثناء. لا شيء يحدث خارج القانون. لا شيء يبعد عن قابليات الأجساد وقابليات الأشياء وقابليات الحياة نفسها. انه مجرد تفاعل. انها فقط معادلة، اختبار فحسب. الديناميت وربما الغاز السام مع الجسد البشري. لا تعني هنا الهيئة. لا تعني الموهبة، لا تعني العلاقات، الصفات الشخصية، لا تعني الحياة نفسها. انه فقط القانون المعجز. أليس التحول في ثانية واحدة نوعاً من الإعجاز. أليس الدمار في ثانية نوعاً من الإعجاز. أليس صعق حياة في ثانية نوعاً من الإعجاز. المعجزة تتوالى والمهم النتائج. المهم الأرقام. تضاف الضحية إلى رقم، تنضم إلى رقم. لن يكون في مقدورنا أن نعرف أين هي في تلك الكتلة الموضوعية التي هي حصيلة حسابية. لن نتعرف عليها في هذا السديم الموضوعي الذي ليس فيه أي خصوصيات. انهم يموتون ويضافون إلى موتى، ولن نعرف سوى هذا الرقم الذي يموت بدوره حال ظهوره. لن يطول ترددنا الأخلاقي. شعورنا اننا في تعاملنا مع أرقام متغيرة هكذا نتواطأ مع الموت لن يطول. يستحيل أن نتعرف على كل واحد، أن نحفظ كل اسم. وما هو الفرق بين أن يكون الواحد رقماً أو اسماً. أشياء كهذه تجرنا إلى نوع من السبات الأخلاقي. ماذا نفعل. نحتج أولاً، ثم نرضخ، نبدأ بالخجل من أنفسنا ثم نستسلم. نتعامل بعد ذلك مع الحصيلة الحسابية اليومية، يوماً بيوم، لكل يوم رقمه، نترك الأرقام تتضخم في مكان آخر، نترك التعداد في مكان آخر. ثم نسمع بصوت بارد أن القتلى جاوزوا المئة وخمسين ألفاً. ليس هذا التعداد الصحيح بالضرورة. انه رقم تقريبي وفي الغالب عرضة للخطأ. قد يكون الرقم الحقيقي مخيفاً أكثر. الرقم المخيف لا يقال لكنه يؤكد أن ليس من أحد يمسك حقاً زمام الأمر. يؤكد أن الإحصائية ليست صحيحة. نسأل كم ألفاً، كم عشرين ألفاً سقطوا من الحساب. ربما سقطوا إلى الأبد. ربما نجدهم بعد حين. لكن هذا لا يهم أيضاً. الرقم ليس حياً ومن يبقون فيه لن تكتب لهم أي حياة.
الشعراء الموتى، على أي قائمة سيظهرون. هل هناك شعراء أحياء أم انهم يستحقون هذا الاسم بموتهم. هل نذكر فيلم «جمعية الشعراء الموتى» ألا يكون الشعراء إلا موتى.. قبل ذلك ماذا يكونون. يهيئون موتهم، إلى كم قصيدة يحتاج الشاعر ليستحق موته. أذكر سركون بولص في لوديف وهو يقول لي ان رئتيه امتلأتا ماء وأن حبة ملح كافية لتخل جسمه، بعد أشهر علمت أنه ينازع في ألمانيا. أعادت “الجمل” طبع مؤلفاته لكن هل هناك بعد من يهتم بأن يؤكد بأنه أحد أكبر شعرائنا المعاصرين، هو الذي كان أيضاً أحد كبار العارفين بالشعر لكن غير مهتم بأن يثبت شيئاً. ماذا يعني رحيل الشاعر هل هي مناسبة لمراجعة أثره أم انها إذن بتنحيته والإشاحة عنه. محمود درويش الذي نشر له ديوان بعد رحيله. لم يكن برغم ما قيل مستعداً للرحيل. لقد كان موته مؤثراً وصار قبره مناراً وما زال اسمه حاضراً بقوة لكن ثمة من يهمس بأن قراءته تقل. هل يعني ذلك أنه دخل المطهر وانه الآن قيد مراجعة، أم يعني أن شاعراً في شهرته ووزن لا يستطيع أن يخترق ما شبه قانوناً عربياً هو خيانة الموتى. حين يدخل هؤلاء إلى التاريخ يجري عليهم اشكالنا مع التاريخ وبخاصة المعاصر، انه نوع من رهبة لا تجعلنا نعترف بحاضرنا على انه تاريخ لنا، ولا تجعلنا نلقي بالاً لما يتراكم فيه ولم يترسم داخله. انه نوع من نسيان الحاضر لا يكاد ينجو منه أحد، طه حسين وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ قد يكونون الاستثناء الذي يثبت القاعدة.
إذا كان الأمر كذلك فماذا نفعل بجمعية شعرائنا الموتى. هل هي حقاً واهنة، أم انها تحتاج سياقات وسيرورات ليست موجودة عندنا. لفرط ما نظن أنفسنا أمناء فنحن ساهون. ليست خيانة انها ضرب من القطيعة. نوع من فقدان التاريخ ولا أذكر بالضبط كم عاماً مر على وفاة بسام حجار. اسمع أن هذا الشاعر السري يتسرب نصّه بدرجة أو بأخرى بعد رحيله. فرصة كهذه يجب أن تعطى لشاعر، للشعراء المكتومين وللشعراء المعلنين لأن الحاضر أيا كان فهو في الغالب فرصة كاذبة. نحن إلى الآن لا ندري إذا كان للشعراء فرص أصلاً. لقد كان الشعر العربي هو المبادر إلى التحديث. لا ننسى أن التحدي اخذ لفترة اسم الشعراء أولاً وهذا شيء أقنع الشعر حينها بأنه بديل عن الثقافة وأحياناً بديل عن التاريخ. كتب جوزيف حرب أطول قصيدة في تاريخ الشعر ولا نعرف إلى أي مدى دخلت تاريخ شعرنا؟ أنسي الحاج في “لن” كتب بيان انتفاضة شاملة. لم تحتمل الثقافة العربية “لن” في حياة أنسي ولا أعرف إذا كانت ستعود إليه بعد موته. تلك فترة رسولية الشعر وهي فترة انتهت على كل حال فقد بدأ الشعر منذ مدة فترة ترهبه وانزوائه. ذلك في الأرجح من عوارض انحدار الثقافة وقد يكون في أساسها، خلو الثقافة العربية من الشعر هو بالتأكيد مظهر دفاع. لا يكفي القول ان الرواية هي البديل فحتى الرواية لا تلقى رواجاً كافياً، وليس واضحاً انهم لم يباشروا بعد تأسيس “جمعية الروائيين الموتى”.
السفير


