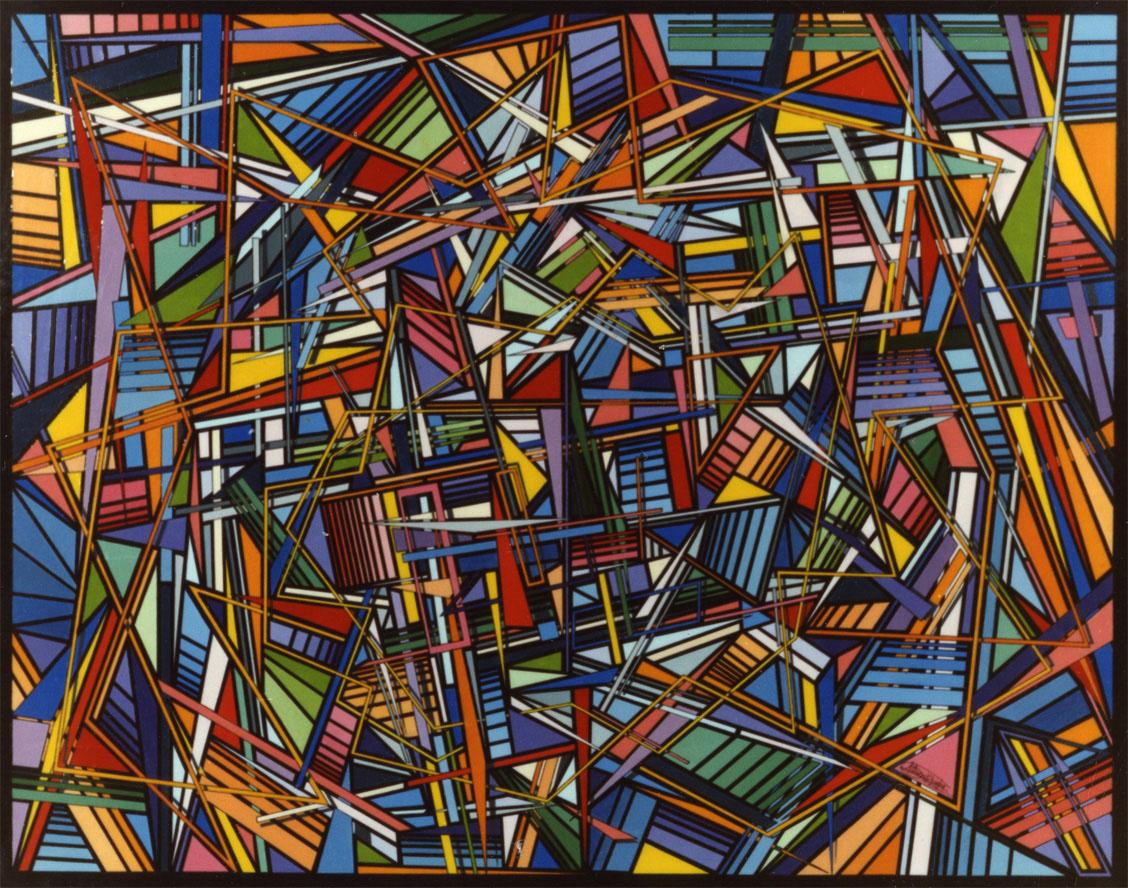النقص الديمقراطيّ لدى ديموقراطيّينا/ حازم صاغية

إبّان المراحل البرلمانيّة، المتقطّعة غالباً، في بلدان المشرق العربيّ، ظهر سياسيّون وقوى سياسيّة نسبوا أنفسهم إلى الديمقراطيّة مصحوبةً بلون من الحداثة. بعضهم أسّسوا أحزاباً. بعضهم كتبوا وساجلوا. بعضهم كانوا نضاليّين في دعوتهم. هؤلاء لم يكونوا سياسيّين تقليديّين وعائليّين، أو لم يقدّموا أنفسهم كذلك.
لكنّ الحصيلة كانت سلبيّة لأسباب تتعدّاهم بالطبع، مع أنّهم مسؤولون عن بعضها: لقد عجزوا، لأسباب شتّى، عن تأسيس كيان صلب للديمقراطيّة وثقافتها، وعن إحداث اختراق ديمقراطيّ جدّي للسياسة.
مع “حزب الوفد” المصريّ، المؤسّس في 1919، بدأت الحياة الحزبيّة الحديثة في المشرق. هو لم يكن الحزب الأوّل، لكنّه كان الأكبر والأهمّ. سعد زغلول وصحبه من الأعيان والوجهاء، الريفيّين والمدينيّين، تأثّروا بـ “حزب المؤتمر” الهنديّ الناشىء في 1885. الموضوع الاستقلاليّ كان الشاغل الأساسيّ للحزبين.
بعد رحيل زغلول في 1927، تنافس على القيادة فتح الله بركات، ابن شقيقه، ومصطفى النحّاس، سكرتير الحزب العامّ. الثاني فاز بالانتخاب على الأوّل. النتيجة جاءت مفاجئة، ليس فقط لأنّ الانتخابات الحزبيّة لم تكن مألوفة، بل بسبب اعتقاد مفاده أنّ زغلول كان يرغب في أن يخلفه قريبه.
التجربة متقدّمة تُحسب لـ “الوفد”.
النحّاس أعطى الأولويّة للمسألة الديمقراطيّة في الحياة السياسيّة المصريّة: معاركه كانت متّصلة مع الملك فؤاد حتّى رحيله في 1936، ثمّ مع ابنه فاروق. الحدّ من سلطة الملك قضيّته. الحدّ من سلطة “الوفد” قضيّة الملك. الأخير، لأجل هذا الهدف، احتكر “القضيّة الوطنيّة” وأنشأ حوله تحالفاً من الرجعيّين المناهضين لبريطانيا: الشيخ مصطفى المراغي وأحمد حسين وحسن البنّا والضابط الانقلابيّ، البروسيّ الهوى، عزيز علي المصري، أستاذ “الضبّاط الأحرار” اللاحقين.
في هذه الغضون قاوم النحّاس، وهو مؤمن، إقحام الدين في السياسة. رفض تنصيب فاروق في احتفال دينيّ لأنّه “ليس في الإسلام سلطة روحيّة”. وردّاً على استخدام أحمد حسين، زعيم “مصر الفتاة”، شعار “الله – الوطن”، هاجمه النحّاس واعتبر استخدام الله في السياسة “شعوذة”.
معاركه دفاعاً عن الدستور، ضدّ المَلكيّة المطلقة لفؤاد، بلغت ذروتها في 1930، وعرّضته لمحاولة اغتيال في المنصورة. الحلف المحيط بفاروق كان مسؤولاً عن محاولات عدّة لاغتياله. الضابط أنور السادات كان واحداً من المكلّفين بالاغتيال.
لم يساوم النحّاس مع عبد الناصر بعد انقلابه. في مطالع 1953، حُلّت الأحزاب بما فيها “الوفد”. النحّاس رفض دوماً عسكريّة النظام والحكم الديكتاتوريّ. منذ انقلاب يوليو 1952 حتّى وفاته ظلّ يعارض عهد ما بعد الانقلاب. لم يضعف أمام سحر القائد، ولا أمام “انتصاراته القوميّة”.
في العهد الناصريّ، خضع للمراقبة وحُدّدت إقامته ومُنعت زيارته وحُرّم ذكر اسمه في الصحف.
مقابل هذا الرصيد المضيء، تعطّلت الانتخابات داخل “الوفد” منذ انتُخب النحّاس على رأسه. ما هو أسوأ سبق أن حصل في أواسط الثلاثينات: مع موجة الحركات الشبابيّة المتأثّرة بالفاشيّة، لا سيّما “القمصان الخضراء” التابعة لـ “مصر الفتاة”، ضعف “الوفد” والنحّاس أمام هذا الإغراء. هكذا نشأ، أوائل 1937، تنظيم “القمصان الزرقاء” الوفديّ بحجّة الدفاع عن الوفديّين وعن الديمقراطيّة.التنظيم انبثق من “رابطة الشبّان الوفديّين” التي تولّاها المحامي زهير صبري، وبدأ بفرقتين طلاّبيّتين حملتا اسمي عبد الحكيم الجرّاحي وطه عفيفي. هذان الأخيران كانا قد قُتلا على أيدي الجنود البريطانيّين في 1935.
النحّاس لم يكن مطعوناً بوطنيّته: ففضلاً عن الأصل الاستقلاليّ لـ “الوفد”، كانت حكومته من أنجز المعاهدة الاستقلاليّة الشهيرة في 1936. في أزمة 2 فبراير 1942 بين الملك والبريطانيّين، في ذروة الحرب الثانية، لم يؤلّف الحكومة إلاّ خضوعاً لإنذار بريطانيّ.
مع هذا، وحتّى في “الوفد”، ظلّ النقص الديمقراطيّ يستعين بالقوميّة ورموزها. والحال أنّ “الوفد” بدأ يتغيّر منذ “القمصان”. شوارع القاهرة والاسكندريّة ومسيراتهما صارت مسرحاً لصدامات متكرّرة بين “الخضر” و”الزرق”.
داخل “الوفد” نفسه، ضاقت فسحة النقد. النحّاس ما لبث أن طرد قياديّين بارزين خالفاه الرأي: محمود فهمي النقراشي وأحمد ماهر اللذين أسّسا حزب “السعديّين”.
في العراق، عُدّ كامل الجادرجي الداعية الأبرز للديمقراطيّة. هو ورفيقه محمّد حديد كانا الأقرب لأن يمثّلا السياسيّ الديمقراطيّ الحديث. رفضا العنف في السياسة. حاولا بناء ما نسمّيه اليوم “يسار الوسط”، أو ما أسماه الجادرجي “ديمقراطيّة إشتراكيّة” متأثّرة بحزب العمّال البريطانيّ وبالأفكار الفابيّة. يومذاك، بعد الحرب العالميّة الثانية، كان حزب العمّال، بقيادة كليمنت أتلي، يبني دولة الرفاه ومجانيّة الطبّ في بريطانيا.
على مدى الأربعينات رفض الجادرجي أشكال العمل السرّيّ، مقترحاً نشر الأفكار والممارسات الديمقراطيّة في المجتمع. وفي 1946 عارض بقوّة سامي شوكت وقوميّته الشوفينيّة واعتبر أنّه يجسّد “بعث الفاشيّة في العراق”، بحسب العنوان الجامع لمقالات كتبها ونشرها عامذاك. سامي شوكت كان من المحيطين بساطع الحصري، تولّى مديريّة المعارف العامّة. أسّس “حركة الفتوّة” التي شارك الكثيرون منها في انقلاب رشيد عالي الكيلاني في 1941. قلّد هتلر في شكله وشاربه وملبسه الميليشيويّ، وأطلق العنان للاساميّته، كما مجّد “صناعة الموت”. سمّاه الجادرجي “موسلي العراق”، تيمّناً بالفاشيّ البريطانيّ أوزوالد موسلي.
لكنّ الجادرجي كان أشياء أخرى أيضاً.
بداياته كانت على قدر من الاختلاط. بعد مناصرته للسياسيّ القوميّ العربيّ ياسين الهاشمي، انضمّ في 1933 إلى جماعة “الأهالي” التي استمدّت اسمها من صحيفة “الأهالي” الصادرة في 1932. الجماعة أرادت التخلّص من اتّفاقيّة 1930 مع بريطانيا بهدف الحصول على استقلال كامل.
لقد كانت جماعةً عراقيّة وطنيّة عابرة للأديان والمذاهب والإثنيّات، لكنّها انطوت على سائر التلاوين الإيديولوجيّة. عنها تفرّعت “تشكيلات سرّيّة” كان في عداد المنضوين فيها الزعيم التاريخيّ الذي يُرجّح أنّه مؤسّس “الأهالي”، جعفر أبو التمّن. لكنْ انضوى فيها أيضاً بكر صدقي الذي تولّى تنظيمها العسكريّ، وفي 1936 نفّذ الانقلاب العسكريّ الأوّل في العالم العربيّ.
الجادرجي وافق على المشاركة كوزير اقتصاد في حكومة الانقلاب التي رأسها حكمت سليمان، المنتمي بدوره إلى “الأهالي”. المبرّر الذي غالباً ما أورده لاحقاً هو قمعيّة وسوء حكومة ياسين الهاشمي التي انقلب عليها الجيش، وهي قمعيّة وسيّئة بالتأكيد. اختلف الجادرجي مع بكر صدقي وبعد نحو ثمانية أشهر استقال من حكومة سليمان اعتراضاً على “تدخّل الجيش في أمور الحكومة”. اضطرّ إلى مغادرة العراق.
“الأهالي” تفرّعت لاحقاً إلى شيوعيّين وقوميّين عرب وديمقراطيّين عراقيّين. في 1946 أسّس هؤلاء الأخيرون، وعلى رأسهم الجادرجي وحديد، “الحزب الوطنيّ الديمقراطيّ”. لكنْ بدل الاتّعاظ بتجربة 1936، أيّد الجادرجي انقلاب 1958، وإن تراجع عن تأييد عبد الكريم قاسم. حليفه ورفيقه محمّد حديد تولّى وزارة المال واستمرّ على صلة جيّدة بقاسم حتّى بعد تركه الوزارة في 1960. هكذا شهد الحزب أخطر انشقاقاته التي دمّرته عمليّاً.
في 1962 حلّ قاسم “الحزب الوطنيّ الديمقراطيّ” الذي لم تقم له قائمة بعد ذاك.
مجيد خدّوري في كتابه “عرب معاصرون – دور الشخصيّات في السياسة” (جون هوبكنز) أقام نوعاً من التوازي بين الجادرجي وكمال جنبلاط، من غير أن يعطي الأهليّ – الطائفيّ كلّ حقّه في ما خصّ الثاني.
لقد أسّس جنبلاط، في 1949، “الحزب التقدّميّ الاشتراكيّ” الذي قدّمه بوصفه اختراقاً ديمقراطيّاً وحديثاً لتقليديّات السياسة اللبنانيّة. أحاط نفسه بوجوه مثقّفة مسلمة ومسيحيّة كعبد الله العلايلي وكلوفيس مقصود وموريس صقر. لكنّ هذا كلّه لم يحجب حقيقة أنّ الحزب وعاء لزعامة جنبلاط الدرزيّة والتقليديّة.
أفكاره المعلنة كانت خلطة غير متجانسة من اشتراكيّة وديمقراطيّة معطوفتين على روحانيّات آسيويّة وصوفيّات وأديان توحيديّة. إفراطه في التركيز على الديمقراطيّة كان ملحوظاً، خصوصاً في معارضته عهدي الرئيسين بشارة الخوري (الذي زوّر انتخابات 1947) وكميل شمعون (الذي زوّر انتخابات 1957). لكنّ حزبه لم يكن أفكاراً إلاّ بالحدّ الأدنى. ففي الحزب كانت سلطة جنبلاط حديديّة وأوتوقراطيّة الطابع.
خارج الحزب، كان أهمّ العناصر الدافعة لحركته نزاعه مع زعامات الجبل المارونيّة الذي يضرب جذره في حقب أسبق. ذاك أنّ جنبلاط كان أحد أعمدة العهد الشهابيّ الذي هو أقلّ العهود ديمقراطيّة في التاريخ اللبنانيّ الحديث. إلاّ أنّ ذاك العهد خاصم خصومه الموارنة، وعلى رأسهم كميل شمعون. إذاً: لا بأس.
وكرهاً بشمعون و”المارونيّة السياسيّة”، التحق جنبلاط بالتيّار الناصريّ العريض بعد 1956، ثمّ اندمج سياسيّاً وعسكريّاً في المقاومة الفلسطينيّة بعد 1975. ولئن كانت الأخيرة غير معنيّة بالديمقراطيّة، وتنتمي إلى خارج الجماعة السياسيّة اللبنانيّة، فالأولى مناهضة تعريفاً للديمقراطيّة.
هذه الانحيازات المرفقة دوماً بالعنف لم تنجم عن إغلاق أبواب التغيير السياسيّ بما قد يبرّر اللجوء إلى أدوات غير شرعيّة. صحيح أنّ ظروف التغيير السلميّ في 1952 لم تعد متوافرة بالدرجة نفسها في ظلّ الاستقطابات التي أحدثتها الناصريّة. لكنْ حتّى في 1958، وُجدت كتلة مسيحيّة معتبرة مناهضة لشمعون على رأسها البطريرك المارونيّ بولس المعوشي وحميد فرنجيّة، وفي عدادها قيادات كجون عزيز ونسيم مجدلاني وفؤاد غصن وغيرهم. لقد كانت هناك فرصة للسياسة هُجرت بسرعة نحو العنف.
الشيء نفسه يقال بمزيد من التوكيد في الفترة التي انتهت بحرب السنتين 1975-76. فعلى رغم التوتّر والاستقطاب اللذين أثارهما الوجود المسلّح للمقاومة الفلسطينيّة، تمكّن جنبلاط، بوصفه وزيراً للداخليّة، من أن يمنح الترخيص الشرعيّ لأحزاب عقائديّة كالشيوعيّ والقوميّ السوريّ. ثمّ في انتخابات 1972، فاز الناصريّ نجاح واكيم والبعثيّ عبد المجيد الرافعي، وخاض الانتخابات أمين عام الحزب الشيوعيّ نقولا الشاوي.
الديمقراطيّة، بالتالي، كانت أضعف ما تكون في حالة جنبلاط. في “هذه وصيّتي” الذي كتبه بالفرنسيّة قبيل مصرعه في 1977، بدا واضحاً أنّ استعداده للتعايش مع الموارنة والعلويّين صفر. الاستعداد العنصريّ بدا، في المقابل، خصباً جدّاً. المبرّر اللفظيّ كان دائماً: “المسألة القوميّة”. لكنْ حين اغتالته القوّات السوريّة، لم يترك الاغتيال أيّ أثر على الديمقراطيّة اللبنانيّة وثقافتها. أثره كان حصراً على الطائفة الدرزيّة وزعامتها وتحالفاتها.
أكرم الحوراني يبقى البطل التراجيديّ ورجل النقائض الأبرز في المشرق. ديمقراطيّ جدّاً وقوميّ جدّاً وطبقيّ جدّاً: إنّه خليط انفجاريّ يهدم بيد ما يبني بيد أخرى. هذا المسار يمكن رصده على امتداد حياته السياسيّة والحزبيّة: في الحزب “الاشتراكيّ العربيّ” الذي أسّسه في حماة ثمّ في “حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ” الذي جاء حصيلة اندماج حزبه و”حزب البعث العربيّ” لميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار.
ديمقراطيّة الحوراني تبدّت في دفاعه عن الاستقلال السوريّ وعن “الجمهوريّة” في مواجهة الملكيّتين الهاشميّتين. في رفضه استيلاء الضبّاط على السلطة بعد إطاحة أديب الشيشكلي في 1954 ثم بعد عصيان قطنا عام 1957. في معارضته المتطرّفة لأنظمة الاستبداد العسكريّ، من عبد الناصر ابتداء بـ 1959، حين استقال من مناصبه في “الجمهوريّة العربيّة المتّحدة” إلى البعثيّين العسكريّين، تلامذته السابقين، ابتداءً بـ 1963.
قوميّته تجلّت في تطوّعه، عام 1941، في العراق لنصرة انقلاب الكيلاني، ثمّ في فلسطين في 1948.
طبقيّته جعلته “زعيم الفلاّحين”، ودفعته إلى الصدام الحادّ بعائلات ملاّكي الأراضي في حماة (العظم، البرازي، الكيلاني)، وعقد مؤتمر حلب الفلاّحيّ الشهير صيف 1951.
تذليل العلاقات الطبقيّة الجائرة وتحسين شروط الفلاّحين لم يعهد بهما إلى العمليّة السياسيّة نفسها، ولم يستبعد منهما اللجوء إلى العنف. وهنا، أيضاً، لم يكن الباب مسدوداً أمام السياسة: مثلاً، في انتخابات 1949، نجح الحوراني وحده فيما نجح ستّة من لائحة الملاّكين. في انتخابات 1954، حصل العكس تماماً: فاز الحوراني ومعه خمسة من لائحته، ولم يفز من لائحة “الإقطاع” سوى عبد الرحمن العظم.
لكنّ “المسألة القوميّة” هي التي كان لها اليد السوداء الأطول على ديمقراطيّته. في العراق ثمّ فلسطين، توثّقت علاقة الحوراني بالضبّاط، لا سيّما منهم الحمويّين (أديب الشيشكلي، عبد الحميد السرّاج، مصطفى حمدون، عبد الغني قنّوت، بهيج كلاّس…). ولإدراكه المبكر أهميّة الجيش في السياسة، وثّق علاقاته بتلامذة الكلّيّة الحربيّة في حمص. معارضته مرّتين لاستيلاء الجيش على السلطة، ترافقت مع إسهامه بتمكين الضبّاط “القوميّين” و”التقدّميّين” من الإمساك بعنق الحياة السياسيّة والديمقراطيّة. الضبّاط هم الذين فاوضوا عبد الناصر على وحدة 1958 ثمّ جرّوا وراءهم السياسيّين. معارضته الوطنيّة والديمقراطيّة للهاشميّين، لم تمنعه من غضّ النظر عن الوطنيّة والديمقراطيّة طلباً للوحدة مع مصر الناصريّة (مع أنّه في مذكّراته تحدّث عن تحفّظات لديه، اضطُرّ إلى ابتلاعها تجنّباً للاتّهام بـ “الخيانة القوميّة”). في حربه اللاحقة مع عبد الناصر، استعمل فلسطين واتّهم عبد الناصر بأنّه يعمل للصلح مع إسرائيل أكثر ممّا استخدم الديمقراطيّة السوريّة كنموذج مناهض للنموذج العسكريّ الناصريّ.
لقد توفّي أكرم الحوراني عام 1996 في عمّان، وهناك دُفن. يومذاك، كان انقضى عامان على اتّفاقيّة السلام الأردنيّ – الإسرائيليّ التي عُرفت بوادي عربة.
موقع درج