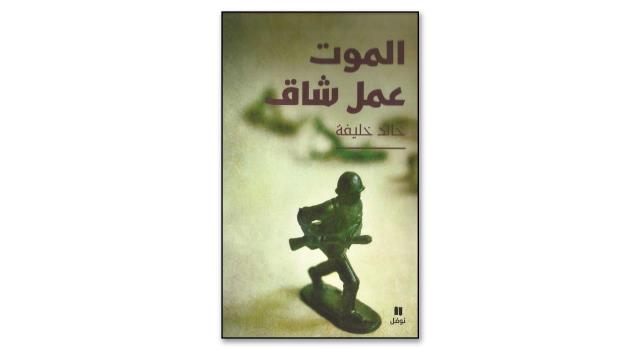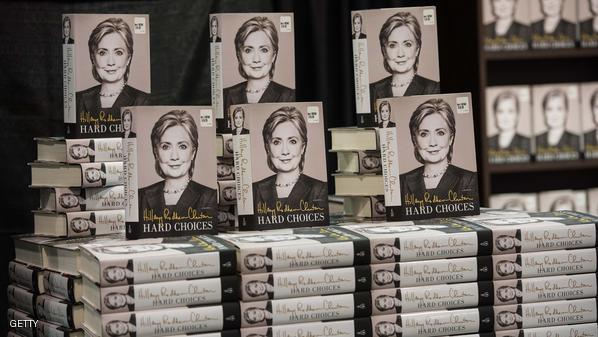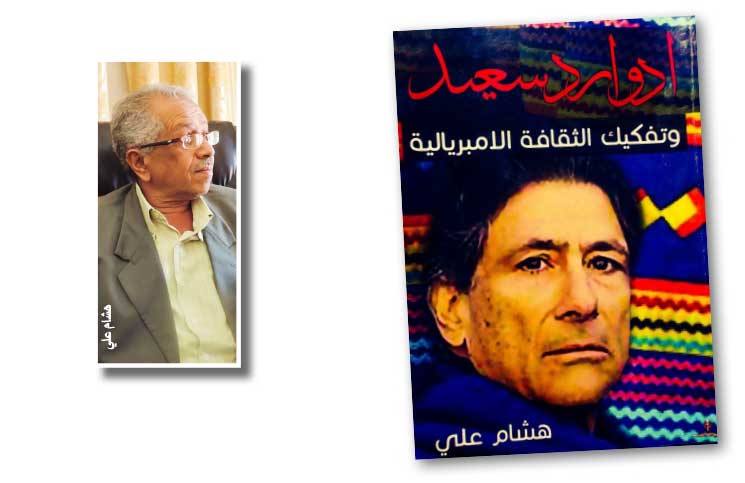حكايات نصر أبوزيد:الطفل الجنّي وفتى عِلم النجوم/ أسامة فاروق

في أحد الأيام، اكتشف أحد أبناء قرية “قحافة”، القرية الصغيرة في دلتا النيل شمالي مصر، اختفاء غرض ما من بيته، وكان في القرية شيوخ يدّعون القدرة على الاتصال بالجن، تتم استشارتهم لدى فقدان أحدهم لشيء ما أو الشك في أنه سرق، وكان ابن “قحافة” يتوسم فيهم استخلاص المعلومات من خلال طفل صغير، لأن الطفل يفترض به البراءة، أما البالغ فقد لوّثته الذنوب. يومها، كان أحد الأطفال قد تخلف عن الذهاب لمدرسته لمشكلة في أسنانه، ولأنه الطفل المتوافر فى ذلك الوقت، قرر الشيخ استخدامه كوسيط بريء مع الجن المُستفتى، فغطى رأسه بطاقية ثم وضع أمامه فنجاناً من الحبر، وبعدما قرأ تعويذة أو اثنتين، أشار إليه بالتحديق في الحبر لينقل له المشهد في قاع الفنجان، وسأله: “ماذا ترى؟”… كل الطقوس لها نظام واحد، ولم يكن هناك استثناء. كان مفهوماً أن مشاهدة جنّي في قاع الفنجان هي إشارة البدء للاحتفال وترتيب المقاعد، وكان الأطفال دوماً يجيبون: “نعم أراه”، فيستطرد الشيخ فى السؤال: “كيف يبدو؟”. أما الطفل المختار فلم ير شيئاً سوى الحبر شاغلاً حيز الفنجان كله، وظل الحضور يطالبه بالتركيز وأن يدقق النظر، وظل الشيخ يسأل: “ماذا ترى؟”، ويكرر الطفل إجابته: “لا شيء”. كانت فضيحة بلا شك، لكنها دلّت على طفل استثنائي.
في يوم آخر، استمع الطفل الذي صار شاباً، إلى شيخ يخطب فى مسجد صغير. كان يندد بالسحر باستخدام آيات من القرآن، قال إن النجوم كانت زوجاً وزوجة لكنهما مارسا الزنى، فلعنهما الله ونتيجة لذلك أصبحا نجوماً، لم يقتنع الشاب بهذا الكلام. قال للشيخ: “هذا كلام تافه، غبي، النجوم لم تكن يوماً من الآدميين”. صُدم الناس لدى سماعهم لهذا الحوار، ففي النهاية كان ذاك مجرد صبي يناقش شيخاً، فسألوه: “كيف يمكن أن تتحدث بهذه الطريقة؟”. تصور الفتى أنهم سيضربونه، لكنهم بدلاً من ذلك أخبروا والده بالحادثة، فسأله بدوره واستمع إلى روايته إذ أخبره: “لقد درسنا في المدرسة أن النجوم لم تكن يوماً من آدميين”، فأجابه والده: “أنت على حق، لن أعاقبك، لكن، في المستقبل، كن مهذباً وأنت تختلف مع الناس”.
هذه ليست حكايات للتسلية، بل وقائع رسمت شخصية واحد من أهم المفكرين في العصر الحديث. فهذا الشاب، هدد الإسلاميون حياته، ولم يعد قادراً على التدريس، وصار محاصراً في منزله، محاطاً بالحراس، بل طالبوا بالفصل بينه وبين زوجته، على خلفية أن المرأة المسلمة لا يمكن أن تكون متزوجة من غير المسلم، لأنهم ببساطة لم يتقبلوا أفكاره وأعلنوه مرتدّاً، ولم يعد مسلماً. وكانت النتيجة أن هجر مصر ليقضي فى هولندا ما تبقى من حياته… هذا الشاب هو نصر حامد أبوزيد.
القضية التي يعرفها الجميع، يرويها صاحبها بالتفاصيل في سيرته التي صدرت مؤخراً في القاهرة، تحت عنوان “صوت من المنفى”، ويمكن تلخيصها في فقرة واحدة يقول فيها أبوزيد: “لا أريد أن يؤخذ عني انطباع بأنى ضد الإسلام، بل على العكس من ذلك، أنا لستُ سلمان رشدى جديداً. إن أحد أكبر مخاوفي أن يعتبرني الغربيون ناقداً للإسلام. هذه ليست الصورة كاملة، أنا معلم وباحث ومفكر. أرى دوري هو إنتاج الأفكار، كما أتعامل مع القرآن كنص إلهى أوحي به للنبى محمد. هذا النص وصلنا فى صورة لغة بشرية هى اللغة العربية، وبالتالي كانت أبحاثي تدور حول نقد الخطاب الإسلامي. لقد بينت كيف أن المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تستخدم الخطاب الديني لتستحوذ على السلطة، وقد هدد ما كتبته مَن يمتلكونها”.
لكن القضية ليست العنصر الملفت فى الكتاب، الكل يعرف تفاصيلها. الملفت حقاُ هو تلك القصص التى تكشف عن حكّاء كبير، وتكمل الصورة الناقصة عن نصر حامد أبوزيد، لمن لا يعرفه أو قرأ له فقط من دون أن يراه. ذلك الجانب الإنساني الخالص، والظروف الاجتماعية والسياسية التى صاحبت نشأته. نصر أبو زيد الإنسان، لا الباحث أو لا حتى المهرطق، بل السمين المستدير الذي كان يعاني من وزنه الزائد طوال حياته: “جئت هذا العالم ثقيلاً مستديراً وقصيراً” يقول أبوزيد. لكن وزنه الذي كان مثار سخرية الأطفال الآخرين، كان سبباً في تحول اهتماماته واختلافه عمن حوله: “لم أكن خفيف الحركة مثلهم، فتعلمت أن أعوض هذا النقص، وكانت القراءة هوايتي، تمتعت بها كثيراً، وأدركت أنها النشاط الوحيد الذي يمكن أن أتفوق به”.
نصر الذي مات والده، صاحب محل الخُضار، وتحمل مبكراً عبء أسرة كبيرة: “بوفاة والدي شعرت بتغير عميق ينتابني، لم أعد أرى نفسي طفلاً، فجأة أصبحت رجلاً أحمل مهمة كبيرة استولت عليّ بالكامل”. هو الشاب الذي أصر على استكمال تجارة والده، واستكمال تعليمه في الوقت نفسه، ثم العمل في مهن متعددة لمساعدة الأسرة الكبيرة، لأن تلك التفاصيل لم تكن منفصلة أبداً عن أبحاثه وشخصيته بعد ذلك، كما يقول. التجربة الحياتية تقع فى قلب ما نسميه المعرفة، بل تجاربنا وخبراتنا هي التي تشكل المعرفة، إذ إنها ليست كياناً مستقلاً، بمعزل عن فهمنا وتأويلنا للحقائق والأحداث. هذا التأويل، لدرجة بعيدة، ينبع من تجاربنا الشخصية. لهذا السبب يشهد اثنان الحدث نفسه، ويكون لكل منهما رواية مختلفة، يقول أبوزيد: “أحد أسباب كتابتي لهذا الكتاب هو بيان كيف ارتبطت واندمجت تجاربي الشخصية مع أبحاثي الأكاديمية”.
لم يكن البحث الأكاديمي بالنسبة إليه مفهوماً مجرداً، أو اختياراً لمهنة ممتعة، بل جاء بحثه العلمي للحياة من خلال تجاربه الشخصية: “شغفي للبحث عن العدالة الاجتماعية لم يأت من فراغ، لقد كنت أبحث عن إجابات لأسئلة، أسئلة نبعت بالأساس من الصعوبات التى واجهتها في مشوار رعايتي لعائلتي”. ويقول فى موضع آخر: “أنا أنحدر من عائلة فقيرة، انتمي إلى الفقراء، أدافع عن حقوقهم. آمنت لسنوات أن الإسلام لا يمكن أن يؤول إلا كدِين يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية”. وهذا أجمل وأهم ما في الكتاب.
فى أحد الأيام، وربما نتيجة للضغوط الملقاة على عاتقه، انفعل على والدته، ألقى بمقص كان فى يده باتجاهها، تفادته ثم لقنته أقسى دروسه على الإطلاق. لم تعنفه أو تطلب من أحد تعنيفه. فقط، جمعت أغراضه وألقته معها خارج باب المنزل. مرت ساعات وطال وقوفه أمام الباب ولاحظ الناس ذلك، تجمعوا حوله واستدعوا الأقارب لحل المشكلة وتدخل أحدهم: “لا يوجد رجل في العائلة يقال له لا، لكن ها هي أمي، امرأة، تقف أمامه وترفض ما يطالبها به. وكما لو أنه حاول أن يذكرها بمسؤوليتها تجاهي، فقال لها: أنت لا تستمعين إليّ، لكنها كانت شجاعة: استمع لي، نصر ولدي، قام بإلقاء هذا المقص ناحيتي، الآن هو مجرد ولد أطعمه”.
ثم كان الدرس الذي تعلّمه نصر، ولم ينسه أبداً. فقد أجبرته أمه على تقبيل قدمها أمام القرية كلها: “تعلمتُ أن أقدّر القوة التي احتاجتها لتتخذ مثل هذا الموقف، والذي، ربما، لولاه، لخرجَت عائلتي عن نطاق السيطرة، وصارت النتائج كارثية”.
(*) “صوت من المنفى.. تأملات فى الإسلام” – ثمرة حوار مطول أجراه نصر أبوزيد مع الأستاذة الجامعية إستر نيلسون. ترجمته نهى هندى، وصدر عن دار “الكتب خان”.
المدن