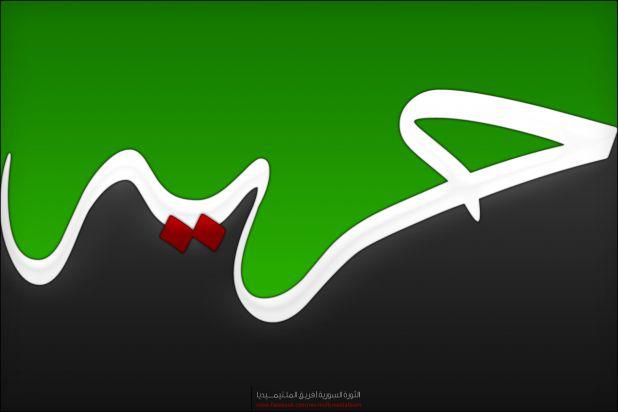رسالة مُكرّرة إلى الآخرين: أيُ دعمٍ يريده السوريون؟

محمد العطار
بعد ثلاثة عشر شهراً على اندلاع الثورة في سوريا، مازال الكثيرون في الخارج يطرحون السؤال عينه: كيف ندعم الشعب السوري دون أن نكون جزءاً من تحالفات سياسية إقليمية أو دولية لا نرضى بها؟ وعلى الرغم من أن هذا السؤال قد يبدو لبعض المنتفضين تخاذلاً يخفي تردد حكوماتٍ وحتى شعوب، أو يبدو في أحسن الأحوال متأخراً عما يجري في الواقع، إلا أن الحاجة تبقى مُلِّحة إلى مقاربة هذا السؤال بمزيدٍ من الصبر والتفهم.
في أواخر شهر آب المنصرم وخلال نقاشٍ مفتوح نظمه مسرح الرويال كورت اللندني، سألني أحد الحضور: “كيف يمكننا أن ندعم الشعب السوري في ثورته دون أن نخدم أجندات سياسية يبدو تجاوزها صعباً؟” صمتُ حينها حائراً للحظات قبل أن أجيب مُرتجلاً: “لا شك عندي أنك مازلت قادراً على تمييز عدالة قضية المنتفضين وجوهرها الإنساني، بمعزلٍ عن أي تشويش سياسي أو إعلامي”. أمورٌ كثيرة تغيرت منذ ذلك الحين، لكن السؤال عينه مازال يتردد دون أن أملك اليوم جواباً أوضح من ذلك الجواب الذي بدا حينها مُقتضباً ومُرتجلاً .
لأسباب عديدة – لا مجال لاستعراضها جميعاً في هذه العجالة – يبدو جلياً أن السوريين يدفعون أثماناً مُضاعفة لشرح ما هو واضح أصلاً ولحشد الدعم لثورتهم. ترتبط أبرز هذه الأسباب في رأيي بتجارب بلدان الربيع العربي الأخرى. فمن جهة لم يستسغ الكثيرون صعود قوى إسلامية إلى الواجهة حتى وإن تم ذلك عبر صناديق الاقتراع، مما جعل البعض غير راغب في رؤية الأمر ذاته يتكرر في سوريا. ومن جهة أخرى يبرز النموذج الليبي كمثال مُنفِّر لأي شكل من أشكال التدخل المُباشر وخاصةً لشرائح واسعة من الأوروبيين الذي وجدوا أنفسهم مضطرين لمباركة عمل عسكري بدا في حينها حتمياً لإنقاذ شعب من الإبادة. بالطبع في هذا السياق لا يمكن أن نغفل التجربة العراقية المريرة التي مازالت حاضرة بقوة في الأذهان مُذكّرةً على الدوام بنوايا التدخلات الأجنبية المُغلَفة بادعاءات كاذبة لنشر الديمقراطية.
من نافل القول أن جملة هذه التحفظات تقوم في جوهرها على تعميماتٍ لا تأخذ بعين الاعتبار الفروق السياسية والاقتصادية والثقافية بين بلدان الربيع العربي، هذه الفروق التي تلعب دوراً مفصلياً في رسم التباين بين مكونات الحراك الاجتماعي وطبيعته في كل دولة من جهة، وفي نظرة القوى الإقليمية والدولية إلى مصالحها في كل من هذه الدول من جهة أخرى. الأهم والأخطر أن هذه التحفظات تُغفل الجوهر الذي قامت من أجله هذه الثورات بالأساس وهو توق الشعوب لإنهاء حكم أنظمة مستبدة وفاسدة وشمولية، وتُعلي عليها مخاوف يستند معظمها إما إلى القياس أو على التكهن، لتصبح هذه المخاوف أهم من حقوق الشعوب في استرداد الحرية والكرامة! أياً يكن، فالسوريون وجدوا أنفسهم مضطرين للتعامل مع هذه المخاوف التي لم يكن لهم اليد الطولى في صنعها أساساً!
زرتُ برلين مرتين مؤخراً، وفي المرتين لمستُ تعاطفاً صادقاً مع قضية السوريين، إلا أن السؤال عينه تكرر وإن بأشكال مختلفة: كيف لنا أن ندعم الثورة وليس هناك برنامج واحد للمعارضة؟ ماذا عن القوى الإسلامية المُتطرفة؟ ألا يعقل أنها قد تخطف أو ربما خطفت الحراك الثوري؟ ما هي الضمانات أن لا تتحول أشكال ناشئة من المقاومة المسلحة إلى ميليشيات ذات لون ديني واحد؟ هل من بديل حقاً عن الحرب الأهلية؟
من الواجب القول هنا: أن ما يزيد من وجاهة هذه الاستفسارات هو الميل المُتزايد في وسائل الإعلام الغربية إما إلى اختزال الثورة في سوريا في مكونها العسكري الناشيء والذي انضم لاحقاً إلى الحراك الثوري وبالتالي تصويرها على أنها بروفة حرب أهلية لا أكثر ولا أقل، أو إلى حصرها في لعبة التجاذبات السياسية الدولية.
بتاريخ 26 آذار الماضي، نشرت صحيفة دير شبيغل تحقيقاً صحفياً لأولريكه بوتس أثار موجةً كبيرة من ردود الفعل. يورد المقال سرداً قاسياً لتجاوزات غير مُبررة من قبل بعض عناصر الجيش السوري الحر في حي باب عمرو الحمصي. تجاوز السجال حول هذا المقال ما دار عن طبيعة التحقيق الصحفي وهوية الأشخاص فيه ومصداقية ما قالوه، وخصوصاً الطريقة التي عبر بها أحدهم والمدعو “حسين” عن نفسه وأفعاله (تصل به الأمور لوصف نفسه بالمجنون!) ليعيد المقال إلى الواجهة الحديث عن الوضع المُركب في سوريا، وضبابية المستقبل في هذا البلد وكلفة التغيير العالية فيه، وربما بالتالي التريث في دعم الثورة. هذا يعيدنا إلى الحلقة الأولى: كيف ندعم تغييراً لا يحمل ملامح أو ضمانات استقرار واضحة؟
يمكننا بالطبع الإجابة على هذا السؤال بطرق عدة، منها أن نقول مثلاً: أن التردد في دعم الثورة ومطالبها المشروعة هو الذي يسبب مزيداً من التعقيد في الوضع على الأرض ومزيداً من الغموض لمستقبل بلدٍ بات نسيجه الاجتماعي أضعف من أي وقت مضى بفعل سياسيات سُلطة لا تؤمن إلا بالحل الأمني العسكري. أو أن نقول مثلاً: أن سياسات النظام هي من شرّعت الأبواب لكل راغبٍ بالتدخل بالشأن السوري، بدل حقن الدماء والتسليم بشرعية مطالب المنتفضين. لكنني اليوم وأكثر من أي وقتٍ مضى لا أعتقد أنه بإمكاني أن أجد جواباً أكثر صدقاً ولا أكثر منطقية من ذلك الذي قدمته منذ حوالي السبعة أشهر لذلك السيد البريطاني في الرويال كورت: جوهر هذه الثورة مازال ماثلاً بوضوح تحت طبقات التعقيد والتجاذب السياسي. لم يتغير أي شيء البتة في أساس صراعنا مع السلطة في سوريا، مازال عموم السوريين يناضلون لانتزاع حريتهم ولاسترداد حقوقهم الأساسية في الكرامة والمساواة والعيش الكريم. ومازالت السلطة تجابه طلّاب الحرية هؤلاء بنفس البطش والتأجيج الطائفي والدفع نحو ارتكاب عنفٍ مضاد، تماماً كما فعلت منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة.
منذ طلائع الحراك الأولى في درعا وحتى اللحظة مازال صراع المنتفضين مع السلطة صراع إنساني وأخلاقي في المقام الأول، هذا ليس تبسيطاً للأمور ولا تصويراً طوباوياً للثورة بل واقع مازلنا نعيشه، التعقيدات السياسية وسيناريوهات المُستقبل المُقلقة لم تكن في معظمها إلا نتائج لتزايد قمع النظام واستخدامه المفرط للقوة. أدركُ تماماً أن هذا لا يعفي جميع السوريين من مسؤولياتهم في مواجهة تحديات المُستقبل، لكنه أيضاً لا يجب أن يُضلل من يرغب حقاً في دعم شعب يناضل من أجل حقوقه المشروعة. فالثورة وقبل أن تكون معركة سياسية بين النظام ونخب مُعارضة أو بين تكتلات إقليمية ودولية، هي أولاً نضال من أجل حقوق الإنسان وقيم العدالة والمواطنة. من لا يرى، أو من لم يعد راغباً برؤية الأمور بهذه الطريقة فهذا شأنه ومسؤوليته، لكنها ليست مسؤولية عموم المنتفضين في أرجاء سوريا.
في شهر تموز المنصرم وأثناء تجمعنا في ما عرف حينها بمظاهرة المثقفين بحي الميدان الدمشقي ونحن نسير على مرأى من رجال الأمن، تقدم أحد الموالين للنظام وهو شاب في مقتبل العشرينات واخترق صفوفنا لوحده وهو يشتمنا، كنا حوالي المئتي شخص وكان هو وحيداً. كان بمقدوره شتمنا والبصاق علينا لأنه يعرف أن فرق الأمن والشبيحة على بعد أمتار مستعدة للهجوم علينا بالعصي الكهربائية والهروات في أي لحظة، وهو ما فعلوه لاحقاً وهم يصرخون “بدكون حرية يا ولاد….”. كان المشهد مُفجعاً في تلخيصه غياب العدالة والآلية التي يتعامل بها النظام مع المتظاهرين. بالطبع يومها تم اعتقال العديد من الوجوه الثقافية المعروفة، كتاب ومخرجين وصحافيين ومصورين. غني عن القول أن أحدهم لم يكن مسلحاً، بل لم تكن عسكرة الثورة مطروحة برمتها آنذاك. منذ أيام قليلة أي بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على تلك الحادثة، ومجدداً لم يكن الناشطون الذين وقفوا أمام مجلس الشعب السوري يوم 12 نيسان 2012، وهو ذات اليوم الذي دخل فيه التعهد الهش بوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مسلحين إلا بلافتات تقول “أوقفوا القتل”! لكن كيف تم التعامل معهم؟ لا مفاجآت: الضرب والشتم والاعتقال.
لنفترض أننا صدقنا رواية النظام حول العصابات المسلحة التي انتشرت فجأة في كل أرجاء سوريا، وأننا قبلنا بضرورة التعامل معها بحزم، لكن هل تغيرت ردود فعل النظام على معارضيه “السلميين” منذ 15 آذار 2011 حتى اللحظة؟ هل تسامح النظام مع المتظاهرين من حملة الورود أو اللافتات؟ هل يميز النظام في بطشه بين معارض ماركسي وآخر ليبرالي؟ بين ثائرٍ علماني وآخر متدين؟ بين مسلمٍ ومسيحي؟ إذا اجتمع هؤلاء على إسقاط النظام دون أدنى مساومة أو مواربة فهم سواسية بالنسبة إليه، هذا مثبتٌ على الأرض وبالتجربة، عليكم فقط إلقاء نظرة سريعة على قائمة الشهداء والمُعتقلين.
في لحظة كتابة هذا المقال أُفكر بمن أعرفهم من المعتقلين، فأرى طيفاً جميلاً كقوس قزح، بهياً كسوريا، رجال ونساء، مسلمون ومسيحيون وعلويون وأكراد، مهندسون وأطباء وكتاب وصحفيون وعاطلون عن العمل. هؤلاء، كما الشهداء، هم روح الثورة التي يجب أن لا تكون خافية على من يريد دعمها لكنه يقف مُرتبكاً أمام التعقيدات السياسية والمؤتمرات والبيانات الصادرة من هنا وهناك. الأسباب التي قامت لأجلها الثورة مازالت قائمة كما كانت، ومازال الانتصار للثورة هو انتصارٌ للحرية كقيمة عُليا، وانتصار لحقوق الإنسان الأساسية، ولشعب ثار في وجه سلطة مستبدة. التحفظات على أداء بعض الثوار وتجاوزاتهم حق مشروع، والعمل على تصويب هذه التجاوزات واجب. أما القلق من المستقبل فنحن تشاركه جميعاً، فلا ضمانات بيد أحد ليقدمها، إلا الوعد بالسعي نحو الحرية ودولة العدالة والقانون.
دعم السوريين الثائرين لاسترداد كرامتهم وحريتهم المسلوبة ودعم أي شعب آخر يثور لأجل حريته هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية أولاً، هكذا كان جوابي لمن سألني من شهور، هذا هو جوابي الآن وهكذا سيكون جوابي في المُستقبل أيضاً.
مسرحي سوري
نشر المقال في جريدة “تاز” الألمانية 28/4/2012
http://www.taz.de/!92334/