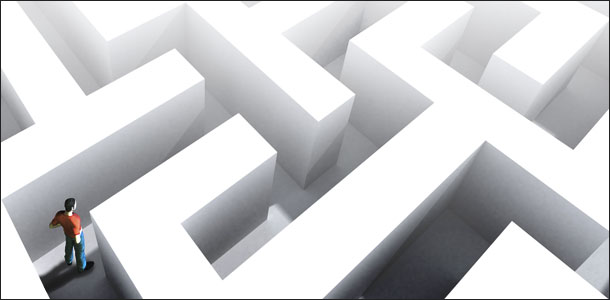عام على مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق

ذكرى المجازر الكيماوية: أوباما ليس أفضل من أدونيس!/ صبحي حديدي
محطة CNN الأمريكية شاءت إحياء الذكرى السنوية الأولى للهجمات الكيماوية الوحشية، التي شنّها نظام بشار الأسد على الغوطتَين الشرقية والغربية، فجر 21 آب (أغسطس) 2013؛ بطريقة مبتكرة حقاً، أخلاقياً ومهنياً أيضاً: استضافة بثينة شعبان، مستشارة الأسد الإعلامية، وصاحبة الهرطقة الأشدّ بؤساً وابتذالاً وخبثاً حول تلك الهجمة (أنّ المعارضة السورية خطفت أطفالاً ونساءً وشيوخاً من منطقة الساحل، ونقلتهم إلى الغوطة، ثمّ قصفتهم بالأسلحة الكيماوية)؛ لا لكي تعلّق شعبان على تلك الذكرى، حتى من باب نفيها أو تكرار التخرصات إياها، بل لكي تشرح للمشاهدين دور «حكومة الرئيس بشار الأسد» في مكافحة «داعش»!
في عبارة أخرى، اختارت أتيكا شوبيرت، مذيعة الـCNN التي حاورت شعبان، أن تستذكر الهجمة الكيماوية عن طريق… عدم استذكارها نهائياً، وعدم إحراج شعبان بأيّ سؤال عنها، وعدم إثارة الرابط (كما صارت الموضة الرائجة اليوم) بين إخفاقات سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول سوريا، واستفحال جرائم «داعش» وانتقال أخطارها إلى الجوار… مدهش، في جانب ثانٍ خاصّ، ومهني وأخلاقي أيضاً، أنّ شوبيرت (أندونيسية الأصل، وبنت العالم الثالث على نحو ما) اشتُهرت بتغطيات صحافية دراماتيكية، حول الذكرى الستين لإسقاط القنبلة الذرية على هيروشيما؛ وكذلك محاكمات شوكو أساهارا، مهندس هجمة غاز السارين الإرهابية على طوكيو، سنة 1995؛ والتوتر النووي في شبه جزيرة كوريا، سنة 2006.
ولكن لماذا يعتب المرء على شوبيرت في هذا التقصير، إذا كان المواطن السوري علي أحمد سعيد إسبر (أدونيس)، لم يكتفِ بتجاهل هذه الذكرى، فحسب؛ بل تفادى نهائياً أية إشارة إليها منذ وقوعها، ويتباكى اليوم على ويلات سنجار وقراقوش والموصل، بل ويترحم على أيام «جنكيز خان وهولاكو وبقية الطغاة قبلهما وبعدهما»، ممّن «كانوا على بدائيتهم ووحشيتهم أكثر إنسانية وأصدق إسلاماً من الطغاة الجدد في القرن الحادي والعشرين»؟ ثمّ، في مستوى آخر سوري بدوره، لماذا يُلام أدونيس إذا كانت جهة معارضة مثل «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» قد تجاهلت الذكرى ـ حتى ساعة كتابة هذه السطور على الأقلّ، واعتماداً على موقع الهيئة الرسمي ـ ولم تنسَ، في المقابل، الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي 2170، «المتعلق بالجماعات الإرهابية المتطرفة في كل من سوريا والعراق»؟
انعدام الاكتراث، أو ندرته، أو قلّته، بصرف النظر عن النوازع الأعمق خلف كلّ مستوى؛ ليس جديداً على مأساة السوريين مع نظام لم يعد يأبه لرادع، أو يقيّده وازع، حتى حين تكون المجازر بين الأشدّ وحشية وبربرية. هنا استعادة، وجيزة، لنماذج من جرائم النظام، ابتداءً من كانون الثاني (يناير)، 2013، وحتى مجازر الغوطتين: مصرع 87 من طلاب جامعة حلب، و106 من أبناء حمص، بينهم نساء وأطفال قُتلوا حرقاً أو بالسلاح الأبيض، والعثور على 80 جثة في نهر قويق بحيّ بستان القصر في حلب؛ وفي شباط (فبراير)، مقتل 83 من المدنيين، بعضهم سقط جراء تفجير قرب مقرّ حزب البعث في دمشق؛ وفي نيسان (أبريل)، أكثر من 483، بينهم نساء وأطفال، في مجزرة «جديدة الفضل» التي ارتكبتها وحدات الحرس الجمهوري؛ وفي أيار (مايو)، إعدام قرابة 50 من السجناء في سجن حلب المركزي، ومقتل 145 رمياً بالرصاص في مجزرة شهدتها مدينة بانياس الساحلية؛ وفي حزيران (يونيو) أجهز الجيش النظامي على 191 مواطناً في مجزرة قرية «رسم النفل» في ريف حلب؛ وفي آب (أغسطس) أسفرت الهجمات الكيماوية على الغوطة عن أكثر من 1500 ضحية.
على صعيد مواقف قوّة كونية عظمى مثل الولايات المتحدة، تحيل ذكرى المجازر الكيماوية إلى ذلك الخطاب المخاتل، والمتحذلق، الذي اعتمده الرئيس الأمريكي في هذا الملفّ. كان النظام السوري قد استخدم الأسلحة الكيماوية مراراً، في مناطق سورية مختلفة، حين أصرّ أوباما على أنّ استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ما يزال مسألة «تصوّر»، واحتمال «انطباعي» فقط، وليس واقعة ملموسة ومرئية، تستند على أدلة مادية قاطعة. الإدارة، استطراداً، لم تكن متأكدة، أو ليست متأكدة نهائياً وقطعياً، من أنّ النظام السوري قد تجاوز ذلك الخطّ الأحمر الشهير الذي رسمه سيّد البيت الأبيض. لهذا يصعب «تنظيم تحالف دولي» حول أمر «مُتصوَّر» فقط؛ و»لقد جرّبنا هذا من قبل، بالمناسبة، فلم يفلح على نحو سليم»، قال أوباما، في إشارة (صحيحة) إلى الخطأ الذي ارتكبه سلفه جورج بوش الابن في العراق.
هذا بالرغم من أنّ أوباما كان المعنيّ الأوّل بتداعيات ما وقع بعدئذ، وقبلئذ، من استخدام للأسلحة الكيماوية، لأنه كان صاحب الوعد الشهير بأنّ اللجوء إلى هذا السلاح سوف يغيّر قواعد «اللعبة»، وبالتالي سوف يستدعي خطوات أخرى تصعيدية من جانب واشنطن، ضدّ النظام السوري. وقبل شهرين، فقط، من وقوع مجازر الغوطتين، كان أوباما قد أعاد التأكيد على هذا الخطّ، ثمّ تابع طرائق الالتفاف على تبعاته (التي كان هو الذي ألزم نفسه بها!)، حين أكّد: «مهمتي هي أن أزن المصالح الفعلية الحقيقية والشرعية والإنسانية لأمننا القومي في سوريا، ولكن أن أزنها على أساس الخطّ الأساس الذي رسمته، وهو البحث عمّا هو أفضل لمصلحة أمن أمريكا والتأكد من أنني لا أتخذ قرارات مرتكزة على أمل وعلى صلاة، بل على تحليل صلب بمصطلح ما يجعلنا أكثر أماناً، ويكفل استقرار المنطقة».
وفي أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية تقريراً بالغ الأهمية، حول مجازر الغوطة، وقّعه ثلاثة من خيرة أعضاء الفريق الذي يغطّي الشأن السوري: آدم إنتوس، نور ملص، وريما أبوشقرة. الخلاصة، التي تتكىء على شبكة من التفاصيل المترابطة والمتقاطعة، تفيد التالي: كان البنتاغون قد علم بالضربة مسبقاً، وبالتالي يصعب القول إنه لم يسكت على مذبحة كانت وشيكة، كفيلة بالانقلاب إلى صيغة إبادة جماعية؛ تماماً كما حدث بعدئذ، باعترافات مسؤولي البيت الأبيض أنفسهم، ابتداءً من أوباما نفسه، وانتهاءً بوزير خارجيته جون كيري، مروراً بمستشارته للأمن القومي سوزان رايس. الفارق أنّ ضجيج الإدارة وعجيجها لم يصطخب إلا خلال مراحل التلويح بضربة عسكرية ضدّ نظام الأسد، ثمّ خفت وخمد تماماً حين استدار أوباما على عقبيه، وصرف النظر.
أخيراً، كان الموقف الشعبي العامّ في أمريكا، وضمنه معظم التغطيات الإعلامية، يذكّر بمناخات ما بعد انكشاف مذبحة «ماي لاي»؛ التي نفّذتها قوات أمريكية نظامية في فييتنام، سنة 1968، ضدّ المدنيين العزل، وأسفرت عن مقتل قرابة 500 شيخ وامرأة وطفل، وارتكاب فظائع بربرية كالإعدام الجماعي والاغتصاب واللواط والتمثيل بالجثث. ذلك لأنّ عشرات الأصوات الأمريكية، التي ترتدي اليوم أقنعة الطهارة، وتحضّ على تجريد حملات صليبية ضدّ مَنْ تصنّفهم في خانة «الإرهاب»، عشوائياً وكيفما اتفق؛ هي نظائر الأصوات ذاتها التي لم تكتف بالسكوت عن مجرمي الحرب، منفّذي مجزرة «ماي لاي»، فحسب؛ بل حاولت تبريرها ومباركة أبطالها طيلة أسابيع، قبل انكشاف الحقائق على النحو المروّع المعروف.
وفي هذا السياق، تظلّ الدلالة الأهمّ هي الاجذاب الأمريكي، الجَمْعي والهستيري، الشعبي وليس الشعبوي فقط، نحو قراءة المذابح الجماعية بوصفها سيناريوهات لا مفرّ منها؛ أو، في خطّ تأويل آخر، أنها أقلّ ويلات من سواها. الأمر الذي يسمح بتساؤل مشروع: لماذا يتوجب أن يكون الأمريكي أوباما، أفضل من السوري… أدونيس؟
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
أسوأ من الكيماوي/ حازم نهار
لا تزال صور ضحايا مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق تستثير في كثيرين ردات الفعل المؤلمة ذاتها، على الرغم من مرور عام على الحادثة المؤلمة. أطفالٌ بعمر الورد يختلجون، ويزبدون من أفواههم، وتنقطع أنفاسهم مختنقين رويداً رويداً، وآخرون يصرخون، باحثين عن أهلهم وأولادهم، فيما المسعفون لا يستطيعون مجاراة الكارثة الكبيرة، بحكم الحصار الخانق الذي حرمهم من الدواء والمعدات، فيستعيضون بسكب المياه على الضحايا. كان يوماً عصيباً حقاً.
في كل مرةٍ، يعتقد المتابع للحدث السوري أن هذا الفعل، أو سواه، للنظام السوري هو الأسوأ، فإذا به يُفاجأ، بعد فترةٍ، بخطوة تفوق سابقتها بالسوء والجريمة. فقد اعتقد كثيرون أمام مجزرة الكيماوي أنه لا شيء سيكون أسوأ منها، فإذا بهم يصحون، في لحظة أخرى، على صور لنحو 11 ألف سوري قتلوا تحت التعذيب. ما زال في جعبة النظام السوري الكثير من الإدهاش الجرمي، وأعتقد أنه كان، وسيظل، وفياً لعهده الذي أطلقه بأنه لن يترك سورية إلا حطاماً فوق حطام. مع ذلك، ثمّة ما هو أسوأ من الكيماوي، إنْ على مستوى النظام ومواليه، أو على مستوى “المجتمع الدولي” والمعارضة السورية.
كانت ردة فعل الموالين للنظام إزاء المجزرة مثيرة للدهشة بالفعل. ففي مناطق، عبّر عسكريون وأمنيون وجماعات محسوبة على الشبيحة وعائلاتهم في دمشق وغيرها، عن شماتتهم وفرحتهم بضرب الكيماوي، معتبرين أنها الخطوة الأصح التي قام بها النظام للقضاء على “الإرهاب”، على حد تعبيرهم، كما بدأوا بتوزيع الحلوى وإطلاق “الزمامير” من سياراتهم التي بدأت تجوب الشوارع فرحاً بمقتل أطفال مَن كانوا، بالأمس القريب، جيرانهم وشركاءهم في المواطنة.
كانت شماتة موالي النظام السوري مؤلمة حقاً، لكنها، من الوجهة السياسية، تعني ما هو أسوأ. إنها ضربة موفّقة لشعار الثورة السورية: “الشعب السوري واحد”، فهي تزيد من التشكيك السائد بقدرة السوريين على أن يشكلوا شعباً واحداً، وهذا أخطر بكثير من فكرة التقسيم التي تروّجها دول وأطراف وجماعات سياسية عديدة. ونعلم أن النظام السوري، على مدار نصف قرن، لم يتعامل مع السوريين بوصفهم شعباً واحداً، بل كقطع معزولة، أساس كل منها طائفي أو ديني أو عرقي أو أيديولوجي، على الرغم من خطابه “القومي العربي” الذي يصمّ الآذان، ليكون هو وحده الذي يجمع بينها برباط القهر والاستبداد. فالشعب مفهوم سياسي، أي يُصنع صناعة، وليس معطى نهائياً، وإنّ صناعة شعب على أساس الاندماج الوطني، بالمعنى الديمقراطي، تحتاج حقاً إلى إرادات، وهذه الإرادات يصيبها العطب كلما برزت إلى السطح ممارسات شنيعة، كالتي يحفل بها الوسط الموالي للنظام.
كان خطاب معظم اليساريين، حتى أولئك الذين يحسبون أنفسهم على معارضة النظام السوري، خطاباً ضد الضحية، بعضهم اتهم الجماعات المتطرفة من الساعات الأولى للمجزرة الكيماوية. الأرضية التي ينطلق منها هؤلاء في مقارباتهم للحدث السوري معروفة ومفهومة، فهي تقوم، في جزء كبير منها، على الألم الذي يعيشونه، بحكم هامشيتهم وهزالتهم، بما يدفعهم دائماً إلى اتباع نهج “تفكير الجكارة”، وفي جزء آخر على الأيديولوجيات العمياء التي جعلتهم يحتقرون الناس العاديين وآلامهم، ربما لأنهم لم يتبعوا تعاليم ماركس وجيفارا في الثورات، وربما لأن الأيديولوجيات الصدئة تبقى لديهم أهم من الإنسان، لكن لا نستطيع، بالطبع، أن ننفي الانتهازية السياسية التي ينعم بها بعضهم.
كانت سياسة ما يسمى “المجتمع الدولي”، قبل جريمة الكيماوي وبعدها، أسوأ من الكيماوي. فالطريقة التي تصرفت بها الدول، في فترة ما قبل الكيماوي، كانت تقدم رسالة، بشكل غير مباشر، للنظام السوري، مفادها بأنه في وسعك أن تفعل ما تشاء، فأنت، كإسرائيل، نظام مدلّل تقف عنده وتتعطل جميع القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان. بعد المجزرة، كان سعي “المجتمع الدولي” كله موجهاً نحو “الإمساك بأداة الجريمة”، أي التخلّص من الكيماوي السوري، تجسيداً لنمط السياسة العالمية السائد، والقائم على المصالح العارية، من دون أي بعد حقوقي أو إنساني. على العكس، شكلت عملية نزع الكيماوي السوري رخصة للنظام، ليدخل في شراكةٍ مع “المجتمع الدولي”، وهذه الشراكة تتطلّب وجوده، وبقاءه من أجل القيام بوظيفته في تسليم الكيماوي بشكل آمن، وإلا كيف نفسّر تغاضي المجتمع الدولي عن قتل النظام عشرات آلاف من السوريين، في فترة ما بعد الكيماوي، باستخدام الصواريخ والبراميل المتفجرة؟
لا يكترث “المجتمع الدولي” بنتائج سياساته، إنْ في سورية أو على مستوى العالم. إذ تقدم هذه السياسات حقائق خطرة: فقدان الثقة بالقانون الدولي، السخرية من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، الاستهزاء بالمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، الكفر بمبادئ العدالة والحريات والديمقراطية التي يفخر بها الغرب، الشرعية الوحيدة هي شرعية القوة، وصاحب القوة يربح. ربما يقال إن هذا كله لا قيمة له في السياسات الدولية، وهذا، واقعياً، صحيح. لكن، مَن قال إن العالم يمكن أن يسير نحو الأمام بلا قانون، فالعالم الذي يفتقد القيادة السياسية الأخلاقية سيكون مصيره، على الدوام، إنتاج الفشل والتطرف في آن معاً في أماكن شتى، وأزمنة مختلفة.
أليس ما حدث في سورية، وما رافقه من تجاهل دولي وإقليمي، هو ما أفسح المجال، في أحد وجوهه، لبروز ونمو قوى معارضة متطرفة، تنهل من معين النظام السوري ذاته، خطاباً وسلوكاً وأخلاقاً؟ أليس هو أيضاً ما أعطى مجموعة عبد الفتاح السيسي في مصر قوة الدفع باتجاه القتل، وأدى إلى حدوث ما حدث في ميدان رابعة العدوية وغيره؟ في الواقع والتاريخ، لا شيء يضيع، ومَن يزرع سيحصد ما زرعه، ولو بعد حين.
كان أداء المعارضة السورية، أيضاً، أسوأ من الكيماوي. فهي واجهت المجزرة بالندب والصراخ والعويل فحسب، وهذا لا يجعلها تزيد شيئاً عن أداء المواطن السوري العادي الذي يبني، بشكل طبيعي ومبرر، سلوكه وحديثه، استناداً إلى الحس الآني والمباشر فحسب. الغضب والألم مبرران، بل وضروريان، عند الجميع. لكن، أن يقف رجل السياسة في حدودهما فحسب، فتلك هي الكارثة. تنفعل المعارضة السياسية لحظياً، ثم تنسى، ولا تتابع شيئاً، ولا تقوم بأي عمل. أسوأ السياسيين هم الذين يعيشون كعمال “المياومة” الذين لا يعملون إلا في حدود اللحظة الحالية، من دون أي تخطيط أو إعداد للمستقبل، وينتظرون العالم لكي يقوم عنهم بكل واجباتهم. فالمجزرة الكيماوية لم تلق أي متابعة إنسانية أو قانونية أو سياسية، أو حتى على مستوى حشد الرأي العام العالمي والعربي، في اتجاه تقديم المتورطين بهذه الجريمة إلى محاكمات دولية عادلة، أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب.
لقد جرّب السوريون الموت بالطرق كافة، من الموت بالرصاص، والموت في أقبية التعذيب، إلى الموت جوعاً وحصاراً، والموت بالصواريخ والبراميل المتفجرة، إلى الموت بالكيماوي ومشتقاته، إلى الموت بالدواعش وتفريخاتها، إلى الموت غرقاً أو عجزاً عند بوابات حدود الدول. وفي جميع المحطات، لم يكن الموت قهراً بعيداً منهم، بسبب “نظامهم العظيم” و”المجتمع الدولي الموقر” و”معارضتهم السياسية الغراء”.
أفلام قصيرة في ذكرى مجزرة الكيماوي بسوريا
يحيي السوريون اليوم الذكرى السنوية الأولى لمجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، التي راح ضحيتها أكثر من 1400 شهيد من المدنيين. وضمن حملة استذكار المجزرة والتذكير بمعاناة السوريين المستمرة، أطلقت الحركة المواطنية غير السياسية “استيقظي جنيف” Wake Up Geneve بالتعاون مع اتحاد منظمات الإغاثة الطبية السورية (UOSSM)، فيلم رسوم متحركة قصيراً بعنوان “كلنا سوريون”، يهدف إلى تذكير الرأي العام بالمأساة التي مزقت سوريا وحياة مواطنيها، باعتبار أنّ “واجبهم الأخلاقي يستدعي التحرك، كي لا تتحول الحرب المستمرة في سوريا إلى نمط معتاد”.
ويعرض الفيلم، الذي أخرجه رامي عباس، مشاهد من الحياة اليومية لأشخاص يجلسون في المقهى، وآخرين يشاهدون مباراة كرة قدم، وغيرهم يتنزه على الشاطىء، لينتقل بعدها مباشرة نحو عرض مشاهد معاكسة تعرض ما يجري في سوريا وتصوّر حجم المأساة التي يعيشها أهلها من تهجير وقصف وتدمير للمنازل والممتلكات. ويستعيد الفيلم صوراً من مناطق شهدت مجازر ودمار وصورة لنزوح الآلاف من مخيم اليرموك في دمشق. ويختم الفيلم بعبارة “تحرككم من أجل سوريا هو واجب إنساني اتجاه الأجيال المستقبلية. كلنا سوريون”.
WE ARE ALL SYRIANS
<iframe width=”640″ height=”360″ src=”//www.youtube.com/embed/6cuR3tOZ5bs?feature=player_detailpage” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
كما أطلق حزب “الجمهورية” السوري المعارض، فيلماً قصيراً حول مجزرة الكيماوي، يوثّق من خلاله تفاصيل المجزرة وما نتج عنها، إضافة إلى ردود الفعل العربية والدولية عليها. وفي خلال سبع دقائق، يعرض الفيلم صور لشهداء المجزرة، وشهادات لشهود عيان هم: أحد الناجين من المجزرة، وممرض في مستشفى الحجي، وحفّار قبور.
وتستهل المشاهد والعبارات التي يعرضها الفيلم بعبارة “عام على المجزرة والمجرم ما زال طليقاً”، لينتقل لعرض المواقف الدولية من استخدام الكيماوي في سوريا، وأبرزها موقف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الذي يقول “سنتدخل عسكرياً إذا حركت دمشق الكيميائي”، رئيس الوزراء البريطاني، دايفيد كاميرون، الذي يحذر من “استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا”، إضافة إلى موقف إيران الرسمي في هذا الخصوص، والذي يرى بأن “استخدام الأسلحة الكيماوية من أي طرف في سوريا خط أحمر”.
لكن، بعد حصول المجزرة واستشهاد المئات من المواطنين السوريين، تبرز مواقف دولية جديدة يستعيدها الفيلم، مذكراً المشاهد بأبرز ما قاله كل من الرئيس أوباما، الذي أكد حينها بأن “صور النساء والأطفال الذين قتلوا في الهجوم الكيميائي تدفعنا للتحرك”، والخارجية الروسية التي صرّحت بعد المجزرة بأن “الأنباء عن استخدام السلاح الكيميائي بريف دمشق قد تكون عملاً استفزازياً”، وصولاً إلى مواقف عدة دول أخرى نددت أيضاً بالمجزرة.
الوعود التي قدمها المجتمع الدولي، والتي لم تلاق أي تطبيق فعلي على الأرض، بحسب الفيلم، تتحدث عنها مواطنة سورية، تشكّل كلماتها خاتمة للفيلم. إذ تقول “لقد خاب أملنا، فقدنا الثقة في المجتمع الدولي، فقدنا الثقة في معاهداتهم وخطاباتهم. جميعهم كاذب”. وتضيف “الأسد يقتلنا بالسلاح الكيماوي وغير الكيماوي. لكن الموت بالكيماوي ربما يكون أسهل من الوسائل الأخرى التي يقتلنا بها الأسد. لقد كانوا نياماً وماتوا بهدوء. أما أن ترى ولدك يموت كل يوم جوعاً، أو أن تراه يموت متأثراً بجروحه، أو أن تراه يفقد عضواً من أعضاء جسده، سيكون ذلك أصعب من رؤيته يموت بالسلاح الكيماوي”.
فيلم حديث من إنتاج حزب الجمهورية حول مجزرة الكيماوي
<iframe width=”640″ height=”360″ src=”//www.youtube.com/embed/IC5kYQy1L10?feature=player_detailpage” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
المدن
مجزرة الكيماوي وجرائم داعش/ خضر زكريا
مر عام على المجزرة التي ارتكبها النظام السوري في غوطة دمشق الشرقية، وراح ضحيتها نحو 1500 شخص، بينهم أطفال ونساء وشيوخ كثيرون، نتيجة استخدام الأسلحة الكيماوية الفتاكة. وبعد ضجة كبيرةٍ، أثارها ما يسمى “المجتمع الدولي”، وتهديد الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، وبموجب صفقة أميركية روسية إيرانية، سلّم النظام أسلحته الكيماوية، لكنه استمر في تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها بوسائل أخرى، لعلها أكثر همجية، سميت البراميل المتفجرة، وخلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين في معظم أنحاء سورية.
سالت دماء سورية كثيرة منذ مجزرة الكيماوي. وساهمت في إسالتها مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وتدّعي معارضة النظام السوري، في مقدمتها ما أطلقت عليه عبقرية السوريين تنظيم “داعش”. وتسابق داعش هذا مع النظام في القتل والتدمير، وكان همه الرئيسي السيطرة على مناطق سيطرت عليها قوات المعارضة، ولا سيما المجموعات التي تنضوي تحت لواء الجيش السوري الحر. وهكذا سيطر داعش على مدينة الرقة ومعظم ريفها، وعلى مساحات واسعة من محافظة دير الزور، بما فيها حقول النفط، وأجزاء من محافظة الحسكة، ومن أرياف محافظة حلب.. كل هذا و”المجتمع الدولي” صامت لا يحرك ساكناً، سوى وعود جوفاء، واتهامات للمعارضة بشتى التهم، ليعفي نفسه، حتى من تقديم أبسط وسائل الدفاع عن النفس للجيش السوري الحر.
فجأة، وبسرعة مذهلة، قرر “المجتمع الدولي” التدخل ضد تحركات داعش، ولكن، ليس في سورية، بل في العراق. فما إن أُعلن عن استيلاء مجموعات مسلحة عراقية، بينها داعش، على الموصل، وإعلان البغدادي “خليفة” للدولة الإسلامية، وبدء التحرك للسيطرة على شمال العراق، أعلن المجتمع الدولي النفير: تحركت طائرات أميركية لضرب مواقع داعش، بحجة الدفاع عن المسيحيين المهجرين من الموصل والدفاع عن الأيزيديين الهاربين نحو الجبال، وعن الأكراد الذين يتهدد داعش إقليمهم شبه المستقل. وتتسابق، اليوم، دول الاتحاد الأوروبي لتقديم السلاح لأكراد العراق، لكي يتمكنوا من مواجهة الزحف الداعشي.
أكثر من ذلك، قرر “المجتمع الدولي” إقصاء نوري المالكي عن رئاسة الوزارة العراقية، على الرغم من صلفه وتهديداته. ورضخت إيران صاغرة لضغط الولايات المتحدة للقبول بتغييره.
ما السر؟ لماذا يسكت المجتمع الدولي، والولايات المتحدة على رأسه، سنوات، عن تدمير سورية وقتل شعبها وتشريده، سواء من النظام أو من داعش وأمثاله، ويهرع للتحرك في العراق بهذه السرعة، وبهذا الزخم؟ ألأن الدم العراقي أغلى من الدم السوري في نظر المجتمع الدولي؟ لا شيء يدل على ذلك، ولا شيء يدل على أن أي مبدأ أخلاقي، أو إنساني، يلعب دوراً في تحرك الذين يتشدقون بالديمقراطية وحقوق الإنسان صباح مساء.
الأمر، على ما يبدو لي، متعلق بعوامل لا دخل للعامل الأخلاقي، أو الإنساني، منها أن العراق، على عكس سورية، بلد منتج للنفط على نطاق واسع. وهذا من أهم ما دعا الولايات المتحدة إلى التحرك لإخراجه من الكويت عام 1991، وإلى غزوه وإسقاط نظامه عام 2003. وأن العراق، منذ ذلك الحين، واقع تحت النفوذ الأميركي، مع اعتراف أميركا لإيران بحصة كبيرة من ذلك النفوذ. أما سورية، فتعد ضمن المجال الحيوي الروسي، منذ عهد طويل، والنفوذ الإيراني فيها على توافق مع المصالح الروسية على طول الخط تقريباً، والموقفان، الروسي والإيراني، من الثورة السورية واحد إلى حد كبير. كما أنه، في العراق، حكومة إقليم كردستان، الحكومة القوية التي حققت، في السنوات الماضية، استقراراً وتنمية للإقليم شهد لها الجميع، ويمكن للغرب الاعتماد عليها، في حال حدوث صعوبات، أو خلافات جدية، مع الحكومة المركزية في بغداد. أما في سورية، فلا يرى الغرب، حتى الآن، بديلاً موثوقاً به للنظام السوري.
ليست الأخلاق إذن، وليست مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما يستدعي تحرك “المجتمع الدولي” لنصرة هذا الطرف أو ذاك. هي المصالح، والمصالح وحدها التي تحركه.
جميع حقوق النشر محفوظة 2014
حيّ على إحياء ذكرى مجزرة الكيماوي والغياب/ ضحـى حسـن
قومي يا أبي قومي”، ينادي أبو محمد ابنتيه، يحملهما، يحاول أن يوقظهما، لكن دون فائدة، يعيدهما إلى جانب الأطفال “النيام” الآخرين. على ما يبدو أن نيام ذاك الصباح استيقظوا في مكان آخر بعيد جداً عن هذه الحياة.
شهدت بلدات الغوطة الشرقية حالة نوم غريبة، تجاوزت مدتها العام، عائلات بكاملها لم تستيقظ حتى اليوم. لا دماء كانت على تلك الأجساد، أو أي آثار تدل على أنهم أموات، من بعيد ترى 1466 جسداً ممدداً غافياً فقط.
“معظم الأطفال ماتوا وهم يحلمون. قليل منهم وصل للنقاط الطبّية وتمكنوا من إسعافه. الرحيل الجماعي للعائلات هو الصورة الأكثر إلحاحاً. الأم والأب وأطفالهما، نقلوا من أسرَتهم إلى قبور جماعية ضمت رفاتهم.”، كتبت رزان زيتونة.
اليوم الخميس نحيي الذكرى الأولى لمجرزة الكيماوي. خلال ستين يوم تقريباً بقيت المجزرة تدقّ حياتنا اليومية بشكل واضح لنا نحن البشر، لتتنقّل بعد ذلك إلى الجزء الداخلي لذاكرتنا لمدة ما تقارب ثلاثمئة يوم. وقد استحضرناها اليوم بالحالة ذاتها إلى حد ما، المشاعر، والصور، والغضب، والألم.. كما اليأس والعجز اللذين تضخما لاحقاً بسبب التخلّي الذي تعرّض له النيام في الغوطة، سواء منّا أو من العالم ككل بأنظمته ومجالسه. الشعوران المنضمّان أخيراً أكثر حضوراً فينا عند إحياء الذكرى، ومن الممكن أن يكونا المسببين الرئيسيين لإخفاء المجزرة داخل العقل في الساحة الخلفية منه.
المجزرة في الرأس
في ذكرى إحياء مجزرة الكيماوي، سأضع الرأس البشري على طاولة التشريح، في محاولة للبحث عن مسبّبات ضياع أجزاء من الذاكرة أو اختفائها أو حتى وضعها في القسم الخلفي منها، بعد التعرّض لصدمات نفسية، وأيضاً عن كيفيّة استعادتها.
العقل الموجود في هذا الرأس تعرّض خلال السنوات الثلاث الماضية إلى صدمات كثيرة عاطفية وجسدية، مباشرة وغير مباشرة، لدى معظم البشر في سوريا. ولأنّ الصدمات ما زالت مستمرة، غاب عن صاحب الرأس إدراك تأثيرها على الذاكرة والتذكر، إلى حين مروره بموقف ما نبّهه إلى الثقوب الكثيرة في ذاكرته.
لنذهب أبعد من ذلك، لنفترض أن الرأس تجاهل فقدانه لأجزاء من ذاكرته واعتبره أمراً طبيعياً، وأنه كان على يقين بقدرته على استحضار الذكرى في حال ألح على ذلك بينه وبين نفسه.
ذاكرته السابقة للسنوات الثلاث الماضية أصبحت شبه متلاشية، وعملية الاستحضار باتت شبه مستحيلة، ولم يبق سوى صور وأسماء مبعثرة غير واضحة، لذلك قرر الاكتفاء بما يحمله رأسه من ذاكرة السنوات الثلاث الأخيرة والتي أضاع اليوم أجزاء كثيرة منها أيضاً بعد أن أخفاها دون قصد في مكانٍ ما داخل عقله.
وكان ذلك التنبّه في يوم إحياء ذكرى مجزرة الكيماوي، التي تم إستحضارها بشكل جماعي ساعد العقل هذا بشكل أو بآخر على استعادة شريط ذكرياته في تلك الفترة المرتبطة بالمجزرة بشكل عام أو المرتبطة بحياته بشكل خاص.
قد يكون الأمر كالتالي، للبشر ذاكرة جماعية مخفية، ولهم أيضاً ذاكرة شخصية مخفية، ويبدو أن حالة استحضار تفاصيل التذكر الجماعي من شأنها استحضار الذاكرة الشخصية المرتبطة بها زمنياً بشكل أو بآخر، وكأننا أمام الأولى تهزّ الثانية: “أنا استيقظت، استيقظي أنت أيضاً من السبات”.
في تذكر الأحبة
في موقع المجزرة، كان هناك أربعة أشخاص: رزان وسميرة ووائل وناظم، مع فريق من المدنيين الناشطين، عملوا على توثيق ما حدث ونقله. شهدوا الموت ودفن الضحايا وصرخات أقرباء النيام وأحبابهم، تنقّلوا من نقطة طبّية إلى مقبرة، إلى نقطة طبية ومقبرة أخرى.
بعد ما يقارب 3 أشهر من وقوع المجزرة، خُطفت رزان وائل سميرة وناظم، أي بعد 3 أشهر تقريباً من الآن سيكتمل عام على الغياب.
“أكثر من 8 أشهر مرّت منذ أن اختُطفت رزان، أشعر وكأن دهوراً مضت، كل يوم يزيد إحساسي بالأسى والحزن، كلّما فتحت جهاز الكومبيوتر أبحث عنها بشكل لا إرادي لأحدّثها، الوقت يمر ببطء شديد والشعور بالمرارة والخيبة يزيد، هي مركز الحياة لكل شي بالنسبة لإلي ولعيلتنا”. ريم أخت رزان زيتونة.
في حالة اخت رزان، ذاكرتها لا تحتاج إلى ضغط تذكر جماعي كي تستحضر الغياب، الذاكرة المرتبطة بأشخاص قريبين تبدو كافية لإبقائهم في الجزء الأمامي من العقل، على الرغم من كل الصدمات المتتالية، فمشاعر القلق على حياة الأخت، والشوق إليها، وكذلك التشبث في أمل خروجها من الغياب في أي لحظة، تبقي العقل والأحاسيس متصّلة بتفاصيل حياة الشخص المغيب.. هنا لا حاجة للعقل بأمر خارجيّ حتى يستحضر تلك المجزرة، في ذكراها السنوية الأولى.
في الرقة، هناك من لا يزال يحصي الغياب يوماً بعد يوم: “291 يوماً على غيابك أبو حازم”، هكذا تحصي زبيدة خربوطلي على صفحتها على موقع فيسبوك أيام غياب زوجها اسماعيل الحامض، الذي اختطفه مسّلحو تنظيم البغدادي.
“بحسّ إنه واقف قدامي، بحكي معو كلّ النهار، كأنّه موجود وعم يسمعني، بالشتا طلّعت تيابه وكويتها، وبالصيف عملت نفس الشي، بحال طلع فجأة يكون كلّ شي جاهز، كل يوم بقلّب صوره، ماغاب عني ولا لحظة، ما بحياتي حسيت بهيك قهر وحزن”. زبيدة خربوطلي
عدّاد الغياب هذا تحول إلى عادة يومية عند كل من ينتظر أقربائه المغيّبين من مخطوفين ومعتقلين. وهنا قد لا يصحّ الحدث عن التذكّر، لأن النسيان لم يقع أصلاً..
“كل الأغاني تصلح للحزن في غيابك أبي ..كل المدن تصلح لانتظارك ..”، وفا مصطفى ابنة الأب المغيب منذ عام 416 يوماً في أحد فروع المخابرات السورية.
قد لا يحصى الغياب بالسنوات هنا، بل هو يوم.. يوم ثان.. يوم ثالث… “لا يمكنني تصديق عدّادات الغياب، أخي الصغير سيدخل سنته الثانية في سجن داعش… أُشعِل شمعة واحدة، وأُعلّق على الأبواب عداداً يومياً، كما يفعل نصف الأصدقاء مع مفقوديهم على “فيسبوك”، يأتي محمد نور إلى الكوابيس، يحمل عداداً كبيراً من النحاس، يرميه داخل رأسي ويرحل، أحاول أحياناً إبتكار أخبار كاذبة لأمي، أحكي لها كوابيس أقل حدّة على القلب، وحين تنام، تهاجمها الكوابيس ذاتها التي تدق رأسي بقوة”. عامر مطر، شقيق نور مطر الذي غيّبته “داعش” في الرقة منذ أكثر من عام.
الخميس، حيّ على الذكرى
قبل عام تماماً، في الحادي والعشرين من شهر آب، قتل النظام السوري 1466 نفساً في يوم واحد، مستخدماً سلاحاً يحظره كلّ العالم. غداً الجمعة، غداة الذكرى الأولى، نعود إلى طيّ الملف، وركنه في الساحة الخلفية للرأس، بانتظار الذكرى الثانية، فيما الرجل الذي دفن ابنتيه العام الماضي ما زال يحصي أيام الغياب، 360 .. 361.. 362..
للكيماوي صوت ولون/ ديمة ونوس
تتسع حدقة العين. تطفو على البياض كأنها تقبض عليه. يضيق التنفس. القفص الصدري يصبح كتلة ثقيلة يتسرّب الهواء إليها بطيئاً، شاقّاً. الأسنان تتكتك. يسمع صوت اصطكاكها ممزوجاً بأنين خفيف أو محاولة بكاء عابثة. قشعريرة تدبّ في أعضاء الجسم، كل الأعضاء. حتى المعدة ترتجف في البطن. الكبد والكليتان. الناس تسمع الصوت. تراه. تشمّه. لصوت الكيماوي رائحة ولون.
يقول الطفل إن عائلته سمعت صوت طائرة، فهبّت راكضة إلى الطابق العلوي حيث يسكن جدّه لينزل إليهم، ثم ليموتوا مع بعضهم بعضاً، إلى جانب بعضهم بعضاً، لينظروا في أعين بعضهم بعضاً أثناء رحيلهم الأخير. يتعانقون بالأعين، بحدقة العين التي تتسع وتطفو على البياض كأنها تقبض عليه.
الطفل كان جالساً على الكنبة في الصالون، متكتلاً على نفسه، رافعاً ساقيه، يضمّهما إلى جسمه ويحيطهما بيديه الصغيرتين. الطفل مازال متكتلاً على نفسه حتى اليوم، وحيداً في زاوية غرفة من الغرف، في مكان من الأمكنة. يقول إن أخاه اشتمّ رائحة الصوت أثناء صعوده الدرج، وإنه لم يكمل خطواته، عاد إلى البيت فلحق به أبوه وأمه وأخته. كلّهم شمّوا رائحة الصوت. صار أخوه يركض في البيت بلا وجهة محدّدة. والطفل ما زال متكتلاً على نفسه، يراقب ويبكي. أخوه راح يتقيأ ويتقياً ويتقياً. تقيأ روحه وسقط على الأرض ومات. ثم سقطت أمه وأبوه وأخته. هو لا يعرف ماذا حدث بعد ذلك ويقول إنه يجهل تماماً كيف وصل إلى هذا المكان الذي يشبه الملجأ. لم يفقد الوعي ولم يصبه دوار لأنه اكتفى بسماع الصوت ولم يشمّه. نجا هو وماتت عائلته بأكملها.
عائلة الطفل السوري المتكوّم على نفسه، مثل أي عائلة في أي رقعة من العالم، تتكون من أم وأب وأخ وأخت وجدّ. أربعة أفراد سوريين ماتوا من بين 1450 آخرين شمّوا رائحة صوت الصواريخ المحمّلة بغازي السارين والخردل القاتلين.
قبل تسعة أشهر، التقيت في منطقة البقاع بامرأة بلا ملامح. تحمل طفلاً يبلغ من العمر سنة ونصف. كانت قبل الكيماوي أمّاً لتوأم. وبعده باتت أمّاً لطفل واحد، لا تعرف أين نصفه الآخر. هربت تحت قصف الغوطتين. اعتقدت أنها تحمل طفليها. هي معتادة على حمل طفل بيدها اليمنى وآخر بيدها اليسرى. شمّت الرائحة، كتمت أنفاسها، لا بدّ أن شللاً ما أصاب يدها اليسرى فلم تدرِ أنها تركت ابنها الآخر. هي لا تعرف مكانه، حتى الآن. ولا تزال عيناها شاردتين، وحدقتاها تبتلعان الفراغ الذي يغلّف وجهها.
سنة مرّت على قصف النظام السوري للغوطتين الشرقية والغربية بالكيماوي. سنة مرّت، وضحايا الكيماوي، باتوا منسيين. رمت الولايات المتحدة جثثهم في عرض البحر. سفينة أميركية مجهزة تجهيزاً خاصاُ “حيّدت” 600 طن من مكونات الأسلحة الكيماوية بالكامل في عرض البحر المتوسط. السفينة ستسافر خلال أسبوعين إلى فنلندا وألمانيا لتفريغ حمولتها من عملية “التحييد”. هناك، في عرض البحر، سترمي السفينة جثث الضحايا المنسيين، بكل أناقة، وربما تصاحب العملية طقوس احتفالية بمرور الذكرى السنوية الأولى للكيماوي. النظام سلّم السلاح الكيماوي. لم يسلّمه قبل الاستخدام بل بعده. واشنطن رحبّت بتحفظ! معها حق. إذ لا ضمانات بالتزام النظام تعهداته في هذا الشأن. إلا أنه فاجأهم خلال الأشهر الـ12 التي تلت الكيماوي، إذ استعاض عنه بالكلور و”البراميل”. سلّم سلاحه وانتهت القضية. سلّمه وأجرى انتخابات “نزيهة” وفاز بها. الكيماوي “خط أحمر”. وأي غازات أخرى لا تزنّرها الخطوط.
سكّين “داعش”، ترعب النفوس وتفعل في المتفرّج فعل الكيماوي بضحاياه. سكّين “داعش” الحادة التي تلتمع فوق رقبة الضحية، أرعبت العالم أكثر بكثير من الكيماوي! وأكثر من “البراميل” والصواريخ والقذائف والقنص والتعذيب والكلور والقنابل المغناطيسية. لأن حاملها إسلامي ومتطرّف وإرهابي. أما قائد الطائرات فعلماني والقنّاص يعود إلى بيته ويشرب كأس نبيذ أو ويسكي ومن يمارس على معتقليه تعذيباً جسدياً، زوجته سافرة. كلنا نخاف من سكين “داعش”. إلا أن مسألة الخوف تلك، تستدعي تأملاً نفسياً ربما. ما الذي يجعل السكين أكثر إيلاماً من الكيماوي؟ ما الذي يدفع المجتمع الدولي للصراخ في وجه “داعش” والتفرّج بصمت على “سكاكين” النظام السوري الذي تفنّن خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، بإشهارها. لو أن صحافياً أميركياً كان صدفة في الغوطة قبل عام، واستنشق الكيماوي ومات اختناقاً، هل كان سيستفزّ العالم كما حدث البارحة أمام مشهد الصحافي الأميركي بلباسه البرتقالي وسكين “داعش” على رقبته؟
عام على الكيماوي. ثلاثة أعوام ونيف على حرب طاحنة يقودها النظام السوري ضد شعبه. والمعارضة السورية ممثلة بـ”الائتلاف الوطني” تلوم الولايات المتحدة الأميركية كما أفعل أنا الآن. المعارضة التي لم تفعل خلال تلك السنوات الثلاث سوى اللوم والشكوى كأنها مجرد صحافية أو كاتبة مقال! والطفل الذي ماتت عائلته أمام عينيه، لايزال متكوّماً على نفسه. والأم الثكلى تحدّق في الفراغ. والنظام السوري أعيد “انتخابه”. وسكين “داعش” تجزّ في الأذن قبل العين. وضحايا الكيماوي، ليسوا سوى أرقام وكتلة واحدة ممددة على الأرض، مقسمة إلى أجساد ملفوفة بالأبيض كالشرنقة.
استنشاق الموت”: بصريات القتل بالكيماوي/ وليد بركسية
يبدأ إعلان حملة “إستنشاق الموت” بصوت طفل صغير حزين يروي تفاصيل بسيطة من حياته في ظل الخوف من القذائف قبل أن تحصل مجزرة الكيماوي في غوطتي دمشق، قبل عام، ويفقد عائلته. تتوالى الصور “للمجزرة السورية الكبرى” مع معلومات سريعة لأعداد الضحايا وصورهم المؤلمة.. فيما تطفو على الشاشة عبارات تسأل “ما ذنب هؤلاء الأطفال”، لينتهي الفيديو بصوت الطفل الحزين وهو يتمنى الموت “للّحاق بعائلته التي اشتاق لها كثيراً”.
هذا البروموشن جزء من حملة بصرية تطغى فيها الأبعاد العاطفية على ما سواها في مشاركات الحملة، حتى فيديوهات الحملة الرسمية تنتهج الأسلوب العاطفي المبالغ فيه أحياناً. وتحاكي عاماً كاملاً مضى على مجزرة استخدام السلاح الكيماوي في غوطتي دمشق الشرقية والغربية. تختزل حملة “استنشاق الموت” العام الكامل، بكثافة في صفحات “فايسبوك”، بهدف استذكار أرواح الضحايا والشهداء، وتذكير العالم بالجريمة المروعة، قبل أن تنتقل، السبت المقبل، لإحياء الذكرى الأليمة على أرض الواقع في ساحة السلطان أحمد في اسطنبول التركية، عبر فعاليات متعددة.
تتخذ الحملة في “فايسبوك” طابع المشاركة بين منظميها والجمهور. يوحد كل تلك الجهود هاشتاغ الحملة بالعربية #استنشاق_الموت وبالانجليزية #BreathingDeath. ويعمد المشاركون حتى اللحظة، إلى مشاركة صور الحملة الرسمية المعبرة برمزية بسيطة عن “الذكرى السنوية الأولى للفاجعة”، إضافة إلى صور المجزرة التي تناقلتها وسائل الإعلام قبل عام كامل. صور الأطفال والجثث التي باغتها الموت خلال الليل تنبثق من جديد على صفحات الموقع الأزرق، كأن الوقت لم يمر وكأن كل شي حدث بالأمس فقط.
ونشرت الحملة عبر صفحتها الرسمية في فايسبوك “فيديو دعائياً” يصور الذكرى الأولى للمجزرة، وكتب أصحاب الحملة معه: “جرب السوريون الموت بكافة الطرق على يد السفاح المجرم بشار الأسد وفي يوم 21/ 08/ 2013 وبالتحديد في منتصف اللّيل، جرب أهالي المعضمية في الغوطة الغربية وعدة بلدات في الغوطة الشرقية، جربوا الموت استنشاقاً، فكان استنشاق الموت”. وتبين الحملة في أحد منشوراتها أنها “لا تتبع لأي جهة ثورية أو إعلامية أو سياسية، وإنما هي نتاج تعاون بين عدد كبير من الناشطين السوريين في الداخل والخارج الذين تخلوا عن الانتماءات الضيقة وعملوا تحت سقف الثورة فقط”. ويوضح ناشطون في الحملة لـ”المدن”، أن “الحملة تطوعية ثورية تتوجه لمخاطبة الرأي العام العالمي ليس لتذكيره بالمجزرة فحسب وإنما لمخاطبة الشعوب الفعالة للضغط على حكوماتها للتحرك من أجل محاسبة بشار الأسد ونظامه بوصفهم مسؤولون عن ارتكاب المجزرة”. ويظهر ذلك في خاتمة بيان الحملة بشكل لا يخلو من الطوباوية.
“بدأنا الترويج للموضوع من خلال العد العكسي بتغيير صورنا الشخصية كل ليلة للدلالة على عدد الأيام التي مضت على ارتكاب المجزرة”، يقول مؤسس الصفحة. أما على الأرض، “فستكون هناك عدة إعتصامات في العديد من دول العالم مثل فرنسا وأميركا وبولندا والسويد وتركيا وإسبانيا وبلجيكا وبريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى بعض الدول العربية مثل الأردن ولبنان”. وستتم تلاوة بيان الحملة أثناء الإعتصامات، وجمع توقيع المشاركين على العريضة المطالبة بمحاكمة مرتكبي المجزرة. كما ستكون هناك مظاهرات في غوطة دمشق وريف دمشق إضافة إلى ندوة إعلامية في مدينة زملكا أحد المدن التي تم استهدافها بالصواريخ الكيماوية”.
ويوضح فيديو الحملة ودعوات الحملة المكتوبة ما ستقدمه “استنشاق الموت” للجمهور طوال الفترة المقبلة، فمن جهة تقدم معلومات صرفة عن المجزرة كأرقام الضحايا والشهداء وحيثيات استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد، ومن جهة أخرى تقدم مسرحية صامتة لما حصل في الغوطة الشرقية ومجموعة من الأفلام الوثائقية التي تصور المجزرة من زوايا مختلفة (إنسانية بالدرجة الأولى) إضافة لبيانات رسمية عن المتضامنين باللغتين العربية والتركية.
شعار الحملة الرئيس هو “عام على الجريمة والقاتل طليق”. وتنطلق الحملة منه للتنديد بجرائم نظام الأسد ككل بحق الشعب السوري طوال ثلاث سنوات ونصف من عمر الثورة في البلاد. ولا تخرج الحملة في تنديدها عن الأطر التقليدية التي تبدو عديمة النفع على أرض الواقع. فكتبت الحملة في تعريفها الأساسي بشيء من التقليدية: “كانت مجزرة الكيماوي التي جرت في غوطة دمشق قبل عام من الآن وصمة عار على جبين الإنسانية. فبعد سنتين ونصف من القتل المستمر، واستخدام نظام الأسد للرصاص والمدافع والصواريخ في قتل الشعب السوري، الذي كان ذنبه الوحيد هو مطالبته بالحرية، تجرأ النظام واستخدم السلاح الكيماوي المحرم دولياً، وقتل أكثر من ألف إنسان جلّهم من الأطفال والنساء النائمين بسلام في غوطتي دمشق خلال دقائق قليلة”.
لا إعلانات ترويجية للأفلام الوثائقية التي ستعرض لاحقاً، لكن الصفحة شاركت بعض المقاطع المكتوبة والصور من أحد تلك الأفلام بعنوان “انتظار الموت” الذي يروي “قصة أكثر من 1500 شهيد”. ويبدو من تلك المقاطع أن الفيلم يقوم على الدمج بين العواطف والمعلومات الصرفة لتقديم الرسالة الإعلامية المنددة بالمجزرة، فيما لا توجد أي تسريبات حتى اللحظة عن تفاصيل الفيلم الآخر “الليل الكيماوي” سوى أنه مترجم إلى اللغات الانجليزية، الألمانية، الروسية و التركية. ويوضح الناشطون لـ”المدن” أن أبرز صعوبات إنتاج الأفلام تمثلت “بالتعرض للقصف داخل الغوطة أثناء محاولة العودة لمكان المجزرة والتصوير في بعض المنازل التي مات فيها كل سكانها، إضافة الى الصعوبات الفنية الأخرى من عدم توفر الكهرباء وانقطاع الإنترنت”.
تنشر الصفحة تباعاً لقاءات بسيطة مع بعض “الناجين من المجزرة” والتي تصور لحظات الرعب بانتظار الموت من الداخل وليس من عيون خارجية تعلق على ما يجري وهي تشعر بالأمان. هذا النوع من المشاركات هو الأقوى تأثيراً على الإطلاق وإن استخدم في الأفلام الوثائقية بحرفية فإنه سيشكل عنصراً قوياً لدعم الرسالة التضامنية ككل. ورغم كثرة المشارَكات في الحملة، إلا أن بعض المشاركين أبدوا عدم اقتناعهم بكل تلك الجهود مفضلين التوحد في جهود أكثر فاعلية، فكتب أحدهم أن “مسرحية الكيماوي انتهت في مكانها” فيما كتب آخر “أن كل هذه اللعبة السياسية لا تعنيه”، فيما تبقى الغالبية الكبرى من المشاركين في الحدث الافتراضي متحمسين لإحياء ذكرى الحادثة بشيء من التلذذ بلعب دور الضحية والتباكي أمام الكاميرات.. لا أكثر.
المدن
صهيل الذاكرة السورية في ذكرى مجزرة الغوطة/ مضر رياض الدبس
من يُعاصر مجزرةً لم تنتهِ تُربكه كتابة ذكراها، كل ثقة بما يكتبُ عنها لا تخلو من التقصير في مقتضى حالها. يدركه الحذر، في الجُمل، من كلماته، حالما يضع سؤالَه الأول: بأي كلماتٍ أكتب نصًا لم تتصور مخيلتي مضمونَه إلا على سبيل الإفراط في التشاؤم والإمعان في تصور همجية غريبة مستبعدة؟. الخجل، في الذكرى، من ذاكرتنا، يَشعُر به حالما يدركه السؤال الثاني: بأي كلماتٍ أكتب نصًا في ذكرى رحيل الآلاف، والمئات منهم أطفالاً نُوِّموا إلى الأبد تنويمًا كيماويًا؟ويشعر بالخجل، أمام المعرفة، من ضحالة معرفتنا، وضعف إدراكنا أن المجزرة كانت كامنةً بيننا قبل الثورة، ولكن لم نَرها. وأن القاتلَ ينظر إلينا كائنات هلاميّة يملأ بهم جداول إحصاءاتٍ مزورة،ويستطيع، بُعيد أي لحظة يمكن أن تحمل طابع اليقظة تحويلنا إلى أرقامٍ تُملأ بها الجداول في مؤسسات توثيق الانتهاكات ومنظمات حقوق الإنسان.ولكن للموتى القدرة على القيامة، والإقامة، وترجيع صدى صوتٍ قديمٍ أطلقوه. هم من استيقظ من الغفوة فخُيِّبَ أملُهم في الصحوة، لاحقتهم الاشتراكية البعثية وهماً في حياتهم،ويقيناً في تَشارُك السُمّ في هوائهم، وتَشارُك المثوى الأخير في مماتهم، وتَشارُك شاهدة القبر الجماعي الذي يَكبُر. وللوهم ألف طريقة للخداع ولكن هذا اليقين يَجُّبُ ما قبله. لم يسمح لهم واقع الاستبداد أن يقرأوا المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية). لكن السليقة أسعفتهم إلى التشبع بها بعد حين. فقدواأطفالهم،وفقدوا السلامة والحياةَ بحثًا عن الحرية والنضال من أجلها. قتلهم سلاح “التوازن الاستراتيجي” الذي، “إن وجد، فهو سلاح يقف بوجه النووي الإسرائيلي فقط”!..لكن التاريخ، غالباً، لا يطيل الانتظار ليقول ما ينبغي أن يقول، ومن يَقتلُ في غزة والضفة يشبه من يَقتلُ في سورية منذ سنين. وسيكون التاريخُ شاهدًا على ماضٍ لن يعود، وبين الحكايات الديماغوجية والحيوَات الواقعية عِبرٌ تعيش طويلًا. فلنا أن نقول في أطفال الغوطة ما قاله درويش في أطفال كفر قاسم:
شرف الطفولة أنها
خطرٌ على أمن القبيلة
أهنئ الجلاد منتصراً على عينٍ كحيلة
كي يستعير كساءه الشتوي من شعر الجديلة
مرحى لفاتح قرية!.. مرحى لسفاح الطفولة!..”
وتبقى اللغة والبلاغة اليوم لا تطابق ما يقتضي الحدث، ولكن كم توطَّن من معنى خذلته اللغة، وكم من أخبار المجازر قطّعت مواضيع الفكر الإنساني توضيحًا كما قطّع الزملكي المُجهَدُ بَصلةً، لا يملك غيرها دواء، على أنوف أحبَّائه علَّهم ينجون. ولكن، منذ أحداث “الجَمل” و”صفين” و”النهروان” حتى اليوم،ظلَّ أكثرنا لا يعقلون. ماذا تنفع الذاكرة أمام الشغف برقصة الموت؟وبماذا تنفع الذاكرة إن كان عليها أن تَهِبَ الحزنَ مادَّتَه وتزوِّده بمسببات البقاء؟ الأمل الحقيقي، في يوم الذكرى، خفقان قلب أمٍ مكلومةٍ ولكنها قادرةٌ على الحب أكثر، تشرح للعالمِ سرَّ الفرحِ الذابلِ في عينَي طفلةٍ سوريَّة تسألُ إن كانت على قيد الحياة. ربما هذا الحب يوقظ ما تبقى من ضميرٍ إنساني في العالم؛ ولا تسمح الإنسانية للأحداث الهمجية أن تتكرر.
قال الأمين العام الحالي للأمم المتحدة في ذكرى الإبادة الجماعية في راوندا: ” الناجون من أعمال الإبادة في رواندا دفعوا بنا إلى مواجهة الحقيقة المُرّة التي مفادها أنّ تلك المأساة كان بالإمكان تفاديها. ولذا، فإنّ السبيل الوحيد لإحياء ذكرى من لقوا حتفهم في رواندا قبل سبعة عشر عامًا هو ضمان ألا تتكرّر هذه الأحداث أبدًا.”وهذا صحيح، وقلوب السوريين اليوم ترنو إلى الإنسانية بأملٍ ينبع من فطرتهم المحبَّة للسلام وللحياة، وتقول للإنسان أينما كان: السبيل الوحيد لإحياء ذكرى من لقوا حتفهم في الغوطة قبل عام،وفي راوندا قبل سبعة عشر عامًا، هو ضمان ألا تتكرر هذه الأحداث في أي بقعة من العالم أبدًا. وبإحياء ذكراهم تصهل ذاكرتُنا كحصانٍ أصيل: نُحْيي حبَنا الفطري للحياة، واحترامنا الآخر، وتمسكنا بوطننا وبروح التسامح فيه، نُحْيي مبادئنا الأولى الأصيلة التي تقوم على نبذ الإجرام والتطرف أيًا كان فاعله ومهما كان سلاحه.ونُحْيي حُلمَنا وحقَنا المشروع في العيش في سورية حرة موحدة آمنة تحتضن جميع أبنائها. نروي الوردة الثاكلة وننتظر مخاض طفل جديد وولادة أمل جديد….
غوطة دمشق.. الكيماوي الذي لا ينسى/ سامر السليمان
تجاوزت الساعة الثانية عشرة ليلاً والكهرباء مستمرة في غيابها الطويل، حيث اعتاد الناس في الغوطة الشرقية النوم قبل ذلك الوقت بكثير. في تلك الليلة عائلات كثيرة ظلت نائمة إلى الأبد. وعائلات كانت تتحلق حول موائد الطعام البسيط، وبقيت كذلك إلى الأبد. أب يحضن ابنه على صدره وظلا في عناق أبدي. في تلك الليلة كان القصف قوياً، فتجمع الأهالي في الطوابق الأرضية. لكن الغاز السافل لا يستقر إلا في تلك المناطق المنخفضة. حين أتى المسعفون وجدوا أفواجاً من الناس، في وضعياتهم الأخيرة المتخشبة. إنه تأثير غاز السارين، المركب الكيماوي القاتل في ليلة 21 آب/أغسطس 2013. حينها قصف النظام زملكا وعين ترما، حي النيزارية وعربين وجوبر. قتل ليلتها أكثر من 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين.
المناطق التي قصفت هي مواقع مدنية، وليست قريبة حتى من خطوط التماس والجبهات. لا يحتمل ذلك الخطأ في التصويب. فقتل المدنيين كان مقصوداً، ليتم تدمير الحاضنة الاجتماعية للثورة، ومناطق التمرد.
بعد ليلة المجزرة، بقي المسعفون والأهالي يعثرون على المزيد من الجثث، لشهور . ويحكى أن عائلات بأكملها أبيدت عن بكرة أبيها. والمبالغ التي وفرها حينذاك “الائتلاف الوطني” للعائلات المتضررة، لم يتم صرفها، لعدم وجود أقارب أحياء للضحايا.
هجر الأهالي منازلهم بعد ذلك، ولم تعد سوى أعداد صغيرة فقط. أغلب الضحايا كانوا من النساء والأطفال. ولم تنجُ الحوامل من الموت؛ فهن لا يستطعن الهرب، ومعظمهن كنّ نائمات وبقوا كذلك إلى الأبد. يقول أحد المسعفين “وجدنا أعداداً كبيرة من طيور الحمام (الستيتيات) نافقة أيضاً، حيث لا يطير الحمام ليلاً”.
بعد الكيماوي، وقف أهالي الغوطة مع فصائل المعارضة المسلحة، وطالبوا، على الرغم من تحفظاتهم الكثيرة، بالتسليح. لا بل ذهب بعضهم إلى المطالبة بقصف دمشق، كي يشعر أهلها بما أصابهم وينتفضون. كان شعور الانتقام طاغياً، ولكن الفصائل لم تفعل شيئاً. ويعلق أحد الناشطين بأن “الفصائل الإسلامية تعمل بأوامر خارجية، ولا يعنيها أبداً مشاعر الناس، ولا يعنيها الناس من أصله، وبالتالي لم يفعلوا شيئاً”.
حينها قالت مستشارة الرئيس بثينة شعبان، إن من قُتل من النساء والأطفال هم من بين 300 “علوي” من قرى ريف اللاذقية، الذي اختطفوا، بعد عملية واسعة النطاق للجيش الحر. ولكن النظام لم يبادلهم، وبقوا أحياء ولم يقتلوا، وهو الأمر الذي عرف لاحقاً.
بذل المسعفون حينها جهوداً استثنائية لإخلاء المنطقة ومساعدة الناس، واستشهد عدد منهم، ومن الأطباء أيضاً، ويذكر أن عدداً كبيراً من مقاتلي “كتيبة مجاهدي الشام”، وقائدها أبو جعفر، قتلوا لأنهم لم يأخذوا أي احتياطات، لتفادي خطر التسمم والموت. يقول أحد الناشطين إن الكثير من الفعاليات تحركت حينها لإثبات أن الغوطة ضُربت بالكيماوي، من قبل النظام، الذي خاض بدوره معركة إعلامية إنكارية، متهماً قوى المعارضة، بقصف نفسها بالكيماوي، لاستدعاء التدخل العسكري. وهناك من اعتقل أو قتل، وهو يحاول إيصال عينات من مواقع القصف إلى خارج سوريا. ولكن الفريق الدولي الذي دخل إلى الغوطة حينها، وأخذ عينات من الصواريخ ومن أجساد الناس، أثبت أن ضربة الكيماوي لا يمكن أن تكون إلا من جهة النظام، وتتطلب معدات وإمكانيات تقنية عالية لا تتوفر إلا له.
انتظر الناس وقتها الصواريخ الأميركية لدك مواقع النظام، حيث ساد اعتقاد شعبي بأن ذلك قادم لا محالة. وهدأت العمليات العسكرية حينها، بدل أن تشتد، وخاصة بعد ارتباك النظام وأخلائه مواقع عسكرية مهمة له. وشعر أهالي الغوطة بالخذلان الكبير حين تقدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بمبادرة تسليم الكيماوي.
بعد سنة لم تجر محاسبة المتورطين في استخدام الكيماوي، ولا انشئت محاكمات دولية. ولا يزال النظام الذي مثل سوريا في الهيئات الدولية، مستمراً بقصف المدن والقرى، ولم يتورع بعدها عن استخدام الكيماوي مراراً.
المدن
الكيماوي.. شهادات ناجين من مجزرة الفجر/ عمر الدمشقي
الكيماوي.. شهادات ناجين من مجزرة الفجر المفاجأة أصاب الجميع بالذهول، وانتشار الجثث على مساحة أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع، كان صادماً ومخيفاً
امرأة تستغيث فيخذلها الصراخ، وشيخ يحاول إنقاذ طفل فيلقاه الموت، وعائلة لم ينج منها إلا من يروي قصة رحيلها، وجثث متناثرة في الأزقة والشوارع؛ هي صور من شهادات بعض الناجين من مجزرة الكيماوي، أكبر وأفظع المجازر في القرن 21، مجزرة دون دماء ولا أشلاء.
مضى عام كامل على مجزرة الكيماوي بالغوطة الشرقية، ولكن مشاهدها المروعة لم تغادر بعد مخيلة الناجين منها، ممن كانوا شهوداً على هول المناظر في المنازل والشوارع والأزقة والحارات. ويختزن الناجون في ذاكرتهم الكثير من المشاهد والتفاصيل التي عجزت وسائل الإعلام عن نقلها، فالمفاجأة أصاب الجميع بالذهول، وانتشار الجثث على مساحة أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع، كان صادماً ومخيفاً.
إلقاء صواريخ محملة برؤوس كيماوية، على أحياء مكتظ بالسكان، قتل أكثر من 1300 مدني، فيما تأثر أكثر من 1800 نتيجة استنشاق غاز السارين. الصواريخ استهدفت المنطقة الواقعة بين زملكا وعربين، وبين زملكا وعين ترما، وبين زملكا وحزة، وفي زملكا عند مسجدي التوفيق والحمزة، وهي مناطق خالية من مقاتلي المعارضة. ولا يريد السوريون اليوم بعد مرور عام على الكارثة، أن ينسوا المجزرة. على الرغم من آلامها يستذكرونها، ويستحضرون صور شهدائهم وأطفالهم، لتزيدهم إصراراً وعزيمة على إرادة الحياة والحرية والكرامة، التي مازلوا يدفعون ثمنها الباهظ.
أحد الناجين من عائلة كانت تعد 12 شخصاً، المختار أبو سليمان حزرومة، قال لـ”المدن”: “كانت الفاجعة أكبر من الاحتمال، مزقني منظر الأطفال الذين خنقتهم الغازات، يوم بدا كأنه كيوم القيامة”. فما شاهده أهالي الغوطة ذلك اليوم يعمّق الجراح، والمشاهد المرعبة التي عايشها الناس ستظل ترافقهم مدى الحياة. يكمل المختار: “أن ما حدث لا يتخيله العقل”.
مدير المكتب الإعلامي لبلدة زملكا يتذكر المجزرة: “الزمن عقب المجزرة كان يحسب بالدقيقة، من أجل إنقاذ المصابين أو نقل الجثامين”. ويضيف “سمعنا صوت سقوط صاروخ، له صوت مرتفع جداً، وكأنه تفريغ لغاز مضغوط بشدة. الدخان الناجم عن الصاروخ كان أزرق اللون”.
لم يترك الموت للسكان سوى الانتظار في المستشفيات أو الخروج لملاقاته في الشوارع. ويروي أحد الناجين، أنه ما إن هدأت أصوات الانفجارات، حتى هرع الناس مذعورين باتجاه مناطق لم يصبها السارين، كسقبا وحمورية وكفربطنا وجسرين، تاركين قتلاهم في الشوارع والبيوت.
يقول مدير مستشفى ميداني كان مناوباً وقت المجزرة، بأن الحالات التي وصلت المشفى، كانت مصابة بضيق شديد في التنفس، واصفرار كامل في الجسد، وتضيق في الحدقة الدبوسية للعين. وأن بعض الحالات كان لديها تسرع شديد في نبض القلب، وتعرق كثيف، بالإضافة إلى فرط لعاب بشكل رغوي من الأنف والفم، وتشوش في الرؤية، وهلوسات. الإصابات تراوحت ما بين خطيرة وشديدة الخطورة، بحسب أماكن التواجد، وبحسب كمية الغاز التي تم استنشاقها.
محمد الشمس، من بلدة زملكا، لا زال يشعر بالمرارة نتيجة عجزه عن إنقاذ أسرة أحد أقربائه التي قضت جميعها، وظلت جثث أفرادها في بيتهم لأكثر من 12 ساعة. ويقول محمد إن قلبه يحترق كلما تذكر أنه فشل في إنقاذ الناجية الوحيدة من عائلة ابن عمه، “من الصعب أن يستنجد بك أحد، وأنت لا تستطيع أن تفعل له شيئا”. ويضيف “كانت قريبتي تستغيث وتقول أنا عايشة.. عايشة يا محمد.. أنا عايشة. لكنني لم استطع فعل شيء لها”.
الغوطة الشرقية –
المدن
مجزرة الغوطة: حقوقيون لم ييئسوا من الأمل بالعقاب
ليال أبو رحال
تجاوزت المنظّمات الحقوقيّة، بعد مرور عام على مجزرة الغوطة الشرقيّة في ريف دمشق، مسألة استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي، المحرّم دولياً، كما لم يتمكّن مجلس الأمن الدولي بعد، برغم ثبوت الأدلّة على استخدام غاز السارين بشكل موسّع، من إصدار أي قرار، يتضمّن إدانة النظام السوري.
لا يعكس غضّ النظر عن محاسبة النظام السوري على استخدام الكيماوي، بعد موافقته على تسليم ترسانته من “الكيمياوي”، تقصيراً من الجهات الحقوقية والدوليّة المعنيّة، بقدر ما يرتبط باستخدام النظام ذاته أسلحة أخرى، على نطاق واسع، بات أكيداً أن ضررها على المدنيين أشدّ من واقعة “الكيماوي”.
يلتصق الحديث عن “كيماوي” الغوطة اليوم ببراميل الموت المتفجّرة، التي تحصد أرواح المئات من المدنيين. طالب مجلس الأمن الدولي، في قرار أصدره في فبراير/شباط الماضي، بالكفّ عن “الاستخدام العشوائي للأسلحة” في المناطق المدنيّة، بما في ذلك البراميل المتفجّرة، لكن القرار بقي حبراً على ورق. يندّد الحقوقيون والناشطون بارتفاع عدد ضحايا البراميل المتفجّرة، منذ إصدار القرار الدولي المذكور.
تقول الباحثة في الشأنين اللبناني والسوري في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، لمى فقيه، لـ”العربي الجديد”، إنّ “تحرّك مجلس الأمن، على خلفيّة استخدام السلاح “الكيماوي” أمر جيّد، وتخلّي سورية عن مخزونها أمر جيد أيضاً، لكنّ هناك انتهاكات أخرى بأسلحة أخرى، تُستخدم يومياً”. من هنا، ترى أنّه بات لزاماً اليوم، الانتقال إلى مرحلة ما بعد “خط الكيماوي الأحمر”: “مجلس الأمن مطالب بخطوات مماثلة إضافيّة، فالسوريون يموتون يومياً من جراء استخدام البراميل المتفجّرة”.
تقتل البراميل المتفجّرة السوريين يومياً، لكنّ المطالبة بتحرّك المجتمع الدولي لإدانة النظام بشأن استخدامها، لا تبرّر السكوت عن تقاعسه في محاسبة المتورطين بمجزرة الغوطة الشرقيّة. وشهد العالم، قبل عام من اليوم، استخداماً موثّقاً للأسلحة الكيميائية، وصفته “هيومن رايتس ووتش” حينها بأنّه “الاستخدام الموسّع الأوّل، منذ استخدمت حكومة العراق الأسلحة الكيميائية على المدنيين الأكراد العراقيين في حلبجة قبل خمسة وعشرين عاماً”. قتل أكثر من ألف مدني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في الحادي والعشرين من أغسطس/آب الماضي في ريف دمشق. أكّدت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير أصدرته في العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي، أنّ الأدّلة المتوفرة لديها، توحي بقوة، بأن القوات النظامية السورية، مسؤولة عن هجمات بالأسلحة الكيماوية على بلدتين في محافظة ريف دمشق في 21 أغسطس/آب 2013.
وقالت إنّ “الهجمات التي قتلت مئات المدنيين وبينهم العديد من الأطفال، يبدو أنها تمّت باستخدام غاز أعصاب على درجة سلاح، يُرجح أنه غاز سارين”. توضح فقيه، التي ساهمت في إعداد تقرير “هيومن رايتس ووتش”، أن “كلّ الأدلّة التي توفّرت لدينا، من نوعيّة السلاح وطريقة استخدامه، والهجوم على المنطقة المستهدفة، والأعراض التي ظهرت على الضحايا، تؤكّد أنّ الحكومة تقف وراء المجزرة”.
تذكّر فقيه بتحرّك المجتمع الدولي بعد المجزرة، بدءاً من إجبار الحكومة السورية على الاعتراف بمخزونها الكيميائي، وصولاً إلى تخليها عنه. تبدي فقيه، مراراً، أسفها الشديد، للفشل في محاسبة المسؤولين عن المجزرة أو التحقيق بشأنها، رغم أن استخدام الأسلحة الكيمائية يُعدّ خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.
تشير إلى أن “هيومن رايتس ووتش”، وبالشراكة مع مائة منظّمة دوليّة ومحليّة، رفعت رسالة الى مجلس الأمن، طالبت فيها بتحويل النظام السوري إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة، لـ”التحقيق ومحاسبة المسؤولين السوريين عن الانتهاكات خلال أكثر من ثلاث سنوات”. وتعود، مرة جديدة، لتبدي أسفها، بشأن معارضة كل من روسيا والصين لصدور أي قرار يدين سورية.
لا يدفع عجز مجلس الأمن الدولي عن التحرّك لمحاسبة المرتكبين، المنظمات الحقوقيّة إلى اليأس من إمكانية إحقاق العدالة. تشدّد فقيه على أنّ الناشطين الحقوقيين، كما أهالي ضحايا مجزرة الغوطة، يأملون بمحاسبة المجرمين. وتقول في هذا الصدد “نتواصل مع عدد من عائلات الضحايا. بعضهم يتمسّك بأمل معاقبة المتورطين، لكنّ حياة البعض الآخر، تدمّرت”. أكثر من ذلك، تفيد فقيه بأن معاناة بعض العائلات مستمرة. تتحدّث عن أمراض يعانيها مدنيون ويُعتقد أنّها مرتبطة بتنشّقهم كميات من الغاز المستخدم، مؤكدة أنّ نتائج استخدام “الكيماوي” مستمرة.
الرسالة الكيماوية للمعارضة: نحو “داعش” وأخواته
إسطنبول ــ عبسي سميسم
أظهرت جريمة الضربة الكيماوية عجز الإرادة الدولية عن تطبيق أي من أحكام الشرعية ومواثيقها التي تتعلق بأبسط حقوق الشعوب، وخصوصاً حين يتعارض تطبيق هذه الأحكام مع مصالح الدول الكبرى وحلفائها، خصوصاً إسرائيل.
كما أعطى التفاهم الروسي الأميركي بشأن المجزرة، الضوء الأخضر للنظام في دمشق ليرتكب ما يشاء من انتهاكات بحق من يعارضه، وجعله في حل من خط الرئيس الأميركي باراك أوباما الأحمر، الذي ظل يلاحقه على مدار الفترة اللاحقة للضربة الكيماوية، إذ أدرك بعد مجزرة الكيماوي أن لا خطوط حمراء أمامه في قتل السوريين وبالطريقة التي يريدها.
ربما تكون جريمة الكيماوي هي الحدث الأبرز الذي جعل النظام يتعنّت في رفض أي حل سياسي، والذهاب باتجاهات تضمن له البقاء أطول مدة ممكنة في السلطة بغضّ النظر عن الوسائل التي يتبعها. وقد تجلّت مظاهر هذا التعنت باستخفاف النظام بكل الجهود الدولية التي بذلت للتوصل إلى تسوية سياسية في جنيف، وذهابه باتجاه مسرحية الانتخابات الرئاسية من أجل قطع الطريق أمام أي حل سياسي.
وتلقّت المعارضة السياسية من خلال جريمة الكيماوي، وما تبعها من توافقات دولية، رسالة مفادها أن موضوع التدخل الدولي الحاسم لحل القضية السورية هو أمر غير مطروح على المدى المنظور، وأن المطلوب الإبقاء على توازن قوى يُبقي على حالة استعصاء عسكري وسياسي، من شأنه إطالة أمد الأزمة قدر المستطاع لاستنزاف كافة الأطراف، وأن دعوات التدخل الدولي من أجل إنشاء مناطق عازلة، أو مناطق حظر جوي، أو حتى ممرات إنسانية، هي دعوات غير مقبولة بالنسبة إلى الأطراف الدولية المتدخلة بالشأن السوري، ولا مصلحة لأي منها في المساهمة بإقامتها.
ولعل أبرز تجليات الضربة الكيماوية، كانت على مستوى الوسط المعارض، الشعبي منه والعسكري، إذ فقد هذان الوسطان آخر ذرة ثقة بالمجتمع الدولي، وبالتالي بالجهات السياسية التي تمثّلهم في الخارج (من مجلس وطني، وائتلاف)، كون تلك الجهات تعتمد في عملها على علاقاتها مع الأطراف الدولية، الأمر الذي ساهم بذهاب قسم من الحاضنة الشعبية للمعارضة إلى تأييد التشكيلات العسكرية ذات الاتجاهات المتطرفة، التي أجادت قراءة احتياجات سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وساهمت بتأمين متطلبات حياتهم اليومية، من خلال الدعم المالي الهائل الذي تتلقاه.
كما دفع هذا الأمر بالكثير من التشكيلات العسكرية التي كانت تحت مسمى “الجيش الحر”، إلى الانضواء تحت ألوية التشكيلات السلفية التكفيرية ومبايعتها، (كجبهة النصرة وداعش)، إذ زادت شعبية تلك التشكيلات ونفوذها بعد الضربة الكيماوية في معظم المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وهو هدف طالما سعى النظام للوصول إليه من أجل تصوير الثورة السورية على أنها إرهاب.
فالمجتمع الدولي، من خلال تخاذله وغض طرفه عن جريمة الكيماوي التي ارتكبها النظام، ساهم في خلق حالات من التطرف لم يكن ليعرفها المجتمع السوري لولا شدة العنف التي مورست بحقه. ويقول رئيس ومؤسس “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، لـ”العربي الجديد”، إن النظام السوري استخدم قبل مجزرة الغوطة، غازات يُعتقد أنها كيماوية في 28 حادثة، منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 في حي البياضة بحمص، وآخرها كان في 21 يوليو/تموز 2013 واستهدفت حي مخيم اليرموك جنوبي دمشق، وخلّفت ما لا يقل عن 83 قتيلاً وإصابة 1271 آخرين، لتأتي مجزرة الغوطة في وقت يكون فيه الهواء أبرد ما يمكن، حتى يحصد الهجوم بالغازات السامة أكبر عدد ممكن من القتلى.
وقد وقّعت الحكومة السورية بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول 2013، على الانضمام لاتفاقية نزع وتدمير الأسلحة الكيماوية، وبتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2013 صدر القرار 2118، وتضمّن بنداً ينصّ على تدخل مجلس الأمن تحت الفصل السابع في حال الإخلال بالاتفاق من قِبل الحكومة السورية.
ويشير عبد الغني الى أن السوريين استبشروا خيراً بهذا القرار، وأن من قتل أبنائهم لن يفلت من العقاب، خصوصاً أنه قد صدر تحت الفصل السابع. وأضاف: “فعلاً فقد توقف النظام السوري لمدة عن قتل السوريين عبر استخدام الغازات السامة، واستمرت عمليات القتل عبر التعذيب، وصواريخ سكود، والقنابل البرميلية، والذخائر العنقودية، والمدفعية، والهاون”.
ويلفت الى أن “هذه الأسلحة التقليدية هي التي قتلت 99 في المئة من السوريين، بينما كل الهجمات بالأسلحة الكيماوية قتلت 1 في المئة”. ويلفت عبد الغني الى أنه “بعد برود الموقف الدولي تجاه النظام السوري، والحماية الروسية والصينية، عاد مع بداية عام 2014 لاستخدام الغازات السامة، إذ سجّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 27 حادثة لهجمات بغازات يُعتقد أنها سامة، استهدفت 11 منطقة واقعة في ثلاث محافظات هي ريف دمشق، وحماه، وإدلب، وأدت تلك إلى مقتل 35 شخصاً، وإصابة ما لا يقل عن 920 آخرين.
وبحسب الناشط السوري الحقوقي، فإن كل الهجمات التي وقعت بعد صدور قرار مجلس الأمن 2118، لم تكن بغاز السارين، وإنما بغاز الكلور الذي يُعتبر أقل تأثيراً من السارين، إلا أن الهدف الرئيسي من استخدامه هو نشر الذعر بين الأهالي، وقد تحقق ذلك.
الغوطة.. جريمة تبحث عن عقاب/ بشير البكر
عام وجريمة الغوطة من دون عقاب. قالت لجان التحقيق الدولية من هو القاتل، وحددت سلاح الجريمة، وتحرك الغرب تحت بند معاقبة الجاني، لكنه اكتفى بأن صادر منه أدوات الجريمة، وتركه طليقا.
صمت الغرب بعد ذلك، ومن حينها، صار المجرم أكثر حرية، وأخذ يتصرف بلا حرج، فقتل، حتى اليوم، أكثر من مائة ضعف من السوريين الأبرياء. قتلهم بأسلحة أخرى، وكما استعمل في الغوطة سلاح قتل جماعي، واصل القتل بأدوات الموت الرخيص، البراميل البدائية المتفجرة، التي لا تكلف شيئا، وتستخدم تقنية رش الذباب والصراصير.
السوريون ذباب وصراصير، هكذا يتعاطى معهم رئيسهم الشاب، بشار الأسد، ولا يتحرك أحد لوضع حد لانحرافاته، التي فاقت كل أنماط الانحطاط الحيواني في التاريخ. بلغت الاستهانة بأرواح السوريين حدَّ أن العالم توقف عن إحصاء أعداد الضحايا، ليس لكثرتهم فقط، بل لأن الأرقام لم تعد تعني شيئاً، وسواء سقطت مائة ضحية أو أكثر في اليوم، فالأمر سيان، لأن الخبر السوري صار يعبر في وسائل الإعلام، من دون أن يكترث به أحد.
بات موت السوريين تفصيلاً بين تفاصيل كثيرة في المنطقة، وكلما تقادم به الوقت، قل الاهتمام به، ولا غرابة في أن يغدو، في وقت قريب، أمراً عاديا، وكأن هؤلاء، الذين يتساقطون كل يوم بأدوات القتل الأسدي، مجرد أرقامٍ، تمحوها أرقام أخرى.
ربما قال قائل إن هول المأساة يعمي البصر والبصيرة. وربما صارت المسألة السورية من التعقيد بمكان فاقت فيه قدرة البشر على التفكير في حلول لها، فهي متشعبة إلى حد كبير، وتتفرع عنها مشكلات تحتاج كل واحدة منها إلى ورشة عمل تحتاج إلى أعوام. هناك الدمار الهائل، الذي لحق بالعمران والبنى التحتية. بالإضافة إلى حوالى عشرة ملايين مشرد ولاجئ. وهناك قرابة مليون معاق. لا مدارس ولا مستشفيات، هذا عدا الجيوش وأمراء الحرب وجماعات الإرهاب “الداعشي” وجيوش الإسلام، التي لا حصر لها.
تشكل جريمة الغوطة تاريخاً مفصلياً في مسار الثورة السورية، ودرساً لم يتعلم منه السوريون شيئا. ذلك أن اكتفاء الغرب بمصادرة السلاح الكيماوي لتدميره، إنما كان يعني أن الباقي تفاصيل، وهذا ما فهمه بشار الأسد جيداً، فصعد من سفك الدماء والتدمير والتهجير، ورفض السير في حل سياسي في جنيف، وذهب إلى التجديد لنفسه في ولاية رئاسية ثالثة.
وبدلاً من أن يعيد السوريون تنظيم أنفسهم سياسياً وعسكرياً، ازدادوا انقساماً، وأضاعت النخب، التي تصدرت مشهد الثورة، الوقت في صراعات مناصب ومكاسب، بينما كان شعبهم يذوق الويلات، ويدفع الفاتورة مضاعفة في كل يوم يمر.
واليوم، بعد مرور عام على جريمة الغوطة، يبقى الأفق مسدوداً، ولا مؤشرات، لا على وقف القتل، ولا على حل سياسي. والأكثر مأساوية من هذا وذاك، لا تبدو هناك نية لدى أحد للتفكير في حلول للمأساة، طالما أن المنطقة ملتهبة من غزة إلى الموصل.
ويمكن القول من دون تردد إن المسؤولين، مباشرة، عن المأساة السورية هم أنفسهم، الذين يتحملون مسؤولية قتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم. من أطلق يد بشار الأسد في سورية، هو ذاته الذي أباح لبنيامين نتنياهو أن يهدم غزة على رؤوس أهلها.
في الحالين، تخلت القوى العظمى عن مسؤوليتها الأخلاقية، فلم تعد مكترثةً بما يجري في المنطقة، وصارت تبخل حتى في قرار إدانة من مجلس الأمن، أو توجيه لومٍ، أو مناشدةٍ، لوقف قتل المدنيين الأبرياء. وحدهما، نتنياهو والأسد، يتصرفان بكل حرية، وليس هناك طرف دولي يكلف نفسه عناء وضع حد لهما، حتى لكأن البشرية في طريقها إلى شريعة الغاب.
مر عام وجريمة الغوطة بلا عقاب، ويبدو أن المجرم ركن إلى قناعةٍ بأنه سيفلت من ذلك، وسيدفن الجريمة بارتكاب جرائم أخرى، ولكن هذه الجريمة ليست من النوع الذي يتقادم عليه الزمن، لأنها من أفعال الإبادة وجريمة ضد الإنسانية، وقد شاهدنا أخيراً أن مسؤولي جرائم الإبادة في كمبوديا، (الخمير الحمر)، تمت محاكمتهم بعد 35 عاماً. والأمل، اليوم، معقود على عشرات المنظمات الإنسانية، التي لا تزال تعمل على جلب بشار الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية.
الأسد يواصل جرائمه والعالم يتفرج
عام على مجزرة الكيماوي
لم تطمس أنهر الدماء المتدفقة في سوريا وفي العراق بحراب «داعش» وبراميل بشار الأسد المتفجرة، تلك الصور التي صدمت العالم لمئات الأطفال الممددين في غوطتي دمشق الشرقية والغربية؛ قتلى بلا جروح وبكامل أجسادهم الندية. لكن الجريمة تواصلت، والعالم اكتفى بالتفرج والتنديد مكتفياً بسحب سلاح الجريمة (السلاح الكيميائي) والحفاظ على من استخدمه (نظام بشار الأسد)، ومنع السلاح عن «الجيش السوري الحر» على الرغم من وعود التسليح، ما سمح للنظام بتحقيق تقدم في غير مكان، ولتنظيم «داعش» الإرهابي بالسيطرة على مناطق حررها الثوار وطردوا قوات الأسد منها في بداية الثورة.
ولمناسبة الذكرى السنوية الأولى للمجزرة أصدر «الإئتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية» تقريرا، قال فيه إن «نظام الأسد استخدم السلاح الكيميائي المحرم دولياً 33 مرة ضد الشعب السوري الأعزل مستهدفاً 25 منطقة، وكان أعنف هذه الاستخدامات في الغوطة الشرقية بتاريخ 21/8/2013 مخلفاً عدداً كبيراً من الشهداء وصل إلى 1507 شهداء. وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يتعامل المجتمع الدولي بمبدأ محاسبة المجرم على جريمته وإنقاذ باقي السوريين من إجرامه، تأتي اليوم الذكرى المشؤومة الأولى لمجزرة الكيماوي، وقد اقتصرت الاجراءات الدولية حتى الآن على مصادرة سلاح الجريمة ليس إلا«.
وأضاف في مقدمة التقرير، أنه «كانت هذه المجزرة الخرساء هي الأبشع في قرن تسوده شريعة حقوق الإنسان، فالأسد لم يقتل المدنيين بصمت فقط، بل مرّت هذه المجزرة في ظلّ صمت دوليّ مماثل أكثر إيلاماً، أثّر بدوره في ثقة الشعب السوري بالإنسانية ومجتمع الديمقراطية والقانون في العالم. لم يقف كيماوي الأسد عند دمشق وغوطتها فحسب، بل تجرّأ وبعد الصمت الدولي على استخدام هذا السلاح المحرم دولياً مرات ومراتٍ داخل سوريا الغاضبة والتي غصّت ساحاتها بإرادة شعبية مدنية طالبت بإسقاطه. في الوقت الذي كان من المفترض أن يتعامل المجتمع الدولي مع القاتل بمبدأ المحاسبة وإنقاذ السوريين من وحشية هذا الصائل العسكري والسياسي الذي أعمت عينيه حبّ السلطة، فقدّم سوريا وشعبها على طبق من ذهب للوحوش الإقليميين والدوليين بشرط ضمان كرسيّه الراجف الذي طّرزه بجماجم أطفال الكيماوي!. تأتي اليوم الذكرى المشؤومة الأولى لمجزرة الكيماوي، وقد اقتصرت الاجراءات الدولية حتى الآن على مصادرة سلاح الجريمة ليس إلا.. حيث سارع المجتمع الدولي إلى مصادرة السلاح الكيمياوي وفق اتفاق عقده مع نظام الأسد غير آبه باستمرار النظام بجرائمه ومجازره سواء بالكيماوي أو بطرق أخرى«.
ووجه رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة رسالة أمس للشعب السوري موضحاً فيها أن: «النظام المجرم ارتكب جريمته في ظل صمت مطبق وكامل من المجتمع الدولي الذي اكتفى بتجريد المجرم من السلاح ومن ثم تركه طليقا.» وأكد البحرة أن: «هذه الجريمة فضلاً عن كونها جريمة حرب،فإنها جريمة بحق سوريا وشعبها عندما تنازل المجرم عن السلاح الذي دفع الشعب السوري ثمنه من دمه وقوت أطفاله«. وأضاف البحرة:» نقول للعالم أجمع لن نهدَأ ولن يستقر ضميرنا حتى نرى المجرم المسؤول عن ارتكاب هذه الجريمة في قبضة العدالة»، مؤكداً أن «الائتلاف الوطني يعمل بكل جهد وتفان من أجل إيصال هذه القضية لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها أبشع جرائم الحرب التي ارتكبَت في العصر الحديث».
وختم البحرة قائلا، «إن آلام الشهداء وزفرات الأمهات والآباء الذين شاهدوا أبناءهم وهم يختنقون بالغاز ستكون هادياً لنا في دربِنا وموجهاً في عملنا، وحقاً لن نتنازل عنه«، وشدد على ضرورة أن تكون: «هذه الذكرى حافزاً لنا يدفعنا لتَوحد حول راية الوطن الراية الجامعة لنا، وطننا الذي نحب والذي سنعمره رغم أنف البغي«.
وعشية الذكرى الأولى للمجزرة، كرر نظام بشار الأسد ليل الأربعاء ـ الخميس جريمته مستهدفاً حي جوبر الدمشقي بالغازات السامة ما أسفر عن سقوط خمسة شهداء والعديد من الإصابات وحالات الاختناق، باعثا برسالة إلى المجتمع الدولي في ذكرى هجمات الغوطة، فحواها أنه لن يتوقف عن قتل الشعب وأنه غير آبه بالمجتمع الدولي، وأنه مستمر في ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات والخروق.
وتزامن ذلك مع 4 غارات جوية شنتها طائرات النظام على الحي، فيما طال قصف بقذائف الهاون، بلدة حزرما في منطقة المرج في الغوطة الشرقية، مصدره قوات الأسد في الحواجز المحيطة، والذي تسبب بجرح عدد من المدنيين.
وأمس، كرر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان بلاده سلمت قبل اشهر اسلحة لمقاتلين في المعارضة السورية «حوصروا» بين القوات النظامية ومقاتلي الدولة الاسلامية.
وقال هولاند خلال زيارة لجزيرة لا ريونيون ان هذه الاسلحة سلمت «قبل اشهر عندما كان مقاتلون للمعارضة السورية يواجهون في وقت واحد جيوش الديكتاتور بشار الاسد وممارسات المجموعة الارهابية التي تسمى الدولة الاسلامية».
وصرح للصحافيين «لم يكن في وسعنا ان نترك السوريين الوحيدين الذين يمهدون للديموقراطية (…) بدون اسلحة».
وقال هولاند الذي كان لمح الى هذا الامر في حديث نشرته صحيفة «لوموند« الاربعاء، انه اتخذ هذا القرار «طبقا لتعهداته» و»لقواعد الاتحاد الاوروبي» مؤكدا ان فرنسا سلمت «جزءا من المعدات المسموح بها لهؤلاء المقاتلين» المعارضين السوريين.
واضاف «اليوم ما يحصل في سوريا فظيع. فمن جهة يواصل نظام بشار الاسد عمليات القصف والتنكيل (ومن جهة اخرى) الدولة الاسلامية وبينهما اولئك الذين كان يفترض ان يحضروا للمستقبل ووجدوا انفسهم بين فكي كماشة».
وتابع «بالتالي لا يمكننا وقف الدعم الذي قدمناه لهؤلاء المعارضين الذين يشاركون وحدهم في ارساء الديموقراطية».
واضاف ان فرنسا «لا يمكنها القيام بذلك وحدها» بل «يجب القيام بذلك بالتعاون مع اوروبا والاميركيين».
الائتلاف السوري، أ ف ب
في الذكرى الأولى … أوراق اعتماد معمدة بالدم/ محمد صبرا
لعب النظام السوري، منذ بداية تشكله على يد الأسد الأب، دوراً وظيفياً مهماً في السياسة الدولية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، كان نتيجة طبيعية لموقع سورية الجغرافي الذي ساهم بتضخيم القوة التي يتمتع بها نظام مستقر، يحكم هذا البلد. لقد كانت سورية تقع، على الدوام، بين حدي عبء الجغرافيا وعبقرية المكان، ما أدى إلى وضع متأرجح في المكانة السياسية للنظام الحاكم في سورية، أياً كانت طبيعته. وانطلاقاً من فهم عميق لهذا الموقع الجيوسياسي، مارس النظام السوري صلفاً غير معتاد منذ بداية الثورة السورية، وهو يدرك أن موقف القوى العالمية من عملية التغيير في سورية لن يكون على الشاكلة المصرية أو الليبية ولا اليمنية.
كانت ممارسات هذا النظام تشي بأنه مرتاح في استخدام فائض القوة لديه ضد طموحات الشعب، من دون خشية حقيقيةٍ من المحاسبة على ما يفعل، فبعد أربعة أشهر من الثورة، وسقوط أكثر من ألف شهيد، أبدت الولايات المتحدة الأميركية موقفاً اعتبر الأشد لهجة حتى ذلك التاريخ، إذ قالت هيلاري كلينتون، في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة الأوروبية، كاثرين أشتون، في 12 يوليو/تموز 2011 “الرئيس الأسد ليس شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه، ونحن ليس لدينا أي شيء على الإطلاق للاستثمار في بقائه في السلطة”.
جاء هذا التصريح في عقب جمعة “إرحل” التي صادفت يوم 1 يوليو/تموز 2011، والتي أكدت أغلب وكالات الأنباء أن عدد المتظاهرين فيها كان زهاء أربعة ملايين متظاهر، في أكثر من مائة نقطة تظاهر على امتداد الجغرافيا السورية. كان جلياً، منذ هذا التاريخ، أن “الثورة السورية قد أصبحت قوة لا تقاوم، اصطدمت بشيء لا يمكن تحريكه”، على حد تعبير فؤاد عجمي.
يدرك المتفحص لكلام هيلاري كلينتون طبيعة الدور الوظيفي الذي كان يلعبه النظام السوري في السياسات الأميركية في المنطقة، في ظل علاقة شديدة التعقيد، تحكم الطرفين، ويبقى الثابت الأساسي فيها عدم تعريض أمن إسرائيل للخطر. هذا الدور الوظيفي هو نقطة الارتكاز التي استثمر فيها حافظ أسد، منذ منتصف السبعينيات، بتدخله في الحرب الأهلية اللبنانية. ولا يغيب عن بالنا أن دخول الجيش السوري إلى لبنان كان بمباركة أميركية، وبمعارضة من الاتحاد السوفييتي السابق، والذي يفترض أنه الحليف الاستراتيجي للنظام السوري وقتها. هذا الأساس التاريخي قد يلقي بعض الضوء على البعد الوظيفي للنظام السوري.
لقد أدرك بشار الأسد أن اهتمام المنظومة الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ينصب بالدرجة الأولى على أهمية ضبط السلاح الكيماوي، وليس على تحقيق أي عملية ديمقراطية في سورية، تؤدي إلى رحيله. لم يكن هذا الموقف خافياً على أحد، وكان أكثر من مسؤول أميركي يردِّد أن الولايات المتحدة لن تسمح بتسرب الأسلحة الكيماوية السورية إلى حزب الله، أو إلى الحركات الجهادية. كان واضحاً أن الولايات المتحدة تعيش أزمة أخلاقية، بسبب موقفها المتردِّد من تقديم دعم جدي للثورة السورية، لكن ضغوط أطراف دولية أخرى، ولا سيما بعض الدول العربية وتركيا وفرنسا والتي كان موقفها واضحاً بعدم إمكانية بقاء بشار الأسد في السلطة تحت أي مسمى، قد حرك الولايات المتحدة الأميركية، للبحث عن حلول أخرى للمعضلة السورية.
تجلت هذه الحلول في بيان جنيف في 30 يونيو/حزيران 2012، وهو حل غير قابل للتطبيق، بسبب غموضه، وعدم وجود فرصة حقيقية لتغيير جدي في موازين القوى، يسمح بفرضه من جانب قوى الثورة السورية. أعقب صدور بيان جنيف تقدم جيد للمعارضة المسلّحة على الأرض، سمح بسيطرتهم على مساحة كبيرة من الجغرافية السورية، تقدر بأكثر من نصف مساحة سورية، واستمر هذا التقدم يضطرد باتساع خلال عام 2012 وبداية عام 2013. وكانت كل الدلائل تشير، على الرغم من تعقد المشهد السوري ونمو الحركات المتطرفة، إلى إمكانية زحزحة مكان الأسد، وإلزامه باتباع حل سياسي ما.
في هذه اللحظة الحرجة بالنسبة له، بدأ النظام السوري يقيس مستويات الصراع، وإمكانية الاستغناء عنه أميركياً بالدرجة الأولى. كان بشار الأسد قادراً على إعادة تجديد أوراق اعتماده لدى الإدارة الأميركية، ليس من باب مكافحة الإرهاب الذي لم يعد يقنع أحداً، بل من باب استثمار الحساسية الإسرائيلية المتعلقة بالسلاح الكيماوي، فكانت عملية استخدام السلاح الكيماوي في غوطة دمشق في يوم 21 أغسطس/آب 2013 هي العرض الذي قدمه الأسد، وتلقفه الأميركيون بشغف، فقد كانوا ينتظرون هذه اللحظة التي كان الجميع يدرك أنها ستأتي.
في مؤتمر هرتسليا للأمن، المنعقد في 14 مارس/آذار 2013، صرح رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الجنرال أفيف كوخافي: “الأسد ما زال يسيطر على السلاح الكيماوي في البلاد، لكنه يدرس تصعيد الحرب مع الثوار، ويقوم بتحضيرات متقدمة لاستخدام السلاح الكيماوي ضد الثوار”. وأردف “الأسد لم يعط الإشارة بعد لاستخدامه”. تناقلت هذا التصريح كل وكالات الأنباء العربية والأجنبية. كان الجميع يعلم أن الأسد سيستخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه، لكن الجميع تركه يستخدم هذا السلاح، ليفاوضه على تسليمه، والأسد فهم هذه المعادلة. وافق مباشرة على تسليم هذا السلاح، وبهذا تمت صفقة مع العالم أجمع، يضمن بموجبها أنه لا يمكن إطاحته في فترة التسليم التي تمتد تسعة أشهر، أي حتى منتصف عام 2014، كما جاء في قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في 27 سبتمبر/ أيلول 2013، والذي تبناه مجلس الأمن في القرار رقم 2118 الصادر عن مجلس الأمن في التاريخ نفسه. إذن، ارتكب الأسد جريمته، وضمن بقاءه في السلطة تسعة أشهر، وبقرار دولي، باعتباره أصبح شريكاً في عملية تسليم السلاح الكيماوي. في هذه الفترة، سيعمل نظامه على تغيير جوهري في موازين القوى، يضمن له تجديداً إضافياً، وهو ما استطاع تحقيقه بإيجاد البيئة اللازمة لازدهار تنظيم الدولة الاسلامية الذي سيكون محلاً لتفاوض مقبل بين الأسد والقوى العالمية.
كانت جريمة استخدام السلاح الكيماوي مزدوجة، فهي، فضلاً عن وحشيتها والهمجية الكامنة وراء العقل المخطط لها، كانت جريمة من أجل بقاء فرد في السلطة، بمباركة من المنظومة الدولية. لم تكن أداة لكسر إرادة الثورة، أو لتحقيق الانتصار على العدو، وإجباره على الاستسلام، كما يحدث عادة في حالات استخدام السلاح الكيماوي، أو أسلحة الدمار الشامل، بل كانت مجرد استثمار بدماء السوريين ساهم العالم كله بأخذ الحصة المناسبة منه. ستبقى هذه الجريمة جرحاً غائراً في الوطنية السورية، وستبقى وصمة عار على جبين المنظومة الدولية. إنها السقوط الأخلاقي المريع لعالم يدّعي أنه متحضر.
العربي الجديد
العام الخانق
مجموعة الجمهورية
قُبيل فجر الحادي والعشرين من آب الماضي بقليل، فيما أغلب سكّان زملكا وعين ترما في الغوطة الشرقية، والمعضميّة في الغوطة الغربيّة، نائمون، انسلّ الغاز القاتل من الصواريخ الغادرة، دون ضجيجٍ أكبر من أصوات الاختناق المكتومة، ليسرق أنفاس أكثر من ١٣٠٠ شهيد، ويترك خلفه حوالي ٣٠٠٠ مصاب، شاهدين على أكبر مجازر النظام الأسدي بحقّ الشعب السوري منذ بداية الثورة. لم تكن مجزرةً عاديّة –هذا إن كان هناك مجازر «عاديّة»– بل كانت، لغدرها، مثالاً على سلوكيات هذا النظام منذ تأسيسه، وخصوصاً منذ اندلاع الثورة السوريّة في آذار ٢٠١١، وكانت أيضاً، لصمت سلاحها القاتل، صورةً لكيف تصرّف العالم أمام ما قبلها من مجازر، وأمام هذه المجزرة بالتحديد، وأمام ما سيتلوها خلال عامٍ هو الأكثر مأساوية في تاريخ سوريا.
ضجّت الأروقة السياسية والإعلامية الدولية في الساعات والأيام التالية للمجزرة، بالتزامن مع اشتداد قصف النظام على مناطق غوطة دمشق المنكوبة، فيما بدا وكأنه محاولة لمسح الأدلة قبل دخول مفتشي الأمم المتحدة، الذين كانوا قد وصلوا إلى دمشق قبل أيامٍ ثلاثة من المجزرة للتحقيق –المشروط والمُقيّد– في استخدام السلاح الكيماوي في ريف حلب. بدا للكثيرين أن العالم لا بدّ سيتحرّك، ولا سيما أن استخدام السلاح الكيماوي كان قد رسمه الرئيس الأميركي باراك أوباما خطاً أحمراً عام ٢٠١٢. دقّت الولايات المتحدة طبول الحرب حينها، وبدا لمتابع نشرات الأخبار أنه يعيش الساعات الأخيرة قبل بدء الغارات الجوّية على مواقع جيش النظام. تزامناً مع دويّ طبول الحرب، انطلقت صيحات «لا للحرب على سوريا» في عشرات التظاهرات والاعتصامات حول العالم، في لغةٍ استفزازيّة وريائية تعامت عن عامين ونصف من المذبحة المستمرّة بحق السوريين، وأتت لتنتفض ضد احتمالات التدخّل العسكري الغربي فقط، وصمتت مع انتهاء احتمالات هذا التدخّل، رغم أن المذبحة استمرت ونمت بشكل صارخ.
انتهت احتمالات أي تحرّك دولي جاد ضد نظام بشار الأسد بعد شهر من المجزرة، حين تم إقرار صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا تقضي بتسليم النظام السوري ترسانته الكيماوية وفق جدول زمني محدد، مقابل تراجع الولايات المتحدة عن توجيه ضربة عقابية للنظام، ونالت الصفقة غطاءً أممياً عبر قرار لمجلس الأمن، المجلس نفسه الذي عاش رقماً غير مسبوق من الاستخدامات المزدوجة، الروسيّة والصينية، لحق النقض ضد أيّ قرار مضادّ لمصالح بشار الأسد في حربه ضد السوريين.
حصل التوافق الدولي حول قرار مجلس الأمن رقم ٢١١٨، وبارك العالم صفقة الكيماوي التعيسة مع إضافة توصيات بعقد مؤتمر دولي للسلام في سوريا، دون جدول زمني محدد لعقده، ولا إلزامات حقيقية له بتحقيق نتائج تقلّل من معاناة السوريين. لقد طرح العالم معادلة مُغرِقة في سرياليّتها: يُسلّم القاتل سلاحه مقابل الصفح عن الجريمة! معادلة غير موجودة في أيّ شرع أو قانون، دولياً كان أم محلياً. هي خلاصة برود أروقة الـ«ريال بوليتيك»، البعيدة كلّ البعد عن الناس، وعن الإنسانيّة.
بطبيعة الحال، لم تحظَ احتمالات الضربة العسكرية الغربية حينها بتوافق عام على مستوى الرأي العام المعارض. لكن، أياً كان الموقف منها، لا شكّ أن التلويح بالضربة العسكرية ثم الامتناع عن إتمامها، ولا سيما بهذا الشكل، كان أسوأ ما فعلته إدارة أوباما طيلة تعاطيها، التعيس بالتعريف، مع المسألة السوريّة. لقد أنهى الصمت العالمي على هذه مجزرة الكيماوي الكلام في فم وأقلام الكثيرين، وأحبط كل التطلّعات لدى الذين كانوا يرون بصيص أمل في أن يتحرّك العالم لنصرة الشعب السوري. لقد كان في رسم الكيماوي وحده خطّاً أحمر استخفافاً كبيراً بدماء السوريين، ففيه ما يشبه الرسالة للنظام بأن استخدام كلّ ما دونه من أسلحة مباح، لكنّ اختفاء الخط الأحمر هذا، أيضاً، أوصل الاختناق لعتبة المستحيل، بل وتخطّاها.
وراء هذه العتبة، نمت «داعش» كسرطان مميت…
تنظيم «الدولة الإسلامية» هو نتيجة عوامل كثيرة. ولد قبل مجزرة الكيماوي بشهور، وبدأ خطره يتنامى في الشهرين الأخيرين قبل المجزرة، لكن التمدّد المريع للتنظيم، وسيطرته وحده على مساحات شاسعة من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، جاء في ظلّ ظروف التحطّم والتعفّن التي ولّدتها حرب النظام والتي ألقت بثقلها على سوريا والسوريين بعد صفقة الكيماوي. العالم الذي بيّن، قبل عام من اليوم، أن لا دم سوريّاً يحرّكه، لا من حيث الكمّ ولا من حيث نوع السلاح المستخدم لسفكه، توافق قبل أيام من أجل إخراج قرار لمجلس الأمن ضد «داعش»، دون أيّ إشارة لإجرام نظام لا يخجل من تقديم أوراق اعتماده كشريك لـ«المجتمع الدولي» في «الحرب على الإرهاب» بعد شهور طويلة من التحالف الموضوعي الفجّ والوقح مع داعش، لدرجة أن أهل الرقة اعتقدوا للوهلة الأولى أن عشرات الغارات التي سكبت الحمم على مدينتهم وريفها في الأيام الماضية كانت أمريكية المصدر وليست أسديّة.
بطبيعة الحال، لا مجال للتقليل من خطورة داعش الكبرى على سوريا والعراق، فالأنباء الواردة يومياً من مناطق سيطرتها أكثر من كافية لتبيان أنها أداة لحرق كلّ أسباب الحياة، لكنّ اختزال المسألة السوريّة خصوصاً، وقضيّة الشرق الأوسط عموماً، في الحرب على إرهاب داعش قد يجرّ ويلات بحجم هذا الخطر أو أكبر. أيّ معنى قيمي يمكن أن تحمله محاربة داعش إن كان بشار الأسد شريكاً محتملاً، موضوعياً كان أم صريحاً؟
لقد عاش السوريون عاماً كارثياً بكل المقاييس، انهار فيه كلّ ما تبقى من القيم والمعاني… عاماً يتحمّل العالم مسؤولية رئيسة وكبرى عن كلّ الجرائم التي ارتُكبت فيه، وعن تنامي نفوذ وخطورة داعش. الحرب على الإرهاب المطروحة الآن، دون موقف صارم وقطعي من نظام بشار الأسد، ودون دعم فعلي، سياسي وعسكري، لقوى الثورة والمعارضة السورية، هي صفقة كيماوي جديدة دون ترسانة ترحّل إلى ما وراء البحار. إنها نذير عام خانق آخر، دون حتى فرصة لالتقاط الأنفاس.
في ذكرى المذبحة… شاب من غوطة دمشق يروي قصة تهريب عينات من «مجزرة الكيميائي» التي ارتكبها النظام السوري إلى تركيا/ نوران النائب
دوما ـ «القدس العربي» «كان شيئا لم يشبه أي شيء آخر، لم يكن هنالك أبشع من روائح الجلد المحروق بعد سقوط القذائف إلا رؤية الناس في عريّها ماثلة أمام عينيه كما يوم الحشر، أشعلت سيجارتي، ووصل بي الحد لأن أشعر بالذنب لأنني لازالت حياً بين كل هذه الجثث الملقاة من النساء والأطفال والرجال»، هذا ما رواه لنا جهاد في ذكرى «مجزرة الكيميائي» التي حصلت في الغوطة الشرقية العام الماضي.
وعلى الرغم من أن جهاد من دوما، استطاع حينها مرافقة فريق طبي بجمع عينات من صاروخ كيميائي وكبد طائر ميت والثياب والجثث، وتهريبها إلى خارج الغوطة بعيدا عن أعين النظام السوري، في رحلة خطرة استغرقت 15 يوما، «لكن تهريب هذه العينات لم تؤت ثمارها حتى اليوم بسبب التخاذل» بحسب أحد أعضاء الفريق الطبي.
بداية القصة
يروي لنا جهاد الناجي من مجزرة الكيميائي في الغوطة القصة لـ»القدس العربي» حينما «كان متواجداً في منزله بدوما عندما بدأت الناس تصرخ مخبرة عن وقوع المجزرة ، ليتوجه مسرعا بصحبة أصدقائه إلى مدينة زملكا بهدف تقديم المساعدة، بعد أن وضعوا كماماتهم على وجوههم».
يقول: «إن أكثر من 90٪ من الحالات التي رأيناها تتوافد إلى النقاط الطبية أصبحت في تعداد القتلى»، مستحضرا أقسى المواقف التي مرت أمام عينيه عندما كان يرى الطفل المستنشق غاز السارين وهو يرجف ويحتضر».
هذا أصعب ما مر به جهاد، «أحسست بروحي تصعد قبل روح الطفل الذي يحتضر، ولم نستطع حينها فعل أي شيء سوى الوقوف مصدومين بداية الأمر وبعد استيعاب الأمر صعدنا إلى المنازل وكسرنا الأبواب لإخراج الضحايا والمغمى عليهم». يصف جهاد المكان بقوله «لم يكن هنالك أبشع من روائح الجلد المحروق بعد سقوط القذائف، إلا رؤية الناس في عريّها ماثلة أمام عينيه كما يوم الحشر»، موضحا «لم نفكر لا بوضع الرجال والنساء داخل بيوتهم ولا ما هو مكشوف أو مغطى، أشعلت سيجارتي ونظرت إلى أصدقائي نظرات مبهمة فلم استوعب أي شيء».
وصل الأمر بجهاد لأنه يشعر بالذنب لأنه مازال حياً بين كل هذه الجثث الملقاة من النساء والأطفال والرجال، فقد شاهد مسبقا مصابين بضربات كيماوية في جوبر وعدرا لكن الذي رآه في «مجزرة الألفي شهيد» لم يره في مكان آخر، متابعا «هذا شيء أكبر من الحقد والكراهية وأعجز عن تسميته».
عيّنات
في اليوم الثاني مباشرة من وقوع للمجزرة، قام جهاد برفقة الطبيب ياسر الشامي وكادره الطبي في الغوطة الشرقية بجمع عينات من صاروخ كيميائي مرمي على رأسه على الأرض، كانوا حذرين عندما سحبوا قطعة منه خشية من سقوطه على الأرض قبل انفجاره، بالإضافة لعينات من كبد طائر ميت، وعينات من الثياب والجثث قاموا بوضعها ضمن «كونيتير» أي جهاز حافظ للبرودة كي لا تفسد، فيما حفظوا العينات ضمن ثلاجة لضمان سلامتها.
وعن المكان الذي تم فيه دفن ضحايا المجزرة في بلدة حزة في الغوطة، يقول جهاد بخجل: «تم دفنهم بطريقة مخزية، حيث رأى يد فتاة خارجة من القبر ولم يتم دفنها جيداً وكذلك رأى قدم رجل آخر»، متابعا «تم رمي الجثث فوق بعضها البعض»، مبرراً ذلك بكثرة عدد الضحايا والجرحى مقارنة بعدد المسعفين والمسؤولين عن الدفن.
جهد كبير بذله جهاد ورفاقه أثناء جمعهم عينات المجزرة الكيميائية قبل دخول فريق المراقبين الدوليين إلى المنطقة للاستقصاء عن الموضوع، وهذا الأمر الذي جعلهم يسارعون لتأمين طريق إلى خارج الغوطة الشرقية لإيصال العينات المذكورة، بعد مرور شهر على المجزرة بسبب انتظارهم لتأمين طريق سفرهم. يوضح أن «كل عينة كانت متواجدة داخل كيس عندما خرجت أنا والطبيب ياسر وكادره من البلاد، بعد أن كلفتنا ما تسمى الهيئة الطبية العسكرية بتمثيلها في الخارج، كما نسق أحد الأطباء المرافقين لنا مع السفارة الفرنسية وجهات أخرى».
وحول طريق الخروج من الغوطة، يروي لنا جهاد أنهم «خرجوا تهريب عبر طريق بعيد عن أعين قوات أمن النظام السورية»، مبينا أن الرحلة كانت شاقة جداً واستغرقت 3 أيام مشياً على الأقدام، لكن ما جعل رحلتهم بالغة الخطورة هو تخوفهم من أن تفسد العينات التي في حوزتهم أثناء الطريق ما لم يصلوا في الوقت المحدد.
نقطة الخروج
من بلدة البحارية كان الموعد المنشود لخروج جهاد والفريق من البلاد، الفريق كان مؤلف من مئة وثلاثين شخصا، أحدهم كانت قدمه مصابة والآخر كان على النقالة، مشوا على أقدامهم 3 أيام، فيما بقيت العينات داخل «الكونتيتر» حافظ البرودة كما وضعوا ثلجا بداخله.
عند الساعات الأولى للرحلة انفجر لغم بأحد الشبان الذين كانوا ضمن القافلة وجلس جهاد ورفاقه على الأرض مدة ساعة كاملة يفكرون بما يجب فعله حيث كانت الرحلة ستلغى، وهنا تبرع أحد الشبان بالعودة بجثة الشاب وهو عسكري منشق عن جيــــش النظام السوري من دير الزور وأكملت القافلة طريقها، وبما يشبه «النمـــل» تابعوا المسير صفاً واحداً وراء بعضهم البعض، كل فرد منهم عينيه مصوبة على قدمي الشخص الذي أمامه، لأنه لو خرج أحدهم مترأ عن الخط من الممكـــن أن ينفجر به لغم كما حدث بداية الطريق.
وكان الأمر الأكثر صعوبة بحسب جهاد، هو الشخص الممدد على النقالة، حيث كان كل من في الرحلة يتناوبون على حمله في البداية لكن المعظم بدأ يتهرب من حمله بعد منتصف الطريق، كما أن الزوادة المخصصة للرحلة «التمر والماء» قاربت على الانتهاء فيما بعد لأن الرحلة استغرقت اكثر مما توقعوا، أي مدة 15 يوماً وكاد الكثير منهم أن يموت عطشاً وجوعاً.
يتابع، كان الطقس حارا جداً و»صار الشاطر يلي بيخبي المي عن رفيقو، برغش ودبابير كأننا في جهنم وليس في طريق»، ويصف جهاد هول الموقف عند وصولهم إلى مكان وقف فيه الدليل على الطريق ليخبرهم بأن هنالك مرحلة تدعى مرحلة الخطر، وبدأ الجميع ينطق بالشهادة استعداداً للموت، حيث كان
على يمينهم نقطة تابعة لقوات النظام وعلى يسارهم مخافر لشرطة النظام، لكنهم تابعوا المشي لمدة خمس ساعات وسط الأهوال والمخاطر.
وصلنا بأمان
وفي هذه المرحلة بحسب جهاد «أصيب بعض الأشخاص بإغماء وبعضهم بكى»، وما لبثت طائرة الهليكوبتر التابعة للنظام تحلق وتغور فوق رؤوسهم لدرجة أن دليل الرحلة الذي يفترض أن يكون معتادا على الطريق أن نطق بالشهادة استعداداً للموت.
وكي لا يراهم الطيار «مكثوا مدة نصف ساعة على الأرض، وبدأ الدليـل يخبرهم أن عليهم أن يخلعوا كل ما يمكن أن يلمع في ثيابهم ويديهم سواء كانت ساعة أو أي شي آخر، وهنا كاد جهاد أن يسقط رعباً، وبدأ يشعر بالندم على قيامه بتلك الرحلة التي كان من الممكن أن يخسر حياته من أجلها، كما كانت خسارتهم للعينات محتملة جداً في هذا الطريق».
وصلوا أخيرا إلى «بئر القصب أو بر الأمان» كما يسميه جهاد ، وتم حمل المصابين وأخذهم إلى الدراجات وهنا افترق أعضاء القافلة، وبقي الطبيب ياسر الشامي وفريقه الطبي لإتمام مهمتهم.
بدوره، قال الطبيب ياسر الشامي إنه: «كان أرسل عينات عن المجزرة قبل خروجه من الغوطة الشرقية إلى المخابرات الفرنسية في العاصمة الأردنية عمان لكن بعض المخابرات الأردنية باعتها للروس مقابل آلاف الدولارات».
وعندما وصل الطبيب ياسر الشامي مع الفريق الطبي إلى معبر باب الهوى شمال سورية، قام بالتواصل مع «إيرك» مسؤول السفارة الفرنسية في تركيا وأخبره بوصولهم فطلب منهم إرسال العينات مع أحد الوافدين الذي خصصه لتلك المهمة، ووطلب منهم أن يعودوا من حيث أتوا، لكنهم رفضوا. وبعد الخلاف الحاصل مع الفرنسيين على معبر باب الهوى وإصرارهم على تسليم العينات وعودة الفريق إلى سورية لجأ الطبيب الشامي لكتيبة أحرار الشام من أجل حمايتهم، وبالفعل قدمـــوا لهم المساعدة للدخول إلى تركيا، حيث تم تسليم العينات للفرنســـيين بعد مفــاوضات.
فرنسا تنكر
يوضح الشامي أن فرنسا الآن تنكر استلامها للعينات، و»لم نستطع بعد كل هذا العناء الحصول على نتائج تحليلها، وإلى الآن وبعد مرور سنة كاملة بقى الموضوع قيد البحث لكن دون فائدة»، مشيراً إلى أنهم برحلتهم تلك قاموا بتوفير آلاف الدولارات على المخابرات الفرنسية لدراسة عينات كيميائية ملتقطة حديثاً ومعرفة مدى خطورتها، فهم لا يأبهوا لما فعله الغاز بآلاف السوريين.
ويشير الشامي إلى أهمية العينات المأخوذة من قبلهم مقارنة مع عينات المراقبين الدوليين الذين قدموا إلى زملكا لفترة وجيزة لا تذكـــر بعد مضـــي شهـــر على المجزرة، إذ أن العينات التي سلموها إلى فرنســـا تم جمعها بعد مرور يوم واحد على الحادثة، وهذا ما لم يستطع القيام به فريق المراقبين بالإضافة لقيام الشامي وفريقه بسحب العينات من كبد طائر ميت وكبد جثة مدفونة بعد الاستئذان من أهلها، وهذا أيضاً لم يستطع المراقبون الحصول عليه في عيناتهم.
1700 ضحية
وكان الائتلاف الوطني المعارض سجل في نهاية سنة 2013 ما يزيد عن 1700 ضحية جراء قصف الغوطة بالكيميائي معظمهـم من النساء والاطفال بالإضافة إلى أكثر من ستة آلاف مصاب.
وفي إحصائية للجان التنسيـق المحلية، أشارت فيها أنّ عـدد الإصابات بتلك المـجزرة قوبل بالزيادة الى 7000 مصاب، في ظل النقص الحاد بالأدوية من الأتروبين وعبوات الأوكسجين ومواد الإسعاف في المشافي الميدانية ضمـن مناطق الـريف الدمشقي.
ومما لا يمكن تجاوزه هو الحصار الخانق من قبل قوات النظام السوري على مداخل الغوطة الشرقية والتي تقوم بتنفيذ عمليات الإعدام الميداني لكل من يحاول إدخال مواد طبية إلى المناطق المحاصرة وهو ما يعني صعوبة شديدة في حصول المصابين على الأدوية ما أدى إلى إبطاء شفائهم وتفاقم حالتهم.
وكانت المنظمة السورية لحقوق الإنسان حذرت من ارتفاع حـصيلة الضحايا لتتجـــــاوز عدد 3000، مشيرة إلى أن الإحصاءات الأولية لمصابين مجـــزرة الكيميائي شملت من تمّ إسعافهم وممن كانوا في الملاجئ ، فيما لم تشمل الأسر والعوائل التي تم اختنـــاقها ضــــمن المنزل ولا زالت أبواب منازلها موصـــدة تــحول بين الوصول إليها.
وبحسب شهود عيان كان النظام السوري قصف حينها المنطقة المستهدفة بالكيميائي بشتى أنواع الصواريخ والقذائف الأخرى ما أرغم الناس على النزول للملاجئ لضمان سلامتهم وهذا الشيء أسهم في ازدياد عدد الضحايا البشرية والمادية على اعتبار أن غاز السارين أثقل من الهواء.
القدس العربي