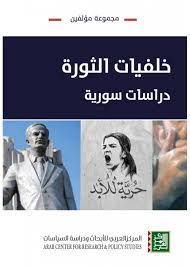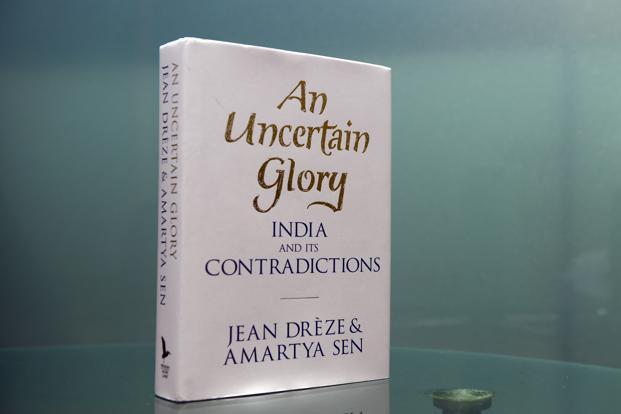كتاب – “الثورة اليتيمة” لزياد ماجد: يُتمٌ بمعنى الغدر/ روجيه عوطة

يسترجع زياد ماجد في كتابه “سوريا، الثورة اليتيمة” (شرق الكتاب-2014)، بأسلوبه الجامع بين السرد والمجادلة، أحداث الثورة السورية، مبيناً مظاهرها على اختلاف حقولها. ويسند فعله هذا بعرض ضمني للخطط، التي اعتمدتها عائلة الأسد لإخضاع السوريين، واعتقالهم في نظام “الأبد”. بهذه الطريقة التوثيقية، شبه الكرونولوجية، يساهم الكتاب في خلق ذاكرة أرشيفية للحراك السوري، الذي واجهته السلطات البعثية بالإجتثاث الواقعي، والإخفاء الإعلامي، محاولةً إصابة المنتفضين بـ”الأمنيزيا”، من أجل إعادتهم إلى طاعتها المبددة في آذار 2011.
يستوي “تمهيد” الكتاب على تركيب جملي، يبدأ بـ”رغم”، لينفي ما يلي هذه العبارة من ظروفٍ قاسية، تواجهها الثورة السورية باستمراريتها. وسرعان ما يبلغ ماجد غايته من هذا التركيب الممهِّد، بالحديث عن يُتمٍ، أصاب الثورة وخائضيها، الذين تُركوا وحدهم في التصدي لنظام المجازر والبراميل. لذا، يستخدم الكاتب وصف “الثورة اليتيمة”، الذي أطلقه فاروق مردم بيك على الثورة في سوريا عام 2012، محاولاً رصد أسباب هذا اليُتم ودوافعه، محاججاً مرسّخيه، ومجذّريه، من مؤيدي الديكتاتور بشار الأسد.
إلا أن اليُتم، الذي يصف الثورة، لا يصيب معناه الأساسي، أي فقدان الإبن أو الإبنة للأب (بحسب إبن السكيت)، بل ينطوي على الغدر أكثر. فمن المستحيل أن تكون الثورة “يتيمة”، إذ لا بنوة تجمعها بأحد، كما لم تُنجب من أب وأم، بل على العكس تماماً. فقد اندلعت في سوريا على إثر تفلت مجموعة من “الأبناء” من قواعد الخوف، التي لطالما أذعن الأهل لها. وهم، بكتابتهم على جدران إحدى المدارس في درعا، واجهوا سلطة بشار الأسد السياسية العامة، والمؤسساتية، الممثلة بالمدرسة، بالإضافة إلى العائلة. ذاك، أنهم تحرروا من أوامر الآباء والأمهات، الذين لو عرفوا أن أولادهم سيخطّون شعارات الثورة، لكانوا تصدّوا لهم، ومنعوهم عن هذا الفعل، “خوفاً” عليهم، وعلى أنفسهم، وربما منهم. تالياً، في تلك اللحظة الغرافيتية، لم يعد طلاب درعا أبناء أحد، بل أصبحوا ثوريين فقط، مثلما سيصير ملايين السوريين في ثورةٍ، لم “تولد من رحمٍ”، على طريقة نزار قباني في إحدى قصائده (ست الدنيا يا بيروت)، بل اندلعت في أغلب الأنحاء السورية، بعدما أتى فاعلوها الأوائل، أي طلاب درعا، من الـ”لا-مكان”، وليس من المكان البعثي، الذي كان النظام قد جمده على طول عقود. فتلك الثورة لم تنطلق أوديبياً بقتل الأب، رغبةً في أمّ، بل أطاحت هذين الطرفين معاً.
في هذا المضمار، تكمن “استثنائية الثورة السورية”، التي يشير ماجد إليها، بحيث أن السوريين يواجهون نظام “الأبد”، المؤسس أولاً على الإستبداد العنيف، الذي يحضر في العلاقات العمودية، بين السلطات والناس، توازياً مع حضوره في الروابط الأفقية بين المكونات المجتمعية، جماعات و”أفراداً”، وثانياً، على احتكار السياسة وزمنها، وثالثاً، على تحويل الإجتماع ومكانه إلى معتقل. استطاع الثوريون في سوريا أن يخترقوا هذا النظام، ويتحدّوا عنفه بالتظاهرة، ومن ثم بالمقاومة المسلحة، ويستولوا على مكانه، ويغيّروه من سجن إلى شارع، ويخلقوا أزمنتهم الخاصة والعامة. تحرروا من المجتمع، الذي أراده النظام مضادا للسياسة، وعبروا بذواتهم إلى اللاسياسة، التي كلما ابتعدت عن عنصري العائلة والمجتمع، أي الأب والأم، وما يلحقها من أوديبية، اقتربت من السياسة أكثر.
هذا على مستوى علاقة الثورة بداخلها، أما في مضمار علاقتها بالخارج، فيحلّ اليُتم، كمقولة تعوق التسييس من ناحيتين متداخلتين، الأولى متعلقة بالنظر إلى الثورة على أنها “إبنة” أطراف دوليين، وهم، في هذا المعنى، “الأب والأم”، اللذان أنجباها. والثانية، التوجه إليهما بطريقة أهلية، يتبعها اللا-إكتراث من قبلهما، لأنهما ليسا والديها في الأساس. نتيجة ذلك، وإن غدرت “المجتمع الدولي” بالثورة، كما هو الواقع في سوريا، يجري التحدث عن تحول الثورة إلى “ثورة يتيمة”. هذا الحديث أهلي، غير سياسي. فتوجه تشكيلات المعارضة إلى العالم بوصفه “أبا” أو “أما”، تالياً، مؤسسة خيرية، هو بمثابة مخاطبة ما قبل سياسية. كما أن توصيف مماطلة هذا العالم، وصمته، بـ”اليُتم”، هو توصيف لا سياسة فيه أيضاً.
فـ”اليُتم” ليس سوى غدر وخيانة، تعرضت الثورة السورية لهما بوضوح، ولا سيما من “حلفائها” في “العالم الميت”، في مقدمهم الإدارة الأميركية، التي سطرت خطاً أحمر حول استعمال الأسد للكيميائي، وحين استخدمه، محت الخط، وبقيت الجثث وحدها في ساحة الجريمة. القاتل ليس معروفا فحسب، بل مسنود أيضاً. أنه يواصل بطشه بدعم النظامين الروسي والإيراني، والميليشيات الطائفية، التابعة للأخير. كما أنه يحاكي، بنظامه المستبد، “بعثية” الأنظمة الدولية، التي تغض النظر والفعل عن ارتكاباته. بالفضل عن نشر مؤيديه المباشرين، والمترددين، والساكتين، لمقولات، يقف الكاتب عليها بالنقد والدحض، من قبيل “حماية” الأسد للـ”أقليات”، بالإضافة إلى “علمانية النظام السوري”، و”محاربته للإمبريالية”، عدا “وحشية الثورة”، و”إسلاميتها”. في هذا السياق، يؤكد ماجد أن النظام “وفق في خطابه وتقديمه لصورته بين ركائز ثلاث: “الممانعة” يكسب فيها قوميين ويساريين ومناهضين للإمبريالية، وعداء للإسلاميين يقرّبه من بعض الدوائر في الغرب ومن العلمانويين عامة، ومظهر حداثي يُبرزه في موقع المتقدّم على محكوميه، ويُرضي به مقلدين سطحيين لما يعدّونه “غرباً” أو مدعي تقدمية في سوريا نفسها”.
مع ذلك، استمرت الثورة المندلعة في وجهه، لأنها جذرية، تحمل طاقة ابداعية قوية، بها تهدم المجتمع، الذي كبت النظام الفاشي مكوناته الجماعاتية تحت إيديولوجيته “العلمانوية والإشتراكية”، مثلما سحق الأفراد طبعاً. في هذا الهدم، يجد الكاتب مكمنا من مكامن خطورة الثورة، “إذ صار فيها اليوم عنف بمقدار ما كانت فيها طاقة على احتمال العنف المسلّط ضدها ونبذه”. وقد يصح استنتاجه عن الخطر هذا لو أنها تواجه طرفاً غير نظام الأسد، الذي حول المجتمع إلى كُل واحد، سجني وتسجيني على السواء، وصار من المستحيل أن يسقط بدون إسقاط معتقله المجتمعي، من خلال تفليت مكبوته الفردي والطوائفي. فالثورة السورية تهدم المجتمع لأنها تُسقط النظام.
في النتيجة، الثورة السورية مغدورة، وليست يتيمة. فبعد ألوف القتلى، وملايين اللاجئين والمحاصرين، لا يحرك العالم ساكناً حيال ما يحصل، وهو بهذا، يقف إلى جانب نظام البراميل المتساقطة على روؤس السوريين. “لا عذر لعالم لا يتدخل ضد “همجية النظام” بحجة تفضيلها على “همجية الجهاديين”، لأنه إذ يتمنع يحصل حينها- كما ينبّه فاروق مردم بك- على الهمجيتين”. لا عذر لهذا العالم، الذي من الممكن الإقتباس من ميشال فوكو، للتوجه إلى أنظمته الدولية: “أرجوكم، لا تتحدثوا لنا أبداً عن أيام ديكتاتور موغل في الحداثة ومآسيه، في بلد موغل في القدم، فالشيء القديم هنا في سوريا هو الأسد: البالغ من العمر نحو الخمسين عاما، المتأخر عن زمنه بمئة عام… لقد أصبح التقليد اليوم هو مشروعه التحديثي، وسلاح الطاغية الذي يحمله، ومنهجه في الفساد، فالقديم الوحيد في سوريا هو النظام”. يسقط غدر العالم للسوريين، لأن ثورتهم ليست إبنته، وهي، لم تتيتم منه، بل هو الذي غدرها، وخان نفسه!
الكتابة الناشطة
لا تكتفي كتابة زياد ماجد بنصها فحسب، بل تتعداه إلى فعلٍ مماثل لها، من ناحية المبدأ والغاية. هذا ما يجعلها كتابة ناشطة، يمارسها الباحث والأستاذ في الجامعة الأميركية بباريس، كأنها امتداد لهمّته، التي يناصر بها إشكالية الإجتماع والسياسة في البلدان المحكومة بالإستبداد والتعصب، على تفرق أشكالهما. من هنا، يبدو ماجد كأنه يكتب في رواقٍ من أروقة الفضاء العام، الذي حتى لو كان غائباً أو مفقوداً في هذا البلد أو ذاك، تنحو الكتابة إلى بنائه، مشرعةً إياه على احتمالات الرأي والموقف المختلفين، بحيث أنها تهندسه أفقياً، وتسعى إلى تمتين أغلب جوانبه، فلا تستطيع السلطة اختراقه بعموديتها القاسية، أو بتشميلها العنيف.
في الكثير من الأحيان، يصمم ماجد نصه بالإستناد إلى ترتيب عددي (أولاً، ثانياً، ثالثاً…)، يحاول، على أساسه، الرد على مقولة معينة، أو البحث في واقعة محددة، من دون أن يصرف المعالجة عن أي حجة من حجج خصومه. كما أنه، بين وقت وآخر، يفترض دليلا أو برهانا، لم تبلغهما فطنة “المقاومين والممانعين”، لكنه يأتي على ذكرهما من حيث الإحتياط، الذي ينجز النقاش، ويثبِّت ديموقراطيته.
هذا ما يسم النص بالهدوء، إذ إن الكاتب لا يضطرب في أي جملة من جمله، ولا يقع في شدة من شداته، فمهما كان الموضوع، الذي يتطرق إليه، عصيا على التحمل، نتيجة كثرة الجثث المدفونة تحته، ووقاحة القاتل الحاضر فوقه. لا ينقبض ماجد بكتابته، أو يتكدر. على العكس، يواصل كتابته بتسكين انفعاله، فتسيل حدّته في الموقف، الذي يخشاه الخصم، ويهابه أكثر من حذره حيال الرأي المغتاظ أو الناقم.
بهذه الطريقة، يكتب زياد ماجد ممارساً “يساريته الأفقية”، التي لا تتعقد حين تواجه استفهاماً عسيراً، أو عندما تنقل من واقع إلى آخر. هي وليدة تجارب سياسية عدة، من التأسيس الحزبي في لبنان، والمشاركة في تظاهرة 14 آذار، إلى معارضة النظام الأسدي في سوريا، فضلاً عن تميز هذه اليسارية بنظرتين عربية وفرنسية، يجمعهما مسلك الحرية، الذي يتخطى كل حد، تضعه الديكتاتوريات لتعتقل محكوميها، وتعزلهم عن عالمهم. في هذا المطاف، لا تنفصل كتابة زياد ماجد عن هذا المسلك، إذ يحملها من النص إلى الفعل، فيستكمل الكاتب موقفه بنشاط، يكاد يكون ميدانياً، بالإضافة إلى كونه معطوفاً على نقد مستمر، تنتجه علاقة “غرامشية”، يشير إليها ماجد على مدونته الإلكترونية، بين “التشاؤم في الفكر” و”التفاؤل في الإرادة”، وما يلحقهما من كتابة ناشطة، تؤيد التغيير، وتدافع عن المطالبين به، كما تدين الإبادة المرتكبة في حقهم.
إلى مقالاته المنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية، وإلى حراكه الشارعي، يستخدم ماجد الشبكة الإفتراضية، حيث ينشط في فضاءات التواصل، متابعاً وملاحظاً. فقد كتب مرةً عن “الفايسبوك”، وزر الإعجاب، مسمّياً إياه “لايك الحرية”، الذي صار، مع اندلاع الثورة السورية، إلتزاماً سياسياً حرية المنتفضين، وصمودهم في وجه نظام الحجز والقتل. هكذا، في النص، والواقع، والإفتراض، يشيد ماجد رواقه، كي تكون كتابته على وجه من وجوه النشاط والجدوى، ولا سيما في “عُجالاتها”، فتواصل إطاحة خطاب “المقاومة والممانعة”، الذي يدرك زياد ماجد مدى بطشه وعنفه جيداً، ذاك، أنه قتل واعتقل وهجر الكثير من أصدقائه ورفاقه بين لبنان وسوريا.
النهار