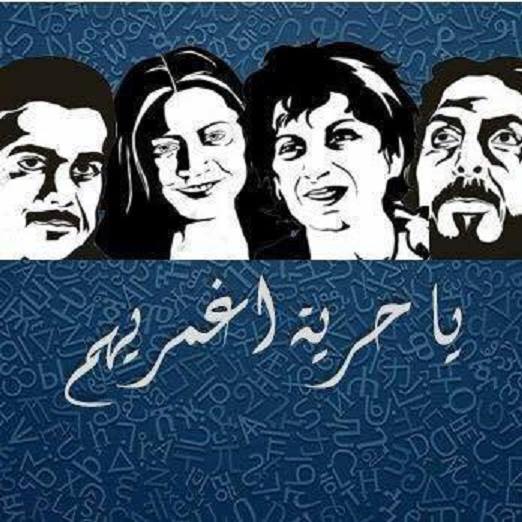ما لا يمكن تحصيله أكثر بكثير!/ علا شيب الدين

ليس الإصرار على الحياة أقل غموضاً من الميتافيزيقا
هذا بعض ما يمكن أن يحصّله العقل، وهو يتأمل بعض ما يجري في سوريا باندهاش، أصله ذاك الإصرار المهمّ على الحياة، الذي تجلى في أوضح صوره بعدما فرض النظام الأسدي المحتل حصاراً خانقاً على مناطق في حمص مثلاً، أو ريف دمشق وغيرها من المناطق الثائرة عليه، إذ منع عن الناس كل أسباب الحياة من غذاء وماء ودواء وكل شيء!
لا تزال المنظمات الدولية الإنسانية، حتى لحظة كتابة السطور، تشكو عدم استطاعتها الوصول إلى المناطق المحاصَرة، في ظلّ منْع الجيش النظامي فرق الإغاثة من الوصول إلى المحاصَرين، بينما يدخل مفتشو الأسلحة الكيميائية الدوليون إلى المناطق السورية كافة بما فيها المحاصَرة، ويخرجون بسهولة. لقد طال أمد الحصار، حتى أن البعض مات جوعاً في بلدة المعضمية مثلاً، وباتت المجاعة تهدد الناس. في ضوء ذلك، بادرت مجموعة من العلماء المسلمين السوريين يوم 15 تشرين الأول 2013، إلى إصدار فتوى تجيز أكل القطط والكلاب والحمير درءاً للمجاعة في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، وأحيائها وبلداتها الجنوبية.
نعتقد أن فتوى من هذا الطراز، ربما تكشف ليس فقط عن رغبة عميقة في الحياة وإصرار عليها، بل عن حبّ جمّ للإنسان في حدّ ذاته ولذاته، وتقدير له كقيمة عليا، لا ضير في التنازل عن بعض المعتاد والراسخ لأجله، والتعاطي تالياً، مع المعتقد الديني السائد بمرونة وحيوية إكراماً لوجوده. فمن المعلوم أن المخلوقات والكائنات والأشياء، والأطعمة والأشربة المستخلَصة منها، صُنِّفت في الإسلام بين طاهر ونجس. الكلاب والقطط مثلاً، من الحيوانات ذات المخلب أو الظفر أو الناب، وهذه نجسة لا يؤكل لحمها (“وَعَلى الذين هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ…” سورة الأنعام/ 146).
في كتيّبه “إيديولوجيا الجسد/ رموزية الطهارة والنجاسة”، دار الساقي)، يطرح فؤاد إسحق الخوري الأسئلة الآتية: لماذا يُحرَّم أكل كلّ ذي ناب أو مخلب أو ظفر؟ ماذا في الناب أو المخلب أو الظفر كي يُحرَّم؟ ولماذا تحلُّ الأنعام المجترّة المشقوقة الظلف؟ في متن محاولة الإجابة يقول: “استحوذ الكلب والخنزير على اهتمام الفقهاء، أكثر من الحيوانات الأخرى. ولعل الاهتمام بنجاسة الكلب يعود إلى ملازمته الإنسان منذ زمن طويل؛ فهو من أوائل الحيوانات التي دُجِّنت. يضاف إلى ذلك ميل كثير من البشر إلى تربية الكلاب المعروفة بأمانتها وودّها وولائها. فهي مضرب مثل في الأمانة”، ثم يستطرد: “الكلب له وظائف كثيرة في حياة الإنسان: يصيد، يحرس البيت، يساعد على الرعي، يستكشف الجرائم، يخفف من ألم الوحدة، ويُعتبر رفيقاً للأولاد” (صفحة 46 – 47).
إذا كان تحريم أكل لحم الكلب واعتبار هذا الحيوان نجساً في الإسلام، بغاية تدجينه والإفادة منه عبر توظيفه في الصيد والحراسة وكشف الجرائم وغير ذلك، فلهذا التحريم كما نعتقد، دلالات “براغماتية”، تشير إلى ذهنية نفعية عملية، من شأنها تصنيف الكلب في باب النجس حتى لا يُقدِم الناس على أكله، تالياً تضيع فرص الإفادة منه في جوانب معيشية أخرى غير الطعام. ينطبق هذا على حيوانات أخرى ربما، كالحمير. فمعلوم كم أفاد الإنسان من الحمار عبر تسخيره في حمْل الأثقال مثلاً، وعلى هذا، يمكن فهم أحد أسباب منع أكل لحمه في الإسلام، أو قبوله على مضض. هكذا، وبـ”المنطق البراغماتي” ذاته، ربما يمكننا تفسير الفتوى التي أجازت أكل لحوم الكلاب والقطط والحمير، ولو أن الخنازير موجودة في غوطتي دمشق لربما أجيز أكل لحمها أيضاً. فما دامت الوظائف المفيدة للإنسان التي يمكن أن تقوم بها الحيوانات المذكورة المدجّنة قد باتت، بعد حصار خانق يهدد بالموت جوعاً، هامشية وغير ضرورية قياساً إلى أولوية الإفادة من لحومها درءاً للمجاعة، ومحافظةً على حياة الإنسان في المناطق المحاصَرة ودفاعاً عن بقائه، فلا شيء يمنع من تغيير المعتقد في شأنها، والانتقال من طور تحريم أكل لحومها إلى طور إحلاله، أو من مرحلةٍ لطالما اعتُبر فيها هذا الحيوان أو ذاك رجساً ونجساً إلى مرحلة يلائمها في معنى ما، براغماتي، اللااعتقاد، أو اللاإيديولوجيا واللاحكم واللاتصنيف في ما يخص الأطعمة مثلاً. إن السماح بأكل لحوم حيوانات مصنَّفة في باب النجس، قد يساهم في معنى ما، في التدليل العملي على أن الإسلام بالفعل هو دين يُسْر (“يريد الله بكم اليُسر ولا يريد بكم العُسر…” سورة البقرة/185).
في أثناء السعي وراء مصير ملحمي في حرب استقلال، نبع المرسوم الديني، أو الفتوى المذكورة، من واقع مرير، من محنة. فـ”بومة مينيرفا لا تبدأ في الطيران إلا بعد أن يرخي الليل سدوله” على تعبير هيغل في كتابه “أصول فلسفة الحق”. بومة مينيرفا (الحكمة) على ما يبدو، لا تظهر إلا في أحلك الأوقات، والاجتهاد العقلي لا يبدأ ربما إلا بعد “استواء الواقع” تماماً إن جاز التعبير، أو بعد تبلوره. هكذا، قد تفتح فتوى من مثل تلك التي أجازت أكل ما كان يُصنَّف نجساً، وغيرها مما قد يكون مشابهاً لها في جرأته، باب التجديد الذي من شأنه ألا يشعر الناس في ظلّه بشلل وجودي، وألا يخشوا التجريب ونبش القديم وإعادة النظر في التقليد وقراءته على ضوء الراهن، ما يسمح ربما بفتح باب آخر لا يقل أهمية، أي باب التفكير النقدي الحر، والتبصّر الذهني في المعتاد والمألوف انطلاقاً من الواقعي اليومي بوصفه وحدة مضطربة، قوامها أجزاء مضطربة أيضاً، وطرح رؤى جديدة للعيش تنطلق من صميم المتاهة التي هي الحياة. هكذا تبدأ ربما العلاقة النقدية مع الدين، علاقة نابعة من تجربة ذاتية حية، تتصل بخصوصية المنطقة والثقافة والروح والحضارة التي ينتمي إليها الناس الذين قد يفيدون من تجارب الآخرين، إلا أن التعلّم الحقيقي لا ينبع إلا من تجاربهم فقط ومن أخطائهم وعثراتهم فحسب. بهذا يمكن الردّ على أولئك الذين ما انفكّوا يقللون شأن الثورة السورية وغيرها من ثورات “الربيع العربي”، وينظرون إلى ثورات شعوبنا في ترفّع عبر مقارنتها بالثورة الفرنسية مثلاً واعتبار هذه “حدثاً تاريخياً”، كونها قطعت مع الماضي، بينما “الربيع العربي” مجرد أصوليات دينية لا تقطع مع الماضي، بل غير قادرة على ذلك، وهو تالياً ليس حدثاً تاريخياً، وإن كان يريد أن يكون كذلك، فعليه الاقتداء بالثورة الفرنسية، محاولين بذلك نقل تجربة إنسانية تنتمي إلى مكان وزمان معينين، و”تطبيقها” على زمان ومكان آخرين مختلفين، جاهلين بلا عقلانية هذا الإجراء ولا واقعيته، بل تهافته، مع أنهم ينسبون إلى أنفسهم التعقل والعقلانية!
2
ليس موت الإنسان تحت التعذيب أقل فظاعة من أكله وهو ميت
هذا أيضاً بعض ما يمكن أن يحصّله العقل، وهو يتأمل ما يجري في سوريا باندهاش.
ظهر أبو صقر، الذي يتحدّر من حي بابا عمرو بمدينة حمص، وكان قبل اندلاع الثورة عاملاً في ذلك الحي، في مقطع فيديو في حزيران 2011، وهو يشارك في تظاهرة ملوّحاً مع الآخرين بأغصان الزيتون تحيةً لمنشقّين عن جيش الأسد. في فيديو آخر أثار ضجّة إعلامية في أيار2013، ظهر وهو يأكل ربما قلب جندي ميت من جنود الأسد. كان أبو صقر قد انضمّ إلى “الجيش السوري الحر” في شباط 2012، قبل ذلك قُتل شقيقه عندما ذهب لمساعدة امرأة وطفل قُتِلا أمامه، كما روى للـ” بي بي سي”، وبمرور الأيام فقدَ شقيقاً ثانياً له. ظهر أبو صقر مرةً ثالثة في فيديو وهو يعلن عبر بيان، استعداده للمحاكمة على ما فعله بالجندي الأسدي، إلا أن ذلك لن يحدث، حسبما قال في بيانه، إلا إذا مثل بشار الأسد للمحاكمة أيضاً.
إذا افترضنا صحة كل ما ورد آنفاً، فإن الفيديوات الثلاثة ربما تكثّف الصيرورة التي أوصلت الشاب ابن السابعة والعشرين عاماً إلى ما وصل إليه. وإذا حاولنا التعاطي مع مسألة أكل جثة العدوّ الميت هنا، أو أجزاء منها، من منظور سيكولوجي، لربما رأينا في هذا السلوك تماهياً في المعتدي، أو محاكاة فيزيقية بحتة لشخص المعتدي، بدءاً بمحاكاة المعتدي المباشر القريب (الجندي الأسدي الميت)، مروراً بأزلام المعتدي الأكبر وأدواته الأشدّ قسوة وتطرفاً في تعاملهم مع الإنسان السوري الضحية (الشبّيحة والمرتزقة القادمين من خارج الحدود)، وصولاً إلى المعتدي الأكبر نفسه (الأسد ونظامه). بتعبير سيكولوجيّ أكثر اختصاصاً ربما، نرى في هذا السلوك تطبيقاً لعملية نفسية لا واعية إجمالاً، هي “الاجتياف” حيث تمّ بواسطته تمثل الشاب الذي يعتبر نفسه ضحية، خصائص المعتدي أو المتسلط لكي يجعلها جزءاً من ذاته. على غرار إدماج الطعام جسدياً، اجتافَ ذاك الشاب (أي أدخل في جوفه) المتسلط أو المعتدي، ليس رمزياً فحسب، بل فيزيقياً أيضاً عبر إقدامه على فعل أكله، أو محاولته فعل ذلك. فهو (أي الجندي الأسدي – المتسلط أو المعتدي) كما قال الشاب: “كان يحمل هاتفاً نقّالاً وعليه مقاطع فيديو تظهره وهو يغتصب أمّاً وابنتيها. كان يجرّدهنّ من ملابسهنّ وهنّ يتوسلن له بالله، وفي نهاية المطاف ذبحهنّ بسكّين”. “ضع نفسك مكاني، وهم يأخذون والديك ويشتمونهما، يذبحون أشقاءك ويقتلون عمّك وخالتك… لقد حدث معي هذا كله، وقد ذبحوا جيراني أيضاً”. “ماذا كنتَ لتفعل؟” سؤال يوجهه إلى الصحافي الذي كان يجري معه مقابلة بعدما طلب منه أن يضع نفسه مكانه. يضيف: “لقد دُمّرت القصير، ودُمّر حي بابا عمرو، ودُمّرت حمص بالكامل، ولا يبالي أحد لذلك. أنظر كيف يعيش اللاجئون الآن”.
إن التماهي بالمعتدي أو المتسلط هنا، وتمثّل عدوانيته وسلوكه واستعارة صفاته، من شأنه التخفّف ربما من انعدام الشعور بالأمن، من خلال السعي إلى إزالة الحيف الذي لحق بأبي صقر وبأمثاله من الذين تعرّضوا للظلم والاضطهاد، ومن خلال التشفّي من ناحية، والتنكّر للمخاوف الذاتية من ناحية أخرى. يدلل على ذلك ربما قوله في المقابلة ذاتها: “كان علينا أن نخيف الأعداء، وأن نهينهم، فقط كما يفعلون بنا، والآن لن يجرؤ أحد منهم على الانوجاد في أي مكان يكون فيه أبو صقر”.
أمسى أبو صقر يُلقّب بـ”آكل لحوم البشر”. قد يرى البعض في أمثال أبي صقر مجرمين، يشكلون آفة اجتماعية يجب أن تُجتثّ. ذلك صحيح من الناحية الظاهرية، لكن يبقى أن الإجرام الحقيقي الذي يفتك بالمجتمع السوري هو الإجرام الأسدي وحلفاؤه أجمعون. مخرِّبو الإنسانية أولئك، لا بدّ من مواصلة الثورة والكفاح في أشكاله كافة من أجل اجتثاثهم. بعد ذلك قد يحلّ المناخ الذي يسمح بالعمل الحقيقي على تغيير البنية العلائقية للتسلط في سوريا، وتغيير الأدوار جذرياً لا الأشخاص فحسب.
ليس الفارق كبيراً إذا ما قُتِل المرء، أأكله عدوّه أم تركه، فالأسوأ من أكله بعد موته، هو موته. البشرية لم تشهد ربما ما هو أكثر بشاعة من تعذيب الإنسان حتى يسلّم الروح، بحجة الكفر بالآلهة الأسدية، وبتهمة المطالبة بالحرية والكرامة السورية، كالذي يحصل في أقبية مخابرات الأسد! أو أشد فظاعة من حصار كالذي يفرضه هذا الأخير ونظامه على بعض المناطق الثائرة وحرمان أهلها من النساء والأطفال والمسنّين والشباب من الطعام وغيره! حتى أنه من المعيب وصف هذا النظام بـ”الهمجيّ”، خصوصاً إذا عرفنا في “قصة الحضارة” نفسها (ج1، ص41) أنه “كان مألوفاً عند “الهمج” أن مَن يملك طعاماً يقتسمه مع مَن لا يملك منه شيئاً؛ فلما قصّ تيرنر على رجل من “ساموا” قصة فقير في لندن، سأله “الهمجي” في دهشة: وكيف هذا؟! أليس هناك طعام؟! أليس له أصدقاء؟! أليس في المكان بيت للسكنى؟! أين إذن نشأ هذا الفقير؟! أليس لأصدقائه منازل؟!”.
* كاتبة سورية
النهار