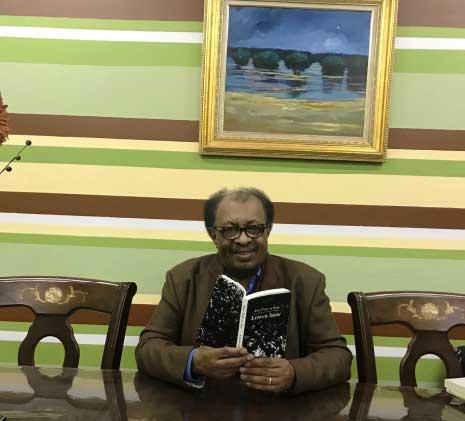نائب مدير معهد الاتحاد الأوروبي للبحوث الأمنية فلورنس غوب: يجب إشراك المسلحين بالمفاوضات السورية

حاورها في باريس: محمد المزديوي
اعتبرت نائب مدير معهد الاتحاد الأوروبي للبحوث الأمنية، فلورنس غوب، في مقابلة مع “العربي الجديد”، أن وهم النصر بالحرب يستبد بالزعامة السياسية الموجودة حالياً في سورية، ولهذا لا ترغب بتقديم تنازلات لأي كان، مشيرة إلى أن جيش النظام السوري انخرط في معارك عنيفة جداً ضد الشعب السوري، ولهذا لا يُنظَر إليه باعتباره محايداً، محذرة من أن التنظيمات السورية، ليس فقط “الجهادية” منها، بل والوطنية أيضاً، ستتبنى استراتيجية حرب العصابات، لعدم إراحة قوات النظام. وأكدت أن دور السعودية هدّام في اليمن، مشككة بجدية الرياض حالياً في الوصول إلى حلّ سياسي ثم أمني، ومعبرة عن مخاوفها من نشوب صراع عسكري بين السعودية وإيران، لن يكون بالضرورة كبيراً.
* بعد الهزائم الكبرى التي تعرّض لها تنظيم “داعش” في سورية والعراق، ما الذي ينتظر فرض الأمن في سورية؟
“داعش” والمنظمات الإرهابية الأخرى ستتأقلم مع السياق الاستراتيجي، لأن وضعيتها الحالية كلاسيكية، أي شبه عسكرية، فهي تتقدم على مستوى الأراضي التي تكتسحها وتحاول قضم أراضٍ جديدة، والاحتفاظ بها. ولكن في المرحلة اللاحقة ستتحول إلى استراتيجية حرب عصابات نوعاً ما، عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية، ومحاولة ضرب الدولة السورية، مع إدراكها أنه ليس لديها القدرة على إسقاطها، ولكن يستطيعون أذيتها. ستواصل هذه المنظمات طرح مشكلة أمنية، لكن ليس مثلما هي الحال عليها الآن، أي أن الدولة السورية، على الأرجح، ستستعيد السيطرة على كامل الأراضي السورية، لكن من دون القدرة على منع تمرد. يمكن أن يتخذ الأمر شكل النموذج العراقي بعد العام 2003، وربما ما حدث في اليمن. شيء من هذا القبيل. هذا عن السياق الاستراتيجي الحالي، ولكن الجيش السوري يخرج من حرب شديدة العنف، وأيضاً كل المؤسسات الأمنية في سورية، وبالتالي فإن معنوياتهم ليست جيدة، وثمة نقص كبير في الأموال لصيانة الأسلحة. كما أن الحرب تسببت بمقتل أعداد كبيرة من أفراد الجيش والشرطة السوريين، وبالتالي فهم بحاجة إلى نوع من الراحة، لكنهم لن يستمتعوا بها لأن التنظيمات السورية، ليست فقط الجهادية، بل والوطنية، ستتبنى نفس الاستراتيجية في حرب العصابات. وأنا لا أتصور أن تكون سورية في حالة من الهدوء قبل عدة سنوات، لأن الصراع سيعرف تحولات، لن يكون مثلما هو الحال اليوم، أي حرب أراض ومناطق، بل صراع بين كتلتين متواجهتين، كتلة متعبة جداً وأخرى تتأقلم مع سياق استراتيجي، أي أن بُعداً أمنياً آخرَ محكوم عليه بأن يدوم.
*ماذا عن المفاوضات بين النظام والمعارضة؟ هل تفيد في شيء؟
لا أقول إنها لا تفيد في شيء. هي جزء من صراع، وكل صراع له فترة حياة. أي أنه توجد ساعة داخلية، كما يقال في دراسة الصراعات. على أي حال، المفاوضات تساعد في وضع حدود ما. من الجيّد حصول توافق بين المعارضة السياسية ودمشق، ولكن هذا لا يعني أن من يتواجدون على الأرض متفقون مع ما يتقرر في المفاوضات. وفي تاريخ البشرية أمثلة عديدة عن وجود فارق بين المستوى السياسي والمستوى الأمني. مثلاً في الجزائر، في ستينيات القرن الماضي، وفي لبنان الذي شهد محاولات كثيرة للسلام، كانت المليشيات هي التي تعارض. الأمر ليس حصراً على العالم العربي، ونحن نراه في كل مكان. وحين لا تكون للزعامة السياسية سيطرة على الأرض، ولا على المجموعات المسلحة، يمكن أن تتفاوض كما تشاء، لكنها لا تغيّر الوضع على الأرض. إذن يجب إشراك المجموعات المسلحة في المفاوضات، من أجل ضمان دعمها، على المستوى السياسي، وهذا ما لا نراه اليوم في سورية. ولكن كما يحدث في السياسة، دائماً، يجب أن تتأزم الأمور أكثر حتى تلوح بارقة أمل. أي بعد توقيع اتفاقات لا تأثير لها على الأرض، يكتشف المتفاوضون ضرورة انخراط المجموعات المسلحة في مسار السلام.
* لدينا انطباع بأن القوى الإقليمية وغيرها التي جاءت الى المنطقة باسم مكافحة “داعش”، لا تكترث لتوفير الأمن للشعب السوري.
أنا أعمل على موضوع الأمن. والأمن لا تستطيع هذه القوى أن تتفهمه. وقد بدأ الأمر في ليبيا بعد 2011، إذ كان هناك مقررون سياسيون في ليبيا وأوروبا، وكانوا يقولون سنقوم بإدماج المليشيات في الجيش الليبي، إلا أن المليشيات رفضت الاندماج في الجيش كما رفض الجيش استقبال المليشيات. إن من يعمل في القطاع الأمني على وعي بهذه الأمور، وصحيح أن المدنيين، بشكل عام، لا يفهمون ديناميات الأمن. أما في سورية، فإن ما يستدعي انتباهي هو أنه لا يجري الحديث، إلا قليلاً، عن مرحلة ما بعد وقف المعارك وماذا سيجري، لاحقاً، في الشق الأمني. لأنه إذا نظرنا إلى النموذج الليبي، فإن الشق الأمني هو الذي طرح مشكلة. فأثناء الحرب في 2011، ومع إرساء المجلس الانتقالي الليبي ومقترحاته حول الإعلان الدستوري، لاحظنا غياباً شبه كامل للمسألة الأمنية. وفي سورية يوجد نوع من الإنهاك الكبير، إلى درجة أن مقررين في أوروبا وأميركا يريدون الانتهاء من الأزمة، بشتى الوسائل، من دون طرح أسئلة الأمن على المدى الطويل. ولكني، كباحثة، أنظر إلى الأمر باعتباره مشكلة حقيقية، لأنه لا اقتصاد من دون أمن، ولا سلام من دون اقتصاد، والسياسة توجد بين هذه العناصر الثلاثة، ولكن لا يمكن أن نناقش مصير سورية بعد انتهاء الصراع من دون الأمن. أرى أن الجيش والمؤسسات السورية غير قادرين على توفير الأمن لوحدهما. ولا أعتقد أيضاً أن إيران وروسيا لديهما رغبة بالبقاء في سورية طويلاً، لأن الأمر مكلف لهما. كما أن الشعب السوري لا يريد بقاء قوات خارجية على أراضيه، ليس فقط قوات غربية وإنما أيضاً القوات الروسية والإيرانية. وقد نشرتُ أخيراً مقالاً حول صعوبة تخيل إصلاح الأمن في سورية بعد توقف المعارك، لأننا لا نعرف الظروف الدقيقة حينئذ، ولكن يجب التفكير في الأمر، وإلا فإن الأمر سيكون عبارة عن هدنة تتبعها مفاوضات ثم سرعان ما يتم خرقها من قبل المتحاربين، لأنه من دون تصور إصلاح للأمن، سننتقل في سورية من المرحلة الأولى للحرب إلى مرحلة ثانية، وهذا ما يخيفني.
* البعض يرى أن الجيش السوري يمكنه أن يلعب دوراً مهماً في مرحلة بناء السلام، على غرار الجيش اللبناني. هل تتفقين؟
نعم، ولا. لأن الجيش اللبناني لم يلعب دوراً في المعارك أثناء الحرب الأهلية في لبنان. كان حاضراً هنا وهناك، ولكن ليس الجيش اللبناني هو الذي تحرّك باسم الحكومة اللبنانية وارتكب مجازر ضد المواطنين. لقد خرج هذا الجيش، من الناحية المؤسساتية مُفرغاً ومُنهَكاً، ولكن نظيفاً من الناحية السياسية، خصوصاً إذا ما قورن بالجيوش الأخرى. وقد اعتمد على تمثيله لمختلف الطوائف اللبنانية كرمز للبنان ما بعد الطائف. أما الجيش السوري فقد انخرط في معارك عنيفة جداً ضد الشعب السوري، ولهذا فلا يُنظَر إليه باعتباره محايداً. ولكن ما يمكن أن نفكر فيه أو ما نتخيله، وقد كتبته في المقال، هو إنه إذا وُجِدَت إرادة سياسية لبدء إصلاح حقيقي وإدماج بعض المليشيات، والتقدم في منطق لا غالب ولا مغلوب، وهذا ما كان واضحاً جدّا في لبنان، سيكون من الأفضل أن يتم الأمر، في سورية بنفس الطريقة، وهذا ما سيتيح مصالحة، وحينها، يمكن أن نستخدم الجيش السوري باعتباره عاملاً مُوحِّداً. وهنا يمكن تسريح الجنرالات وكبار الضبّاط وإحالتهم على التقاعد، ويمكن للمعارضة أن تطالب بفتح محاكمات، ولكن يمكن التوصل إلى اتفاق، ويتم خلط جديد لكل الوحدات وإدماج بعض المليشيات، ونبدأ مسار تجنيد للشباب. هذا ما يمكن تخيله، ولكن من أجل حصول هذا الأمر فإنه يجب أن يكون هناك زعامة سياسية سورية ترغب بتحقيق هذا الأمر. ولكنْ لدي انطباع أن دمشق، في هذه الفترة، يستبدّ بها وهم أنها انتصرت في الحرب، ولهذا فربما ليست لديها رغبة في تقديم تنازلات تجاه أي كان. ولكن الجيش السوري في هذه الحالة لن يُنظَر إليه باعتباره موحّداً وجامعاً بل كعنصر يساهم في فرض الاستقطاب بشكل أكبر. وهذا مؤسف، لأننا حين نفكر في الجيش العراقي، الذي عاش لحظات مأساوية كما الجيش اللبناني، فإن العراقيين يحبونه على الرغم مما حدث في مدينة الموصل. يوجد رأسمال سياسي يمكن الارتكاز إليه في البناء، ولكن يجب تجنب وضعية يصبح فيها الجيش قاتلاً للشعب، لأن كثيراً من السوريين عايشوا الجيش باعتباره قاتلاً. الطاقات موجودة، ولكن من أجل استخدامها يجب توفر إرادة سياسية، لا أراها في الوقت الراهن في دمشق.
* ماذا عن المثال اليمني، حيث انشطر الجيش الوطني، هل سيكون من السهل إعادة تجميعه في مسار السلام؟
الأمر ممكن، ولكن يجب، أيضاً، توفر إرادة سياسية. وحين ننظر إلى ما أنجز في لبنان، حيث انسحب اللواء السادس، وهو شيعي، ككتلة واحدة، سنة 1984. وما أنجز فيما بعد هو الخلط بين جميع الوحدات، بحيث نجد أفراداً من كل الطوائف في كل الوحدات. هذا يمكن أن يحدث. وفي اليمن، انقسم الجيش، فمن جهة يوجد الحوثيون، ومن الطرف الآخر يوجد من يساند الجنرال علي محسن الأحمر ومن يناصر الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح. ولم يحصل بين العامين 2011 و2014 إصلاح للجيش اليمني من زاوية مهنية. كان هناك لجنتان لدراسة الموضوع في اليمن، إحداهما كان يفترض أن تهتم بكل ما هو مهني، مثل كيف سيكون التجنيد والترقيات وغيرها من الأشياء المهنية، لكن اللجنة الثانية غلب عليها طابع التسييس، وكان الإصلاح، في نظرها يعني إبعاد كل من ساند صالح والأحمر. ويمكن للجيش أن يستعيد تلاحمه إذا أبعد عن السياسة واهتم بالشق الأمني فقط. هناك قواعد من أجل هذا، ولكن الأمر يحتاج إلى دعم، خصوصاً من الخليج. لكني لست متأكدة من أن الرياض فهمت شيئاً حين تصرّ على أنه يجب عزل كل أصدقاء صالح من أجل إحداث تغيير في الجيش، لأن هذا رد فعل سياسي. يجب النظر إلى الجيش باعتباره، قبل كل شيء، مؤسسة لها هدف محدَّد وليس وسيلة سياسية. هذه ظاهرة نراها في كل مكان، وليس فقط في المنطقة العربية، وهو أمر يضر بالجيش. يجب العودة إلى المنطق: فهو كيانٌ يُنتج الأمن.
*هل ستؤثر المستجدات السعودية المتلاحقة على الوضع الأمني في اليمن؟
السعودية حالياً في وضعية بالغة الأهمية، من الناحية السياسية، إذ إن ولي العهد، محمد بن سلمان، يحاول بسط سلطته أو تعزيزها. ولكني رأيت الأمر باعتباره معادياً للحرس الوطني، الذي كان دائماً في نوع من التنافس مع الجيش الوطني السعودي. والأمر مهمّ، لأن الكثيرين اعتبروا الجيش السعودي وكأنه مؤسسة لا وجود لها، يبتلع أموالاً من دون أن ينتج شيئا. ومن الممكن أن تساهم حركات محمد بن سلمان الأخيرة في تعزيز الجيش السعودي، في السعودية. ولكن بما يخص اليمن لا أرى أن الجيش السعودي يلعب دوراً بنّاءً. ومثلما هي حالة الجيش الإيراني في سورية، فهو أيضاً منهك ويأمل بنهاية الصراع. ولكني لا أرى إرادة في الوصول لاتفاق يمكن أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد. يمكن أن يتوقف إطلاق النار خلال شهور ثم يعاود الصراع. من أجل سلام مستدام يجب العثور على حل حقيقي للصراع.
إن الأمر يتعلق بأرضية جديدة للسعودية التي لم تتعود التفاوض حول إجماع بين جميع الأطراف، لا هي ولا الإمارات، وهو ما تتقنه قطر. إنّ دور السعودية هدّام في اليمن، وأشك في جديتهم حالياً بالوصول إلى حلّ سياسي ثم أمني. لديّ مخاوف من نشوب صراع عسكري بين السعودية وإيران، لن يكون بالضرورة كبيراً، وقد يحدث في جزر الإمارات الثلاث، لكنه يمكن أن يزعزع المنطقة، خصوصاً في لبنان. كما لا يمكن تخيل الدور الذي يمكن لإسرائيل أن تلعبه، خصوصاً أنها لا تخفي نواياها بضرب “حزب الله”، وبالتالي يمكن أن يترافق الصراع بين السعودية وإيران مع هجوم إسرائيلي على لبنان. كما أن القوة الجوية السعودية، التي كانت قبل الحرب في اليمن شبه منعدمة، اكتسبت خبرات في حربها ضد صالح والحوثيين، أثناء قصفها لكلّ ما يتحرك في هذا البلد. هذا الإحساس الجديد بالقوة، لدى السعودية، والذي لم يكن موجوداً قبل ست سنوات، ينذر بدخولها في حرب ضد إيران و”حزب الله”، إذ إن لدى السعودية، الآن، القدرة والإرادة، وهما شرطان ضروريان، في الصدام مع إيران، وهو ما يبعث على القلق.
* ماذا عن ليبيا، والاتفاق الذي فرضه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على طرفي الصراع الرئيسيين؟
مشكلة ليبيا هي نفسها في سورية. ثمة محاولات للعثور على حلّ سياسي، وهو شيء جيد. ولكن من يشكلون المشكل الحقيقي، أي مصدر انعدام الأمن على الأرض، هي المليشيات، التي غالبيتها غير ممثلة في المفاوضات، لأنه لا أحد يريد أن يتواصَل معها بشكل مباشر. والمشكل مع اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، أنه ليس هو من يتفاوض، وهو مرتبط بطبرق، وهو يمثل خطراً سياسياً بالنسبة للزعماء السياسيين في طبرق لأنه يريد أن يحل محلهم، لأنه الوحيد الذي يمثل خليطاً ما بين الوزير والقرار السياسي. لحفتر بعض السيطرة على الوضع، ولكن تحالفه السياسي هش، كما أن هناك مليشيات تغير ولاءاتها. الواقع الليبي متشظٍ، وهو ليس صراعاً بين متطرفين وعلمانيين، إنه خليط من كل شيء. نحن الأوروبيون نميل للقول إن كل حلّ هو سياسيّ، بينما يرى العرب أن كل حلّ هو أمنيّ. وفي الحقيقة، نحن معاً على خطأ، لأنه يوجد دائما خليط بين الإثنين. وطالما أن حفتر والآخرين لا يستطيعون أن يزاوجوا بين الإثنين فإن عدم الاستقرار سيستمر في ليبيا. لن تكون بالضرورة عبارة عن معارك محتدمة، بل يمكن أن يستقر الوضع لبعض الوقت، على صورة مناوشات. ولكن هذا لن يكون كافياً، لأننا نأمل في ليبيا مستقرة على الصعيد الأمني، يحكمها دستور موحد.
* ألا تشكل الأزمة الليبية تهديداً جدياً لأوروباً يتجاوز تهديدات سورية واليمن والعراق، البعيدة عن أوروبا، نسبياً؟
فرنسا وإيطاليا واعيتان جداً بخطورة الأمر. وعلى مستوى البلدان الـ28 في الاتحاد لا توجد نفس الإرادة السياسية في التحرك، وقد كان جان إيف لودريان، حين كان وزيراً للدفاع في فرنسا، من أنصار التدخل في ليبيا. لست متأكدة من أن إرسال قوة أوروبية إلى ليبيا سيكون فكرة جيدة، ولكن يمكن اللجوء إليها، حين التوقيع على مؤتمر للسلام، بتفويض من الأمم المتحدة. يجب العثور على بلد لا يزيد من تقسيم الليبيين أكثر، باكستان أو غيرها، المهم قوات دولية، لا تتضمن قوات أوروبية ولا أميركية، حتى يتسنى لليبيين إعادة بناء جيشهم وقوات الأمن الخاصة بهم. أعتقد أن أوروبا لن تتحرك حتى يحدث اعتداء مرتبط بشكل وثيق مع ليبيا، وحينها سنسمع ردود فعل دولية. وفي السياسة الخارجية أو السياسة الدولية لا يحدث تحرك إلا حين يستحيل تجنبه. هناك فرنسا وإيطاليا اللتان تتحركان على الأرض، من خلال إرسال قوات خاصة، ولكن هذا لا يحل المشكلة، لأنه يتوجب التوصل إلى حل سياسي حقيقي، لوضع حد لكل شبكات المخدرات والهجرة السرية والإرهاب والسلاح. أنا متفقة معك بأن المشكلة لا تخص ليبيا والمغرب العربي فقط. والسلاح الذي خرج من ليبيا نجده الآن لدى 16 مجموعة مسلحة. إنها قنبلة موقوتة وستنفجر يوماً، لكن بشكل أكثر عنفاً وقوة.
* لماذا لم تنجح فرنسا بإرساء الاستقرار في الساحل؟
أنت تعرف أن الساحل منطقة واسعة جداً، وأن كثيرا من دوله غير متفقة على سياسة واحدة. ليبيا غير مستقرة، فيما المغرب والجزائر متنافسان، بينما مصر تعمل بصفة فردية، والدول الأفريقية تعاني من ضعف وهشاشة. كان الأمر سيكون أكثر سهولة لو أن للدول الأفريقية تصورا مشتركا عن الوضع. كما أن فرنسا تحس أنها وحيدة، ولا تلقى الدعم من دول الاتحاد الأوروبي. صحيح أن ثمة مشروعا أوروبيا لتكوين قوة أفريقية، لكن يجب أن يكون انخراطها أكبر، لأن الأمر مكلف، مادياً وطويل الأمد. فرنسا لوحدها لا تستطيع النجاح، بسهولة، في مهمتها، فهي تحتاج لدعم أوروبي وأميركي، كما أن على الدول الأفريقية أن تتحد حول هذه القضية. وأخشى أن تكون 2018 محتدة في الساحل. ولن تعي الدول الأوروبية خطورة الأوضاع في الساحل حتى يقع حدث كبير يربط الأمن الأوروبي بالأمن المغاربي وأمن الساحل. وبما أنه لا يوجد رباط مرئيّ جداً، وبما أننا في أنظمة ديمقراطية، فإن على الشعب أن يفهم ما هو مهم. وألمانيا لن تتحرك ما دام لا يوجد رباط مرئي جداً. وفيما يخص فرنسا، البلد الأوروبي الأكثر تدخلاً في الخارج، فإنه يصعب عليه العثور على شركاء، وهو يحتاج إلى حدث كبير حتى يتحرك ويجذب شركاء معه. والشعب الفرنسي عموماً يؤيد ما تقوم به حكومته في الخارج، لكن الدول الأوروبية غير مقتنعة بالرؤية الاستراتيجية الفرنسية. يجب توفر شركاء، في ظل غياب أميركا، وعدم معرفة نوايا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وغياب بريطانيا التي كانت تتقاسم مع فرنسا الرؤية الشاملة للعالم، والتي تعرف انفجاراً داخليا بسبب “بريكست”.
العربي الجديد