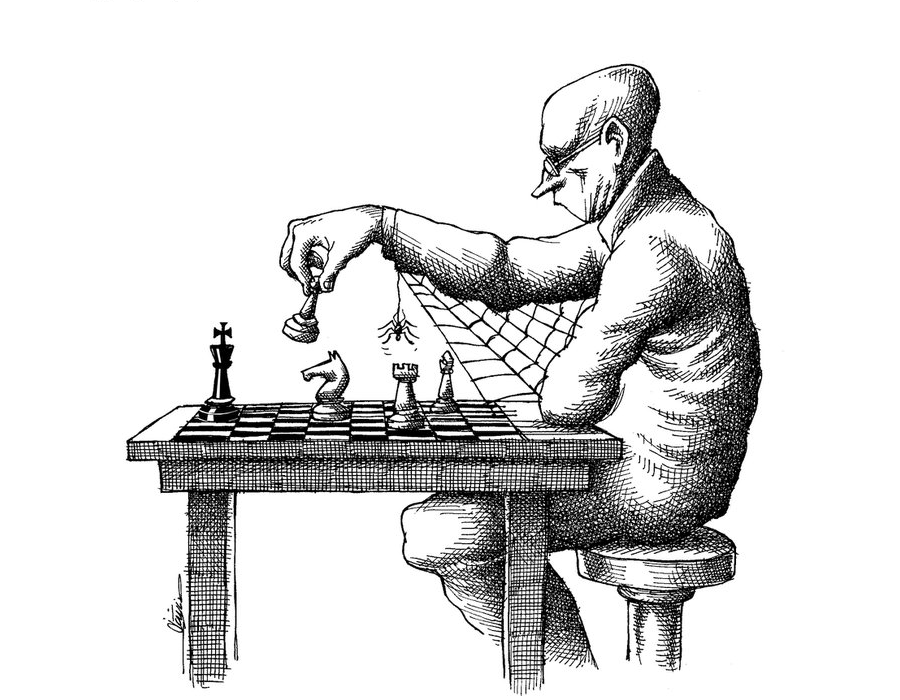“أم علي”، بقرة الله/ جولان حاجي

الدعسوقة كونٌ مصغَّر، على منوال السلحفاة لدى الصينين القدامى؛ بطنُها المستوي أرضنا، ظهرها قبةُ السماوات، سماء قانيةُ الحمرة مرصَّعةٌ بسبع نجومٍ سود هي أيامُ الإنسان السبعة على هذه الأرض، سبعة ثقوب سود تبتلع الزمن الذي ينبعُ ويفيض بين أيدي الأطفال.
تقول أغنية أطفال روسية: “يا بقرة الله الصغيرة الأثيرة، طيري إلى السماء واجلبي لي خبزاً أسودَ”. لعل هناك جذراً روسياً كامناً في اللغة الييديشية التي تسمي الدعسوقة: “بقرة موسى”، فأل خير يربّيه اليتامى في علب كبريت فارغة.
أعيش مرة أخرى صباحاً خريفياً مضى، فيه رفعتُ الكأس المقلوبة فتململتْ بقرة الله على الفور، يقظى كقطٍّ يتمطّى. كنتُ قد نسيتُ أنني وضعتُها هناك منذ ليلة البارحة، حيث غفتْ حبيسةً في ناقوس زجاجي، أو ربضتْ منتظرةً هذه اللحظة. بالأمس، لم يكُنْ في نيتي قتلها، تمنيتُ أن تختفي فحسب فلا أراها في الغد ولا أتذكّرها، أن تختفي بطريقة لن أستوعبها أبداً لدى هذه المخلوقات الضئيلة التي تعرف كيف تحيا وكيف تنجو من دون أيّ ضجيج. تمنيتُ لو تنصرفُ من تلقائها، فلا أتخيّلها تزحف فوقي وأنا نائم، أو تتسلّق شعري كالقمل، قبل نزولها إلى غرفة دافئة مهجورة مطلة على الجنوب لتموت في هدوء. لم أستدرجها إلى أناملي لأطلقها بنفخة من فمي في هواء الخريف. قلتُ سأضعها على بصيلات السيكلامان، في أصيص الزهور الوحيد لديّ، لتفترسَ حشراتٍ أخرى لا أراها. لكنها تجمّدتْ حين مسستُها بسبابتي وانكمشتْ أرجلها، تماوتت وانقلبتْ على ظهرها كخوذةٍ نحاسية لجندي أردتْهُ شظية وراء جدار. مِن أية حديقةٍ أو كنيسةٍ أتَتْ؟ مِن أيّ شقٍ تسلّلتْ؟ ماذا لو عشّشت وباضتْ هنا؟ أي الشقوق والثغرات الخفية سأسدّ مرة أخرى؟ هل شدّها نصوع هذه الجدران، أم الدفء في هذه الغرفة التي ترطّبها كثرة النوم والوحدة، الدفء داخل هذا المبنى العتيق الذي تتفسّخُ فيه الأيام؟ “ارحميني، يا سيدة الكرامات”، أستعطفها، وكأنها رسالةٌ من الجحيم، دليلٌ أرسلته الطبيعة نذيراً لي أو بداية حملة، قبل وصول سربٍ من شقيقاتها سيجتحن هذه الغرفة الصغيرة، زاحفاتٍ إلى الزوايا بين الجدران والسقف، ويتركن لطخاتٍ صفراء سيخطئ في تفسيرها مَن سيستأجر هذا المكان من بعدي. لا أعلم كيف سأقتلهنّ. أفكّر بأنني سألملمهنّ وأضعهن في طبقٍ صغير أتركه على العتبة ليأكلهنّ كلبُ جارتي، أو أصفّفهن على حافة النافذة ليلتقطهنّ عقعقٌ مطلعَ الصبح. ضيفة الحظّ والشؤم، لن تقضم كتبي القليلة، مثلما قضمتْ بضعةُ فئران كتبَ أبي في الصناديق أثناء انتقالنا من بيت إلى بيت. لن تُتلِف ملابسي القليلة، مثلما أتلف العثّ سراويلَ أخي المطوية تحت الأريكة راسماً في مخملها الأسود أكثر من خريطة لكردستان.
ليست حشرة الطفولة، ولستُ أنا ذاك الطفل الذي وضعها على ظاهر يده اليمنى، جالساً على أكياس الحنطة، ثم نفخ عليها باتجاه الجنوب، مردّداً في قلبه الأمنية: أن تأتي له بكرة قدم من موسم الحج في مكة، فتصل حاملةً الكرة بين أرجلها، بعد رحلة طويلة من الكعبة إلى جبال طوروس. وهنا أيضاً، في باريس، وجهتُها القِبلةُ، ولربما رأى مؤمنٌ بالغيب إعجازاً في هذه المصادفة: حشرة تصلّي تحت القبة الحمراء لجسدها وتسبّح مثلما تسبّح رعودُ الخريف باسم الله. إنها لا تشبه العنكبوت التي تعاف الكنائس عادة ولا تبني بيتها فيها، لأن العناكب تنفر من خشب السنديان.
هكذا تنقلب الألفة إلى كابوس، والذكرى إلى علقم. الآن، احمرار قشرة الدعسوقة كامدٌ فاهٍ، باعثٌ على الاشمئزاز قليلاً، باعثٌ على القلق مثل شامةٍ نافرة تسرطَنَتْ. يمكن هرس سقف هذا الجسد بضربة من ظفر الإصبع الوسطى. يبدو ظهورها، في منتصف تشرين، أمراً غير مألوف، خرقاً لقوانين الطبيعة التي أجهلها. لا أعرف متى تختفي مثل هذه الحشرة، وهل ستدخل سباتاً شتوياً كالدبابير والنحل، لتهجع في غرفتي الشتاءَ كلَّه قبل أن تستفيق مطلع الربيع، أو ربما تموت أثناء نومها الطويل. لا أعرفُ بمَ تتزوّدُ، وماذا وجدتْ في هذه الغرفة الصغيرة، الصامتة مثلها داخل درع الهشاشة، وماذا ترعى حين أراها أحياناً بعد انتصاف الليل تزحف كظل صغير أسود خلف الستارة، وتترك على زجاج النافذة المبقَّعة بمطر الخريف وغباره ما تتركه على يد طفل اتّسختْ وخشنتْ بلعبِ الدحاحل: نقطة صفراء كمّونية صغيرة، بقايا لذة أو هلع، خراء أو دم نزفتْه حين دهمها الخطر متجسّداً فيَّ، دمٌ يُشَمّ كماءٍ آسن تعفَّنت فيه ورودٌ منسيّة.
حركتها بطيئة في هذا النهار الغائم، مكتنزة قصيرة الخطوات مثل جَدّة ٍكردية. تراها تُحتضر أم أن طفرةً ما جعلتْها حشرةً ليلية؟ فتحتْ جناحيها اللذين لاح تحتهما غشاءان أسودان انفتحت طياتهما فاستطالا كوشاحين رفعتْهما نسمة، كرموش اصطناعية في جفون ممثل ميت. أثار المنظر غثياناً حقيقياً أخذني إلى فناء كوكب الأرض كله بالتلوّث: طعم المبيدات والأسمدة في الفم والدم، الهواء والتراب مسمّمان حول الجذور والغصون. الحتوف قريبة دائماً، وما هذا اللون البني الباهت كبراز جاف على درع الحشرة إلا علامة موت. تذكرتُ نفورَ صديقتي المسافرة حين وصفتُ لها شجرةً أزهرت في غير أوانها: “هذه شجرة السرطان”.
موقع رمان