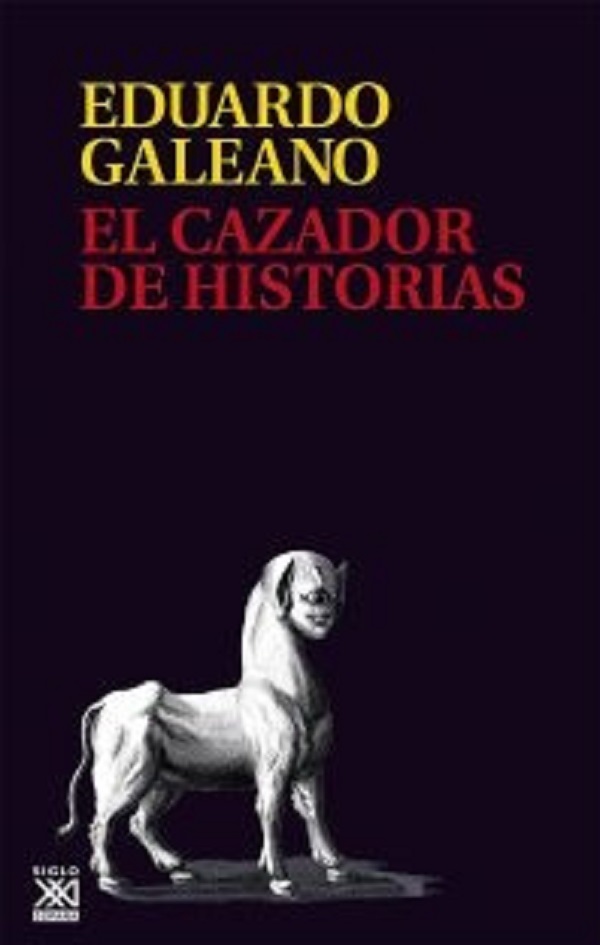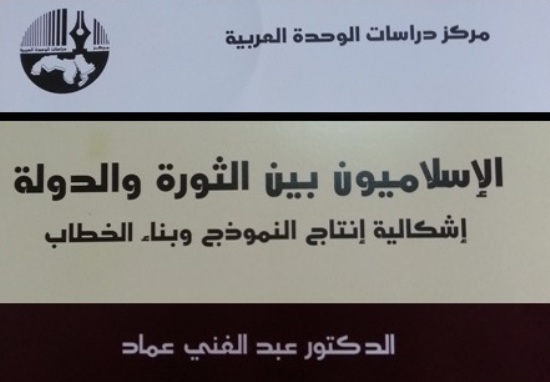اسطنبول كما ترويها نساؤها بتناقضاتهن
كاتيا الطويل
لكلّ مدينة عطرها ولونها وخناجرها. لكلّ مدينة أزقّتها وقصصها ودمعاتها. ولكلّ مدينة نساؤها. ومَن يسرد حكاية مدينةٍ أفضل من نسائها؟ مَن يسدل حجب المدينة ثمّ يرفعها بأناة وإغراء أفضل من نسائها؟ مَن يروي حبّ المدينة ورغبتها وموتها أفضل من نسائها؟
واسطنبول لها حكاياتها على غرار كلّ المدن. مدينة العشق العتيقة، تنفرج أساريرها عند كلّ زاوية ومع كلّ قبلة يتبادلها عاشقان بِوَجَل. لكنّها أيضاً مدينة القسوة والصقيع، تكشّر عن أنيابها عند كلّ زلّة قدم ومع كلّ إشارة ضعف. ولاسطنبول طعم آخر عندما ترويها النساء، في «اسطنبول في قصص قصيرة ترويها النساء»، وهي مجموعة قصصيّة، صدرت تحت إشراف هاند أوت، تروي حكايا اسطنبول وتُظهرها بمختلف أوجهها. «على شواطئ ذلك المضيق اللازوردي، نشأت مدينة على حواف قارّتين، ملتحفة بالغموض. سيّدة الأعاجيب، مبدعة التناقضات، شاه المفاتن. أسموها في الأزمنة الغابرة بوابة السعادة، واليوم، تُعرف ببوّابة الثكل. هذه الحكاية الخرافيّة هي حكاية هذه المدينة» (ص 9).
كلّ قصّة قصيرة روتها كاتبة مختلفة، وكلّ قصّة كانت مرآة مجتمع امرأة جديدة. فتضافرت القصص لتنسج ثوب اسطنبول المزركش بألف لون ولون.
مَن هي اسطنبول؟
في سبع وعشرين قصة، تظهر اسطنبول مدينة كثيفة الخيوط، متعدّدة الوجوه، متناقضة الملامح. فتارةً هي الأم الحنون التي يركض إليها أبناؤها هرباً من قسوة الغربة واللاانتماء، وطوراً هي الرجل المستبدّ الذي يعامل أولاده معاملته داء يجب إبادته. ومع كلّ قصّة قصيرة، أظهرت الكاتبة ناحية معيّنة عرفتها من مدينة البوسفور المزدوجة المشاعر. ففي القصّة الثالثة عشرة مثلاً، تظهر اسطنبول ملاذ المرأة المصابة بالسرطان والتي تقرّر عدم الخضوع لعلاج. هذه المرأة الصلبة التي تفاجئ الطبيب بردّ فعلها المتماسك، تقرّر إكمال حياتها متناسية المرض المتربّص بها، متجاهلة الموت المحلّق فوق رأسها. فتتحوّل اسطنبول إلى شريكتها في جرم الحياة، إلى مناصرتها في استفزاز الموت. تتحوّل اسطنبول إلى صديقة تخرج برفقة البطلة بحثاً عن قصّة حبّ أخيرة.
أمّا القصّة الخامسة، فهي قصّة المرأة التي تُشعر القارئ بأنّها تختنق. فتصف له الرائحة الكريهة التي تشمّها والتي تكون الوحيدة القادرة على شمّها. رائحة مقزّزة، يتّضح للمرأة أنّها رائحة تنبعث من زوجها الجالس قربها في القطار. هذه القصّة هي قصّة امرأة محجّبة، متزوّجة، حياتها باهتة، زوجها مثير للاشمئزاز والنفور، ووضعها المادّي عادي يميل إلى الفقر. وترى هذه البطلة اسطنبول القاسية، الباردة، والمجحفة، اسطنبول التي تقدّم نساءها لرجال لا يستحقّونهنّ. وتبقى الصدمة الكبرى في نهاية هذه القصّة القصيرة، عندما تصل المرأة إلى وجهتها وتنظر إلى زوجها بقربها وتجده ميتاً. فتسير بكلّ هدوء مبتعدةً عنه، وتنزل من القطار، وتنتهي القصّة بمشهد المرأة وهي تنزع الحجاب عن رأسها وتتركه على الأرض خلفها. فكأنّ الرجل لم يكن من القوّة التي تؤهّله لإكمال الرحلة إلى جانب المرأة، فانسحب قبل أن يبلغ وجهته، وموته هذا حرّر المرأة وأطلقها كائناً جديداً مستقلّاً في شوارع اسطنبول.
ويحار القارئ، ويعجز عن اختيار صورة واحد تتجلّى فيها هذه المدينة. فها هو مثلاً في القصّة الثالثة يرافق الأمّ إلى موعدها مع ابنتها. أمّ هادئة، أنيقة، أرستقراطيّة تتناول الشاي مع ابنتها الدائمة الاستعجال والانشغال والقليلة الاهتمام بمظهرها. فتظهر اسطنبول في هذين الجيلين المختلفين، ولكنّها تظهر أكثر في حاجة الأم إلى ابنتها، في رغبتها في الإفصاح عن دواخلها ومشاطرة ابنتها همومها، ولكنّها ترتبك وتتراجع في كلّ مرّة. فالابنة العاجزة عن التواصل مع أمّها تبقى غافلة عن مخاوف أمّها من الوحدة والموت. فتتحوّل اسطنبول إلى هوّة الأجيال.
أمّا في القصّة الحادية والعشرين فينتقل القارئ مع الكاتبة إلى مجتمع مختلف، ينتمي إلى الطبقة العامّة من الناس تكون فيه المرأة رهينة أُطُر أكثر تزمّتاً وتضييقاً. فالبطلة هنا عاجزة عن رؤية من تحبّ بسبب أمّها القاسية والمتشبّثة بآرائها وأحكامها على الناس. ويتطوّر السرد مع هذه الفتاة الشابّة لتتحوّل إلى أم تدّعي مرض النسيان لتهرب من واقعها.
مهد المرأة المستقلّة
عاصمة الإمبراطوريّة الرومانيّة ومن بعدها الإمبراطوريّة البيزنطيّة ومن بعدهما عاصمة الإمبراطوريّة اللاتينيّة فالدولة العثمانيّة، عاملت اسطنبول المرأةَ بتوتّر. فلم تكن العلاقة دوماً علاقة أمان واستقلاليّة وحرّيّة، فتارةً كانت اسطنبول تقسو على نسائها وطوراً كانت تقوّي شوكتهن في مواجهة الذكوريّة المجحفة. وفي عدد من هذه القصص القصيرة، نجد المرأة المتحكّمة بزمام أمورها والقادرة على تحديد مسار حياتها. فالقصّة الثانية، وقد تكون الأطول من بين قصص المجموعة، تُروى على لسان امرأة تقرّر العودة إلى زوجها الأوّل بعد فترة انفصال ناهزت التسع سنوات. وخلال هذه الفترة عاشت المرأة حياتها بحرّية، فعملت كمترجمة كتب، وعاشت في بيتها بمفردها. استقلَّت عن زوجها ووالديها، واستطاعت أن تدخل في علاقتين مع رجلين اختارتهما بمفردها.
وتبقى هذه المرأة على حريّتها ونمط عيشها حتّى بعد مصالحتها مع زوجها، فها هي تختار بيتهما الزوجي الجديد، وتختار تقسيمه، وتبقى على مزاولة مهنتها. وتظهر هذه الاستقلاليّة مريحة ومنمّية لشخصيّة البطلة إلى أن تكتشف حكايا بحّارة البوسفور الذين يأتون إلى شواطئ اسطنبول بحثاً عن عشيقة. فتتحوّل صور رجال البوسفور إلى أطيافٍ تثير ارتباكها وحيرتها، بخاصّة عندما تكتشف أنّها محطّ إعجاب أحد هؤلاء البحّارة وأنّه يريدها عشيقةً له يزورها في كلّ مرّة يخرج فيها من البحر.
وكذلك نجد القصّة الثامنة عشرة، وهي قصّة امرأة تتحدّث في علاقاتها الغراميّة. فها هي على العشاء مع رجل لا تحبّه، بينما الرجل الذي تريده تكون عاجزة تمام العجز عن بلوغه أو إعلامه بحبّها. وتتقدّم الأحداث، وتشعر بخيبة الرجل الذي أمامها والذي راح يدرك أنها لن تمنحه شيئاً من ذاتها ولا حتّى قبلة، بينما تروح مخيّلتها تجنح نحو الرجل الآخر. الرجل الذي تنتظر اتّصاله، وتذهب من أجله إلى صالون التجميل من أجله.
تتحدّى الفتاة، في القصّة العشرين، سلطة والديها المنتميين إلى الطبقة المخمليّة من المجتمع وتتزوّج طبيباً يكبرها سنّاً، ويكاد يكبر والدها سنّاً. تتمتّع هذه الفتاة بشخصيّة الفتاة المتمرّدة الثائرة على قوانين المجتمع الراقي ومفاهيمه، فتترك منزل أهلها وتنتقل للعيش مع زوجها على رغم رفضهم ذلك. فتظهر كامرأة باحثة عن حرّيتها ومتشبّثة بما يمليه عليها قلبها. لكنّ النهاية تقلب الموازين، ليتبيّن أنّ المسألة ليست مسألة حبّ وثورة، بل هي رغبة فتاة مدلّلة بالخروج على المألوف. ففي اللحظة التي يقبل فيها والداها بزوجها الجديد تفقد الاهتمام به، وتعود لتنام في سريرها في منزل والديها.
أمّا القصّة الثانية والعشرون، فهي قصّة المرأة المعاصرة بامتياز. هي قصّة المرأة العاملة، الناجحة في عملها، والمتمتّعة بمنصب مرموق في المجتمع. هذه المرأة الجميلة الفاتنة الأنيقة، المتمتّعة بجميع المزايا لتجسّد مثال المرأة في القرن الحادي والعشرين، تعود إلى منزلها، إلى عائلتها، لتقوم بمهام الطبخ والتنظيف. هذه القصّة هي قصّة المرأة التي تتعلّم أن تتحدّى الوقت والمجتمع والواجبات لتتمكّن من نيل استقلاليّتها من دون أن يؤثّر ذلك في عائلتها وأبنائها. هذه المرأة التي تحاول دوماً مجاراة الزمن وإنجاز واجباتها في أوقاتها المحدّدة، تجد نفسها مجاهدة وحيدة لا يحسّ أحد بمعاناتها ويمجهودها.
الصفعة القاسية
في مقابل صورة المرأة المستقلّة والمتحرّرة التي رسمتها كاتبات القصص القصيرة، تبقى المرأة في قصص أخرى كائناً يرتبط مصيره ارتباطاً وثيقاً بإرادة الرجل، ومتطلّبات المجتمع. وتبقى اسطنبول مدينة تفضّل أبناءها على بناتها. فهي منذ القدم، مدينة الرجال شأنها في ذلك شأن المدن التي تنتمي إلى الحضارة نفسها: «لقد كانت المدينة رجلاً لقرون عدّة خلت، وهي لا تعرف كيف تحبّ النساء. من أجل ذلك، أقتل نفسي في هذه المدينة كلّ يومٍ مرّة تلو مرة». (ص 304).
تقسو اسطنبول على نسائها، وتترك لرجالها حرّية الحب والعيش والتصرّف. فمثلاً في القصّة السادسة والعشرين، وهي أكثر القصص تماسكاً وإتقاناً لكون الكاتبة اختارت أن تتحدّث فيها تارةً بلسان المرأة وطوراً بلسان اسطنبول، نقع على الرجل القاسي الذي يضرب المرأة ثمّ يشوّهها بسكّينة كي يمنعها عن العمل. وهنا ينتقل التشوّه من الوجه إلى الفؤاد لتصبح المرأة طائراً مجروحاً يخشى التحليق ويخشى الحياة.
وكذلك في القصّة التاسعة، وهي قصّة رمزيّة زاخرة بالإشارات المدروسة، تظهر المرأة منصهرة في مجتمعها، ولكن أيضاً مقموعة. فالفتاة التي تخرج من بيتها محجّبة تنزع الحجاب عن رأسها على باب الجامعة. فالحجاب ليس خيارها على رغم أنّها ترتديه احتراماً لعائلتها وعاداتها وتقاليدها. هذه المرأة الطموحة، على غرار بنات جنسها، عندما تصل إلى سؤال مصيريّ تتركه وتلوذ بالفرار.
وحتّى في القصص التي يكون الرجل فيها غائباً، فغيابه صاعق ومحرّك للأحداث كما في القصّة الثامنة عشرة التي تقبع فيها البطلة منتظرة عشيقها على أحرّ من الجمر. وبينما هي تتحضّر وتتوقّع مجيئه أو اتّصاله في كلّ ليلة، تنتهي القصّة بعدم حضوره. ولا يشكّل هذا الغياب أيّ نوع من أنواع الخيبة، بل هو مفتاح لسؤال أخير تُنهي به الكاتبة نصّها «متى؟». ويشكّل منطلقاً لآمال تتجدّد كلّ صباح: متى سيأتي؟
المدينة القاتلة
ومن جهة أخرى تُتهم اسطنبول بأنّها السبب وراء هذه الذكوريّة وهذا الاستبداد، فتظهر كالجلّاد القاسي العنيف. لكنّها جلّاد يجلد الرجال والنساء على حدّ سواء: «المدينة كانت بائعة هوى، يعيش رجالها ويستهلكون الحب كما لو أنّه بالمال يُشترى، ونساؤها مشوّشات، غاضبات، وبالتالي وحيدات» (ص 242).
وتنسلّ صورة المجتمع بين الكلمات. فالحديث وإن اكتفى بتناول المرأة وعلاقاتها بالرجل وبعائلتها وبربّ عملها، فهو يتوسّع لينقل صورة المجتمع بأسره. فنجد المجتمع المخملي يكمّل الطبقة المتوسّطة والدنيا من المجتمع، وكذلك نجد الحياة الليليّة في اسطنبول ونمط عيش الشباب المحبّ للحياة والمقبل عليها بشراهة وتعطّش. ولا ننسى طبعاً علاقات الصداقة والطباع البشريّة والغرائز التي يتعرّف إليها القارئ ويتأمّل تأثيرها في نساء اسطنبول وحياتهنّ فيها. ومن ناحية أخرى نجد موضوعات أكثر جدّية وفلسفيّة كمسألة الحياة والموت والحب والزواج والطلاق. وتوصف اسطنبول بأنّها مدينة الحياة التي لا تنفكّ تذكّر أبناءها بزوالهم الوشيك والحتمي: «مدينة حيّة، تُشعرك بأنّك على قيد الحياة ولا تنفكّ تذكّرك بالفناء» (ص 157).
وتظهر اسطنبول مدينة جارفة، تسيّر أهلها وفق مشيئتها بعيداً من رغباتهم. فلهذه المدينة آراؤها وخططها ومتاهاتها التي يعمل الجميع وفقها. وفي القصص القصيرة السبعة والعشرين كلّها، يجد القارئ نفسه إلى جانب البطلة في حالة ذهول أمام ما آلت إليه الأمور: «إنّ اسطنبول لهي مدينة فاتنة، خارقة. بينما أنت مستغرق في إعداد خططك، تحدّد لكَ مصيراً آخر». (ص 90).
وتتميّز هذه القصص، على اختلاف موضوعاتها ومؤلّفاتها والأطر الزمانيّة والاجتماعيّة التي تدور فيها، بتسلسل سردي منطقي ومتماسك ولغة موجّهة لجميع القرّاء. فهي سهلة الفهم وقريبة المتناول وتتراوح صفحات القصّة الواحدة بين خمس إلى خمس عشرة صفحة، ما عدا قصّتين أو ثلاثة تخطّت هذا العدد الإجمالي للصفحات.
وتظهر اسطنبول تارةً حليفة المرأة وطوراً منازعتها الأولى، ولكنّها في كل الأحوال تبقى مدينة لا بدّ من التوقّف عندها طويلاً، وتصعب مفارقتها عندما يحين وقت الرحيل: « ملتحفة بالعار، عجزتُ عن قول أيّ شيء لكِ عندما رحلتُ. على أيّ حال، لم تحبّي يوماً الوداع، وكنتِ دوماً على ثقة من عودتنا إليك. فاغفري لي، يا حبيبتي، كلّ الأخطاء التي ارتكبتها بحقّكِ. انتظريني، يا مدينة حزني. هذا نشيدي لكِ، اسطنبول. يا حبيبتي اسطنبول».
الحياة