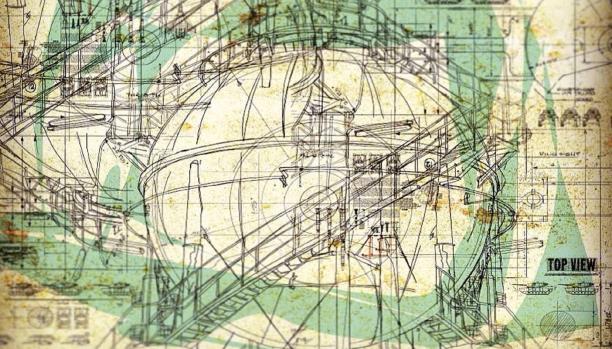الأرض الحمراء/ عزيز تبسي

-1-
وكانت تنبسط في وهدة بين تجمع للفّحامين والزّجاجين، وأكوام من ردميات الحجارة والأتربة المنقولة من مواقع الأبنية التي بدأت تتكاثر أعدادها في المدينة عقب حرب تشرين الأول/ أكتوبر، والعمارات الجديدة التي ارتفعت ولم تتشاهق، وبقي في عمقها متسع لإنشاء ملاعب صغيرة يلعب الأولاد فيها ما يعتبرونه كرة القدم، وملعب أوسع رُفع مرماه بعارضتين من أنابيب معدنية، طليتا كما تطلى أطراف الأرصفة، باللونين المتعاقبين الأبيض والأسود، وكان يأتي ليلعب فيه شبان أكبر عمراً، ينقسمون إلى فريقين، يرتدي كل منهما لباساً موحداً، يحملون كراتهم المصنوعة من الجلد، في سلال على هيئة شباك صيد، وكأس من البرونز يضعونها في عهدة حكم المباراة، ويمنحها في ختامها الهادر للفريق الفائز. تظهرهم هيئاتهم أكثر جدية من الأولاد، الآتين بلباسهم اليومي، حاملين كراتهم الفقيرة، بموادها التي يعاد طبخها في مراجل، وسكبها سائلةً في قوالب الحديد…ولطالما طالبوا بعضَهم وتعاهدوا قبل المباراة، على الرفق في ركل الكرة، عارضين أحذيتهم للتأكد من خلوها من مسامير ناتئة، رافعين أقفيتها كما لو أنهم أمام بيطار، يتفحص حوافر الخيول قبل إعداد قياس حدوتها الحديدية.
لم يتعلموا قواعد اللعب الهانئ، يقذفون الكرة إلى الأعلى ويركضون لملاقاتها ومداراتها بأقدامهم. ترتطم رؤوسهم برؤوسهم، وأقدامهم بأقدامهم وأكتافهم بأكتافهم…. كما لم يكن أملهم إحراز الأهداف في المرمى المقابل فحسب، بل إتمام المباراة قبل تمزّق الكرة، أو تمزق لحمهم، بدحرجة غير متأنية فوق النواتئ الخارجة من تحت التراب، والمبعثرة فوق هذه الأرض الحمراء.
ترى أتساءل، أيٌ منهم يوماً، أكانت أرضاً حمراء عن حقيقة أم وفق مجاز، تعثر في تمييز تدرجات ألوان التراب؟ أم أن يقينهم تثبت على الدم، الذي سال من أيديهم وأرجلهم وجبهاتهم، وامتزج بترابها، ليكون كافياً لوسمها باللون الأحمر؟
-2-
إلى شمالها بساتين تعقبها بساتين، توزعت على ضفتي النهر الهزيل. همّ أصحابها بزراعة الخضار الموسمية، ومشاتل أصص النباتات المنزلية والزهور، وانتزعت فسحة منها لإنشاء إسطبل ناد رياضي، انفرد بتربية الخيول وتعليم الفروسية.
في غربها النهر، الذي يفصلها عن حي محطة بغداد الصاخب على الدوام، مضرّج بمزاجه المخصوص، الذي يضاف غنى تنوعه الملّي، رغبات مفصح عنها للتميز والسعي إلى الأسبقية في الحداثة والابتكار، بالقبض الحار على الجديد، لم يعق ثقل ميراث أهله، اندفاعهم اللجوج نحو الحياة الحلوة بطعومها ومذاقها.
وفي جنوبها يعلو “جبل النهر” الذي يفصلها عن حي العزيزية، المرتبك على الدوام، بهدوئه وتوازنه المثقل بتقليديته الرفيعة التي حملوها معهم وحافظوا عليها، أولئك الذين شيدوا بيوتهم وقصورهم، في نهاية القرن التاسع عشر واستهلالية القرن العشرين.
-3-
لم يمتلكوا في بيوتهم فائضاً من الألبسة ليستبدلوها، بدائلها هاجعة في محلات الرتائين، تنظر دورها مع أكوام الألبسة لأناس آخرين، ليعيدوا دعم رتوقها بأقمشة أقل رقة، ويحيكوا فوقها خيوط طولانية وعرضانية لتمتينها. لم تكن مصانع النسيج قد توصلت إلى أقمشة تقاوم السحج على الحصى والتراب.. ويتبقى لأهاليهم الدعاء لتحقيق توازن لا يتحقق، بين اندفاع أولادهم وحماسهم، ورقائق أقمشة “التركال” و”التريفيرا”، التي سرعان ما تتمزق وتنثال خيوطها، بأي احتكاك خفيف مع جدار خشن أو مسمار خارج من مقعد المدرسة.
وصلت السياسات الأميركية، بـ “نقطتها الرابعة” و”حلف بغداد”، ونزولها الصاخب على شاطئ بيروت….كما بوصفها أم رؤوم لثلة من الانقلابيين، الذين زعموا أنهم يريدون مواجهتها وتدمير صنائعها، وهم رابضون في أحضانها متفيئين بظلالها، آخذين بنصائحصها، مرتلين تحذيراتها، مجوّدين توجيهاتها.
وصل كل ذلك، قبل وصول نسيج الجينز المرتبط بها وباسمها وأعرافها، وعُرف باسم “الكاوبوي” أو “الكي بوي” – بعدما ترّهل الاسم بعبوره المسافات البعيدة – الذي كانت قد ابتكرته مصانع نسيجها من عوادم القطن، وخصصته لعمال الأعمال البرية القاسية كرعاة البقر وعمال المناجم والمزارعين.
حاز هذا النسيج على وصف “ضيان” تعبيراً عن القدرة على تلازم الديمومة والمتانة، وامتلك المقدرة على النجاة من امتحانات حياتهم اليومية، ولم يعرف هؤلاء الأولاد في حينها، أن السياسة الأميركية ستكون أشد “ضياناً” من هذا النسيج الذي اشترته أمهاتهم وآباؤهم، حيث سيهترئ كما حال أبدانهم وأعمارهم وبلدانهم، بينما سياستها وسياسة صنائعها باقية لا تزول.
-4-
تبدّلت الأرض الحمراء، في غفلة من الأيام الوسنانة، كما تبدلت أشياء كثيرة في المدينة، واعتاد الخياطون لصق الأعلام الأميركية على أقفية بناطيل الجينز، كعلامة على تنشق التابعية الحداثية من الأنوف المزكومة بالغبار وهباب عوادم السيارات. وصلتها جحافل الجرافات من الجهات الأربع، كأنما أرادت تطويقها قبل خنقها وتبديد أثرها، نصفتها بشارع وحاذتها بشارعين واسعين من الجهتين الشرقية والغربية، ردمت وهدتها من تجريف أكوام الأتربة المركونة على أطرافها، شيّدت في جنوبها مدينة ملاهي للأطفال، وفي شمالها جامعاً كبيراً، وفي وسطها حديقة منخفضة، يرتادها العجائز والمتقاعدون في الصباح.. وأصحاب المآرب الخاصة في أوائل الليل.
– أمازلتم تحبون كرة القدم؟ أي بعد ذاك المآل الذي أوصلها إلى الصخب الفاجر والرعونة النذلة، مسنودةً بالأموال القذرة المنهوبة التي توخت الاستحمام في هذه الرياضة المعبودة، وغيرها من النشاطات الترفيهية والبدنية، بغاية العودة إلى أكذوبة المال الأبيض، كما لون الثلج والقطن والألبسة الداخلية، وأولئك اللاعبون الذين يباعون ويشترون كما العبيد في أسواق النخاسة، ليقتفوا بعدها مسارات مصابيح الشوارع، ويعاد استبدالهم، فور استهلاك الغاز الخامل في جوفهم، بمصابيح أشد توهجاً. على الرغم من هذا، يطلقون عليهم بمبالغة غير متأنية: النجوم، وحكام مباراياتها المتشبهون بالقضاة، الذين يتلاعبون باحتراف الخبير في أحكامهم، مما يؤثر على النتائج والترتيب التفضيلي للاقتراب أو الابتعاد عن الصدارة والتتويج بالأوسمة والألقاب.. وشركات المراهنات التي تنتمي إلى المافيات، تمول كل ذلك وتقف في ظلاله، وتحرق أعصابه، وتجفف بقايا حمرة الوجدان في خديه….أما زلتم تحبونها؟
إن بقي لنا شيء نحبه منها، فليس إلا جمهورها المترنّح، والعشب الأخضر لملاعبها، والصور المتبقية من ذكريات الأرض الحمراء، التي أخذ فيها الفرح لون الدم.
حلب نيسان 2016
العربي الجديد