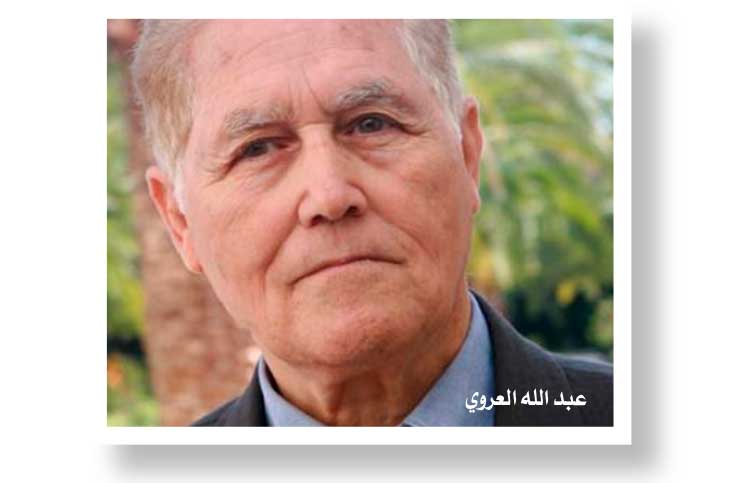الإسلام السياسي: التكيف أو الفشل/ علي العبد الله *
لا تزال حركات الإسلام السياسي تثير الضجيج حول شعبيتها الواسعة في الشارع العربي والإسلامي، والتي جسدها، كما تقول، فوزها في عدة انتخابات برلمانية، وتربط هذه الشعبية وهذا الفوز بصوابية خيارها الفكري والسياسي ونجاعة الأساليب التي تتبناها في حل المشكلات التي يعاني منها المسلمون، مع أنها إما لم تدخل تجربة عملية إلى الآن، أو دخلت وفشلت، ولكنها ترفض اعتبار التجارب الفاشلة مقياساً للحكم عليها. فهل هي قادرة بصيغتها الحالية على تحقيق التغيير والازدهار؟
لقد منح حضور الإسلام في حياة المسلمين، لارتباطه بالدور التكويني والبنيوي الذي لعبه في تشكيل شخصية المسلمين وتاريخهم، ناهيك عن إغراءات إعادة إنتاج النجاح التاريخي، حركات الإسلام السياسي مبررات الوجود والانتشار. لكن تبني المرجعية الإسلامية الذي يضع صاحبه في تطابق واتساق مع عقيدة المجتمع فيجعل قدرته على التواصل والتفاهم مع المواطنين عالية واستقطابهم وتحشيدهم ممكناً، لا يجعل إقامة مجتمع متطور ومزدهر تحصيل حاصل. فالمكاسب والإيجابيات، التي ينطوي عليها تبني المرجعية الإسلامية، حساسة وقابلة للعطب، لأنها كما يمكن أن تكون نقطة قوة يمكن أن تتحول، إذا لم يدرك أصحاب هذا الخيار ما يكتنف خيارهم من عقبات ومصاعب، إلى نقطة ضعف قاتلة ذلك لأن الإسلام صيغة مركبة إلى حد الالتباس وتسمح بتعدد القراءات/ الخيارات ما يستدعي التفكر والبحث لاختيار الخيار الانسب في كل زمان ومكان.
وإذا كان الدين في البلاد الإسلامية من شروط الوجود، حسب د.محمد عابد الجابري، فانه، كما قال، «شرط غير كاف، ويحتاج كي ينجح إلى طرح أهداف سياسية واجتماعية واضحة وقادرة على معالجة مشكلات أوسع الجماهير الشعبية، وإلى أخذ قضية التحديث بكل مظاهرها السلبية والإيجابية في الاعتبار وتوظيف الدين في قضية العدل الاجتماعي والحكم الديموقراطي والتحديث الفكري والحضاري وتحريك الخريطة الاجتماعية وتوازناتها». كما أن الإسلام، الذي يقبل تعدد القراءات، وهذا جعله مرناً ومفتوحاً على الزمان والمكان ولا يمكن اختزاله في صيغة نمطية واحدة، قد اختطفته القراءات السائدة التي تحولت، بسبب ضيق الأفق، إلى مذاهب مغلقة لا تقبل المراجعة بحيث أصبحت هي الدين وليست قراءة له قابلة للجرح والتعديل. كما ترتب على هيمنة العقل الفقهي المرتكز الى آلية القياس، وتضخم الفقه، نتيجة اتساع التجربة الاسلامية مكاناً وزماناً، نشوء حالة يمكن وصفها بـ «قابلية التذرر» الفقهي وبالتالي المجتمعي، حيث صار بإمكان كل منا أن يدعم موقفه الراهن بالاستناد إلى واقعة تاريخية أو رأي فقهي لفقيه أو أكثر، فصار المسلمون موحدين في العنوان مختلفين في البيان. وهذا جعل إمكانية وضع تصور إسلامي محدد مسألة بالغة الصعوبة والأهمية في آن. هذا بالإضافة الى هيمنة فكر الأشاعرة، الذي يحيل كل ما يجري في الكون إلى الله ويُسقط الحرية عن الإنسان، على الفكر الاسلامي.
وهذا يضع حركات الاسلام السياسي امام اختبار جدي لقدرتها على تجاوز العقبات العامة والذاتية، وأولها حل الاشكال الفلسفي وتقديم بديل يتأسس على الحرية والمسؤولية، التي وضعها الخالق في جبلة الانسان وجعلها أساس تميزه في الكون، ثم مواجهة حالتها الفكرية والسياسية وتصرفها في ضوئها بدءاً من نزع قميص القداسة والتحدث باسم الاله والشرع الإسلامي وإطلاق مفردات على تجربتها ذات دلالة شرعية تجعلها مقدسة مثل: الرسالة، الدعوة، الشرع، الوحي، النص. ما أضفى عليها سمات فوق بشرية وجعلها فوق النقد والمراجعة، وطبع المؤمنين بها بروحية طابعها القبول والتسليم من دون تدقيق وهذا عطل الحس النقدي لديهم ونمى الاستعداد للتلقي والتنفيذ. والإقرار بالطبيعة البشرية لاجتهاداتها والقبول بالمراجعة والتقييم وسحب فكرة «المحنة» (الله هو الذي قدر أن يُضطهد الإسلاميون حتى يمتحنهم ويجزيهم على قدر صبرهم) التي رفعتها هذه الحركات في مواجهة المطالبة بالتقييم والنقد الذاتي من التداول. فالشرعية والشعبية توفران إمكانية وترتبان مسؤولية وهذه تفرض إعادة نظر في المنهج الفكري السائد. المنهج الذي ضخّم الجانب العقائدي والأخلاقي على حساب الجوانب السياسية والاجتماعية، وقاس الأوضاع والجماعات بمقياس عقيدي، ما جعله يقسم الناس إلى أخوة وأعداء، ويرفض ليس فقط الثقافات الأخرى بل حتى فكر المدارس الإسلامية المختلفة عنه، والتخلي عن النظرة النكوصية للواقع والتي تجعل الماضي خيراً من الحاضر وتحكّم الأموات في الأحياء وتميل بالكفة لصالح الموروث على حساب الإبداع، والعودة عن الروحانية إلى العقلانية، وعن النزعة الدعوية إلى التثقيف العلمي والسياسي.
لذا غدا وجود حركات الإسلام السياسي ومستقبلها مرتبطاً بعلاقة سببية وطردية بقدرتها على الانتقال من شعارها الراهن «الإسلام هو الحل» إلى تقديم «حل إسلامي» يفي بمستلزمات عملية التغيير والتنمية ويحقق الازدهار والاستقرار. وهذا يستدعي: 1- التحرر من المنهجية التقليدية التي سادت الفقه الإسلامي التقليدي، وبخاصة الاجتهاد الفردي والمنهج التوليدي، واعتماد منهج جماعي وتكاملي يشارك فيه علماء من كل الاختصاصات. 2- التخلص من تبعات التخندق المذهبي، الذي حول الإسلام إلى أديان، بالانفتاح على الجميع وأخذ اجتهاداتهم بالاعتبار. 3- اعطاء عمارة الكون وإقامة العدل والمساواة بين البشر الاهتمام المناسب. 4- تقديم حل عقلاني وعملي لقضايا الفرد والجماعة، المجتمع والدولة، قضايا الاقتصاد والاجتماع والثقافة، التعليم والصحة والخدمات والفن، مستوى معيشة المواطنين ونمو وتفتح الشخصية الإنسانية…الخ. 5- وضع أسس لمواجهة المشكلات السياسية، ووضع قواعد وآليات لإدارة مؤسسات الدولة والشأن العام واقتراح تكييف مؤسسي إجرائي لممارسة الشورى وأهل الحل والعقد، يأخذ الانقطاع الحضاري الذي أمتد لقرون بالاعتبار، يتسق مع روح العصر ومستدعيات الدولة الحديثة.
كل هذا في إطار حل رزمة أو ما سماه المفكر المستقبلي الفين توفلر «هجمة منطقية شاملة» تأخذ القضايا والمشكلات في ترابطها وتداخلها وتأثيراتها المتبادلة بحيث تحقق التكامل والاتساق وعدم التناقض.
* كاتب سوري
الحياة