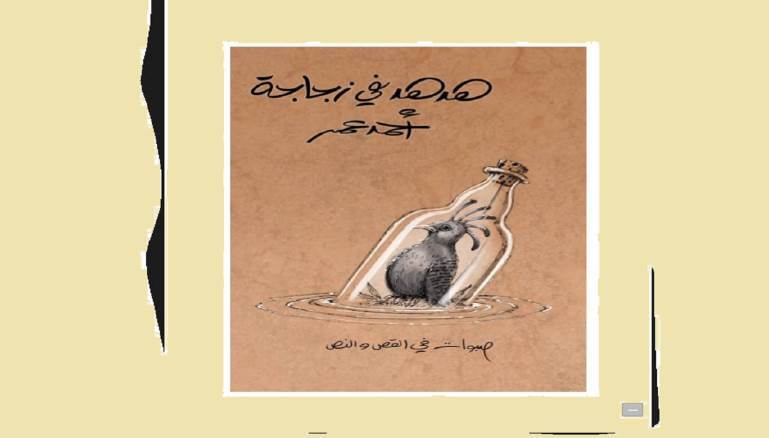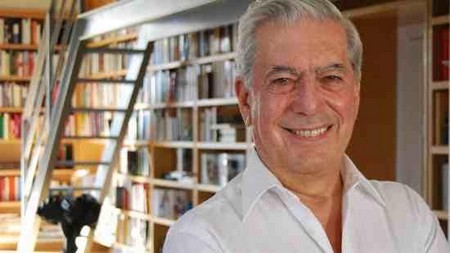“الدين والعلمانية” لعزمي بشارة: الصيرورة التاريخية بين الأيديولوجيا والنظرية/ حسام أبو حامد
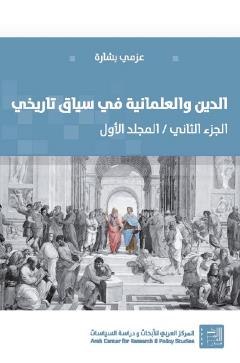
في كتابه “الدين والعلمانية في سياق تاريخي”، ينطلق عزمي بشارة من مقدمة تكتسب أهمية على الصعيدين المنهجي والمعرفي، وهي أنه لا يمكن فهم الدين بوصفه وعيا زائفا، بل ينبغي رؤية الظاهرة الدينية في غناها. فالدين ظاهرة اجتماعية، وكذلك التدين، الذي يتحول إلى ظاهرة قائمة بذاتها، وحتى التدين الفردي هو ظاهرة اجتماعية، وسيقع الباحث في مأزق بنيوي حين يُعرّف ظاهرة اجتماعية كالدين، إذا لم يأخذ في الاعتبار التغيرات في تعريف الظاهرة لذاتها (فهمها الذاتي)، وتجاهَلَ أن باحِثي أي ثقافة حين يتناولون فهم الدين في ثقافة أخرى، فإنما ينطلقون من فهمهم للدين في ثقافتهم. ويكتسب هذا السفر المعرفي الضخم أهمية إضافية في اللحظة العربية الراهنة التي يتقاطع معها هذا العمل، ويخوض في أسئلتها المشتعلة حتى على المستوى الميداني.
الجهد الذي يدعو إليه عزمي بشارة في دراسة الظاهرة الدينية هو جهد علماني، لأنه يعيِّن حدود الدين معرفياً، ويفصله عن غيره من الظواهر. يظهر ذلك في الواقع ذاته لا في النظرية فحسب، حيث تحددت الظاهرة في الواقع ذاته، بحيث ما عاد ممكنا فهم ظواهر عدم نشوء أديان جديدة من دون فهم عملية العلمنة. إن فهمنا للدين، كما يذهب بشارة، يتغير بحسب العلمنة، كما أن أنماط التدين في مجتمع من المجتمعات تتأثر بأنماط العلمنة التي مر بها.
الدين والتدين: الظاهرة الاجتماعية
الانفعال بتجربة المقدس، والتأثر بها أساس العاطفة الدينية. لكن هذه العاطفة لا تتحول إلى دين بمجرد الانفعال بتلك التجربة، بل لا بد أن تؤمن النفس بالمقدس، وبوجوده الحي والعاقل في الغيب، وبأن من الواجب عبادته. للإيمان حياة خاصة فهو يرتكز على المقدس لكنه يتجاوزه إلى محاولة الفعل بالمقدس، وتنظيم عملية التأثر والتأثير، حتى بعد انقضاء التجربة. وبقدر ما يقود الإيمان أيضا إلى تنظيم المقدس، في عقائد بدرجات متفاوتة، يقود إلى الطاعة. أما مأسسة هذا الإيمان في عملية إنتاج جماعة، وإعادة إنتاجها من جهة، والانفعال بتجربته من جهة أخرى، هو الذي يميز التدين من بقية تجارب المقدس.
تقسم المقاربة الدينية للعالم الحياة إلى مقدس وغير مقدس (عادي)، وكي تتحول من التجربة الدينية إلى الدين، يجب أن يتمأسس هذا التقسيم، ويصاغ، وأن يقوم بشر على تدبيره. فما يميز الدين عن غيره، كما يؤكد بشارة، ليس المشترك بينه وبين أوجه النشاط البشري الأخرى، لكن هذا المشترك يصبح أكثر أهمية للفهم إذا ما ميز مجموعة نشاطات من غيرها، وفي عدادها الدين.
هناك تجارب أخرى للمقدس نشأت خارج الإطار الديني، حدث فرز تاريخي تميز من خلاله بشكل أكثر حدة الديني من غيره، ووضع الحدود المعرفية بين الدين وبقية الظواهر الأخرى التي تشترك معه في الجنس أو النوع، وهنا عملية علمنة للشؤون الأخرى التي تبقى معرضة لسيطرة الفكر الديني، لكن عندها يجب أن يكون اختراقا أيديولوجيا، فالدين دين في حدوده، وأيديولوجيا خارجها.
المقدس أكان شعورا إنسانيا، أو تقسيما متوارثا تقليديا من زاوية نظر الباحث، أو واقعا حقيقيا متجاوزا في إيمان المؤمن، هو شرط الدين الأصلي، لكن الدين الأصلي يخرج عن أصله ويصبح شرط ذاته حين يتحول إلى ظاهرة اجتماعية، عقيدة يعتنقها بشر، وتقوم عليها مؤسسة.
لا تدين من دون دين ولا دين من دون تدين، لكن التدين يتخذ طريقه بتشييء الإيمان، وتظهر العلاقات الدينية حتى تصبح لها حياتها الخاصة، فيصبح التدين هو الدين حتى لو كان من دون إيمان، وقد يصبح مجرد هوية اجتماعية (شخصية فردية أو جماعية) في عصر الهويات.
إنا نهدر خصوصية الظاهرة الدينية، وقوتها، وأهميتها، بعملية دحض الدين، والهجوم عليه كأنه مجرد خرافات، فالدين ليس نظرية خاطئة لتفنّد وانتهى الأمر، لا ينتهي أمر الدين بدحضه، وتفنيد علميته، وإثبات خطأ تفسيراته للدنيا، ولو صح ذلك لما كان الدين مؤثرا بهذا الشكل الكبير في الولايات المتحدة الأميركية، وأميركا اللاتينية، والفيليبين، ومصر، وإيران، وفي المشرق والمغرب العربيين.
يشير بشارة إلى الأهمية السوسيولوجية لمقال منشور لإيميل دوركهايم عام 1899، رأى فيه أن العلم هو الذي يفترض أن يدرس الظاهرة الدينية، شرط أن تتوفر له الأدوات، لأن الدين ظاهرة اجتماعية، معتقدات متوارثة، ومرجعيات ملزمة، وممارسات هي في مجملها اجتماعية، أما حالات التطوير الفردي للممارسات الدينية تبقى ثانوية قياسا على الظاهرة الاجتماعية. يشخص دوركهايم إعادة إنتاج الجماعة عبر الممارسات الطقسية كأهم وظيفة للدين، ويرى أن مهمة الفكر الاجتماعي، فلسفيا كان، أو أنثروبولوجيا، هي أن يميز بين طقوس وشعائر علمانية، وطقوس غير علمانية، دينية أو بديلة من الدين.
يتوصل دوركهايم إلى تعريف موجب للدين نفسه “الدين منظومة موحدة من العقائد والممارسات في علاقة مع أشياء مقدسة مفصولة ومحرمة، إنها عقائد وممارسات من شأنها أن توحد كل من يتبعها في جماعة أخلاقية (أو عرفية) تسمى كنيسة”. حسب بشارة، يفترض هذا التعريف الفصل بين المقدس والدنيوي، والحلال والحرام، ليجد فيه جميع مركبات الظاهرة الدينية: المؤسسة الدينية- الاتباع- العقيدة- الممارسة، وهي العناصر التي يجب أن تجتمع في نمط تديّن معين.
هل الدين، كما يذهب دوركهايم، هو تسامٍ للجماعة، من أجل إعادة إنتاجها، باعتبارها حالة من الوحدة؟ بعض الباحثين يعترضون بالقول إن هذا غير صحيح، والدليل أن الدين يفتت المجتمعات، ويؤدي إلى الحروب. يتساءل بشارة: هل التناقض بين تشكيل الجماعة وتفتيتها أمر وهمي؟ برأي بشارة، هذا التناقض ليس تناقضا منطقيا، بل هو تناقض قائم في الواقع ذاته، وكثيرا ما أدت بلورة جماعات إلى تفتيت مجتمعات قائمة بذاتها، وهذا الاستنتاج ليس مثالا داحضا للنظرية، هل أيرلندا الشمالية، أو لبنان، أو العراق، مجتمعات يجري توحيدها، أو تفتيتها بوساطة الدين؟ هل وظيفة الدين إعادة إنتاج لجماعية هذه الكيانات، باعتبارها قومية؟ الواقع أن الطائفة لا الوطن، أو القومية، هي الجماعة المتخيلة هنا، وهي تشمل ممارسة الانتماء الطائفي من دون تديّن.
يخلص بشارة إلى أن المجتمع الوطني حين يعجز بأدواته عن إنتاج القومية، أو الأمة المواطنية باعتبارها جماعة متخيلة تتبارى مع الجماعة الدينية، أو تخضعها، أو تجبرها على العيش في كنفها، فسوف يكون الإنتاج الديني للجماعة الدينية مُفتِتَا للمجتمع، لا موحدا له. إنه في هذه الحالة مُوحّد للجماعة باعتباره مادة في خلق جماعة متخيلة، لكنه مفتت للمجتمع.
العلمنة بوصفها صيرورة
باستثناء الدلالة على التقابل بين الكهنة والعامة، وعلى مصادرة أراضي الكنيسة، حدثت تطورات فكرية في أوروبا سبقت استخدام لفظ “علمانية” ذاته، فمرت الثورة الفكرية، وفلسفة التنوير من دون استخدامه. يرى بشارة أن ليس اللفظ هو الأساس، بل العملية الفكرية التي أدت إلى نشوئه، والسياق التاريخي الذي يكتب فيه معناه، والبنى السياسية والاجتماعية التي يشرحها.
التمايز بين المقدس والدنيوي، وبين الدين والدولة، كان قائما قبل استخدام مصطلح العلمانية، وحتى قبل الحداثة. لكنه كان قائما موضوعيا، لا باعتباره موقفا يدعو إلى هذا الفصل ويعتبره من أسس التقدم الانساني، فالأخير هو العلمانية، والتي هي موقف من التمايز لا التمايز ذاته، وهي موقف إيجابي من انحسار الدين في مجاله باعتباره دينا.
في الحداثة وحدها سميت هذه الصيرورة علمانية، أو علمنة بالمعنى الضيق للكلمة، لكنها كما يذهب بشارة جزء من صيرورة تاريخية تسبق الحداثة، هي عملية فصل المقدس عن الدنيوي التي مكنت من مجرد تعريف الدين بأنه مجال اجتماعي قائم بذاته، وهي بداية عملية تمايز صيرورة تاريخية طويلة تمتد إلى ما قبل تسميتها عملية علمنة. هي جملة تمايزات في مجالات المعرفة، وفي البنى الاجتماعية، والممارسة الاقتصادية، والعلمية، والسياسية، وهي تتخذ انعطافا حادا عشية العصر الذي نسميه الحداثة. ففي مرحلة ما قبل الحداثة كان المجال الديني يعرِّف سلبا كل ما هو غير ديني، لكن في الحداثة صار المجال العلماني يعرف المجال الديني أي يحدده. هذه ليست مواقف أو قرارات، بل عملية تطور تاريخي ما لبث أن ولدت الأيديولوجيا التي تبررها، والموقف الأيديولوجي والأخلاقي المعياري الذي يدعو إلى تحقيقها، بوعي وإرادة باعتبارها تقدما في تاريخ البشرية، وكذلك الأنموذج النظري الذي يفسرها.
يلح بشارة على التعامل مع العلمانية بوصفها عملية تمايز اجتماعي بنيوي، وتغير في أنماط الوعي كصيرورة تاريخية، تمر بها المجتمعات كافة. وطبيعة صيرورة العلمنة التي مرت بها المجتمعات هي التي تحدد، ليس طبيعة العلمانية التي تنتج فيها، وموقعها، ومدى هيمنتها كأيديولوجيا فحسب، بل طبيعة أنماط التدين أيضا.
كان التعبير عن هذه التحولات الكبرى يجري في إطار الظاهرة الدينية الشاملة، المتواشجة مع بقية الظواهر، وكلما تقلصت شمولية الظاهرة الدينية، نشأت أنماط من التعبير السياسي والاجتماعي خارجها. ويبدو لبشارة أن فصل الدين عن الدولة هو جزء من عملية نشوء الدولة البيروقراطية المنظمة، وتمايز المجتمع من الدولة واستقلاله النسبي عنها، ففي تجليات العلمانية في الحداثة، وحين يكون مقر الدين الرئيس هو المجتمع ، ينتشر وينحسر فيه لا في الدولة، فإنه يصبح بهذا المعنى واحدا من انتماءات الفرد في الحيز العام، وجزءا من الحريات العامة في الدولة، فيولّد تمايز المجتمع من الدولة، وتمايز الفرد من الجماعة، أنماطا مختلفة من التديّن، ومقاربات مختلفة للدين لم تكن معروفة مسبقا، كانتشار التدين الفردي والجماهيري، وينشأان في غياب الجماعة العضوية التي هي مهد للدين.
إن المجريات المؤدية إلى العلمنة بمعناها الضيق لا تتم بفصل الدين عن الدولة، بل بتحول الدولة إلى العنصر الأقوى في مركب دين/ دولة، بحيث تتحول العلاقة إلى صراع ينتهي إلى استخدام الدين، مؤسسة، وعقيدة، ورجال دين أيضا، في عملية تبرير الدولة، والاستخدام الأداتي له، وحتى الاستخدام المتبادل هو بحد ذاته نوع من التمايز.
في عالم حديث يُعرّف فيه الدين وتحدد حدوده لم يعد الدين الحالة الثقافية العامة التي يُعبَّر بوساطتها عن التغيرات الاجتماعية والسياسية، إذ تتولد في هذا العالم تعبيرات جديدة عن المقدس بأدوات جديدة غير دينية (روحية وفكرية وسياسية وفنية) تساهم في منح المعنى، ليواجه الدين خيار الانسحاب من هذه المجالات إلى حصونه الأخرى، لكنه يلعب فجأة، عند ولوج عملية العلمنة حقول المعنى هذه، دور الأيديولوجية الاجتماعية والسياسية، التي يتقاطع فيها أيضا الديني والعلماني، لكن لا تنشأ ديانات جديدة غير بديلة، وهذا أحد مؤشرات العلمنة.
العلمنة كصيرورة تاريخية واقعية، هي عملية تطور شهدتها المجتمعات الأوروبية، وغير الأوروبية، بصفتها عملية دَنْيَوَة للوعي والممارسة البشرية، تتمايز عبرها العناصر الدينية وغير الدينية، ويتم تحديدها ومأسستها. وهي عمليا كمفهوم، اسم لا نموذج تفسيري لعملية تطور إنسانية عامة على مستوى التاريخ الطويل في ما يتعلق بعلاقة السلطة الدينية بالسلطة السياسية، أو الدين بالدولة. هذه الصيرورة اتخذت في أوروبا شكلها الخاص الذي أنتج المفهوم، وبالمفهوم الأضيق الأكثر عينية وبالتالي، الأكثر قدرة على التفسير. وهي في منظور الوعي والثقافة مرحلة من تطور الوعي يفسر بموجبها موضوع التفكير، أكان في الطبيعة، أم في المجتمع، من ذاته، وبقوانينه، لا بقوى روحية خارجة عنه، وهي مرحلة في تطور المجتمع والدولة، يتقلص فيها الوزن الاجتماعي للدين، ويتحول فيها القرار الديني إلى قرار إيماني حر، حتى لو احتفظ الدين بتأثيره في المجال العمومي.
العلمانية بوصفها أيديولوجيا
بخصوص العلمانية كأيديولوجيا وموقف، يقترح بشارة استخدام تعبير “العلمانوية” لوصف أحد السياقات التي تدل عليها، وهو مذهبة العلمانية، أو الإيمان بها معتقديا، على نمط الإيمان شبه الديني.
تتقاطع العلمانوية مع الإلحاد، لكنها ليست إلحادا بحكم تعريفها، لكنها كموقف أيديولوجي تعني في تعريف دقيق لها، اتخاذ موقف سلبي من وجود الدين في الحيز العام، وعدم الاكتفاء بأن يكون الدين، والتدين، والإيمان، قرارات فردية، بل تذهب إلى خصخصة الدين كظاهرة، لا خصخصة القرار الفردي في الشأن الديني فحسب، والرقابة عليه، باعتبار تأثيره سلبيا ولا بد من ضبطه، ودفع الدولة إلى تبني موقف سلبي من التدين ومظاهره الاجتماعية (بما فيها السياسية)، لدفعه خارج الحيز العام.
يؤكد بشارة أن أنموذج (براديم) العلمنة لم يتحقق على شكل خصخصة الدين في أي مكان، إذ بقي الدين مهتما بالحيز العام، وأصبح الهدف الذي تصبو إليه العلمانية هو تحييد الدولة في الشأن الديني، أما الأيديولوجيا العلمانية (العلمانوية) التي بلغت حدود خصخصة الدين وحصره في المجال الفردي، فغالبا ما تعايشت مع أيديولوجيات شكلت أديانا علمانية بديلة، أو تحولت هي أيضا إلى أيديولوجيا تحارب الدين في الحيز العام، وتدعو إلى إقصائه، وطورت هي أيضا أساطيرها.
إن خصخصة تاريخية للدين لا تعني بالضرورة إبعاده عن الشأن العام فلم يكن الدين دائما قرارا فرديا، لكن تقاس علمنة المجتمعات بمدى تقلص وزن الدين السياسي، وتقلص تأثيره في وعي الناس وسلوكهم الاجتماعي. العلمنة صيرورة ليست مختصة بدين من الديانات بل عملية تمايز الوظائف الاجتماعية، وتوسطها بعلاقات تشكل الوحدة الاجتماعية والسياسية، وتجري في كافة المجتمعات، مع فارق في أنماطها وظروفها التاريخية، وهي كصيرورة تاريخية وكنموذج سوسيولوجي لا تقبل أي تنميط أيديولوجي نهائي لها.
تتعامى الدعاية الإلحادية الصارمة عن حقيقة أن الدين ليس مؤثرا باعتباره نظرية فيزيائية، أو كيميائية، أو كونية، تتمدد بين دقائق علم الوراثة حتى الفلك، بل هو مؤثر باعتباره مرجعية، وسلطة إيمانية، ومنظومة من التعويضات الرمزية، والروحية، والشعائر. ولم تنجح أي أيديولوجيا غير دينية حتى الآن في منافستها، والإتيان بمثل سطوتها على سلوك جماهير واسعة، وأحلامهم، وآمالهم، وفهمهم لذواتهم.
وبرأيه، أن أي أيديولوجيا علمانية منفتحة ونقدية ومتنورة فعلا، لا ترغب أصلا في مثل هذه المنافسة مع الدين، وإلا تحولت هي ذاتها إلى أيديولوجيا شمولية. ففي مجتمعات غربية، لم يجر التخلي على الدين بوساطة أيديولوجيا شمولية يعتنقها “مهاويس”، بل انحسر الدين من الهيمنة الفكرية الاجتماعية في مقابل العقلانية، الاختصاصية في مواضيعها، تضاف إليها تعددية هائلة لأنماط التعويض الفردي والجماعي، في مجالات فنية، وسياسية، وقيمية، وجمالية، وتقنية، ومعروضات وسلع روحية استهلاكية.
العلمانية اجتياح مسيحي، فماذا عن العلمنة؟
خضعت المجتمعات الغربية لصيرورة دَنْيَوَة الوعي والممارسة البشرية في سياق خاص، ناتج عن الثورة العلمية والصناعية، وتجلت الدنيوة في الفهم العلمي للعالم المحيط الذي يفسره بقوانينه الداخلية لا بالغيب، وبالتالي نشوء مقاربة فكرية في فهم ظواهر الدنيا بقوانينها، ونشوء الموقف العلماني في فهم العلاقة بين الدين والدولة.
مع التحولات المتتابعة التي اجتاحت أوروبا لم تعد الدولة ذراعا دنيوية للكنيسة، وتعلم الفاتيكان أنه من الأفضل أن يحظى هو بالحرية الدينية، ويتنازل عن توجيه سياسة الدولة، فكيّفت الكنيسة نفسها مع التعددية الدينية. وأُعلِنت الحرية الدينة في المجمّع الفاتيكاني الثاني 1965، ولم يعد النظام القديم من خلال علاقته الوثيقة بالكنيسة هو البديل من الديمقراطية، بل أنظمة شمولية لا سيما الشيوعية. تواءمت الكنيسة مع العلمانية والعلمنة كعملية نزع للقداسة عن أي شأن دنيوي، وأصبح إدراك العالم لعالميته، والدنيا لدنيويتها، من أهداف الكنيسة، فخلط القداسة بالدنيا يثير مخاوفها من قوى وأفكار دنيوية تنافس الدين.
يتفق بشارة مع المقاربة التي تحصر نشوء العلمانية بأوروبا، لكنه يرى بأن عملية العلمنة لا تقتصر عليها، وإذا كان من الضروري العودة إلى البحث في المسيحية اللاتينية، ولغتها، ولاهوتها لفهم العلمانية ونشأتها، فينبغي ألا نتوقف هنا، فمثلا حدث تطور لوعي سياسي خارج الدين باستمرار في الثقافة العربية الإسلامية عند الحكام، بدءا بعمر بن الخطاب، الذي غالبا ما وجد نفسه مضطرا إلى التفكير سياسيا من خلال مرجعية مصلحة الكيانية السياسية الوليدة، وتكييف النص المقدس غير المكتوب في مصحف بعد، أو حتى تجاهله في بعض الأحيان.
ينبّه بشارة إلى أن وجود مؤسسة دينية مبلورة وواضحة المعالم والحدود يسهل عملية ارتباطها وإخضاعها للدولة، حدث هذا في السياق التاريخي الأوروبي. لكن وبالرغم من مؤسسات دينية عديدة، افتقد الإسلام مؤسسةً هرميةً موحدةً، مما جعل المجتمعات الإسلامية مجتمعات أكثر دينية. بعثرة المؤسسة الدينة الإسلامية، وعدم وضوح شكلها، صعّب على الدولة تنظيم العلاقة معها ومأسستها، وصعّب بالتالي إخضاعها لها، مما جعل العلاقة بين المجال الشرعي والمجال السياسي يتسم بالتشابك، والاشتباك في وقت واحد.
علمانية لا علمانوية:
لتفادي تحول العلمانية إلى علمانوية، في مواجهة مجتمع متديّن، ومن أجل تحقيق حالة لا ينتهي فيها التحرر من الإكراه الديني إكراها علمانيا، يدعو بشارة لدراسة الأوضاع الاجتماعية، وتحديد ما ينتج عند شعب من الشعوب في مرحلة تاريخية معينة، حين ندرس العلاقة بين الدين والدولة والمجتمع السياسي، من زاوية نظر تلتقي فيه الإرادة للدفاع عن حرية المعتقد، مع منع الإكراه في الدين.
المسألة في أحد وجوهها يضعها بشارة في السياق التالي: كيف يمكن أن تلتقي المساواة بين الأفراد، وانبثاق شرعية الحكم من إرادة الشعب، مع عدم الإملاء في الشأن الديني، في الظروف الاجتماعية والسياسية السائدة المحددة، وبالاستفادة أيضا من التجارب الخاصة والعالمية بهذا الخصوص؟ هكذا يحدد شعب من الشعوب مصطلحه في العلمانية السياسية، كإدراك أيديولوجي فكري للحاجة إلى حياد الدولة في الشأن الديني، وعدم الإكراه في الدين، وظروفه المعطاة. هذا النوع من البحث يراه بشارة مفيدا، أكثر من الخلاف على معاني الكلمات التي تطورت وتبدلت عبر التاريخ.
العلمانية (سواء بفتح العين أو كسرها) في وصف علاقة الدين بالدولة، تعني في الحد الأدنى تحييد الدولة في شأن القرار الديني أو المذهبي، وفي الحد الأقصى تصورا أيديولوجيا لخصخصة القرار الديني، أي إخراج الدين من الحيز العام، والتحكم به أو فرض الرقابة عليه. لكنها كنظرة إلى العالم، لها معنى في أي حقل من حقول النشاط البشري، كتفكير وتقويم في هذا المجال المعين، بموجب قوانينه، التي يستنبطها العقل والتجربة الإنسانية، أو بموجب مجاله المعرفي الذي يميزه، دون خلط بين المجال المعرفي للأسطورة، والمجال المعرفي للعالم، وبالاستغناء عن إدخال المقدس، أو الأسطورة، أو توريطهما، أو الاستعانة بتفسير روحي، أو إلهي من خارج هذا المجال، من أجل تفسيره وفهمه وفهم قوانينه. وكلتاهما، العلمانية الفكرية والسياسية صيرورة، ونتاج صيرورة، مرت بها أنماط الوعي ومجالات المعرفة المختلفة، كما مر بها المجتمع، تجري فيها كلها عمليات تمفصل وتمايز لمجالات النشاط الإنساني والمعرفة بعضها من بعض، ومن المقدس.
العلمانية كمقاربة مؤلفة من مجموعة مواقف وتحليلات ظاهرة أوروبية، ولا بد من دراسة نشوئها لفهمها كظاهرة اجتماعية سياسية تاريخية، ولفهم إمكانية تنقلها عبر الثقافات، أما العلمنة فتطمح لأن تكون نظرية في تفسير تطور من زاوية محددة، هي زاوية علاقة الدين بأنماط الوعي، وعلاقة الدين بالدولة والمجتمع، وهي كنظرية لا تثبت ذاتها بالتبريرات، ولا تدحض المواقف الأيديولوجية المسبقة، وإنما تحاول تطبيقها على الصيرورات التي تطمح أن تفسرها، هذا هو اختبارها، وليس النقاشات السفسطائية في شأنها، وقد نستنتج فائدتها أو عدمها من مثل هذا الامتحان، وقد نستنتج أنها تشرح أمورا أخرى، وتغفل أخرى، ولا بد من تعديلها، أو تحديد أدق لشروط سريانها، فليس الحديث هنا عن نظرية فيزيائية.
مسؤولية مشتركة:
منذ الدولة العثمانية، مرورا بالحقبة الاستعمارية وبعدها، تعرضت المجتمعات الإسلامية لعملية تحديث مفروضة عليها من الخارج، في ظل انكشاف على الهيمنة الاقتصادية والعلمية الغربية. بدت تلك العملية تهديدا للثقافة القائمة، فخاضت تلك المجتمعات مسار التمسك بالحقيقة الدينية، عبر فصلها عن الاستنتاجات العلمية، والمقولات التاريخية، أو بوعي وظائف جديدة للدين، فأصبحت الحقيقة الدينية حسب بشارة قضية “هوية”، ومسألة تحديد للخصوصية الثقافية للذات، في إطار تعددية هوياتٍ وثقافاتٍ عالمية.
يلحظ بشارة أن ما يجمع الإسلاميين، المتطرفين وخصومهم على حد سواء، هو تجاهل واقع الإسلام في حقيقته الأنثروبولوجية، أي كما يمارسه المسلمون بشكل عيني. هؤلاء ينفون الشرعية الإسلامية عن الإسلام الواقعي، ويدّعون أنه ليس الإسلام الحقيقي الصالح، ويقفزون عنه إلى عقيدة أخرى غير الإسلام المعيش، الذي اصطلح عليه المسلمون. والآخرون (خصوم الإسلاميين)، يدّعون أنه من عناصر الفساد والتخلف، أو يدّعون أنه مجموعة خرافات وأباطيل، أو يقللون بالمجمل من أهميته، ويعتبرون تضخيمها أمرا مصطنعا. النتيجة العملية لذلك تمثلت في إهمال دراسة التدين الشعبي، والتدين عموما، في واقع المجتمعات الإسلامية، وفهم دوره الفعلي في المجتمع والأخلاق والسياسة. يحمّل بشارة مسؤولية هذا الإهمال، أصحاب الفكر الإسلامي وأصحاب الفكر العلماني على حد سواء.
***********
في “الدين والتدين” (ط1، بيروت: كانون الثاني/ يناير 2013) وهو عنوان الجزء الأول من كتاب “الدين والعلمانية في سياق تاريخي” الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يحاول عزمي بشارة أن يضع الدين في سياقاته التاريخية (عملية التحديث التي جرت وتجري، وشكلها ووظيفتها، لا سيما سياقات عملية العلمنة الجارية والتي جرت) تلك مهمة ضرورية لشرح العلمنة والعلمانية ووضعهما في سياقاتهما التاريخية.
في الجزء الثاني (ط1، بيروت: كانون الثاني/ يناير 2015)، وفي مجلده الأول “العلمانية والعلمنة: الصيرورة الفكرية” يعالج بشارة الصيرورة الفكرية والثقافية لنشوء العلمانية، من أصولها الأوروبية، عبر عملية تأريخ نقدي للأفكار، يعيد النظر في ما هو مألوف من مقاربتها حتى الآن، ولتقديم فهم مختلف لجدلية الدين والسياسة في التاريخ الأوروبي، وفهما أفضل لجذور التفكير العلماني، انطلاقا من السياق التاريخي.
أما في المجلد الثاني “العلمانية ونظرية العلمنة”، فيعالج نماذج تاريخية لعلاقة الدين بالدولة، بغية إجراء فحص نقدي معمق لنظريات العلمنة في علم الاجتماع، في ضوء هذه المعالجات لتاريخ الفكر والممارسة، محاولا إرساء أساس نظري لمناقشة الموضوع لاحقا في سياقات أخرى. ورغم أن هذا الجزء يحوي مقارنات مع سياقات عربية إسلامية حين اللزوم، إلا أن المُؤلِّف يطمح إلى تناول العلمنة في الإسلام (بمعنى تطور المجالين الديني والسياسي) في جزء ثالث منتظر.
المهمة الفكرية والتثقيفية للكتاب كما يحددها المؤلف، هي أن يتوصل القارئ النقدي، متدينا أم غير متدين، إلى قناعة مفادها، أن الدين ليس مجرد مجموعة من الأباطيل أو النظريات الخاطئة في فهم العالم، وأن العلمانية ليست عبارة عن نظرية علمية.
“الدين والعلمانية في سياق تاريخي” (في 1888 صفحة)، علاوة على كونه في المستوى المعرفي مرجعا مهما تحتاجه المكتبة العربية المعاصرة، هو كتاب تأسيسي على صعيد المنهج والأدوات المفهومية لسوسيولوجيا عربية في الدين والعلمانية.
عنوان الكتاب: الدين والعلمانية المؤلف: عزمي بشارة
ضفة ثالثة