الفكر كضحية للنخب التقليدية: قراءة أوّلية في عصور ما قبل الحداثة
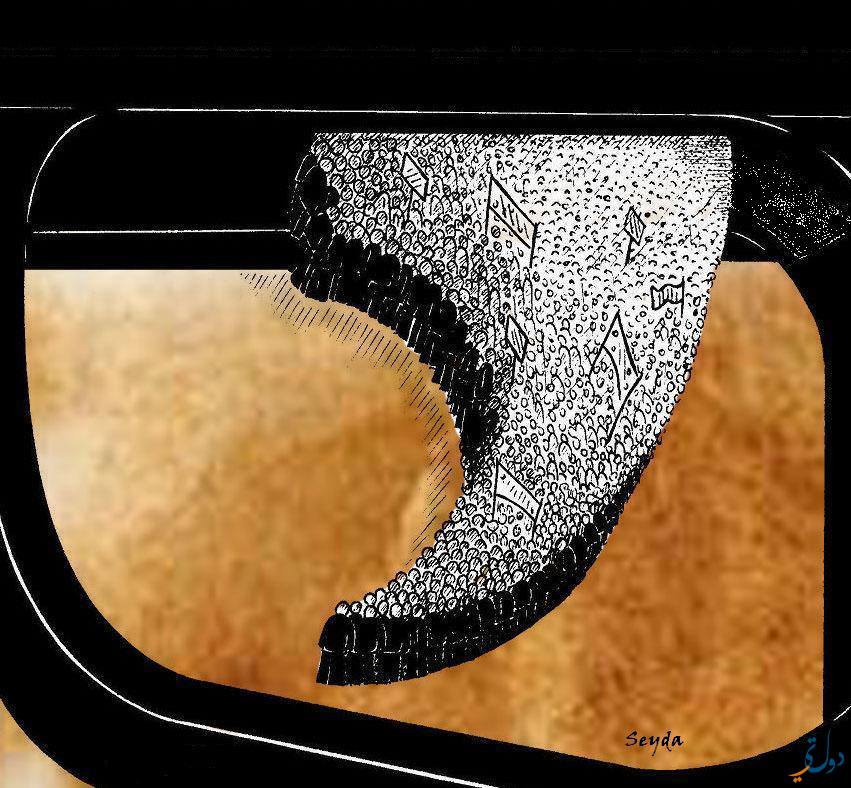
طلال المَيْهَني()
تَحْوي المكتبة الوطنية في باريس نسخةً نادرةً من مقامات الحريري تم تحريرها، في القرن الثالث عشر للميلاد، بعد أن زُيِّنَتْ بما يقرب من مِئَةِ لوحةٍ مُنَمْنَمَةٍ أبْدَعَها الرسام العبّاسي يحيى بن محمود بن يحيى الوَاسِطِيّ. ونَقَعُ في هذه المخطوطة البديعة، والفريدة من نوعها، على صحيفةٍ تُصَوِّرُ مشهداً لمجموعةٍ من الأشخاص الجالسين، وهم يناقشون شؤوناً فكريةً، في واحدةٍ من مدارس/مكتبات البصرة.
وفي شكلٍ مُوَازٍ تقدِّمُ الجِدَارِيَّة الجصِّيَّة “مدرسة أثينا” للفنان الإيطالي “رفائيل Raphael” (ت. 1520 م)، والمُعَلَّقة في “غرفة التواقيع الرسولية Stanza della Segnatura” في الفاتيكان، تصويراً مُتَخَيَّلاً لمراكز النقاش الفكري في العصر الإغريقي: أكاديمية أفلاطون (نسبةً إلى أكاديموس البطل)، وليسيوم أرسطو (نسبةً إلى الإله أبولو وِفْقَ تقليد الليسيوس).
وفي حين لا يُفْصِحُ الوَاسِطِيُّ عن هويات واهتمامات الشخصيات المرسومة في المخطوطة، يَنْبَرِي رفائيل إلى تصوير مجموعةٍ من أعلام الفكر الكلاسيكي يختلط فيها الفيلسوف والنبي والبطل وفنان البلاط البابوي: أفلاطون، أرسطو، هيراقليطس، زارادشت، الإسكندر المقدوني، إضافةً إلى رفائيل نفسه، وغيرهم.
وعلى رغم الاختلاف في الزمان والمكان والثقافة والمدرسة الفنية، إلا أن ما يجْمع الجدارية الفاتيكانية مع المُنَمْنَمَةِ العراقية، هو ذلك التلازم اللافت بين الاشتغال الفكري (وما يدلُّ عليه من أقلامٍ وأوراقٍ وكتب)، وبين مظاهر الأُبَّهَة والبذخ في الملابس والزخرفة والنمط المعماري، مع تَفَرُّدٍ صارخٍ للعنصر الذكوري الذي يتجلَّى من خلال اللِّحى المُشَذَّبة (وكأن الفكر والمرأة لا يجتمعان). ويشير ما سبق إلى الخلفية النخبوية المُرَفَّهة والذكورية والتقليدية للشخصيات المرسومة، كما أن عناصر المكان، والملامح البارزة في المشهد التصويري المعروض، توحي بارتباطٍ مع النخبوية الدينية المقدسة الغَيْبِيَّة. ويتكرر مثل هذا التلازم اللافت، على مستوى الأعمال الفنية على مَرِّ التاريخ القديم، كانعكاسٍ للتلازم التقليدي بين الفكر والنخبوية (بالمعنى الإقصائي والمحدود) على مستوى الثقافات السائدة في عصور ما قبل الحداثة.
تؤكد الميثولوجيا على هذا التلازم بين الفكر والنخبوية خاصةً في صيغتها المُتَعَالِيَةِ المقدسة؛ حيث يُعْتَبَرُ كُلٌّ من “توت Thoth” الفرعوني، و”هرمس Hermes” الإغريقي، و”ميركوري” الروماني، و”نابو Nabu” الآشوري، و”الكتبي” (الكلمة مشتقة من فعل كتب) عند عرب الأنباط آلهةً خاصةً بالمعرفة والفكر والكتابة والمال والتجارة في ثقافاتٍ عريقةٍ وقديمة. وفي مرحلةٍ موازية ولاحقةٍ تعتبر الأساطير والأخبار المضطربة والمرتبطة بزراداشت وفيثاغورس وغيرهم امتداداً للسردية الهرمسية؛ نسبةً إلى “هرمس مُثَلَّث العَظَمَة Hermes Trismegistus” (وهو مزيجٌ لاحقٌ من الإله الفرعوني توت والإغريقي هرمس، مع حضورٍ عربيٍّ/عبرانيٍّ باسم النبي إدريس/أخنوخ/إينوخ). ويؤكد هذا الإرث على قداسة المعرفة، وعلى حَصْرالاشتغال الفكري بها من قبل شخصٍ يوصف بأنه نبيٌّ أو فيلسوفٌ أو عالمٌ أو حكيمٌ أو عارفٌ أو طبيبٌ أو ساحرٌ (وأحياناً تغيب الحدود بين هذه الصفات). حيث يُمَثِّلُ النبي/الرسول، على سبيل المثال، حالةً خاصةً من التواصل الذي يُحْتَفَى به بين الغيبي السماوي المقدس وبين الأرضي المُعَاش والمحسوس، كما في الوصايا التي دُوِّنَتْ على ألواح النبي موسى، وحكمة النبي داوود والنبي سليمان، أو الكتب السماوية (الكلمة) التي أوحِيَ بها إلى الأنبياء.
وقد أخذ هذا التلازم الميثولوجي والغيبي، بين الفكر والنخبوية، إسقاطاً بشرياً مُجْتَمَعِيّاً على مستوى الواقع المُعَاش في عصور ما قبل الحداثة. ولكن، وعلى الخلاف من الغاية المُفْتَرَضَةِ للنبوّة في النشر المَشَاعِيِّ للمعرفة (محلياً أو عالمياً)، فقد تَبَلْوَرَتْ “نخبٌ” (هي امتدادٌ لنُخَبٍ كانت أصلاً في مواقع السيطرة) وتسلّقت واحْتَكَرَتْ القوة والسلطة والقوامة على الناس، باسم الدين وباسم المعرفة والفكر. وتدعو هذه الظاهرة إلى وقفةِ تأملٍ؛ فمنذ انتقال الإنسان من مرحلة الجمع والالتقاط إلى مرحلة الاستيطان والزراعة ونشوء الدول الأولى، ومع بواكير التاريخ المُدَوَّن والأديان المُنَظَّمَة، وحتى نهاية العصور الوسطى كانت المعرفة، بأنماطها المختلفة، وبما يَتَّصِلُ بها من اشتغالٍ فكريٍّ (وبغضِّ النظر عن عُمْقِهِ وعن مدى عقلانيته)، مُقْتَصِرَةً على “النخب التقليدية”: النخب الدينية، والنخب السلطوية، والنخب الأهلية، والنخب ذات الثروة ورؤوس الأموال.
إذ تدّعي النخب الدينية، المُتَمَثِّلَة في شخصية الساحر والماجوس Magus والشامان والكاهن ورجل الدين وغيرهم، النيابة المباشرة عن الغَيْبي المُقَدَّس والتحدث باسم الرب، أو القدرة على التواصل مع هذا الغيبي المقدس أو مع ما وراء الطبيعي (معرفة الغيْب، ممارسة الكرامات، السيطرة على ظواهر الطبيعة، استحضار الأرواح والجن). أما النخب السلطوية، ومن يتبعها أو يرتبط بها من الجند والديماغوجيين، فقد نَصَّبَتْ نفسها كآلهةٍ جديدةٍ في الأرض يُحَرَّمُ الخروج عليها أو عصيانها. يضاف إلى ذلك النخب الأهلية كالزعامات القبلية والعشائرية والوجاهات العائلية، والأغنياء من أصحاب الثروة ورؤوس الأموال، أو من ارتبط بالبلاط السلطوي، أو حَظِيَ برعايةٍ من قِبَلِ المتنفذين وأصحاب السَّطْوَة.
وغالباً ما تتقاطع مصالح هذه “النخب التقليدية” مع بعضها لتخلق شبكةً معقدةً من توازنات القوة التي يصعب تفكيكها، حتى أنها قد تتماهى مع بعضها ليغدو الحاكم التقليدي، على سبيل المثال، معادلاً للإله (كما في الفرعون) أو للكاهن الأكبر (كما في الإمبراطور البيزنطي)، هذا عدا عن أن الحاكم التقليدي هو الأكثر ثراءً وقوةً وسطوةً إلخ. وقد يغدو الوجيه العائلي، صاحب النفوذ والمال، ذا أصولٍ مقدسة (كما في أشراف وأسياد أهل البيت في الفكر الإسلامي، والبراهمة عند الهندوس إلخ) ولهذا يصعب الحديث في شكلٍ مستقلٍ عن نمطٍ من أنماط “النخب التقليدية” دون التطَرُّق إلى تشابك مصالحها مع الأنماط الأخرى.
وقد ترك ذلك آثاره في المجتمعات وعلى مستوياتٍ عدّة. فعلى مستوى اللغة دَأَبَتِ “النخب التقليدية” في بعض الثقافات إلى فرض حالةٍ من “الفصام اللغوي” كانعكاسٍ للطبقية والتمايز النخبوي. ففي سياق الاشتغال الفكري يتم توظيف لغاتٍ نخبويةٍ تختلف عن لغات العامة، كاللغة الرسمية في الصينية واليابانية القديمة، والسنسكريتية في الهند، والفهلوية في بلاد فارس، واللاتينية في أوروبة. وبالتوازي تمكن مقاربة العربية الفصحى (القرشية) كمثالٍ في منطقتنا على هذه النخبوية اللغوية التي تَرَسَّخَت في المراحل المبكرة من تطور الفكر الإسلامي. كما أن ممارسة الكتابة والقراءة بحدِّ ذاتها غَدَتْ أعمالاً ونشاطاتٍ تشتمل على نخبويةٍ وقداسة، وصفةً ملازمةً “للنخب التقليدية” التي لا يمكن للعامة أن تَتَحَلَّى بها. وعلى المستوى الطَبَقِي شاع في مجتمعات ما قبل الحداثة تقسيمها، رسمياً، إلى طبقات الكهنة والفرسان والنبلاء مقابل ما تبقّى من عامة الشعب، وتعتبر المجتمعات الهندوسية مثالاً معاصراً على استمرار هذا التقسيم الطبقي المتماهي مع المقدس. أما على مستوى الحكم فقد تُرْجِمَتْ مصالح “النخب التقليدية” في أنظمةٍ مختلفةٍ تحت عنوان “حكم القِلَّة oligarchy”: بلوتوقراطية (حكم الأغنياء)، وأرستوقراطية (حكم النبلاء)، وستراتوقراطية (حكومة عسكرية: حكم العسكر وِفْقَ صيغٍ قانونية)، وتيموقراطية (حكم الأشراف والوجهاء)، والديكتاتورية (حكم الفرد). وتسعى جميع أنظمة الحكم المذكورة، على المستوى العملي، إلى تركيز القوة في يد شريحةٍ صغيرةٍ ومحدودةٍ من المجتمع، على حساب “الشعب” الذي يُحْرَصُ على إبقائه في حالةٍ من الجهل والبؤس بما يكفل سهولة السيطرة عليه. وحتى الديموقراطية الإغريقية، التي يتم التغنّي بها، لم تكن في منأىً من سطوة “النخب التقليدية”: إذ كانت ديموقراطية أثينا متاحةً فقط للذكور البالغين من حاملي الجنسية الأثينية (وهذا متعلقٌ بمُلْكِيّة الأراضي والعبيد)، مع حرمان النساء، والعبيد، والفقراء من أيِّ مساهمةٍ في صناعة القرار.
لقد فَرَضَتْ هذه “النخب التقليدية” نفسها في هذه الأرض، واعتادتْ احتكار الفكر، والتعامل معه كأداةٍ للتمايز والتكبُّر، أو كوسيلةٍ لتكثيف القوة العنفية والروحية، أو كترسيخٍ لبنيةٍ تقليديةٍ هرميّةٍ تحتل وفقها هذه النخب موقعاً مُتَعَالِياً وثابتاً. وكان هذا الاحتكار علامةً فارقةً على مَرِّ العصور، وأداةً تسمح بكتابة التاريخ وفقاً لأهواء “النخب التقليدية” (ومن هنا تنبع أهمية التحليل الدقيق السياقي والتفكيكي لما وصلنا من كتاباتٍ تاريخية). وقد شكّل هذا الاحتكار مَلْمَحاً من ملامح “التوجه المضاد للفكر” في عصور ما قبل الحداثة.
فقد حرصت النخب الدينية على تفسير المعرفة والفكر ضمن شروطٍ صارمةٍ تنبع من قراءةٍ (أو بالأحرى قراءاتٍ) إيمانيةٍ معينة أو من مصالح متقاطعةٍ، في شكل مباشر أو غير مباشر، مع مصالح النخب السلطوية وغيرها. فعلى سبيل المثال يُنْسَبُ إلى أحد كبار اللاهوتيين الأوائل، ومستشار الإمبراطور قسطنطين الأول، “لاكتاتنتيوس Lactantius” (ت. 320 م) قوله: “ما الغاية من المعرفة؟ ما الفائدة من معرفة منبع النيل؟ وما فائدة ما يبحث فيه العلماء تحت قُبَّةِ هذه السماء؟”. وتدعم هذا “التوجه المضاد للفكر” قراءاتٌ تأويليةٌ لمَلْحَمَةِ الخليقة، حسب سفر التكوين في العهد القديم؛ حيث يُطْرَدُ آدم من الجنة لأكله من شجرة المعرفة، في مقايضةٍ رمزيةٍ بين خلود الانصياع، وشقاء العقل المفارق للإله والدال عليه في ذات الوقت. لكن مثل هذه القراءات تتناقض مع حقيقة أن المعرفة هِبَةٌ من الهِبَاتِ السبعة للروح القدس وِفْقَ التعاليم المسيحية.
ومع أن القرآن الكريم لا يربط بين الشجرة المُحَرَّمَة وبين المعرفة أو الاشتغال الفكري، ومع أن آدم، قد عُلِّمَ الأسماء كلها، وأن “اقرأ” كانت أول ما نزل من القرآن على النبي محمد (حسب بعض الروايات)، فإن كل ذلك لم يمنع من يدّعي النطق باسم الدين الإسلامي من تحريم صنوفٍ من المعرفة أو تحديد نطاق الاشتغال الفكري أو الترويج لـ “توجهٍ مضادٍ للفكر”. نجد ذلك في قمع المعتزلة وازدراء الفلسفة، في حملةٍ تراكميةٍ تُوِّجَتْ بكتاب “تهافت الفلاسفة” للغزالي (ت. 1111 م)؛ حملةٌ لم يستطع “تهافت التهافت” لابن رشد (ت. 1198 م) أن يمحو آثارها التي اخْتُصِرَتْ في الثقافة السائدة، وبكل أسفٍ، في عبارةٍ إقصائيةٍ ومُطْلَقَةٍ مَفَادُها: “من تَفَلْسَفَ فقد تَمَنْطَقَ، ومن تَمَنْطَقَ فقد تَزَنْدَقَ”. وإمعاناً في تمايز النخب الدينية فقد تم تصنيف المعرفة والاشتغال الفكري إلى علومٍ دينيةٍ مَرْمُوقَةٍ، وعلومٍ دنيويةٍ يتم اعتبارها كعلومٍ من الدرجة الثانية. يضاف إلى ذلك أن أصناف العلوم، ونتيجةً للتبادل الثقافي عبر قرون، انقسمت إلى علم الظاهر وعلم الباطن “المَضْنُون به على غير أهله” (وهو عنوان كتابٍ منسوبٍ، للمفارقة، إلى الغزالي)، ما زاد من ترسيخ البعد النخبوي للمعرفة والاشتغال الفكري.
ولم تكن مواقف النخب الأهلية وأصحاب الثروة بأحسن حالاً، خصوصاً وأن هذه النخب كانت مُولَعَةً بالحفاظ على امتيازاتها، وعلى المنظومة القائمة المستندة أساساً إلى عدم المساواة بين البشر، وفي حاجةٍ دائمةٍ إلى العبيد والسخرة واليد العاملة الرخيصة؛ وهل هناك ما هو أفضل من استمرار الجهل والفقر لضمان استغلال الجموع من قِبَلِ هذه النخب؟ أليس تحييدُ “الشعب” عن فُرَصِ اكتساب المعرفة والاشتغال الفكري كفيلاً بتحقيق مآرب هذه النخب؟
وقد تجلّى هذا التحييد في ممارساتٍ (مستمرةٍ حتى يومنا) سُمِّيَتْ بـ “الغموض المقصود obscurantism”؛ حيث يتم، وفي شكلٍ ممنهج، مَنْعُ المعرفة أو عرقلة وصولها إلى “الشعب”، أو كتابة النصوص الفكرية بأسلوبٍ مُبْهَمٍ ومُوَارِب ما يجعل فهمها مُتاحاً لقلةٍ من الناس. نجد مثل هذا “الغموض المقصود” في شريحةٍ هامةٍ من آثار العصور الوسطى: كما في أفكار الغنوص والهرمسية والأفلاطونية المُحْدَثَة والتصوف، وبعض ما ينسب إلى فيثاغورس، وجابر بن حيان، وجعفر الصادق، والكندي، وابن وحشية، وبعض كتابات الفارابي وأخوان الصفا، والفلسفة المشرقية للرازي وابن سينا، وبعض كتابات فرانسيس دي أسيزي، وألبرتوس الكبير، وروجر بيكون، وناحمانيديس، وأبراهام أبوالعافيا، وغيرها مما يندرج في باب “الروحانيات mysticism” مثل “المعارف الباطنة esotericism”، وما دُوِّنَ في كُتُبِ السِّحر والطلاسم (كُتُب الغريموار grimoire). وعلى الأرجح فقد سَبَقَتْ هذه الممارسات (وتَلَتْ) أفلاطون الذي أدْخَلَ، في نطاق النخب السلطوية، ما يُسَمَّى بمفهوم “الكذبة النبيلة noble lie” (باليونانية: gennaion pseudos)؛ الكذبة التي يمارسها الحاكم لترسيخ الأمر الواقع وإعطائه بُعْداً تبريرياً، بكل ما يحويه هذا الأمر الواقع من لاعدالةٍ ولامساواة. ويُمَهِّدُ ما سبق الدرب إلى تدشين الاستبداد وتنصيب الحاكم الطاغية، ويكفل استمرار التمايز الاستعلائي والطبقي بين “النخب التقليدية” المُحْتَكِرَة للفكر والقوة، وبين “الشعب” الذي نادراً ما كان في حالةٍ تسمح له باكتساب المعرفة على نطاقٍ واسع، أو المساهمة في الإنتاج الفكري، أو الاهتمام بهذه القضايا بالأساس، ما جعله غارقاً في حلقةٍ مُفْرَغَةٍ من الضعف والجهل.
طبعاً لم يكن لدى النخب الدينية والأهلية وغيرها القدرة على فرض رؤيتها الصارمة، والتحكم بالمعرفة والاشتغال الفكري، أو الترويج “للتوجه المضاد للفكر” في السنوات الأولى من المسيحية والإسلام، وذلك بسبب عدم اكتمال عملية التزاوج مع السلطات الحاكمة، وعدم تَجَذُّر ملامح وقواعد ما سَيُعْتَبَرُ، في مرحلةٍ لاحقةٍ، فكراً قويماً (أرثوذوكسياً)، في مواجهة الأفكار التي سَتُعْتَبَر مُنْحَرِفَةً عن جادة الصواب. بالإضافة إلى أن التزاوج بين مصالح “النخب التقليدية”، والحاجة إلى قوةٍ عنفيةٍ لفرض أو قمع رؤىً معينة، ما كان ليتم دون وجود نخبٍ سلطويةٍ قادرةٍ على، أو مهتمةٍ بممارسة العنف على نطاقٍ واسع (لا بُدَّ من تخصيص مقالٍ منفصلٍ لمناقشة القمع العنفي للفكر وللمشتغلين بالفكر عن طريق الاضطهاد الممنهج والتصفية الجسدية). وربما كان لهذه العوامل، أي ضعف “النخب التقليدية” وعدم قدرتها على ممارسة الهَيْمَنَةِ المُطْلَقَةِ في بعض المراحل التاريخية، دورٌ في إعطاء الإبداع الفكري دفعةً هامةً وملحوظةً في القرون الأولى للمسيحية والإسلام.
وعملياً تشكّلُ التقاطعات بين مصالح “النخب التقليدية”، التي قد تتوافق أو تتناقض، أو تُرَوِّجُ أو تُعَادِي مواقف فكرية معينة، مَلْمَحاً آخر من ملامح “التوجه المضاد للفكر”: إذ غالباً ما كان الاشتغال الفكري، المدعوم رسمياً في عصور ما قبل الحداثة، انعكاساً لتنافسٍ سياسيٍّ/دينيٍّ بين “النخب التقليدية” السلطوية/الدينية/الأهلية، أو مُوَجَّهاً لتمجيد حاكمٍ أو أمير أو مُحْسِن كبير. ففي منطقتنا، على سبيل المثال، كان “بيت الحكمة” في بغداد الذراع الفكري للخلافة العباسية، يقابله “دار الحكمة” في القاهرة التي كانت في عُهْدَةِ الخلافة الفاطمية. الأمر ذاته نراه في التنافس بين مختلف المدارس الفلسفية، منذ العصر الهلنستي، كانعكاسٍ للتنافس بين خلفاء الإسكندر المقدوني: السلوقيون، والبطالمة، والمقدونيون، أو بين الإمبراطورية الرومانية الشرقية (البيزنطية) في القسطنطينية، والغربية في روما (وخليفتها الإمبراطورية الرومانية المقدسة).
لقد تَقَاطَعَتِ القراءات والمدارس الفكرية المختلفة والمتنافسة مع طموحات وأمزجة ومُيُولِ الحُكَّام، واخْتَلَطَت مع أقنعةٍ دينيةٍ ومذهبيةٍ وعرقيةٍ وإثنية، مع ميلٍ إلى تصفية بعضها البعض إمّا عن طريق المجادلة، أو عبر اتّباع الطرق العنفية بعد التحالف مع النخب السلطوية القائمة. ويمكن تتبّع الخلاف على المعرفة والاشتغال الفكري، في الفكر الديني الإسلامي مثلاً، في مدرسة أهل الرأي التي مالَتْ إلى إعطاء دورٍ أكبر للعقل في استنباط الأحكام الفقهية مقارنةً، مع ما بَاتَ يُعْرَف، بمدرسة أهل الحديث. ويُمَثِّلُ المعتزلة حالةً فريدةً في إيلاء أهميةٍ مركزيةٍ للعقل يتجاوز النص، حسب بعض التفسيرات، كَوْنَ النص لا يمكن إِدْرَاكُهُ أصلاً إلا من خلال العقل وقد وصل أبو الحسن الأشعري (ت. 936 م) إلى صيغةٍ توفيقيةٍ وسطى، لحلِّ هذه المُعْضِلَةِ، تُرَسِّخُ الموقع المركزي للنص، وتُعْلِي من شأن العقل لحدٍّ ما. من المهم التنويه إلى أن مثل هذا الخلافات، التي تأخذ في الغالب بعداً إقصائياً يُلْغِي الآخر، موجودةٌ في مختلف مدارس الفكر الديني في المسيحية واليهودية والهندوسية والبوذية وغيرها، مع تقاطعاتٍ ملحوظةٍ مع مختلف أنماط “النخب التقليدية”.
وعليه، وعبر الترويج “للتوجه المضاد للفكر”، وَقَعَ الفكر ضحيةً “للنخب التقليدية” في عصور ما قبل الحداثة. مع التأكيد على أن هذا “التوجه المضاد للفكر” كان محصوراً في دوائر هذه النخب، كنتيجةٍ مباشرةٍ لممارساتها: بسبب التصادم بين مصالحها، و/أو التصادم بينها وبين تطورات النشاط والإبداع البشري ودعوات التغيير التي تهدد الواقع القائم.
وضمن هذا الوضع الهَرَمِيّ الجامد، في عصور ما قبل الحداثة، كان من الصعب على “النخب الفكرية” أن تَتَشَكَّل (كما يحدث في العصر الراهن) كَشَرِيحَةٍ مهمةٍ في مجتمعاتها المُسَيْطَر عليها من قبل “النخب التقليدية”. وإن حَدَثَ وتشكّلتْ مثلُ هذه النخب فإنها قلّما تكون حرّةً أو مستقلةً أو قابلةً للنضج والديمومة، بل غالباً ما تكون منتميةً أصلاً إلى “النخب التقليدية”، أو متماهيةً معها على الأقل: عبر الارتهان لرؤيةٍ إيديولوجيةٍ مُسْبَقَة، أو عبر كونها محسوبة على بلاطٍ أو أميرٍ أو صاحب نفوذٍ ممن يملك المال والقوة والرغبة بتوفير أداوت الاشتغال الفكري من مخطوطاتٍ ومكتباتٍ ومأوى وأعطياتٍ وغيرها (كانت المخطوطات، التي اشْتُهِرَ الرهبان والورّاقون بنسخها، باهظة الثمن وغير متوفرةٍ على نطاقٍ واسعٍ، على خلاف الكتاب المطبوع).
لكن هذا الوضع الجامد الذي سَادَ في عصور ما قبل الحداثة قد بدأ بالتغير، عملياً، مع رياح النهضة والتنوير التي كَسَرَتْ حالة الركود، وجَلَبَتْ معها تبدلاتٍ عميقةً كان لها أكبر الأثر في رسم مَعَالِمِ العصر الحديث الذي نعيش فيه: من خلال خلق شرائح مجتمعيةٍ واقتصاديةٍ وفكريةٍ جديدةٍ تنافس “النخب التقليدية”، وتُجْبِرُها على إعادة ترتيب مواقعها في سبيل استعادة زمام سيطرتها على المعرفة والفكر، وذلك في سيرورةٍ مُعَقَّدَةٍ وغير متجانسةٍ يمكن التطَرُّق إليها في مقالٍ منفصل.
() كاتب سوري
المستقبل




