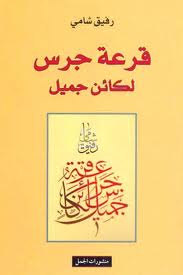القراءة وعي العقل وعقل الوعي/ محمد صابر عبيد
تندرج علاقة الوعي بالعقل وعلاقة العقل بالوعي في إطار التمثّلات الفلسفية التي ترمي إلى تدعيم موقف العقل من الأشياء، وتسليحه بعمق الرؤية وسعة التواصل والتفاعل مع الخارج، وهو ما يقود إلى السعي نحو اكتشاف مساحات جديدة لتطوير بنية العقل من الداخل، ودفعه لاحتواء المعلومة والقيمة والفكرة لتشغيلها على مستوى الفعل والسلوك والإنتاج بمختلف أشكاله وتصوراته.
تعرّض العقل العربيّ – في العصر الحديث خصوصاً – لمزيد من التحليل والتفكيك والنقد (وربما الاستهانة) في قراءة مضادّة من طرف أعدائه التقليديين وغير التقليديين أيضاً، وسعت هذه القراءة المضادة بقصدية واضحة إلى الخروج باستنتاج عام يقضي بسلبية هذا العقل وعجزه واتكاليته، لأنه ينهض في تقديرهم على أسس بنائية هشة، لا تأخذ بأسباب الحضارة الحديثة ومقولاتها الفكرية والفلسفية المتقدمة.
لعلّ من أولى الأسس وأهمها التي اعتمدها الآخر ذريعةً لتهميش العقل العربيّ والحطّ من قدراته الحضارية، ذلك الوصف الذي طالما وُصف به الشعب العربيّ منذ أن تفتّحت أولى بواكير الصراع في المشهد التاريخيّ الحديث والمعاصر إقليمياً ودولياً، وهو أنّ الشعب العربيّ أمّي لا يقرأ، تأكيداً واضحاً وصريحاً على حضور القراءة وفاعليتها وخطورتها في صوغ الوجه الحضاري للشعوب والأمم.
لذا فإنّ كلّ تقنيات الحرب الفكرية والثقافية الحديثة التي يشنّها “الآخر”، بمختلف أشكاله وألوانه واتجاهاته على منطقة العقل العربيّ بحلمه وذاكرته وذوقه، تستهدف أولاً عزله عن فضاء القراءة وتقليل فرص اتصاله بها قدر المستطاع، عبر إدخاله في متاهات من الأزمات والمشكلات واللعب والإغراء، وإجهاده باليوميّ والهامشيّ والثانويّ والتافه، وسحبه إلى مناطق ملغومة بالمطبّات والألغام ومصائد المغفلين، تستنفد كامل وقته وجهده وإمكاناته، بحيث يصبح التفكير في القراءة عنده شبه مستحيل، وهنا يتحقق للآخر انتصار لا تحققه أعظم أسلحة الدمار الشامل وأحدثها.
في حدود منهج هذه الدراسة ومقتضياتها الثقافية والرؤيوية، لسنا معنيين تماماً بتقويم هذه الحرب ونتائجها، ووعي “العقل العربيّ الحديث” المتأخر بها، بقدر ما افترضناه مدخلاً للحوار مع منظومة الأفكار المترشّحة من العنوان، وهو يطرح أسئلته ويزاوج بين مفرداتها بتداخل نظري – جدلي، يجعل من مهمة النظر فيه ومعالجته موضوعاً حضارياً مرناً، قابلاً باستمرار لمزيد من الحوار والجدل والإنتاج.
تحريض
القراءة في أولى صورها تحريض منطقة معينة من مناطق الجسد على جلب المتعة، بقيام الفاعل البصريّ بالمرور على المحفور الذي يتركه سواد الكتابة على بياض الورقة، واستدراج محمولاته وإغوائها، ونقل اللذّة المتحصّلة من ذلك إلى ما هو معنيّ من طبقات الجسد، وتعبئة الذهن بطاقة تنظيم هذه الفاعلية وترسيبها في مشهده وإضافتها إلى مكنزه الخبرويّ.
القراءة برنامج حياة يخلق تواصلاً حيّاً مع المقروء، ويمتدّ في الزمن بلا حدود لأنه خرق للزمان والمكان معاً، وتقدم في تفاصيلها الحسابية الأكاديمية المعلومات بمختلف صنوفها وأشكالها ومحطاتها لتضيف إلى التخزين خبرة أخرى تحرّكه وتعيد إنتاجه بدلالة الوافد الجديد، وتوسّع من نطاق التجربة وتضعها على أعتاب استشراف أكثر امتداداً وانفتاحاً. كما أنها تعيد ترتيب الأفكار وتهندسها على نحو يجعلها أعمق وأدق وأنشط، يساعدها في ولوج آفاق أخرى مختلفة تساهم مساهمة عالية في تهذيب اللسان والسلوك. تعمل القراءة على صعيد تشكيل لسان القارئ، على بعث لغته والارتفاع بتعبيره وتحديث أسلوبه بما يخلق لديه سياقات في التفكير الصحيح، وتنشئ مساحة واسعة للتأمل ومرآة كثيفة تضاعف إحساس الفرد بالأشياء على نحو يحقق تعادلية فنية موضوعية بين الداخل والخارج.
إنّ النشاط في القراءة يحيل على العقل، ويمرّن العواطف على الارتفاع بوجودها على مستوى التفاعل كي تتخلص من سذاجتها وسطحيتها وتقييد انفلاتها وانسياحها. إنّ الفاعل القرائيّ حين يتدخل في فضاء القارئ يعزله عن التهويل والمبالغة ويتجاوز مناطق القبح إلى مناطق الجمال، ويدفع إنسان القراءة إلى الإقبال على الحياة وترصين استعداده للمواجهة والجدل، فضلاً عن تحصينه ومضاعفة إيمانه، حيث يكفّ عن كونه مجرد رقم يضاف إلى سلسلة أرقام، ويتحوّل إلى صاحب مشروع إنساني فاعل.
إنّ استناد القراءة إلى عامل الوعي يفترض إجراء قياس وتقويم لتجربة كلّ قراءة، يخلصان إلى تمرين العقل القرائيّ وتدريبه على حسّ الانتخاب والاختبار، حفاظاً على عنصر الزمن في المعادلة، والانتقال من منطقة القراءة الصافية إلى القراءة البحثية، أي حضّه على التدرّج في الارتفاع عمودياً في سلّم التلقي نحو ما هو أخصب وأكثر دينامية، في السبيل إلى اكتشاف القراءة العميقة – القراءة النموذجية. وهي تسهّل إعادة الإنتاج لفضاء المقروء ومساءلته ومحاكمته والتدقيق في أطروحاته ومقولاته وإشكالياته، ومن ثم اقتراح نتيجة قرائية واضحة بإزاء المقروء على النحو الذي يقودنا إلى الزعم بقراءة فاعلة منتجة.
بهذا المعنى تتخلّص القراءة من محدوديتها المفهومية لتكون مشروعاً قرائياً، وكلّ تجربة قراءة تشتغل داخل المشروع القرائيّ العام بأكثر من آليّة، فهي إمّا أن تلغي ما تجده لم يعد صالحاً أو استنفد صلاحيته النظرية والفكرية، وإمّا أن تعدّل ما تجده بحاجة إلى تطوير ما في بعض حلقاته بالمستوى الذي يناسب الرؤية الجديدة التي أفرزتها القراءة الراهنة، وإمّا إنها تضيف جديداً إلى المتراكم الخبروي الفكري المتحصّل سابقا. وحتى يأخذ الوعي دوره الأصيل في تجربة القراءة وتوجيه ممكناتها، يدفع كلّ قراءة لاحقة – وبفعل حضور الوعي – إلى مرحلة أدق وأعمق من سابقتها، وهو ما يجعلنا بعد ذلك نؤمن بحركية القراءة وجدليتها.
تعدّ الثقافة المنتج الملموس والإفراز الأهم لوعي القراءة، من الموضوعات التي تنطوي على مشكلة ومنهج. فهي حال حضارية لا تتحقق عفو الخاطر، بل هي بحاجة إلى تخطيط وتخطيط استراتيجيّ نوعيّ، أو إنها بنية مركزية أولى ذات علامة حية في حياة الإنسان والشعوب والحضارات، تنتقل بالفرد إلى وعي الذات والآخر معاً. بذلك تتهيأ أمامه الفرصة المثالية ليكون جزءاً فاعلاً في أكثر حلقات التطور والحضارة في العالم، بحيث يجد نفسه مرتبطاً بها ومسؤولاً عنها أينما كانت، على النحو الذي يقوده إلى الارتفاع بمحليته واستنهاضها بما يناسب منطق العصر، ومسؤولاً مسوؤلية أخلاقية وحضارية عن تحقيق جدل الفعل الحضاريّ بين منطق العصر من جهة، والظروف الاجتماعية والثقافية والبيئية لوطنه من جهة أخرى. صحيح أننا نمتلك كلّ المقومات التي تجعل منا أمّة حضارية في الراهن كما كانت في السابق، لكنّ ما يعوزنا هو الثقافة بهذا المفهوم، بمعنى المحرّكات الصحيحة لتشغيل ميكانيزمات الفعل الحضاريّ الكامن فينا، بعيداً من التغنّي السلبيّ المجرد بالماضي المجيد، وإضافة مزيد من الخطابات الإنشائية التي تقمع التطلّع من دون أن تدري، وتحول دون العمل الهادئ الرصين المبرمج الداعي إلى سماع كلّ الأصوات مهما كانت مختلفة ومتباينة، ومقاربتها ومناقشتها وتطوير العلاقة معها والإفادة منها.
لا نجد أنفسنا مجازفين في التلاعب بمقدّرات المصطلح وفرض حمولة لا طاقة له بها، إذا قلنا إنّ الثقافة تبدأ من الطريقة التي يتناول فيها الإنسان طعامه وشرابه، إلى تفكيره بتقنيات اختراع كبسولة يتناولها المريض أو حتى غير المريض، لتقدّم تقريراً مصوّراً عن حالة بدنه وتشخيص أيّ نقص أو مرض يعاني منه، ومن حرصه على تفادي التفريط بقطرة ماء زائدة، إلى التفكير الجاد في تحقيق حلم أوتوبيس الفضاء مثلاً. هذه هي الثقافة التي ننشد ونتطلّع ونتمنى ونحلم، ونرجو في هذا الإطار أن تتحوّل إلى سلوك يوميّ ووعي ماثل، بما يجعلها قادرة بفعل القراءة ووعيها أولاً على أن تتحوّل إلى تقاليد تنفذ إلى بواطن العقل وأعماق الروح. لا شكّ في أنّ هذه السياقات ليست مجرد قنوات للمرور السريع، بل هي بؤر تسهّل التبلور والاختمار والإنتاج. فالتقاليد إذاً منتجة، لا يمكننا عدّها حاضنة محايدة لأنّها متدخلة ومغيّرة لكل حالة تنتظم داخل سياقاتها، مع الانتباه إلى أنّ الانتظام داخل هذه السياقات يحتاج إلى مؤهلات متنوعة، ترتفع إلى مستوى روح الفاعليات وأنشطتها داخل نظم السياقات.
نحسب أنّ ذلك يستلزم قدراً عالياً من التأصيل والتكييف، ويتطلب خلق علامات خاصة تنتمي إليها وتدل سيميائياً عليها وتتميز بها، كي تحفل بخصوصيتها وتحاور بِسِماتها على النحو الذي يتهيأ لها أسلوبها الخاصّ في التشكيل والتعبير والتدليل، فضلاً على هدفها في تعزيز روح الديموقراطية والجماعية والشعبية في مفرداتها، لتنهض هذه التقاليد في ما بعد بفضح علامات البدائية والتخلف والعشوائية والفوضى والاستبداد، تبدأ عملياً من تنظيم الفرد لذاته، وصولاً إلى كلّ المؤسسات الاجتماعية والإدارية والاقتصادية والثقافية التي يعمل فيها، ويشعر أنه يتحمّل دوراً ثقافياً مركزياً في إرساء دعائم التقاليد فيها.
إنّ التقاليد القائمة على أسس ثقافية رصينة، والثقافة المنتجة لفضاء من التقاليد والمقبلة من مناطق القراءة الخصبة المسلّحة بوعي متقدم جريء، هي التي تعيدنا نحن العرب إلى حاضرة المشهد الحضاريّ الحديث، وتجعلنا داخل حدود الصورة. فهل يتكشّف القرن الجديد عن شعب عربيّ يقرأ، ويكذّب الكثير من النبوءات التي زعمت غير ذلك، ويرغم الآخر على قبوله عضواً في نادي إنتاج المعرفة؟
■ أستاذ جامعي وشاعر عراقي
القدس العربي