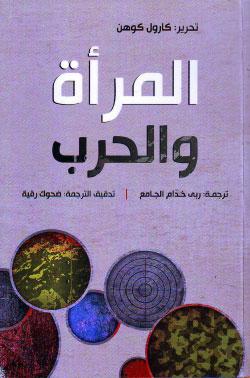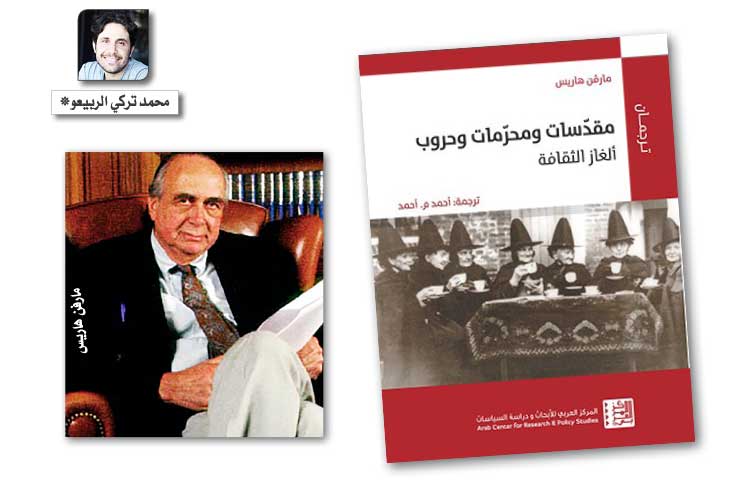المدينة في العالم الإسلامي
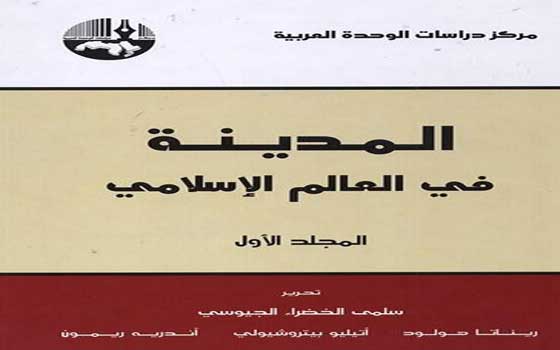
تاريخ المدينة في الشرق الأوسط: من نهاية السلطنة العثمانية إلى حرب شوارع بيروت/ محمد تركي الربيعو
حظيت فكرة النظر إلى المدينة في العالم الإسلامي بوصفها كائناً عضوياً حياً، في العقود القليلة الماضية باهتمام كبير من قبل عدد من المؤرخين والأنثربولوجيين والروائيين الغربيين والمحليين (أبناء العالم الإسلامي). إذ نُظِر إلى المدينة بوصفها تتألف من أجزاء شديد الترابط مع أنماط سكن واتصالات وأمكنة عامة ومؤسسات متداخلة ومتبادلة التأثير، تُنتِج معاً ثقافة الحياة المدينية.
من هنا، اعتُبِرت دراسة المجال المديني عند كتاب كثيرين مصدراً معرفياً غنياً للكتابة وإعادة اكتشاف المدينة، ومن بين هذه الجهود يمكن الإشارة إلى عمل الروائي التركي أورهان باموق «إسطنبول»، أو إلى العمل الأنثربولوجي الذي جمع كل من غيرتز، وغيرنز، ولِ روسن في عملهم عن مدينة «صفرو» في المغرب، الذي أظهر أن كل ساكن في المدينة يمتلك تجربة خاصة مع المكان، على الرغم من اشتراكه مع سواه في عناصر بيئية أخرى. هذه التجارب الخاصة هي إلى حد كبير نتاج عوامل العمر، الطبقة، المكانة، الجندر.
ومن بين الكتب الجديدة والغنية التي صدرت في هذا السياق، يمكن أن نشير إلى كتاب «المدينة في العالم الإسلامي» الذي صدر بمجلدين (1600 صفحة) عام 2008 عن مؤسسة (تواصل شرق– غرب/بروتا)، ثم ترجم للعربية عام 2014 في مركز دراسات الوحدة العربية. وأشرف على تحريره كل من الأكاديمية الفلسطينية سلمى الجيوسي، والمؤرخ الفرنسي أندريه ريمون (صاحب العديد من الدراسات والكتب حول المدينة في العصر العثماني)، والأنثربولوجية في جامعة بنسلفانيا (ريناتا هولود)، والباحث الإيطالي أتيلو بيتروشيولي.
وقد ضم الكتاب ما يقارب الـ45 مشاركة لباحثين ومؤرخين ومتخصصين في علم الآثار والجغرافيا، والأنثربولوجيا، ودراسة المناطق الحضرية، حيث شمل مدنا إسلامية تمتد من وسط آسيا حيث بخارى وسمرقند مروراً بفيروز آباد وأصفهان الإيرانيتين، وبإسطنبول وبورصة العثمانيتين، وصولاً إلى بغداد والقاهرة ودمشق وحلب وبيروت والقدس وطرابلس والرباط.
ولعل ما ميز هذا الكتاب بخلاف كتب عديدة تناولت تاريخ المدينة في العالم الإسلامي، هو اشتماله على معطيات لا تتعلق بالنسيج المديني التاريخي فحسب، وإنما على دراسات للتحولات الحديثة والمعاصرة التي أصابت هذا النسيج المديني أيضاً. كما أن هذا الاهتمام بالواقع الحديث لم يكن يقتصر على جوانب معينة في هذا النسيج، مثل المواقع السياسية والوطنية التي صنعت صورة المكان، وإنما شمل كذلك وبكثير من التركيز التدفق الكلي للعمليات المدينية وصولاً إلى الزمن الحاضر وما انطوت عليه من نتائج. وانطلاقاً من ذلك، فإننا نروم في هذه المادة تسليط الضوء على هذا المحور، على أمل أن تكون هناك قراءات لباقي الأبحاث والجوانب في هذا الكتاب، الذي يحتاج حقيقة إلى أكثر من مراجعة، خاصة في ظل التحولات التي شهدتها المدينة العربية في السنوات القليلة الماضية، إذ أخذت الحدود التي تفصل بين المدينة واللامدينة تضمحل، كما أن الحروب بداخلها لا تغير فحسب من الطوبوغرافية المدينية، وإنما تساهم أيضاً في ولادة أشكال اجتماعية مسيطرة جديدة (الميليشوي) واقتصاد حروب افتراسي، الأمر الذي أنتج خطاباً انقسامياً جديدا للمدينة وللفضاء الاجتماعي في داخلها.
تحديث مدن
السلطنة العثمانية (1800-1920):
يرى جاك لو أرنو الباحث في المرصد الحضري للشرق الأدنى ((IFBO أنه حتى أواسط خمسينيات القرن التاسع عشر، كان الاهتمام برعاية المدن متروكاً لإدارات الولايات. أما بعد ذلك، فشهدنا بداية تأسيس المجالس البلدية، ظهر أولها في إسطنبول عام 1855، ولاحقاً في بيروت عام 1863، وفي سالونيك عام 1869، يليها في العام التالي طرابلس الغرب. وفي عام 1877 عمم البرلمان نظام البلديات على جميع مدن السلطنة. وقد عهد القانون إلى هذه الإدارات الجديدة مجموعة واسعة من المهمات من الرقابة على المباني الجديدة إلى إنشاء المأوي للفقراء، مروراً بشرطة الأسواق ومسك سجلات الأحوال الشخصية. غير أن ضعف الوسائل المتاحة لم يسمح لها بالقيام بكامل مهماتها. ورغم أن السلطات العثمانية لم تكن ترغب كثيراً في بداية الإصلاحات ببروز قوة محلية منافسة لدورها في المدينة، مع ذلك يرى – جاك أرنو- أن هذه الإصلاحات ساهمت بالإضافة إلى نشر الدولة لتقنيات المواصلات والنقل (التلغراف وسكك الحديد) ومد شبكات تصريف المياه والتزود بالطاقة والكهرباء، في تعزيز دور المدن التي أصبحت وسيطاً حقيقياً للإدارة المركزية، ولا سيما منذ عام 1864 بعد إصلاح الولايات.
كما أن هناك عاملاً جديداً برز داخل المدينة، تمثل بحسب الباحث بالوظائف والمهن الجديدة التي خلقتها شركات المواصلات والتلغراف. ذلك أن إدارات الشركات التي كانت تقوم على تلك الأنشطة كانت متمركزة في المراكز المدينية. وقد استفاد العديد من موظفي هذا القطاع وتفرعاته من مداخيل كبيرة لم يسبق لها مثيل، وهو ما جلب ممارسات استهلاكية جديدة داخل المدينة مثل: المقاهي الكبيرة والمطاعم وصالات السينما الكبرى، وسواها، لتلبية الحاجات الخاصة بهذه الفئة الاجتماعية الجديدة.
كما أدت هذه التحولات في أنشطة المدن، إلى تراجع الصناعات الحرفية ليتم استبدالها بطريقة إنتاج جديدة: المصنع، حيث يعمل عدد كبير من الموظفين الذين يتقاضون أجراً. من جهة أخرى، يستقطب قطاع الخدمات حجماً متزايداً من الموظفين، وهو الأمر الذي أدى إلى خسارة تدريجية لسلطة المؤسسات التقليدية (الكار والحرفيات والمؤسسات الدينية)، وحتى لو أتى اختفاؤها متأخراً.
أدت كل هذه التغيرات بحسب الباحث، إلى فترات نمو داخل المدن ترافقت مع تسريع إعادة التنظيم في المجموعات الاجتماعية والأنشطة داخل النسيج الحضري التقليدي. ففي السابق كنا نجد مدناً مثل الإسكندرية وحلب وبورصة وسالونيك مؤلفة من مجموعات صغيرة وقطع أراض تتراوح مساحتها ضمن نسبة واحد إلى مئة. فكنا نجد ضمن المجمع العمراني الواحد بين وسطه وأطرافه أراض تختلف مساحتها وقيمتها ومردودها، ما أدى إلى اختلاط في الأنشطة والمجموعات الاجتماعية المختلفة.
غير أنه مع ستينيات القرن التاسع عشر، لم تعد العقارات تقسم تدريجياً بناء على طلب أولئك الذين يمكن أن يكونوا قادرين في البناء. فمن أجل الاستفادة من عائداتها إلى أقصى حد، وخفض المساحة التي تشغلها شبكة الطرقات، سبق المالكون العقاريين الشارين وقسموا أراضيهم وفق أشكال هندسية منتظمة. ونتيجة لذلك غاب التنوع والاختلاط اللذان ميزا النسيج الاجتماعي القديم، فأصبحت كل أرض مفرزة تستهدف فئة معينة ومتجانسة من الشارين، في حين كانت تظهر الفوارق بين موارد الراغبين في البناء من خلال حجم أراضيهم – كانت منازل الميسورين أكبر من منازل الفقراء– وليس من خلال موقعها.
في هذا السياق، نظمت المجموعات الاجتماعية نفسها في أحياء جديدة، بطريقة تنطوي على تميز أكبر مما كان عليه الحال في النسيج الاجتماعي القديم. فضلاً عن ذلك، أكملت التشريعات التي صدرت في ذلك الحين التوجه إلى تنظيم المدن في مناطق وظيفية. وقد تزايد منع بعض الممارسات، أو منع بعض السكان في مناطق معينة. وجرى تصنيف بعض المؤسسات بـ»فاسدة وخطرة» مثل المقاهي والحانات وأمكنة الشحادين والبغاء ..إلخ، وأُلزِمت جميعها على ممارسة أنشطتها في مناطق حددها المشترع بصورة واضحة ودقيقة. وتجلى هذا التدخل بصورة واضحة وفظة في الإسكندرية عام 1920حين قررت البلدية منع دخول البدو إلى المدينة.
المدينة والأيديولوجيات مابعد الكولونيالية:
من ناحية أخرى، يرى حسن الدين خان، استاذ العمارة وصون التراث التاريخي. أن الدول غالباً ما اختارت التعبير عن استقلالها في عواصم جديدة أو مناطق جديدة ضمن عواصم قائمة. ففي تركيا خطط المهندس الألماني هرمان يانسن (1928 – 1932) لأنقرة كي تكون مدينة «رشيدة وحديثة». وفي باكستان خطط المخطط اليوناني النافذ قسطنطين دوكسياديس (1959-1964) إسلام اباد، وكانت نظرياته الحضرية مستندة إلى تصميم القطاعات والأحياء ضمن نظام نقل أوسع وإطار قطري. وقد قسم تخطيطه «المنطقي» المدينة إلى قطاعات سكنية، لكل قطاع مرافقه ونقلياته وعقدته التجارية، كما ينقسم سكان القطاع بحسب الدخل أو المهنة كموظفي الحكومة مثلاُ، وبذلك غالباً ما يعرف المرء بالمكان الذي يسكنه.
ووفقاً لخان، انعكست القومية الناشئة والأشكال الجديدة للتنظيم الاجتماعي، وبنية السلطة الداخلية الجديدة، في أشكال وهندسة معمارية حضرية مثل الساحات العامة والبرلمان، من بين أشياء أخرى. لكن مع بداية السبعينيات تغير هذا الأمر بعض الشيء، فقد أدى انبعاث الثقة بالإسلام كهوية من جديد بدافع من نجاح أوبيك (المنظمة المصدرة للنفط) التي استطاعت إعادة بناء سوق النفط لمصلحتها، لانتشار فكرة هوية إسلامية موحدة لدول ذات أغلبية إسلامية. وحتى في تركيا، الدولة العلمانية الأحدث في العالم الإسلامي، كان ثمة ارتداد في الثمانينيات والتسعينيات، حيث أدلت دوائر محافظة وإسلاموية بدلوها في عملية التنمية. وكانت فكرة هوية إسلامية واحدة فكرة معقدة عويصة أمام ثقافات إسلامية مختلفة. وعلى الرغم من ذلك، فقد تحولت إلى صيحة تعبئة سياسية وثقافية قدمت فكرة الإسلام لا كمعتقد فحسب بل كقوة ثقافية دنيوية. وكان أوضح شاهد على هذا ما جرى في إيران. فالمعارضة التي بدأها أتباع آية الله الخميني ضد الشاه عام 1977، مع شعار «استقلال، حرية، جمهورية إسلامية»، أدت إلى الثورة الإسلامية 1978-1979. وأفضت دعوة العودة إلى المبادئ الإسلامية إلى التشكيك في التنمية الحضرية على النمط الغربي، وإلى هندسة معمارية جديدة أيدت البناء الإسلامي التقليدي، بالقول لا بالفعل، وبتعابير شكلية لا أكثر من دون أي اعتراف حقيقي بقواعده الجوهرية.
بيروت الطائفية والحنين إلى المدينة القديمة في القاهرة:
غير أنه مع بداية الثمانينيات، يرى كل من الباحث اللبناني جو نصر، والفرنسي أريك فرداي، أن العالم العربي كان يشهد نموذجاً انقسامياً جديداً، تمثل هذه المرة في القتال الدائر في شوارع بيروت، الذي أدى إلى تكون قطاعين، كل منهما ذي تركيبة طائفية متجانسة على جانبي خط التماس. فضم شرق خط التماس المسيحيين بمستوى كلي تقريباً، وضم الغرب أكثرية مسلمة. وهو ما أدى إلى ولادة ضواحي جديدة أيضاً، خصوصاً على طول الساحل الشمالي وفي التلال وكذلك في السهل الجنوبي. وبعد انتهاء الحرب وبدء تنفيذ مشاريع إعادة إعمار بيروت، كانت هذه الخطط أكثر تطرفاً مما توقع البعض. فقد دعت الخطط الجديدة إلى عمارة حديثة، ذات وظائف تجارية وسياحية، وعلى حساب حفظ التراث وملاك الأراضي القدامى والمستأجرين. كما أنها قبلت في الواقع، التغيرات الاجتماعية الناتجة عن القتال بل عملت على ترسيخها.
أما في ما يتعلق بالقاهرة، فيلحظ أريك دنيس في دراسته لها، أنه مع بداية التسعينيات فتحت الدولة جذرياً ومن دون أي قيود، أبواب المساحات الصحراوية المحيطة بالمدن الجديدة. فجعلت احتياطي الأراضي هذا بتصرف الشركات العقارية التي عملت على تطوير منتج واحد فيه: المدن الخاصة والمجتمعات المحروسة. وهكذا، فإن مساحة ما لا تقل عن 100 كيلو متر مربع (أي ما يوازي ثلث مدينة استغرق إنشاؤها على ما هي عليه آلاف السنوات) باتت في غضون 10 سنوات فقط مكانا سهلاً للبناء وتالياً للسكن.
وقد تلاشى كلياً الخطاب الذي كان يصر بإلحاح عن ضرورة حماية المدينة من غزو الفلاحين، وضرورة الدفاع عن اندماجها، لمصلحة صورة سلبية تماماً لانحطاط المدينة ككل، وقد شكلت سلسلة أحداث بالتدريج صورة المدينة التي يجب الرحيل عنها إلى المدن المحروسة جيداً. ولذلك لم يعد من معنى للدفاع عنها.
من جهة أخرى غدت النظرة إلى الأحياء المركزية القديمة بمثابة موضوع لبرنامج محافظة يأمل أن يحول المركز القديم إلى متحف تحت اسم «المدينة الإسلامية» أو «المدينة الفاطمية»، وترافقت هذه الرؤية وعلى نحو متزايد مع حملة ترميم سريعة للقصور والمساجد، في معرض يراد له أن يبقى نظيفاً وناعماً ومتوهجاً، ولو على حساب الأشكال الأصلية وما تركه الزمن حقاً. كما أن هذا التثوير لروائع الماضي لم يقف عند حدود المدينة القديمة ومعالمها، بل أثر أيضاً في المدن الخاصة الجديدة من خلال إضفاء الطابع التراثي على عمارة وساحات هذه المدن، وهو السلوك الذي يصفه دنيس بأنه لا يهدف إلى طلب الأصالة، بمقدار ما يسعى إلى تحريك مشاعر الحنين عبر اختلاق جديد للزمن تتم من خلاله دعوة الشخص إلى المبادرة لحماية نفسه في ظل القلق المتزايد، واضطراب الحياة اليومية، وفي ظل التعقيدات القائمة والتبعية لمرجعيات متداخلة. وهي طريقة في تشكيل متروبول، وإن بدا أنه يعيد تفعيل أنواع التجمع القديمة، فهو لا يترك مكاناً للتساؤل حول مظاهر التمزق الاجتماعي ولا يحاول حتى إلباسها شرعية موروثة.
كاتب سوري
القدس العربي