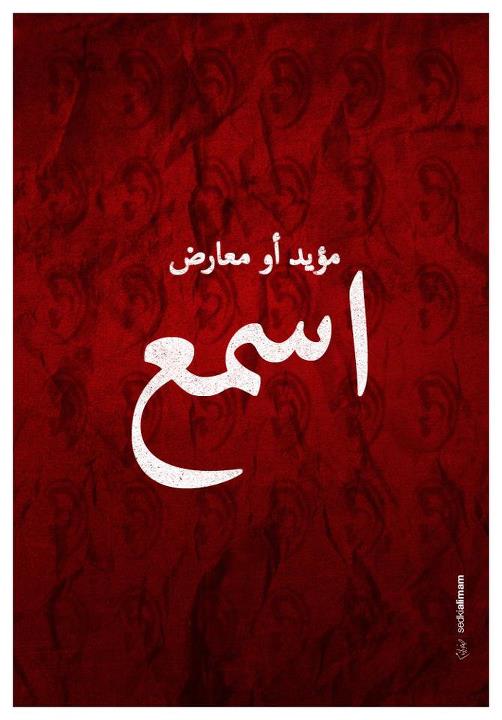الموجة الإسلامية الثالثة والثورة: بعض الأصول والدلالات والآثار
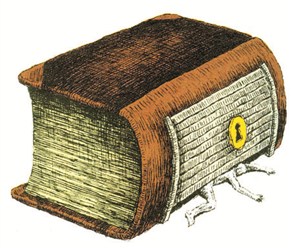
ياسين الحاج صالح
ليست موجة الصعود الإسلامي الحالية، المواكبة للثورات العربية، أو المترتبة عليها، هي الأولى في البلدان العربية. سبقتها موجتان: موجة التأسيس التي امتدت بين أواخر عشرينات القرن العشرين وأواسط أربعيناته، وذلك بعد إلغاء الخلافة العثمانية وفي ظل وقوع البلدان العربية تحت الحكم الأوربي. ثم موجة ثانية في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته، وفي ظل الاستبداد ومواجهته.
يفصل بين الموجتين الأخيرتين جيل أو أكثر أيضا، بين ربع قرن وثلثه، “تغوّلت” خلاله الدولة في العالم العربي، ولم يتحقق لأي منها اختراق اقتصادي حاسم أو السيطرة على المشكلة الديمغرافية، وساد الفساد والتخاذل عن مواجهة أية قوى دولية أو مشكلات اجتماعية محلية، وعم الميل إلى توريث الحكم في الجمهوريات العربية الأساسية، وهو ما تحقق فعلا في أقدم هذه الجمهوريات، سورية.
الموجة السابقة كانت أميل إلى العنف أو عنيفة حيال النظم الحاكمة، تكفيرية أو نزاعة إلى التكفير ثقافيا واجتماعيا، استبعادية حيال التيارات والقوى السياسية الأخرى. ولا ريب أنها أسهمت في تفاقم الطابع الدراكولي للحكم في البلدان العربية، وإن يكن تأثيرها في ها الشأن ظرفيا، وليس بنيويا. فقد أظهرت هذه النظم، في سورية والعراق، وفي تونس وليبيا ومصر، ميلا ثابتا للانفراد بالسلطة وقمع المعارضين قبل أن تتعرض لأي تحد منظم من جهة الإسلاميين. المواجهة مع الإسلاميين عززت استعدادا قويا أصلا لدى هذه الأنظمة.
ولقد انتهت تلك الموجة بإخفاق الإسلاميين في كل مكان، وتعرضهم للسحق الأمني في بعض البلدان (سورية وليبيا وتونس والجزائر)، ومحاصرتهم وحظر تنظيماتهم قانونيا في جميعها، وإن حظي الإسلاميون بضرب من اعتراف واقعي متأخر في مصر. وبمحصلة هذه الموجة برز الإسلاميون بوصفهم الخصم النوعي الأبرز للأنظمة المعنية، ونالوا عطفا واسعا بوصفهم ضحاياها الأبرز.
أصول الموجة الثالثة
من سمات الموجة الحالية، بالمقابل، أن الإسلاميين يسجلون حضورا كبيرا في الحياة العامة، والموقع الأول في الحكم عبر صناديق الاقتراع، وهذا إثر ثورات لم يقودوها هم (لم يقدها أحد في الواقع)، وشاركوا فيها متأخرين عن مبادرات شبابية غير حزبية عموما، لكنها “علمانية” في توجهها العام دوما.
في تونس نال إسلاميو حزب النهضة الموقع الأول في الانتخابات التشريعية، وظهروا بوصفهم الكتلة الأكثر تماسكا في البرلمان. وفي مصر تحقق لمجموع الإسلاميين فوز أعرض، وإن لم يتضح بعد ما إذا كان التحالف بين تياري الإخوان والسلفيين ممكنا. وفي ليبيا ليست الصورة العامة واضحة أيضا، لكن يرجح أن يكون الإسلاميون قوة سياسية كبيرة في مجتمع جرى تفريغه من السياسة والتنظيم الاجتماعي المستقل طوال أكثر من أربعة عقود، وإن تشابك حضورهم هنا مع تجاذبات قبلية وجهوية. والأمر ليس واضحا في سورية أيضا، لكن ليس هناك ما يسوغ الشك في أن يكون للإسلاميين حضور مهم في الحياة السياسية والعامة في سورية ما بعد الأسدية. على أن هذا الحضور المحتمل يختلط حتما ويتعدّل بالحساسيات الطائفية في البلد. ومثل ذلك في البحرين، وإن اختلط هناك ببعد إقليمي للصراع السني الشيعي والعربي الإيراني. ولعله يمتزج في اليمن بالبنى القبلية وبتمايزات مذهبية أيضا، فضلا عن التهديد السياسي والأمني الذي تمثله تنظيم “القاعدة”.
في الحالات كلها يظهر الإسلاميون أقرب شيء إلى التعبير السياسي “الطبيعي” عن مجتمعات عربية متعددة، بينما هي على أعتاب أطوار جديد من حياتها السياسية. لكننا سنظهر هنا ما يتحقق اليوم ليس ثأر الطبيعة من تلاعب مصطنع بها، على نحو ما قد يفضل الإسلاميون أنفسهم تصوير الأمر، بل هو نتاج الإفلاس النهائي لحكم نخب مترهلة، تجمع بين احتكار السلطة وهيمنة واسعة على الموارد الوطنية وتحكم واسع بحركة المعلومات، وسيطرة واسعة بدورها على حياة السكان، تضعهم أحيانا في شروط تقارب العبودية، في سورية وليبيا بخاصة. وعلى ما هناك من فوارق في أصول الأنظمة الحاكمة عربيا، وفي ما تقوله عن نفسها، فقد انتهت إلى أن تشبه بعضها بدرجة كبيرة: أنظمة حكم مؤبدة، يحكمها حكما مطلقا زعماء كهول منذ سنوات طوال (26 عاما في تونس، 42 في ليبيا، 30 في مصر، 34 في اليمن، و42 في سورية أيضا)، ويهيئون أبناءهم لوراثة حكمهم، وهو ما كان تحقق فعلا في سورية منذ عام 2000. يجمع نخب الحكم في هذه الأنظمة أيضا أنها ثرية، فاحشة الثراء غالبا، منفصلة في روابطها وأنماط حياتها عن حياة أكثرية محكوميها، وسارت سياساتها جميعا باتجاه التخلي عن الوظائف الاجتماعية للدولة، دون أن يكون سجل أي منها في مجال التنمية متميزا. وهي بعد هذا كله تدير أنظمة تنخرها المحسوبيات وأشكال الفساد الأشد فجورا، وتظهر تهاونا بالغا في معالجة المشكلات الاجتماعية الداخلية، كما في ممارسة سياسات مستقلة على المستويين الإقليمي والدولي.
ولقد عملت طوال عقود على صنع فراغ سياسي وثقافي عميق حولها، بحيث يكون أمثال معمر القذافي وحسني مبارك وزين العابدين بن علي وحافظ الأسد ثم ابنه وعلي عبدالله صالح أعلاما في السياسة والفكر، لا يعترض أحد على أقوالهم وأفعالهم، ولا يساءلون عم يفعلون، مهما فعلوا. المعارضون السياسيون سحقوا بعنف متفاوت، وجرى استتباع من كان أسهل قيادا من بينهم. وبعد أن كان يبدو أن هذه الأنظمة “تقدمية”، تحمل فكرا وقيما جديدة، فقد أخذ يتكشف أنه لا مبدأ لها من أي نوع، غير البقاء في الحكم، ولا أخلاق لرجالها تنهاهم عن القتل والسرقة والكذب. في مواجهة نظم سلطة محض كهذه سيظهر الإسلاميون مجموعات لها فكر وأخلاق وأصول، وثقافة.
وعلى هذا النحو، وقعت المجتمعات المعنية تحت وطأة إفقار سياسي وثقافي مفرطين، محرومة من أشكال الانتظام والتجمع والتعاون المستقلة التي تتيح للناس الدفاع عن أنفسهم أو التكاتف فيما بينهم لتحقيق أهداف مشتركة، ومحرومة بالقدر نفسه من الشكوى والاحتجاج وإسماع صوتها في الفضاء العام والاعتراض العلني على من يسوسون الأمور ويوجهونها. بعبارة أخرى، حكم على السكان بأن يتفرقوا فلا يربطهم رابط، وبأن يبتلعوا ألسنتهم فلا يسمع لهم صوت(1). لذلك نتكلم على خط فقر سياسي تعيش تحته مجتمعاتنا بسبب واقع الصمت والبعثرة المفروضين.
“الإسلام” هو حد الفقر السياسي في مجتمعاتنا. فهناك “تجمعات” لا تستطيع السلطات أن تبعثرها أو تفضها هي تجمع المؤمنين للصلاة في المساجد، وهناك “آراء” لا يسعها أن تقمعها، وهي الجهر بالمعتقد الديني أو تلاوة النصوص المقدسة. والواقع أن اقتران موجة من توسع ممارسة التعبد الإسلامي وبين طغيان هذه الأنظمة في السبعينات أكيد لا ريب فيه.
على أن لقيام “الإسلام” بوظيفة حد للفقر السياسي تأثير راجع عليه: تغدو الصلاة فاعلية احتجاج ضمنية، وتكتسب تجمعات المصلين وظيفة سياسية مباشرة، وربما تتطور في بعض الحالات لتصير ضربا من حزب (تجمع المصلين في هذا المسجد أقرب إلى الإخوان، وذاك إلى السلفيين…). وبالمثل يتحول الكلام الإلهي المقدس إلى آراء سياسية مباشرة هي ما يتسلح به الناشطون الإسلاميون في وجه النظام الحاكم، وفي وجوه خصومهم الآخرين. وعلى هذا النحو رأينا، بدءا من مصر، قراءات جديدة للمتون النصية الإسلامية تستخرج منها مذهبا سياسيا، أو تجعل الحكم السياسي أصلا من أصول الإسلام. وهذا في سياق ما بدا أنها عملية أسلمة عامة، اجتماعية وثقافية، وتطال الزي والعلاقة بين الجنسين، وتطمح إلى السيطرة على الدولة.
ونتكلم على إفقار ثقافي بفعل ما تعرضت له مجتمعاتنا من تعرية شديدة وحرمان من إنتاج المعاني والدلالات المستقلة. “الإسلام” هنا أيضا حد. فهو نظام معنى لا يسع أية سلطات مستبدة أن تتحكم في عمليات إعادة إنتاجه أو تراقب جميع أقنية تداوله وصيغ توظيفه.
لكن إذا كان تحليلنا قريبا من الصواب، فإن محركات الأسلمة اليوم، ومنذ أكثر من جيل، تحركها مطالب “علمانية” ودنيوية، تتمثل في الاستحواذ الاجتماعي على السياسية والتحكم بشروط الحياة الدنيوية، بما في ذلك إضفاء المعنى على ما يميزها من عناء شديد، وقيام هويات صلبة في مجتمعات تعرضت للكشف والبعثرة، بما يرفع من قيمة حياة أفرادها ويوفر لهم قدرا من الحصانة.
وما يجري على أيدي الإسلاميين بالذات هو ضرب من العلمنة الإسلامية، عبر تحويل التجمعات الدينية إلى منظمات سياسية، والنصوص المقدسة إلى آراء، وزج الكل في الصراع السياسي والاجتماعي.
نريد القول إنه من وراء تديين السياسة الظاهر، علينا أن نرى الشروط الواقعية لتسييس الدين، وبخاصة ما قلناه عن الإفقار السياسي.
ومن المفهوم أن يكون الإسلاميون هم المرشحون الأفضل بما لا يقاس للاستفادة من حد الفقر السياسي هذا. فسياستهم تستند إلى إقامة تطابق بديهي بينهم وبين “الإسلام”، أي مع جماعة المؤمنين على الأرض ومع الله في السماء. وهم يقيمون شرعيتهم على الاثنين معا: تمثيل “الأمة” (معرفة بالإسلام)، والحكم بما أنزل الله.
ولقد بذلوا جهودا مهمة من أجل صون التطابق بينهم وبين عموم المسلمين المؤمنين من السكان، في مصر بخاصة، عبر شبكات التكافل الاجتماعي وتقديم العون للفقراء، مستفيدين في ذلك من تقاليد التكافل الإسلامية. هذا بينما لم تنجح التيارات السياسية والفكرية الأخرى في صنع تقاليد جديدة، ولم تشكل مراكز إنتاج لثقافة جديدة وفكر جديد، فكان أن انضوت عمليا تحت جناح النظم القائمة. “التقاليد”، والقواعد والرموز المشتركة عموما، هي ما يربط الناس إلى بعضهم، ومن دونها هم نثار لا وزن له من الأفراد المعزولين العاجزين.
وعلى هذا النحو تلتقي شروط الإفقار السياسي الشديد من جهة، مع تطلعات الإسلاميين السياسية من جهة أخرى، لتفسر هذا “الواقع الطبيعي” الذي نصادفه حيثما تلفتنا في البلدان العربية التي شهدت ثورات، واقع تصدر الإسلاميين المشهد السياسي بعد الثوري في بلداننا.
فإذا كان ذلك صحيحا، فإن صعود الإسلاميين ليس أمرا غير معقول أو مؤشرا على عقل عربي أو إسلامي “مضروب”، أو على نقص العقلانية في تفكيرنا، بل هو المعقول عينه. فعبر “الإسلام” تستحوذ مجتمعاتنا المفقرة سياسيا على السياسية المحرمة، على الاجتماع والتعاون، وعلى الكلام والقول في الشؤون العامة، فتضفي معنى على حياتها، وتتشكل كذوات سياسية فاعلة ومطالِبة. وإن كان ذلك صحيحا أيضا، فإن لصعود الإسلاميين حدود لن يتأخر عن بلوغها. فمن شأن ارتفاع مجتمعاتنا عن خط الفقر السياسي، والظهور المحتمل لعرض سياسي متنوع بعد الثورات، أن يخفف الطلب على الإسلاميين ويوقف صعودهم السياسي، أو يرهنه بأدائهم الاجتماعي والاقتصادي، والسياسي. لقد استمد الإسلاميون قوتهم من تشكيل هوية سياسية صلبة في ظل استبداد مشتط. الميزة الأعظم للثورات اليوم هي إتاحتها فرص تشكل هويات سياسية جديدة متنوعة، سوف تنافس من كل بد الإسلاميين، وتوفر لعموم السكان بدائل متنوعة.
بالمقابل، سوف يواجه الإسلاميون الحاكمون ملفات صعبة، وليس من المتوقع أن تكون معالجتها أسهل عليهم مما على غيرهم. وبعد أن يخسروا وضع الضحية، والتعاطف الشعبي المترتب عليه، سوف يُحكَم عليهم أكثر وأكثر بأدائهم، دون شفيع من العقيدة ومن التعاطف مع الضحية، ومع توافر خيارات متزايدة في “السوق السياسية” الجديدة.
في تونس هناك منذ الآن هياكل دولة أقوى شخصية من أن يسيطر عليها الإسلاميون (وإن كانت هناك مؤشرات على محاولتهم السيطرة عليها)، وفيها نخبة أشد تنوعا وأرفع مستوى من أن يحتويها الإسلاميون. الأمر أيسر للإسلاميين في مصر فيما يبدو، لكن لا يبعد أن يؤدي الفشل في معالجات المشكلات المعقدة إلى صحو سياسي وفكري مؤلم. أما في سورية، فالدولة أشد ضعفا بعد، لكن لدينا مجتمع متنوع دينيا ومذهبيا وإثنيا، ممانع حتما لهيمنة إسلامية (سنية)، ولدينا نخب تحوز شرعية ذاتية من كفاحها ضد الاستبداد.
الموجة الإسلامية الراهنة والديمقراطية
ليس هناك ما يسوغ الاعتقاد بأن يكون سجل الإسلاميين في مجال الحريات وحقوق الإنسان إيجابيا، على ما قد يفترض من وصولهم إلى الحكم في انتخابات جرة وفي أعقاب ثورات شعبية ضد الاستبداد.
من جهة أولى، هناك مشكلات كبيرة في الفكر الإسلامي تضعه في تعارض مع تلك المبادئ العالمية المقررة، بخاصة النظر المباشر والحرفي للنصوص الدينية، على نحو يميز الحركات الأصولية في كل مكان. ومنها التصور المباشر والحرفي بدوره لله كحاكم سياسي، ومشرّع مباشر. ومنها ما يتصل بالتمييز بين الرجال والنساء (في الميراث والشهادة والولاية على النفس والولاية العامة)، والتمييز بين المسلمين وغيرهم (في شأن الولاية العامة بخاصة)، فضلا عن مشكلات تتصل بالانقسام الإسلامي والعلاقة بين الطوائف الإسلامية، وهي مشكلة حساسة في كل من سورية والبحرين واليمن. ومنها كذلك مشكلات معقدة تتصل بتعريف الدين لكل من الأخلاق والقانون والعلم والأمة والدولة. ربما نمر بتوترات وصراعات كبيرة إلى حين تستقل هذه الدوائر عن الدين، بحيث يمسي الدين… دينا.
والواقع أن هناك تطورا في هذه المجالات يتمثل على الأقل في نظرة أكثر إشكالية إلى قضايا الفكر الإسلامي، السياسي والاجتماعي والحقوقي، ما يعني أنها لم تعد “كلاما منزلا” لا يجادل فيه. التاريخ يفعل فعله في الإسلاميين وتفكيرهم، وإن فضلوا دوما حجب هذا التأثير التاريخي وراء الاستمرارية النصية، وإن اخترعوا على الدوام أصولا قديمة لما يضطرون إلى قبوله من مستحدثات.
ولعل من المنافع الكبرى لسيطرة الإسلاميين السياسية أنها ستفجر تناقضات تفكيرهم، على نحو ما يجري دوما للأحزاب العقدية عند “تطبيق” عقائدها، وهو ما سيلزمهم بحل هذا التناقض أو الانحلال تحت وطأته. ومن غير المتصور أن يجري حل التناقص لمصلحة التفكير الأصولي التقليدي. وقد تتمثل”حيلة التاريخ”، إذن، في أن يكون الإسلاميون هم الوسيط التاريخي لدرجة أكبر من علمنة مجتمعاتنا وسياستنا.
وعلى كل حال، ليس هناك خصوصية إسلامية في هذا الشأن. فليس هناك دين يولد دينا بالمعنى الحديث للكلمة (علاقة بين المؤمن وربه)، بل هو يصير دينا عبر عمليات تاريخية نطلق على مجموعها اسم العلمنة. وليس لدى أي دين استعداد علماني ذاتي، بل تضطر الأديان إلى إخلاء المجالات الخمسة المشار إليها فوق، الدولة والقانون والعلم والأخلاق والهوية أو تعريف الأمة، وغيرها (الفن مثلا)، بفعل تطورات تاريخية متنوعة.
من جهة ثانية، وعدا مشكلات الفكر الإسلامي المشار إليها، هناك قضايا صعبة، اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية، فضلا عن الإدارة الديمقراطية للحياة السياسية، ستواجهها أية أطقم حاكمة بعد الثورات. وليس لهذه المشكلات حلول إسلامية، وإن زعم الإسلاميون العكس. وبقدر ما تضغط هذه المشكلات على الحاكمين الجدد، ويتعثرون حتما في معالجتها، ويتعرضون لانتقادات واحتجاجات مجتمعات تنتشر فيها روح الحرية والتمرد، فإن ذلك قد يغري الحاكمين الجدد بتوسل العنف كأداة سياسية عادية، حسما لمشكلات عسيرة. وبالطبع، العنف يسهل معالجة المشكلات السياسية على المدى القصير، لكنه يعقد كل شيء على المدى الأطول. فهل لدى الإسلاميين مناعة خاصة حيال اللجوء إلى العنف كأداة سياسية عادية؟ بل لعل حرفيتهم النصية الغالبة تُخفِّض عتبة اللجوء للعنف لديهم، فتُيسِّره لهم وتمنحه شرعية دينية. الحرفية في التفكير الديني (وغير الديني) مقترنة في كل مكان بانخفاض عتبة اللجوء إلى العنف. بينما يقترن التفكير والفهم الديني وغير الديني الأكثر تعقيدا بارتفاع عتبة اللجوء إلى العنف (لنفكر في تقابل الصوفية مع الوهابية في هذا الشأن).
لكن هنا أيضا ربما يكون تعميما في غير مكانه أن نرسل الكلام على الإسلاميين في العديد من البلدان، كما لو كانوا مثل بعضهم. فالإسلاميون أشبه ببلدانهم مما بعنوانهم السياسي المشترك، وإن كانت هناك مشكلات عامة تجمعهم. في تونس يشبهون تونس، وما يتوفر فيها من استقلال نسبي للدولة عن المجتمع، ومستوى مأسسة عامة يبدو معقولا. في مصر يشبهون مصر المتعَبة، كثيرة السكان والمشكلات الاجتماعية، وفي سورية ربما يشبهون مجتمعا منقسما، جرى إضعاف الدولة العامة فيه إلى أقصى حد. وهم شيعة في البحرين (مع وعي ذاتي حاد بالتقابل مع حكم سني)، وسنة في سورية (مع وعي ذاتي حاد بدوره بالتقابل مع نظام يتحكم بمفاصله الحساسة علويون)، وهو ما قد يضفي بعد إقليميا على الاحتجاجات والتغيرات السياسية المحتملة في البلدين.
تبدو فرص الدمقرطة أقوى في تونس بسبب ما قلناه من استقلال الدولة. فخلافا للانطباع المتعجل تلزم دولة أكثر واستقلال أكبر للدولة عن المجتمع من أجل ديمقراطية أكثر. إلى ذلك يظهر أن في تونس توازنات اجتماعية غير مؤاتية لانفراد الإسلاميين بالحكم، رغم أن أكثرية سكان البلد الساحقة عرب ومسلمون وسنيون ومالكيون. وهذا على كل حال تظهره نتائج الانتخابات في تونس. فقد أعطتهم 40% من الأصوات، و20% من التونسيين المصوتين فقط، فيما أعطت غير الإسلاميين نحو 60% من أصوات نصف التونسيين الذين شاركوا في الانتخابات. وتاليا فإن من شأن محاولتهم تحزيب الدولة أن تواجه باستنفار اجتماعي وسياسي وثقافي قوي في تونس، نرى منذ الآن بعض بوادره.
في مصر تلوح فرص الدمقرطة أشد مشقة. لدينا هنا مشكلات أعقد بكثير، وتوازنات اجتماعية تبدو أقل مواتاة للديمقراطية. هنا أيضا نتائج الانتخابات تعطي مؤشرات مقلقة. الفائز الأول، الإخوان، وبنحو نصف أصوات الناخبين، تنظيم إسلامي محافظ اجتماعيا وغير ديمقراطي سياسيا، والثاني، السلفيون، تنظيم إسلامي أشد محافظة وأصولية وأدنى ديمقراطية بعد. التيارات غير الإسلامية مشتتة. والجيش يصعب أن يقوم بدور تركي موازن لدور الإسلاميين بسبب ضعف شرعيته وافتقاره إلى قيادة رفيعة المستوى. من المحتمل لذلك أن أمام الشعب المصري صراعات كبرى في السنوات القادمة.
في سورية الأمور بعيدة عن أن تكون واضحة بعد عشرة شهور ونصف من الثورة. لكن مع ما تعرض له المجتمع السوري من عنف مهول تتصلب النفوس ويزداد اللجوء السياسي إلى الله وتظهر علائم أسلمة أوسع. وليس معلوما كيف ستستقر الأمور، إن كان لها أن تستقر. خلافا لتونس ومصر، سورية مجتمع أقل اندماجا، حكمه طوال عقود نظام طغيان، لم يكتف بتغطيس محكوميه عميقا تحت خط الفقر السياسي، بل توسل كذلك تفريقهم وإضعاف ثقتهم ببعضهم نهجا في الحكم، يضاف إلى العنف السائل الوفير. وهناك اليوم مخاطر جسيمة على وحدة المجتمع السوري، بل وعلى وحدة البلاد. وفي الأوساط الأكثر تماهيا بالثورة، يسجل نفوذ الأسلمة توسعا كما قلنا، وإن لم يكن واضحا إن كان المكسب يعود إلى الإخوان المسلمين أم إلى إسلاميين غيرهم. والأرجح أن سورية ستعاني مشكلات كيانية أساسية، وليس فقط المشكلات السياسية العسيرة التي ستواجهها تونس، أو الأشد عسرا التي ستواجهها مصر. في البلدين الأخيرين لن تكون ثمة مشكلة تتصل بسلامة الكيان الوطني.
لكن هل كان من شأن الأمر أن يكون مختلفا لولا الإسلاميين؟ أو لولا تصدرهم المشهد السياسي في تونس ومصر؟ لكان الأمر صعبا أيضا, وإن ربما بطريقة مختلفة. فالواقع أن المستقبل السياسي لبلداننا، ومنه الموقع الذي يحتمل أن يشغله الإسلاميون، وثيق الصلة بأوضاعها الراهنة، وتجاربها التاريخية الحديثة والمعاصرة. من وجهة النظر التاريخية، الإسلاميون أقرب إلى مظهر لمشكلاتنا الاجتماعية والوطنية ونتاج لها منهم إلى سبب هذه المشكلات وجوهرها.
وبنظرة عامة، نرى أنه من غير المحتمل أن تتمخض ثوراتنا عن ديمقراطيات ناضجة في أي وقت قريب. هذا لا يطعن في كونها ثورات ديمقراطية، فقد شاركت فيها كتل شعبية غير مسبوقة في حجمها، وقد كانت موجهة بصورة مركزة ضد نظم الاستبداد ونمط ممارسة السلطة، ولقد استمدت قاموسها في الغالب من اللغة الديمقراطية المعاصرة، الحرية والكرامة وحكم القانون وحقوق الإنسان. لكن النظام السياسي الديمقراطي المأمول قد يحتاج إلى وقت وصراعات إضافية قبل أن يتشكل ويستقر.
يُضعف من احتمال التطور الديمقراطي المتسق أيضا أن مفهوم الإسلاميين للديمقراطية إجرائي، يردها إلى الانتخابات والهيئات التمثيلية، ويستبعد منها مبدأ السيادة الشعبية وحرية الأفراد. ولا يمكن للديمقراطية الإجرائية إلا أن مفتقرة إلى الوعي الذاتي وضعيفة الشخصية، ما يجعلها عاجزة عن الدفاع عن نفسها.
الموجة الإسلامية الثالثة والنظام الإقليمي والدولي
الثورات العربية ثورات وطنية وديمقراطية جوهريا. قلنا لماذا نصفها بأنها ديمقراطية. فلماذا هي وطنية؟ لأنها متوجهة بصورة أساسية نحو “أمة” المحكومين، ويحركها نازع إعادة بناء الدولة والشرعية والحياة السياسية حولهم. ولأنها كذلك جهد ثوري جبار من أجل إعادة السيادة وتقرير المصير للشعب بعد مصادرتهما من تشكيلات حكم استبدادي مطلق، لا تختلف جوهريا عن الاستعمار، وإن بيد بني جلدتنا. بعض نخب الحكم الاستبدادي تابعة بصورة صريحة لمراكز القوى الدولية، وبعضها الآخر ينتظم حول صيغة “الدولة الخارجية”، أي إغلاق الملعب الداخلي واللعب في الإقليم بالتفاهم مع تلك المراكز الدولية. وفي حين أن الدول العربية كلها خارجية، يتجه تطورها السياسي نحو الخارج، فإن سورية من بينها بلغت حد الكمال في هذا المضمار: إغلاق تام للداخل السوري، وتفرغ للعب الإقليمي، مع الكثير من الإيديولوجية الوطنية، ودون استبعاد الإرهاب كأداة حكم في الداخل وأداة نفوذ في الخارج.
والثورات العربية وطنية تاليا بمعنى أنها مندارة نحو الداخل الاجتماعي، ومضادة لشرط “الدولة الخارجية”، التي تمتد جذورها وتستمد شرعيتها من العقيدة القومية العربية. وهي بالتأكيد ليست ثورات قومية، ولا تبدو منشغلة بالقضايا التي تكونت العقيدة القومية العربية حولها، الوحدة العربية وقضية فلسطين.
لهذه الوضعية أصول، نُجمِلها ببساطة في أن النزعة القومية الموجهة ضد الخارج والمنشغلة ببناء إجماع داخلي لا يعرف انشقاقا كانت من أدوات الحكم في معظم البلدان العربية، بمن فيها تلك التابعة للقوى الغربية، مثل نظام مبارك. فالأمر يتعلق بنظرة قومية إلى العالم، لا بمضمون الإيديولوجية القومية. وتلك نظرة تفترض إجماع الداخل وقابليته للاختزال في هوية واحدة مبرأة من الشروخ، تتشخص في الحاكم، وتُسلِّم أيضا بالصفة العدائية الجوهرية والتآمر الجوهري للخارج. وما آلت إله أطقم الحكم هذه من تخاذل وخور، دفعها إلى التفاهم مع القوى الخارجية، لكن دون مساس بالأسس البارانوئية للنظرة القومية إلى العالم.
رغم علاقاته بإسرائيل وتبعيته لأميركا، كان نظام مبارك “ممانعا” وقوميا في نظرته إلى العالم، أي انعزاليا عن العالم على مستوى الثقافة والحساسية، ومعتنقا لعقيدة المؤامرة، وميالا إلى المماهاة بين النظام والوطن. الأمر نفسه في بلد مثل ليبيا، لكن درجة الكمال هنا أيضا لسورية. في هذه الحيثية تونس مختلفة بعض الشيء، والإجماع الداخلي المفروض فيها كان قائما على التحديث والتباعد عن المجال العربي بالأحرى، لا على التبني الإيديولوجي والأداتي لمشكلاته. ربما لذلك نرى مظاهر أكبر للتقارب مع العالم العربي في تونس بعد الثورة. تونس الأكثر اكتمالا كدولة مستقلة قد تكون مؤهلة أكثر من غيرها لممارسة عروبة ما بعد قومية وغير قومية. وإن تكن تبدو اليوم عروبية أكثر من أي وقت مضى منذ استقلالها.
من جهة أخرى، تحمل البلدان المعنية كلها مشكلات معقدة على عاتقها، لا تكاد تترك مجالا لأن يكون لها تأثير سياسي مهم في محيطها في أي وقت قريب.
هذا التوجه نحو الداخل وإعادة بناء الداخل يُرجِّح قدرا من انسحاب وقتي للدول العربية المعنية إلى داخلها، أو إعادة بناء الأولويات حول القضايا الداخلية.
إلى ذلك، يبدو واضحا حتى اليوم أن الثورات تفجرت في بلدان تجمع بيت قسط من التحديث الاجتماعي والسياسي وبين الافتقار إلى مؤسسات عامة شرعية ومقبولة. دول الخليج تبدو خارج هذه المعادلة، وهذا لالتقاء مؤسسات ملكية تبدو غير منازعة كثيرا رغم أنها تعسفية مثل غيرها، وريع استخراجي ضخم، يوفر ضربا من الرفاه الريعي. السعودية معرضة لتوترات أكثر من غيرها بفعل وقوع شرائح من السكان خارج الآليات التوزيعية الخاصة بدولة الرفاه الريعي، وبتأثير وجود مهم لسكان شيعة، متمركزون في مناطق بعينها (شرق البلد)، ويشغلون موقعا دونيا فيها بحكم تعريف الدولة السعودية لنفسها (كدولة مسلمة سنية، حنبلية المذهب). تمثل البحرين استثناء مهما لكونها تعاني من خلل كياني بفعل الطبيعة شبه المطلقة لحكم أسرة تنحدر من الأقلية السنية وتحكم مجتمعا أكثريته من الشيعة. ويبدو المغرب والأردن حائزان على مؤسستين ملكيتين لا تتعرضان لمنازعة جذرية، وهما تُدخِلان تعددا محسوبا على نظاميهما السياسيين.
يبقى السودان والجزائر وموريتانيا والعراق دولا مرشحة مبدئيا لتحولات مشابهة لما عرفت بلدان “الربيع العربي”. لكن موريتانيا عرفت تغيرا سياسيا مهما قبل موسم الثورة العربية. والسودان عرف تغيرا كيانيا بانفصال جنوبه بينما كانت بلدان أخرى في أجواء الثورات. والعراق خرج بالكاد من تحت الاحتلال الأميركي. هذه البلدان الأربعة تبدو مشبعة سياسيا، إذا صح التعبير، أي أنها عرفت تغيرات مهمة في السنوات الأخيرة، بحيث لا تعاني قطاعات نشطة من مجتمعاتها من جوع إلى التغيير، أو طلب قوي عليه. لذلك لا يتوقع تفجر ثورات وشيكة فيها، لكن ربما يكون السودان والجزائر مرشحان للثورة مع ذلك أكثر من موريتانيا وأكثر من العراق.
وبفعل تقاطع هذه العوامل الثلاثة، إفلاس النهج القومي في التفكير والحكم، والانشغال المحتم بالشؤون الداخلية، وما يبدو من دور مهم لدول الخليج الغنية في النظام العربي، لا يرجح أن تكون للثورات العربية انعكاسات مهمة على النظام العربي، وعلى نسق العلاقات بين العالم العربي والعالم. يضاف إلى ذلك أن إسرائيل، العدو العربي العام، تبدو في موقع حصين ولا يستطيع أي بلد عربي بمفرده منازعتها، ولا فرصة لجهد عربي مشترك في أي مستقبل منظور.
ما نريد قوله مما سبق أن هناك أسباب قوية لعد توقع انعكاسات قريبة للثورات العربية على الأوضاع الإقليمية والدولية. لا يغير من ذلك أن يكون الإسلاميون في الحكم. فالأمر أوثق صلة بالمشكلات التي تفرض نفسها، وبموازين القوى الفعلية، منها بالمعلنات الإيديولوجية. وهذا ما يدركه الإسلاميون أنفسهم في كل حال. فهم منذ الآن يعرضون نزعة “واقعية” في مقاربة العلاقة مع القوى الإقليمية والدولية المهيمنة. في مطلع الثلث الأخير من شهر ديسمبر الماضي صرح يسري حماد، الناطق باسم حزب النور السلفي المصري، لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزبه ليس ضد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ولا مشكلة لديه في استقبال السياح الإسرائيليين مثل غيرهم. والتقى رئيس حزب الحرية والعدالة المصري، الواجهة السياسية للإخوان المسلمين، بوليم بيرنز، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية يوم 12/1/2012. ورغم أنه لم يُعلم ماذا جرى في هذه الاجتماع، فهو مؤشر على أن السياسة العملية للإسلاميين مستقلة عن الإعلانات العقدية.
لكن إذا صح ما نقول عن ثورات متجهة نحو الداخل، فإن الآثار الإقليمية والدولية للثورات العربية ستأخذ وقتا، وستمر عبر إعادة بناء الدولة والحياة السياسية في بلداننا حول مطالب الداخل الاجتماعي وتطلعاته. وليس هناك أي مبرر لتوقع أن يستكين هذا الداخل لأوضاع غير عادلة، تتمثل في موقع مميز لإسرائيل في المجال العربي وفي كونها الإقليم القاعدة لنظام شرق أوسطي متكون جوهريا حول خفض وزن العرب، دولا وثقافة، في المنطقة التي يشكلون الأكثرية فيها.
وإذا كان تتابع الثورات العربية قد كشف عن وجود مجال عربي متفاعل، أو ضربا من داخل عربي تتفوق تفاعلاته الداخلية، المعنوية والثقافية على الأقل، على تفاعلاته مع غيره، فلا بد أن يجد هذا الواقع مرتسماته السياسية بعد حين بحيث يتكون قطب سياسي عربي، يقف قبالة أقطاب مثل تركيا وإيران، ويكون مركز جذب للبلدان العربية.
على أن من العوامل شديدة الأهمية في تقدير تغيرات الدور الإقليمي والدولي لبلداننا بعد الثورات ما يتصل بكيفية التحول من النظم الاستبدادية إلى ما بعدها. فرصة تونس ثم مصر أكبر في بلورة سياسات مستقلة لأن ثورتيهما أسقطتا نظامي بن علي ومبارك بالقوى الذاتية للتوانسة والمصريين. لكن ليس متصورا مع ذلك أن تتحلل مصر من معاهدة الصلح مع إسرائيل في السنوات القريبة القادمة. الملف أثقل من أن يخضع التفكير فيه لأية اعتبارات إيديولوجية، تخص الإسلاميين، أو حتى التفضيلات المباشرة لأكثرية المصريين.
ليبيا التي سقط نظامها بمزيج من مقاومة مسلحة وتدخل أطلسي ستكون أقل استقلالية على أرجح تقدير، وأقل تدخلا في شؤون محيطها، وربما أكثر مجاراة للسياسات الغربية، أو قد يكون ذلك موضع تجاذب في ليبيا بين الإسلاميين وغيرهم من النخبة السياسية الليبية الجديدة. اليمن ربما يكون أوثق ارتباطا بالسعودية ومجلس التعاون الخليجي. أما في سورية فكل شيء غامض ومعقد، وقد تتطاول الأزمة كثيرا ويلحق بالبلد خراب عميم. لكن في كل الأحوال نرجح أن سورية ما بعد الأسدية وما بعد البعثية ستكون، إلى حين، أكثر انكفاء إلى داخلها وأقل انشغالا وقدرة على الانشغال بشؤون محيطها العربي. أما إذا سقط النظام السوري على يد غير السوريين، وهذا يبدو مستبعدا حاليا، فستفقد سورية قسطا كبيرا من استقلالها طوال سنوات. وربما تكون موضع تجاذب إقليمي على نحو سبق أن خبرته بين استقلالها والحكم البعثي.
من العوامل المهمة أيضا في تحديد مدى تأثير الثورات العربية على استقلالية سياسات الدول المعنية حسن سير الحياة السياسية فيها باتجاهات أكثر ديمقراطية. فإذا تحقق قدر مهم من الحريات العامة والسياسية وحكم القانون، وأمكن لقطاعات أوسع من الجمهور العام أن تنظم قواها وتسمع أصواتها، كان ذلك سندا لدرجة أكبر من الاستقلالية في السياسات الإقليمية والدولية. المهم أن توجد حكومات مسؤولة، وقدر من التعددية الفعلية في الحياة السياسية وانتخابات أقرب إلى النزاهة. يمكن لمصر أن تبدأ بالنهوض خلال عقد أو عقد ونصف إن تحقق لها ذلك، ولتونس أن تزدهر اقتصاديا وثقافيا، ولسورية أن تقف على قدميها وتعاود التقدم.
وبينما ليس هناك سبب للوثوق بديمقراطية الإسلاميين، فإن الأمر ليس رهنا بهم وحدهم. لا ينبغي أن يكون مفاجئا لأحد أن الإسلاميين شغوفون مثل غيرهم بالبقاء في الحكم، وأنهم ربما يحاولون التلاعب بالداخل والخارج من أجل أن يحتفظوا به. وهم إن وصلوا إلى الحكم في تونس ومصر، وربما في ليبيا بعد حين، عبر صناديق الاقتراع، فليس ثمة ما يسوغ أنهم سيحترمونها دوما، أو سيمتنعون عن التلاعب بها حيثما استطاعوا.
وبينما غلب الطابع “المبدئي” على سياسات الإسلاميين قبل الثورات، ثم امتزجت المبدئية بالبراغماتية أثناء الثورات وفي أيامها الباكرة، فلا يبعد أن تدفع تجربة الحكم إلى انفكاك المبدئي عن البراغماتي، بحيث يتوسل الإسلاميون المبادئ المقدسة لتقييد المحكومين الضعفاء، فيما يعرضون وجههم البراغماتي للأقوياء الإقليميين والدوليين.
وهذا احتمال يوجب على اليساريين والليبراليين أن يتحرروا من عقدة النقص حيال الإسلاميين، ويبلوروا سياسيات عامة أكثر حساسية للمشكلات الاجتماعية والوطنية، بخاصة أنهم سيكونون الموقع الطبيعي للمعارضة السياسية في إطار يهيمن عليه الإسلاميون. لن يتأخر الوقت قبل أن يرتفع الطلب الاجتماعي على تفكير وسياسة مغايرين مع وجود الإسلاميين في الحكم، والليبراليون واليساريون هم المؤهلون مبدئيا لتقديمهما.
في المحصلة لا نتصور أن تعرض ثوراتنا سياسات إقليمية وتدخلية ثورية في وقت قريب، ومن غير المحتمل أن يتجه أي من بلداننا إلا الاصطدام بالمحور الأميركي الإسرائيلي قريبا. تحول دون ذلك الإمكانيات المتواضعة والوجهة الجوهرية للثورات نحو الداخل وبناء الداخل. ولا نتوقع أن يكون القول الفصل في هذا الشأن لإيديولوجية القوى الأكثر نفوذا في نظمنا السياسية ما بعد الثورية، بل لموازين القوى الفعلية.
لكننا نرى أن نهج الثورات الراهن هو الأسلم على المدى المتوسط، نحو جيل من اليوم (ربع قرن)، لبلورة سياسات أكثر استقلالية وأجدى على المدى الأطول في مواجهة إسرائيل وقوى الهيمنة الدولية. لقد فشل نهج الدولة الخارجية وسياستها قطعا. الدولة الداخلية التي تعد بها الثورات مؤهلة للرد على هذا الفشل، وإن تغيرت وسائلها ومقارباتها ولغتها في المواجهة.
مصر معافاة اقتصاديا وسياسيا، وتسيطر على مشكلاتها السكانية والاقتصادية، وتُصلِح نظم تعليمها، هي أجدى لفلسطين بكثير من مصر كثيرة الانشغال بفلسطين، لكن شعبها متدهور الأوضاع المادية والمعنوية.
ومن شأن تونس مزدهرة سياسيا واقتصاديا وتعليميا أن تمثل نموذجا إيجابيا يحتاجه العالم العربي على نحو ما احتاج إلى نموذج الثورة التونسية.
ورغم أية صعوبات محتملة فإن حياة سورية قائمة على التعددية، ولو مضطربة، أفضل على مدى أطول للفلسطينيين وليس للسوريين وحدهم.
باختصار، يبدو أن الاستقلالية العربية حيال القوى الدولية إما أن تكون ديمقراطية أو لا تكون أبدا. مصر غير الديمقراطية لا يمكن أن تكون مستقلة. وسورية غير الديمقراطية أيضا.
الإسلام السياسي، ممثلا بتنويعات الإخوان المسلمين، مختلط السجل في شأن الاستقلالية. فقد كان تاريخيا في صراع مع الموجة السابقة من الاستقلالية العربية، وقد تمثلت في الحركة القومية العربية كما هو معلوم. ولطالما كان الإخوان أقرب إلى الحكم السعودي، وهو “الإقليم القاعدة” للّا استقلالية العربية، منهم إلى مصر الناصرية وسورية البعثية مثلا. لكن حركات الإسلاميين في الجيل الأخير أظهرت نزوعا استقلاليا وضعها في خصام مع القوى الغربية، هذا بينما كانت الحركة القومية العربية تتعفن وتفقد طاقتها التوحيدية (في سورية والعراق تحولت إلى قناع لعداء مستعر بين الدولتين، ولأسوأ أشكال التلاعب بوحدة الشعبين، وإلى إيديولوجية مشرعة لنظامين من الأشد وحشية عالميا)، وتخسر أكثر قدرتها على أن تكون القاعدة الفكرية والسياسية للاستقلالية في المجال العربي.
سوف يكون الإسلاميون سندا لسياسات مستقلة في المجال العربي بقدر ما يكونون قوة ديمقراطية وليس بقدر كونهم إسلاميين. وسيكونون عبئا على الاستقلالية بدرجة تتناسب مع نزوعهم إلا الاستئثار بالسلطة العمومية في بلداننا. هنا أصل الحكاية وفصلها.
هوامش (1) تراجع مقالة الكاتب: مفهوم لخط الفقر السياسي، على الرابط: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=27910.
(2) أضع مدرك “الإسلام” بين قوسين للقول إن الأمر لا يتعلق بتشكيل اعتقادي اجتماعي سياسي يبقى متماثلا مع ذاته على مر الأزمنة، بل هو يتشكل بنوعية الطلبات الاجتماعية الموجهة إليه، وهذه تحددها الشروط الاجتماعية العيانية. القصد نزع بداهة المدرك، والتنبه إلى عمليات “صنع الإسلام” وإضفاء الصبغة الإسلامية الجارية أمام أعيننا.
(3) الإسلام والمسلمون ليسوا غرباء على عملية اختراع التقاليد التي يتكلم عليها المؤرخ البريطاني إريك هوبسباوم في كتاب من تحريه بعنوان: اختراع التقاليد، ت: الحارث النبهان، مطبوعات وزارة الثقافة، دمشق، 2011. عقيدة الحاكمية الإلهية مثلا اختراع حديث، لكن جرى تأصيله بالعودة إلى القرآن والتجربة النبوية. أما مغزاه فلا يتعدى التطلع إلى السيطرة الكلية والحصرية على السلطة العمومية، على نحو وسم نماذج السلطة الشمولية قبل وبعد الحرب العالمية الثانية، ومعلوم أن أبو الأعلى المودودي، وهو مبتكر المفهوم كان متأثرا بتلك النماذج، وبه تأثر سيد قطب.
(4) ينظر في هذا الشأن كتابي: أساطير الآخرين، نقد الإسلام المعاصر ونقد نقده، الطبعة الأولى، دار الساقي، بيروت، 2011. بخاصة الفصل المعنون: الدين الحقيقي، الدين المحض، طبع الدين؛ هل الدين دين فحسب؟
(5) في التفكير العربي المعاصر هناك تصوران عريضا للديمقراطية، تصور إجرائي يعتنقه الإسلاميون عموما، ونجد عناصر له في كتابات الشيخ يوسف القرضاوي مثلا، ومفهوم ثقافوي، يرى الديمقراطية ثقافة، نشأت في الغرب، وعلينا أن نأتي بها كاملة. وخير مثال على هذا التصور هو كتاب ثقافة الديمقراطية للكاتب السوري جورج طرابيشي (صادر عن دار الطليعة في بيروت، 1998). وهو يرى أن أصل الاستبداد كامن في صناديق رؤوسنا فلا تحلها صناديق الاقتراع. في مواجهة هذين التصورين ننحاز إلى تصور اجتماعي وصراعي للديمقراطية، يشدها إلى العمليات والمقاومات الاجتماعية، وتكوّن الذاتيات السياسية، ويرى أن الثقافة الديمقراطية تتكون عبر الصراع الاجتماعي وكتعميم لعملياته. أقرب شيء إلى هذا التصور كتاب: ما هي الديمقراطية: حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية؟ للسوسيولوجي الفرنسي ألان تورين، ترجمة حسن قبيسي، دار الساقي، بيروت، 2001.
(6) من أجل مفهوم الدولة الخارجية، يراجع كتابي: السير على قدم واحدة، سورية المُقالة، الطبعة الأولى، دار الآداب، بيروت، 2012؛ ص 242-248.
(7) ارتبطت الأسر هناك بنشوء الدول وكياناتها، فلم تعرف السعودية أسرة حاكمة غير آل سعود ولا الكويت غير آل الصباح…، والأردن غير السلالة الهاشمية، وأعرق من الجميع المغرب في هذا الشأن الذي تحكمه الأسرة العلوية منذ قرون، بحيث تكاد تندغم شرعية الأسرة بشريعة الكيان ذاته. وهذا خلافا للأسرة الأسدية في سورية. هذه سبقها رؤساء وقادة متنوعون، الأمر الذي يضعف شرعية حكم الأسرة هنا. كان من أبرز هتافات الثورة السورية: سورية لينا [لنا]، وما هي لبيت الأسد! و: ما في للأبد [حكم أبدي]، ما في للأبد/ عاشت سورية ويسقط الأسد! سورية ممكنة بدون الأسد، خلافا لما يضمره شعار “سورية الأسد”، أو ترجمته الصريحة: الأسد أو لا أحد!
(8) http://www.almasryalyoum.com/node/561181. في وقت لاحق تنصل الرجل من الكلام مع المنبر الإسرائيلي، لكنه لم يتراجع عن مضمون تصريحه. http://www.alwafd.org/ميـديا/40-صحف/138854-حماد-يتبرأ-من-حواره-مع-إذاعة-جيش-إسرائيل
(9) في شأن هذا الاجتماع ينظر الرابط: http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=324653&IssueID=2380.
(10) لا يبدو أن إيديولوجية النظام الممانعة خدعت الشعب الفلسطيني اللاجئ في سورية. أكثر الفلسطينيين متعاطفون مع الثورة التي سقط خلالها 40 شهيدا فلسطينيا على الأقل حتى منتصف شهر يناير الماضي. ينظر الرابط: http://www.lccsyria.org/wp-content/uploads/2012/01/فلسطين-والثورة.pdf