رؤيــــة لمســار الثـــورات العــربيــة
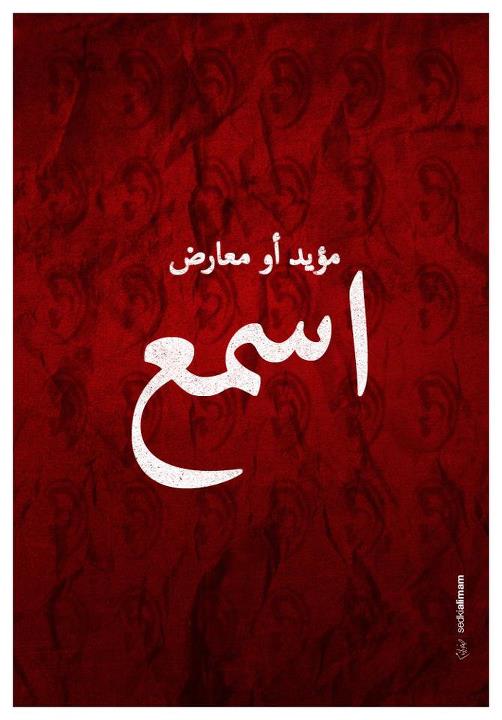
ســامح راشــد
تخفق الثورات لأسباب متعددة، أولها أن يتم إجهاضها من البداية، سواء بواسطة تدخل مباشر وشامل من السلطة الحاكمة، أو بتراجع القائمين عليها مبكراً لعدم وجود احتضان شعبي لها، وغالباً ما يصعب في هذه الحالة الفصل بين الثورة والانتفاضة المؤقتة أو الجزئية. هناك أيضاً أسباب ذاتية أخرى قد تسمح باندلاع الثورة لكن تحول دون اكتمالها أوعلى الأقل تعطلها. من أهمها افتقاد القيادة أو الأهداف الواضحة أو مقومات الاستمرارية. وأخيراً هناك سبب جوهري ومباشر هو التضييق على الثورة وخنقها سواء من جانب قوة داخلية أو خارجية، ما يحول دون نضج الثورة واكتمال مسيرتها، بل ربما يؤدي إلى الانقلاب عليها لاحقاً استغلالا لفقدانها التأييد الشعبي وبالتالي الحماية والشرعية.
تنجح الثورات إذا اجتمعت فيها المقومات السابقة، قيادة واعية محل توافق إن لم يكن إجماع، بالإضافة إلى أهداف واضحة وعملية وقابلة للتطبيق وتعكس مطالب وأوضاع الشعب بمختلف شرائحه الاقتصادية وطوائفه الاجتماعية واتجاهاته السياسية والفكرية. وأخيراً إذا نشبت الثورة في بيئة خارجية مواتية تقبلتها واعترفت بها ثم بدأت في التعاطي معها بإيجابية وتفاعلت معها بشكل يساعد على اكتمالها ونجاحها.
ولا يعني هذا بحال أن كافة عوامل النجاح لا بد أن تتوافر حتى تنجح الثورة، فهذه حالة مثالية يصعب تصورها عملياً. بيد أن المقصود هو غلبة عوامل النجاح على عوامل الفشل أو المعوقات. وفي كل الأحوال كان العامل الخارجي حاضراً دائماً في الثورات وعمليات التغيير السياسي سواء التدريجي أو المفاجئ في الدول حديثة العهد بالديمقراطية أو غير الديمقراطية أساساً. إلا أن حدود تأثير هذا العامل ضمن حزمة مقومات نجاح أو فشل عملية التغيير، ارتبطت دائماً بوزنه النسبي ضمن العوامل الأخرى وتالياً لها في الترتيب، خصوصاً تلك المتعلقة بمقومات ذاتية مثل توافر القيادة والتأييد الشعبي وواقعية الأهداف، فضلاً عن العامل الأكثر تأثيرا ومحورية وهو توافر مصادر القوة اللازمة لفرض إرادة الثورة.. وهي القوة التي تجسدها غالباً في هذه الحالة المؤسسة العسكرية أو الأمنية. ويتحدد تأثير العامل الخارجي إلى حد بعيد وفقاً لدرجة توافقه أو تعارضه مع مواقف هاتين المؤسستين سواء بتأييد ورفض الثورة وعملية التغيير.
مآلات الربيع العربي:
بالنظر إلى ما آلت إليه حالات الثورة والاحتجاج التي سادت الدول العربية العام الماضي، يمكن القول مبدئياً إن تلك الموجة لم تكن شاملة لكل الدول العربية ولا حتى لمعظمها، بل على العكس، فإن عدداً محدوداً فقط منها شهد تغيرات داخلية بفعل ثورة أو احتجاج، إذ لم يزد عدد تلك الدول عن 5 دول هي تونس، مصر، ليبيا، اليمن، سوريا. بل وصف أوضاع تلك الدول بالتغير يظل مجازياً ويتفاوت من حالة إلى أخرى، فسوريا مثلاً لا تزال تشهد ثورة مستمرة حتى الآن، ولم تسفر بعد عن تغيرات جوهرية ملموسة، لكن نظراً لأن العودة إلى ما قبل اندلاع الثورة هناك أصبح أمراً مستبعداً في ضوء التطورات والمعطيات الجارية، فهي تعد ضمن دول الربيع العربي التي لم تكتمل فيها دورة التغيير بعد. أما بقية الدول العربية فقد شهد بعضها حالات احتجاج محدودة أو جزئية، وبعضها الآخر لم محاولات حقيقية لإحداث تغير جذري أو حتى تحول تدريجي نحو تغيير منظومة الحكم. إذا في المجمل يصعب اعتبار وصف “الربيع العربي” وصفاً عاما شاملاً ينسحب على غالبية الدول العربية. وإنما هو توصيف لحالة بدت مبشرة بالعمومية والشمول، بيد أنها توقفت مبكراً فلم تمتد إلى كل الدول العربية، بل لم تتطور لا بالقدر ولا بالاتجاه ذاته في الدول التي طالتها.
وفي الدول الخمس المشار إليها، يمكن بسهولة اكتشاف أن تغيرات جزئية وقعت في كل منها، وتنصب بالأساس على شق بعينه أو مستوى معين من نظم الحكم فيها. تُستثنى من ذلك ليبيا التي لم تشهد في الأصل نظاماً بالمعنى المتعارف عليه. لذا فإن ليبيا هي الحالة الوحيدة التي شهدت إزاحة أو إطاحة كاملة للوضع القديم، الذي كان مختزلاً في شخص القذافي بالمعنى الدقيق وليس المجازي للاختزال.
ومن اللافت أن الترتيب الزمني لوقوع حالات الاحتجاج أو الثورة، يقابله ترتيب مشابه في التطور الذي شهدته كل من تلك الحالات؛ فتونس التي أشعلت شرارة الثورات العربية بهروب زين العابدين بن علي خارج تونس في الرابع عشر من يناير 2011، هي الأسبق حتى الآن في معدل التقدم نحو استكمال ما هدفت إليه ثورتها. ومصر التي تلتها زمنياً تليها أيضاً في مدى التقدم الحاصل، حيث أطيح بالرئيس المصري في الحادي عشر من فبراير 2011، وتباشر مصر حالياً عملية تجديد في السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً للاختيار الشعبي الحر. أما اليمن التي ظلت الثورة فيها تراوح مكانها طوال عام 2011 ولم تحرز الاحتجاجات الشعبية فيها تقدماً فعلياً إلا بعد توقيع المبادرة الخليجية بل بعد الشروع في تنفيذها فعلياً، فهي خرجت لتوها من عملية إحلال لشخص الرئيس بتولية نائبه الذي بدأ يشرع تدريجياً في تغير بعض القيادات السياسية والعسكرية ويواجه صعوبات ومشكلات حقيقية. بينما لا تزال الثورة في سوريا تصارع من أجل البدء في تحقيق أهدافها بإسقاط النظام الحاكم. ويكاد الوضع هناك يتحول إلى حرب أهلية بعد أن اتخذ منحى الصراع المسلح المباشر بين النظام وجماعات مسلحة بعضها تشكل خصيصاً من منشقين عن الجيش النظامي للدفاع عن المدنيين السوريين.
يصعب الجزم بوجود دلالة محددة للارتباط الشرطي الملاحظ بين الترتيب الزمني والترتيب الموضوعي لتطور حالات الاحتجاج والثورة المشار إليها. لكن ثمة تفسيراً أولياً لهذا الارتباط، مفاده أن النظم والقيادات الحاكمة في تلك الدول كانت تتابع ما جرى في الحالات التي سبقتها زمنياً، بيد أن اللافت بشدة أن في كل حالة تتجه القيادة إلى مدى أوسع في التمسك بالسلطة وتقطع شوطاً أبعد في الصراع المباشر مع الثورة أو الاحتجاجات الشعبية. إذاً نحن أمام مجموعة من المتشابهات والمشتركات جمعت حالات الاحتجاج والثورة في الدول العربية التي ينطبق عليها وصف الربيع العربي. وليس من المبالغة القول إن حالات أخرى من الاحتجاج الشعبي قد لا تنطبق عليها مواصفات الثورة أو لا تندرج بالضرورة في سياق ذاك “الربيع العربي” إلا أنها بدورها تتشارك دوله في طريقة تعاطي النظم الحاكمة مع الاحتجاجات. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك حالة البحرين، التي قد يصعب إدراجها ضمن حزمة دول الربيع العربي، نظراً لخصوصية تركيبتها الديموغرافية والطائفية الغالبة على مطالب الشريحة الشعبية المتمسكة بإسقاط أو تغيير نظام الحكم (رغم ضخامة حجم هذه الشريحة).
عوامل النجاح والفشل:
الدلالة المستخلصة من استعراض مآلات الربيع العربي، أن بين حالات ذاك الربيع اختلاف في طبيعة ومضمون كل حالة من ثورة بالمعنى الكامل إلى ثورة جزئية إلى احتجاجات طائفية إلى بذور ثورة تحولت سريعاً إلى حرب كاملة. لكن بينها أيضاً سمات وظواهر مشتركة أهمها انقسام قوى المعارضة وعدم وجود قيادة واضحة موحدة للثورة (عدا ليبيا). ما جعل معطيات ومجريات الربيع العربي في مجمله خاضعة في تطورها إلى محددين أساسيين: الأول هو مدى امتلاك الطرف القائم بالثورة (الشعب بالعموم أو القوى السياسية أو الرموز المحركة لها) أدوات إنجاحها ذاتياً. والثاني هو موقف الأطراف الخارجية الذي مثل بذاته في كل الحالات إما إضافة إلى تلك الأدوات، أو خصماً منها. وهذان العاملان هما محركا نجاح أو فشل الثورات العربية بل ويحكمان وتيرة تطورها واتجاهه.
– القوة المسلحة:
وينصرف الحديث عن الأداة الذاتية حصرياً إلى القوة المسلحة، فهي الأداة المباشرة التي تضمن فرض إرادة الثورة إذا أيدتها، أو تستطيع كسرها إذا وقفت ضدها. وبالنظر إلى الحالات الخمس المشار إليها (تونس، مصر، ليبيا، اليمن، سوريا) يمكن بسهولة ملاحظة ما للقوات المسلحة في كل منها من دور محوري في تحديد مصير الثورة أو الاحتجاجات المطالبة بالتغيير، وكذلك وتيرة التطور الحاصل في المضي نحو هذا المصير.
ففي كل من تونس ومصر، تدخلت المؤسسة العسكرية إثر تأزم الموقف وتزايد احتمالات تفجر الغضب الشعبي بشكل يصعب معه السيطرة على سلوك الجموع الغاضبة. فكان قرار القوات المسلحة في الدولتين بتبني المطلب الشعبي الأساسي وهو خروج رأس النظام من السلطة. ويلاحظ أن في الحالتين ظلت المؤسسة العسكرية تراقب تطورات الموقف دون تدخل، وتبنت حياداً سلبياً تجاه المواجهات الأمنية وأحداث العنف التي صاحبت الاحتجاجات، وكذلك تجاه الحلول والإجراءات السياسية التي حاول كل من بن علي ومبارك استخدامها لاحتواء المطالب الشعبية. إلى أن أخفقت المؤسستين الأمنية والسياسية بمعاونة المؤسسة الإعلامية في احتواء الموقف بل ساهمت في تعقيده وتأجيج الغضب الشعبي. فبادرت المؤسسة العسكرية إلى التدخل للحيلولة دون انفجار الموقف في وجه الجميع، عبر التضحية بقمة النظام الحاكم وبعض النخبة الضيقة المحيطة به. لكن اختلف تطور الحالتين لاحقاً، حيث توارت المؤسسة العسكرية في تونس عن صدارة المشهد السياسي وأفسحت المجال للسياسيين لقيادة البلاد وفق إجراءات سياسية متسلسلة، بالتوازي مع إجراءات تدريجية باتجاه إصلاح مؤسسي وحالات محاسبة لبعض المسؤولين السابقين عن الفساد المالي والسياسي. بينما في مصر تمسك المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاستمرار بلعب دور أساسي ومباشر في قيادة وحكم البلاد بمختلف مستوياتها وقطاعاتها. وتكشف لاحقاً أن أحد أبرز أسباب هذا التمترس في موقع القيادة والحكم هو عدم الاطمئنان لما قد يفضي إليه خروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي مبكراً، سواء بالنسبة لمستقبل البلاد وتطورها السياسي ككل، أو بالنسبة لمستقبل التعامل مع القوات المسلحة ذاتها (المؤسسة والقيادات). وعلى خلاف المرونة التي أبدتها المؤسسة العسكرية التونسية في السماح للقوى السياسية الثورية والمعارضة السابقة باستلام السلطة تدريجياً. كانت المؤسسة العسكرية المصرية أكثر تحفظاً واستمساكاً بتضييق مساحة الحركة أمام القوى الثورية والسياسية. وحرصت بوسائل قانونية مباشرة وأخرى غير مباشرة على تقليص هامش التغيير سواء السياسي أو الاقتصادي أو المؤسسي إلى أدنى حد وذلك فقط عند التعرض لأعلى درجات الضغط الشعبي.
إذاً يمكن القول إن أداة القوة الذاتية القادرة على فرض التغيير المطلوب، لم تكن متاحة في أيدي الثورتين التونسية والمصرية لدى نشوبهما. وقامت المؤسسة العسكرية في الدولتين بتدشين عملية التغيير نيابة عن الثورة، لكنها انسحبت بشكل كبير في الحالة التونسية وتركت الساحة السياسية للسياسيين، بينما وقفت في مصر حائلاً دون مضي الثورة والقوى السياسية في تحقيق ما كانت تطالب به من تغيير شامل لا يتوقف عند رأس النظام فقط.
في اليمن وليبيا وسوريا، وقفت المؤسسة العسكرية من اللحظة الأولى إلى جانب النظام الحاكم بشكل واضح. ورغم وقوع انقسام داخلها في حالة اليمن وصل إلى حد الاشتباك بين بعض مكوناتها، إلا أن هذا الوضع سابق على الثورة ويعزى إلى منهج منظم كان يعتمد الرئيس السابق علي صالح بتقسيم وتوزيع قيادة فرق وقطاعات القوات المسلحة بين أبنائه وأخوته. لكن الثابت أن القوات المسلحة لم تؤيد الثورة اليمنية من البداية، وظلت خيوط قيادتها والسيطرة عليها دانية لعلي صالح حتى بعد أن قام بالتوقيع على المبادرة الخليجية. وبعد تولي نائبه عبد ربه منصور هادي مقاليد الرئاسة بدأ إصلاح المؤسسة العسكرية عبر تغير بعض قياداتها الموالين بشدة لصالح، وواجه رفضاً قوياً وصل إلى حد إعلان بعض القيادات التمرد على قرارات استبعادها، ثم وقعت في أبريل الماضي محاولة فاشلة لاغتيال هادي أثناء عرض عسكري لقوات الأمن المركزي كان مقرراً أن يحضره.
ولا يحتاج الأمر في حالتي ليبيا وسوريا إلى إيضاح، حيث قامت المؤسسة العسكرية في البلدين بدور مباشر وجوهري في تعطيل انتصار الثورة الليبية، وهو ما تحقق في ليبيا بعد حرب ضروس كان الدور الأكبر فيها للمشاركة العسكرية الخارجية، أفضت إلى تدمير وتفكيك البنية العسكرية التابعة للقذافي. ولا تزال ليبيا تعاني من غياب سلطة أمنية ودفاعية مركزية تتولى حماية البلاد والعباد، حيث تقوم بتلك المهام فصائل متنوعة المشارب من الثوار. ما جعل المسار السياسي في ليبيا منفصلاً نسبياً عن الوضع الميداني وتوزيع القوة الصلبة. وأدى إلى وقوع احتكاكات بينهما فضلاً عن خلافات ومواجهات تكررت بين الأطراف التي تمتلك السلاح خصوصاً القبائل في مواجهة فصائل الثوار. والمحصلة هي بطء التقدم نحو إعادة توزيع الموارد وتحقيق تنمية شاملة في أنحاء ليبيا خاصة تلك التي عانت تهميشاً طويلاً إبان عهد القذافي، مع افتقاد السيطرة المركزية على مفاصل الدولة وأدوات قوتها. فاندفع بعض سكان المنطقة الشرقية إلى إعلان رغبتهم في إقامة إقليم مستقل واعتماد الفيدرالية نظاماً للدولة الجديدة. الأمر الذي أصاب الحالة الليبية بدرجة من الجمود والتعثر في مضمون وحقيقة التغيير الذي تطلع الليبيون إليه. وإن كانت الاستحقاقات المقررة تمضي في إجراءاتها (مثل انتخابات المؤتمر الوطني الذي يمثل أول جمعية تأسيسية منتخبة) إلا أن اكتمال مراحل وإجراءات هذا المسار تظل محل، فضلاً عن فرص نجاحها في وضع ليبيا على الطريق السليم قريباً في ضوء التعقيدات المحيطة بها.
في حالة سوريا، تركيبة المؤسسة العسكرية السورية تشبه إلى حد ما مثيلتها في اليمن، فهي موزعة إلى قطاعات تتفاوت في درجة عدائها وممارساتها ضد الثوار والمدنيين السوريين، حسب درجة ولائها واقترابها من دائرة الحكم في دمشق. إلا أن غياب الدور الخارجي العسكري المباشر كان سبباً كافياً في عدم حسم الوضع الميداني لصالح الثورة السورية. وإن كان وجود الضغط السياسي الخارجي قد ساهم بشكل كبير في منع الآلة العسكرية السورية من قمع الثورة وتصفيتها كاملة بالقوة المسلحة.
– الدور الخارجي:
المحدد الثاني لتطور الثورات العربية وما آلت إليه، خصوصاً تلك التي لم تحقق نجاحاً بعد. هو موقف الأطراف الخارجية. ويشمل النطاق الخارجي المقصود هنا المستويين الإقليمي والعالمي، أي الأطراف العربية وغير العربية من داخل المنطقة، والأطراف الأخرى من خارجها. وليس من المتصور أن تكون البيئة الخارجية مواتية بشكل كامل أو رافضة بشكل كامل، فدائماً هناك مصالح متباينة وبالتالي مواقف وسياسات متباينة. حتى وإن اندرجت جميعا في اتجاه واحد سواء بقبول أو رفض الثورة. لكن تتفاوت درجة القبول أو الرفض وكذلك أشكاله وأدواته. ما ينعكس بالتالي على درجة وطبيعة تأثر الثورة بتلك البيئة الخارجية والتفاعل بينها وبين كل من مكونات تلك البيئة الخارجية بمستوييها الإقليمي والعالمي. ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى بعض أمثلة التعامل الخارجي مع الثورات. ومن أشهرها ما عرفت باسم ثورة مصدق في إيران، فقد كانت الولايات المتحدة تتابع ثورة التغييرات والتطلعات التي فجرها مصدق في طهران، وما إن تحولت تلك الموجة من التطلعات إلى سياسات وإجراءات تمس مباشرة مصالح الولايات المتحدة وتحديداً الشركات النفطية الأمريكية، تم الضغط على إيران مصدق بأشكال متعددة أفضت إلى الانقلاب عليه وانتكاس ثورته أو بالأحرى “انتفاضته” الوطنية المدعومة شعبياً. وهناك أمثلة أخرى مشابهة في بعض دول أمريكا اللاتينية، فبعض حالات التغير السياسي الداخلي كانت تجري بدعم خارجي مباشر سواء كان التغير نتيجة ثورة شعبية أو انقلاب عسكري، بما في ذلك انقلابات وقعت ضد ثورات شعبية.
فيما يتعلق بالربيع العربي، أول ما يدعو إلى التأمل في هذا الصدد، هو وجود علاقات ارتباط واضحة بين الخصائص المميزة لكل من حالات الربيع العربي، وتأثير الأدوار الخارجية فيها. وأول ما يمكن رصده من تلك العلاقات الارتباطية، التناسب العكسي بين المدى الزمني لاندلاع الثورة أو تفجر المطالب الشعبية ومعدل تطورها، وحدود التدخل الخارجي المباشر. فالملاحظ في الحالتين التونسية والمصرية، أن الأطراف الخارجية (بمستوييها الإقليمي والعالمي) فوجئت باندلاع الأحداث وبتطورها سريعاً، فاستغرقت في البداية فترة زمنية (تكشف لاحقاً أنها كانت طويلة للغاية مقارنة بمعدل تطور الواقع على الأرض) قبل أن تبدأ في التفاعل معها وتبني أي موقف. ففي حالة تونس ظلت الدول الكبرى المعنية بشؤون المنطقة، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا، بعيدة عن التفاعل المؤثر مع ما يجري داخل تونس لعدة أيام.
وكما فوجئ العالم كله باندلاع ثورة في تونس ثم أخرى في مصر بعد أيام فقط من نجاح ثورة تونس. كان يفاجأ أيضاً بتلاحق الأحداث في كل منهما بشكل لم يكن يسمح بفرصة واسعة لدراسة الأمر وتقدير الموقف والمفاضلة بين البدائل. إلى حد أن الموقف الأمريكي من الثورة المصرية خلال أيامها الثمانية عشر، كان يتحدد يوما بيوم بل تغير أكثر من مرة في يوم واحد عندما جاء السفير/ فرانك ويزنر (سفير أمريكي سابق في القاهرة) مبعوثا من أوباما لبحث الموقف في مصر مع مبارك. وإذ كانت القوى من خارج المنطقة عاجزة عن ملاحقة الأحداث، فإن دول المنطقة لم تكن في وضع أفضل. باستثناء بعض محاولات دول عربية الوقوف إلى جانب مبارك في أيامه الأخيرة عندما بدا واضحاً إن حكمه إلى زوال، فأعلنت دول خليجية أنها مستعدة لتقديم مساعدات مالية ضخمة لمصر إذا بقي مبارك في الحكم. أما جامعة الدول العربية فلم تتبن أي موقف ولم يكن لها دور يذكر.
في المقابل فإن امتداد حالات اليمن وليبيا وسوريا لأشهر طويلة، ترافق مع وجود دور كبير ومؤثر للأطراف الخارجية، سواء من داخل المنطقة أو خارجها. ربما يكون هذا الارتباط العكسي بدهياً، لكن دلالته المهمة تكمن في شموله دولاً شديدة الأهمية بالنسبة لدول المنطقة والعالم مثل مصر، ودولاً أقل أهمية ومحورية مثل ليبيا، ورغم ذلك فإن القدرة الخارجية على التأثير المباشر في مجريات الثورة المصرية وقت اندلاعها كانت ضئيلة للغاية. ما يعني أن المفاجأة تفوقت في تأثيرها على الدراسات والخطط الموضوعة مسبقاً والمفترض أنها تتحسب لكافة السيناريوهات المحتملة في دولة بحجم وثقل مصر بالنسبة لواشنطن.
الظاهرة الثانية التي تستحق التوقف عندها فيما يتعلق بتأثير العامل الخارجي على تعطل أو تقدم الثورات العربية، هي الارتباط بين حدود الاتساق والتوافق بين الأطراف الخارجية، ومدى التقدم في عملية التغيير الداخلية بل وإنهاء الأزمة المتعلقة بمبدأ إحداث التغيير أساساً. فبعيداً عن حالتي مصر وتونس اللتين لم تدخلا في نطاق التأثير أصلاً، لوحظ أن التدخل المباشر متعدد الأطراف في حالتي ليبيا واليمن كان عاملاً أساسياً في اجتياز الثورة مرحلة الأزمة المستحكمة، وانتقالها إلى وضعية الحل وإجراء عملية التغيير. وذلك على خلفية التوافق حول أسلوب حل الأزمة في كل منهما. بخلاف الحالة السورية التي كانت محل خلاف من البداية على كافة المستويات، بدءاً بالمستوى العربي حيث تباينت مواقف الدول العربية تجاهها، بين اعتبارها شأن داخلي بحت، وتقييم مبكر لها بأنها ثورة كاملة تحتاج إلى مساندة ودعم خارجيين. ثم على المستوى الإقليمي حيث برز –ولا يزال- تناقض واضح بين موقفي إيران وتركيا من تطورات الأزمة السورية. والأمر أكثر وضوحاً بالنسبة للأطراف من خارج المنطقة. إجمالاً يمكن القول إن حضور أو غياب التنسيق والتوافق في حسابات ومصالح الأطراف الخارجية تجاه كل من حالات الربيع العربي كان سبباً مباشراً وجوهرياً في تعجيل أو تعطيل مسار الثورة والتغيير.
والسؤال الذي يستحق الطرح في هذا السياق، يتعلق بحسابات تلك الأطراف تجاه كل من حالات الربيع العربي. بما في ذلك المصالح المطلوبة والقيود المفروضة على تلك الأطراف، بحيث أمكنها التوافق معاً على ضرورة التدخل المباشر بأقصى أشكاله في ليبيا مثلاً، وعجزت عن الأمر ذاته بالنسبة لسوريا، بينما توافق معظمها على إدارة الثورة اليمنية بخطة سياسية متدرجة وقامت فعلياً بتطبيقها على الثوار وعلى النظام.
قدمت بعض التحليلات تفسيرات محددة وقاطعة للتوافق الخارجي حول التدخل العسكري المباشر في ليبيا، يتمحور التآمري منها حول الثروة النفطية الليبية. بينما يركز الرسمي منها على الجانب الأخلاقي المتعلق بحماية المدنيين من الإبادة بواسطة القذافي. وهذا التبرير تحديداً هو ما تبنته الجامعة العربية في تسويق قرارها استدعاء مجلس الأمن لفرض منطقة حظر جوي على ليبيا. وهو الذي فتح الباب أمام التدخل العسكري الخارجي بتفويض من مجلس الأمن. أما في سوريا فرغم تبني بعض الدول العربية الحجة ذاتها لتبرير الدعوة إلى تدخل عسكري مباشر، إلا أن القيود التي واجهتها الأطراف الأخرى هي التي منعت الاستفادة من ذلك الغطاء العربي للتدخل العسكري المباشر، خاصة بعد أن قامت الجامعة العربية بالفعل إحالة الملف إلى مجلس الأمن. بيد أن التحرك الدولي المدفوع أمريكيا وعربياً ووجه بموقفي روسيا والصين في الأمم المتحدة، وموقف إيران الداعم بشكل مباشر وعملي للنظام السوري سياسياً واقتصادياً. وبعد أن كانت تلك الفجوة في المواقف هي القيد الأساس على فكرة التدخل العسكري. تولدت بمرور الوقت وطول أمد الأزمة قيود أخرى من أهمها دخول الولايات المتحدة عام الانتخابات الرئاسية بما يفرضه من تكبيل شبه كامل للرئيس الأمريكي في حركته الخارجية خصوصاً فيما يتعلق بقرارات مهمة مثل العمل العسكري. لذلك يمكن بسهولة ملاحظة أن الأطراف الخارجية المعنية بإدارة الأزمة، لجأت جميعا إلى إعادة إنتاج حلول وخطط سبق تجربتها بنفس تفاصيلها تقريباً. فيما يمكن اعتباره مخرجا سياسياً حظي بتوافق ضمني غير معلن بين مختلف الأطراف. فالمبادرة العربية التي بدئ في تنفيذ أهم بنودها وهو إيفاد بعثة مراقبة إلى سوريا مطلع العام الجاري. لم تتح لها الفرصة للنجاح أو حتى للتطبيق الجيد والكامل. وتم سحب بعثة المراقبين قبل اكتمال عددهم وعلى الرغم من أن تقرير رئيسها (مصطفى الدابي) كان تقييمه لها إيجابياً وطالب بتوسيع نطاقها وزيادة عدد أفرادها حتى تتمكن من إنجاز مهمتها بصورة أفضل. لكن مبادرة بعض الدول العربية سحب مراقبيها والعمل من خلال الجامعة العربية على اعتبار المهمة قد فشلت كان هو السبب الأساس في عدم اكتمال المهمة بالفعل وفشل المبادرة العربية. لكن عجز مجلس الأمن عن التحرك ضد النظام السوري دفع الأطراف كلها مرة أخرى إلى إحياء الخطة العربية لكن تحت مظلة أوسع وبصياغة أخرى عرفت باسم “خطة عنان” وهي تكاد تتطابق مع الخطة العربية السابقة. المعنى الكامن في هذا التسلسل أن أحد المعسكرين الخارجيين المعنيان بالأزمة السورية لديه رغبة قوية في دفع الأزمة السورية نحو الحسم عسكرياً أو بالضغط المباشر أياً كانت طبيعته. إلا أن العقبات التي واجهته متمثلة في موقف المعسكر الآخر (تقوده روسيا والصين وإيران) ثم القيود الأمريكية الداخلية، دفعت إلى تبني حل سياسي مكرر ومجرب من قبل بشكل جزئي. ورغم مرور أسابيع على الشروع في تنفيذ “خطة عنان” لا يزال الوضع على الأرض يراوح مكانه، وتواجه الخطة ذات العقبات التي واجهتها من قبل الخطة العربية.
الحالة اليمنية تقدم مثالاً أكثر وضوحاً على الدور الخارجي ومحوريته في توجيه مسار الثورة ومعالجة الأزمة المرتبطة بها. فمع استمرار أعمال العنف من جانب قوات الأمن اليمنية تجاه المتظاهرين السلميين وعدم استجابة الرئيس اليمني لمطالب الخروج من السلطة. بادرت بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوساطة بين صالح والمعارضة اليمنية، ثم طورت جهود الوساطة في مبادرة متكاملة تضمن خروج صالح مكن السلطة بشكل سلمي مع عدم ملاحقته قضائياً، وبنود أخرى ترسم خارطة طريق سياسية لتحقيق جزئي متدرج لمطالب الثوار اليمنيين، دون تغيير جذري كامل أو مفاجئ في هيكل السلطة. وبعد عدة تعديلات وصياغات قبل الرئيس اليمني السابق المبادرة “برعاية” سعودية مباشرة. ووصلت مراحل تنفيذها حالياً إلى ما أشير إليه سابقاً بشأن إصلاح الجيش وتصحيح بعض الأوضاع المتعلقة به خصوصاً على مستوى المناصب والقيادات. ومن المهم هنا الانتباه إلى غياب أي دور للجامعة العربية في إدارة هذا الملف من بدايته وحتى الآن. وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس الأمن. مع عدم وضوح طبيعة وحدود أدوار أطراف خارجية أخرى غير دول مجلس التعاون الخليجي، منها إيران من داخل المنطقة، والولايات المتحدة من خارجها. لكن غياب أو على الأقل محدودية تلك الأدوار الأخرى، لا تعني بالضرورة خلافاً أو اختلافاً حول صيرورة الأزمة ومراحل تطورها، بل قد تعني بحد ذاتها قبول تلك الأطراف الغائبة -ظاهرياً على الأقل- وإقرارها بما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي.
إذاً بالنظر إلى مختلف حالات الثورة والتغير الداخلي التي شهدها العالم العربي العام الماضي ولا يزال، سواء التي لا تزال معلقة وتنتظر مزيدا من التقدم مثل اليمن وليبيا، أو سوريا التي لا تزال تعاني من مخاض لفظ النظام القديم، يمكن القول إن توسيع نطاق الدور الخارجي ونقل الملفات إلى الإطار الدولي لا يساعد على حل الأزمات ولا على إنجاح الثورات أو حتى إنقاذ أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين. على خلاف الحالة اليمنية التي تمت إدارتها على نطاق محدود أضيق حتى من الجامعة العربية ذاتها. ورغم استغراق تنفيذ المبادرة الخليجي شهوراً، إلا أنها في النهاية طبقت وبقدر من الخسائر البشرية أقل كثيراً ما وقع في سوريا وأيضاً مما تكبدته ليبيا ثمنا للتدخل العسكري المباشر والشامل ضد القذافي. وفي المقابل، فإن دور المؤسسة العسكرية –شأن كل الدول غير الديمقراطية- كان محورياً في حماية أو تعطيل مسار الثورة في حالات الربيع العربي. بيد أن تطور الدور اختلف من حالة إلى أخرى. فبدا واضحاً أن أكثرها تقدما هي تلك التي شهدت ابتعاداً سريعاً للمؤسسة العسكرية فور اضطلاعها بمهمة حماية وإنجاح الثورة لدى اندلاعها، بينما تلك التي لا تزال المؤسسة العسكرية أو بعض فصائلها تعمل لحساب النظام الحاكم بشكل كامل، فهي التي لم تغادر بعد مرحلة الأزمة، ولم تحقق الثورة فيها أياً من أهدافها بعد. وبين هذه وتلك توجد حالات يتفاوت فيها قرب أو ابتعاد المؤسسة العسكرية عن مجريات الأحداث السياسية. وبغض النظر عن دوافع وخلفيات اختيار بعد أو قرب تلك المسافة، الواضح أنه كلما كانت أكثر قرباً كلما كان المسار أكثر تعقيداً وأقل إيجابية بالنسبة لتحقيق وإنجاز التغيير الذي استهدفته الثورات أصلاً.
عن مجلة شؤون عربية – العدد 150





