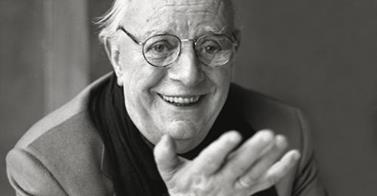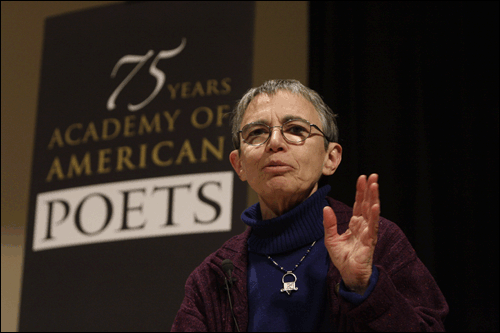بيوت الديكتاتوريين/ أمير تاج السر
في مكتبة صغيرة في مدينة مانشستر البريطانية، عثرت على كتاب مصور رخيص اسمه: ، قام بإعداده صحفي بريطاني، والكتاب كما هو مبين من عنوانه، من نوع تلك الكتب التي غالبا ما تكون تحقيقات فضولية، يقوم بها البعض، وينشرونها في الصحف، ثم يجمعونها في كتاب.
ولا أعتقد شخصيا أنها تهم قطاعات كبيرة من القراء، باعتبار أن البيوت حتى لو كان يسكنها ديكتاتوريون، أو سفاحون هي في النهاية لا تدخل بقوة في التاريخ الشخصي لأولئك السكان، وأيضا أن أولئك الموصوفة بيوتهم، لم يحكموا العالم كله، ليهتم بهم، وإنما حكموا شعبا معينا، وللأسف لا تنكشف سؤاتهم، وتوصف بيوتهم في مثل هذه الكتب، إلا بعد موتهم أو إسقاطهم، كما لاحظت في كل النماذج التي أوردها هذا الكتاب ابتداء من جوزيف بروس تيتو، الذي حكم يوغسلافيا السابقة منذ أربعينيات القرن الماضي، حتى الثمانينيات، إلى صدام حسين، العراقي الذي أسقط في الألفية الجديدة.
لكن ما يجعل مثل هذا الكتاب شعبيا، ويمكن أن يتصدر قوائم المبيعات أيضا. في الغالب، ذلك الكم الهائل من الفضول الذي يكتسينا جميعا من مجرد مشاهدة العنوان، وتلك الرغبة الكبيرة، أن نرى كيف كان يعيش أولئك الذين تبدو حياتهم الخاصة بعيدة تماما عن التصور.
في البداية أؤكد أن الديكتاتورية في حد ذاتها، مرض من الأمراض المزمنة. يصاب به البعض ولا يصاب البعض الآخر، ليست ديكتاتورية حكم الشعوب وإذلالهم والتحكم حتى في أمزجتهم، فقط، ولكن أيضا ديكتاتورية أن تدير وتتحكم في محل للحلاقة مثلا، به عدة عاملين، وأن تكون مناديا للسيارات في موقف يضطر الناس إلى دخوله والخروج منه، وأيضا أن تكون ربة منزل، تمتلك صلاحية أن تجوع سكانه أو تشبعهم، وما زلت أذكر بالرغم من مرور زمن طويل، عثمان هيصة، سائق العربة الفقير الذي عمل في إحدى المؤسسات الزراعية، أقصى شرق السودان، أيام أن كنت أعمل هناك، وكان بما يسكنه من أعراض مرض الديكتاتورية، قادرا على التحكم حتى في رؤسائه الفعليين، وتسييرهم حسب إرادته، وكان عاديا جدا أن تجد سيارة المؤسسة الخاصة بالمدير، مركونة أمام بيته في أي وقت، بينما المدير يمشي في البلدة على قدميه. وأظنني ذكرت في كتابي مرايا ساحلية، الذي تحدثت فيه عن سيرة مدينة بورتسودان أوائل سبعينيات القرن الماضي، ابن عوف، الخفير بالمستشفى، القادم من شمال السودان، حين كان يتحكم في باب الدخول، مانعا المرضى ومرافقيهم من الدخول، وأحيانا لا يسمح حتى للأطباء بالدخول لممارسة عملهم. ولدرجة أن مظاهرة تهتف بسقوطه، أسوة بالديكتاتوريين العظماء، اندلعت في المدينة ذات يوم. وتعودت أن أجد في كل مكان أذهب إليه، أو تربطني به صلة عمل أو كتابة، ديكتاتورا يتوج نفسه عائقا أمام أي سهولة أو سلاسة، لا لشيء، سوى أنه مصاب بمرض الديكتاتورية.
بعيدا عن نماذجي، بالطبع، يأتي كتاب: ، يأتي بشرح واف عن كل ديكتاتور ورد ذكره، وفترة حكمه إن كان حاكما، أو تقلده لوظيفته إن كان في وظيفة أخرى ذات مسؤوليات كبيرة، مع نشر عدد من الصور التي تبين الداخل المخفي، المريب، الشاد للفضول بالتأكيد، في كل بيت.
لكن ماذا يتوقع أن يطالع القارئ في الكتاب، أو يعرف ماذا في داخل هذه البيوت؟
في الحقيقة، وفي أي كتاب سيبدأ أحد قراءته، لا بد أن ثمة تصورات. كتاب عن راقصة يمنح تصورات معينة، عن مغن أو لاعب كرة، يمنح تصورات معينة أيضا، وحين يطرح لاعب التنس أندرية أجاسي كتابا عن حياته، يستطيع من ينوي قراءته أن يتخيل أمجادا رياضية، وحياة كلها نجاح، تلمع في كل صفحة من صفحات الكتاب، وهكذا داهمتني الهواجس في ، وأنا أبدأه، أتوقع أن يسيل الدم من صفحاته، أن تكون الديكورات الداخلية جماجم، والسجاد على الأرض، من أجساد البشر،
لكن شيئا من هذا لم يحدث في الواقع، كانت البيوت كلها تقريبا متشابهة في تأثيثها، وتشبه أي بيوت ربما يملكها مواطنون عاديون في أي مكان. أصص الأزهار في كل ركن، الزوايا الخشبية التي تحمل التحف الصغيرة، والمكتبة التي في الغالب بطول الحائط وممتلئة بالكتب المتنوعة. يوجد سجاد يبدو عاديا وليس من النوع الغالي أو الفاخر، توجد غرف نوم وغرف جلوس مفروشة بعناية، لكنها ليست فاخرة جدا، ربما كان ثمة ببغاء في قفص، أو حوض لأسماك الزينة ، به عدة سمكات، وباستثناء الخزائن الخاصة بزوجات بعض الديكتاتوريين، وأشهرها صورة خزانة أحذية إميلدا ماركوس، زوجة رئيس الفلبين القديم، والغاصة بآلاف الأنواع من الأحذية، لا يوجد شيء غريب.
إذن وباختصار شديد، فإن معظم ما ذكر عن هنا، لم يكن مثيرا أو مشبعا لفضول القراءة، ولا أحسست به يغطي العنوان الكبير الممد في الكتاب. ربما كانت تلك البيوت هكذا فعلا، وربما لم تنبش جيدا ولم تقرأ سيرها جيدا، وبالتالي كانت كتابتها ونشرها، مسألة بلا معنى.
كاتب سوداني
القدس العربي