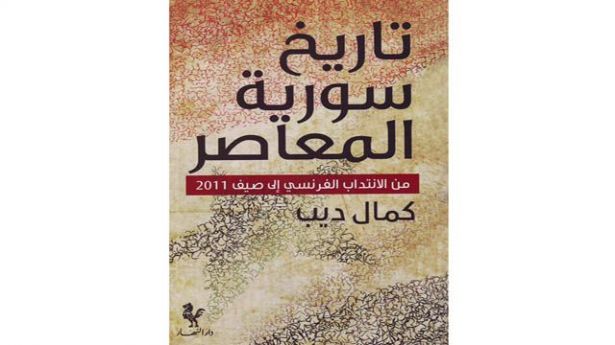تاريخ لبنان الثقافي: ثقافةٌ سادت ثم “بادت”!/ جمال شحيّد

صدر هذا الكتاب عن المكتبة الشرقية (بيروت) في نهاية 2016. ويتابع فيه كمال ديب مسار الثقافة في لبنان خلال قرنين من الزمان. والكاتب أستاذ جامعي كندي لبناني يدرّس في جامعة أوتاوا؛ له زهاء خمسة عشر كتاباً في التاريخ السياسي بخاصة، ومنها “تاريخ سوريا المعاصر: من الانتداب الفرنسي إلى صيف 2011″ و”أزمة في سوريا: انفجار الداخل وعودة الصراع الدولي 2011- 2013″ و”الحرب السورية”. ويقع “تاريخ لبنان الثقافي” في 590 صفحة، يعالج فيه الكاتب المسألة الثقافية في لبنان منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى العقد الثاني من القرن الحالي.
قد لا يوافق قارئ مثلي على كل ما يقوله كمال ديب عن الثقافة والمثقفين في لبنان، لكن الكتاب موثّق أكاديمياً، وفيه معلومات وتفاصيل كثيرة عن المجال الثقافي اللبناني، بدءاً من عهد المتصرفية ومروراً بدولة لبنان الكبير ووصولاً إلى ولادة الشخصية الثقافية اللبنانية، التي أرادها ديب متمايزة عن الشخصية الثقافية العربية إجمالاً، مع أنه تكلّم عن مثلث حلب بيروت القاهرة ثقافياً.
عباءة فضفاضة
يستهل الجانب الثقافي من كتابه بالتكلّم عن خليل مطران ويتوقف مطولاً عند جبران خليل جبران ليصل إلى خمسينات القرن العشرين مع الأدب الملتزم. وينتقل بعد ذلك إلى مجالين هما الفولكلور والدبكة من جهة والمطبخ من جهة أخرى. ولا شك أنه كمغترب هاجر إلى كندا منذ أكثر من عشرين سنة يحنّ إلى أجواء القرية اللبنانية بعاداتها الاجتماعية والمطبخية، ولكنها لا تدخل مباشرة في صميم الثقافة التي وضعها نصب عينيه في هذا الكتاب. ثم يتوقف عند الأخوين رحباني وفيروز وزياد. وينتقل بعدها إلى الشعر، فيتكلم عن أدونيس ويوسف الخال ونزار قباني – وهم سوريون – وعن محمود درويش – وهو فلسطيني – وعن خليل حاوي – وهو لبناني–. ويتساءل القارئ لماذا وضع هؤلاء الشعراء الأربعة تحت العباءة اللبنانية. ألأنهم عاشوا فترة من حياتهم في بيروت؟ أم لأنهم ساهموا في بناء ما يسميه “الثقافة اللبنانية” التي هي بالأحرى “الثقافة العربية”؟
ثم يأخذنا ديب إلى نشأة المسرح على يد مارون النقاش (1817-1855). ويمرّ بسرعة على الحركة المسرحية الضعيفة ما بين 1900 و1950، مستشهداً برأي ساخر لميخائيل نعيمة في كتابه “الآباء والبنون” يقول: “شعبنا لم يدرك بعد أهمية التمثيل في الحياة، لأنه لم يرَ بعد نفسه على المسرح، واللوم على كتّابنا لا على الشعب”. ويعود ذلك ربما إلى ربط المسرح بالفسق والفجور، مما دفع بعض المسرحيين آنذاك إلى التخفي وراء أقنعة كي لا تُجرَح سمعتهم الاجتماعية والاعتبارية. وينتقل بعدئذ إلى النشاط الذي دبّ في المسرح اللبناني بعد عام 1960 مع منير أبو دبس وأنطوان كرباج القائل بأن المسرح “علم”، وريمون جبارة وأنطون ملتقى وروجيه عساف ونضال الأشقر. كما يتكلّم عن أهم الفرق المسرحية ومنها “محترف بيروت للمسرح” و”المسرح الاختباري” و”فرقة شوشو” و”الفرقة الرحبانية”. ويصل إلى مسرح زياد الرحباني ويسهب في تحليل مسرحياته: “سهرية” (1973)، “نزل السرور” (1974)، “بالنسبة لبكرا شو” (1978)، “فيلم أميركي طويل” (1980)، “شي فاشل” (1983)، “بخصوص الكرامة والشعب العنيد” (1993)، “لولا فسحة الأمل” (1994)، “الفصل الأخير” (1994). ويتوقف الكاتب بعد ذلك عند مسرح الشانسونييه، وبخاصة عند “مسرح الحكواتي” مع المسرحي العبقري روجيه عساف بمسرحيات مشهورة كـ”مجدلون” (1968) و”بيان الحكواتي” (1979) و”أيام الخيام”(1984).
جرد سينمائي
وينقلنا ديب إلى السينما اللبنانية التي انتقلت من أفلام “سفر برلك” (1967)، “بنت الحارس” (1968)، “بياع الخواتم” (1964) التي تتكلم عن الأرزة وجرن الكبة والدبكة وخبز المرقوق والدلعونا. ويتوقف عند أكبر مخرجَين لبنانيين هما برهان علوية (مع فيلم “كفر قاسم” 1974، و”لا يكفي أن يكون الله مع الفقراء” 1978 [وهو فيلم عن تجربة المعماري المصري حسن فتحي]، و”رسالة من زمن الحرب” و”رسالة من زمن المنفى” 1988، و”إليك أينما تكون” 2001)، ومارون بغدادي في أفلام يتيمة هي “بيروت يا بيروت” (1975)، و”حروب صغيرة” (1982)، و”لبنان بلد العسل والبخور” (1987)، و”الرجل المحجب” (1987) قبل أن يخطفه الموت الكارثي عن عمر ناهز 33 سنة فقط. ويستعرض ديب سينما ما بعد الحرب اللبنانية مع سمير حبشي وزياد الدويري ونادين لبكي، وتأسيس السينماتيك اللبنانية عام 2002. ولا يغفل عن ذكر نقّاد السينما مثل إبراهيم العريس وجورج كعدي ونديم جرجوره ومحمد سويد وإميل شاهين ورندة الشهال. ولاحظ أن السينما اللبنانية تفتقر إلى مؤسسات تدعمها. لذا اعتمد المخرجون الشباب على التمويل الخارجي الأوروبي بخاصة، كليلى عساف في فيلم “الشيخة”، وسمير حبشي في فيلم “الإعصار”، وجوسلين صعب في فيلمي “كان ياما كان” و”بيروت”، وجان كلود قدسي في فيلم “آن الأوان”. ويذكر المؤلف وجود 180 صالة سينما في لبنان عام 1975، ولم يبق منها إلا 27 صالة بما فيها الصالات المستحدثة. ويدرج قائمة بـ36 فيلماً لبنانياً لفتت اهتمام نقاد السينما.
ماهية لبنان
ويكرّس الكاتب للفكر اللبناني فصلين طويلين لاحظ فيهما ظهور منحنيين فكريين متعارضين: منحنى العروبة والمشرقية، ومنحنى الفَرْنَجة والأوْربة. وكلاهما حاولا تبيان “ماهية لبنان” و”ماهية المقدّس”. يقول: “منذ الثلاثينات إلى السبعينات من القرن العشرين، كان الاغتراب النفسي يتعمق حيث كان أساتذة بعض المدارس يقطبون حواجبهم أمام احتمال انتماء تاريخ لبنان إلى محيط مشرقي وعربي. حتى أن المعلمين والمعلمات وذوي الطلاب في بعض المدارس كانوا يشجعون الطلاب على التحدث بالفرنسية دون العربية، وعلى تعلم تاريخ فرنسا وثقافتها… وفي مدارس أخرى سخر المعلمون من الفرنسة والفينقة، وذكّروا طلابهم من خارج المنهاج الرسمي بعروبة لبنان وأهمية التراث الإسلامي فيه”.
أمام هذا الشرخ الفصامي في تحديد هوية لبنان، يتوقف ديب عند بعض المفكرين الذين حاولوا تحديد وإبراز العلامات الفارقة في الهوية اللبنانية. يتوقف عند كمال الحاج القائل في مناقشته مع قومي عربي: “إن اللبناني، الذي يطمح إلى القومية العربية، يعمل ضمناً على إزالة لبنان، إن آجلاً وإن عاجلاً… فإما لبنان ضد القومية العربية، وإما مع القومية العربية ضد لبنان… هب أن القومية اللبنانية كرتونة، فقد تغلبت هذه الكرتونة على فولاذكم المزعوم. وعندما يتغلب الكرتون على الفولاذ فهذا يعني أن كرتوننا فولاذ وأن فولاذكم كرتون”. ويبتدع كمال الحاج كلمة “نصلامي” [نصراني + إسلامي]، وهما المكوّنان لقومية لبنانية واحدة، في نظره.
الحل هو العلمانية
ويتوقف الكاتب عند كتاب “المثقفون العرب والغرب” (1970) لهشام شرابي، فيمايز بين فئتين من المثقفين: فئة المثقفين المسلمين – وهي أسيرة التحريم وتمثل التيار المحافظ في الثقافة العربية الذي يستمد نسغه من التراث التراكمي عبر التاريخ أو من العصر الذهبي في الحضارة العربية – وفئة المثقفين المسلمين الذين “تمسكوا بالقيم والأهداف المستمدة من الغرب، وربطوا المسيحيين العرب بالحضارة الأوروبية والغربية”، ولعبوا دوراً حاسماً في النهضة العربية إبان القرن التاسع عشر، فأتى “الأدب العربي من خلال المنظار المسيحي” متسربلاً بحلة قشيبة، “فنحا هذا الأدب منحى إنسانياً بارزاً غير ديني، نتيجة مساهمة المسيحيين”. ونشأت فكرتان متعارضتان – كما يقول شرابي – بين المُنادين بدولة الخلافة والمُنادين بالهوية العربية العلمانية. كما نشأ تيار بين المسلمين أعاد النظر في الشأن المقدس وهاجم الجمود الديني، مثل طه حسين في كتابه “في الشعر الجاهلي” وعلي عبد الرزاق في “الاسلام وأصول الحكم”، وفرج فودة ونصر حامد أبو زيد وأدونيس – وكلهم غير لبنانيين. ويتوقف الكاتب عند بعض ممثلي التيار التراثي في الإسلام، كحسن البنا الذي “مزج الإسلام بالعروبة” وسيد قطب الذي أطلق صفة “الجاهلية” على المجتمعات الإسلامية الحالية، وشكري مصطفى أمير جماعة التكفير والهجرة المتشددة في مصر. ويعيدنا من ثم إلى جورج قرم الذي هو عروبي نهضوي مستنير انتقد الأصولية بشتى أنواعها لأنها تنكّرت للعقلانية. وعوّل قرم على الانتفاضات العربية لأنها قد تؤدي إلى تكوين مجدِّد لثقافة التنوير ولخلق وعي جماعي عربي جديد. ورأى أنه يجب تحييد الدين عن الصراعات السياسية المستفحلة حالياً، لأنها كلها “صراعات على المال والموارد الطبيعية والسلطة والجاه، ولا علاقة لله بكل هذه الأمور”. ورأى أن الحل الوحيد لتجاوز هذ الصراعات هو العلمانية.
الدين والعقل
ويأخذنا كمال ديب بعد ذلك إلى تلك المشادة التي نشبت في عقدي الثمانينات والتسعينات بين محمد عابد الجابري وجورج طرابيشي، والتي انشغل بها المثقفون العرب طويلاً [وكلاهما غير لبنانيين]. ويمرّ المؤلف بسرعة على محمد أركون وعبد الله العروي وفرج فودة ونصر حامد أبو زيد، كي يتوقف مطولاً عند المنظومة الفكرية النقدية التي قدّمها أدونيس الذي توصّل إلى قناعة تقول “إن مشروع الحداثة فشل بكامله في المجتمع العربي”. وتبريره هو أننا لا نستطيع “أن نفهم القرن الحادي والعشرين بنظرة أُرسِخت في القرن الأول الهجري… وما زال بعضهم يلوك نظرة متطرفة تدّعي أن في الإسلام حلاً لكل شيء”، ذلك أن العقل عند أدونيس، كما يقول كمال ديب، هو قبل الدين، وأن الدين تابع للعقل، وليس العكس. وهذا تيمناً بما قاله ابن الراوندي في القرن التاسع: “إذا كان الدين متفقاً مع العقل فلا حاجة لنا فيه. وإذا كان مختلفاً مع العقل فنحن نرفضه”. لهذا يعلن أدونيس “انقراض الحضارة العربية” بسبب صعود الإسلام الأصولي والمتطرف.
وفي الفصل الأخير من الكتاب، الذي يحمل عنوان “انتكاسة النهضة؟”، يتوقف كمال ديب عند الحرب اللبنانية متسائلاً: “كيف يمكن لبلد جبران خليل جبران والرحابنة، ومدينة الأربعين جامعة ومنارة العرب وعاصمتهم الثقافية، ومطلّهم على الحضارات الغربية ونموذجهم في التنوع الديني… أن يغرق في حرب مدمرة استغرقت 16 عاماً؟ وكيف يستطيع بلد زرع حديقة لجبران في وسط المدينة أن يستعمل هذه الحديقة ساحة للقتال المتجدّد؟”.
إدورد سعيد وأدونيس
ويتصادى صوتان عاليان في الثقافة العربية هما صوت أدونيس الذي خصّه المؤلف بصفحات طويلة في كتابه، وصوت إدوارد سعيد الذي ندّد بالاستشراق وبنظرة الإعلام الغربي إلى الإسلام، ونادى بدولة علمانية في فلسطين تضمّ العرب واليهود، وانتقد بشدّة الأنظمة الظلامية في العالم العربي. لقد سعى إدوارد سعيد في مشروعه النقدي – كما يقول الكاتب – إلى “تفكيك الفكر الغربي، ونقد الخطاب الناتج منه، وتوصّل إلى أنّ التفريق بين شرق وغرب هو في صميم ثقافة الإمبريالية، وأن مفكّري الغرب قد اخترعوا الآخر الشرقي والعربي والمسلم تمييزاً للشخصية الغربية من الآخرين الذين يقعون بنظرهم في سلم حضارة أدنى، واعتبر مثقفو الغرب أنهم أصحاب العقل والمنطق المتسلح بالعلوم، وأن هذا الشرق الذي استعمروه لاعقلاني وغير متحضّر”.
المال والسلطة
ويتوقف كمال ديب عند العدد الهائل للمحطات الفضائية الناطقة بالعربية (1321 محطة)، ويرى أن معظمها لا يشاهّد وأنها في جلّها مرتبطة بالمال والسلطة، وأن أغلب برامجها يحرّض على التقاتل والكراهية، و”يروّج للرجعة الدينية ويضخّ المسلسلات التافهة ومئات ساعات المباريات الرياضية والفن الهابط والفيديو كليب؛ والنصف الثاني من برامجها قمع وهيمنة ومعاداة للديموقراطية والفكر المدني وتبجيل سلطات الاستبداد وأصحاب الجلالة والفخامة الأبدية”. ويرصد الكاتب النفوذ الثقافي اللبناني الذي كان يغطي المنطقة العربية بالصحف والمجلات والكتب التي تصدر في بيروت، وكيف خبا بريق بيروت بسبب “نمو الإسلام السياسي”، كما يقول، وانهيار فكرة العروبة العلمانية الديموقراطية التي نشرت ثقافة الحداثة”.
مراجعة المثقف
وينهي الكاتب كتابه بملحق استعادي مهم جداً، وعنوانه “مراجعة المثقف”؛ وفيه يعود إلى تلك المحاضرة القنبلة التي ألقاها أدونيس في مسرح المدينة عن “بيروت اليوم. أهي مدينة حقاً، أم أنها مجرد اسم تاريخي؟” ويستعرض ردود الأفعال المتباينة على هذه المحاضرة. تبدأ المحاضرة بالعبارة التالية: “كما تدمّر الطائفية فضاء الثقافة والإنسان في بيروت، فإن هذه الهندسة تدمّر فضاء المكان… بيروت اليوم مجموعة أحياء كمثل صناديق بطبقات مظلمة ومغلقة”. ويضيف أدونيس: “وكما أن بيروت مدينة بلا مدنيّة، فإن الثقافة السائدة فيها تبدو هي كذلك نوعاً من الاستزلاف، لكثرة ما تنطوي عليه من الرياء والزخرفية والتبجّح والبعد عن القضايا الكبرى في مختلف المجالات”. بكلام آخر ينعى أدونيس موت الثقافة في بيروت، كما ينعى مفهوم المدينة إنسانياً وثقافياً.
ثقافة عربية شاء من شاء
وجاءت ردود الأفعال – ولا سيما رد بول شاوول – مثقلة بعبارات التنديد والتجريح. “لماذا يحقد على بيروت؟ ألأنه خرج من التداول الشعري والنقدي منذ ثلاثة عقود؟” ويقول شوقي بزيع بلغة هادئة: “في هذه المدينة المرفوعة على صليبها منذ أكثر من ربع قرن، ثمة ثقافة للنخاسة والاستتباع والترويج الطائفي ولعق أحذية السلاطين، وثمة ثقافة أخرى للاعتراض والرفض والممانعة والدفاع عن ثمالة الروح”. ويتهمه عقل العويط “بالتعامي عن الموهوبين والكتّاب والشعراء الذين اعتبرهم جميعاً غابة أصداء، في أحد الأيام. حتى وإن كانوا مريدين وأتباعاً؟”. ويضيف عباس بيضون أن أدونيس تقصّد استفزاز الشوفينية اللبنانية “التي خبرها جيداً”. ويتساءل عبده وازن قائلاً: “ألم تكن بيروت مختبراً حقيقياً للثقافة الحديثة والحية وللأفكار الجديدة والتيارات الطليعية؟ لماذا إذاً جذبتْ من جذبت من كتّاب عرب وشعراء وفنانين ومثقفين؟ أليست بيروت هي المدينة التي تضمّ ساحاتها وشوارعها – على خلاف الكثير من العواصم العربية – أقل ما يمكن من تماثيل للزعماء والرؤساء ومن صور لهم؟” ويردّ أدونيس قائلاً إن “بيروت مدينة أعشقها. وبقوة هذا العشق وسيطرته، لا أقدر أن أراها إلا جميلة وكاملة”.
يسجل لكمال ديب أنه ساق لنا تفاصيل هذه المشادة المتعلقة ببيروت. وأظن أن في إدراجه أسماء العديد من الكتّاب والمفكرين غير اللبنانيين في كتاب “تاريخ لبنان الثقافي”، تلميحاً إلى أن الثقافة اللبنانية هي جزء لا يتجزأ من الثقافة العربية، شاء من شاء وأبى من أبى.
ضفة ثالثة