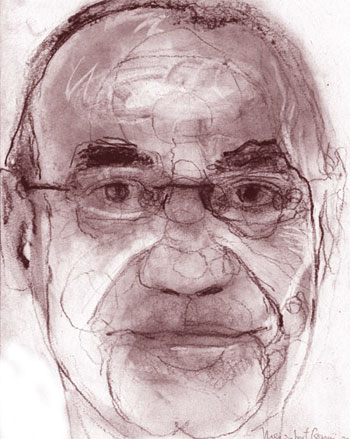تحولات في معنى “الثورة”
حازم صاغية
تقع التحولات العربية الراهنة، في لحظة كونيّة تتسم بسمات محدّدة في ما خص معنى “الثورة” ودلالات هذا المفهوم. فمنذ أواخر السبعينيات تلاحقت ثلاث موجات تاريخيّة، تتقاطع فيما بينها بقدر ما تتنافر، إلا أنّ الخلاصة التي استقرت عليها غير بعيدة عمّا تشهده الآن هذه الأحداث العربية:
في 1979، مع الثورة الإيرانيّة بزعامة آية الله الخميني، والثورة البولندية برعاية الفاتيكان في ظل سيّده البولندي يوحنا بولس الثاني، ومع حركة “المجاهدين” الأفغان ضد الغزو السوفييتي، اتخذ الدين موقعاً مركزيّاً في مفهوم “الثورة” كما في واقعها. حصل ذلك بعد عقدين ونيّف من قمع التنظيمات الدينيّة في البلدان العربيّة ذات النظم العسكرية، وبعد عقود مديدة من مصادرة التعبير والمؤسّسة الدينيّين في بلدان المعسكر السوفييتي.
ثمّ في أواسط الثمانينيات، مع انطلاق العولمة مصحوبة بثورة الاتصالات وتقنياتها، بدأت تصير دمقرطة المعلومات وإشاعة الحصول عليها، ومن ثمّ كسر قبضة الحزب الواحد على المعرفة والإعلام، شرطاً شارطاً لأيّ فهم أو تأويل لـ”الثورة”. وقد أسهم ذلك في انزياح السياسة قليلاً من السلطات ودائرتها الضيقة إلى المجتمعات وصلبها القاعدي وأنظمة قيمها، فباتت مسائل “حقوق الإنسان” و”المجتمع المدني” والحريات الشخصية والجندرية تملك أهميّة لم تكن لها من قبل.
وهنا تأسّست بدايات لقاء بين الموجتين الأولى والثانية، أفادت منها القوى الإسلامية في بعض المجتمعات التي تعاني القمع وسحق حقوق الإنسان. وفي هذا السياق جاء تعطيل الانتخابات الجزائرية في 1990 بعدما فازت “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” في دورتها الأولى، ليشكل حدثاً مفصليّاً.
وأخيراً، مع بدء التسعينيات، تدخلت ثورات أوروبا الوسطى والشرقية ضد الأنظمة السوفييتية لتجعل السلميّة شكلاً لـ”الثورة”، كما تجعل الديمقراطية هدفاً صريحاً لها. وهذا التطوّر العظيم لم يكن ليحصل لولا الإسهام التاريخي الفذ للزعيم السوفييتي آنذاك ميخائيل جورباتشوف: فهو بتفكيكه قبضة الحزب الواحد على الاتحاد السوفييتي، وانتهاجه سياسة سلميّة وتصالحية مع الغرب، لم يسهّل عمل تلك الثورات فحسب، بل حال دون حدتها القومية لصالح سطوع لونها الديمقراطي. لقد تراجع عداء الثورات لروسيا ليتقدم إصرارها على بناء الديمقراطية.
إلى ذلك عمل الانكسار الإمبراطوري في الاتحاد السوفييتي وفي يوغوسلافيا السابقين على تعميق الفرز وتبديد اللبس ما بين الديمقراطية والقومية: فأنْ تكون ديمقراطيّاً أكثر يعني أن تكون قومياً أقلّ، وأقلّ اكتراثاً بمراكمة أسباب القوّة والسلاح.
وهذه الموجة الأخيرة وجدت ما يرفدها في تطوّرات بالغة الأهمية جدّت خارج حدود أوروبا، تصدرها سقوط النظام العنصري في جنوب أفريقيا، وتمدد رقعة الديمقراطية في بلدان أميركا اللاتينية.
وقد حصل صعود تلك الموجات الثلاث على حساب موجات منحسرة كان لانحسارها انعكاسه على معنى “الثورة” نفسه:
فالثورة الطبقية التي ولدت في روسيا في 1917 ونجحت في الانقلاب على المعنى الكلاسيكي للثورة حتى ذاك الحين (بوجهه الفرنسي المعادل للحرية والأخوّة والمساواة، وبوجهه الأميركي الجامع بين الاستقلال والنزعة الدستورية) كانت قد كفت عن الإقلاع في “العالم الثالث”، بعد عقود على طردها من بلدان الرأسمالية المتقدّمة في الغرب. وقد تعدّدت أشكال ذلك: من استقرار بعض الثورات الطبقية على أنظمة مستبدة ومغلقة فقدت كل قدرة على إلهام سواها (كوبا)، أو رسوِّها على حروب بين رفاق إيديولوجيين مفترضين (حرب أوغادين بين أثيوبيا والصومال “الماركسيّتين” آنذاك، واحتلال فيتنام لكمبوديا البول بوتيّة)، أو على مسوخ أنظمة اشتراكية (اليمن الجنوبي سابقاً). كلّ هذا جاء معطوفاً على التخشب السوفييتي الذي افتتحته الحقبة البريجنيفيّة المديدة، وحدّة النزاع المتطاول الروسي- الصيني، ناهيك عن اختيار الصين، بعد مأساة “الثورة الثقافية” الماويّة، أن تسلك الطريق الرأسمالي اقتصاديّاً من دون التخلي عن حكم الحزب الواحد. ولمن لم تستوقفه الستالينية وجرائمها، بات من الصعب غض النظر عن أنظمة كأنظمة “بول بوت” في كمبوديا وأنور خوجا في ألبانيا وكيم إيل سونج في كوريا الشمالية ونيكولا تشاوتشيسكو في رومانيا بوصفها، على تفاوت، كاريكاتورات دموية عن كل الوعود الكبرى لتغيير العالم وتحريره.
وكذلك انحسرت موجة الثورات القومية التي ترقى نشأتها إلى الاحتكاك الأول بين الاستعمار الغربي و”سكان المستعمرات”. ذاك أنّ الاستعمار نفسه انطوى وضمر على دفعات، فيما الانقلابات العسكرية القومية التي زيّنت نفسها “ثورات شعبية”، راحت تتكشّف أنظمة قمعية وسجوناً كبرى من دون أن تسجّل أي نجاح على أية جبهة كانت. وكما لمسنا عن كثب، كانت القذافية في ليبيا الكاريكاتور الأنصع لتلك الانقلابات القومية.
أمّا ثورات “التحرّر الوطني” فجعلت تتفسّخ تباعاً، ما بين نشاط إرهابي معلن واندفاع في حروب أهلية تمعن في تفسيخ المجتمعات التي يُفترض أنّها قامت للانتصار لها. وإذا كانت تجربة الثورة الفلسطينية خير برهان على ذلك، في الأردن ولبنان، فإنّ الثورات الأخرى التي تخلط “العداء للإمبريالية” بمحمول إيديولوجي- طبقي أرفع لم تنته نهايات أسعد حالاً، على تباين تلك النهايات: من بوليفيا الغيفارية إلى كونغو لوران كابيلا إلى كولومبيا التي تموّل ثورتها بعوائد المخدّرات والتهريب.
يكفي أن نتذكر كيف انتقلت رمزيات الكلاشنيكوف وغيفارا والتوباماروس مسائل مسلية في أحسن الأحوال، بينما ورث “حزب الله” الديني “المقاومةَ” عن الثورة الفلسطينيّة واليسار، قبل أن يرث وائل غنيم وتوكل كرمان “الثورة” عن جمال عبدالناصر وعبد الله السلاّل.
وعلى هامش هذه الأحداث العريضة بقي صعود البنلادنية وهبوطها تطوّراً عارضاً في ما خص مسارات المجتمعات والأفكار. وبهذا استحقّت تلك الظاهرة اعتبارها إرهاباً بحتاً لا يندرج، تعريفاً، في أيّة سياسة ولا يراكم أي وعي سياسي.
وهذه ليست تطورات بسيطة أحدثها خطأ من هنا، ومؤامرة أميركية من هناك. إنّها علامات على تحولات الزمن، تحثّ على الإنصات إليها وإلى تناقضاتها قبل التعجيل في إصدار أحكام القيمة.
الاتحاد