حفرٌ في دوافع الكتابة واتجاهاتها/ حبيب سروري
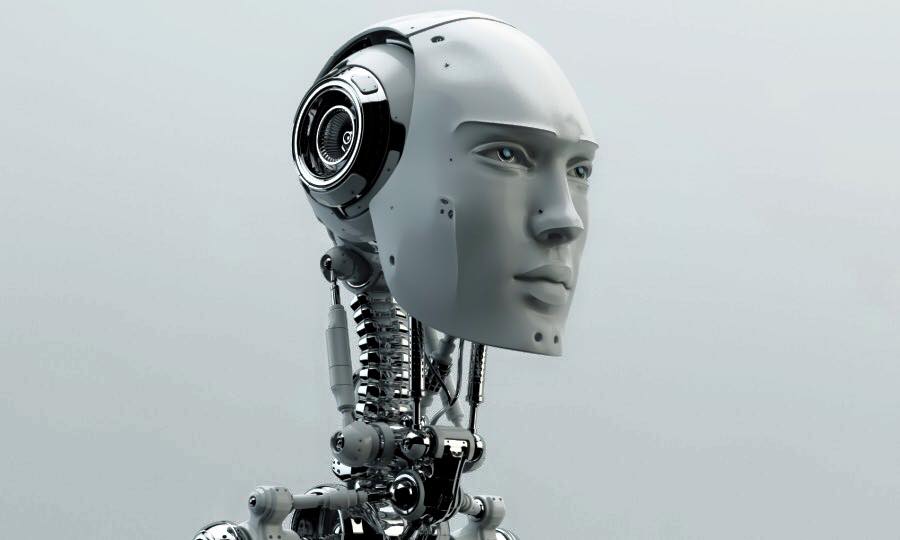
سأبدأ بردٍّ نظريّ عام على سؤال دوافع الكتابة، قبل الغوص عميقاً في خصوصيات تجربتي الشخصية. الدافع الأول للكتابة، في رأيي، هو كون الإنسان “حيواناً اجتماعياً” في الأساس: تأنْسنَ بيولوجياً وتطوّرَ تاريخياً بفضل ثراء شبكة علاقاته الاجتماعية بالآخرين، وتفاعلاته الغنية معهم.
يحتاج دوماً، على نحو حيويٍّ أساسي، لأن يستوعب العالَم الذي يحيطه، وأن يستشرفه بالاستفادة من تجارب الآخرين، وأن يدلو بدلوه في إغناء رؤيتهم للعالَم من وحي تجربته الخاصة ومعاناته، أو من وحي ملَكات خياله.
هكذا، لعل الكتابة في الأساس فعلُ حبٍّ اجتماعيٍّ أولاً وأخيراً، لا يخلو من رغبة في حضورٍ ذاتي مؤثر، أكثر أو أقل نرجسية، في مسرح الحياة الإنسانية. وربما هي أحياناً بدافع التطهير الروحي بالفن: “كاترسيس”، كما يقول الإغريق. وربما هي أحياناً أيضاً محاولةٌ لِهزيمة شيءٍ ما.
أو لعل مصدر ندائها كل هذه الدوافع معاً.
أحد أهم جسور علاقة الإنسان بالآخر: اللغة، بكلّ أجناسها: لغة الكلام، لغة الموسيقى، لغة الرياضيات… لها جميعا مساحات متقاطعة مشتركة في خارطة الدماغ البشري، كما برهنته علوم العصبونات مؤخراً.
الكلمات كائناتٌ خطيرةٌ في الحقيقة، تعيش معنا وبنا ولنا في كل لحظة، لها حياة دافقة متجددة، وتاريخ مثير. هي صرح وفضاء الوعي واللاوعي معا في الذات الإنسانية.
هي جسد الروح باختصار شديد.
نسجُها في مقطوعات سردية له تأثيرٌ إيقاعيٌّ موسيقيٌّ جماليٌّ ساحر. له مدلولات دقيقة ثاقبة كنظريات رياضية، أو شاعرية مفتوحة تُذكي الحيرة والإيحاء والتساؤلات.
له مفعولٌ اجتماعيٌّ خطير، تطهيريٌّ تنويريٌّ أو ظلاميٌّ تخديري، تحريريٌّ إمتاعيٌّ أو تحريضيٌّ تعبوي… جذريٌّ آسرٌ حاسمٌ أحياناً. لأنتقل الآن للردّ على السؤال المتعلق بخصوصية تجربتي الشخصية، على صعيد الكتابة الأدبية. في صغري، وبفضل بيئتي العائلية، أحببتُ حفظ الشعر، ثم نظمه. كنا نمارس لعبة “السجال الشعري” أسبوعياً في العائلة، مساء كل خميس. وكانت لحظات ممتعة.
بَعثتُ، وأنا في الرابعة عشرة، قصيدة لمجلة أدبية يمنية مرموقة جداً: “الحكمة”. نُشِرَت لي مع شعراء مهمين، دون أن تُكتب حتّى تحت عنوان القصيدة عبارة “شاعر ناشئ” التي تقلل من تجربة الشاعر، بسبب تذكير كلمة “ناشئ” بِسنّه.
سعادةٌ هائلة، لا أستطيع وصفها.
بعدها كتبتُ قصائد هنا وهناك. سكنَتني حينها رغبة هائلة بكتابة الشعر ونشره. ثم توقّفتُ في السابعة عشرة، لدخولي في تجارب حياتية صعبة، عائلية واجتماعية، وظّفتُها في أول رواية لي بالفرنسية: “الملكة المغدورة” ، التي لا تخلو من عناصر سيرة ذاتية.
المركزية الديموقراطية!
كنت أشعر آنذاك برغبة هائلة بأن أكون حرّاً من تأثير أبي رغم حميمة ودفء علاقتنا، ومن ثقل وجود بعض النشطاء السياسيين الذين خنقوا حياتنا اليومية اليمنية الجنوبية ودمروها بشعارات عنفهم الثوري، وأن أكونَ في الوقت نفسه مساهماً بقوة في “الحياة التقدمية” في عدَنِ “الاشتراكية العلمية” التي اندمجتُ بها بحبٍّ وإخلاص. أن تكون حرّاً، ومندمجاً وسط المعمعة الاجتماعية والسياسية الجديدة ذات الأرضية التوليتارية: معادلة عويصة.
بعد التوقف لمدة سنتين عن كتابة الشعر، كتبتُ، من وحي تجربتي الحياتية الصعبة، 3 قصائد أنضج من قصائد تجربتي السابقة، وبلغةٍ وبُنيةٍ مختلفتين: “محاكمة في الزمن القادم”: قصيدة نقدية رافضة للأقنعة الجديدة في الحياة السياسية، “لأُمِّي وهي تمحو أميّتها”، و”الريح القادمة من صنعاء”.
لم تنشر جميعها حينذاك!
صدمة.
قرّرتُ بعدها أن أكتب مقالات منتظمة.
= بماذا ستبدأ؟؛ سألتني مسؤولتي الحزبية العزيزة في منتصف سبعينيات عدَن، عندما بُحتُ لها برغبتي في الكتابة والنشر.
= بمقالاتٍ عن الحرية!؛ أجبتُ.
أعطتني كتاباً من سلسلة “تاس” أو “مِير” السوفيتية، عن الحرية. بعد قراءة بضع صفحات منه، اكتنفتني أمّ الخيبات، ورغبة حادّة في البكاء لا أنساها، لم أكن أعرف حينها التعبير عنها:
كل الكتاب كان يتحدث، كما يبدو، عن العلاقة بين المفهومَين الفلسفيين: الحرية والضرورة. يبدو الإنسان في سياقه أشبه بمركبة فضائية، أسيرة قوةٍ وقوةٍ مضادة: الجاذبية والطاقة الكهروحرارية.
“تضادٌّ ديالكتيكي خلّاق”، حسب تعبير الكتاب.
تبدو الحرية، من وجهة نظر الكتاب، كما لو كانت الجذر التربيعي لمدى انسياب الرغبة بين مخالب الخضوع! قمة الحرية في هذا السياق، من منظور الكتاب: الانخراط في الحياة الحزبية، والالتزام بمبدأٍ لينينيٍّ ذي تضاد ديالكتيكي هو الآخر: “المركزية الديمقراطية” (“أرقى أشكال الديمقراطية”، حسب الكتاب!).
عندما استحضر اليوم ذلك الكتاب، أتذكر جورج أورويل، وروايته 1984:
لم توجد في الكتاب، مثلما لم توجد في النظام السوفييتي التوليتاري، عبارات أساسية للحديث عن الحرية: حرية السفر، حرية التعبير، حرية الضمير، حرية الثرثرة… لأنها مُحِيت من القاموس السوفييتي كما هو حال “نوفالونج” جورج أورويل.
السبب: فاقد الشيء لا يعطيه بالطبع، وبكل بساطة.
لم أكتب أي مقال حينها. تراكمَتْ لديّ رغبات مكبوتة. كتبتُ قصائد أحيانا، إحداها عن موت سلفادور إليندي، والأخرى “مرثية لقصيدةٍ ضائعة” (قصيدة أضعتُها، وأضعتُ مرثيتها أيضا، وما زلت أشعر، حتى اليوم، بالألم لكل ذلك).
جميعها لم تنشر.
ثمّ الولادة الثانية: السفر لفرنسا في 1976 للدراسة، تعلّم اللغة الفرنسية أولا، ثم الدراسة والأبحاث الكثيفة حتى عام 1992 التي تحوّلتُ فيها إلى بروفيسور جامعي. لم أستطع خلال تلك الفترة كتابة أكثر من أنصاف قصائد غالباً… غير أن تراكمات لسيناريوهات ومواضيع كتابات سردية كانت تتشكل على الدوام في اللاوعي. طبقات فوق بعض تضغط، تضغط، بانتظار ولادة جديدة.
1992: عام الولادة الجديدة.
داهمتني رغبة عنيفة، بعد التحوّل فيه إلى بروفيسور جامعي، بكتابة رواية، بالفرنسية، لأنها كانت حينها لغة قراءاتي اليومية، والقاعدة التحتية لثقافتي وحياتي الجديدة، وكنتُ قد كتبتُ بها أطروحتين علميتين، وكتاباً علمياً أيضاً.
القبائل الماركسية!
لعلها كانت رغبة في خوض تجربة جديدة مع اللغة والسرد أساساً، وتفريغ تراكمات أكثر من عقدين… الموضوع الذي فرض نفسه لأوّل تجربة روائية كان ابن حدَثين جوهريين، مؤلمين جداً، في حياتي حينذاك: ذبحُ ملكة شطرنج بالفأس من قبل أب الراوي، على طريقة داعش اليوم، في لحظة صراع فكري حاد بينهما؛ و”ذبح” أم الراوي التي وصلته إلى فرنسا لعلاج مرض سرطان، لم يُشخَّص كسرطان في عدَن وتأخر علاجه كثيراً جداً، قبل أن تصل وتموت في المستشفى أمام عيني ابنها!
ملِكتان ذبيحتان، هما ملكة واحدة في الحقيقة، ملِكتي: “الملكة المبقورة”، عنوان روايتي الأولى بالفرنسية، 1998. في هذه الرواية غوصٌ نحو جذور تكويني في الطفولة: عدَن السبعينيات والقبائل الماركسية؛ الجدل الفكري مع الدين بين الراوي وأبيه حول العقل والنقل…
ترجمَتُها إلى العربية، من قبل الأستاذ علي محمد زيد، كانت لحظة جوهرية في مساري السردي:
أيقظَتْ ترجمتهُ كلمات عربية كنت أعشقها ونسيتها؛ أشعلَتْ الرغبة الهائلة للكتابة بالعربية، لكن من وحي مكتسبات الفرنسية وروحها النابضة المتجدّدة الآسرة، بجانب مواصلة متعة القراءة بالفرنسية؛ وربطتني بتفاعل مباشر مع القارئ في اليمن والعالم العربي، ضاعف من رغبتي في الكتابة!
وجدتُ حينها نوعاً من التكامل والتناغم والانسجام مع الذات والآخر، بشكلٍ أو بآخر. تفجّرتْ فيّ بعد ذلك رغبة خوض أول مشروع كتابة سردية بالعربية مباشرة: “همسات حرّى من مملكة الموتى” (1). 7 قصص قصيرة. طويلة جداً في الحقيقة. لعلها كانت فعلا مشاريع روايات مستقبلية أكثر مما هي قصص قصيرة بالمعنى التقليدي للكلمة. سنجد ظلالها وامتداداتها بشكل أو بآخر في معظم رواياتي لاحقاً، حتى آخر عمل روائي لي: رواية “حفيد سندباد” (1)، 2016.
لعل الهمّ الآخر الكبير لهذه المجموعة القصصية كان أيضاً إرساء أوّل علاقة استراتيجية حميمة جديدة مع اللغة العربية التي أهملتُها طويلا. بعدها بدأتُ أوّل الروايات بالعربية: دملان (1)، ثلاثية كبيرة، نوعها الأدبي: “تخييل ذاتي معاكس”، (كلمة “معاكس” مهمة جداً هنا)، موضوعه الرئيس: اليمن، وبدايات الانهيار… لا تخلو الرواية من انزياحات كثيرة خارج هموم اليمن، من أسفار فانتازية، من حيوات مجتمعات تخييلية، ومن مغامرات شهرزاد الإلكترونية… درسها بعمق الأستاذ صادق السلمي في أطروحة دكتوراه عن أعمالي.
تلتها رواية: “طائر الخراب”. ضمن ثيمة اليمن أيضاً، وتنبؤات الانهيار المؤكد القادم الذي نعيشه بأمِّ أعيننا الآن. لن أطيل الحديث عنها. أترككم مع دراسة الأستاذ سامي القيّام، بجامعة هارفارد، عنها. ثم رواية: “أروى”، ضمن ثيمة جديدة ثالثة، تقع في إطار عبارة فيليب سوليرس: “الحياة ملكٌ للنساء، أي ملك للموت”.
موضوع ثري ممتع ذو شجون، كان من المحال أن لا أدلو بِدلوي فيه، والدخول في مغامرة تخييل لولبية لذيذة في معمعانه وأقبَيته. ثم روايتَا: “عرق الآلهة”، و”تقرير الهدهد”: ضمن ثيمة جديدة، بعيدة عن اليمن، لكنها شغلتني قدر ثيمة اليمن: الحروب الروحية ضد الظلمات!…
تلتهما رواية: “ابنة سوسلوف”: ديستوبيا الربيع اليمني، في تقاطع ثيمتين سابقتين: اليمن والحروب الروحية، ومن وحي يوميات الربيع اليمني. ما الحروب الروحية أوّلاً، قبل الحديث عن هذه الروايات؟
من نافل القول إن الحياة حروبٌ دائمة: اقتصادية، عسكرية أحياناً، حروب الآلهة في الأولمب، حروبهم ضد الشياطين، حروب البشر الدائمة في يوميات حيواتهم الاجتماعية، حروب الذات مع نفسها (أو “جهاد النفس”، كما يقول الحديث الشريف)… “الحرب أبٌ لِكل لشيء”، كما قال هرقليطس. ولعلّ منبعَ نهر الحروب الحربُ الروحية. تلك التي يحاول بشرٌ خلالها السيطرة على أرواح آخرين، أي على عصبونات أدمغتهم، لِغرس مسلّماتٍ وآيديولوجيات فيها؛ أو لِمقاومةِ ذلك الغرس.
“الحرب الروحيّة لا تقلُّ شراسةً عن معارك الفرسان” كما قال آرثور رامبو في “فصلٍ في الجحيم”. ومن يكسبها، “يمتلك الحقيقة في روحٍ وجسد”، حسب تعبيره الذي اعتنى بالإشارة إليه. به يهيمن على أجساد وعقول بشرٍ يوجّههم كيفما يشاء، للجهاد أو للسلام، للخير أو للشر…
لن أتطرّف مثل الإمام الخميني الذي قال: “إن لم يكن الإسلام سياسةً فهو لا شيء” لأقول: “إن لم تكن الرواية حرباً فهي لا شيء”، لكني سأكتفي بالقول إن المعارك الروحية مادةٌ أثيرة للرواية، شريطة أن تستثمرها بتقنيات روائية فنيّة راقية.
سأتعرض هنا لِشرارات حروبٍ روحية اندلعت منها روايتي الخامسة “تقرير الهدهد” (400 صفحة، دار الآداب)، والسابعة “ابنة سوسلوف” (دار الساقي). كتبتُ قبلهما روايتي الرابعة: “عرَق الآلهة”، ذات الأهمية الخاصة في ثيمة الحروب الروحية.
كانت شرارة اندلاعها سؤالا طالما أرّقني وأثارني: “متى، كيف، ولماذا جاءت وتطوّرت فكرة الآلهة في تاريخ تطور الإنسان، ولماذا بقيت إلى اليوم؟”
للخوض في هذا السؤال المعقد الهائل، استخدمتُ في هذه الرواية تقنيات التخييل العلمي، واستثمرتُ آخر نتائج العلوم الدماغية والاجتماعية والأنثروبولوجية، لكن في سياق روائي شاعريٍّ خالص، وفي متنٍ غرامي كثيفٍ عارم.
ثم اندلعَتْ رغبة كتابة “تقرير الهدهد” خلال عام 2009 الذي رافق مرور قرنين على ميلاد داروين، وقرن ونصف على ظهور كتابه: أصل الأنواع.
أبو العلاء المعري
لاحظتُ، على هامش احتفالات ذلك العام، حصرَ قائمةٍ كبيرة من كل مفكري وكُتّاب الأرض، منذ عهد الإغريق إلى قرن التنوير، الذين قالوا، بشكل حدسيّ، كلمتين صغيرتين حول وحدة الكائن الحي، وتطوّره البيولوجي الدائم. كفى ذلك لتمجيدٍ جماعي لِعبقريّةِ القائل وألمعيةِ حدسه… عشتُ ذلك العام بشغف، من 1 يناير حتّى 31 ديسمبر. تابعتُ ببليوغرافيا مختلف تلك الأسماء، آملاً أن أجد في رواية أو مجلة أو كتاب اسم فيلسوفٍ عربيٍّ قال في هذا الجانب قبل أكثر من 10 قرون، بِحدسه الاستثنائي، أهمَّ وأعمقَ مما قاله كل كوكبة أولئك المفكرين والكتاب.
قال:
1) والذي حارتِ البريّةُ فيهِ حيوانٌ مستحدَثٌ من جمادِ
2) أرى الحيَّ جنساً ظلّ يشملُ عالمي بأنواعهِ، لا بوركَ النوعُ والجِنس!
3) جائزٌ أن يكونَ آدمُ هذا قبلَهُ آدمٌ على إثرِ آدم!
حزنتُ كثيراً لعدم ذكر أبي العلاء حينها، لأن صاحب هذه الأبيات منسيٌّ في عقر داره أساساً، قطع فيها رأس تمثاله الوحيد. يعيش على الدوام تعتيماً متعمَّداً. أليس ذلك سلاحٌ تقليديٌّ للقوى الظلامية في حربها الروحية، فيما سلاحنا: الذاكرة والعلم الحديث والكلمة الحرة والمرح؟
منذ صباح 1 يناير 2010 وحتى عيد ميلاده: 27 ديسمبر 2010 (قبيل غروب الشمس ولِدَ أبو العلاء!)، كتبتُ “تقرير الهدهد” التي اندمج فيها التخييل الروائي بالسيرة الذاتية لِرهين المحبَسين، أو بالأحرى لِـ “طليقِ الجناحين”: الشعر والفلسفة.
إذ له في الرواية، معشوقته: طالبته القديمة، هند، التي تنجب منه أهم أبطال الرواية بعد الشاعر: نور؛ وتحميه عن بعد مثلما تحمي الإلهة أثينا عولس، بطل الأوديسيا، في حربه ضد إله البحر بوسيدون.
“في حناياها أودعَ الشاعرُ الضريرُ الذي قِيلَ إنه قال:
هذا جناهُ أبي عليَّ وما جنيتُ على أحد
جنيناً صغيراً في غاية الحسنِ والعذوبة، اسمهُ: نُور، جدّتي الثانية والثلاثون (عطّرَ اللهُ ثراها، وأسكنَها قصراً يُطِلُّ على أسنى حدائقِ جنّاتِه!)”، كما يقول راوي “تقرير الهدهد”، آخر سلالة أبي العلاء المهدّدةِ اليوم بالانقراض، والذي يحيا في عصرنا وينتظره موعدٌ قدريٌّ مع أبي النزول.
أبو النزول هو أحد أوجه أبي العلاء في الرواية: يكلِّفه “الأعلى جدّاً”، ومدير مكتبه أمينيائيل، بالنزول إلى الأرض في رحلةٍ معاكسةٍ لرحلة “رواية الغفران”، لِكتابة تقرير خطيرٍ جدّاً: “تقرير الهدهد” عن أوضاع العالَم والعرب اليوم.
يكتبه خلال رحلة زمكانية يعبر فيها، بمفعولٍ رجعي وهو يلهث وراء أشعة الضوء التي تحمل صور الماضي، كل تاريخ الكون منذ الانفجار الكوني الكبير، سارداً أهمّ منعطفاته الكبرى كما يراها بأمّ عينيه، ومستشهداً بأبيات كثيرة لأبي العلاء، طليعيةٍ حدسيّةٍ سبقت زمنها كالعادة بكثير…
ما إن انتهيتُ من كتابة “تقرير الهدهد” (يوم عيد ميلاد الشاعر، في منتصف الشهر الذي فصل موت بوعزيزي وهروب بن علي من تونس) حتى انطلق “الربيع العربي” (ليس بسبب الرواية، لسوء الحظ!).
عشتهُ بكلِّ جوارحي منذ اندلاعه كثورة فجّرها شباب فيسبوك بعقلية حديثة مستقلة عن الأحزاب السياسية الفاسدة، حتّى استيلاء الإسلام السياسي عليه. وراقبتُ بشكل خاص الربيع اليمني الذي أعرف تضاريس مسارحه تماماً.
مثل بقية ثورات الربيع سقطَتْ ثورة اليمن سريعاً في هاوية الإسلام السياسي ومصالح الأحزاب السياسية المشبوهة الفاسدة. جنّ جنوني وأنا أرى كل الأوجه المرعبة (مثل الأب الروحي لبن لادن، المتخصص بغسيل الدماغ الظلامي، وعلماء برّروا على الدوام الزواج البيدوفيلي للطفلات القاصرات) يتهافتون إلى “ساحة التغيير”، يلقون خطب “الجمعات الثورية”، ويوجّهون الساحات التي تندلع منها “مليونيات” لا اختلاط فيها بين الجنسين، وأخرى ترعب النظر: سيلٌ بشريٌّ كثيف من نساء مكيّسات من أقمص الرأس إلى أخمص القدمين بأنقبة طالبانية سوداء.
من هنا برزت الشخصية الرئيسة لابنة سوسلوف: فتاةٌ كانت لها في عدَن علاقة حبٍّ عذريٍّ بريء بالراوي عمران، ولدت في بيت مؤدلجٍ سوسلوفيٍّ من جنوب اليمن، عاشت في طفولتها (كجرحٍ نفسيٍّ لا يندمل) كل نفاق وإخفاقات وحروب وفشل هذه التجربة الماركسية التي يحوم طيفها في كلِّ أرجاء الرواية (المسكونة بنزيف مدينةٍ عربيّةٍ ساحرةٍ تحتضر: عدَن).
يستقطبها إثر ذلك الظلاميون ويرسلونها إلى قصر شيخهم في صنعاء، لتتحوّل إلى سبيّتهِ وطفلتهِ ومعشوقتهِ وزوجةِ ابنهِ في نفس الوقت، وإلى قائدة الحركة النسوية للإسلام السياسي في اليمن أيضاً. يتغيّرُ اسمُها من فاتن إلى أمَة الرحمن!…
تعود بالصدفة الخالصة علاقة الغرام العنيفة بين أمَة الرحمن والعلماني عمران الذي يهربُ بين الآن والآن من الغرب إلى عدَن وصنعاء، حاملاً كلّ جراح الدنيا بعد وفاة زوجته نجاة في حادثٍ إرهابي مشهور، قبل سنين من اللقاء القَدري بمعشوقة الطفولة، فاتن…
تتطوّر العلاقة الغرامية الكثيفة السريّة وتتقدّم زمنيا حتّى موعد الربيع اليمني. تتفجّر حينها ملءَ الرواية حربٌ روحيّةٌ عارمة بين عاشقين يناضلان في قطبين مختلفين من نفس الثورة. تكشف العلاقات الجنسيّة الملتهبة فيها، أيّما كشف، أقنعة نفاق الإسلام الجهادي.
وأخيرا كتبتُ رواية: “حفيد سندباد” (1)، في 2016. ثيمة رابعة جديدة، تهتم باستشراف المستقبل القريب من وجهة نظري.
لأتحدّث قليلا هنا عن هذه الرواية: تدور كل أحداث الرواية خلال ثلاثين ساعة فقط، كارِثيّةٍ جدّاً في حياة كوكب الأرض، بدأتْ في صباح 30 يوليو 2027!
لكنها مفعمة بتنقّلات “زجزاجية” لا تتوقف في المكان والزمان، خلال نصف قرن سبق هذين اليومين. يبدو فيها الكوكب الأزرق، أكثر فأكثر: قريةً صغيرة تقع في أطراف أصابع نادر الغريب، بطل الرواية.
يجد الراوي (بصدفةٍ غريبة، أو ربما بفضل موعدٍ غامض؟) ماكينتوشاً في زبالة في صباح 30 يوليو 2027، في معمعان تفجّر أزمة كونية توشك أن تطيح بحياة أهل الأرض. يحوي الكمبيوتر كل يوميات نادر الغريب، بطل الرواية، الذي غاب عن الراوي منذ عام 1983.
يقرؤها خلال أكثر من 20 ساعة بمعيّة روبوته بهلول.
نادر الغريب، أهم شخصيات الرواية: مغربي، متعدد الأصول. لأسباب مرتبطة بالبنية الدرامية لجذور شخصيته وأسرارها التي لا تنكشف إلا في نهاية الرواية، يسافر من بلدٍ إلى بلد، يعيش وحيداً متنقّلاً بين المقاهي والفنادق وقارعات الطرق. أسبوعان هنا، ثم أسبوعان في الطرف الآخر من الكرة الأرضية.
يضع مجانا بين الآن والآن، كما يقال، برمجيات ترفيهيةً صغيرةً على الإنترنت لتكونَ بمتناول الجميع، أو أخرى مهنيّةً يبيعها لِتسمح له بحياة بوهيمية حرّة يطوف بها العالَم، ترافقه حقيبةٌ شخصية وكمبيوترٌ محمول فقط!
نصوص يومياته التي يعجّ بها كمبيوتره تؤثث معظم الرحلة الزمكانية للرواية في أحشاء هذا النصف قرن.
لا تكشف كل هذه المئات من الجيجابايتات أيّاً من أسرار حياة نادر الغريب الكبرى في الحقيقة، بل العكس: تراكم الأسئلة تلو الأسئلة، والأسرار الجديدة تلو الأسرار!…
لا تنكشف جميعها إلّا في أقصى نهاية الرواية!
الراوي، من مواليد عدَن، له حياة تتوزّع بين الشرق والغرب، سياقها من نوع آخر مختلفٍ كليّة عن سياق رفيقه القديم نادر، لكنه يمثِّل الشاهد الثاني بامتياز على سيرورة هذا النصف قرن.
من شخوص الرواية المهمّين اثنان يسمحان باستيعاب اتجاهات حضارتنا المعاصرة: العالِم الروسي ديمتري بابكين الذي هرب من موسكو إلى باريس، والعالِم الفرنسي ميشيل لينيه.
الحبكة الدرامية لهروب الأوّل، وموته التراجيدي في النهاية، والتطور المهني للثاني ومصيره، رمزان يكثّفان سيرورة اتجاهات حضارتنا المعاصرة.
صراعات هذا الثنائي، منذ منتصف الثمانينيات، حول اتجاهات الأبحاث العلمية في مختبر أبحاثهما: بين البحث النظريّ الذي لا يهتم إلا بتوسيع المعارف الإنسانية، أو البحث التطبيقي الذي لا يهتم إلا باحتياجات العالم الصناعي، أي: بين الجميل أو المفيد، بين الفن أو التقنية، بين الشعر أو الأسواق الاقتصادية، بين السمو والتحليق في أقصى المعرفة الإنسانية أو عبادة الدنيوي لا غير… صراعاتهما هذه تُلخِّص إشكالية عاشها عالمنا المعاصر في العقود الأخيرة التي اكتسحت فيها الليبرالية الاقتصادية العالَم، وقادت إلى تحالف قوى المال والتكنولوجيا الذي يقود كل المناحي السياسية والثقافية والبيئية لِعالمِنا المعاصر.
انتصر في هذه الصراعات ميشيل على ديمتري باللكمة القاضية، لنحيا اليوم نتائج ذلك الانتصار!
أهم رموز نتائجه: التطوّر التكنولوجي الصارخ الذي جسّده دخول الروبوت المؤنسن بهلول لحياة الراوي، وتطوّراته السريعة خلال 12 سنة على نحوٍ يحاكي بدقّة التطوّر المرتقب للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وانتقاله من ذكاء “موجّه” يفوق اليوم ذكاء الإنسان في مجالات محدّدة كلعبة “الغو”، إلى ذكاء “غير موجّه”، يتعلّم فيه الروبوت كيف يتعلّم، ويتحرّر لذلك من خضوعه للإنسان، ليهمين أكثر فأكثر على كلِّ حياته.
يبدأ تحرّره عند رفضه لاسمه “بهلول”، وتغييره لاسمٍ آخر: “حيدر”، أو “كارمن”، ثم يلحقه صياغته لـ “بيان حقوق الروبوتات المؤنسنة”…
علاقة الراوي بروبوته المؤنسن المفعم بآخر برمجيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الذاتي، تطوّرت لصالح الثاني وسيادته، كما يتضح مع تقدّم فصول الرواية!
كلّ ذلك التطوّر يتقدّم في عالمٍ أنانيٍّ يسود فيه القوي على الضعيف، العالَم الصناعي المتطوّر على الدول الضعيفة. يبحث فيه الأوّل عن عدوٍّ له بعد سقوط الإمبراطورية السوفييتية. يجده: دول العالَم الإسلامي.
طبقات رسوبية مفعمة ببقايا الفكر الظلامي في هذا العالَم الجديد تلجأ للانتقام من ظلم العالَم المتطوّر، بالإرهاب العنيف الكليّ الذي وصل أوجه يوم 30 يوليو 2027، مختاراً لحظة تفجّرهِ بذكاء: تواشج أزمات العالَم الأول المالية والبيئية الكبرى قبل أسبوع من ذلك التاريخ…
عن كتابة المقالات الصحافية
بجانب كتابة الروايات، بدأتُ بكتابة مقالات صحافيّة دوريّة في أهم الصحف اليمنية والعربية، ثم أسبوعية منتظمة، وبين الحين والحين في صحفٍ فرنسية كليبراسيون واللوموند..
في كل المقالات العربية أحاول الحديث والجدل بجرأة وحرية في قضايا فكرية وقراءات نقدية ودراسات وانطباعات متنوعة.
جمعتُ بعضها، في صيغٍ أوسع من صيغ المقالات وأكثر حريّة، ضمن كتب. نُشِر اثنان منها: “عن اليمن ما ظهر منها وما بطن” (1)، “لا إمام سوى العقل” (1)، والثالث تحت الطبع في دار رياض الريس: “لِنتعلّم كيف نتعلّم!” (1).
لم ألاحظ ما يلي إلا الآن، من وحي سؤالٍ فطينٍ وجّههُ إليّ منظمو هذه المحاضرة، عن العلاقة بين رواياتي ومقالاتي: واكبَ الكتاب الأول وتناغمَ مع روايتَي دملان وطائر الخراب في تبؤرهِ حول اليمن.
واكبَ الثاني: “لا إمام سوى العقل” (عبارة أبي العلاء المعري، بطل رواية “تقرير الهدهد”)، مع كتابة روايتَي “عرَق الآلهة” و”تقرير الهدهد” وحروبهما الروحية، في بحثه عن دحض كثير من المسلمات غير العقلية السائدة عربياً.
وواكبَ الثالثُ كتابةَ رواية “حفيد سندباد” وهمِّها الكوني، في محاولاته لاستيعاب واستشراف حضارتنا الدولية الراهنة، والمساهمة بها على نحو فعّال.
محاوره الثلاثة: الطبيعة الإنسانية 2.0، كوكبنا الأزرق اليوم، معالم حضارتنا الجديدة. كل المقالات المنشورة في الكتابين الأول والثاني منفصلةٌ كنصوص عن الأعمال الروائية التي واكبَتها، وإن تناغمتْ معها في منحى الثيمة غالبا فقط. أّما في الكتاب الثالث، فثمّة أحيانا تقاطعٌ ملحوظ بين بعض تلك المقالات وبعض شذرات الرواية.
بالطبع، تختلف الصياغة أحيانا بين متن المقال من ناحية، والمقاطع الروائية من ناحية أخرى، لكن التفاعل هنا، في هذا الكتاب الثالث، يتعدّى أحيانا مواكبة ثيمة الموضوع فقط، كما هو حال الكتابين الأول والثاني، ليتقاطع مع بعض النصوص الروائية، ويتفاعل معها إثراءً وإثراءً مضادّاً.
من وجهة نظري: إذا كانت مسرحَةُ الرواية، مثل سينمتِها، وسيلتين لتوسيع أبعاد بثّ الرواية ومداها، فلعل توظيف شذرات من الرواية في مقالات سردّية ثقافية أو أدبية، مكتملةٍ وعلى نحو مستقل، وسيلةُ إثراء أخرى هي أيضا، تستحق العناية والدراسة أحيانا.
عن الالتزام
لعل هَوَسي بأن أكون حراً، مهما كان الثمن، كان أهم اختيارات حياتي. لكنها حرية لا تبحث عن الاصطدام، تحاول أن تتموضع في أكبر مساحة ممكنة، عبر تعايش سلمي مع الآخر، وبمرونة سلميّة مهذِّبة.
بيد أن قرار اختيار الحرية هو الحاسم دوماً.
برهن ذلك راوي الملكة المغدورة (روايتي الوحيدة التي لا تخلو من السيرة الذاتية) في علاقته بوالده، وبحشوان: صديقه الطاغية الصغير.
ثم منحَني سفري لفرنسا فضاءَ الحرية النموذجي، وزاد من عشقي المتشبث والمهووس بها.
ألاحظ اليوم: انعكس شغفُ الحرية، منذ البدء في كل كتاباتي بدون استثناء، بالإصرار على عدم الانضواء أو المدح لهذا القائد السياسي أو ذلك، لهذا الحزب السياسي أو ذاك، لهذه الأيديولوجية أو تلك.
بل بالعكس، ثمّة نقدٌ صارم دائم في كل الاتجاهات، ورغبة حرّى في أن أكون إلكترونا حرا على الدوام.
أستطيع اليوم أن أنشر كل ما كتبته، منذ أول حرف كتبته، في كل المراحل السياسية المتأرجحة التي عاشتها اليمن، وعشتُها في كل مكان، دون خجل.
وأظن أن النزوع للحريّة، والانتصار للعقل والروح النقدية، تهيمن دوماً على كل حرف كتبته.
لكن لا يعني ذلك أني غير ملتزم لأي شيء.
إذا كنتُ فعلا لا ألتزم بأية أيديولوجية سياسية أو دينية أو إلحادية، فأنا أسير الشعورِ الفطري بحب الآخر وبرغبة فتح جسور دائمة معه، وبمبادئ العلاقات الإنسانية السامية عموماً…
لعلّي أيضاً ما زلتُ وفيّاً للماركسية كطوباوية، كما اكتشفتُها مبكِّرا في عدَن. وليست كـ”ديكتاتورية بروليتاريا” ومشروع سياسي أيديولوجي، لا يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الطبيعة الإنسانية.
ملتزمٌ دوماً بالطبع ببعض الأفكار اليسارية، كمقارعة الطغاة والظلاميين بدون هوادة، ورفض طغيان سلطة المال… لكنه التزام حر، لا يخضع لأي توجيه عقائدي أو حزبي. وعلى الصعيد الأدبي: بين “الأدب لأجل الأدب” أو “الأدب لقضايا الإنسان”، أميل، إذا لزم الاختيار، للأول:
أعشق الكلمات، في الحقيقة، لأجلها ولها. المصطلحات اللغوية الجديدة، والسرد الشهي، والاستشهادات الممتعة، وكيمياء الكلمات وتضاريسها وأبعادها، وموسيقى النص، غايات مقدّسة بالنسبة لي بحدّ ذاتها، تستهويني أثناء القراءة والكتابة، قبل كل شيء.
بالطبع، إذا كان النص السردي ينصبُّ لهدفٍ فنيٍّ بحت، فذلك جميلٌ جداً. وإن كان أيضا، في الوقت نفسه، للتعبير ذي البعد الإنساني، أو البوح، أو لهدف ملتزم، فلِمَ لا؟…
المثير هنا ربما: يوازي هذا الاختيار الأدبي، اختيارَ راوي “حفيد سندباد”، على الصعيد العِلمي، بين العالِم النظري الذي لا يهمّه غير تحليق الرياضيات وجمالياتها (العِلم لأجل العِلم): ديمتري بابكين، والعالِم التطبيقي: ميشيل لينيه الذي لا يهمّه غير الجدوى الاقتصادية للبحث العلمي.
إذ يميل الراوي للأول، ديمتري! وإن كان ما اختاره لنفسه في مجال الأبحاث العلمية هو أن يكون شخصياً جسراً بين الاثنين.
عن الكتابة باللغتين
استمرَّ تناغم القراءة بالفرنسية غالباً، والكتابة بالعربية غالباً، في فيزياء حياتي السردية لمدة سبع روايات، وحوالي 20 سنة.
ما القادم؟ رواية بالعربية، أم بالفرنسية؟
لا أعرف بعد. أشعر أن الرغبة بكتابة رواية جديدة بالفرنسية الآن تمتلكني أكثر فأكثر، وربما سيكون ذلك مصير آخر رواياتي عموماً، كما لو كان أشبه بعودة دائرية، تحترم مبدأ التماثل الهندسي المهيمن على حياتي دائماً، لأني بدأتُ تاريخياً بكتابة رواية بالفرنسية، ولأن الفرنسية أصبحت، هي الأخرى، “لغة روحٍ وجسدٍ” بالنسبة لي، أندم غالبا على عدم استخدامها للكتابة الأدبية بشكل منتظم.
لا أعرف بعد، لكن هناك رغبة للعودة للفرنسية. بدأتُ أشعر بها بعد إنهاء كتابة “حفيد سندباد”، كما لو كنتُ قد فرّغتُ كلّ ما لديّ تقريبا بالعربية، في حقول التخييل عن الماضي والمستقبل أيضاً.
أريد دوماً، في كل الأحوال، أن يخلق التفاعل بين اللغتين، في حوض كتاباتي، نصوصاً جديدة مدهشة، تفيدهما معاً.
*كاتب روائي يمني
(محاضرة ألقيت بدعوة من “مركز دراسات الشرق الأوسط”، في جامعة هارفارد، يوم الثلاثاء 21 مارس 2017)
ضفة ثالثة


