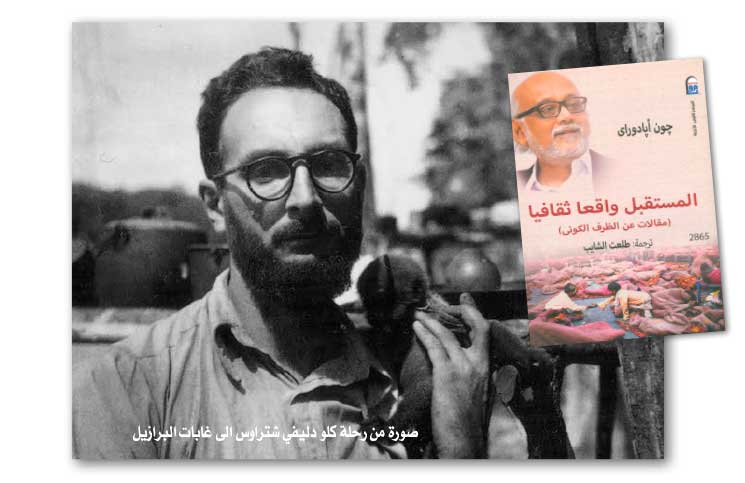خارج المكان… حالة الاستثناء… اقتصاد الأخلاق : أنثروبولوجيون في مخيمات المشرق العربي/ محمد تركي الربيعو

يعكس جزء كبير من الأدبيات الصادرة عن اللاجئين في منطقة المشرق العربي، سوء الطالع الذي ابتلي به تاريخ المنطقة بشكل عام. من هنا فقد ركزت بعض المدارس على المعاناة والتراجيديا والظلم الذي يعانيه اللاجئون، باعتبارها موضوعات تجد جذورها التاريخية في الخلاف الإثني والطائفي السائد في المنطقة. بينما أخذت مدارس أكثر حداثة عن أجندة البحث تلك، تصور مخيمات اللاجئين (الفلسطينية مثلا) باعتبارها أرضا خصبة للتطرف الديني والتشدد، أو تتمحور حول المسائل القانونية والتهجير القسري وجبر الضرر، وقبل كل شي «حق العودة « للاجئين الفلسلطينيين، وربما في المستقبل حول حق عودة اللاجئين العراقيين والسوريين الذين هجروا من بعض المناطق على أساس طائفي وإثني.
ضمن هذا السياق، يأتي كتاب «اللاجئون الفلسطينيون في المشرق العربي» إصدار المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ترجمة ديما الشريف، الذي أشرف على تحريره كل من آري كنودسن كبير الباحثين الأنثروبولوجيين في «معهد كرستيان ميكلسين» النرويجي، وساري حنفي أستاذ الأنثروبولوجيا في الجامعة الأمريكية في بيروت، ليقدم مقاربة وافاقا انثربولوجية جديدة، حيال البحث في حالة الاستثناء التي يعيشها هؤلاء اللاجئون داخل بعض المخيمات، التي أخذت تشكل شكلا اجتماعيا مكانيا جديدا وفريدا من ناحية تركيبتها، بحكم تحولها إلى ملاذات إنسانية مجردة من أي معنى بمثابة «لامكان»، أو بالأحرى مرحلة من التقسيم المتخيل والفعلي للمنطقة إلى جيوب وفق خطوط إثنية وطائفية جديدة.
اللاجئ والإرهاب في عصر الإمبراطورية
ترى الباحثة الأنثروبولوجية جولي بيتيت- مديرة دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية في جامعة لويزفيل الأمريكية- أنه في السياق الأوسع لعالم ما بعد الحرب الباردة، ما عاد ينظر إلى المهجرين، وفق منظومة الحقوق التي يضمنها القانون الدولي والمعايير الإنسانية، بمقدار ما تعاظمت النظرة اليهم باعتبارهم مسألة أمنية.
الأمر الذي أدى إلى استحداث إجراءات جديدة لمسألة اللاجئين تقوم على فكرة إعادة احتوائهم في أماكن إنتاجهم، كما بدى مع حروب التسعينيات في البلقان والعراق. لأن من شأن احتواء المهجرين في ملاذات آمنة أو منتشرة على نطاق واسع داخل حدود الدولة، أن يجعل تصنيفهم كأشخاص مهجرين داخليا أمرا ممكنا، وأن يقلل كذلك من احتمال زعزعة الاستقرار الإقليمي، الذي قد تتسبب به تدفقات كبيرة للإجئين، إضافة إلى ذلك كله، يخفف الاحتواء من الحاجة إلى رد دولي على الأزمة.
كما أن الجديد في مقاربة مسألة اللجوء، أن بعض المحللين الغربيين بات يصنف اللاجئين في خانة واحدة مع آخرين. فعلى سبيل المثال، يشير محللو معهد بروكينغز إلى الصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة في إيقاف «تدفق الأشخاص الخطرين عبر الحدود العراقية، لاجئين ورجال ميليشيات وغزاة أجانب وإرهابيين». وبكلام آخر، بات اللاجئون اليوم هم مرادف الإرهابيين و»ناقلين للصراع «، حيث يشير مصطلح «الناقل» هنا إلى الكائن الحامل للمرض والمسبب له، تماما مثلما حصل مع الهايتيين من طالبي اللجوء في الولايات المتحدة، الذين صنفوا على أنهم حاملو مرض نقص المناعة المكتسبة.
وفي هذا السياق تتطرق الباحثة لبعض الطروحات التي سعى الأمريكيون لتطبيقها في العراق، عبر إنشاء مناطق عازلة ونقاط لتجميع اللاجئين تكون «مصفاة»، بمعنى أن تكون أماكن فارغة من أي مضمون بالنسبة إلى اللاجئين «لامكان»، وأن تكون موضوعا جديدا بلا أي مضمون، بحيث تجسد فكرة اللاجئ «غير المرئي».
وبحسب هذه الطروحات فإن المصفاة «كانت تعني وسيلة تصفية توضع على مدخل تقاطع للصرف الصحي لمنع المواد الصلبة من دخول المجارير وسدها». يمكن لـ»المصافي» أن تنشأ في مناطق حدودية قرب المطارات في العراق، وبالتالي يمكن أن تؤمن من الأمريكيين ولا ضرورة لوجود هيئة دولية كي تتحمل هذه المسؤولية. وبذلك يغدو الهدف من إنشاء مصاف منع حركة عبور الحدود، والأكثر أهمية من ذلك أن القوات الأمريكية ستتمكن من احتواء اللاجئين ونزع سلاحهم، والإبقاء على سلميتهم، لكن بعد فشل هذه الطروحات، ظهرت وسيلة مكانية جديدة للفصل في بغداد، حيث بني جدار اسمنتي، ظاهريا بهدف الحد من العنف، وواقعيا لإعاقة حرية التنقل بين قطاعات النسيج الاجتماعي المكاني الذي بات يكتسب طابعا «سنيا» و»شيعيا»، مثلما حصل بالنسبة إلى الجدار الإسرائيلي المشيد في الضفة الغربية لتشديد الفصل والعمل على «فلسطنة العراق».
فضاءات فوكو الفلسطينية في لبنان
من جانب آخر، يتطرق ساري حنفي إلى مسألة الإدارة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، لا من الزاوية الأمنية فحسب، بل من زاوية العزل أو الفصل الذي بات مفهوما مركزيا في نقاشات التركيز المكاني للخطر الاجتماعي، وفي شأن الإدارة المحلية /المدينية، حيث اعتبرت المخيمات في لبنان «جزرا أمنية»، وعوملت بوصفها فضاءات استثناء ومختبرات تجريبية للسيطرة والمراقبة. ومن أجل فهم حضور أنموذج الإدارة في لبنان ومستقبله، يستعين الباحث بعمل ميشيل فوكو «المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن»، الذي تحدث الأخير من خلاله عن نوعين من القوة التي برزت بين القرن السابع عشر ونهاية القرن الثامن عشر، ردا على علاج المصابين بالجذام والطاعون.
فقد كان علاج الجذام يتم من خلال منطق الفصل/ العزل، والاستبعاد/ الإقصاء والاحتجاز، حيث يطرد المصابون بالجذام من المدينة ويحتجزون في مستعمرات للجذام من خلال قوانين وقواعد معينة، ويحولون إلى أشخاص غير مرئيين، من خلال «منفى مسيج»، ثم يتركون للموت وسط مجموعات لا جدوى من التمييز في ما بينها. على العكس من ذلك أدى الطاعون، باعتباره مرضا معديا وينتشر ويقتل الناس بسرعة، إلى إجراءات واستجابات مختلفة مبنية على التقسيم المكاني، أي الفصل المتعدد والعلاج الفردي. فقد كانت الأحياء والشوارع والمساكن تحت ملاحظة ومراقبة وسيطرة دقيقة. وكان على كل مواطن أن يتقدم للتفتيش أمام مفتشين، وبذلك ساعد هذا التقسيم في نشوء السياسات البيولوجية/الحيوية التي ساعدت الإحصاءات الحكومية في تحسين تقنيات السيطرة والمراقبة.
وفي رأي حنفي يعد فصل المصابين بالجذام والتقسيم المتتبع لعلاج المصابين بالطاعون ممارسات من العصور الوسطى، لكنها تستمر للأسف باعتبارها علاجات للسكان «غير المرغوب فيهم» في لبنان، حيث يتم التعاطي مع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ( وربما نضيف المخيمات السورية حاليا) بوصفها فضاءات تحتاج إلى المراقبة، وفضاءات «استثناء واستبعاد». كما أن أنموذج الإدارة الجديد الذي يرتكز على حكم المخيم بوساطة شرطة مكافحة التمرد والشغب (مخيم نهر البارد) ليس إلا طريقة لمعاملة المخيم باعتباره مدينة من العصور الوسطى مصابة بالطاعون، فقد أصبحت الإدارة الجديد للمخيمات طريقة للانتقال من حالة مدينة مصابة بالجذام، حيث يجب على المصابين أن يكونوا غير مرئيين إلى حالة مرئية بشدة، ما يعني أن يصبح كل فرد مشتبها فيه، يسجل عند دخوله، ويراقب أثناء وجوده داخل المخيم.
حاكمية إسلامية:
من جانب آخر، يرى حنفي أنه على الرغم من كون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يتمتعون بالحقوق المدنية والخدمات ذاتها التي يتمتع بها المواطنون السوريون، وهم مندمجون اجتماعيا أكثر من اللاجئين الفلسطينيين في أي دولة مضيفة أخرى. بيد أن احتكار الدولة للسياسة، أعاق عمل العديد من الفصائل الفلسطينية والمنظمات المجتمعية داخل هذه المخيمات للقيام بعمل سياسي، لكن مع توصل النظام والفصائل الإسلامية إلى ابرام صفقة واضحة، تقوم على توافق سياسة حركة حماس مع سياسة سوريا الخارجية، منحت الحركة حيزا لممارسة العمل السياسي.
وقد استثمرت حماس مبدئيا رأسمالها السياسي المحدود من خلال قنوات اجتماعية، عوضا عن القنوات السياسية العلنية. ونتيجة ذلك، أخذت الحاكمية الاسلامية تحتل المسرح الاجتماعي، وبذلك لم تعد تمتد إلى المستوى الأصولي المتعلق بالأخلاق والنظرة إلى العالم فحسب، بل أخذت تتجلى أيضا، في مصطلحات أكثر تحديدا في مجال السيطرة والمراقبة الحقيقية. بهذا المعنى، أخذت تبدو التفسيرات المحددة للإسلام (ليس في مجال الشريعة فحسب، بل أيضا في مجال الأخلاق) كأنها بدأت تقوم بدور «عقلية الحكم» أو الحاكمة بالنسبة لسكان المخيم.
الأمر الذي بات يعني – بحسب تفسير حنفي – أنه من خلال إصلاح الذات والعلاج وتقنيات تغيير الجسد وإعادة التشكيل المحسوبة للحديث والمشاعر، تقوم حماس بضبط أنفسنا عبر التقنيات الذي يطرحه خطابها الأخلاقي والروحاني.
وبذلك غدت الإسلاموية التي صاغتها حماس داخل المخيمات، كعلم روحي بالمعنى الحرفي للكلمة، بمثابة الطريقة التي يبني من خلالها الشبان الفلسطينيون أنفسهم، كما دفعت إلى الواجهة فكرة أن «اقتصاد الأخلاق» بإمكانه أن ينظم المجتمعات في غياب الهرميات التقليدية، وبالتالي يصبح تراكم الرأسمال الأخلاقي طريقة للبروز والتميز بين الأقران، وأخيرا طريقة لفرض الاحترام والسلطة في المخيمات.
باحث سوري
القدس العربي