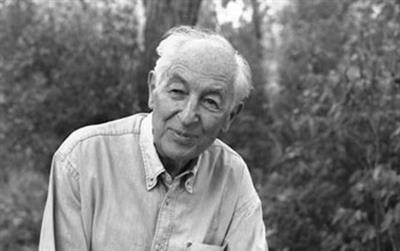درس الختام/ محمد خضير

غالباً ما يواجه الكاتب، وأيُّ منتِج في جنس من الأجناس الأدبية، موقفين في حياته الإبداعية والفكرية، موقف الافتتاح وموقف الاختتام. غير أنّه بالنسبة لكثير من الكتّاب فإنّ الموقف الافتتاحي قد يكون هو الموقف الختامي في الوقت نفسه، لأن الثاني يشكل “امتداداً دورياً في التاريخ” للموقف الأول. وعلى سبيل المثال، فإنّ الدرس الافتتاحي لرولان بارت (درس السيميولوجيا) الذي ألقاه بالكوليج دو فرانس في 7 يناير 1977، كان موقف الاختتام لسلسلة من المواقف البنيوية واللسانية التي منهجت كتبَه الأولى. وقد أنهى بارت درس السيميولوجيا بقوله: “إنّ عليّ دورياً أن أُبَعث من جديد، وأكون أصغر سنّاً ممّا أنا عليه”. وهذا ما تشهد عليه كتبه الأخيرة مثل “أسطوريات” و”خطاب العاشق”.
وليس بارت المفكّرَ الوحيد الذي يعقد النهايات بالبدايات على نحو معكوس، فقد اتجه سارتر وكامو للرواية والمسرح بعد تأسيس المنهج الفلسفي الوجوديّ لكل منهما بكتابين افتتاحيين أساسيين “الوجود والعدم” و”الانسان المتمرد”.
أمّا ديريدا ولاكان فعُرِفا بكتابيهما عن جان جينيه وإدغار ألن بو، وقد سَمَتْ فيهما طراوةُ الأدب على صرامة الفلسفة؛ فكان الكتابان خاتمتين لتأسيسات افتتاحية في التفكيك وعلم النفس البنيوي. وكان باشلار بعد كتُبه الأساسية حول “العقل العلمي” قد عاد ليجرب منهجه الظاهراتي في تأليف كتب طريّة مثل “جماليات المكان” و”لهب شمعة” و”الماء والأحلام”.
قياساً على ترابط هذين الدرسيْن، ماذا كان سيؤلّف عالم الاجتماع العراقي علي الوردي مثلاً لو امتدّت به الحياة؟ هل سينعطف بعد “لمحاته التاريخية” ودروسه الاجتماعية والنفسية التأسيسية لكتابة سيرة الرصافي أو الزهاوي من زاوية منهجية أطرى وأمتع؟ أم أنّه سيجرّب كتابة روايةٍ يحبكُ حوادثَها بشخصية أحد السلاطين، فيختم بها حلقةَ الدرس الاجتماعي والتاريخي الأول؟ وإلى مَ كان سينعطف زكي نجيب محمود ومحمد عابد الجابري ومصطفى سويف وحسين مروة ونصر حامد أبو زيد، بعد أداء أدوارهم الافتتاحية؟ كم من الشخصيات القلِقة ظلّت حبيسة جدرانهم المعرفية العالية؟ ألم يسبقهم ابنُ سينا والغزالي وابن طفيل بقرون في تأليف رسائل فلسفية تنحو منحى القصة لإعمام حكمتِهم المتعالية وترقيق تلك الجدران بل الإطاحة بها؟
وحين نقترب أكثر من الحاجز الرقيق بين الفلسفة والأدب، التجربة العقلية والابداع الخيالي، فثمّة فنون غير القصة والرواية والمسرحية، يتبارى فلاسفةٌ عالميون على اختتام نصوصهم الأساسية بها، كالمذكرات واليوميات والرحلات، وهذا ما لم يفكر به المفكرون العرب وفلاسفتهم (عدا طه حسين ومالك بن نبي وادوارد سعيد وعبد الله العروي) لكي يعقدوا أولاهم بآخرتهم؛ حيث ظلّت دروس أولئك الافتتاحية بلا ختام”.
بالمقابل فإنّ الأدباء العرب المعاصرين لم يخترقوا حاجز الفلسفة الى ما أمامه، ويتنبّهوا على تدوين يوميات التجربة الابداعية الذاتية من وجهة معكوسة كسابقيهم (جبران ونعيمة وشدياق وطهطاوي والحكيم) إذ ظلّت مطالعُ سعدِهم الأدبي بلا خواتيم فكرية وبراهين نظرية سديدة على إبداعهم الأدبي الخيالي. بينما يتبارى غيرهم في الجانب الآخر من الأرض (ساباتو وكونديرا وموريسون وأوستر وترانسترومر وسيميك) على اختراق الحاجز الوهمي بين الذات المتخيلة والعالم الموضوعي بدروس ختامية شهيرة (ونستثني أيضاً مثالاً انفرادياً هو الشاعر أدونيس الخارق العكسي لعالم الأدب الماورائي).
إنّ تجارب أدبية ختامية استثنائية (أدوار الخراط، جمال الغيطاني، ممدوح عدوان) أضاءت كبرقٍ خاطف الحدودَ التي تنتظر عندها نفوس ذاتية حائرة، لكنّها لم تكن كافية لخزن طاقة فكرية عالية تدفع الدروسَ الختامية الى ما وراء العالم الأدبي المحدود.
وبذا يظلّ الحدّ الفكري/ الذاتي قائماً لابتداء رحلةٍ جديدة تسطع فيها البروق كما سطعت يوماً في عقولٍ انسانية فريدة، للعبور والاستثناء والتحوّل الذي لمستْه دوريس ليسنغ على الجانب الآخر من الحدّ: “إني أتغيّر. لا شيء يبقى من دون تغيير” فدفعَها هذا الإدراك لكتابة “مفكرتها الذهبية” التي نالت عليها جائزة نوبل.
هل كانت تجربة لسنغ النسوية، ومرحلتها الجنوب/ افريقية حداً نهائيا للتحول وتدوين درسها الختامي؟ ما بال الأدباء العرب ينتظرون _ وقد عصفَت بحياتهم عشرات البروق والعواصف_ للتفكير بحدّهم النهائي، ذاك الذي لاح للألماني راينر ريلكه على الجانب الآخر أيضاً، فكتبَ عنه إحدى قصائده، بل أنّ قصائده أغلبها أمثلة على الاختراق الفلسفي العميق؟
ضفة ثالثة