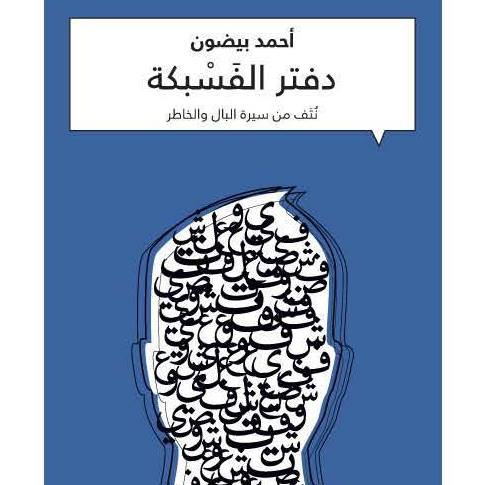” رسائل أنسي الحاج إلى غادة السمان” –مراجعات مختارة-

رسائل لم تكن في الحسبان… أنسي الحاج العاشق «المتوهم» عندما راسل العشرينية غادة السمان بوَلَهٍ وجنون
عبده وازن
كشفت الروائية السورية غادة السمان رسائل حب كان قد كتبها لها الشاعر أنسي الحاج في العام 1963 وجمعتها في كتاب شاءته هدية إلى رواد معرض بيروت للكتاب عنوانه «رسائل أنسي الحاج إلى غادة السمان» (دار الطليعة). وإن بدا هذا الكتاب بمثابة مفاجأة كبيرة حملتها صاحبة «لا بحر في بيروت» إلى قرائها وإلى قراء شاعر «الوليمة» فالحدث الذي تتمثله هذه الرسائل يكمن خصوصاً في كشفها «قصة» حب ولو متوهمة أو عابرة قامت بين الشاعر الذي كان في السادسة والعشرين والكاتبة التي كانت تتهيأ في العشرين من عمرها لدخول عالم الأدب وتحديداً عالم القصة القصيرة في بيروت التي قصدتها لتواصل دروسها في الجامعة الأميركية وكانت صدرت لها للتو أولى مجموعاتها «عيناك قدري».
< لم يكن أحد من أصدقاء أنسي الحاج يتوقع أن يكون الشاعر قد عاش مثل هذه المغامرة التي لم تدم طويلاً، فهو لم يروِ عنها بتاتاً حتى للأشخاص الأقرب إليه الذين كان يستودعهم بعضاً من أسراره، ولم يذكر غادة في حواراته الصحافية ولا في مجالسه. بل إنه لم يكتب عن غادة في زاويته الشهيرة «كلمات» في ملحق النهار، أي مقال مع أنه كتب الكثيرعن الأدباء والفنانين وعلّق على روايات ودواوين ومجموعات قصصية كثيرة.
ومن يعد إلى كتاب «كلمات» بأجزائه الثلاثة لا يجد اسم غادة السمان في الفهرست، ما يعني أنها غائبة عنه تماماً. لكن غادة تنشر في ختام كتاب الرسائل شهادة صغيرة كتبها الحاج عن مجموعتها القصصية «رحيل المرافئ القديمة» وتحمل تاريخ «ربيع 1973» ومن دون أن تذكر الصحيفة التي نشرتها، مكتفية بالهامش الآتي: «هذه الشهادة كتبها أنسي الحاج بعد عشرة أعوام من تاريخ رسائله إلى غادة». تُرى هل كتب الحاج هذه الشهادة في زاويته الشهيرة ثم أسقطها من الكتاب؟ فالشهادة تنضح محبة وإعجابا لكنها تخلو من الحماسة الشديدة التي عرف بها الشاعر وفيها يقول: «بمزيد من الجرأة، بمزيد من الصدق، بمزيد من الغوص على الذات، تعود غادة السمان إلى قراء قصصها القصيرة بمجموعة جديدة عنوانها «رحيل المرافئ القديمة»، وبضع من القصص تستوحي هزيمة 1967. وكلها، من دون ريب، تضع القارئ في مناخ شديد الحرارة ومرات ملتهب الحمى».
ويتطرق في الختام إلى زواجها قائلاً: «بعد زواجها، قيل سوف تهجر التأليف. وكالعنقاء قامت من رمادها، وإذا بالزواج تجربة جديدة حوّلتها الكاتبة بموهبتها الأكيدة، إلى مركز إلهام إضافي. غادة في كل ما تكتبه شاعرة. هي حقاً شاعرة».
واللافت أن كل الرسائل التسع كتبها الشاعر وفق تواريخ بعضها، في الأيام الأولى من كانون الأول(ديسمبر) 1963 وقد غابت التواريخ عن أربع رسائل بدت أنها كتبت في السياق الزمني نفسه وبالروح نفسها أو النفَس نفسه. كتبت الرسائل تباعاً وكأنها قصائد أو نصوص، ومعظمها فعلاً يفيض نزقاً وتوتراً وجمالاً، على غرار شعر الحاج. ويظهر بجلاء أن أنسي كتب هذه الرسائل ثم توقف أو انقطع عن مراسلة غادة مع أنه أعلن حبه لها أكثر من مرة وأحيانا مجاهرةً أو علناً. ولكن ما هو هذا الحب الذي لم يدم وفق الرسائل سوى أيام معدودة ولكن محمومة حباً وهياماً ووهماً وتوهماً.
كيف قدّر لهذا الحب العنيف والغامض أن ينتهي هكذا مثل هبة هواء؟ لو كانت غادة تلقت رسالة أخرى أو حتى قصاصة رسالة، لكانت نشرتها من غير تردد، إلا إذا أرادت أن تخفي ما شاءت أن تخفيه، وهذا مستبعد تماماً.
غادة جريئة جداً في كتابتها كما في حياتها، علاوة على نبلها وعفويتها. وكانت صادقة عندما قالت إنها لم ترد على رسائل أنسي ولم تكتب له. وفي مقدمتها المختصرة للرسائل تقول: «لم أكتب لأنسي أي رسالة، فقد كنا نلتقي كل يوم تقريباً في مقهى الهورس شو – الحمرا أو مقهى الدولتشي فيتا والديبلومات – الروشة أو مقهى الأنكل سام … وهذه المقاهي انقرضت اليوم». لكنها عندما نشرت في العام 1993 الرسائل التي كتبها الروائي الفلسطيني غسان كنفاني إليها والموقعة خلال العامين 1966 و1967 اتهمها بعض الصحافيين بإخفاء رسائلها إليه وقالوا إنها كانت استعادت رسائلها منه وأخفتها أو أتلفتها لئلا يقرأها أحد. وردت غادة موضحة أنها بحثت عن رسائلها إليه لتنشرها في الكتاب نفسه ولم تجدها وتحسرت على ضياعها. وعندما صدرت رسائل كنفاني أحدثت ضجة في المعترك الأدبي والسياسي العربي وانبرى الكتاب والصحافيون يدبجون المقالات حول هذه العلاقة العاصفة التي قامت بين المناضل الفلسطيني وغادة واستاء بعض المناضلين الفلسطينيين من الصورة التي تكونها الرسائل عن كنفاني العاشق المهزوم والضعيف والذي بدا أشبه بدمية بين يدي معشوقته.
لا تمكن المقارنة بين رسائل كنفاني ورسائل الحاج ولا تمكن المقابلة بين قصة كنفاني وقصة الحاج. الأول أحب غادة حباً حقيقياً وبادلته غادة الحب مبدئياً بينما أحب الحاج غادة حباً ظل ملتبساً بين نزعته الأفلاطوينة والنزق إن صح القول، ولم تبادله هي هذا الحب. والرسائل تشهد والوقائع أيضاً.
كانت غادة في العشرين من عمرها، صبية حسناء ومثقفة، متحررة على الطريقة الغربية، تواصل دراستها العليا في حقل الأدب الإنكليزي والمسرح العبثي في الجامعة الأميركية، وقد أصدرت مجموعتها القصصية الأولى «عيناك قدري» ولقيت ترحاباً لدى النقاد في بيروت ودمشق.
أما أنسي فكان في السادسة والعشرين، متزوج وله ابنة وابن، أحد شعراء مجلة «شعر» وصحافي لامع في جريدة «النهار»، وكان أصدر ديوانيه «لن» و«الرأس المقطوع». وتفيد الرسائل التي كتبها إلى غادة بأنه كان يعيش حالاً من الصراع الداخلي ومن الاضطراب الذي عرفه سابقاً أيام كتب ديوانه «لن»، وكان يبحث عن خشبة خلاص وعن حب ينقذه من نزاعه الداخلي المضطرم. ولعله وجد في غادة بل وجد حتماً فيها، المرأة المنتظرة فراح يقنع نفسه بأنه يحبها وأن عليه أن يحبها.
وهذا ما تؤكده جمل كثيرة في الرسائل ومنها مثلاً: «إنني أحب أن احبك»، «أحب أن أحبك لأنك تمثلين في نظري خشبة الخلاص الوحيدة الممكنة أو اللاممكنة»، «قررت أنني أريد أن أحبك» … حالات التخبط هذه ليست بقليلة ولكن لن يلبث أن يليها اعتراف صارخ بحبه لغادة، جهاراً وبعنف أحياناً مع أن حبه ظل مبدئياً من طرف واحد ومكث وقفاً على التمني اللحظوي وغير الثابت، يقول: «إنني بحاجة إليك»، «أظن أنني كنت أحس بأنك منذورة لي»، «ليتك تعلمين كم أنت كل شيء في صيرورتي»، «إما أنت أو النهاية»… ثم تتدفق عاطفته بما يشبه النزق فيقول لها: «اسكبي على عقلي نارك. خذيني. افتحي لي باباً، افتحي لي قبراً… فتتي أعصابي، خذيني، لم يصرخ أحد من قبلي هذه الصرخة: خذيني». ويقول في رسالة أخرى: «أشعر بجوع إلى صدرك ، بنهم إلى وجهك ويديك ودفئك وفمك وعنقك، إلى عينيك…».
لعل أغرب ما في هذا الحب المتفجر هو انطفاؤه السريع. كان حباً نارياً ولكن بلا جمر، فما أن خمد حتى استحال رماداً. كيف ينتهي مثل هذا الحب الجارف على حين فجاة وكأنه لم يكن؟ ربما لم يحب الحاج غادة مقدار ما أحب صورتها أو المثال الذي تجسده فتاه وراح يوهم نفسه أنه يحبها بل راح يقنع نفسه أن عليه أن يحبها. وهذا ما يؤكده هو نفسه في الرسائل كأن يقول: «كنت أعلم أنني بحاجة إلى إنسان. إلى إنسان يتناسب، في ذكائه وإحساسه وطاقاته جميعاً، الإيجابية منها والسلبية، مع ما أنا فيه وما سأصير فيه»، ويضيف: «أصبحت أنت التجسيد للإنسان الذي أنا بحاجة مصيرية ملحة وعميقة وعظيمة ورهيبة إليه». إلا أن أنسي كان على يقين داخلي أنهما، هو وغادة خطان متوازيان لن يقدّر لهما أن يلتقيا، كما يعبر.
في تقديمها المختصر للرسائل أشارت غادة إلى أنها عجزت عن تمزيق هذه الرسائل التي تصفها بـ «الرائعة أدبياً» فنشرتها غير آبهة لما قد يترك نشرها من آثار. وكم أصابت فعلاً، فالرسائل هي بمثابة اكتشاف ثمين وحدث أدبي، ليس لأنها تكشف فقط زاوية جديدة من حياة أنسي أو سيرته، بل لأنها تمثل نصوصاً بديعة لا تقل بتاتاً فرادة وجمالاً عن قصائد الشاعر ومنثوراته. فأنسي بدا في هذه الرسائل كأنه يكتب لنفسه وعلى طريقته الخلاقة والمشبعة بالتوتر والجمال.
– مختارات من الرسائل
غادة
الوضوح الذي أنا بحاجة إليه لم أقدمه. كنتُ أعرف أنني سأفشل في تقديمه. لكنني أردت أن أجرب. أردت، لأنني أطمع بمشاركتك. أطمع بها إلى حد بعيد جداً. لكن رغم هذا أعتقد أنني سأقول لك شيئاً واضحاً. وقبل كل شيء، هذا: إنني بحاجة إليك. (إذا ضحكت الآن بينك وبين نفسك سخرية من هذه العبارة، فسيكون معناه أنك لا تحترمين مأساتي. ولن أغتفر لك ذلك أبداً). تتذكرين دون ريب أنك ضحكت مرة بمرارة، وانتقام دفين، وشك وسخرية، حيث قلت لك إنني بحاجة إليك. وربما فكرت: كيف يعرف أنه بحاجة إلي، أنا بالذات، شخص لا يعرف عني شيئاً، ولا أعرف عنه شيئاً، ولا يعرف إذا كنت، أنا، (أي أنتِ) بحاجة إلى أن يكون أحد بحاجة إلي… وربما فكرت (وأنا لو كنتُ مكانك لجاءتني الأفكار نفسها) أيضاً، إنني، في تسرعي للقبض على الفرصة السانحة (السانحة في الظاهر) نسيتُ حتى أن أكون لبقاً، أو أن أذهب بمراوغتي مذهباً ذكياً على الأقل، فلا أصوغ «حاجتي» بتلك العبارات المسلوقة، المبتذلة، المبريّة حتى الاهتراء على بلاط النفاق البشري والتعاملات العابرة والزَيف والخبث والتدجيل. وربما، أخيراً، (ولو كنت مكانكِ لفعلت) وربما فكّتِ: أإلى هذه الدرجة يظنني وطيئة المستوى، فلا يكلف نفسه، معي، مشقّة الارتفاع بالنفاق إلى حد أكثر جاذبية، على الأقل؟
ولا أستبعد أن تكون هذه الأفكار، وغيرها أمرّ، قد راودتك في مناسبات أخرى. فقد كانت معظم مواقفي الظاهرية معك مواقف ناقصة تحمل كثيراً على الشك وأحياناً على الاستخفاف والألم والرغبة في تأكيد الذات بنوع من القسوة حتى لا أقول الظلم. لكن، يا عزيزتي (يا لهذه اللفظة السخيفة!) دعيني أوضح مرة أخرى، وأرجو أن لا تضجري.
قبل أن أتصل بك للمرة الأولى كنت أعلم، لكن ربما أقل من الآن، أنني بحاجة إلى إنسان. بحاجة إلى إنسان يتناسب، في ذكائه وإحساسه وطاقاته جميعاً، الإيجابية منها والسلبية، مع ما أنا فيه، وما سأصير فيه. وفكرت طويلاً. ورفضتُ، شيئاً بعد شيء، كل الحلول التي مرّت بفكري. ورفضت كل الأشخاص، ممّن أعرفهم وممّن لا أعرفهم، الذين استعرضتهم. وعندما اتصلت بك للمرة الأولى كنتِ ما تزالين مجرد إمكانية غامضة، لكن قوية. وظلّت هذه الإمكانية غامضة عندما قابلتك للمرة الأولى. وظلّت غامضة أيضاً عندما قابلتك في المرة الثانية، لكنها ازدادت قوة. وفي ما بعد، أصبحتِ أنت التجسيد للإنسان الذي أنا بحاجة مصيرية ملحّة وعميقة وعظيمة ورهيبة إليه. أصبحتِ أنتِ هذا الإنسان لا لأنني أنا صنعتُه منكِ، فحسب، بل لأنك كنتِ أهلاً لذلك. كنتِ أهلاً لذلك رغم أنّك ما تزالين، بالنسبة لي، منغلقة على نفسك ترفضين الخروج إليّ بالعري الذي أشتهيه وأريد أن أتحمّل وزره.
هل حدث هذا التجسيد بسرعة؟ أتتّهمينه بأنه مسلوق سلقاً؟ بأنه من تصوير خيال مريض؟ بأنه إسقاط نفسي؟ بأنه انتهازي ووصولي؟ لا يا غادة. السرعة التي تتصورينها ليست في الحقيقة، سرعة. ربما كانت كذلك بالنسبة لمتفرّج من الخارج لا يعرف شيئاً عن الدوافع البعيدة والمخفية واللامباشرة. أؤكد لكِ أن العملية تمّت، على العكس، ببطء. نعم ببطء. وأعتقد أنني بذلتُ حتى الآن جهوداً جبارة لكي أستطيع الصمود أمام عدم تصديقك وأمام تريّثك وأمام انغلاقك وأمام رفضك وصمتك وابتساماتك التي تظنين أنني لا أدرك مغزاها العميق. بذلتُ جهوداً عنيفة لكي لا أنهار ولكي أحتفظ أمامك بشيء من الاستمرار والقناعة. ولو نفذتِ إلى اعماقي لهالك المنظر: منظر القتل والتقتيل والموت.
بحاجة، إذن، إليكِ.
لا، لستِ مجرد خشبة إنقاذ بالنسبة لي. عندما أقول أنا بحاجة عظيمة إليكِ فمعناه أنني، كذلك، بحاجة إلى من يكون بحاجة، عظيمة، وربما أعظم بكثير من حاجتي، إليّ… إن لجوئي إليكِ ليس لجوء إنسان إلى شيء، بل لجوء إنسان إلى إنسان آخر. إنه رغبة في الارتباط. وإذا كنتُ أريد أن أتخطى وضعي فيكِ فإنني أريد، كذلك، أن تتخطّي وضعكِ فيّ. ليس مثلي من يدرك معنى الكلمات يا غادة: معناها العميق، الحقيقي، الثقيل، المُلزِم، والمحرِّر أيضاً. ليس مثلي من يدرك معنى صرخة: أحبك.
لقد ذكرتُ لكِ، فوق، كلمة جريمة. لماذا؟ لا أعرف. أريدك أن تساعديني على تحديد هذا الشعور، وعلى معرفة أمور كثيرة غيره. أريدك أن تكوني معي. أن تكوني لي. أريد، أكثر من ذلك، أن أكون لكِ.
سأتوقف الآن عن الحكي. الساعة الرابعة والربع صباحاً. لا أعرف إذا كان الخط سيكون سيئاً اليوم أيضاً وأُخطئك. الويل لي إذا لم أستطع أن أراك اليوم. هل تنامين؟ هل تحلمين بشيء جميل؟ الويل لي إذا لم أرك. ماذا سأفعل الآن؟ أنام؟ مستحيل. بلى. يجب. قليل من الشجاعة أيها الجبان.
2/12/1963
غادة
أظن أنني كنتُ أحس بأنك منذورة لي. وكلما كنت أطالع خبراً عنك كان يتولاني شعور واضح بالغيرة والضيق والخوف. كنتُ أغار عليك من العالم. إنني أذكرك بلهجتي عندما كلمتك للمرة الأولى بالهاتف وكنتِ في دمشق. ألم تشعري بنبرات صوتي المليئة باللهفة؟ أم أنك نسبتها إلى المجاملة، أو إلى عادة كل رجل في التودد؟ على كل حال لم يكن هناك لديك أي سبب معقول لتفكري في أي شيء.
وحين رأيتُك للمرة الأولى ألم تلاحظي أنني لم أكن أقابل امرأة غريبة لا أعرفها وإنما امرأة كأنني عرفتها من عهد بعيد؟ ربما لم تلاحظي. أو لعلك لاحظتِ ولم تفكري في شيء.
(أفكر الآن أنك قد تكونين مريضة اليوم فلا أراك. أمس أيضاً لم أرك. أفكر ماذا سأفعل. هل ستكونين مريضة اليوم؟ هناك شيء رهيب يتآمر علي في الخفاء. إنني مصاب بسرطان الزمن والخيبة).
أين كنت؟ كفى… يخيّل إلي أنني سأخسر معركتي الأخيرة. ومهما قلتُ فلك أقول شيئاً مما أريد. اخرس إذن. اخرس أيها المسكين. لقد أُعطيتَ أن تتعلم دروساً كثيرة لكنك لم تتعلم شيئاً. إلى أين ما تزال تمشي؟ إلى أين ما تزال تأمل؟ إنك تنتفض كالديك المذبوح. هذا هو كل شيء. انزف بقية دمك وأنتهِ.
أحقاً؟ رغم كل شيء ما تزال عندي القوة التي تمكّنني من المطالبة بأملي الأخير. إنني أرفض أن أستسلم قبل الدخول في هذا القَدَر. أريد أن أعرف للمرة الأخيرة، وبكل قواي، مَنْ مِن الاثنين أشدّ ظلماً وقسوة ولا معقولية: أنا أم العالم؟
أريد أن أنتزع الجواب، أن أنتزع الجواب بأسناني. لن أذهب قبل أن أعرف.
ليتك تعلمين كم أنتِ أساسية وخطيرة وحساسة. ليتك تعلمين كم أنتِ حيوية ولا غنى عنك. ليتك تعلمين كم أنتِ كل شيء في صيرورتي. ليتك تعلمين كم أنتِ مسؤولة الآن؟
لو تعلمين إلى أي درجة أنتِ مسؤولة عن مصيري الآن لارتجفتِ من الرعب. لقد اخترتكِ. وأنتِ مسؤولة عني شئتِ أم أبيتِ. لقد وضعتُ لعنتي الحرة عليك.
هل يجب أن أعتذر إليكِ عن هذا الاختيار؟ لا أعتقد. في النهاية، لن تعرفي أجمل من حبي. قد لا أكون واثقاً من شيء ثقتي بهذا الشيء. لا يمكن أن تعرفي أجمل من حبي.
وأنتِ؟ هل أظل أتحدّث إليك دون حوار؟
لا. لا. لا يمكن أن يكون العالم قد أقفر إلى هذا الحد من الحنان. لا يمكن أن يكون العالم قد خلا هكذا دفعة واحدة من الحب.
يمكن؟
فليخلُ. فلينتهِ الحب من الأرض وليذهب الناس إلى الجحيم. سأبقى وحدي أطبع حبّي على الحجارة. سأحب وحدي الموت والأشباح. وسأحب النهار أيضاً. وسأحب انقراض نفسي العاشقة في هذا العالم القبر. وسأحبك. ولن أقول شيئاً غير هذا.
3-4-12-1963
غادة
مر النهار؟ إنما العبرة في الليل. لكن الحقيقة أنني طماع، فلو كان الليل قد مر لكنتُ قلت: مر الليل؟ إنما العبرة في النهار. وإذا كان من حقيقة أخرى (والحقائق تُخترع لتغذية الحديث) فهي أن لا ليل هناك ولا نهار وإنما وقت للمجابهة ووقت للهرب. والمرتاحون هم الذين نظموا هذه المناصفة وجعلوا التعاقب مرتباً. بالنسبة لي، مثلاً، اختلط وقت المجابهة بوقت الهرب فصرتُ أجابه وأهرب في وقت واحد وتفرّع هذا الوقت نفسه إلى أجزاء كل جزء منها يتنازعه الهرب والمجابهة إلخ… وليس صحيحاً أنني أخاف الليل أكثر من النهار وإنما أنا أخاف أن أكون وحدي، معزولاً عما يهمني، عما أهجس به وأحبه ولا أصدقه، مقطوعاً عن العالم الذي أتهمه بأنه يخدعني دائماً وخصوصاً في غيابي. فكم أشتهي أن أُباغت العالم وأفضحه وهو يخدعني، هذا الذي يدعي الإخلاص لي، ويدعي العذاب من أجلي، ويدعي العزلة والوحشة والوفاء!
أهلاً بك يا غادة. الساعة الآن شيء ما بعد نصف الليل، لعلك نائمة.
تُرى ماذا يشغل فكرك الآخر؟ أقصد فكرك المخفي وراء الوجه الآخر للقمر؟ كم أحب أن أعرف ماذا دار وماذا يدور في رأسك! وكم تخطئين في وصف هذه الرغبة بالفضول! لأنها ليست أكثر من شهوة عارمة عظيمة إلى تصفيتك من غربتكِ وضمك إلى قلبي وأفكاري وحياتي. أريد، ولا شيء أكثر الآن، أن أتّحد بك.
هل أمضيتِ نهاراً حلواً أمس؟ وسهرة السبت؟ والدروس، كيف الدروس؟ والكتابة؟ ماذا كتبتِ هذه الأيام؟ لم تُقرئيني شيئاً بعد. كأنك تعتبرين ذلك مُستهلكاً سلفاً، أو سراً بينك وبين نفسك وحدها، أو فضيحة للكتمان.
الكتمان! هذه هي الكلمة. أريد أن أمزق الكتمان عنكِ. لماذا يخيّل إلي أنك تخافين مني؟ أقصد تخافين مني خوف عَدَم الثقة لا خوف الجبن. لماذا؟ هل تعتقدين حقاً أنني شرير ومغامر وممثل أو طالب قصة عابرة؟
هل ضايقك هذا الكلام؟ يجب أن لا تتضايقي. لا أعرف شخصاً سواكِ أتحدث إليه. صرتِ كل شيء. أعرفُكِ وتعرفينني منذ البداية. أنتِ أُختي وحبيبتي. بلى، بلى. محوتُ عن شفتيكِ جلاد الابتسامة الهازئة ونفختُ فيكِ إيماني بكِ. ولا أريد أن أعترف بشيء آخر عدا أنكِ هنا، وأنني هنا، وأننا سنبقى معاً، وأنك ستبكين وتضحكين من قلبك وقلبي، وأن مجهولك أضاء في خلايا كياني وانتشر كماء العشق في أحلامي وبدّد جسورك وجسوري وصرنا نهراً واحداً. ولن أدعكِ تتراجعين. ولن أدعك تتركينني أتراجع. لن أدعك تقترفين الجريمة…
… ثم، لماذا يخيّل إلي أنني، في كل ما أقوله لك، أصرخ في واد؟ وأن حواري معك حوار طرشان؟ وأنك لا تقدرين أهميتك بالنسبة لي؟
هل صحيح هذا؟ يا إلهي! ماذا أفعل!…
* * *
غادة
صدري امتلأ بالدخان. أشعر بحاجة لا توصف، لا يصدقها العقل، إليكِ. أشعر بجوع إلى صدرك. بنهم إلى وجهك ويديكِ ودفئك وفمك وعنقك، إلى عينيك. بنَهَم إليك. أشعر بجوع وحشي إلى أخذك. إلى احتضانك واعتصارك وإعطائك كل ما فيّ من حاجة إلى أخذ الرعشة الإلهية وإعطائها. كياني كله تحفز إليك. إنك تُخيّلين على أفكاري وتلتهمينني. هل أكمل يا غادة؟ هل أكمل محاولة وصف ما بي؟ أم أنك لا تبالين؟ أم أنك ستقولين لي أنك معتادة على هذا الهذيان؟ وأنه هذيان مؤقت؟ وأن الصحو الذي يعقبه يفضحه؟ أم أنك ستظلين تتسلحين بالهدوء والحكمة والصبر والتصبر والانتظار والدرس؟ ألا يكفيك؟ ألا ترين؟ ألا ترين؟ هل صُنعَت عيناك الرائعتان لتكونا رائعتين فقط لمن ينظر إليهما؟
* * *
لا شيء يبرّر عذابي الآن إلا صدقي، إذا سلّمنا أن الصدق لا بد أن يكون دائماً شهيداً.
أنتِ تعتقدين أن التجارب التي مرت بك تضطرك إلى التزام موقف الحَذَر الشديد والحيطة والتنبُّه والشك والرفض والسخرية الذي التزمتِه معي حتى الآن. أنا أفهم تفكيرك جيداً…
ولماذا، لماذا يخيّل إلي أنك تعرفين أنني صادق، ولكنك ترفضين أن تنساقي مع هذه المعرفة؟ ولماذا لماذا لماذا قلتِ لي ذلك المساء أننا لن نلتقي أبداً ولن نفترق أبداً؟ هل تدركين معنى هذا الجزم؟ هل تدركين مدى تأثيره عليّ لو تيقنتُ نهائياً أنه صحيح؟ ألا تعلمين أنني… ألا تعلمين أنكِ، بهذا الحكم الذي يعني أننا كالخطّين المتوازيين كل منا بجانب الآخر وليس لواحد منا أن يصبّ في الآخر – إنك بهذا الحكم تصدرين بحقي حكم الإعدام؟ ألا تعلمين أنني شحنتُ كل قواي من أجل هذا اللقاء؟ وأن عدم تحقّقه سيقتلني؟ أم أنك واثقة من أنه لن يتم؟ لا يا غادة! لستِ واثقة. كنتِ تتكلمين بمعاني الماضي وأنا لستُ ماضيك. إنني أرد ماضيك على أعقابه. أنا لستُ مثل أحد. لا شيء أفعله مثلما يفعلونه. لا أحد يحب مثلي. لا أحد يحب بقوة ما أحب، بجمال ما أحب، بروعة حبّي وعظمته ونقائه. لم يعد غيري من يحب في العالم. كل ما في هذا العصر من رجال، آلات وجلود وأشباه بهائم. وقد يعرفون كل شيء، إلا الحب. وقد يفهمون كل شيء، إلا المرأة. وقد يميتهم ويحييهم أي شيء إلا الحب وامرأة. لستُ مثل أحد. إنني آتٍ من حيث لا وقت إلا للحب، وها أنا أعيش عصري باحتقاره وضربه على نافوخه، فهو عصرُ المعلّبات والخدع الرهيبة، إنه عصرُ زوال الحب. أعيشه؟ بل أعلّقه على الحائط. إنه نملة شاسعة أدوسها كل لحظة لأقطع منها جزءاً. إنني أجملُ وأفضلُ وأعلى من عصري. إن عصري هو عاري. إنه عاهتي ولحمي الميت، وأنا أخجل به وأكرهه وأفلّت عليه أفكاري القاتلة. وأكثر ما يقتل هذا العصر السافل أنني أعرف كيف أحب، وأنني أحب، وأنني لا أكف عن الحب، وأنني لن أكف عن الحب. إنني أعظم مجرم معاصر. صدقيني. ولا أعرف كيف سيكون أو هل سيكون العصر المقبل؟ غير أنني لا أرى سبباً واحداً للتفاؤل. والواقع أن ذلك لا يهمني. إنني أحب لا نكايةً بالعصر وإنما لأنني عاجز عن العكس. إنني أتحمل حبي.
الحياة
رسائل أنسي الحاج الى غادة السمان”… ضجيج البوح/ محمد حجيري
ترددتُ في البداية في شراء كتيب “رسائل أنسي الحاج إلى غادة السمان” من معرض الكتاب. رأيت الكتيب بشكله المتقشف في جناح دار الطليعة، تذكرت رسائلها الى غسان كنفاني وما حملته من تعليقات ومقالات بلغت المئات، رأيت الكتب ولم أهتم. قلتُ في ذهني، ما جدوى الانغماس في متابعة الرموز الأدبية والفنية والجدل حولها، هناك أمور أفضل في الحياة، هناك كتب كثيرة ينبغي إعطاؤها وقتاً، في زمن هجمة “فايسبوك”. ولم يكد يمرّ يوم حتى حصل الطوفان الفايسبوكي حول الرسائل السبع (وهي ليس تسع رسائل كما ورد في إحدى الصحف) من أنسي الى غادة. الطوفان نفسه حصل حول فيروز قبل أيام، بعد منع بث أغانيها في كافتيريا الجامعة اللبنانية، وقبلها حول سمر يزبك وزياد الرحباني وصادق جلال العظم والكثير من الشخصيات المعروفة. وتفاوتت التعليقات حول “رسائل أنسي” بين المديح والسخرية والاستهجان والشتم والتهكم والادعاء والسخافة والجعدنة والتفلسف والحماقة والمحاكمة الأخلاقية. بل إن الرسائل فتحت باب النميمة على مصراعيه على حد تعبير إحدى الصديقات.
يوم نشرت غادة السمان رسائلها الى الكاتب غسان كنفاني، قيل إنها تحطم أسطورة “الكاتب الثوري”، تخرجه من كادر الصورة المثالية. وكان الاعتراض الأبرز أنها آذت آني كنفاني، زوجة الراحل، مع التذكير بأن غسان كنفاني كان من لحم ودم وليس كهنوتياً. قيل إنه كتب رواية عن مباغي شارع الحمراء، لم تنشر، حرصاً على صورته المرتبطة بالقضية الفلسطينية في بُعدها الأممي. ومع نشرها رسائل أنسي الحاج كان السؤال البارز لبعضهم “هل يجوز الجَهر بالسرّ؟ هل يجوز انتهاك الخصوصية؟” مع بعض الاستنتاجات “لو كان أنسي الحاج موجوداً لرفض نشر الرسائل”، و”هذا تجاوز للخصوصيات”، و”ما فعلته السمان خيانة للموتى”، والكثير من التعليقات ننشرها (في الأسفل) من دون أن ندخل في نقاشها الآن، فهي تنقل صورة ما ما يجري.
لا أدري إن كان نشر رسائل أنسي الحاج إلى غادة السمان (تحتاج إلى قراءة أدبية في مقال خاص) يستأهل كل هذا الضجيج الفايسبوكي وتأويل المشهد بطريقة غرائبية من بعض الشعراء والكتّاب والقرّاء. لا أعتقد أن الرسائل تحمل بُعداً أكثر من انها رسائل أدبية شخصية تنتمي الى مرحلة غابرة وآفلة ويمكن توصيفها بنصوص مجهولة للشاعر الراحل، لا تبتعد عن شعره ونثره المعروفين، وتكشف جانباً من شخصية أنسي الحاج. من يتابع هذا الشاعر في حوارته وكتاباته ونقده وشعره، ومن يعرفه شخصياً، يجد أنها امتداد لما يكتب. فهو، وإن كان يبعث الرسائل الحميمة “السرية” الى صاحبة “كوابيس بيروت”، ففي الوقت نفسه أرسل بعض الرسائل بشكل علني، وقد سبب “مشاكل” لا نريد الدخول في تفاصيلها. حتى في أشعاره، هناك إعلان حب وتولّه، والأوساط الثقافية تعرف ذلك، وتعرف تكوين شخصية الحاج التي تراوحت بين اعلان “الخجل” مرات و”الفجور” مرات أخرى.
وإذا اردنا تقييم نصوص الرسائل، انطلاقاً من شخصية أنسي الحاج وحوراته، فنلاحظ أن جوهرها هلامي. فيمكن إزالة اسم غادة السمان ليظهر كأنه يخاطب امرأة بالمطلق، المرأة لأجل المرأة، مثلما تخاطب أم كلثوم حبيباً هلامياً سرمدياً. فأنسي المتفجع دوماً على رحيل والدته في زمن مبكر، يخاطب غادة كأنها الإله وهو “معبود المرأة” بأشكال مختلفة. في أكثر من نص وحوار، تغنّى أنسي الحاج بأنه أمضى حياته بين المرأة والحرية، أما الكثير من المعترضين على نشر الرسائل، فأحسب أنهم (أمام الرسائل والغرام)، فجأة انتقلوا من موقع الأدباء الذين يتغنون بالفردية، الى موقع الواعظين الاجتماعيين وثقافة العيب، مع التذكير بأن الكثير من المعلقين في “فايسبوك” لديهم مشكلة مع غادة السمان بحد ذاتها، التي تتجرأ في نشر الرسائل وهذا أمر جيد، لكن يا حبذا لو تنشر سيرتها عن تلك المرحلة.
وغادة التي لم تنشر أي صورة جديدة لها منذ سنوات، تكتفي بإبراز صورها القديمة كأنها باقية هناك في الزمن القديم، حتى في الأدب فتبدو شبه متقاعدة، وإن كانت تكتب في جريدة “القدس العربي”… وفي مسارها، يمكن توقُع الكثير من “الخفايا” المعلنة التي تثير فضول الجمهور، من صورتها في منطقة الروشة مع الموسيقار بليغ حمدي، الى قصتها مع الصحافي ناصر الدين النشاشيبي…
المهم القول باختصار، لا شيء يدعو الى الضجيج، لنقرأ الرسائل بهدوء ونتأمل حياتنا ومراهقتنا، فكل شخص لديه تجربته… ولا شيء يثبت بعد رحيل أنسي الحاج، أنه أحب غادة السمان حباً أفلاطونياًن وإن كان في نصه يظهر هيامه وتولهه. لم تبُح غادة السمان بشكل العلاقة، وإن كانت تبدو أقرب الى العابرة بحكم تاريخ الرسائل. وجلّ ما تقوله غادة إنهما كانا يلتقيان في مقاهي بيروت “المنقرضة”: “كنا نلتقي كل يوم تقريباً في مقهى الهورس شو – الحمرا أو مقهى الدولتشي فيتا والديبلومات – الروشة أو مقهى الأنكل سام …”، ولم تكتب غادة توضيحاً لمسار الرسائل وكيف كانت تصلها، ولماذا يكتب لها الرسائل طالما انهما يلتقيان في المقهى. أبقت الأمور في دائرة الالتباس ووضعت بعض الهوامش تشرح الورق الذي كتب عليه أنسي وهو الدفاتر المدرسية، الى جانب هامش عن أنماط كانت سائدة في مقاهي الستينات. “الجلوس على انفراد كان شبه متعذر في مقاهي المثقفين هذه، إذ ما يكاد يرانا من يعرفنا حتى ينضم الى مائدتنا دونما استئذان كجزء من تقاليد تلك المقاهي”… تبدو الرسائل ناقصة من دون قصتها، أنسي الحاج رحل ولم يكتب، وغادة السمان اقتصر فعلها على نشر وثيقة ربما هرباً من البوح بمشاعرها، وتظهر جزءاً من أنانيتها، وربما تظهر شغفها بالرسائل…
اعترض كثيرون على نشر الرسائل لأنها تتعلق بأنسي الحاج. حقهم في ابداء الرأي والتعليق والاستنكار وتوصيف شكل الحب. لكن هل يتذكر أحدهم ماذا فعلت إحدى مقالات أنسي الحاج عن فيروز ذات مرة؟ ماذا لو كان أنسي الحاج أوروبياً؟ هل سنشهد هذا الكم من التعليقات الاعتباطية؟ ماذا لو ان أنسي أصدر الرسائل؟ بعض الشعراء والكتّاب العرب يتابعون بشغف أي جملة تصدر عن حياة رامبو أو كافكا، لكنهم يرتبكون أمام أنسي الحاج؟ أنسي الحاج الذي كان يتبنى المدراس الادبية الأوروبية من السريالية وغيرها، في جانب من حياته لم يكن بعيداً منها، كان يعبد “المرأة والحرية”، فلماذا كل الضجيج والاستهجان؟
مختصر مفيد: ما زال أدب البوح يثير الضجيج!
بعض ردود الأفعال الفايسبوكية:
جبور الدويهي (روائي لبناني): كأنّي بمستنكري نشر رسائل أنسي الحاج الى غادة السمّان (وهم محقّون في استنكارهم) يصنّفونه فوق الشبهات (الوقوع في غرام “عادي” مثلاً) كجزء من “الميتولوجيا” اللبنانية التي ساهم في الترويج لها.
وديع سعادة (شاعر لبناني): عملتُ مع أنسي الحاج سنوات، في “النهار” و”النهار العربي والدولي” في باريس وفي بيروت، وبحسب معرفتي العميقة به أؤكد أنه لو كان حياً لكان حتماً سيرفض نشر رسائله إلى غادة السمان. فهذه رسائل خاصة وشخصية وليست ملكاً للجميع، وكان عليك يا غادة أن تحترمي هذه الخصوصية ورغبة أنسي بالتحديد. لو كانت هذه الرسائل تتطرق إلى قضايا أدبية لشفع بكِ نشرها يا غادة، أما أن تنشري هذه الرسائل لتقولي فقط أن أنسي كان مغرماً بك فليس ذلك لائقاً.
عيسى مخلوف (شاعر) لماذا ننتظر موت العاشق لننشر رسائله؟ لماذا لا ننشرها وهو حيّ، نستشيره في الموضوع، وإذا رفض، ننشرها رغماً عنه، ونرى ما سيكون ردّ فعله؟
هل كان أنسي الحاج سقطَ في جُبّ الرسائل لو عرف أنّ عواطفه الحميمة ستُنشَر يوماً على حبل الغسيل؟ لو عرف غسّان كنفاني أيضاً وآخرون قد يأتي دورهم؟
تتساءل آن بنجو بعد أن نشرت رسائل فرنسوا ميتران الموجّهة إليها: “هل أحسنتُ التصرّف أم لا؟” (أي أنها نشرتها وهي لا تزال في حيرة من أمرها)… هل راودت هذه الحيرة غادة السمّان وهل تساءلت عن الفائدة من نشرها؟ هل فكّرت أيضاً في نشر رسائلها؟
هل كلّ ما يُكتَب يُنشَر؟
آن بنجو واجهتها أسئلة عدّة، منها ما يتعلَّق بالجانب الأخلاقي والقانوني: “هل يجوز الجَهر بالسرّ؟” و”هل الرسائل مُلك المُرسَل إليه أم أنها مُلك ورثة المُرسِل؟”
ونحن، قّراء هذه الرسائل، أيّ دور هو دورنا وقد أصبحنا، على غفلة منا، كالمتلصّصين من شقوق الأبواب؟ نسعى إلى تقليب الحروف والكلمات لعلّنا نلمح فخذاً عارية من هنا أو شفاهاً ملتهبة من هناك… وهكذا بدل أن يكون الكاتب هو الذي يستعمل الكلمات، تصبح الكلمات هي التي تستعمله، حتى بعد موته.
رنا زيد (شاعرة): غادة السمان، وصمة عار على المشاعر، شخص مخبول، لا يمتلك أي ذوق أو حس إنساني، ونموذج شخصاني مكرور للمرأة العربية الغبية. مشاعر أنسي الأحادية، نمت، في شكل هائل من الأسى وبفردية قاتلة، لأنها لم تعطه ذرة حب، وتستطيع ببساطة، الآن، أن تنتظر موته، لتكتب عن ترجيه وتنشر ضعفه؛ لو أنها أقامت ليالٍ طويلة معه، من الجنس، ليالٍ غير متوقفة، من الجنس والحب والتوق والرغبة والتشظي، ثم نشرت تلك الخصوصية، لكنتُ احترمتها، لكنَّها تدعي العفة والقداسة، حين تنشر مثل هذا التوق الأحادي، والإدعاء أنها المرأة العذراء نصياً، المرأة غير الممتلكة، إنها تقوم بابتزاز مشاعرنا، لتشعر أنها مرغوبة، سحقاً لها كم هي عفنة من داخلها!
منى وفيق (كاتبة): الكثير من الأصدقاء علّقوا على نشر”غادة السمان” لرسائل “أنسي الحاج” إليها و قبلها رسائل “غسان كنفاني”، أغلب التعليقات هاجمت نشرها للرسائل خصوصا بعد وفاة أصحابها ، هنا تعليقي:
لماذ لم يفكّر أحد أنّ نشرها للرسائل نوع من النّدم المتأخّر أو الحبّ الممتنّ المتأخّر ( لا أحد يختار أن يحبّ أو لا يحبّ شخصا يحبّه، لا أحد لا يتمنّى ألا يحب شخصا أحبّه فعلا، لا أحد لم يحاول جادّا أن يبادل من عَشقه عِشقه!)
حتى لو كان نشر غادة للرسائل بسبب إفلاس عاطفيّ أو أدبيّ أو حتى لإشعال حضورها الذي خَفت، هذا يعني أنها بحاجة لأن تشعر بالحب، بحبّها لنفسها، بحبّ من حولها لها، حتى بِحبّ من رحلوا ولم تستطع ربّما أن تحبهم في ذلك الوقت..
شخصيّا سأقرأ الرسائل لا يهمني ما كان الهدف من وراء نشرها لكن أحبّ أن يأخذني الحب المشتعل بين ثنايا الرسائل ويستلبني… يبقى الحبّ فعل مشاركة، إنّنا نحب كي لا نشعر بالوحدة.. وهي الوحيدة، لا تزيدوها وِحدة .
نائل بلاوي (كاتب): ثمة رائحة ذكورية فجة ومعتلة في حكاية ردود الفعل التي انفجرت، رفضاً واحتجاجاً، في وجه غادة السمان، اثر نشرها لرسائل انسي الحاج اليها .
وكانت تلك الرائحة ذاتها قد انتشرت حين اقدمت المذكورة على نشر رسائل غسان كنفاني اليها ايضاً!
هي ذات الرائحة، ذات التظرة المتسلطة واللئيمة التي لا ترى الى الجانب الانساني الشفيف في الرسائل الجميلة ولا تتلمس دوافع اصحابها عند الكتابة، بل تذهب على الفور في مهمة محاكمة المرأة التي استقبلتها.. المعشوقة، وهي غادة السمان هنا، وبحجة اقدامها المتأخر على النشر!
تبدو ردود الفعل {مفهومة هنا ومنتظرة} حين توضع في سياقها العليل والمسكون بروح ثقافة المسكوت عنه، والمطلوب منه ان يبقى، لغير سبب وسبب، متوارياً والى الابد. ثقافة الذكر العربي الذي يملي ويشرط … يرفض ويستجيب كما يحلو له ولا يقبل بحضور الانثى، المعشوقة، المشتهاة الا في القصائد والنصوص.. القصائد والنصوص التي يكتبها هو بالطبع. فالقاعدة المقدسة عربياً تقضي، عند الاكثرية ممن يشتغلون في حقول الابداع قبل سواهم، بأن تغيب المرأة في الواقع وتحضر في المجاز!
المجاز هو السر في متن الحكاية.. وفي القلب من هذه الثقافة التي تخفي كل ما تود ان تقوله خلفه. هكذا يكون على {السيدة العربية المعشوقة} ان تختفي وأن يظهر الذكر المقدس… غسان او انسي لا فرق!
عليها ان تتراجع خطوات طويلة عن خشبة المسرح/ الحياة عموماً. وعليها ان تتلاشى تماماً حين تكون الثيمة هي هذه المتوترة والغامضة عربياً: الحب والجنس، فذاك هو مسرح الذكر {لعبته التي ورث} وعلى الانثى ان تتوارى خلف الكواليس، ان تبقى مجازاً!
هل خدشت غادة السمان هذا التابو؟
ممكن؟ ثم، والسؤال في مكانه الآن: ماذا لو اقدم احدهم، شاعر او كاتب عربي، على نشر رسائل عشيقاته اليه؟
اجزم ألان، جواباً، بأننا سنعثر على الكثير من الردود المادحة لفنون الرسائل وأدب البوح والاعتراف وغير ذاك !
اعرف بأن السمان مطالبة بنشر ما لديها من رسائلهم اليها… ولكن، من يدري، ربما اوصت بنشر ما لديها لاحقاً. وربما لا يزال لديها المزيد من الرسائل، فقد كانت فتاة جاذبة وجذابة انذاك ولم يتوقف عشاقها عند الحاج وكنفاني كما نعرف؟
شخصياً، وقد لا يروق هذا الراي للبعض: احببت غسان كنفاني العاشق في الرسائل اكثر من حبي لغسان الروائي والقاص. كما زاد اعجابي بالحاج الشاعر/ العاشق اثر قراءة بعضاً من رسائله اليها اليوم. اما السمان فلا تزال عندي كما كانت في السابق: مجرد كاتبة عادية لم تثر اهتمامي ابداً.
ردود الفعل الغاضبة على نشر السمان لرسائل الحاج هي نافذة جديدة، في نهاية المطاف واوله، تطل من خلالها على هذا المرض العربي المزمن: الذكورة. المذكر… والثقافة الذكورية المرعبة عموماً. الى جانب حقيقة ان الرسائل ذاتها هامة المعنى، ادبياً وفنياً، ولا يجوز لها أن تدفن مع أصحابها.
ياسر الزيات (كاتب): ليس عيبا أن يحب أنسي الحاج من طرف واحد. العيب هو تباهي غادة السمان بأنه أحبها من طرف واحد، والعيب هو نشرها للرسائل بعد موته، بدون إذن منه في حياته. والعيب كذلك هو أنها لا تنشر رسائلها هي للذين أحبتهم، رغم أنني أشك في أن هذا النوع من النساء يعرف الحب، فهو نوع يهوى جمع العشاق والتباهي بهم. هذه امرأة مريضة نفسيا، وهي على الأغلب غير متحققة جنسيا. هي مشغولة بنفسها، مشغولة بتحقيق أسطورتها الشخصية على حساب لحظات صدق أحسها اخرون.
تيما سلام (كاتبة): غادة السمان تنشر رسائلا غرامية وصلتها من أنسي الحاج سنة 1963!
الرسائل (ما قرأته منها إلى الآن) رائعة أدبيا، وتضعك في سياق “قصة” ذاتية، يخاطب فيها أنسي نفسه أكثر منه “معشوقته”، ويستلّ صوتها أحيانا ليخلق حوارا، ضروريا للاسترسال، قال إنها بخلت عليه به.
الأمر تؤكده السمان، فتقول إنها لم تردّ على رسائل الحاج، أي لن يكون هناك ما يلومها عليه القراء كما حدث مع رسائل غسان كنفاني، عندما نشرت رسائله إليها (سنة 1992) دون رسائلها له “لأنها ضاعت” وتحسرت عليها كما صرحت في حينه.
لكن، غادة، لما لم تنشري رسائل أنسي وهو حي؟! أنت غير الحاضرة في حياته لاحقا أو بين كلماته المُعلن أصحابها! في المقابل أليس من الجميل قراءة هذا الجانب من أنسي بلغته البديعة.
أيضا ألم يرتبط اسم غادة السمان أكثر من “الصحي” بالرسائل؟ بدون أن نبخسها قدرها الأدبي، كثيرون جدا يعرفون عنها من كنفاني، وآخرون الآن سيعرفون عنها من أنسي، أين هو اسمها الثقافي! كان ربما ليكون تواتر إبداعه “المفاجأة” الحقة في معرض بيروت الدولي للكتاب لا “مفاجأة” رسائل الحاج !
لميا مقدم (كاتبة): ماذا في رسائل انسي الحاج لتعتبرونها فضيحة وكشف مستور وخيانة من غادة السمان؟! حب؟ ما به الحب؟ هل الحب فضيحة؟ ضعف؟ انسي الحاج لم يخف ابدا هشاشته وضعفه في الحب ونصوصه شاهدة على ذلك، أين المشكل اذن، والحال ان الكتب التي تتناول علاقات الكتاب والفلاسفة والشعراء هي الأكثر رواجا في كل مكان من العالم؟ الرسائل كانت ستظهر في كل الأحوال بعد وفاتها، ويبدو انها فضلت ان تنشرها بنفسها، على ان تتركها لمن يتولى امر تأويلها، وهي عمل ادبي مدهش، يضيف لأنسي الحاج ولا يقلل منه. شخصيا سعيدة بأنني اقرأ لهذا العاشق الابدي نصا جديدا بهذا الجمال، حتى وهو ميت. عاش انسي الحاج!
إسلام أبو شكير (شاعر): كاتبة مثل غادة السمان لا تنقصها الشهرة.. على العكس فهي ممن يهرب من الأضواء، وأنا لا أذكر انني رأيتها على التلفزيون يوماً، أو حتى سمعت صوتها..
لا ينقصها المال أيضاً في حدود ما هو معروف عنها..
ليست مراهقة..
ليست ممن يهوون خوض المعارك وإثارة الزوابع..
إذاً لا بد من سبب وراء نشرها لرسائل أنسي الحاج إليها..
جميع الاحتمالات تداولها الفيسبوكيون، باستثناء احتمال واحد.. القيمة الأدبية..
لم ير معظم من كتب في الموضوع جمال هذه النصوص.. ما نشره عبده وازن منها على الأقل.. رسائل شكلاً، لكنها في الجوهر جزء من تجربة أنسي الحاج في الكتابة والحب والحياة.. تضيف إليه وتغني رصيده..
لقد أوصى كافكا بحرق أعماله، لكن ماكس برود لم يفعلها.. من يلوم ماكس برود اليوم؟..
ورسائل كافكا الخاصة جداً إلى حبيبته ميلينا وإلى أخته وأبيه هي اليوم جزء من تراث كافكا، والتراث الأدبي العالمي..
أعتقد أن غادة السمان لم تكن أنانية في نشرها لرسائل أنسي الحاج، ومن قبلها رسائل غسان كنفاني.. الأغلب أنها كانت واقعة تحت تأثير سحر الكلمة.. غواية الأدب..
المدن
“رسائل أنسي إلى غادة”.. الخروج من دوامة الإنكار/ محمود منير
في العام 2004، أصدرت غادة السمّان “محاكمة حب” تضمّن ستة عشرة حواراً صحافياً أُجري معها حول رسائل غسّان كنفاني إليها، والتي نشرتها في كتاب قبل ذلك بإثنتي عشر عاماً، أثارت أكثر من 200 مقالٍ تناول القضية بين مؤيّد ومعارض؛ بحسب ما أوردت في “المحاكمة”.
كنت أحد المعترضين في مقال تجنّبت فيه انتقاد “هتك الخصوصيات” –ربما يتّسق ذلك مع توقي الدائم للفضيحة بوصفها تجلّي المعنى-، لاعتقادي أن الكشف عن رسائل حب بعد رحيل صاحبها ومن دون إبراز ردود الطرف الآخر سببان كافيان للاعتراض، حينها.
لكني بتّ أنظر اليوم إلى موقفي ذلك باعتباره مقاربة أخلاقية تفترض “ثوابت” لا وجاهة لها في تلقّي الإبداع الذي هو تكثيف خروجنا عن الواقع وإحداثياته، أو عند دراسة المبدعين حيث خصوصياتهم وزلاّت ألسنتهم وحياتهم السرية التي هي نص موازٍ يُقدَّر دارسوه ولا يُلام فضولي لتلصّصه عليه.
بعد نشر “دفوعي” عن غسّان باغتتني زميلة في الصحيفة حيث أعمل، بردٍّ من غادة تشكرني على مقالي وتضيف بأنه “يوضّح لها أكثر كيف يُفكّر مجتمعنا”. كانت عبارة مستفزّة لمتشكّك مثلي بوظائف الصحافة وأدوارها، وتذكّرت على الفور توصيفاً لصاحب “القبعة والنبي” استللته من رسائله إليها يقول فيه: “أعمل في الصحافة كما كان يعمل العبيد العرايا في التجديف”.
خلال السنوات اللاحقة، تأمّلت كنفاني أكثر على ضوء رسائلها وفي سياق شهادات تُروى عنه، لأتلمّس في أكثر من أثر له رفضاً جذرياً لمسلّمات عديدة، ربما في مقدّمتها استنكاره أن يتحوّل إلى أيقونة تحجب رؤيته، إذ آمن أن للمثقف الملتزم بقضايا نضاله حياةً كاملةً؛ بقوته وضعفه وصوابه وخطاياه وأيام كدّ وعمل وليالي سهرٍ وأنس.
كان صادقاً ومُخلصاً في كلّ تناقضاته، ومتجاوزاً لفصامات مجتمع يُبطن خلاف ما يُعلن، وطالما اعتقدت أن شجاعته تؤهّله للاعتراف لو أنه عاش أطول من أعوامه الستة والثلاثين، وهي قراءة قد تُجاور غيرها في احتمالات خيرُ من يدّل عليها رسائله.
مياهٌ كثيرة جرت تحت الجسر، حتى ظهرت منذ أيام رسائل أنسي الحاج إلى غادة التي سبقت في تسلسلها الزمني رسائل غسّان بسنوات ثلاث، وعادت الضجّة إياها لقرّاء ونقّاد يستهجنون “خرق الحُرمات”، ويعيدون أسئلة – كانت تستبدّ بي في زمن ماضٍ – عن توقيت النشر، خاصة بعد موت كاتبها، وكلّها ملاحظات تؤشّر على مخاوف تتّصل بفقدان صورة “الآباء” أو أيقونات لرموزٍ – للدقّة – نخاف أن نقع على أفعالهم وسلوكياتهم في الحب أو غيره من الانفعالات التي تقع في دائرة المحرّم في مجتمعاتنا.
أول ردّة فعل لجموع الخائفين تبدأ بالإنكار ثم تدخل في خانة التبرير التي لا حدود لها؛ التذرّع بحماية الخصوصية ثم اتهام الطرف الآخر باتهامات غير صحيحة أو خارج موضوع النقاش، كلّ ذلك ابتعاداً عن مواجهة إحدى حقائق بشريّتنا والتصالح معها.
غير أن الحال بالنسبة لـ أنسي تشي ببعض الاختلاف، حيث عشقه عابر ولم يستدع بوحاً وتداعيات في رسائله التي أظهرت اندفاعاً وهياماً سرعان ما خبا بسبب صدّ غادة – عدم الردّ عليه -، خلافاً لغسّان الذي تحدّث بفيض عن ضعفه الإنساني ومرضه (النقرس) ورؤيته الصريحة للصحافة والثقافة والسياسة والنضال وأناس عايشوه.
“رسائل” حُجبت زمناً ثم عادت إلينا، ولا خيار إلاّ بتأمّلها كنصوص موازية لكتّابها تكشف جوانب من حياتهم ودوافع الكتابة عندهم للخروج من دوّامة الإنكار.
العربي الجديد
غادة السمان تتأمل وجهها المسافر في مرايا أنسي الحاج/ علي حسن الفواز
الأثر الثقافي يبقى أثرا، والحاجة إلى تدوينه وقراءته والحفاظ على تاريخيتهِ تبقى مهمة جدا، ولا علاقةَ لها بالأخلاقِ والعواطف، فالكثير من الوثائق تم فضحها والكشف عن سرائرها، والكثير من رسائل المسكوت عنه، تمت تعرية ما فيها من شجن خفي أو أرواح متوهجة.
رسائل حقيقية
كتاب الروائية غادة السمّان الجديد “رسائل أنسي الحاج إلى غادة السمّان” الصادر عن دار الطليعة/ بيروت 2016 يدخل في سياق “كشف الأثر” أو في فضحه، وكـأنّ السمّان التي تعيش عزلتها الشخصية أرادت أنْ لا تحتفظ بهذا الأثر الرسائلي، وربما أنْ تقول –أيضا- بأنهـا كانت المـرأة الأثيـرة عـند الشعراء والروائيين، وأنّ وجودها في بيروت الستينات مـن القـرن الماضي كان حافلا بحضورها الثقافي والأنثوي معا.
فالرسائل -إنْ صدقت الواقعة- لاتحمل إثما شعريا ولا أخلاقيا، بقدر ما تكشف عن شغف شعري بالجمال، وهي – كذلك- لا تدسُّ سُما لأحد بقـدر مـا تحمل تريــاقا شعريا غامرا بالحياة، وبرومانسية المزاج الذي كان يعيشه الشعراء الحالمون بتغيير العالم عبر اللغة.
وبقطع النظر عن أنّ أنسي الحاج قد تكتم عن هذه الرسائل ولم يشرْ إليها في كتـاباته أو مـذكـراته، فـإن نشرها بعد أكثـر من نصـف قـرن من قبـل غـادة السمّان لا يضعها إلّا في سياق الأثر، وأنّ حمولتها البلاغية والعاطفية تكشف عن هوسِ الشاعر بالجمال، وبالحرية، ومع امرأة كانتْ تعرفُ كيف تترك عطرها المُدوّخ على الطاولـة، أو عنـد حافات الحوار.
غادة السمّان صاحبة “عيناك قدري” و“رحيل المرافئ القديمة” و“أعلنت عليك الحب” و“ليلة المليار” وغيرها من الكتب، لا تحتاج إلى جرعة فائقة من الغواية لتكون معشوقة، فهي تكتب بوعيٍ صاخب، وتدرك أنَّ بيروت الستينات من القرن الماضي كانت المدينة الأثيرة التي تتشابه فيها اللغة والبحر والنساء، وأنّ قرّاءهـا وشعـراءها يضجّـون بالكـلام والتمرد والبحث عن زوايا تتسعُ لهذا الضجيج، مثلما أنّها عاشتْ مع الآخرين محنةَ بيروت عام 1975 وكتبـت عنها بشغف المفجـوع بالفقد.
لذا لا يبدو غريبا أنْ تكونَ الرسائلُ حقيقية، رغم أنها عابرة كما يبدو، ولاتعبّر عن عواطف مشبوبة كتلك التي وجدناها في رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان، والتي أصدرتها في كتاب أيضا.
يكتب أنسي الحاج إليها “بحاجة، إذن، إليكِ. لا، لستِ مجرد خشبة إنقاذ بالنسبة لي. عندما أقول أنا بحاجة عظيمة إليكِ فمعناه أنني، كذلك، بحاجة إلى من يكون بحاجة، عظيمة، وربما أعظم بكثير من حاجتي، إليّ… إن لجوئي إليكِ ليس لجوء إنسان إلى شيء، بل لجوء إنسان إلى إنسان آخر. إنه رغبة في الارتباط. وإذا كنتُ أريد أن أتخطى وضعي فيكِ فإنني أريد، كذلك، أن تتخطّي وضعكِ فيّ. ليس مثلي من يدرك معنى الكلمات يا غادة: معناها العميق، الحقيقي، الثقيل، المُلزِم، والمحرِّر أيضا. ليس مثلي من يدرك معنى صرخة: أحبك”.
هذه الكتابة لا تخرج عن لعبة الشعر، ولا عن غواية مزاج الشاعر، فهو الوسيم الغامر حدّ الشبق في القصيدة، يجد في الكتابة حيّزه الفائر لكي يمارس اللذة ويُفصح فيها عن نشيده الشخصي، أليس هو من كتب “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع” عام 1975 إيحاء أو غزلا أو احتفاء بسيدة معروفة في الوسط الفني اللبناني، وبكل ما تحمله هذه المجموعة الشعرية من دفق يزاوج بين الغنائي والتأملي، والطقوسي الابتهالي مع الموسيقي الاحتفالي.
لذة الاستعادة
من الغرابة إذا أنْ يأخذ موضوع هذه الرسائل أكبر من حجمه، وأنْ يوضعَ خارج لحظته التاريخية، أو حتى بعيدا عن معرفة الشاعر ومزاجه وشغفه بالتفاصيل الجميلة، وبتوهج حضور الأنوثة وهي تلوّن العالم بالضوء والسحر، لكنَّ الأخطر والأكثر رعبا أنْ يتحول هذا الموضوع إلى باعث لتأويل الكثير من المواقف واليوميات، ولعل بعض التلميحات التي أشار إليها أنسي الحاج كانت تحمل حساسية نقدية لما تكتبه غادة السمّان، فهو يكتب لها كما تقول إحدى الرسائل.
وبعد صدور مجموعة قصصية جديدة لها “بمزيد من الجرأة، بمزيد من الصدق، بمزيد من الغوص على الذات، تعود غادة السمان إلى قراء قصصها القصيرة بمجموعة جديدة عنوانها “رحيل المرافئ القديمة” وبضع من القصص تستوحي هزيمة 1967. وكلها، من دون ريب، تضع القارئ في مناخ شديد الحرارة ومرات ملتهب الحمى”. هذا الرأي لا يمكن تفسيره خارج التلمّس النقدي العابر، والذي يشي بوجود صداقة ثقافية أكثر من كونها علاقة حسية.
يبدو أنّ لمعرض بيروت هذا العام نكهته الخاصة، وأنّ تزامن صدور هذا الكتاب الرسائلي مع انعقاد هذا المعرض ليس صدفة، فغادة تحاول عبر فيتشية الرسائل كما يقول فرويد أن تمارس نوعـا من لذة الاستعادة، وهي ممارسة شخصية تعيدنا إلى الثقافة المرآوية.
فبالرغم من أنّ الحديث يدور حول أهمية أنْ يطلّع القرّاء على مثل الرسائل التي تخصّ شخصيات عامة، أو بوصفها وثائق تتعلق بالتاريخ الثقافي لها، إلّا أنّ طبيعة الروائية السمّان -كما يبدو- تميل إلى فكرة الاستعادة بوصفها نزعة تعويضية وإشباعية، وفي ظل ظروف زمنية قد تبرر وجود ما يشبه النص الاستيهامي المسكون بالشغف والنـداء والبوح.
هذه الرسائل/الوثائق المقطوعة الإشارات عن تواريخها ومصادرها تبقى أثرا جماليا، وأحسب أنّ رحيل أنسي الحاج سيُفقد بعض توهجها، رغم ما تثيره من فضول عند الكثيرين، ولا أحسب أنها ستكشف جديدا في حياة الشاعر، بقدر ما تؤكد ما ذهبنا إليه، حيث هو المسكوت أبدا بالشعر بوصفه وعيا ومتعة وشغفا بالحياة وقد ظل يصنع الكثير من سعاداتها.
العرب