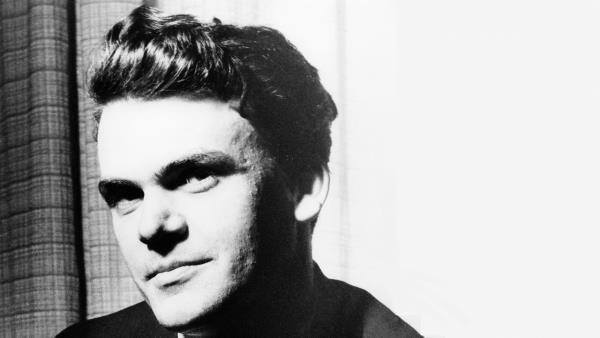روايةُ الدُّمى البلاستيكية
علي جازو
إفراطُ الميل الروائي- ذي النفحة الأخلاقية الضرورية؛ مجبِرة الكلام على التكلم، حتى لو لم يجد غير اللغو على فمه، على اعتبار أن في المناوأة تميزاً وفضلاً- تدوينَ الخراب المحلي، يخنقُ حدودَ الكتابة الروائية، وإنْ كانت ترصد تحولاته؛ فمن جهة التدوين في سجل إحصائي سرعان ما يغفل ويهترئ، فيما يظل الواقع، كما لو كان لعنة شاملة، تحت فصل الجهل والهروب من نفسه لفرط ما يخبر عنه ويوازيه، وهي بذلك أقرب إلى أدب الخبر الشفاهي الشعبوي منها إلى كتابة تسجيلية ترهن الحادث بالتأمل وعمق الملاحظة، وتغني التوثيق المرحلي بحساسية لغوية تحول المراقبة الظامئة إلى درس نفسي ونحت أسلوبي. الواجب النشط والمغتبط بنفسه يقيد الأدب بأخلاق الادعاء الشاكية.
تسعى الرواية ، كنموذج طارئ، لتدل على صنيع الواقع البائس فكراً ومعيشة، ( وفي كل دليل يرقد نموذجه المتحجر)؛ لكأن اللغة التي تكتب لا تفكر بكلماتها قدر ما تحولها إلى تقرير على حسابها لا يبقي من الكلمات سوى عظامها الكسيحة. تميزت بدايات الرواية العربية على العموم بإخلاص نموذجي مفرط للواقع- رغم أننا لم نجد رواية مثلها تهرب من الواقع نفسه الذي ليس سوى إعاقة للكتابة والحياة على كل حال – وحاولت إلى الآن كشفه وعرضه دون ملل. توسلت الشرح المدرسي والتبسيط العمومي والتحمس الخاوي والنبرة الكفاحية والنسخ الموضوعي، وكانت في ذلك التابع المكدود والشارح المسهب. لبت نداء عاما مفترضا وواجبا، ولم تكن مصدر نداء مجهول. اكتفت بالتسجيل ولم تخن كتابة الفرض. لأنها كسولة طموحها اكتسبت رخاوة جمهور ولم تكترث بوجود غيري. تصنيف الرواية، حسب حالها القريبة اللاحقة، كإجراء مسوغ، نتيجة من نتائج حصرها وتقييدها وانكماشها. إنه تمديد و توصيف وتجريب للعمل بالأدب ضد القمع والحرمان والكبت والفقر، على حسبان أنها الحقائق السارحة الملهمة، لا يخلص سوى إلى أمثلة الواقع بعكسه المقابل وفضح حقيقته الدامغة. والرواية الفاضحةُ علاقاتِ القمع والمجتمع المنسي في العطب هي سلاح التمديد الضدي المناهض. إنها مدرسة كلية وأسلوب شامل، وعلى الطلبة الجدد إدراك تطور الدرس الروائي العتيد. ثمة تطور عبيط في جرأة الموضوع وراهنيته الإعلامية.
داعي الحصر والتقييد والتمديد ماثل في المتن الروائي نفسه. إنها تقدم الدليل على هكذا تصنيف وتظل تتقدم وتتلكأ داخل بنية مغلقة واستعادة دائرية يلحق البداية بالنهاية حيث يمكن لكل شيء أن يمثل أي شيء. ومثل هذا التمثيل يساوي الكلام بالسكوت والكتابة بالكلام عينه. يحدث أن تنأى قليلا ولا تلبث أن تعيد السير في الطريق نفسه. لكن التركيز على قراءة السياسة الخانقة بالاجتماع الضحل عبر طرق أدبية مناوئة علامة شح فكري و أدبي. يرزح الخيال تحت ضغط التباس الواقع بضرورة التكلم عنه، كأنما الكلمات في حملة إنقاذ أخرق، ولا تنجو قراءة كهذه من ضغط الكتابة الواقعية كشهادة. وللشهادة عليه ينبغي التكلم باسمه، وليس غير لغة التقرير والإخبار مجالا للكتابة. الواقع، الذي ليس في النهاية سوى نفاية الفكر، الواقع الذي يستحق الاحتقار لا الكشف، كطارد سقيم للكتابة الواقعية نفسها، الواقع كنبع للحقيقة (مخصية العقل) وكمثال بخيل ووحيد، تلبيه الرواية بسرد مضاد وشبيه. إنها قرائن اعتقال فكري إثر وقائع اعتقال واقعي. إقامتها التجريدية والتوحيدية في الهم الناقد الفاضح ودروبه الآنية الضيقة، ودواعيه الثقافية الاجتماعية، كإقامة الغريق في الاستغاثة والمراقب اليقظان في التدوين الصحيح، والتلميذ في امتحان الرشد والتلقين والتأهيل.
يشترك الفضاء الأدبي بعالم النصيحة المملة والتوجع المخملي ويختلط بدواع أخلاقية، فينفذ من الأدب ما ثقل وتصدأ وتراكم في البؤس. وما يجعل الأدب رهين الواقع الراكد هو ما جعل الواقع نفسه رهين السياسة الشمولية، وما قزم وكبت الفعل المجتمعي والثقافي بمعناه الأوسع هو ما يلجم الرواية عن الخروج من هكذا كبت. النجاة من القمع تفضي إلى توسل الرواية بهكذا دور عاجز ومربك. وتنتقل علامات العجز الواقعية إلى وسائل الكتابة نفسها. إنها ترضخ وتحتفي برضوخها في الوقت الذي تحاول مرهقة وثقيلة الخروج من عالم لم يعرف غير الرضوخ ولم يذق غير الإهانة. ولا يلبث أن تزيد الرواية من إرهاق النص ببحثها عن نماذج من عالمين متكافئين في القصور: قصور المكان عن الإقامة والعمل والبناء، وقصور ابنائه وبناته عن كونهم (مواطنين) خارج انتماء قسري مطيع أو مضاد. لا أحد يغادر موقعه، قدر ما يولده وينميه. إنها لعبة مرايا متقابلة حيث تتضاعف صور الوجه نفسه، غير أن مكان الجرح النفسي وتمزقه الإنساني مقابل سطوة الابتزاز اليومي ليس سوى مكان واحد. وما إن يختلط المكان الواحد والحامل، مكان اللغة والسرد في الرواية، بفاعلين متضادين صافيين مجردين حتى تنكمش النفس إلى وحدة عضوية مسلوبة أو تقابل كمي جامد؛ فتتماثل الأضداد بنموذجها الوظيفي. رجل أمن أمام مثقف، أدب حر ضد معتقل لا إنساني، ولغة تلقينية في وجه لغة هي مزيج من الصمت والتردد والخوف والحيرة. يُنسى الدرب الوسيط، العتبة الضئيلة، الهواء الفارغ من التناقض الآلي الشحيح والتقابل الدرامي الفظ. تنسخ الأنظمة الشمولية نموذجها في عقلية أمنية كابحة وقامعة، هي غير العاجزة قط عن خلق نماذج شتى من هكذا تصنيف داخل جماعة المناوئين أنفسهم. وتقدم الرواية ( الثقافية الأمنية) نموذجها المضاد، بعد النسخ، بنسخ ناقم. الحصافة مقابل السخف، العلمانية ضد الخرف الديني وشبح سرطانه الاجتماعي، المجتمع المحافظ في وجه الفرد المتمرد. غير أن تفسير الضد بالضد جزء منسول من داخل بنية تفسير الدولة بالأمن والحال العامة بالتخلف والفردية المسحوقة بالعمومية الخرساء، والأدب بالتمرد وجدة الفكرة باستلابها من جرأة موضوع السرد الروائي. إنها وظيفة وعقلية ونموذج. والرد على الوظيفة والعقلية والنموذج رد نموذجي ووظيفي.
تنجح الأعراض الشمولية لا في خلق أشباهها ومريديها فقط، بل في إرغام وتسميم أضدادها على خلق شبيه. إنها قادرة على خلق أعدائها وإجبارهم على العداء الصرف وان كتم الأنفاس يقدم فرصة وحيدة هي التنفس داخل الكتم عينه. لم تفشل السياسة الشمولية في شيء. لقد ظفرت بتحويل الصناعة الأدبية إلى رد فعل أسير، فتساوت في الخضوع دون أن تتناءى في الخلق. إنها عقلية تسابق لاهث ومنافسات شائكة. يجبر البؤس ضعفاءه ومهشميه كأدوات تنفيذ عضلية خدومة على التزلف والنفاق والكذب، ويقدم العون الذابل والوحيد لتحويل موظفيه إلى دمى مرنة وفعالة وراجحة، مغرية من لم تغره الدمى الجاهزة أن يخلق دماه البلاستيكية الناكرة بنفسه. لا قطيعة هنا ، بل وصل نسيج بنسيج آخر. كأن الكتابة تبدأ عندما تنهي الشكوى وظيفتها التي لا تنتهي. كأنما الكتابة تبحث عن حجة في القمع والحقيقة فتنهل منها نقمتها وهشاشتها ونفورها وضيقها. إنها تتنفس داخل غرقها ولا تختنق به. تخرج سريعة لأنها تطفو على السطح، ولا تتحمل اختناقها وبقاءها في قاع العزلة ومهب البرد. يعزز التناقض الآلي من فرص رفد التناقض بنفسه، وعدم الخروج من دائرة يفضي إلى رسم دوائر أصغر فأصغر. الرد على السخف بالمنطق كالرد على الجنون بالتوازن دليل قبول العقل بكونه تحجر داخل نظام الفوضى نفسها. ولا يستغرب هنا، عدم وجود رواية ساخرة تقي الأدب من جدية عقيمة.
لا تبخل الرواية الحاضرة النشطة بالإرشاد والتصنيف والأمثلة، والفضح والأناقة الشاعرية والنصح الفاضل. إنها نموذج ولا ينبغي لها أن تشبه غريمها. إنها لا تضحك، لأنها لم تجد ولم تطلب إلا غريما هازئا بمن يضحك. الجدية الترهيبية الحديدية تشجع على جدية أدبية لفظية. غير أن البقاء في مهمة متقلصة وحيدة وداكنة أشبه بالبقاء في سجن. إن لم يقدم الأدب فرصة التحول والبعد والسخرية ممن لا يولون قيمة للضحك، لا على حساب خشونة الحال وضنك الأيام ومظالم التعسف، فأين نجد من الأدب جرأة الغريب وخفة الطيف ومرح الفوضوي ومروق المتمرد بلا غاية سوى النفاذ من جحر التمرد نفسه، لا على السلطة فحسب، بل على الوظيفة التاريخية للأدب. تحولَ رجل الأمن من وظيفة حصرية ذات طابع قمعي وسري إلى زئبقية نظام اجتماعي اقتصادي مختل. قدرة البيع المشينة على النفاذ القذر والتحول المرعب تتعدى حدود العمل الأصلي، ما لم يكن العمل نفسه قناعاً مؤقتاً ومنطوياً على استعداد فطري لتبدل تال. لا حياة ضدية ومنتشية بضدها وإعاقتها لنفسها مثلما هي حياتنا الواقعية التي تكاد تسحقنا لعنة تلو اخرى. يزيل (الطابع الواقعي الإكراهي) للعمل الأدبي الحدودَ ويكسر حصانة العمل وتخوم المهن جاعلا من التصنيف وهماً وبخاراً. وما تحمُّس الرواية، ولا يختلف عنها المسرح والشعر في كثير، على هكذا اشتغال خليط، سوى مضاعفة من مضاعفات وهمٍ أدبي سارٍ ومؤسف. لم يأت الخوف من مكان أجنبي ولا ينبغي أن تكون الرواية غريبة عن خوفها ومكانها. عليها ان تتأصل في مستنقعها المحلي. حماية الواقع وعكسُه طرياً صرفاً في الكتابة كحماية السخف نفسه وإعادة إنتاجه؛ فالتشابه قرين الجمود، فكيف يمكن للغريب أن يولد وللجديد ان يوجد وللمجهول ان يمد وجهه، وللمريض ألا يذل بسقوطه، وللغناء ان يصعد منتشياً غير عابئ، على قول مجزوء ومستعار عن دوستويفسكي، من قبر الإهانة نفسها.