رواية الكاتب السوري فواز حداد الجديدة، “السوريون الأعداء”
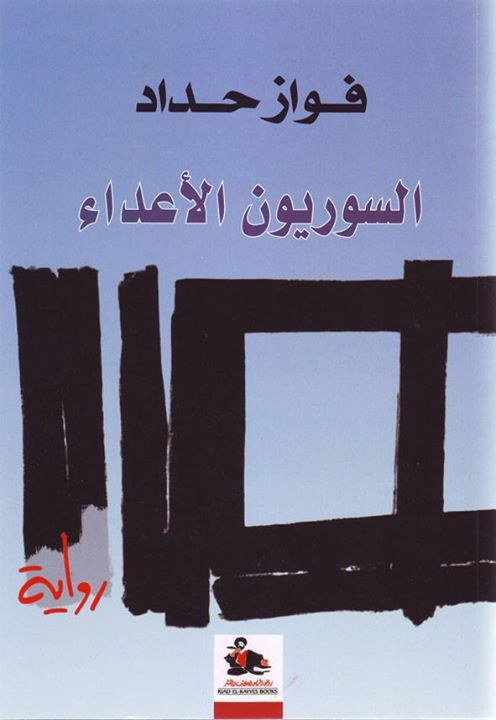
ساعة الصفر باتت معلومة/ فواز حداد
اختبأ البعثي العريق لدى قريبه طالب البكالوريا، على أن يبحث في الصباح عن مخبأ آخر. كان يمقت ابن أخته، لكن الظروف القاهرة اضطرته. حسب الأريحية الريفية، أظهر ابن الأخت كرمه نحو الخال، تخلى له عن سريره، وطعام عشائه، وأصر على استضافته مدة غير معلومة. وطالما كان في خطر، فلن يدعه يغادر، حتى يتوفر له الأمان. أصلح أموره مع خاله، وتبرّع بنقل رسائله إلى رجالات الحزب، وكانوا قد بدأوا بتشكيل تنظيم جديد يعتمد خلايا سرية، في سبيلها إلى الانتشار في أرجاء المحافظات والقرى.
كان الخال البعثي قد رفض تزويجه بابنته، تحجّج بصغر سنه، وفي الحقيقة، كان يحتقره، مثلما احتقر أباه من قبله، بعدما أغوى أخته وتزوجها رغماً عنه، وسامها العذاب، وما زال. هل يسمح بتكرار مأساة أخته مع ابنته؟ تمنى ألا يشبه الابن أباه، لكنه كان نسخة عنه، حقوداً وحسوداً، لا يتورّع عن إيذاء من حوله. حاول من أجل أخته إصلاح الجانب الوضيع فيه، لكن الشاب المعقّد الغيور كان عصياً على الإصلاح. لام الخال نفسه، لما أبداه ابن أخته من شهامة، ألم يبالغ في مآخذه عليه؟ فأعاد تقييمه، وكان للأريحية والشهامة دور كبير في ترجيح كفة الإيجابيات على السلبيات. لو أن ابن أخته أعاد الطلب، فلن يرفض.
سليمان أيضاً راجع نفسه، خاله لن يستعيد أمجاده الحزبية بعدما أصبح مطلوباً، على الأرض خلايا المعارضة مهلهلة وغير ذات وزن. وحَدَسَ أن خاله لن يزوجه بابنته، سواء انتهت محنة فراره رئيساً للوزراء، أو في السجن.
مع نشاط دوريات الجيش والشرطة التي بدأت تجوب حارات حلب بحثاً عن الخال، تنشّطت ملامح المستقبل المجهول، رآه سليمان من خلال الظلال الداكنة لأبخرة الزيت المقلي، وكان في الفترة الأخيرة قد راوده بكثرة وراء مقلاة الفلافل. بدا المستقبل المتواري على وشك التجسّم والخروج من يقظة الحلم إلى يقظة الواقع، ولكي يتحقق فعلياً، ركب الباص إلى دمشق.
في العاصمة، قصد طالب البكالوريا الضابط وزير الدفاع، وكان عازماً على الإعلان عن حركته التصحيحية بين يوم وليلة، بينما كان التنظيم المعارض على وشك البدء بأولى تحركاته لإجهاض نواياه. كان الوزير بحاجة إلى مؤيدين وأعوان وجواسيس يعملون لحسابه في القطاع الحزبي المدني الموبوء بالأفكار الراديكالية، يغنيه عن الاعتماد على حزبيين جشعين لديهم مطامع ومطامح، ينظرون بريبة إليه، يساومونه على مقاسمته السلطة، ويتحينون الفرصة للارتداد عليه، لو لاحظوا ضعفاً منه. كان يلزمه بعض الوقت لإخضاعهم وتطويعهم لقوانين المنفعة المكشوفة، لا قوانين الحزب المطاطة، ولم يكن لحلول ساعة الصفر متسع إلا بضعة أيام، قد تتغير فجأة إلى بضع ساعات.
مقابلة وزير الدفاع لم تكن بالسهولة التي تصوّرها، لهث وراءه من مكان إلى آخر، تعقّبه من القيادة القطرية إلى القومية، فوزارة الدفاع، فالداخلية، من اجتماع إلى اجتماع. يمنعه عنه عناصر المرافقة. لم يسمحوا لطالب البكالوريا بمقابلة الضابط الانقلابي الذي سيصبح بطل التصحيح، على الرغم من تلويح سليمان أكثر من مرة بصلة قرابته للوزير، وإن كانت بعيدة من الدرجة الخامسة، وقد تكون العاشرة. لم يأبهوا به، طردوه لصغر سنه، رغم ذلك استعصى عليهم، كان كلما اقترب منهم أخضعوه إلى تفتيش دقيق. لم يمل طوال يوم كامل من الانتظار واقفاً على الرصيف، أو في ردهة وزارة، أو أمام كولبة حارس، أو منتحياً إلى جانب الباب الزجاجي الدوار… وقد يسعفه الحظ بجدار يسند ظهره إليه.
لم يكن لتلك المقابلة أن تتم لولا أن الوزير خرج غاضباً من اجتماع عقد في مبنى وزارة الإعلام، فلم يجد سليمان حيلة لاعتراضه على الرصيف عند اقترابه من السيارة إلا الارتماء أمامه على الأرض. ظن الوزير أنه تزحلق، فمد يده وانتشله بحركة غريزية، وبينما كان يُنهضه، انتهز طالب البكالوريا لحظات لا يجود بها الزمن إلا مصادفة، وقال له إنه يعرف مكان عبد اللطيف حسون، كانت كافية ليؤجل وزير الدفاع اجتماعه التالي في اتحاد الفلاحين ساعتين من الزمن، ويأخذه معه بسيارته إلى بيته في شارع الباكستان. في الطريق، استمع إلى وشايته شارداً، انشغل بالليل الدمشقي، وكان مكفهر الظلام، هل يصفو له؟ وعندما تنبه إلى المراهق الثرثار، عدل عن الاهتمام به، مستبعداً إيقاع ابن الأخت بخاله. عند مدخل البناية، تركه في السيارة ونزل، بعد أن قال للسائق، أوصله إلى الكراج. لحق به سليمان، ورجاه ألا يترك خاله حراً.
في اللحظة التي استدار وزير الدفاع إليه، أحس بالتعب، وتذكر أنه جائع، قرر إلغاء اجتماعه بالفلاحين، وتناول العشاء وأخْذ قسط من الراحة، وأن يمنح المراهق اللحوح فرصة في وقت كان مستقطعاً من الظلام، ريثما يحل اجتماعه في آخر الليل مع ضباط المخابرات لإجراء ترتيبات ساعة الصفر المجهولة. قال له: إذا ظهر أنك تكذب، فسوف آمر بإعدامك. متوقعاً أن يفر الولد هارباً، لكن الولد أظهر صلابة ولم يتراجع عما قاله. فاضطر الوزير إلى التوقف في غرفة الحرس. رفع السماعة وطلب من حامية حلب التوجه إلى العنوان المذكور وإلقاء القبض عليه. أبقاه لدى الحرس يكرع الشاي، الكوب تلو الكوب، إلى أن تبلغ الوزير من قائد حامية حلب، وهو مضطجع على الصوفا بعد العشاء، أنهم قبضوا على المطلوب وهو واقف الآن بالسروال الصوفي الداخلي، مقيد اليدين، ينتعل شحاطة مهترئة. ولكي يكون على يقين مما تبلغه على الهاتف، قال لهم أسمعوني صوته، فضربه الرقيب قائد الدورية ببوز بسطاره على ركبته. فصرخ المقبوض عليه متألماً. فتأكد أنه بغيته من بحة صوته، التي طالما عكّرت عليه مزاجه في الاجتماعات الحزبية، وكانت دائماً مترافقة بخبطة قبضته على الطاولة. الآن قبضة الضابط سبقت قبضة المعارض، وأصابته على أم رأسه. اعتقاله آذن بالخطوة اللاحقة، وهي الأخيرة، قبل أن يشرق فجر التصحيح على البلاد.
استدعى الولد سليمان من غرفة الحرس، وسمع منه قصته كاملة، طبعاً لم يصدق منها الوطنية الزاعقة التي أسبغها على وشايته، لكنه فهم منها أنه عاطل من العمل، وناجح في الثانوية بدرجة شحط، فأخذ اسمه وعنوانه، ثم أعطى أمراً للمحاسب كي يعطيه خمسة آلاف ليرة. فما كان من سليمان إلا أن باح له بأمر الخلايا السرية، فوعده الوزير بمكافأة إضافية في القريب العاجل.
بعد أن تركه توجه إلى اجتماعه في المخابرات، وكان للخبر الذي حمله معه تأثير كبير في الضباط المجتمعين، كان بعضهم غير ميّال إلى المشاركة بأي انقلاب، ولو كان تصحيحاً لما سبقه، فرص التفاهم مع المعارضين لم تستنفد بعد، كانوا خائفين من جبهة الحزب السرية أن تتوسع وتشن عليهم حرب عصابات تنطلق من الأرياف إلى المدن. أما وقد تهاوت وانفرطت بالقبض على الرجل الفاعل فيها، فلم يعد التصحيح معرضاً للإلغاء، ولا للتأجيل؛ ساعة الصفر باتت معلومة.
نجح التصحيح دون كثير معوقات، أسهمت فيه وشاية سليمان، كانت القشة التي قصمت ظهر الطرف المعادي. لذلك أولاه الوزير الذي أصبح رئيساً للجمهورية بعد بضعة أشهر، رعايته الخاصة، وإن كان عن بعد، لكن سليمان سيبالغ بينه وبين نفسه، ويدَّعي أنه كان السبب في النصر الذي أحرزه الوزير.
لم يُسَلّم ابن الأخت خاله لأسباب عقائدية، وإن زعم أن عضويته في شبيبة الثورة تملي مبادئها الشبيبية على الطالب الشبيبي الإبلاغ عن الرجعيين معرقلي تقدم الثورة نحو تحقيق أهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية، فكان أميناً لها. أما الخال الذي لم يعرقل أياً من هذه الأهداف، وإنما عارض التصحيح، لانحراف دعاته عن الثورة، والتخلي عن العمال والفلاحين وأخذ جانب البرجوازية الرجعية، بما دعي في كتابات المنظرين اليساريين الكبار، بالثورة المضادة، فلم يدر أنه بعد زمن قصير، سيصبح هو وأمثاله الثورة المضادة، بينما ستكرس الحركة التصحيحية على أنها امتداد للثورة المباركة.
هل كان مديناً للمصادفة أم لعواطفه الجريحة؟ تساءل سليمان. لم يكن متأكداً، ما الذي حرّضه على تسليم خاله إلى خصومه، الثأر للإهانة، أم المستقبل المجهول الذي تهيأ له بمصادفة، لم يدعها تضيع هباء؟ الحقيقة، لا ينفصل أحدهما عن الآخر، لولا الأول لما كان الثاني. اعتراف لم يبح به لأحد، لئلا تنتقص خصوصية فعلته من سلامة وطنيته، ما دام السبب المتوافر يزيد عن المطلوب: التآمر على الثورة.
* مقطع من رواية “السوريون الأعداء” الصادرة حديثاً.
العربي الجديد
السوريون الأعداء.. حكاية شعب/ حازم شيخو
الماضي يعود دائماً. لم يخطر ببال النقيب سليمان هذا الأمر حين أمر بنقل الطبيب عدنان الراجي إلى حقل الرمي، وشرع يقتل عائلة الأخير بدم بارد. لم يكن يعرف أنه بذلك خطّ الحكاية التي ستستمر لسنين طويلة، وتتمدد، من دون أن تتمكن من الانفصال عن تلك اللحظة، عن الماضي الذي لا يموت أبداً.
بهذا الحدث تنطلق رواية الكاتب السوري فواز حداد الجديدة، “السوريون الأعداء” (الريس للكتب والنشر). رواية عن سوريا التي انتزعت من أيدي أبنائها لتصبح رهينة نظام قمعي، وتتحول، في سنين قليلة، من دولة إلى ملكية خاصة. يروي الكاتب حكاية ثلاثة سوريين، تتقاطع حيواتهم في سياق الوطن السوري، وتتدرّج بين السلطة والخيبة والشقاء.
يبدأ صاحب “الضغينة والهوى” بذكريات سليم الراجي، ابن مدينة حماة، القاضي في القصر العدلي في دمشق. نتعرّف إلى محنته في عمله بالقضاء، ومأساته التي بدأت عام 1982 حين جاء غرباءٌ بابن أخيه، الطفل الرضيع والناجي الوحيد من المجزرة التي ارتكبت بحق عائلته.
بحْثُ سليم عن أخيه عدنان لا يفضي إلى شيء، إذ اختفت جميع آثاره، وتحول حي الكيلانية، حيث كان يقطن مع العائلة، إلى أنقاض. أنقاض ستُبنى فوقها أحياء جديدة، علّ ذلك يطمس تلك المرحلة السوداء من تاريخ البلد. هذا ما يعمل عليه النقيب سليمان، الذي سيلقّب بالمهندس، بعد انتقاله إلى العمل في القصر الجمهوري. المهندس، الذي ارتكب المجزرة بحق العائلة حين كان ضابطاً إدارياً في الجيش، يُرقّى لتفانيه في خدمة “الدولة”. يعيّنه “الرئيس” في منصب غير واضح المعالم، بل يُترك الأمر لسليمان كي يحدّد ماهية هذا المنصب.
هكذا يبدأ الأخير بهندسة منصبه، لتتعدد مهامه، من إقامة جهاز أمني خاص يُشرف على مراقبة الأجهزة الأخرى، إلى تحويل مالك القصر الجمهوري في أذهان الشعب من “الأخ القائد” إلى “القائد الخالد”. يبدأ المهندس مهمته الأخيرة “بصورة ضخمة ملوّنة للرئيس، علّقت على واجهة مبنى محافظة أمانة العاصمة. حجم الصورة بطول المبنى”. ويتهافت الانتهازيون من الحزبيين والرفاق في اتحادات العمال والفلاحين والطلبة وغيرها من الهيئات والنقابات، على تعليق صور القائد في بيوتهم، وامتداح حكمته وشجاعته.
يقسّم حداد الرواية (472 صفحة) إلى 16 فصلاً، ويبدأ كل فصل مع مذكرات القاضي، التي تُروى بضمير المتكلم. ثم ينتقل إلى القصّ بضمير الغائب ليروي قصة المهندس. وينهي كل فصل برحلة الطبيب الذي اقتلع من أحضان عائلته، ليُرسل إلى حقل الرمي، حيث لا أحد يعود من هناك. إلا أن الصدفة لعبت دورها، وأنقذته من الموت، ليقع في براثن عذاب لا ينتهي.
هكذا، تتتبع الرواية قصة شقائه هو وزملائه المعتقلين في سجن تدمر؛ هناك، حيث الموت أكثر رحمة من البقاء على قيد الحياة. يرسم لنا صاحب “المترجم الخائن” صورة بانورامية لسوريا ومرحلة تكريس “نظام الحركة التصحيحية”. يبدأ من مجزرة حماة، ويعبر الحرب الأهلية اللبنانية، والنزاع بين الشقيقين القائدين، ثم مرحلة انتقال الحكم من الأب إلى ابنه، لينهيها بالثورة التي بدأت في العام 2011، وما تزال مستمرة حتى الآن.
لا يخفى أن شخصية “المهندس” تتعدى ما تُظهره الرواية، كموظف في القصر الجمهوري. إذ إن هذا الذي مارس القتل لأول مرة في حماة، ثم شارف على مراقبة عمل أجهزة المخابرات والجيش والقضاء، وعمل على تأليه القائد الأول في البلاد، ونصح الحرس الجديد بالطريقة التي يتعامل فيها مع المظاهرات، هو أكثر من مجرد شخص لا علم لأحد بماهية عمله. إنه الكيان الذي حكم سوريا، ومجموع الأجهزة التي سيطرت وقمعت وبلورت الشكل النهائي للبلد.
لا تمنح “السوريون الأعداء” نفسها إلى القارئ بسهولة. ليس الأمر متعلقاً بأسلوب الكتابة، إذ أن الروائي لم يتخلّ عن طريقة سرده السلسة؛ ولكن لأن الأحداث التي نقرأها في صفحات الرواية ما تزال قريبة العهد، وما يزال السوريون يعيشونها، ويعيشون عواقبها، ويواجهون النظام نفسه.
لا يتوانى الكاتب عن تسمية الأمور بمسمياتها، ولا يتردد في الخوض في كواليس السلطة وصنع القرار. يتجوّل في أقبية الفروع الأمنية، ويلبث مطوّلاً في سجون البلد ومستنقعاته، ويُشرف على القضاء، الذي كان الأمل الوحيد في الحفاظ على القليل من دولة القانون، ليرينا صورة هذه المؤسسة من خلال قصة القاضي سليم الراجي، وزميله ورئيسه الأستاذ رشدي، اللذين عملا تحت إشراف المهندس في جهاز التفتيش. كان أمل القاضيين محاربة الفساد في البداية، لكنهما سيدركان لاحقاً أن “الملفات التي أسهمنا بها ستكون يوماً ما سيفاً مسلّطاً على أصحابها لضمان عبوديتهم…”.
مع ذلك، فإن الماضي لا يموت، والمجتمع حافظ على هامش حريته الذي أثمر في الثورة الأخيرة. ولم يتمكن النظام من ابتلاع البلد كما تهيأ له، فمصير المجتمعات والشعوب أن تنجو دائماً من براثن طغاتها، وأن تستمر. لكن يبقى السؤال دائماً عن الأفراد؛ قتَلة، وضحايا، وتائهين في دورة التاريخ.
إخوة فواز حداد/ خالد الإختيار
غالباً ما يجد الروائي نفسه متجولاً في عباءة مهرّب متمرّس. الحرفة القديمة التي لا يُعرف لها نطاق اختصاص سلعيّ محدّد، هي صنو الكتابة الروائية. وعندما يمسي “التاريخ” بألف ولام العهد “بضاعة” ممنوعة، لا تلبث أصابع الروائي أن تجد نفسها مشغولة بحياكة “ما جرى وكان” بخيوط ظاهرها الفنتازي المتخيّل، فيما بطانتها ملتصقة ببدن لابسها كجلده “الواقعي”، أو هي جلده.
يعتمر فواز حداد في “السوريون الأعداء” قلنسوة الروائي المؤرخ، ليسرد علينا حكاية ما قبل “اليقظة”، كي لا تفوتنا ثانية أشباح كابوس دهمنا في سباتنا الفائت، فننجرّ، ونحن ننزع بالدم العمشَ عن عيوننا المفتوحة من جديد، إلى ظلمة كهفنا الأول.
فساعة صفر “الحركة التصحيحية”، لا تقررها الأوضاع المعيشية المتردية للشعب، ولا “الرؤيوية” النافذة لضباطها الانتهازيين؛ بل الوشايات وطول سوط القبضة العسكرية العمياء.
من فوتوغرافيات الأبيض والأسود في مقتلة “الإخوان” والكثير ممن شُبّه له أنّهم منهم، إلى الفساد المتلوّن بأصباغ التطوير والتحديث. وبينهما سرمد من رمادي “الاستقرار” و”الأمان”.
كيف تُمسخ لفظة “الثورة” إلى سلسلة حروف يطلقها زفير آسن، وكيف يُعيّن أبناء “الشهداء” بمرسوم وزاري، فيما آباؤهم أحياء يرتعدون.
يحتاج السوريون اليوم لمن يذكّرهم بعداوات ذاتِ بينهم العتيقة، علّهم يكتشفون أنّهم قضوا وطرهم من الحقد والضغينة، فينصرفون إلى التغيير الفعلي “التاريخي” بما هو نقيض، ونقض، لهذا الإرث العطن.
ستمنع الجمارك السورية تهريب “المهرّب” في رواية حدّاد، وسيقاوم النظام محاولة تلاوة تاريخه الذي تفنن في شعوذة تزييفه. لكنّ الضوء المسلّط في هذا العمل على ما مضى، ليس سوى ترنيمة على طريق الجلجلة. وخيراً نفعل بإضاءة شموع للنفق القادم. فخيار النكوص لا صحائف له في قرطاس التاريخ، ولا روايات.
العربي الجديد





