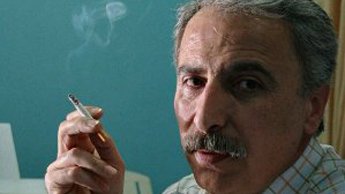روزا ياسين حسن: قررت ألاّ أبقى لحظة خارج الثورة السورية
سامر محمد اسماعيل
ليست مع الكتابة على غرار الروايات العالمية ولا مع الإغراق في المحلية
تصرّ روزا ياسين حسن في روايتها الجديدة «بروفا» الصادرة أخيراً عن دار الريس في بيروت على تحطيم السجون الروحية المتمثلة في مركزية الصوت الواحد، مستخدمةً بوليفونيا السرد كتقنية لا شريك لها للخوض في بنى مجتمعات تقشّر جلدها القديم، لاهثةً وراء فضح المسكوت عنه..
كان لقاء مع الروائية السورية وكان الحوار الآتي:
÷ أهديتِ روايتكِ الأخيرة «بروفا» لجيل السبعينيات جيل الخيبات والخسارات كما وصفته.. هل الرواية قادرة على رد الصاع؟ وأن تجسّر المسافات الزمنية بين جيل عانى من خيباته السياسية وبين جيل يتطلع اليوم للحرية.. هل هناك غياب أو انقطاع بين كل هذه الأجيال؟
} كنت دائماً أنظر إلى جيل السبعينيات الذي أنتمي إليه، على أنه جاء في فترة زمنية سياسية، فرضت عليه أن يتشكل بعيداً عن الطريقة التي تربت عليها الأجيال السابقة، فلقد نشأ الشباب والشابات وقتها في ظل طلائع البعث وشبيبة الثورة واتحاد الطلبة، وهذه المؤسسات كانت أقرب في توجهها إلى مؤسسات أمنية منها إلى مؤسسات لها علاقة بالطفولة أو الشباب، فلقد فرض على هذا الجيل صوت واحد، وقرار واحد، ولُقن ما عليه أن يفكر به، كما لُقن فيما بعد خياراته، ولهذا أطلقت عليه جيل الخيبات والخسارات. لقد جاء جيلنا بعد انسدال الستار على المسرح السياسي والاجتماعي في سوريا، ووقتها كان هناك تفريغ للعمل السياسي، وتفريغ لمؤسسات المجتمع المدني، وأهم من هذا وذاك، تفريغ مجتمعنا السوري من الفردانية، ولهذا تلحظ اليوم هذا الجوع لدى السوريين من أبناء جيلي وغيرهم إلى الفردانية، لكوننا ربينا ضمن مجتمع قطيعي، أجبرنا أن نكون قطيعيين بطريقةٍ أو بأخرى، بالتالي خسارات هذا الجيل متأتية من خيباته السياسية والفردية وضيق مساحات التعبير والحرية. أظن أن لكل جيل أخلاقه؛ أستطيع القول إن هناك شريحة واسعة من هذا الجيل تربت على الأدب السوفييتي، لكن في النهاية حصر جيل كامل في اتجاه أيديولوجي واحد لا يمكن أن يكون في مصلحته، حتى وإن كنتَ متفقاً مع هذا الاتجاه، فالانفتاح على مختلف التيارات والمذاهب الفكرية والسياسية هو في مصلحة الإنسان، ليستطيع بعد ذلك أن يفاضل ويختار بنفسه الاتجاه والأفكار التي يعتقد بها، فضيق الافق الذي كان سائداً في سبعينيات وثمانينات سوريا أدى إلى إنتاج جيل لديه عوز هائل إلى الحرية، فنحن في الثمانينيات استفقنا على حصار اقتصادي وسياسي أثّر على تكويننا المعرفي والفكري، زاد من ذلك طغيان الديكتاتورية على كل ما يحيط بحياتنا، استمرّ ذلك حتى النصف الثاني من التسعينيات. الآن ما يجري في سوريا هو مخالف تماماً لما حدث معنا في تلك الأيام، فالشباب لديهم فرصة كبيرة للإطلاع على ثقافات العالم بالقياس إلى جيلنا، فلطالما رددنا في مدارسنا وجامعاتنا.. «وطن واحد.. حزب واحد.. صوت واحد».
÷ الصوت الواحد.. هذا يقودنا إلى داخل روايتك «بروفا» التي عملت فيها على صياغة غواية الأصوات لكسر هيمنة النظام الواحدي ذي الهياكل الذكورية المتحالفة مع إكليروس الدين لحماية نفسها، لكنك في الوقت ذاته لجأت في الرواية إلى التعويض عن الاستبداد الذكوري السياسي باستبداد تنظيم نسائي سري اخترت له نموذج «القبيسيات» وكأنه لا بديل عن الذكورة في المجتمع السوري إلا بمقاربة نموذج المرأة القضيبية؟
} شخصياً أظن أن تشظي الصوت المركزي هو أكبر حرب ضد الصوت الواحد، فأنا أكره هذا الصوت في الرواية، لأنه يعادل بالنسبة لي الحزب الواحد، والرأي الواحد، وبالتالي تكنيك النص المتشظي يعكس فهماً عميقاً لديّ مفاده أن الشكل دوماً هو وعاء للمضمون، فعبر تعددية الأصوات داخل العمل الروائي تستطيع ككاتب أن تدخل إلى عمق شخصيات روايتك المتباينة للغاية، وهكذا لا يبني الكاتب روايته على أنها قوس محكمة. «بروفا» كانت خياراً وردّاً على مركزية الصوت الذي ربيّ عليه كل الشباب العربي في بلاد الطغاة والديكتاتوريات، أما بالنسبة للتجمّع النسائي الموجود في الرواية، فبرأيي أن كل التجمعات الأيديولوجية هي في صميمها تجمعات لصوت واحد، لكن في الوقت ذاته تنوع الأصوات وتبدلها هو شكل نسوي في نهاية الأمر، ومع أن مجتمع القبيسيات في «بروفا» كان يرمز لصوت واحد، إلا أنه داخل هذا التجمع النسائي كان هنالك نساء رافضات وغير موافقات لهذا الصوت الواحد، وكُنّ في محاولة دائمة لتقويضه.
القطيع والفردانية
÷ لكنك لجأت في «بروفا» إلى نموذج إسلامي على عكس ما لجأت إليه في روايتك الوثائقية «نيغاتيف» التي تعرّضت فيها لتجارب سجينات سياسيات ذوات انتماءات يسارية، دون أن تعرضي لتجارب سجينات إسلاميات، قلت عندها إن ظروف الكثيرات منهن لا تسمح بتوثيق ونقل تجاربهن إلى روايتكِ؟
} الصوت في «بروفا» أخذ مقام المتلصص الذي كان طوال الوقت يستمع لأصوات متعددة، مما أدى إلى انفلاته من سطوة أوتار المركزية، مما اضطر هذا الصوت الواحد أن يستمع لآراء الآخرين من دون أن يتدخل بهم، أو يقسرهم على فعل ما لا يحبونه، لنكتشف أن شخصية موظف المقسم الأمني يجهل وجود أصوات أخرى. برأيي أن تقويض الصوت الواحد يأتي دائماً من العمل على إعلاء فردانيتنا، والفردانية هنا لا أعني بها نرجسيتنا، فهذا أمر مختلف تماماً، الفردانية هنا تعني أننا في النهاية أشخاص لدينا آراء، ولنا الحق بأن نفكر لا أن يفكر الآخرون عنا، ولدينا الحق بأن نصيغ معادلاتنا الشخصية عن العالم الذي نريد أن نعيش فيه، وعلى أثر ذلك نختار ما يناسبنا خارج هيمنة حالة القطيع التي تفرض علينا، فحينما نخرج من القطيعية نستطيع أن نكون أكثر إبداعاً، أما عن سؤالك حول مجتمع القبيسيات الذي رمزت له من خلال شخصية «هالة السماقي» فهذه شخصية تربت داخل جو ديني مغلق، إلا أنني عندما وصفت هذا الجو في الرواية لم أقبل أن أحاكم شخصياته، لأنه في داخل هذا التجمع النسائي المغلق كانت هناك شخصيات بمنتهى الإنسانية، مثلما كان هناك شخصيات عكس ذلك تماماً، ولذلك كان عليّ عند تناولي لمجتمع «القبيسيات» أن آخذ جميع أطيافه وألوانه، فكان لديّ مثلاً شخصية «سحر» المرأة اللطيفة غير المتسلطة، جنباً لجنب مع شخصيات أخرى شديدة الحدة والإقصائية للآخر. شخصية «هالة السماقي» أيضاً خرجت عن التجمع الديني وانفتحت على عوالم أخرى، نتيجة تجربة خاصة لفتت نظرها إلى فردانيتها وعوالمها الداخلية، وتجلى ذلك في حالة الشلل الجسدي الذي أصاب الشخصية، فلم يعد لديها من طريقة للذهاب نحو مكان التجمع النسائي ذي الصوت الواحد إلا خيالها وقدرتها الذهنية لاستحضار ذلك المكان، ولهذا ذهبت السماقي للبحث عن خلاصها الفردي، وهكذا نجحت بتقويض تربية كاملة كانت قد نشأت عليها، لكن المفارقة في هذا أن هالة خرجت من إطار أيديولوجي ديني، لتلجأ إلى خيار صوفي روحاني، وهذا ما أعتبره انتصاراً سلكته الشخصية للخلاص من عبء مركزية دينية أُجبرت على العيش فيها دون أية إرادة أو تفكير بانتقاء فضاءات أخرى خاصة، أو وفق قناعات شخصية بحتة تتعلق بها لا بأي شخص أو تجمع يلزمها بذلك.
÷ هل هذه الكتابة التي تخوضينها اليوم مع مجموعة من كاتبات سوريات وعربيات من جيلكِ يمكن اعتبارها ثورة نساء قد تشكل أبرز ميزات المجتمعات العربية المقبلة، لا سيما أن المرأة في هذه المجتمعات هي مكان للطهرانية الدينية والعفاف الاجتماعي؟
} المرأة تعنيني كثيراً في كتاباتي، لكن وجود شخصيات منفتحة اجتماعياً وجسدياً مقابل شخصيات محافظة وطهرانية، ضروري للكتابة ذاتها، ولهذا يجب أن لا تهيمن الشخصية ذات النمط الحياتي الواحد، فالمجتمعات العربية والسورية، خصوصاً ليست كذلك، المجتمع السوري شديد التلون والتعدد ومن هنا تأتي جماليته وضرورة مجاراته بكتابة متلونة، السوريون متعددو المشارب الاجتماعية، فحتى داخل البيئات التي توصف عادةً بالمنغلقة لا توجد شخصيات متشابهة، على الإطلاق، وتعدد الأبطال في الرواية هو جزء أساسي من هذا المنطق. إن فرضية البطل الروائي المطلق مجرد طرفة، ولذلك تقول إحدى شخصيات «بروفا»: «يخطئ تماماً من يظن أن الرمال التي نراها من بعيد متشابهة»، فكل حبة رمل مختلفة عن الأخرى، كل رجل يختلف عن رجل آخر، كما كل امرأة تختلف عن امرأة أخرى، ولذلك أستمتع بلمس هذه الفروقات بين البشر، فالاختلاف لا يعني العداوة. إننا نختلف لنحبّ بعضنا بصورة أكبر وأكثر إنسانية، ولهذا أردد دائماً بأن اللون الواحد بشع وكئيب ومملّ، ولهذا كان اسم روايتي «بروفا» لأنني أعتبر أن ليس هناك شيء منجز ونهائي في الكتابة، فكل منجز منتهى، وحينما ننجز حريٌّ بنا الموت.
÷ هل نفهم هنا أن تعدد الأصوات هو فقط تعدد أنماط الشخصيات الروائية، أم أنه يأتي داخل الشخصية الواحدة، ألا يمكن أن يحدث ذلك من خلال تعدّد الأساليب وصدامها داخل النص الروائي الواحد؟ كما هو الحال مثلاً في الرواية الفرنسية الجديدة التي تحتفي بالشخصي على أنه موضوعي ومعاصر بشكلٍ أو بآخر؟
} هنا يوجد أمران أساسيان، أولاً هناك الرواية التي تنبع خصوصيتها من المكان والزمان وذات الكاتب، أما ثانياً فمن واجبي كروائية الإطلاع على الثقافات الأخرى والغوص فيها، في الوقت ذاته أنا مدعوة إلى تكريس نوع من أنواع الخصوصية المكانية والزمانية والثقافية والذاتية، وهذه جميعها تنتمي لمرجل واحد يتم فيه صهر هذه العناصر التي يخرج منها العمل الروائي، هنا تصبح الرواية مفتوحة على إبداع الآخر بشكل دائم، فأنا لستُ مع من يقول إنه ينبغي أن نكتب على غرار الروايات العالمية، ولستُ أيضاً مع الإغراق في المحلية، بل يجب التوفيق دائماً بين هذه وتلك. أتفق معك أن تعدد الأصوات داخل النص لا يعني فقط تنوع الشخصيات، فالتنوع يمكن صناعته أو توليده من داخل الصوت الواحد، ففي روايتي «حراس الهواء» مثلاً لم يكن لديّ سوى شخصية «مياسة» بتلك الانحرافات الأسلوبية والتي تتحول من اعتناق الشيوعية إلى مناصرة المايكروبيوتيك، أما في «بروفا» الأمر عكس ذلك تماماً، حيث كان هناك الكثير من العمل على تطوير شخصيات منكسرة، فالشخصية كانت تبدأ بشيء لتنتهي بشيء آخر تماماً، وأثناء ذلك يمكنك ان تلاحظ تلك الانحرافات والتبدلات الشديدة في عالم الشخصية، فأنا لا أعتقد أن الشخصية الروائية تسير ضمن خط مستقيم، فهي في النهاية دائمة الصعود والهبوط، فالشخصية دائمة التبديل والتلوين بقناعاتها وفق عوالمها الذاتية التي تشبهنا في تقلباتنا الحادة كأفراد نعيش ضمن مجتمعات شديدة التمويه والتغير، وهذا يعني تقويض الخط المستقيم لمسار الشخصية نحو كتابة منحنية وحلزونية، لكوننا في النهاية كبشر لا يمكن أن نكون إلا على هذا النحو من اجتماع المفارقات والأضداد والتنوع حتى داخل الشخصية الواحدة، فالكاتب عندما يعطي الحرية لشخصياته سيكتشف أنه لا يستطيع أن يزجها ضمن قالب سردي أو نفسي واحد، فتصبح هذه الشخصيات أكثر تحرراً وصدقاً وتملصاً من هيمنة الصوت الواحد وأسره.
÷ يمكن أن نعتبر أن جراح الفرد هي جراح الجماعة، لكن ثمة من يقول إن معظم ما يكتبه الروائيون السوريون اليوم ينضوي تحت لافتة رواية الأمن، كيف تتخلص الرواية السورية اليوم من سجونها السرية لتتنفس خارج التلصص والتوريات ومناكفة السلطة؟
} ليس لهذا علاقة بمحاولة تسليط الضوء على المناطق المظلمة، أو محاولة نقل جرح الجماعة كما تقول، هذا له علاقة بالثقافة والذاكرة، فسنوات طويلة لا يمكن أن تمحى بهذه البساطة، لكونها عششت في ذاكرتك ووجدانك، فغداً عندما نتحول إلى بلد ديموقراطي، وأنا واثقة من ذلك، علينا أن نقشر عن جلودنا هذا المناخ الأمني المقيم، ونخلص ذاكرتنا من هذا الخوف.. إن شخصية رجل الأمن تخيف السوريين أكثر من أي شيء آخر، حتى أن كوابيسنا تدور حول رجل الأمن هذا، كيف يمكننا أن نكسّر ذاكرة الخوف؟ هي الآن تُكسر، وأولادنا سيعيشون بشكل حر أكثر منا بكثير، سوف تبقى الرواية السورية كما في كل بلاد الديكتاتوريات، وإلى زمن طويل تتحدث عن أقبية فروع الأمن والمخابرات، وعن الخوف الذي زرعته هذه الفروع في الدولة الأمنية، فالرواية هنا كما كل الفنون تعمل على تكسير الأشياء الصلدة داخل الإنسان وتحويلها إلى محض غبار متناثر، الرواية تساعدنا على خلع ثقافة الخوف، أما ذاكرة السوريين فهي في مجملها ذاكرة أمنية. بالنسبة لي، ما يعنيني هو الإنسان بالدرجة الأولى، يعنيني الدخول إلى إنسان أحلامه تشبه كوابيسه، وآلامه مثل أحزانه، فثمة حيوات كاملة عاشت وزجت داخل هذه السجون الروحية، ليس المهم ماذا سنكتب، المهم كيف سنكتب عن ذاكرة أمنية بطريقة تشابهها، ويتم ذلك عبر تكسيرها لتنقل الرواية إلى مناطق مختلفة تماماً عن الذاكرة الجماعية للخوف، أعتقد أن الرواية اليوم هي المدوّن الأول، وليس التاريخ، وهذا لا يعني أن الرواية تعمل بديلاً عن علم الاجتماع أو حتى عن التاريخ، إنها تعمل على الممرات السرية الموجودة في دواخل الإنسان، فالرواية هي سِفر للهامش، هي سِفر للخاسرين والمظلومين، إنها لا تقف إلى جانب المنتصر بقدر وقوفها إلى جانب المهزوم، وهي لا تُكتب للمتن، بل تُكتب للهامش، فالمتن والمنتصر يحتلان كتب التاريخ، بينما تعمل الرواية في الأماكن المغايرة دائماً، لكونها التاريخ السريّ للإنسانية، فعندما تعمل العلوم على الظاهر، تشتغل الرواية على الباطن، ولكوننا كسوريين رُبينا داخل سراديب روحية ونفسية، لا يمكن لرواية اليوم إلا أن تواظب من جديد وبلا كلل على تحطيم جدران هذه السراديب وتهشيمها.
اصنام الخوف
÷ إذاً أين يقع الحب، أين تقع الحياة في هذا الأقيانوس الهائل من السراديب والتلصص والتخفي؟ أين هي العلامات الفارقة في متوالية الضحية والجلاد وتناوب كل منهما على تمثيل دور الآخر؟
} ما يحدث اليوم في سوريا هو محاولة لتكسير أصنام الخوف، والشعب السوري في هذه المرحلة يكتب روايته الخاصة؛ فكما أحاول تكسير ثقافة الخوف عبر اللغة، يفعل الشعب أيضاً الشيء نفسه، إلا أن تاريخ الإنسانية يقول إن الضحية في لحظة زمنية معينة تتحول إلى جلاد، وهذا للأسف هو منطق الأشياء، فالظلم المحبوس تاريخياً داخل الضحية، يأتي عليه وقت ليُفَرّغ في ضحية أخرى كانت فيما مضى هي الجلاد، وهذا منطق التاريخ. أعتقد أن من حق الضحايا على مرّ الزمان أن يثأروا لسنوات عبوديتهم، لكنني أتمنى شخصياً ألا تتحوّل الضحية إلى جلاد، لكن التاريخ لا يقول لنا ذلك، دعني أقل إن من حق الشعوب أن تتحرر من طغاتها، لكنني أتمنى أن تتحرر بكبرياء وكرامة وعزة دون أن تتحول إلى جلاد من جديد، وبدون أن تعيد هذه المتوالية التاريخية.. «جلاد.. ضحية..». وهذا ما أتمنى وآمل أن لا يحدث في سوريا، فأنا كروائية أنتصر دائماً للشعوب ضد السلطات، لأنني مع البرّي ضد المُدَجَّن، مع الهامش ضد المتن، والشعوب دائماً هامش، أما السلطات فهي المتن، ومن حق الشعوب أن تختار.
÷ البعض يقول إن خيار الشعب سيرتكز على أغلبية مذهبية توصل حكومات إسلامية إلى الحكم كما حدث في تونس ومصر والمغرب؟ ألا تهمّش مثل هذه الديموقراطية من جديد حقوقاً ثقافية واجتماعية للأقليات الموجودة؛ مما يفضي مرةً أخرى إلى أحادية الصوت ومركزيته الغاشمة؟
} لا أرى الأمور بهذه الطريقة، بل أرى أن سوريا فسيفساء جامعة لكل الأطياف، وهنا تكمن جماليتها النادرة، وينبغي أن نحافظ كسوريين على هذه الخصوصية، ففي ظل دولة ديموقراطية يحق لكل أقلية أن تمارس ثقافتها وطقوسها وقناعاتها الخاصة بها، وهذا ما أعمل عليه ليلاً نهاراً مع الآخرين ومستعدة للموت من أجله، لكن عندما تعود البلاد لتحكم من قبل صوت أو حزب واحد سوف أظل معارضة على الدوام، وعندما ستتحول الضحية تاريخياً إلى جلاد سأكون معارضة لهذا الجلاد – الضحية، وسأبقى كما الرواية معارضة للجلادين باستمرار؛ الشعب السوري اليوم يحاول صنع ديموقراطيته، ومن أسوأ كوابيسي أن تنحرف هذه المسيرة الجميلة نحو مركزية معينة سأكون عندها في مقدمة المعارضين لها، لكوني كنت وسأبقى مع التعددية التي هي من حق الشعب السوري وتشبهه، فالديموقراطية كما يعرف الجميع، هي حكم الأغلبية من خلال الاحتكام لصناديق الاقتراع.
÷ إلى جانب كونك روائية فقد مارست دوراً جديداً في الأزمة السورية تجلى في عملك مع هيئة التنسيق الوطنية، كيف تصفين دورك كناشطة سياسية في هذه الهيئة؟
} عملي مع هيئة التنسيق جاء من حلم قديم لطالما راودني وأنا أقرأ عن الثورات في الكتب والمذكرات السياسية، كنت أحلم بأن أشهد ثورة في بلدي قبل أن أموت، ولقد جاء الوقت لأحقق حلمي، وأخذت قراري منذ البداية أن لا أكون و لو للحظة خارج هذه الثورة، فأنا لا أستطيع البقاء على الحياد، وما يجري في بلدي هو تجربة تاريخية تغني حياة الإنسان وكتابته إذا كان مقتنعاً بها، فلمَ لا أعيشها وأنا شديدة الاقتناع بها؟ هناك أناسٌ دفعوا دماءهم أثماناً وكان عليّ كمواطنة أن أقف جنباً إلى جنب مع أخي السوري. الحقيقة أني اشتغلت مع هيئة التنسيق الوطنية رغم اختلافي مع بعض أعضائها في الرأي، إلا أنني لا أستطيع إلا أن أرفع القبعة لماضي وحاضر أعضاء هيئة التنسيق رغم اختلافي مع بعضهم سياسياً كما قلت. اختلاف الآراء داخل المعارضات السورية أمر طبيعي بعد عقود طويلة من القمع، فالعمل السياسي السري الذي كان سائداً في سوريا لسنوات لا أعتبره عملاً سياسياً حقيقياً، العمل السياسي هو عمل علني، لكن أن يصل الأمر إلى «التشبيح» بين اتجاهات المعارضة المختلفة كما حدث مع أعضاء هيئة التنسيق أثناء ذهابهم إلى القاهرة للقاء أمين عام جامعة الدول العربية، فهذا أمر مخزٍ ومؤلم للغاية، واستخدام لأساليب النظام التي أرفضها، هذا إقصاء لصوتكَ ودورك، ولا يمكن بناء ديموقراطية من دون سماع الصوت الآخر، لا سيما أن الشعب سوري يموت يومياً، وينتظر من المعارضة الوصول إلى صيغ متقاربة – ولا أقول متطابقة – لإنقاذ البلد من الكارثة.
(دمشق)