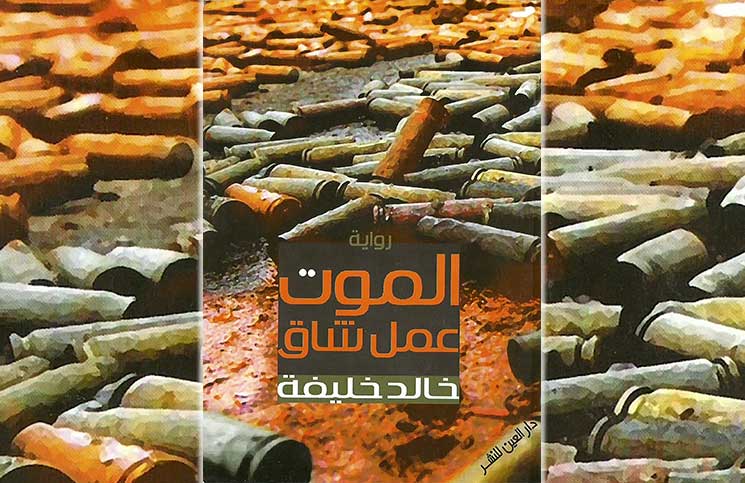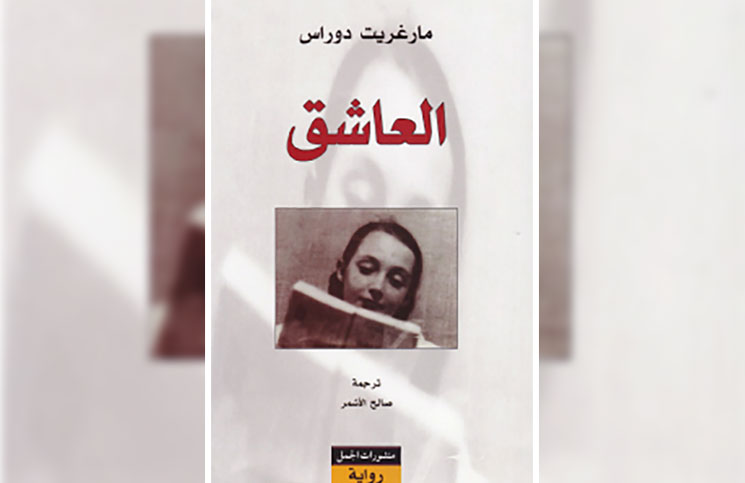سمر يزبك تروي الحرب السورية بلسانٍ مربوط/ مايا الحاج

«المشّاءة» (دار الآداب) رواية سمر يزبك الأولى بعد الحرب السورية، والخامسة في مسيرتها الروائية. هذا التحديد الزمني مهم جداً في التعامل مع هذه الرواية، التي انتظر كثيرون قراءتها لمعرفة رؤية يزبك التخييلية إزاء حربٍ وثّقتها بكتابين يحويان يوميات الحرب في سورية وشهادات من أهالٍ ومقاتلين، «تقاطع نيران» و «بوابات العدم».
قد يظنّ بعضهم أنّ من السهل على كاتبة متمرّسة بناء رواية نواتها الرئيسة حاضرة في واقعها وبين أوراقها، هي التي تسلّلت من تركيا إلى الشمال السوري في ريف إدلب (بين عامي 2012 و2013) وكتبت مذكرات تسجيلية للقاءاتها وانطباعاتها حول ما يجري في بلدها. لكنّ التحدّي الحقيقي يظلّ في انقياد الكاتبة نحو سردٍ قوامه التخييل الإبداعي، لا الواقع التسجيلي. ومع قراءة العمل، يلتمس القارئ قدرة الكاتبة على إذابة كل مشاهداتها (العينية) في قالب روائي يُعبّر- تخييلياً- عن الواقع الخارجي (المُتعيّن).
لم تُخالف سمر يزبك توقعات القرّاء حين جعلت من الحرب تيمتها الرئيسة. فالحرب جذر مشترك في كلّ ما كتبته وتكتبه منذ بداية الثورة، مقالة ونصّاً ويوميات ورواية. لكنّ الحرب لم تحضر في «المشاءة»، عبر نقلٍ مرآوي، شديد الالتصاق بالواقع. إنما أعادت تشكيلها من خلال حكايةٍ ترويها- بصيغة المتكلم- فتاة (مُصابة بداء المشي)، هي أبعد الناس عن حرب شعواء يتحكّم فيها وحوش الداخل والخارج. وهي تُشرك القارئ في «تشكيل» حكاية تنسجها من حكايات كثيرة، مستخدمةً جُملاً «توصيلية» من قبيل: «سنعود إلى حكاية الحاجز»، «أين كنّا؟»، «هل أخبرتك إيّاها»… فيعتقد كلّ قارئ (عبر هذا التكنيك) أنّه هو المُخاطب المجهول الذي تكتب اليه البطلة روايتها من «قبوٍ في قلب الحصار».
اختلاف
تستخرج الراوية أفكارها تدريجاً – بالطريقة التي تخطر لها – بحيث تلجأ إلى تقنية «التناوب»، فتتوقف عن سرد الحكاية الأولى لتروي جزءاً من الثانية ثم تعود إلى الأولى. ومن ثمّ نكتشف أنّ ثمّة مساراً زمنياً محدداً تتبعه الراوية، يحفظ تراتبية الأحداث وتدرّجها. ولعلّ المحطات التي تتوقف عندها الراوية مقرونة دائماً بفكرة «الاختفاء»: اختفاء الأب (البيت)، اختفاء الأم (حاجز الاستخبارات)، اختفاء الفتاة الصلعاء (المستشفى العسكري)، اختفاء الأخ (الحرب في الغوطة)، اختفاء صديقه حسن (القبو تحت الحصار). وهذا إن دلّ فعلى فكرة الطمس والمحو والانعدام. وماذا بقي من سورية في صراع البعث الشمولي مع المتطرّف العقائدي؟
نعود إلى النصّ حيث يبدو لافتاً جداً تكرار السرد. فالراوية ترجع مراراً في خطابها الى الحدث عينه كأنما لترسخه في أذهاننا (علاقتها بالأوراق والمكتبة، معصمها المقيّد بمعصم أمّها…). وإذا قرأنا عن معنى هذا التكرار في معاجم النقد، نجد غالباً أنّ «تكرار السرد شائع عند الأطفال. هم يطلبون دائماً إعادة الرواية التي رويناها لهم، وكثيراً ما يتمنون إعادتها في الحال». وتأتي هذه التقنية لتُرسّخ طفولية الشخصية (وهي شابة لم يُحدّد اسمها ولا عمرها)، المأخوذة بعوالم «أليس في بلاد العجائب» و «الأمير الصغير». وبالحديث عن هاتين الروايتين، نجد أن يزبك تُقيم علاقات ظاهرة مع نصوص عربية وعالمية أخرى، لكنّ هذا التناص يأتي تارةً حرفياً كما في الاستعانة بنصّ (فصل) من كتاب الثعالبي وعنوانه «في ضروب الألوان والآثار»، وطوراً محاكاةً بمعنى التقليد والتحويل كما في «الأمير الصغير»: «ترى الحياة كأنها عبارة عن مستطيل غريب الشكل، يشبه الأفعى التي تبتلع فيلاً» (ص 48).
حين نقرأ في مستهلّ الرواية «لا أعلم إن كنت مهتماً بملمس الأوراق… ولن يُفيدك أي تفصيل أضيفه حول أصابعي حين أمررها فوق الأسطر التي دوّنتها يداي»، ثمّ نقرأ في اختتامها «لم أعد أركّز في الحروف. عليّ أن أصرخ»، نفهم أنّ تلك «الأسطر» ليست أكثر من صرخة أطلقتها البطلة أخيراً بعد سنواتٍ من «الخرس» الاختياري. كأنها تعوّض بالكتابة عن فضفضة لفظية حُرمت منها (لا تحرّك عضلة لسانها)، وفضفضة بصرية ضاقت عنها (مقيدة داخل غرفة ضيقة). تصف الفتاة نفسها (في الصفحة الأولى) بأنّها «مختلفة عن بقيّة البشر»: «أقف وأنطلق بالمشي. أمشي وأمشي. أرى الطريق بلا نهاية. تقودني قدماي وأمشي. أنا ألحق بهما فقط» (ص7). لكنّ «المشي» هنا لا يحمل المعنى الفلسفي اليوناني، ولا يُقارب المفهوم الذي طرحه أنطوان أبو زيد في روايته «المشّاء»، وإن كان العنوان يُحيلنا عليها. ولعلّ «مشّاءة» سمر يزبك ليست سوى النموذج المتخيّل للسوري التائق إلى التحرّر والانطلاق بعد عقود من حياةٍ متشنجة، أو الأصحّ مكبلة، في السجون كما في الشوارع والمنازل التي تنمو على جدرانها الآذان.
تحافظ يزبك على مستوى كلام بسيط يتناسب وشخصية الفتاة، فتبدو ألفاظ الراوية أبسط من معانيها، هي التي اكتشفت مثلاً أنّ الحياة ليست أكثر من تمرين على الموت، تماماً مثلما نتمرّن على الخطّ واللون قبل الرسم والكتابة.
تحولات
ظلّت يد الابنة «المشاءة» مربوطة دائماً بيد أمّها حتى ارتسم على معصميهما سواران بلون الدم المتجمد. أما اختلافها عن الآخرين فجعلها في نظر الجميع «مجنونة». ولم يكن ممكناً أن تلتحق بمدرسة، فظلّت حبيسة غرفة ضيقة في مخيم جرمانا، أو في مكتبة الستّ سعاد.
البيئة الاجتماعية التي تنتمي إليها الفتاة وعائلتها معدومة. تعمل الأم في تنظيف حمّامات إحدى المدارس. كانت تصطحب ابنتها معها، تُقيّدها بأحد عوارض المكتبة بحبل طويل وتتركها تحت مراقبة أمينة المكتبة، الستّ سعاد. في ذاك المكان، وجدت الراوية «كوكبها السحري»، على طريقة بطل أنطوان دو سانت اكزوبيري. علّمتها الست سعاد على مدار سنوات الكتابة والقراءة حتى صارت المكتبة كلّ حياتها. وحين تعود الى البيت، تقضي وقتها بالرسم والقراءة والكتابة. فالورق متعتها الوحيدة، وإن كانت تستمتع أحياناً بمداعبات الشاب الذي يوصل اليهم الأغراض من دكان الخضرجي.
مرّة، أرادت الأم وابنتها تلبية دعوة الست سعاد الى بيتها في «ساحة النجمة». كان عليهما أن تقطعا محطتين (باصين) كي تصلا الى المدينة. توقف الباص الثاني عند حاجز تابع للاستخبارات، أخذ يدقق في الهويات. يسبّ بعضهم، ويُجبر بعضهم الآخر على النزول لأنّه من قرية لا يوالي أبناؤها جميعاً النظام. وفي خضم معمعة التنزيل، انقطع الحبل الذي يربطها بيد أمها، فكأنّ حبل السرة انقطع فعلاً بين الأم وابنتها. شعرت بأنها ولدت من جديد حين استقلّ جسدها عن جسد أمها، فراحت تمشي بحرية غير آبهة بصراخ أمها. قدماها تجرّانها بلا وعي والأم تلحق بها. أطلق العسكري النار عليهما فتموت الأم وتستفيق الابنة الجريحة في المستشفى العسكري على صوت ممرضة تقول «هذا جزاء من يتظاهر ضد سيادة الرئيس».
الذات
التقت هناك بنساء معتقلات سياسيات، سمعت منهنّ ما لم تسمعه يوماً. إحداهنّ كانت صلعاء بعينين دائريتين وواسعتين جداً. سألتها إن كانت بكماء، فأجابتها بالإيجاب، علماً أنّ خرسها كان خياراً لا قدراً. « أنا لست خرساء، وكنت أرتّل القرآن، لكنني لا أرغب في الكلام، وأحبّ قراءة كتاب «الأمير الصغير» بصوتٍ عالٍ عندما يغيب أخي وأمي عن البيت» (ص 55)، تقول الراوية. وحين أخذها شقيقها من المستشفى، ذهبا معاً الى الزملكا في الغوطة الشرقية. سكنت في بيت تجتمع فيه عائلات، علمت من الحياة معهم أنّها لم تكن تعرف شيئاً من حقيقة هذا العالم، «ولا حتى ظلال هذا العالم الذي اعتقدتُ أنّ الكتب أخبرتني عنه بكل شيء» (ص75). وراحت تعلّم الأطفال الرسم بالألوان قبل أن تقصفهم الطائرات بالكيماوي وتجعلهم جميعاً بلون واحد.
ترصد سمر يزبك الحرب السورية الراهنة من الداخل. تتفادى أيّ مقاربة عيانية – اجتماعية، وتغوص في ذات الفرد نفسه. تطلّ على مشهد الدمار الشامل بعين فتاة تنتمي إلى فئة الشخصيات التراجيدية المتروكة لأقدارها. أما البطل الحقيقي للرواية فيبقى «الغياب»، الذي يبتلع كلّ الشخصيات، بمن فيها الراوية التي تبقى وحيدة داخل قبو في مدينة محاصرة بلا أكل وشرب، فنتوقع أن تتيبّس في النهاية كما تيبّست التفاحة التي ظلّت تأكلها على مدار أيام. «وأنا حكاية سأختفي ربما… حلقي جاف، رأسي يدور، لم أعد أركّز في الحروف. وعليّ أن أصرخ» (ص 206). وهذه النهاية تأتي لتُضيء معنى الإهداء الذي كتبته يزبك «إلى رزان زيتونة، في غيابها المرّ».
تُضاف «المشّاءة» إذاً الى روايات كثيرة عن الحرب السورية الراهنة، ولكن هل يمكن هذه الكتابات المتكاثرة أن تؤسس لمرحلة جديدة في الأدب السوري؟ وبماذا عساها تُسمّى، أدب الحرب أم الثورة؟
الحياة